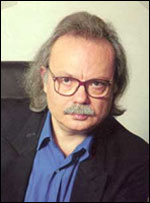 ظل التأثير الثقافي المشرقي على المغرب أهم سمة تتميّز بها أزمنة تطور الإنتاج الأدبي في المغرب وأهم خاصية نجد تمظهراتها في كل الأجناس الأدبية، خصوصاً منها الشعر والرواية اللذين ظلا ظلين للأصل المشرقي الذي أحدث تغييراً في الإبداعية العربية.
ظل التأثير الثقافي المشرقي على المغرب أهم سمة تتميّز بها أزمنة تطور الإنتاج الأدبي في المغرب وأهم خاصية نجد تمظهراتها في كل الأجناس الأدبية، خصوصاً منها الشعر والرواية اللذين ظلا ظلين للأصل المشرقي الذي أحدث تغييراً في الإبداعية العربية.
من هذا التأثير الفعّال تكوّن لدى المثقفين المغاربة سؤال الإبداع وسؤال قراءة هذا الإبداع في كل المناسبات المتاحة التي عرفوا فيها نظريات الشعر العربي الحديث وقربتهم من تجربة الشعراء الحداثيين، وفتحت أمامهم آفاق التفكير في موضوع العلاقة بين الشعر واللغة والرؤيا والتراث والبنية الشعرية فكانت لقراءتهم للشعر والشعراء المشرقيين الأثر الكبير في تشكيل مسارات جديدة للشعر المغربي أعاد به الشعراء المغاربة النظر في كل مكوّنات الإبداعية الشعرية المغربية في علاقتها بذاتها أو في علاقتها بكل السياقات التي تمتح منها مقومات وجودها وفاعليتها واختلافها.
وهناك طبعاً وسائط ثقافية كانت قنوات اتصال بين المشرق العربي ومن بينها المجلات الثقافية التي كانت منبراً حقيقياً تحقق به الكثير من العمق في الرؤية التي تنظر الى التحولات الثقافية والفنية في الوطن العربي. هذه المجلات المغربية التي واكبت هذا التأثير، وساهمت في ترويج نظريات الأدب الجديد، وإذاعة ونشر الدراسات والمتابعات النقدية التي عرفت بكل مظاهر الحداثة في شقّيها الإبداعي والنظري. ومن بين هذه المجلات: "الثقافة الجديدة" التي أصدرها الشاعر محمد بنيس؛ و"الزمن المغربي" للروائي والشاعر بن سالم حميش... ومجلة "آفاق" التي يصدرها اتحاد كتاب المغرب.
أما المجلات المشرقية ـ خصوصاً منها اللبنانية ـ فقد ساهمت بجديدها في إذكاء الوعي بهذه التحولات؛ وذلك بنشر الأدبيات الماركسية والوجودية والحداثية التي تغذّت عليها مسارات الفعل الثقافي في المغرب؛ فكانت مجلة "الآداب" ومجلة "شعر" إحدى أهم المنابر الثقافية التي أسهمت في التعريف بالنتاج الأدبي العربي، والغربي عبر أهم محطاته ورموزه وأعلامه.
والوقوف على التجربة الأكثر حضوراً في هذا التأثير، جعل من مجلة "شعر" الأكثر رواجاً بين الشعراء والنقاد والمثقفين المغاربة؛ باعتبارها كانت الأكثر تحفيزاً لهم على إعادة قراءة الموروث الشعري المغربي للخروج من هيمنة الهندسة الخليلية المعروفة التي كان يعيش في سراديبها الخطاب الشعري التقليدي الاتباعي المحافظ.
وفي سياق الاهتمام بموضوع الحداثة، والتراث، والغرب؛ والحداثة والواقع كاختيارات جوهرية تبلور مضمونها مع ميلاد ورواج مجلة "شعر" والتنظير الشعري للقصيدة الحديثة، وللرؤيا؛ وتأسيس نظرية للشعر العربي الحديث، برزت مسألة أساسية أرادت إعادة النظر في المسلّمات الشعرية المعروفة كالوزن والقافية ليصير الإبداع تجاوزاً للموجود وتحطيماً للقيم الشعرية الثابتة بهدف الإمساك بواقع إبداعي جديد تحكمه أو تحرره رؤيته الجديدة لطبيعة الشعر.
معاني التغيير
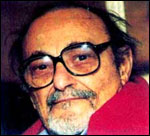 ومثل هذه الطروحات التي راجت بين الشعراء المغاربة؛ كانت وراء الدراسات النقدية، ومقاربات وازنة رسخت مفاهيم قرائية جديدة؛ وأكدت أن معاني التغير الحقيقي لا تتم إلا بخلفيات ثقافية يعي فيها المثقف كل المكوّنات والمفاهيم والأدوات الإجرائية التي تخلف دينامية إبداعية جديدة؛ وضمن منشورات "اتحاد كتاب المغرب" أصدر الناقد المغربي الباحث حسن مخافي كتاباً يهتم ـ خصوصاً ـ بمجلة "شعر" كمرجع هام ساهم في هذا التغير. والكتاب يحمل عنوان "القصيدة الرؤيا. دراسة في التنظير الشعري" وفيه يجيب عن سؤالين مركزيين تناول فيهما المرتكزات التي انطلقت منها مجلة "شعر" لتؤسس للحداثة الشعرية في العالم العربي، ثم الكيفية التي بها تشكل التنظير الشعري ولتطوير الممارسات النقدية في نسق متكامل.
ومثل هذه الطروحات التي راجت بين الشعراء المغاربة؛ كانت وراء الدراسات النقدية، ومقاربات وازنة رسخت مفاهيم قرائية جديدة؛ وأكدت أن معاني التغير الحقيقي لا تتم إلا بخلفيات ثقافية يعي فيها المثقف كل المكوّنات والمفاهيم والأدوات الإجرائية التي تخلف دينامية إبداعية جديدة؛ وضمن منشورات "اتحاد كتاب المغرب" أصدر الناقد المغربي الباحث حسن مخافي كتاباً يهتم ـ خصوصاً ـ بمجلة "شعر" كمرجع هام ساهم في هذا التغير. والكتاب يحمل عنوان "القصيدة الرؤيا. دراسة في التنظير الشعري" وفيه يجيب عن سؤالين مركزيين تناول فيهما المرتكزات التي انطلقت منها مجلة "شعر" لتؤسس للحداثة الشعرية في العالم العربي، ثم الكيفية التي بها تشكل التنظير الشعري ولتطوير الممارسات النقدية في نسق متكامل.
عرّف الباحث بحركة مجلة "شعر" التي اعتبرها أول منبر أدبي عربي كرّس نفسه للشعر العربي الحديث؛ وقضاياه؛ فكان أول عدد في كانون الثاني 1957 في بيروت تحت رئاسة الشاعر يوسف الخال؛ واستمر صدورها الى خريف 1964 حين أعلن الخال عن توقفها... ثم ترى المجلة النور من جديد في كانون الثاني 1967 لكي تتوقف نهائياً بعد خريف 1969.
وضمن الدراسات التي قدمها هذا الكتاب "مفهوم الحداثة لدى مجلة شعر" وعزا الباحث انشغال هذه المجلة بدراسة التراث الى ما قاله يوسف الخال كون اهتمام المجلة انصب ـ بالدرجة الأولى ـ على السير الى الأمام بالشعر العربي على ضوء ما توصل إليه قرينه في الغرب من تحولات في البنية الشعرية ولغتها وصورها؛ وعلى الرغم من وجود إشارات عابرة ـ في سياقات متعددة ـ الى التراث؛ فالباحث يكشف عن رؤية "المجلة" للتراث في أشكال متعددة، بعضها صريح، والآخر ضمني.
ان مجلة "الشعر" لم تكتفِ بتذويب التراث العربي في إطار إنساني عام؛ بل أن هذا التراث الذي شكل هاجسها في التنظير للشعر؛ كان يدعوها كي تجعل تأطير التراث العربي في التراث الإنساني إبداعاً، وأن تأخذ من الغرب وفي الوقت ذاته تجاوز الحساسيات التي يمكن أن "تترتب عن هذا الأخذ".
وأهم سمات الدراسة ـ في هذا الكتاب ـ الحداثة والغرب، وموقع الغرب في الفكر العربي المعاصر ومفهوم الغرب لدى حركة مجلة "الشعر"، ثم موقف "شعر" من الشعر الغربي، وفي طرحه للعلاقة بين العرب والغرب، ذهب الباحث الى أن حركة هذه المجلة انطلقت من مفهومها للغرب، وتعاملها معه، وموقفها منه، وذلك من منظور يلغي المسافة بين الشرق والغرب، مع وجود مفارقات تحكم هذا المفهوم، وتحدد أن الموقع الذي أفرز القصيدة العربية الحديثة، لا يشبه الواقع الذي أنتج الشعر القديم، أو الواقع الذي أنتج الشعر الغربي، أما عن مسألة تطوير القصيدة العربية الحديثة، فظل مجرد تحوّل شكلي في بداية أمره.
أما عن مسألة الحداثة الفنية، ومسألة موقع الغرب في الخطاب العربي المعاصر، فيتحدد حسب الباحث، ضمن مفارقة كانت ولا تزال تعكس عدم نتيجة هذا الخطاب العربي المعاصر الخاصة به والمنبثقة منه طبيعته فإن الغرب يعتبر الوجه الآخر لهذه الإشكالية، ذلك أن في وعي العرب توجد صورتان عن الغرب: غرب التقدم التقني والحرية والعقلانية، أما الغرب الآخر، فهو الغرب الاستعماري.
مفهوم الغرب
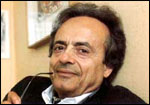 أما مفهوم الغرب لدى حركة مجلة "شعر" فيمكن تلمس وجوده في سياقات متعددة داخل كتابات شعر؛ ذلك أن المسوغات التي قدمتها "المجلة" بحثاً عن مشروعية التماثل مع الغرب، تبدو عليها علامات التفكك ومعنى ذلك أنها لم تقم بقراءة نقدية للثقافة الغربية؛ لأن حلمها الحداثي جعلها تجري وراء التجارب الشعرية لدى الآخر، متجاهلة خصوصيات المجال الذي تتحرك فيه.
أما مفهوم الغرب لدى حركة مجلة "شعر" فيمكن تلمس وجوده في سياقات متعددة داخل كتابات شعر؛ ذلك أن المسوغات التي قدمتها "المجلة" بحثاً عن مشروعية التماثل مع الغرب، تبدو عليها علامات التفكك ومعنى ذلك أنها لم تقم بقراءة نقدية للثقافة الغربية؛ لأن حلمها الحداثي جعلها تجري وراء التجارب الشعرية لدى الآخر، متجاهلة خصوصيات المجال الذي تتحرك فيه.
أما عن القصيدة/ الرؤيا؛ فهي موصولة الى القيم التي تدافع عنها العصرية بالمفهوم الذي كانت حركة مجلة "شعر" تدافع عنه كقيم خالدة، ولكنها قيم غير ثابتة. أي أنها تعبّر عن نفسها بطرق مختلفة من عصر الى عصر؛ كما أن نظرة الإنسان الى هذه القيم في تغيير متميّز. ويدقق الباحث ـ حسن مخافي ـ في مفهوم التجديد الشعري لدى شعر، ويؤكد ـ على ما اتفق حوله الدارسون ـ أنه وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في تميّز تجربة حركة مجلة "شعر" فإن التجديد من ناحية، يبلور موقفاً من التقليد من ناحية أخرى وقد دفعها ذلك الى قراءة التراث الشعري العربي؛ والى الاطلاع على التجارب الغربية التي لم تتأخر في الدعوة الى الاستفادة منها، هكذا عمدت الى نقد الشعر القديم الذي لم يعد يمثل العصر وعمدت الى القول إن التجديد في الشعر لا يتحقق بالاجتهاد في المسائل العروضية والشكلية عامة وإنما التجديد يعبر عن نفسه أثناء إعادة النظر في المضامين التي تعيد بناء العلاقة بين الشعر والشاعر والعالم سواء أكان هذا العالم موضوعياً خارجياً أو ذاتياً داخلياً.
لقد سعت "مجلة شعر" الى إثبات أن للشعر وظيفة قد ترقى الى وظيفة العلم، أي أن للشعر وظيفة معرفية تسمو عن المعرفة العلمية. وأن وظيفته تكمن في الكشف عن هذا اللامرئي الذي ينتصب وراء العالم المرئي المحسوس فألحت على مبدأ الحرية في مقارباتها للعالم بصياغة مضمون جديد للعمل الشعري. أما عن الشعر والرؤيا، فقد جعلت "شعر" تنظر لعلاقة الشعر بالعالم كما تنظر لفن دون حدود.
اللغة الشعرية
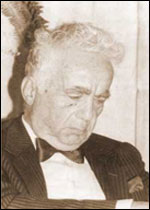 وقد طرح الباحث حسن مخافي سؤالا حول اللغة الشعرية قائلاً: "هل هناك لغة شعرية وأخرى غير شعرية"؟.
وقد طرح الباحث حسن مخافي سؤالا حول اللغة الشعرية قائلاً: "هل هناك لغة شعرية وأخرى غير شعرية"؟.
إن اللغة الشعرية ـ كما يحدد جوابه ذلك ـ لا تتحدد الا من خلال وظيفتها واشتغالها داخل القصيدة، وقد قدم ـ في هذا السياق مفاهيم يوسف الخال حول "اللغة المحكية" عبر إشكالية اللغة العربية، أو ما يسميه "جدار اللغة"، ثم قدم مفهوم سعيد عقل، أما شعرية اللغة العربية الفصحى، فيبدو أن أدونيس كان من أقوى المعارضين لمشروع يوسف الخال اللغوي على النقيض من أنسي الحاج الذي كان يبدو أكثر تطرفاً في هذا المجال. أما عن مصادر الشعرية في اللغة فيراها الباحث حسن مخافي ـ عند مجلة شعر ـ ذات ثلاث رؤى تطرح نظاماً لغوياً بدل اللغة العربية الفصحى، وهو نظام يتمثل في اللغة المحكية، والرؤيا الثانية تتمسك بلغة الضاد، أما الرؤيا الثالثة فتبدو متمردة على الرؤيتين معاً دون أن تجهد نفسها في بناء نظامها الخاص.
وحول الصورة الشعرية، فإن حركة مجلة "شعر" قد وجدت متنفساً لها في هذه الصورة يمكنها من التملص من سلطة اللغة، وإذا كانت اللغة بمرجعيتها الاجتماعية والتراثية تبدو وكأنها خارج إرادة الشاعر، فإن إحدى أدوات امتلاك اللغة بالنسبة للشاعر تتمثل في الانزياحات اللغوية التي تتم عن طريق الصورة الشعرية، ومن هنا كانت مهمة جماعة شعر صعبة، فهي من جهة كانت تهدف الى الكشف عن الرؤيا الشعرية، التي هي بطبيعتها التكوينية غامضة، وهي من جهة ثانية، أرادت أن تعبر عن هذه الرؤيا بلغة تقترب من حيث قاموسها ـ على الأقل ـ من اللغة اليومية، وهكذا حددت مجلة شعر الوظائف الممكنة للصورة الشعرية في الوظيفة التوضيحية التي نستطيع بوساطتها أن ندرك المجردات، ثم الوظيفة البنيوية، أي مساهمة الصورة الشعرية في بناء القصيدة بناء عضوياً، ثم الوظيفة الكونية التي تصل فيها الصورة الى ذروة تألقها، وهذه كلها وظائف متداخلة لا يمكن وضع حدود بين بعضها البعض.
وقد قدم الباحث حسن مخافي في موضوعة "الشعرية" طروحات تتعلق بشعرية الرمز الأسطوري، معتبراً أن هذا الرمز يعبر عن حقيقة مطلقة، أما حركة مجلة شعر فكانت تعتبر الشعر تجسيداً للمطلقات، ومن ثم جاء هذا الدفق الميتافيزيقي للشعر لدى الحركة حيث تخلت القصيدة الحديثة عن الغنائية، واتجهت بها نحو الصورة، لأن وظيفة الأسطورة في الشعر وظيفة رمزية وإيحائية تلعب دوراً كبيراً في البناء الرؤيوي للقصيدة، ومن هنا يتجلى التوظيف الفني للأسطورة في الشعر لدى حركة مجلة شعر.
التلقي
وحول تلقي الشعر، فقد حددت هذه المجلة عملية التلقي الشعري طبيعة الشعر ذاته، لأنه في النهاية تجربة فردية، بالمعنى الوجودي للتجربة، وعليه، فلكي يتم استيعاب هذه التجربة، فإن على القارئ أن يعيد إنتاجها، وهذا مستحيل، لأن الشاعر نفسه لا يستطيع أن يعيش تجربة واحدة في لحظتين زمانيتين اثنتين، وهذا ما جعل أدونيس يضع هذا التلقي أمام طرفي نقيض، الشعر والجمهور، لأنه لا يمكن فهم هذا التناقض إلا بالرجوع الى بعض الثنائيات التي ارتكزت عليها مجلة شعر في مفهومها للشعر، وعلى رأس هذه الثنائيات: الفرد/المجتمع، الشعر/الواقع، وفي نفس السياق تنطرح مسألة الغموض الدلالي، كقضية مضمون شعري قبل كل شيء، وهذا ما جعلها ترجع عدم قدرة الجمهور على استيعاب الشعر الى مضمونه.
ويطرح الباحث حسن مخافي في موضوع الشعر والوزن، قضية قصيدة النثر في مبحث يحمل عنوان: "نحو قصيدة نثر عربية" وأبرز الأشكال الشعرية بين القديم والحديث، ورأى أن أولوية المضمون في تحديد مفهوم الشعر لدى حركة "مجلة شعر" لا يلغي أهمية الأشكال التعبيرية التي يجب أن تصوغ المضمون، ذلك أن هم الحركة إنصب ـ بالدرجة الأولى ـ على محاولة إيجاد دور متميز للشعر يضمن له خصوصيته الشعرية، وذلك بالبحث عن صياغات جديدة من شأنها أن تستوعب تجربتها الشعرية.
ولعل ما يميز حركة مجلة شعر أثناء الحديث عن الأوزان الشعرية، هو موقفها من قوانين الخطاب الشعري العربي، ثم الأزدواجية التي تتمثل ـ من ناحية ـ في الدعوة الى حرية الشعر العربي الحديث ـ ومن ناحية ثانية ـ في إصرارها على اعتبار نفسها امتداداً للتراث الشعري العربي، وترفض أن يكون الوزن مقياساً لفرز الشعر عما هو غيره، ذلك أن تحديد الشعر بالوزن تحديد خارجي سطحي يتناقض مع الشعر، إنه تحديد للنظم لا للشعر، فالأوزان الخليلية منافية لوظيفة الشعر، لأن الشعر ضرب من المعرفة بخبايا الأشياء، وهكذا تمردت مجلة شعر على الوزن، وأعلنت عصيانها على القافية، وهي لا تطرد العنصر الموسيقي من العملية الشعرية، بل تدعو الى حرية اختيار الشاعر لهذا العنصر وملاءمته مع التجربة الحديثة بصفة عامة، بل تقر بضرورة العنصر الموسيقي، وتقر بالحدود بين الشعر والنثر، وكيف أنها كانت تعمل ـ جاهدة ـ على استنبات قصيدة النثر في الأدب العربي الحديث، وقد عرض الباحث مخافي خصائص قصيدة النثر حين جعلت مجلة شعر هذا الفن قائم الذات يتمتع باستقلاله كنوع أدبي، ثم يعرض الى موقف النقد العربي من قصيدة النثر.
وفي المبحث الأخير من كتاب "القصيدة والرؤيا" استعرض الباحث الممارسات النقدية، وتحدث عن مسألة النقد الأدبي في تصور مجلة شعر، واستعرض ملامح النقد المنهجي في تنظيرها، وختم مشروعه الذي يقدم قراءة ناقد مغربي لتجربة "شعر قائلاً": إن النظر الى شعر بوصفها مشروعاً ثقافياً وشعرياً، لا يمكن أن يلغي التفاعلات التي صاحبته، والتي أدت الى إجهاضه، حتى يخيل للدارس أن "شعر" قد أتت متقدمة عن زمانها، فقد رفضت الحركة ما كان يسمى، الى عهد قريب، الشعر الملتزم، وذلك في وقت اعتبر فيه الأدب عامة، والشعر خاصة، أداة في المعركة من أجل القومية والوحدة، من هنا فإن الذين حاكموا الحركة، فعلوا ذلك انطلاقاً من عدم التزامها بالترويج لشعارات المرحلة، فهل تعني العودة الى مجلة شعر التي دشنت مع بداية الثمانينيات تخليا عن تلك الشعارات"؟.
أسئلة كثيرة رافقت الناقد المغربي حسن مخافي وهو يعيد قراءة المشروع الشعري والنقدي لمجلة شعر، وهو في قراءته يريد الخروج بكثير من الأحكام والأفكار والقضايا التي واكبت هذه الحركة، فجعلت الشعراء والنقاد في المغرب يعيدون النظر في علاقاتهم بالشعر بعد أن شغلتهم هذه الحركة بجديدها وبمشروعها الشعري في الرؤيا وفي اللغة وفي قصيدة النثر.
المستقبل
الثلاثاء 26 تشرين الأول 2004