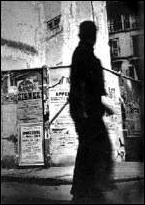 في السعودية أصدرت الدكتورة فاطمة عبد الله الوهيبي كتابا علي نفقتها الخاصة بعنوان "الظل..أساطيره وامتداداته المعرفية والإبداعية ..
في السعودية أصدرت الدكتورة فاطمة عبد الله الوهيبي كتابا علي نفقتها الخاصة بعنوان "الظل..أساطيره وامتداداته المعرفية والإبداعية ..
وعبر فصوله تناقش حكايات الظل في المثيولوجيا، والظل في المدونة التراثية والدينية خاصة في القران الكريم والحديث الشريف، والظل لدي بعض الفرق الدينية، والظل في المدونة الكلامية والصوفية، والظل والفلسفة، والظل وعلم النفس والكتابة، والظل في التراث العربي، وفي الأدب الروائي، وفي الشعر العربي والأجنبي..
والكتاب المهم ينطلق من فكرة أساسية، أن الظل مرتبط بهاجس الإنسانية الأساسي وهو الموت..
ننشر في البستان التمهيد الخاص بالكتاب بالإضافة إلي فصليه الأول والثاني اللذين يناقشان فكرة الظل في المثيولوجيا، والظل في المدونة التراثية والدينية.
الظل لايظهر إلا في فضاء بصري، ولابد من مصدر ضوء ليتحقق حضوره في هذا الفضاء. ولذلك فكل تفكير بالظل سيأخذ في الحسبان مسألتين مهمتين: الأولي تتعلق بفكرة الانعكاس، فالظل انعكاس لشيء معرض للضوء، وما يترتب علي الانعكاس من رؤي ذات علاقة بالامتداد والتضاعف والتناسل، وماينطوي تحتها من امور ذات صفة أفقية ترتبط في النهاية بفكرة الحركة والزمن. والثانية تتعلق بالأصل والفرع. وتنطوي تحت هذه الثنائية مسائل لها صفة العمودية الفوقية والتحتية والتبعية وتفضي هذه المسائل إلي طرف ميتافيزيقي ولاهوتي مرتبط بالمحتد وفكرة العود، وهي تلتف مرة أخري لتتشح ببعدها الزمني الصاعد الي مبتداه. وكلتا المسألتان 'الانعكاس والأصل والفرع' متشابكتان ومتداخلتان.
إن فكرة النور العظيم المرتبط بالمطلق فكرة سائدة في معظم الديانات، ومن هذا النور يشع الإله علي الكائنات والموجودات التي تمسي بدورها ظله علي الأرض.
إن كلمة 'dingir' التي تعني في بلاد ما بين النهرين 'المضيء والساطع' كانت في الوقت نفسه اسم إله السماء،كما أن الجذر السنسكريتي 'div' الذي يعني البريق واليوم يعطي في اللاتينية devus,deivos, dios, dyaus، ومنها يتفرع، كما نلاحظ 'النهار' و'الله' في كثير من اللغات المنحدرة عن اللاتينية. والأوبانيشاد.. ملأي.. برموز النور، فالله يسمي فيها المتألق، وهو إشراق ونور كل الأنوار وكل مايتألق ليس سوي ظل ألقه.
والمتصوفة المسلمون تحدثوا - كما سنري في الفصول القادمة - عن النور الإلهي وعن الظل بوصفه الأصل، وربطوه بالذات الإلهية التي منها شعت بقية الظلالات علي الموجودات . ويمكن القول إن معظم الثقافات والديانات 'صورت الاسرار الإلهية من خلال النور. وما كان بالإمكان شرح هذه الأسرار لولا هذا التمثيل - وهذا أمر منسجم مع التقاليد الصوفية واللاهوتية.. المفاهيم الفلسفية ذاتها، وهي مفاهيم معقدة،.. تصور من خلال أمثلة بصرية.
والمسألة البصرية المرتبطة بالرؤية حاضرة في تلك المعالجات اللاهوتية والفلسفية. وأكبر رمز ضوئي هو الشمس، ومن هنا التلازم الواضح بين الشمس الحقيقية والمجازية وبين الظل والتنويعات عليه صوفيا وفلسفيا وأسطوريا وأدبيا. وقد ارتبط الاثنان، الشمس والظل، بالفضاء البصري وبالعين تحديدا. ومن هنا كثرة الترميزات إلي العين بوصفها تقوم بالدور التبادلي مع الرمز المطلق، وتغدو في التبادل التماثلي بالموقع نفسه الذي يشير إلي النور وما يتفرع عنه من ألق وأشعة وظلال. فكثير من الأساطير تؤكد تماثل العين والنظر والعلو الإلهي. فالإله السماوي فارونا يسمي ذو الألف عين ، كما أن بعض شعوب سيبيريا وكثيرا من الشعوب الأخري تعتبر الشمس عين الله. كما أن الشمس هي عين مثرا وفارونا عند الفيدا، وهي عند الفرس عين أهورا - مزدك، وعند اليونان هيلوس هي عين زيوس، وعند المصريين عين رع.
وفي التراث الإسلامي الصوفي تتكرر صورة الشمس والعين في الإحالة إلي النور العظيم وظلاله في الأرض. وابن عربي يورد في فصل يسميه 'أفاضة العقل نور اليقين علي ساحة القلب' مثالا يقرب فيه فكرته، يقول فيه إن الشمس إذا قابلت الجسم الصقيل فإنه ينبعث عن هذا الجسم نور يضيء مالا تقابله الشمس بانعكاس الشعاع. ويؤكد علي أن من أراد أن يري الشمس فليجعل عينه في الموضع الذي يضرب فيه النور المنعكس.
ولذلك فللضوء والرؤية شكل مثلث - كما يقول - الأول الشمس، والثاني الجسم الصقيل، والثالث موضع ضرب الشعاع المنعكس. وبعد أن يمهد هذه المقدمة يقول: 'واعلم بعد أن ضربت لك المثال أن النفس الحيوانية يفيض عنها نور من جانب التجويف الذي فيه الروح.. فيصل إلي أقصي أماكن الجسد، ثم ينعكس ذلك النور مثل حركة الفلك فيرقي حتي يصل الي الدماغ فيتصل بالعقل اتصال سريان يكون له تأثير استفاضة علي عين البصيرة، فإذا ظهر ذلك النور لعين البصيرة كالشمس للبصر... فينعكس الشعاع من عين البصيرة علي ساحة القلب كانعكاس الشعاع من العين علي المبصرات فينظر إلي عجائب الملكوت، وتتصل الأنوار، وتنفتح عند ذلك العين الثانية في القلب، وهي عين اليقين وهي ناظرة إلي نور اليقين، فإن لله تعالي نورين نورا يهدي به، ونورا يهدي إليه، وله في القلب عينان عين بصيرة وهو علم اليقين والعين الأخري عين اليقين. فعين البصيرة تنظر بالنور الذي يهدي به وعين اليقين تنظر بالنور الذي يهدي إليه، قال الله تعالي 'يهدي الله لنوره من يشاء' وهو نور اليقين. وقال في النور الاخر 'ويجعل لكم نورا تمشون به'، فإذا اتصل النور الذي يهدي به بالنور الذي يهدي إليه عاين الإنسان ملكوت السموات والأرض. ولاحظ سر القدر كيف تحكم في الخلائق وهو قوله تعالي 'نور علي نور'
وغير خاف أن العلاقة بين الروح والجسد مسألة لاهوتية فلسفية نوقشت منذ القديم، وهي ذات علاقة مباشرة بمسألة المعقول والمحسوس والمرئي والخفي، وقد نوقشت من مدخل خلود الروح وفناء الجسد. يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي: ولتصور إمكان خلود النفس هناك ثلاثة اتجاهات:
الأول: يقول إن الإنسان مركب من جسم وروح تقوم بنفسها جوهرا ينتقل في وجوده عن البدن.. والثاني يقول: ان الشخص هو نوع من الشبح والظل للإنسان وهذا الشبح أو الظل يفر من البدن عند الموت. وهذا الرأي نجده عند بعض آباء الكنيسة مثل ترتليانوس في كتابه 'في النفس' وبعض الروحانيين المعاصرين يقولون بقول شبيه بهذا حين يتحدثون عن البدن الكوكبي الذي ينفصل عند الموت ليقوم برحلة إلي بلاد الصيف والثالث: القول بوجود نوع من العقل في النفس، هو العقل الفعال مرتبط بفلك القمر، وهو وحده الجزء الخالد في الإنسان، وهذا هو رأي الإسكندر الأفروديسي والفارابي وابن سينا وابن رشد.
إن المفردات التي تربط بين الظل والشمس والنور والعين وبين مسألة الانعكاس كثيرة. وقد تكررت في نصوص المدونة التراثية والصوفية العربية - كما سنري - وهي ذات مساس مباشر بقضية الروح والعقل ووسائل العقل وحدوده في التعرف علي المحسوس المرئي والمعقول الخفي. إنه اللوغوس الأفلاطوني الذي تناول أفلاطون من خلاله قضية المعرفة وعلاقة العقل بعالم المحسوس وعالم المثل. يقول في الكتاب السادس من 'الجمهورية' بعد حوار طويل عن الحواس وموقع حاسة الإبصار وأهميتها وعلاقتها بمصدر الضوء العظيم الشمس. يقول:
'أليس صحيحا، أن الشمس غير الأبصار، وإن تكن هي سببه، وتدرك بواسطة الإبصار الذي تسببه؟.
- هذا صحيح
فقلت: حسنا. فلتعلم أن الشمس هي ما كنت أعنيه بالابن الذي خلقه الخير. وقد خلقها في العالم المنظور لكي يكون لها فيه، بالنسبة إلي الإبصار والأشياء المنظورة منزلة الخير في العالم المعقول بالنسبة إلي العقل والمعقولات.. فلتطبق هذه المقارنة علي النفس بدورها. فعندما تثبت نظرتها علي شيء وتنيره الحقيقة ويضيئه الوجود وتدركه في الحال وتعلمه ويتضح أنها تعلقته، فإذا وجهت نظرتها إلي عالم الأشياء المعتم، عالم الكون والفساد فإن إبصارها يظلم ولايعود لديها إلا الظنون، وتروح بها الآراء وتغدو بلا استقرار وكأنها عدمت كل عقل.
وفي محاورة 'فيدون' يورد أفلاطون قول سقراط التالي:
'ظننت أني مادمت قد فشلت في تأمل الوجود الحقيقي فينبغي أن أحرص علي عين روحي فلا أفقدها، كما قد يؤذي الناس عيونهم الجثمانية بشهود الشمس والنظر إليها أثناء الكسوف، مالم يتحوطوا فلا ينظرون إلا إلي الصورة المنعكسة علي الماء أو مايشبه من وسيط، حدث لي ذلك فخفت أن تصاب روحي بالعمي الشامل إذا أنا نظرت إلي الأشياء بعيني، أو حاولت أن أتفهمها بواسطة الحواس، وفكرت أنه يحسن بي أن أعود إلي المثل فأبحث فيها عن حقيقة الوجود، وإني لأعترف بنقص هذا التشبيه. لأنني بعيد عن التسليم بأن من يتأمل صور الوجود بوساطة المثل يراها' معتمة خلال منظار 'دون من ينظر إليها وهي في نشاطها وبين نتائجها.
هذا بعض من رحلة العقل في تأمله وجوده وصعوده بالدلائل إلي تأمل الوجود المطلق، إن ذاك الذي عبر عنه ابن عربي بعباراته عن نور البصيرة وعين اليقين يكاد يكون هو الهاجس نفسه عند أفلاطون، وهو يشرح فكرة الضوء والشمس والظلال وعماء البصر في التحديق بعين الشمس دون تدرج في الخروج من ظلمة الكهف التي سجن فيها السجناء يقول:
'فالسجن يقابل العالم المنظور، ووهج النار الذي كان ينير السجن يناظر ضوء الشمس، أما رحلة الصعود لرؤية الأشياء في العالم الأعلي فتمثل صعود النفس إلي العالم المعقول.. فآخر مايدرك في العالم المعقول بعد عناء شديد هو مثال الخير ولكن المرء ما إن يدركه حتي يستنتج حتما أنه علة كل ما هو خير وجميل في الاشياء جميعا، وأنه في العالم المنظور هو خالق النور وموزعه، وفي العالم المعقول هو مصدر الحقيقة والتعقل'.
إن الفهم الأول الذي يتبادر إلي الذهن أن الظل لارتباطه بمصدر الضوء الشمسي مظهر انعكاسي للشمس، وبذلك يبدو الظل دليلا علي وجود الشمس. لكن الآية الكريمة التي ربطت الظل بالشمس تستدعي سلسلة من التساؤلات حول المد والقبض والبسط، والطبيعة الحركية المتغيرة للظل. يقول تعالي: 'ألم تر إلي ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا' . ويقتضي الأمر التفكير لغويا وسيميولوجيا بمعني الدليل. وفي مادة 'دلل' سنجد مايلي ضمن عدد من الدلالات:
- الدل قريب المعني من الهدي وهما من السكينة والوقار في الهيئة.
- الدليل مايستدل به. وقال ابن منظور: 'والدليلة: المحجة البيضاء وهي الدلي. قوله: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قيل: معناه تنقصه قليلا قليلا.
الدليل هنا - كما فهمه ابن منظور من الآية - قائم علي معني النقص. ولست أجد في مادة دلل مايدل علي ذلك. ولكن هذا المعني غير بعيد عن سياق الآية الكريمة، حتي وإن لم تسعف مادة المعجم بمعني النقصان في حركة الدليل، إلا إذا كان المعني المجازي، المرتبط بالوضوح والانكشاف المتضمن في الدليل، هو المقصود هنا، حيث يتم نقله إلي الحقل الحسي البصري المتعلق بحركة الشمس، إذ تكشف الظل فتنقصه بذلك وتطويه أو تدرجه فيها. ولعله لذلك سميت المحجة الموسومة بالبيضاء بالدلي لاشماسها!!
لكن هذا بعد واحد من سياق الآية، فثمة مراحل في خلق الظل. الأول
: المد وقد مده الله، وخصه بصفة التغير والحركة التي هي عكس السكون. وقد نصت الآية علي ان إرادة الله جعلته غير ساكن، وهذا يدفعنا للتفكير في المعني أعلاه من معاني مادة دلل، حيث الدل مرتبط بالسكينة والوقار، فإذا ماربطنا هذا بما جاء بعد ذلك في الآية 'ثم جعلنا الشمس عليه دليلا' يمكن أن نري أن الشمس ستوقف تغير الظل وحركته وستجعله ساكنا. ولعل هذا ما جعل ابن منظور يقول في معني الآية إن الشمس تنقصه قليلا قليلا. وهذه هي الحالة الثانية من حالات الظل في الآية حيث دخل إلي الظل تأثير الدليل. أما الحالة الثالثة، وهي متسقة مع الحركة الثانية السابقة لها، فهي حالة القبض، فالشمس الدليل هيأت الظل بدخولها عليه وتغيير طبيعته الحية المتحركة ليدخل بعد البسط إلي مرحلة القبض والطي والاندراج في ملكوت الله 'إلينا' في رحلة العودة والمآل والصيرورة إلي الله.
إذا كان مأل الظل بعد المد إلي القبض والاندراج مرة أخري في النور المطلق 'قبضناه إلينا' فذلك يستدعي التفكير في الظل وهل هو مجرد ظاهرة كونية بصرية فحسب؟ إن حركة الظل، أي عدم سكونه، تشير إلي التغير والحركة اللذين هما من سمات ماهو حي، وهو مايفضي بنا إلي تأمل التقابل بين المد والقبض أو البسط والقبض. فمن أسماء الله - عز وجل - الباسط والقابض وهما اسمان يرتبطان ببسط الرزق وبسط الروح في البدن. والقبض من قبض الرزق والروح، وكثيرا ما ترد كلمة قبض فلان المدلالة علي الوفاة. وهذا مايوثق علاقة انسحاب الظل بالموت، ولعله من هنا كانت العرب تقول إذا مات أحدهم: أشمس فلان وضحا ظله وكان افتقاد الظل وانسحابه نذير الموت والقبض.
لكن اندراج الظل في النور دخولا في الصيرورة ربما يفسر أيضا مقولة إن الإنسان ظل الله في الأرض. فبسط الظل الإنساني - حسب المعطي السالف - بسط للحياة نفسها ومد في العمر، وقبضه انثناء الظل وطيه وعودته الي موجده وخالقه حينما يموت ويقبض ظله/ روحه وتنتهي حياته. وهذا يستدعي الي الذهن مقولة فويرباخ التي كانت في الأساس تنويعا لمقولة نيتشه عن موت الله. ففويرباخ يؤكد ان الله لم يكن سوي بسط للإنسان، وهذا الاخير مضطر إلي أن يثني الله ويعيد ثنيه. ويبدو أن هذه المقولة هي مقلوب قضية البسط والقبض لمد الظل الإنساني في الرؤية الصوفية وانطواء الكون فيه.
لكن القبض واندراج الظل وطيه في النور مرتبط باستواء الشمس، تلك الشمس التي رأي إليها المتصوفة مجازيا بوصفها المطلق. يقول ابن عربي 'وفي وقت الاستواء يغيب عنك ظلك فيك . وظلك حقيقتك ' ويقول : ' و في الاستواء 'أعني استواء' الشمس في قبة الفلك علي رأس الرجل سر لاينكشف ولانودعه كتابا، وهو موجود في قوله تعالي: 'ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا'.. والشمس وجود الحق، والظل الدنيا ويقول: 'إذ أحاطت الأنوار بالشخص اندرج ظله فيه، وانقبض إليه كما قال سبحانه: 'قبضا يسيرا' حين جعل الشمس علي مد الظل دليلا.. ظلك لايلحقك إن أدبرت عنه متوجها إلي الشمس، وأنت لا تلحقه إن أقبلت عليه، أعرضت عن الشمس. والذي حصل لك فيه في الاقبال هو الذي حصل لك فيه في الادبار. وفي إعراضك عن الشمس الخسران المبين. هذا مثل مضروب ضربه لك الحق في نفسك تقول لك الشمس: أنا فإني أنا النور، والكون ظلك وما فيك منه ما قدر لك، سواء أعرضت عن الكون أو أقبلت عليه، فلا تخسر.
ومن هذا التلازم بين الشمس والظل، وبين الكينونة والصيرورة، وبين قدرات العين المبصرة وقدرات الروح علي المشاهدة واختراق الحجب - يجد القاريء لنتاج المتصوفة، خاصة ابن عربي، أن للظل مكانة محورية في التفكير الصوفي حيث التطلع إلي الاندراج في النور الأعظم، والانثناء والطي فيه، بعد الحياة ومد الظل الذي هو، باصطلاح المتصوفة، بسط الوجود الإضافي علي الممكنات. ولذلك كثرت في الظل مصطلحاتهم، وتكوكبت حوله في المخيال عند بعض الفرق الدينية بعض الرؤي المؤسطرة. ومع ذلك بقي الظل في الظل في الدراسات القديمة والحديثة!
إنه ما بين إشماس الكائن وكونه ظل الله في الأرض وبين إضحاء ظله وانسحاب روحه ظهرت تجليات كثيرة للظل، شغلت أفكار المتصوفة والفلاسفة، وألهبت خيال الفنانين والأدباء، ودفعت بالمخيلة البشرية إلي نسج أساطيرها وطقوسها وهواماتها عن الجسد وظله. وهذا ماتسعي هذه الدراسة عبر فصولها المتنوعة إلي كشف جذوره وامتداداته، والتنقيب في تمثيلاته والتنويعات عليه وتنظيم الأفكار المتعلقة به في محاولة للوصول إلي هويته كمفهوم وتحديد ملامح الوعي به عبر تجلياته المختلفة.
الظل في المدونة التراثية والدينية
الظل والموت والخلود
جاء في لسان العرب في مادة ضحا 'الضحي من طلوع الشمس إلي أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جدا... وليس لكلامه ضحي أي بيان وظهور.. وضحي عن الأمر بينه وأظهره... وفي حديث أبي بكر: إذا نضب عمره وضحا ظله أي إذا مات. يقال للرجل اذا مات وبطل: ضحا ظله. يقال ضحا الظل إذا صار شمسا، وإذا صار ظل الانسان شمسا فقد بطل صاحبه ومات. ابن الاعرابي: يقال للرجل اذا مات ضحا ظله لأنه اذا مات صار لاظل له. وفي الدعاء لا أضحي الله ظلك: معناه لا أماتك الله حتي يذهب ظل شخصك.
هذا نص واضح الدلالة علي عمق العلاقة بين مفهوم الظل وبين الموت، ولابد بالضرورة أنه لهما، هناك في العمق، علاقة بمفهوم الزمن والصيرورة والخلود. وهذا ما يستدعي التفكير مباشرة بالشجر والظلال وتحديدا بالشجرة العظمي أم الشجر، شجرة الخلد.
جاءت في سورة طه قصة الخروج من الجنة، قال تعالي: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وأنك لاتظمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك علي شجرة الخلد وملك لايبلي فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدي فمن تبع هداي فلا يضل ولايشقي.
فهل يمكن أن نتجاهل معني كلمة (تضحي) في الآية الكريمة في سياق الحديث عن البقاء والخلد مع ما تحمله من دلالات تربطها بالموت والفناء. إننا يمكن أن نتأمل هذا المعني في هذا السياق في ضوء ما قيل عن شجرة الخلد في كتب التفاسير. يقول ابن كثير في تفسيره:
'فلم يزل بهما الشيطان حتي أكلا منها، وكانت شجرة الخلد، يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه . وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد، فقال أبوداود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي الضحي سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي محمد قال: 'إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها، وهي شجرة الخلد.
الظل في القرآن الكريم والتفسير
ترد كلمة ظل ومشتقاتها في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، وتأتي في كثير من المواضع بالمعني المباشر المعروف للظل، الذي هو مظهر مادي بصري للأشياء، أو بمعني الاحتماء من حر الشمس بكل ما له ظل من الأشياء، ولكن ترد، أحيانا، بمعني آخر يستوجب التوقف عنده في السياق الذي أحفر فيه عن مفردة الظل ضمن منظومة العلاقات المشار إليها والارتباطات بالموت والحياة والصيرورة والخلود والخلق.
جاءت في سورة الفرقان جملة آيات في سياق الحديث عن الخلق وآيات الله فيه . يقول تعالي: 'ألم تر إلي ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا'. والمفسرون للآية يفسرون الظل هنا إما كمعطي مادي يستلزم الرؤية البصرية، وإما الرؤية القلبية. يقول الشوكاني في تفسير الظل هنا: 'لما فرغ سبحانه من ذلك جهالة الجاهلين وضلالتهم أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم الانعام.. فأولها الاستدلال بأحوال الظل فقال: (ألم تر إلي ربك كيف مد الظل' هذه الرؤية إما بصرية والمراد بها ألم تبصر إلي صنع ربك، أو لم تبصر إلي الظل كيف مده ربك. وإما قلبية بمعني العلم، فإن الظل متغير، وكل متغير حادث، ولكل حادث موجد. ولا يتجاوز المفسرون هذا الحد في التفسير، لكن المتصوفة كما سنري بعد قليل يتعاملون مع هذه الآية من منظور التفكير بالظل كمسألة تتعلق بالذات الإلهية.
ويظهر أن المفسرين يتعاملون مع مفردة الظل في سياق الآيات علي انفراد، فمثلا الشوكاني في تعامله مع مفردة الظل في الآية السابقة لا يربطها مع تفسيره لآية 'ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها' حيث يورد آراء وتفاسير تقول إن المراد هو سجود ظل المؤمن لله طوعا، وظل الكافر يسجد لله كرها.
أما تفسير آية 'هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر، وإلي الله ترجع الأمور' فليس لدي المفسرين مبحث يحقق هذا الارتباط بين الله والظل، فضلا عن ربط هذه المفردة بسياقاتها ودلالاتها في آيات أخر. والمفسرون يتحاشون تأويل كلمة المجيء أو الإتيان لله عز وجل بالمعني الحقيقي أو الظهور الحقيقي مع الظلل. يقول القرطبي في تفسيره للآية: 'قال قتادة، الملائكة يعني تأتيهم لقبض أرواحهم، ويقال يوم القيامة، وهو أظهر. قال أبوالعالية والربيع: تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام، ويأتيهم الله فيما شاء، وقال الزجاج: التقدير في ظلل من الغمام ومن الملائكة، وقيل ليس الكلام علي ظاهره في حقه سبحانه، وإنما المعني يأتيهم أمر الله وحكمه. وقيل: أي بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل، مثل: 'فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا'... وكما أنه سبحانه أحدث فعلا سماه نزولا واستواء كذلك يحدث فعلا يسميه إتيانا، وأفعاله بلا آلة ولا علة، سبحانه وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لايفسر، وقد سكت بعضهم عن تأويلها، وتأولها بعضهم كما ذكرنا. وقيل: الفاء بمعني الباء أي يأتيهم بظلل ومنه الحديث 'يأتيهم الله في صورة' امتحانا لهم. ولايجوز أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء في القرآن والخبر علي وجه الانتقال والحركة والزوال، لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام، تعالي الله الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرا.
وواضح من هذا النموذج في التفسير تحاشي الربط المباشر بين الله عز وجل وبين فكرة الظل بمعناها المادي المباشر. ولكن ما تحاشاه التفسير اقتحمته المدونة الصوفية كما سنري.
الظل في الحديث الشريف
مفردة (الظل) ترد في أحاديث نبوية كثيرة، ولعل أشهرها قوله صلي الله عليه وسلم: 'سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال إلي نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي لاتعلم شماله ما صنعت يمينه'.
ويمكن تأمل الحديث وربطه بما عرضته سالفا عن اندراج فكرة فقد الظل في المدونة التراثية بالموت والصيرورة، فالحديث يشير إلي انعدام الظل عن كل الكائنات والبشر في يوم القيامة حيث لاظل إلا ظله سبحانه يظل به هؤلاء السبعة المذكورين. فعلي الرغم من أن الحديث واضح الدلالة في أن لاشيء له ظل يوم القيامة إلا الله عز وجل إلا أن ذلك المعني لم يستثمر في الإضاءات حول مفردة الظل في أحاديث أخر، أو حتي في تفسير الآيات القرآنية التي تحاشي المفسرون اقتحام دلالتها الأخري.
ومع أن الحديث السابق عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله من بينهم صاحب الصدقة إلا أن ثمة مرويات لحديث آخر بصيغ متقاربة تفرد الصدقة وتجعلها ظلا للمؤمن يوم القيامة، حيث الصدقة ظل للمؤمن، في وقت يقف فيه الناس بلا ظلال.
وهذا الفقد للظلال حال الموت، وحال الانتقال إلي العالم الآخر لايتوقف عنده في هذا السياق الرواة ولا الشراح، وكأنما هي حالة لاتلفت النظر خاصة عند حالة الموت.
ومن الأحاديث التي يمكن ذكرها هنا في هذا السياق حديث جابر بن عبدالله، رضي الله عنهما، إذ يقول: 'جيء بأبي يوم أحد قد مثل به، حتي وضع بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد سججي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه، فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت نائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو، أو أخت عمرو، قال: فلم تبكي أو لاتبكي، فمازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتي رفع'.
فهذا جابر بن عبدالله يتحدث عن أبيه بعد استشهاده في أحد وقد مجثل به. والحديث روي بصيغ متقاربة تؤكد أن الملائكة أظلت الشهيد حتي رفع، ولاترد أية إشارات أو تعليقات حول الحاجة إلي الظل، علي الرغم مما عليه مشهد الاحتفاء بالشهيد عبر تظليل الملائكة له من إثارة وتحفيز للمشاعر والخيال.
وإذا كان في إظلال الملائكة وافتقاد الانسان للظل حال الموت ما يثير الاهتمام، فإن ما يثير الاهتمام أكثر افتقاد الظل حال الحياة، وخاصة ما ورد من شروحات حول حديث إظلال الغمامة للرسول صلي الله عليه وسلم فقد ورد في التعليقات علي هذا الحديث مرويات عن ملكين كانا يظلان الرسول صلي الله عليه وسلم في سفره. وقد رأته ذلك خديجة رضي الله عنها وميسرة. كما روي أن حليمة رأت غمامة تظله وهو عندها صلي الله عليه وسلم. وفي هذا السياق يقول السخاوي: ومن ذلك أنه 'نزل في بعض أسفاره تحت شجرة يابسة فاعشوشب ما حولها، وأينعت هي فأشرفت، وتدلت عليه أغصانها بمحضر من رآه. ومال فيء الشجرة إليه في الخبر الآخر حتي أظلته. وما ذكر أنه لا ظل لشخصه في شمس ولاقمر لأنه كان نورا' ولهذا الجزء الأخير من هذا الخبر أهمية خاصة، حيث يدرج جسد الرسول صلي الله عليه وسلم في حيز النور، فيمسي بلا ظل، ولايعود لشخصه ظل لا في نهار ولا في ليل.
ومن الأحاديث المرتبطة ارتباطا قويا بالظل وبالذات الإلهية الحديث المشهور: 'السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيف، وبه ينتصر المظلوم'. وفي رواية أنس بن مالك: السلطان ظل الله في الأرض فإذا دخل أحدكم بلدا ليس به سلطان فلا يقيمن به'. ويروي أيضا: 'إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض. مرفوعا إلي أنس بن مالك رضي الله عنه، ولعله من هذا الربط بين السلطان وكونه ظل الله في الأرض تشكك به بعضهم وضعفوه.
الظل عند بعض الفرق الدينية
في عدد من نصوصها وكتبها وأسطورة البدايات وخلق الكون
1 الظل وبدء الخلق عند المغيرية:
تتردد مفردة الظل بشكل مهم ولافت في مواضع مختلفة من نصوص الإسماعيلية والنصيرية. وتأتي أهميتها، علي الرغم مما فيها من غنوصية واضحة، من أنها تعكس رؤية وتصورا لله ولكيفية خلق الكون وتتضمن أساطير عن بدايات الخلق والأصول.
أورد الأشعري في مقالاته عن الفرقة المغيرية (نسبة إلي المغيرة بن سعيد)، الذي عد أحد الزنادقة، نصا ينسبه إلي المغيرة بن سعيد يقول فيه: 'وذكرلهم كيف ابتدأ الله الخلق فزعم أن الله جل اسمه كان وحده لاشيء معه فلما أراد أن يخلق الأشياء تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع فوق رأسه التاج، قال وذلك قوله: 'سبح اسم ربك الاعلي'.. قال ثم كتب بإصبعه علي كفه أعمال العباد من المعاصي والطاعات، فغضب من المعاصي، فعرق فاجتمع من عرقه بحران: أحدهما مالح مظلم، والآخر نير عذب. ثم اطلٌع في البحر فأبصر ظله فذهب ليأخذه، فطار فانتزع عين ظله فخلق منها شمسا.
ومحق ذلك الظل، وقال: لاينبغي أن يكون معي إله غيري. ثم خلق الخلق كله من البحرين، فخلق الكفار من البحر المالح المظلم، وخلق المؤمنين من النير العذب، وخلق ظلال الناس فكان أول من خلق منها محمدا صلي الله عليه وسلم .. ثم أرسل محمدا إلي الناس كافة وهو ظل'.
وكان المغيرية يزعمون أن المغيرة بن سعيد كان يعلم اسم الله الأعظم وبذلك منح قدرات خارقة. ويري الدارسون أن فكرة الاسم الأعظم، وإن كانت منتشرة انتشارا واسعا في الاسلام إلا أنهم يرونها يهودية الأصل، إذ إن التراث الإسلامي حسب هؤلاء الدارسين يعتبر بلعام بن بعور العالم الأشهر بالاسم الأعظم، ولذلك يقارن المغيرة مع بلعام، ويرجح أن المغيرة أخذ معرفته السحرية عن امرأة يهودية، وهذا ما يجعل تصورات المغيرة مجرد انعكاس للأصل اليهودي.
وفي الأقوال المنسوبة إلي المغيرة أعلاه تظهر معالم غنوصية. كما يعكس النص الثنائية والتقابل لا بين البحر المالح والماء العذب ولا بين الظلمة والنور فيهما فحسب، بل تبدو الثنائية في تخيل ظل الله تعالي وكأنه إله آخر يشبه الله حيث ينسب المغيرة لله قوله: 'لاينبغي أن يكون معي إله غيري' حيث يظهر الظل صنوا أو شبيها، ولذلك يبدأ الخلق بقلع الظل الذي يفني ولايبقي منه شيء وتتحول عين الظل إلي نور وإلي شمس.
ويبدو أن تيمة ظل الله، الذي كان في بدء الخلق، قد ظهرت في الباطنية اليهودية وفي بعض التصورات المندائية. يقول هاينس هالم: 'إن للتفاصيل القليلة التي توردها المصادر ميولا يهودية أو غنوصية، إذ إن الاسم علي تاج الله هو موضوع معروف في الباطنية اليهودية. يقوم لدي 'فيلو philo' ظل الله بدور أداة في الخلق. ويذكر هذا علي وجه آخر بالتصورات المندائية، إذ يعتبر المندائيون ملك الظلام وليد 'الماء الأسود' وأن الملك الخارج عن العالمين يتتوج بتاج من نور.
الظل في كتب الفرق الدينية
(كتاب الهفت والأظلة) وكتاب (أم الكتاب) نموذجا
أ (كتاب الهفت والأظلة):
(كتاب الهفت والأظلة) من أقدم الكتب التي حملت مفردة الظل في عنوانها، وتناولت فكرة الظل مربوطة بالذات الإلهية وبالموجودات في الكون. ويظهر أن كلمة الهفت في عنوان الكتاب مأخوذة من الفارسية حيث هفت تعني سبعة، وهذا يتواءم مع موضوع الكتاب الذي يتحدث عن الظلال السبعة، علي حين أن كلمة الهفت بالعربية تعني المطمئن من الأرض وتساقط الشيء قطعة قطعة.
ينسب الكتاب للمفضل بن عمر الجعفي تلميذ جعفر بن محمد الملقب بالصادق المتوفي حوالي 148 ه وهو من 'الكتب الباطنية النادرة السرية المهمة. وهو يمثل عقائد الفرقة المفضلية، أتباع المفضل بن عمر الجعفي.
وقد أشار هاينس هالم في كتابه (الغنوصية في الاسلام) إلي أن الطائفتين النصيرية/ العلوية والإسماعيلية تتواتران كتابا يحمل عنوان (كتاب الهفت الشريف) أو عنوان (كتاب الهفت والأظلة) أو (كتاب الأشباح والأظلة) ويرده هالم إلي تراث النصيرية. وهالم يري أن 'نواة (كتاب الهفت والأظلة) هي كتاب قديم يتمحور في محيط الغلاة الكوفيين'.
كتاب (الهفت والأظلة) مقسم إلي سبعة وستين بابا. الباب الأول مخصص لمعرفة ابتداء الخليقة وأول شيء خلقه الله تعالي. وأول شيء خلقه الله حسب الكتاب الظل. يقول المؤلف: 'إن أول شيء خلقه الله تعالي الظل.
قلت: ومن أي شيء خلقه. قال: خلقه من مشيئته ثم قسمه. أما سمعت قوله تعالي في كتابه: 'ألم تر إلي ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 'خلق ماء وأرضا وعرشا. قلت: يامولاي علي أي مثال خلقه؟ قال الصادق: خلقه علي مثال صورته، ثم قسمه إلي أظلة فنظرت الأظلة بعضها إلي بعض، فرأت نفسها، وعرفت أنها كانت بعد أن لم تكن، وألهمت من المعرفة هذا المقدار، ولم تلهم معرفة شيء سواء من الخير أو الشر، ثم أدبها الله.. سبح نفسه فسبحوه، وحمد نفسه فحمدوه.. فلم تزل الأظلة علي ذلك تحمده وتسبحه سبعة آلاف سنة.. فخلق الله من ذلك التسبيح السماء السابعة،ثم خلق من تسبيح الأظلة الأشباح ، وخلق من تسبيح نفسه الحجاب الأعلي .. ثم خلق لهم الجنة السابعة من السماء السابعة... ثم خلق آدم الأول وأخذ عليه الميثاق وعلي ذريته'.
وهكذا يمضي المفضل في سرد قصة خلق ست سماوات أخر وجنات أخر في كل واحدة آدم جديد. ويسرد قصة أصل الأرواح النورانية والأظلة السبعة وحلول الأرواح النورانية في الابدان البشرية.
وفي الباب الثاني المخصص لمعرفة علل الأظلة والأشباح والأرواح وكيف أدبهم الله عز وجل وعرفهم بنفسه يفسر مصطلحاته في الأظلة والأشباح والارواح فيقول: 'إنما تسمت الأظلة لأنها كانت في ظل نور الله عز وجل،
وأما تسمية الأشباح فلأنها ذات الله. وأما تسمية الارواح فلأنها استراحت إلي معرفة الله. وأنها تسمت السماء لأن الله عز وجل سماها من أعمالهم ورفعها... ثم خلق للأرواح أبدانا من نوره، وجعل كل نور في سماء علي حدة، والكل روحا نورانية، وبدنا من نور. فإذا صعد بدن إلي السماء ألبس من الأبدان التي يفاضل بها بدنا، وجعل له حجابا نورانيا. فكان الله إذا نزل إلي السماء لبس حجاب تلك السماء وحجابه من نور، فألبس الأرواح أبدانها من نور وإنما ظهر لخلقه بهذه الصفة تأديبا لهم ليفهموا عنه ما يقول.
وقد كان في مطلع كتابه قال إن الله سبحانه وتعالي : 'خلق النور قبل الظلمة وخلق الجنة قبل النار... وخلق الأظلة قبل الأشباح، وخلق الأشباح قبل الأرواح، وخلق الأرواح قبل الأبدان وخلق الأبدان قبل الموت وخلق الموت قبل الفناء، وخلق الفناء قبل التراكيب.
ويصنف الكتاب بهذه الأطر والرؤي ضمن الأساطير الغنوصية المرتبطة بقصص الخلق والبدايات والأصول المتضمنة لأصل الأرواح النورانية، وخلق السماوات السبع، ونشوء الشياطين، وحلول الأرواح النورانية الهابطة في أبدان بشرية، وتناسخ الأرواح، وأخيرا الخلاص.
كتاب (أم الكتاب)
أسطورة الخلق والظلال
يشير الدارسون إلي كتاب (أم الكتاب) وهو كتاب فارسي عربي متوارث من قبل 'الجماعة الإسماعيلية في منطقة بامير هندوكوش والذي أثبت بجوهره أنه ترجمة لنص عربي للغلاة من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي أو مطلع القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي صنف في العراق. ويري الدارسون امتزاج القرائن الهندية البوذية مع قاموس الغلاة الشيعة الكوفيين. علي أن منهم من يميل إلي اعتباره نصا عربيا لوفرة مصلحات وآراء الغلاة من الشيعة فيه، ولكون النص قد تكون من طبقات بعضها إضافات أو ملحقات، ولكن حسب تقسيم الدارسين فإن القسم الثالث من الكتاب المسمي 'رؤيا جابر' هو القسم الجوهري في الكتاب، وهو المعزو إلي غلاة الشيعة وهو ما يهمني في هذا السياق.
رؤيا جابر
يقدم القسم الثالث رؤيا جابر في رواية متسلسلة وفيه 'يكشف الإمام باقر عن سر الغنوص: خاموس الخالق، وخشوع أمير الارواح سلمان، تكبر العدو عزازئيل. وخلق قبب السماوات السبع (ديوانه)، وخلق الأرض من خلال ملائكة الكواكب السبعة، وهبوط الأرواح النورانية المرتابة علي الأرض،
وانتقالها الفردوسي في 'أشباح' أجساد نورانية، تضليلها بالجنس وظلامها الذي عقب ذلك إلي 'أظلة' وتكثيفها في أبدان من لحم ودم. تنتهي الرواية برجاء الأرواح المحبوسة في الأبدان كي تخلص للنجاة وبوعد الله لها أن تعاد بشروط (معينة) إلي ملكوت النور.
وقد تم بعد ذلك تطعيم رؤيا جابر بتكهنات حول العالم الأصغر والعالم الاكبر تلتحم في مواطن منها بالرؤيا الأصل. تبدأ رؤيا جابر بتفسير البسملة، ثم تتحدث عن شخص الإله الأعلي وجوارحه الخمس، ثم تتحدث عن منكري الصفات الإلهية، ثم تتحدث عن القبب السماوية السبع، ثم عن بداية الخلق، ثم عن المنازل الخمس التي تقر بالله خالقا، ثم عصيان عزارئيل (إبليس) وهبوطه، فظهور الملك من جديد وهبوط الكافرين والعصاة، ثم خلق الأرض، ثم خلق الإنس والجن والعهد مع الله، ثم إغواء المرسلين ونشوء الأبدان، ثم شروط الخلاص من الأبدان.
تقول الرؤيا في جزئها الذي يتحدث عن القبب السماوية السبع: 'يامولاي.. اشرح لعبدك هذا صفة وشرح وعظمة الديوانات الألوهية والأنوار التي تتوالي من ديوان إلي ديوان: فقال باقر: في البدء ستار غاية الأزل الذي هو فوق بحر البيضاء وشخص الملك تعالي: إن محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين هم جوارح هذا الديوان.. إن الأنوار الخمسة للملائكة الخمسة هؤلاء متحدون في بحر البيضاء مثل أشجار الجنة'.
وفي هذا الجزء من الرؤيا ثمة تصورات للظل خاصة بالذات الإلهية مربوطة بالفؤاد ترد علي هذا النحو: 'إن الله.. هو النور المتواصل مع أفئدة أئمة الزمان الموصول من قبة غاية الغايات الأزلي من ديوان بديوان والموصول من عقل القبة الزرقاء إلي روح الحياة الناطقة ومن العقل نشر ظلا علي الفؤاد الأسود إلا أن المترفين يقولون إن ظل الله لايسقط علي الأرض، الأرض هي الفؤاد والله هو هذا الضوء الموصول بالفؤاد. والروح الناطقة التي تعني الملك تعالي هي من هذا النور... إن كل خاموس موجود في هذا الكون أصله من هذا النور... محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الذي سقط ظلهم علي الأرض. هؤلاء الأنوار الخمسة هم المرتبطون بالروح الناطقة.
وتوالي الرؤيا قص قصة خلق الخلق وعصيان عزازئيل ومن تبعه، حتي إذا وصلت الرؤيا إلي القسم الخاص بنشوء الأبدان تكرست مصطلحات الهياكل والأبدان مربوطة بالظلمة وبالقوالب السود، حيث يعترض عزازئيل ومن معه ويأبون السجود فيقول لهم الله: 'اهبطوا كلكم من هذه الهياكل وهذا هو الجحيم كي لاتتصرفوا بفخر، واسكنوا في ذلك القالب الأسود والضيق.. والكثيف المظلم.. إني جاعلكم نساء جميلات في وسط الشكاكين والأذلاء، كي تفتنوهم، ولاتدعوهم علي الصراط المستقيم.. فنقل الملك تعالي جماعات إبليس في قوالب الأظلة وأصل جحيم الأظلة أنه حبسهم فيها.
وأما المعترضون فقد نقلهم في قوالب الأشباح قوله تعالي 'فريق في الجنة وفريق في السعير'.. فقال الملك تعالي للجواهر. المعترضة ها أنتم في جنة الأشباح... وكلوا من كل شيء... إلا من هذه الشجرة لاتأكلوا . يعني لاترتكبوا الزني وعقد معهم عهدا: إني لكم مرسل جبرائيل يعني الهداية الإلهية.. وأنتم تبقون في هذه الفردوس أي في قوالب الأشباح. لكن إذا ما تحول هؤلاء الذين لهم قالب الأظلة إلي نساء جميلات فلا تقربوهن. قوله تعالي 'ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين'.. ولما كان زمن طويل تحول إبليس إلي امرأة جميلة، وكل من تعصبوا له تحولوا كذلك إلي نساء جميلات وظهروا للمعترضين، ففتن جميع هؤلاء.
وهكذا تمضي الرؤيا في قص قصة الخطيئة والهبوط من الفردوس. وتبدو الأظلة هنا مربوطة بالهيكل أو القالب الجسدي الكثيف ومربوطة بالغواية، حيث صارت الأظلة موازية للشجرة ذات الظل أيضا. وبغض النظر عن ربط المرأة مباشرة بإبليس والغواية فإن ما يلفت النظر هنا هو هذا التلازم بين المرأة والظل في هذا النص، وهو ما سأعود إليه في موضع لاحق من هذا الكتاب.
إن رؤيا جابر في (أم الكتاب) أسطورة فنية غنوصية تامة في زي شيعي، كما يري هاينس هالم في دراسته للكتاب. وقد تتبع فيه فكرة الخاموس وجوارح الإله الخمس، وفكرة جلوس الله علي العرش فوق بحر البيضاء، والموضوع الجوهري في رؤيا جابر وهو موضوع التحول وتكبر المعترض وما يعقبه من عقاب وهبوط فكل تلك الموضوعات لها مماثلات وامتداد في المانوية، والمندائية. وتبدو كذلك في الغنوصية المسيحية أيضا، وخاصة في تأويلات فيلون الإسكندري وشروحه للكتاب المقدس (العهد القديم خاصة، وسفر التكوين بصفة أخص).
لكن الأهم من هذا ما يمكن أن نوجزه حول رؤيا جابر هو أنها تتركز في أن النفوس البشرية هي ومضات ضوئية ساقطة من مئة وأربعة وعشرين ألف نور وقنديل، وكان نفيها في جسد العالم عقابا لها علي نسيانها، فهذه النفوس تنسي في كل سماء ما رأته وشهدته في السماء السابقة، ولذلك حينما ينزلون إلي الأرض تتبدي فكرة الخلاص من خلال تناسخ الأرواح. إن 'القفل علي نفوس النور في قوالب... مفاده عملية تظليم متتال وتكثيف، ومن ثم حولوا إلي أشباح نورية، وجعلوا أولا من خلال التضليل بالظل الشيطاني هم أنفسهم مظلمين في أظلة وكثفوا أخيرا في أبدان، تكمن خطيئتهم في العصيان والشهوة الجنسية، لقد سقطوا إزاء التضليل من خلال الأجساد الأنثوية، ان هذا واحد من المعالم الغنوصية المألوفة تبالغ بعض الطرق الغنوصية مثل المانوية في جعله عداء للجسد، لقد حافظ النصيريون/ العلويون إلي اليوم علي خوف نساء - جينوفوبيا.. ويبدو أن 'الأشباح' و'الأظلة' في أسطورة رؤيا جابر تقف في موضعها الأصلي المحكوم بهذا النظام.
الظل في المدونة الكلامية والصوفية الظل/النور:
يلفت النظر في نص ابن منظور قوله: 'يقال للرجل إذا مات وبطل: ضحا ظله. يقال ضحا ظله اذا صار شمسا واذا صار ظل الانسان شمسا فقد بطل صاحبه ومات'.
هذا القول يحيل إلي رؤية للظل تدرجه في صيرورته إلي الشمس، وفلسفيا يمكن النظر إلي أن الضوء منطقة غيب واحتجاب.
وحينما يقال إذا مات الانسان: ضحا ظله، ويقرر العرب معني ذلك بأن الظل صار شمسا فهذا يعني مآل الظل إلي أصله، إذ هو في صيرورته شمسا يدخل منطق العماء. يقول ابن منظور: 'الظل في الحقيقة إنما هو ضوء شعاع الشمس دون الشعاع، فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة وليس بظل'.
إذا حينما يؤول الظل إلي أصله يندرج في حيز النور فيختفي، فالنور - علي عكس ما نتصوره للوهلة الأولي - منطقة غيب وعماء واحتجاب. يقول ابن عربي: 'الظلال محجوبة أبدا عن موجدها وظهورها عند طلوع الأنواع علي من تولدت عنه. وهي أبدا تطلع من خلف حجاب أسبابها لتري موجدها فلا تراه أبدا، فهي في ظلمة كونها محبوسة لا تسرح أبدا.. فلا يري الحق أبدا، إلا من خلف حجاب فإن سبحات الوجه لا تقف لها الأكوان. وقال: إذا أحاطت الأنوار بالشمس اندرج ظله فيه وانقبض إليه، كما قال سبحانه: 'قبضا يسيرا' حين جعل الشمس علي مد الظل دليلا'.
إن العالم عند ابن عربي ليس إلا ظهور صور الأعيان، وذلك الظهور هو النفس الرحماني فيبدو العالم، عالم الصور والموجودات، ليس سوي ظل لهذا الفيض الإلهي. ولعله من هذا المعني يمكن فهم الحديث النبوي: 'السلطان ظل الله في الأرض'.
يقول ابن عربي: 'كل ما سوي الله ظل له. ولما كان السلطان مجمع الصفات الإلهية قال فيه صلي الله عليه وسلم: 'السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم'.
وفي ضوء ما تقدم يمكن فهم فكرة الظل وقد ارتبطت بالموت، حيث تمثل الروح بالضوء المستقر في البدن، فإذا مات الانسان أشمس وأصبح بلا ظل، وانتقلت الروح/ الظل، التي هي ضوء ينعكس، إلي عالمها الأول، يقول الجرجاني في تعريفه للنفس: 'وهي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية وسماها الحكيم الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه.
ويقول ابن عربي مستخدما مجاز الشمس والضوء والظلمة: 'ولما كانت الحياة في الاجسام بالعرض قام بها الموت والفناء فإن حياة الجسم الظاهرة من آثار حياة الروح، هي كنور الشمس الذي في الأرض من الشمس: فاذا مضت الشمس تبعها نورها، وبقيت الارض مظلمة، كذلك الروح اذا رحل عن الجسم الي عالمه الذي جاء منه تبعته الحياة المنتشرة منه في الجسم الحي، وبقي الجسم في صورة الجماد في رأي العين فيقال: 'مات فلان، وتقول الحقيقة: رجع إلي أصله 'منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخري'.
ولأن هذه الروح/الظل تعود إلي بارئها فإن الرؤية الدينية كانت تنظر لسجود الكافر لغير الله نظرة تفصل بين الجسد وحركة الظل. وهذا ما يجعلنا نفهم لماذا جاء في التفسير للآية الكريمة 'ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال' حيث 'جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله'.. وفي حديث ابن عباس: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله'.
ان مفهوم الظل - كما ظهر مما تقدم - مفهوم عميق ومتداخل مع فكرة الوجود المطلق والعدم، ومع فكرة التجلي والعماء، ومع فكرة الموت والخلود. ولاشك أن ارتباط الظل/ الشمس بالموت وعنف التحول إلي عالم الغيب يجعلنا نعيد التفكير في مسألة النور والظلمة علي أساس القضية الميتافيزيقية والانطولوجية معا كما تعكسها الرؤية الصوفية. تلك الظلمة التي يقول عنها الجرجاني: 'الظلمة عدم النور فيما شأنه أن يستنير. والظلمة الظل المنشأ من الأجسام الكثيفة قد يطلق علي العلم بالذات الإلهية فان العلم لا يكشف معها غيرها، ان العلم بالذات يعطي ظلمة لا يدرك بها شيء كالبصر حين يغشاه نور الشمس عند تعلقه بوسط قرصها الذي هو ينبوعه فإنه حينئذ لا يدرك شيئا من المبصرات. تلك الظلمة التي تحيل الي فكرة العماء، حيث صعقة النور التي هي فوق طاقة البشر، وهي من المسائل التي ناقشتها المدونة الكلامية والصوفية وأولتها عناية خاصة.
الظل عند التوحيدي
الظل/ الوجود الإضافي: الممكن والرؤيا:
في كتاب الامتاع والمؤانسة يورد التوحيدي محاورة بينه وبين شيخه أبي سليمان يتحدث فيها عن التمكين، فأبو سليمان يري أن 'التمكين وحده اسم مجردلشيء محدد، والأسماء المحددة دلالتها علي الاعيان لا علي صفات الأعيان أو ما يكون من الأعيان وما يكون في الاعيان'. ويري أن التمكين معتبر بما يضاف إليه، ويناط به، فإن كان من القبيح فهو قبيح، لأنه علة القبيح، وإن كان من الحسن فهو من الحسن لأنه سبب الحسن. وهو يعرف الاضافة التي حدد بها التمكين، يقول: 'والاضافة قوة إلهية سرت في الأشياء سريانا غريزيا قاهرا متملكا قاسرا، لا جرم لا تري حسيا أو عقليا أو وهميا أو ظنيا أو علميا أو عرفيا أو عمليا أو حلميا أو يقظيا إلا والتصاريف سارية فيها، والاضافة حاكمة عليها. وهذا لأن الأشياء بأسرها مصيرها إلي الله الحق، لأن مصدرها من الله الحق، فالاضافة لازمة، والنسبة قائمة، والمشابهة موجودة، ولولا اضافة بعضنا إلي بعض ما اجتمعنا ولا افترقنا، ولولا الاضافة بيننا الغالبة علينا ما تفاهمناولا تعاوناٌ .
ثم عقب علي هذا الكلام مؤكدا علاقة الاضافة والوجود الاضافي بالظل وبالائتلاف والاختلاف، بقوله:
'اذا كنا بالتضايف نتوالي، فبأي شيء بعده نتعادي؟ قال: هذا أيضا بالاضافة، لان الاضافة ظل، والشخص بالظل يأتلف، وبالظل يختلف، وقال: ويزيدك بيانا أن العدم والوجود شاملان لنا، سائران فينا، فبالوجود نتصادق، وبالعدم نتفارق'.
هكذا نري أن الاضافة وهي القوة الإلهية السارية في الأشياء سريانا غريزيا - كما قال - هي اضافة أو وجود ظلي كما جاء في آخر نصه، فالإضافة ظل وسنري كيف أن هذه الفكرة ستمتد إلي التراث الصوفي، وسنعثر عليها بشكل قوي ومكثف عند ابن عربي تحت مسمي الوجود الانفصالي والانبعاثي المرتبط بالظل مباشرة. كما سيحرر من بعد ذلك علي الجرجاني في كتابه التعريفات مصطلحات كبري تحت مصطلح الظل هي: الوجود الاضافي، والظل الأول، وظل الإله، حيث يقول في ربط واضح بين الظل والوجود الاضافي، وبين الممكن أيضا، مثله في ذلك مثل التوحيدي في مفتتح حديثه عن الظل:
'الظل ما نسخته الشمس وهو من الطلوع الي الزوال وفي اصطلاح المشايخ هو الوجود الاضافي الظاهر بتعيٌنات الاعيان الممكنة وأحكامها التي هي معدومات ظهرت باسمه النور الذي هو الوجود الخارجي المنسوب إليها فيستر ظلمة عدميتها النور الظاهر بصورها صار ظلا لظهور الظل بالنور وعدميته في نفسه قال الله تعالي: 'ألم تر إلي ربك كيف مد الظل' أي بسط الوجود الاضافي علي الممكنات.
وعن هذا الوجود الانبعاثي الفيضي المرتبط بظهور الممكنات لحظة بمد الله ظله عليها وتظهر الي الوجود يقول ابن عربي: 'وذلك هو الوجود الخارج المنبسط علي الماهيات القابلة له الظاهرة به، وهو اذا اعتبر من حيث انه واحد أي من حيث حقيقته كان اسم النور من أسماء الله المخبر عنه في التنزيل بقوله تعالي 'الله نور السموات والأرض' وباعتبار وقوعه علي القوابل والمحال وعروضه للماهيات سمي الظل الممدود في قوله تعالي: 'ألم تر إلي ربك كيف مد الظل'.
الظل/ الرؤيا/ الحلم
واللافت للنظر في حديث التوحيدي عن الظل انه يأتي في سياق حديثه عن التمكين والممكن، الذي يشبهه بالرؤيا في مقابل اليقظة، يقول التوحيدي مسندا ما يرويه الي ابن يعيش الرقي: 'قال: الممكن شبيه بالرؤيا لابدن له يستقل به، ولا طبيعة يتحيز فيها. ألا تري أن الرؤيا تنقسم علي الأكثر والأقل والتساوي، وكما أن الرؤيا ظل من ظلال اليقظة، والظل ينقص ويزيد اذا قيس الي الشخص: كذلك الممكن ظل من ظلال الواجب، فطورا يزيد تشابها للواجب، وطورا ينقص تشاكها للممتنع، وطورا يتساوي بالوسط.
وبعد استطراد طويل حول الواجب يقول: 'الرؤيا ظل اليقظة، وهي واسطة بين اليقظة والنوم، أعني بين ظهور الحس بالحركة، وبين خفائه بالسكون. قال: والنوم واسطة بين الحياة والموت، والموت واسطة بين البقاء الذي يتصل بالشهود وبين البقاء الذي يتصل بالخلود.
وهكذا يبدو الظل منطقة متوسطة بين الموت والحياة، كما بدا في الأساس واسطة الوجود الانفصالي الذي يمسي الظل بسببه واسطة وتمظهرا للوجود في الوقت ذاته. هذه الواسطة هي التي جعلته - عند التوحيدي - شبيها بالرؤيا، أو بالحلم وسنري - فيما يأتي من فقرات - كيف أن حواء عند ابن عربي في وجودها الانفصالي الانبعاثي من آدم جاءت عبر مفهوم ظلي أثناء نوم آدم، وبذلك تبدو حواء كأنها حلم.
ولاشك أن هذا الربط بين الظل والرؤيا في مقابل اليقظة يأتي من علاقة الظل/الرؤيا بالجانب الروحاني المرتبط بفكرة النور، النور الذي يحجب عن الجسد حال الموت: فيضحي الظل - حسب عبارة المدونة التراثية - أو حال النوم، حيث يمتد نوع من الحجب شبيه بالموت، حتي قيل إن النوم هو الموت الأصغر. يقول الجرجاني:
'النفس وهي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية، وسماها الحكيم الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن فعند الموت ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن وباطنه وأما في وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه، فثبت ان النوم والموت من جنس واحد، لأن الموت هو الانقطاع الكلي، والنوم هو الانقطاع الناقص، فثبت أن القادر الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن علي ثلاثة أضرب: الأول إن بلغ ضوء النفس علي جميع أجزاء البدن ظاهرة وباطنة فهو اليقظة وإن انقطع ضوؤها عن ظاهره دون باطنه فهو النوم أو بالكلية فهو الموت.
إن الظل/ الرؤيا الذي يمسي واسطة - حسب عبارة التوحيدي - بين اليقظة والنوم أي بين ظهور الحس بالحركة وبين خفائه بالسكون وبين البقاء المتصل بعالم الشهادة والعالم المرئي وبين الفناء عالم الغيب والعالم الخفي - يحيل إلي ما تملكه رؤية إلي الظل تموضعها فلسفيا وفق تقابلات مهمة: فالظل مربوط بعالم النور والروح أي إلي عالم الوحدة وعالم الغيب، في مقابل أن الصور والأجساد مشدودة إلي العالم المرئي المشهود، وهي متغيرة متحركة متنوعة متكثرة.
الظل/ الإلهام
كما أن التوحيدي في موضع آخر وهو يتحدث عن قوة الإلهام وقوة الاختيار جعل الإلهام يقع في المنطقة الظلية، حيث يقول: 'ولما وهب الانسان الفطرة، وأعين بالفكرة، ورفد بالعقل، جمع هذه الخصال وما هو أكثر منها لنفسه وفي نفسه وبسبب هذه المزية فضل جميع الحيوان.. وهذه المزية التي له مستفادة بالعقل، لأن العقل ينبوع العلم، والطبيعة ينبوع الصناعات.... ولما كان الحيوان كله يعمل صنائعه بالإلهام علي وتيرة قائمة، وكان الإنسان يتصرف فيها بالاختيار صح له من الإلهام نصيب حتي يكون رفدا له في اختياره، وكذلك يكون النحل أيضا، صح له من الاختيار قسط من إلهامه حتي يكون معينا في اضطراره، إلا أن نصيب الانسان من الإلهام أقل كما أن قسط سائر الحيوان من الاختيار أنزر وثمرة اختيار الانسان اذا كان معانا بالإلهام أشرف وأدوم وأجدر، وأنفع وأبقي وأرفع من ثمرة غيره من الحيوان إذا كان معانا مرفودا بالاختيار، لأن قوة الاختيار في الحيوان كالحلم، كما أن قوة الإلهام في الإنسان كالظل.
الظل عند ابن عربي
يأتي حديث ابن عربي عن الظل في تضاعيف مسائل كبري، وهو لا يخصص فصلا للحديث عنه لكن يمكن تجميع جملة آرائه لنتتبع الخيوط التي تشكل نسيج رؤيته للظل.
الظل والوجود والانفصال
في الباب الذي يتحدث فيه ابن عربي عما يسميه 'دورة الملك' وهي عنده 'عبارة عما مهد الله من آدم إلي زمان محمد من الترتيبات في هذه النشأة الانسانية، بما ظهر من الاحكام الإلهية فيها' يستخدم عددا من الالفاظ التي سرعان ما يتضح للقاريء، كلما توغل في هذا الباب، انها أشبه بالمصطلحات. وهي تعد مفاتيح أساسية لرؤيته لكيفية انبعاث الوجود، فكلمات مثل: الوجود والانفصال، والعّمْر، والظل وما يتبعه من صفات متجذرة في المكانية كلها كلمات محملة بالروح المصطلحية. يقول ابن عربي:
'وكل منفصل عن شيء فقد كان عامرا لما عنه انفصل، وقد قلنا انه لا خلاء في العالم. فعمر 'الشيء المنفصل' موضع انفصاله بظله، إذ كان انفصاله الي النور، وهو الظهور. فلما قابل النور بذاته، امتد ظله، فعمر موضع انفصاله: فلم يفقده من انفصل عنه. فكان مشهودا لمن انفصل إليه ومشهودا لمن انفصل عنه. وهو المعني الذي أراده القائل بقوله: شهدتك موجودا بكل مكان'.
ويقول متحدثا عن العالم كظل لله - عز وجل - 'اعلم ان القول عليه سوي الحق أو مسمي العالم هو بالنسبة الي الحق كالظل للشخص، فهو ظل الله.. فمحل ظهور هذا الظل الإلهي - المسمي بالعالم - إنما هو أعيان الممكنات عليها امتد هذا الظل.. وبين أنه لابد للظل من أمور ثلاثة حتي يظهر: الأول هو الذات - ذات الظل - والثاني هو المحل الممتد عليه الظل، والثالث النور الذي يدرك ويتميز به الظل'.
ويواصل ابن عربي حديثه عن الوجود المنفصل وعن الظل قائلا:
'فمن أسرار العالم، أنه ما من شيء يحدث إلا وله ظل يسجد لله، ليقوم بعبادة ربه علي كل حال، سواء أكان ذلك الأمر الحادث مطيعا أم عاصيا. فإن كان من أهل الموافقة، كان هو وظله علي السواء، وإن كان مخالفا ناب ظله منابه في طاعة الله. قال تعالي: 'وظلالهم بالغدو والآصال'.
ويواصل حديثه مفسرا حديث السلطان ظل الله في الأرض قائلا:
'السلطان ظل الله في الأرض' اذ كان ظهوره بجميع صور الأسماء الإلهية، التي لها الأثر في عالم الدنيا. والعرش ظل الله في الآخرة. فالظلالات، أبدا، تابعة للصورة المنبعثة عنها حسا ومعني 'فالظل' الحسي قاصر، لا يقوي قوة الظل المعنوي للصورة المعنوية، لأنه 'أي الظل الحسي' يستدعي نورا مقيدا، لما في الحس من التقييد والضيق وعدم الاتساع. ولهذا نبهنا علي الظل المعنوي بما جاء في الشرع من أن 'السلطان ظل الله في الأرض' فقد بان لك أن بالظلالات عمرت الأماكن'.
إن القاريء لنص ابن عربي يلحظ أن مفهوم الظل عنده ملازم لعدد من الأفكار التي تحدد عناصره:
أولها: ارتباطها بالمصدر العلوي الذي عنه يحدث الفيض والظهور في صور محسوسة.
ثانيها: ارتباطه بالصورة، وهو يؤكد أن الظل تابع للصورة المنبعث عنها حسا ومعني. ومن هنا جاء تقسيمه للظل المعنوي والظل الحسي. وهذا يفسره نظرته إلي أن نفثة الرحمن تظهر الموجودات في صورة محسوسة، ولذلك فالظل أثر هذا الظهور والايجاد الفيضي النفثي، ومن هنا يمكن فهم مقولة 'السلطان ظل الله في الأرض'. إذ ظهوره هو ظهور بجميع صور الأسماء الإلهية كما قال.
ثالثها: وهو مرتبط بما قبله إذ الصور تحتاج الي التموضع حسيا ومكانيا، ومن هنا يرتبط حديث ابن عربي عن الظل بالمكان 'فالظلالات عمرت الأماكن' وعنده أن 'لا خلاء في العالم' فالظل امتلاء، مقابل الاصرار علي ألا خلاء في العالم، ولذلك كلما تحدث عن الظل تظهر مفردات الحيز والامتداد والموضع.
رابعها: ارتباط الظل بالمكان له علاقة - كما قلت - بمقولته أن لا خلاء في العالم، ومن هنا تأتي مفردة 'عّمْر' واشتقاقاتها ملازمة لمفهوم الظل، وتبدو كلمة 'عّمْر' وكأنها مصطلح فماذا يعني عنده؟ يقول في أول النص السالف: إن كل منفصل عن شيء فقد كان عامرا للذي انفصل عنه، وبما أنه لا خلاء في العالم فإن الشيء المنفصل يعمر موضع انفصاله. وهذا يعني أن كلمة عمر عنده مرادفة لملأ، لكن معني عمر أيضا مرتبط بمعني الانفصال.
خامسها: يرتبط مفهوم الظل بمفهوم الانفصال، ويلحظ القاريء تلازم حضور كلمة الانفصال مع حديث ابن عربي عن الظل أو عما يسميه الوجود الانبعاثي 'ولاحظ أن هذا شديد الصلة بالنقطة الأولي المشار إليها سالفا عن المصدر العلوي والفيض' يقول ابن عربي في أول نصه السالف: 'فعمر الشيء المنفصل موضع انفصاله بظله، اذ كان انفصاله الي النور، وهو الظهور. فلما قابل النور بذاته، امتد ظله، فعمر موضع انفصاله، فلم يفقده من انفصل عنه. فكان مشهودا لمن انفصل إليه. ومشهودا لمن انفصل عنه.. فمن أسرار العالم إنه ما من شيء يحدث إلا وله ظل يسجد له.. سواء كان ذلك الأمر الحادث مطيعا أو عاصيا'.
فالظل إذا هو لحظة انفصالية عن الشيء الذي كان هو يملؤه. إن لحظة الانفصال هذه لحظة ايجاد وحدوث، لحظة وجودية مرتبطة بالظهور والانكشاف، تجعل الشيء الظل المنفصل مرئيا مشهودا. وهذا ما يجعل مفهومي العّمْر والانفصال أساسيين ومشتبكين في كونهما عنصرين أساسيين في تحديد ماهية الظل عند ابن عربي. ان الانفصال خيط يشبك الشيء الحادث بالشيء الموجد له، والعّمْر/الملء هو الذي يحدث الشيء المنفصل في المكان اذا يبرز 'يظهر وينكشف'، ويتخذ له صورته المحسوسة في العالم. هذا الايجاد ايجاد انبعاثي مرتبط بالنور. فالشيء كان في عماء مطلق إلي أن انفصل وقابل النور بذاته، فالظل ليس كينونة مظلمة، انها دلالة الوجود ولحظته المنبعثة من الاحتجاب والعماء، لذلك الظل وجود انبعاثي، وهو لحظة امتلاء، ولكنها لحظة مشدودة دائما إلي الشيء المنفصلة عنه، فكأنما الظل/الشيء المنفصل يحمل حنينه وشهوته للعودة إلي ما انفصل عنه. وهذا ما يفسر سلسلة الانفصالات/ الظلالات وأنواع وجودها عند ابن عربي وتراتبها بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وتحركها عبر ما يسميه 'دورة الملك' ومراتبها، ومن خلال نظرته إلي الانفصال والعمر المرتبطين بالظل والمرتبطين بالتالي بالصورة وشهودها حسيا، وهي نظرة مرتبطة بأساس الرؤية الجنسية التوالدية عنده.
الظل/المرأة
يفسر ابن عربي خلق حواء من آدم عبر تفكيره بالظل ويري أن وجودها ظلي انفصالي. يقول ابن عربي 'ويحسن أن يلاحظ القاريء المصطلحات الآنفة الذكر مثل عمر وانفصل، اذ هي ضرورية لفهم ما يلي' يقول: 'فدورة الملك عبارة عما مهد الله من آدم إلي زمان محمد من الترتيبات في هذه النشأة الانسانية.. فأول موجود ظهر من الاجسام الانسانية، كان آدم عليه السلام، وهو الاب الاول من هذا الجنس.. وهو 'آي آدم' أول من ظهر بحكم الله من هذا الجنس.. ثم فصل الله عنه أبا ثانيا لنا سماه أمّا فصح لهذا الأب الأول الدرجة عليها لكونه أصلا لها، فختم الله به النواب، من دورة الملك بمثل ما به بدأ: لينبه 'تعالي' علي أن الفضل بيد الله، وأن ذلك الأمر ما اقتضاه الأب الأول لذاته، فأوجد 'الحق' عيسي عن مريم، فتنزلت مريم منزلة آدم، وتنزل عيسي منزلة حواء، فكما وجدت أنثي من ذكر، وجد ذكر من أنثي، فختم 'الله' بمثل ما به بدأ، في ايجاد ابن من غير أب، كما كانت حواء من غير أم فكان عيسي وحواء أخوين، وكان آدم ومريم أبوين لهما.
هنا يمكن أن يلحظ القاريء أن مفهوم الانفصال مرتبط بما يسميه الوجود الانبعاثي أو الاضافي، ووجود المرأة هنا وجود ظلي انفصالي انبعاثي متفرع من الأصل. يقول ابن عربي بعد ذلك بقليل:
'ولما انفصلت حواء من آدم، عمر 'الله' موضعها منه بالشهوة النكاحية إليها، التي وقع بها الغشيان لظهور التناسل والتوالد: وكان الهواء الخارج الذي عّمْر موضعّه جسم حواء عند خروجها، إذ لاخلاء في العالم فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي اخذته حواء بشخصيتها، فحرك 'الله' آدم لطلب موضعه، فوجده معمورا بحواء، فوقع عليها. فلما تغشاها حملت منه. فجاءت 'حواء' بالذرية. فبقي ذلك سنة جارية في الحيوان من بني آدم وغيرهم بالطبع. لكن الانسان 'الحقيقي' هو الكلمة الجامعة، ونسخة العالم فكل ما في العالم جزء منه، وليس الانسان 'الحقيقي' بجزء لواحد من العالم. وكان سبب هذا الفصل، وايجاد هذا المنفصل الأول - طلب الأنس بالمشاكل في الجنس، الذي هو النوع الأخص، وليكون 'أيضا' في عالم الاجسام، بهذا الالتحام الطبيعي الانساني، الكامل بالصورة الذي اراده الله، ما يشبه القلم الأعلي، واللوح المحفوظ، الذي يعبر عنه بالعقل الأول والنفس الكل. واذا قلت: القلم الأعلي، فتفطن للاشارة التي تتضمن الكاتب وقصد الكتابة، فيقوم معك 'عندئذ' معني قول الشارع: 'إن الله خلق آدم علي صورته'.
لقد ذكرت سالفا ان مفهوم الظل يحيل إلي أنه لحظة وجود وانبعاث ولحظة امتلاء، وهي - كما يبدو من نصوص ابن عربي - لحظة مشدودة إلي الشيء المنفصلة عنه. وهو ما يذكره بصراحة في نصه السالف، وتوجهه فيه فكرة التناسل الكوني أو ما يسميه النكاح الساري، الذي به يستمر الكون ويتوالد، لأن الظهور/الظل الذي هو لحظة الانفصال أو الوجود والبروز الي عالم الشهادة من عالم الغيب والعماء مشدود الي التشكل والصورة اذ ينعكس عليه نور الموجد. ومن هنا يجد ابن عربي الخيط المرهف لمجازه البعيد الذي يربط فيه بوجه شبه بين اللحظة الجنسية الحسية بما يسميه العقل الاول واللوح المحفوظ. يقول ابن عربي بعد ذلك: 'فيكون أول منفصل فيها 'أي في دورة الملك' النفس الكلية عن أول موجود وهو العقل الاول، وآخر منفصل فيها حواء، عن آخر موجود وهو آدم، فإن الانسان آخر موجود من أجناس العالم'.
انه حسب التقسيم السالف للوجود والانفصال عنده تبدو حواء في وجودها الانفصالي في تراتبية تقابل النفس الكلية التي هي وجود منفصل عن العقل الأول، الذي يقابله من جهة ثانية آدم.
اذا هذا العقل الأول هو ظل أول حسبما يمكن الاستنتاج من مصطلحات ابن عربي.
ولكن ما لم ينص عليه صراحة من تسمية العقل الأول بالظل الأول سيذكره صراحة الجرجاني في كتابه التعريفات.
مصطلحات الظل عند علي الجرجاني
الوجود الإضافي:
يحدد الجرجاني في كتابه التعريفات مصطلح الظل قائلا:
'الظل ما نسخته الشمس وهو من الطلوع إلي الزوال، وفي اصطلاح المشايخ هو الوجود الاضافي الظاهر بتعينات الاعيان الممكنة وأحكامها، التي هي معدومات ظهرت باسمه النور الذي هو الوجود الخارجي المنسوب إليها، فيستر ظلمة عدميتها النور الظاهر بصورها صار ظلا لظهور الظل بالنور وعدميته في نفسه قال الله تعالي: ألم تر إلي ربك كيف مد الظل أي بسط الوجود الإضافي علي الممكنات.
الظل الأول هو العقل الأول لانه أول عين ظهرت بنوره تعالي. ظل الإله هو الانسان الكامل المتحقق بالحضرة الواحدية.
فها نحن أمام ثلاثة مصطلحات للظل حسب المعجم الصوفي: الظل/الوجود الاضافي 'وقد مر الحديث عنه فيما تقدم'، والظل الأول، وظل الإله أو الانسان الكامل.
الظل الأول/ العقل الأول
عرف الجرجاني الظل الأول بأنه 'العقل الأول لأنه أول عين ظهرت بنوره تعالي. وفي موضع آخر يعرف الجرجاني مصطلح 'البيضاء' تعريفا له علاقة مباشرة بمصطلح الظل الأول، يقول:
'البيضاء، العقل الأول فإنه مركز العماء وأول منفصل من سواد الغيب . وهو أعظم نيرات فلكه فلذلك وصف بالبياض ليقابل بياضه سواد الغيب فيتبين بضده كمال التبين، ولأنه هو أول موجود. ويرجح وجوده علي عدم، والوجود بياض والعدم سواد، ولذلك قال بعض العارفين في الفقر إنه بياض يتبين فيه كل معدوم وسواد ينعدم فيه كل موجود، فإنه أراد بالفقر فقر الامكان'.
ونلاحظ هنا أن تعريف 'البيضاء' يرتكز علي العقل الأول، ولذلك فالبيضاء ترادف الظل الأول. وذلك يحيل إلي التفكير بمصطلح الظل الأول من حيث كونه علي الحقيقة أو المجاز، فمن جهة الظل ضوء وانعكاس من نور الله الذي انفتح من الغيب والعماء المطلق، وهذا الضوء/الظل اشارة علي الاتصال أو استمرارية الاتصال بالخالق وبمصدر النور، انه آية توسط تحيل، من خلال ما يمكن رؤيته ولمس دلائله، إلي الخفي. ولذلك تتكرر في المدونة الدينية والصوفية خاصة مجازات الشمس والعين المجازية عين العقل وعين الروح. ولو عدت الي نص الجرجاني أعلاه لرأيته يعرف الظل الأول، بأنه العقل الأول لانه أول عين ظهرت بنور الله.
فمصطلح الظل الأول - كما أسلفت - يتضمن الضوء والانعكاس معا. وكونه يرتبط بالعقل الأول لا يعني ذلك أنه من باب المجاز، ويمكن لنص لابن عربي أن يفسر هذا علي النحو التالي، اذ يقول: 'الصورة، وهي تنقسم قسمين: صورة جسمية عنصرية، تتضمن صورة جسدية خيالية، والقسم الآخر، صورة جسمية نورية. فلنبتديء بالجسم النوري فنقول: إن أول جسم خلقه الله أجسام الأرواح الملكية المهٌّيمة في جلال الله، ومنهم العقل الأول والنفس الكل.. اعلم ان الله - تعالي - كان قبل أن يخلق الخلق - ولا قبلية زمان، وانما ذلك عبارة للتوصيل تدل علي نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع، - كان - جل وتعالي في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء. وهو أول مظهر إلهي ظهر فيه، سري فيه النور الذاتي كما ظهر في قوله: 'الله نور السموات والأرض' فلما انصبغ ذلك العماء النور فتح فيه صور الملائكة المهيٌّمين الذين هم فوق عالم الاجساد الطبيعية ولا عرش ولا مخلوق تقدمهم. فلما أوجدهم تجلي لهم، فصار لهم ذلك التجلي غيبا، كان ذلك الغيب روحا لهم، أي لتلك الصور وتجلي لهم في اسمه الجميل فهاموا في جلال جماله، فهم لا يفيقون'!
اذا ها هو الظل الأول/ العقل الأول
صورة جسمية نورية وعنها انفصلت - حسب عبارة ابن عربي - النفس الكلية، وهو 'العقل الأول' أول موجود ظهر أو انفصل عن سواد الغيب المطلق أو ما يسميه الجرجاني مركز العماء أو 'البيضاء' لأنه أول منفصل من سواد الغيب.
وقد تحدث ابن عربي عن هذا العقل الأول بوصفه القلم الأعلي، فقال:
'إن العقل الأول، الذي هو أول مبتدع خلق، هو القلم الأعلي: ولم يكن ثم محدث سواه. وكان مؤثرا فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح المحفوظ عنه، كانبعاث حواء من آدم في عالم الأجرام، ليكون ذلك اللوح موضعا ومحلا لما يكتب فيه ذلك القلم الأعلي الإلهي، وتخطيط الحروف الموضوعة للدلالة علي ما جعلها الحق - تعالي - أدلة عليه. فكان اللوح المحفوظ أول موجود انبعاثي. وقد ورد في الشرع: 'إن أول ما خلق الله القلم ثم خلق اللوح. وقال للقلم: اكتب! قال القلم: وما اكتب؟ قال الله له: اكتب وأنا أملي عليك. فخط القلم في اللوح ما يملي عليه الحق، وهو علمه في خلقه الذي يخلق، إلي يوم القيامة. فكان بين القلم واللوح نكاح معنوي معقول، وأثر حسي مشهود - ومن هنا كان العمل بالحروف عندنا - وكان ما أودع في اللوح من الأثر مثل الماء الدافق، الحاصل في رحم الأنثي. وما ظهر من تلك الكتابة، من المعاني المودعة في تلك الحروف الجرمية، 'هو' بمنزلة أرواح الأولاد المودعة في أجسامهم'.
يبدو هنا الظل الأول أو القلم الأعلي مفهوما تجريديا متعاليا، وابن عربي، كما يبدو، يربطه مباشرة بمفهوم الكتابة التي تتطلب شقين: شق معنوي نظري، وشق حسي عملي. يقول في السياق نفسه:
'ثم أوجد 'الله' فيه 'أي في اللوح المحفوظ' صفتين: صفة علم وصفة عمل، فبصفة العمل، تظهر صورة العالم عنه 'أي عن اللوح المحفوظ' كما تظهر صورة التابوت للعين عند عمل النجار. فيها 'أي بالصفة العملية' يعطي 'النجار' الصور، والصور علي قسمين: صور ظاهرة حسية، وهي الاجرام وما يتصل بها حسا، كالأشكال والألوان والأكوان: وصور باطنة معنوية غير محسوسة، وهي ما فيها من العلوم والمعارف والارادات، وبتينك الصفتين ظهر ما ظهر من الصور. فالصفة العلامة أب، فإنها المؤثرة: والصفة العاملة أم، فإنها المؤثر فيها، وعنها ظهرت الصور التي ذكرناها'.
ويأتي حديث ابن عربي هذا عن العقل الأول/ القلم الأعلي في سياق رؤيته لما يسميه النكاح الساري وتحته تندرج مصطلحات كثيرة علي رأسها ما يسميه الآباء العلويين والامهات.
وها نحن نري كيف يربط القلم الاعلي بالقوة المؤثرة التي هي قوة 'الأب/المذكر' أما الصفة الفاعلة العاملة التي تقبل التأثير فهي الأم عند ابن عربي، والنتيجة هي الحروف والكتابة، وهي مظهر لتجلي النفس الرحماني الذي يوجد الوجود ويظهره بوصفه صورا وتجسدا!
ان الاساس الجنسي الذي يحرك رؤية ابن عربي يتجلي في أقوي صوره هنا، ولكن هل هنا اثر أفلاطوني؟ حيث يعزو أفلاطون أصل الكلام واللوغوس الي الاب؟ لقد لاحظ دريدا وهو يدرس أفلاطون انه يعزو أصل الكلام الي الموقع الابوي، يقول دريدا: 'فيكفي ان نسلط انتباها دؤوبا - وهو ما لم يقم به علي حد علمنا أحد حتي الآن - علي تواتر رسم أفلاطوني يعزو أصل الكلام وسلطانه، اللوغوسي Le logos تحديدا، الي الموقع الابوي. وذلك لا لأن هذا يحدث عند أفلاطون وحده أو يحدث عنده بامتياز. فنحن نعرف هذا أو نتخيله بسهولة. لكن ألا تفلت 'الافلاطونية' وهي التي تموقع كامل الميتافيزيقيا الغربية في مفهوميتها، من شمولية هذا الالزام البنيوي، بل تدلل عليه بالتماع وحذق لا يضاهيان، فهذا لمما يحيل الامر أكثر دلالة. ولا كذلك لان اللوغوس هو الاب. بل ان أصل اللوغوس هو أبوه وقد نقول، مفارقين معجم تلك الحقبة، ان الفاعل المتكلم هو أبو كلامه'.
في فصل مهم يخصصه ابن عربي لمعرفة ما يسميهم الآباء العلويون والأمهات، وهو الذي يمهد من خلاله للحديث عن العقل الأول يقول:
'اعلم - أيدك الله ! - انه لما كان المقصود من هذا العالم الانساني وهو الإمام، لذلك اضفنا الآباء والامهات اليه فقلنا: آباؤنا العلويات وأمهاتنا السفليات. فكل مؤثر أب، وكل مؤثر فيه أم. هذا هو الضابط لهذا الباب.
والمتولد بينهما، من ذلك الاثر يسمي ابنا ومولدا، وكذلك المعاني في انتاج العلوم، انما هو بمقدمتين تنكح احداهما الاخري بالمفرد الواحد الذي يتكرر فيهما، وهو الرابط، و'هذا' هو النكاح 'المعنوي' والنتيجة التي تصدر بينهما هي المطلوبة، فالأرواح كلها آباء والطبيعة أم لما كانت محل الاستحالات. وبتوجيه هذه الارواح علي هذه الاركان، التي هي العناصر القابلة للتغير والاستحالة، تظهر فيها المولدات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان: والإنسان أكملها'.
وتبدو أولي الامهات السفليات عنده في منطقة المعدوم الممكن، أي في المحجوب المظلل غير المرئي الي أن يتحقق ظهوره، يقول عما يسميه الاب الاول والأم الاولي والنكاح الأول: 'وهذا الباب انما يختص بالامهات - فأول الآباء العلوية معلوم وأول الأمهات السفلية ، شيئية المعدوم الممكن. وأول نكاح القصد بالأمر. وأول ابن وجود عين تلك الشيئية التي ذكرنا - فهذا أب، ساري الأبوة. وتلك أم، سارية الأمومة، وذلك النكاح سار في كل شيء
. والنتيجة دائمة، لا تنقطع في حق كل ظاهر العين.
فهذا يسمي عندنا 'النكاح الساري في جميع الذراري' يقول الله - تعالي - في الدليل علي ما قلناه: 'انما قولنا لشيء اذا اردناه أن نقول له كن فيكون.
اخبار الأدب
مارس 2008