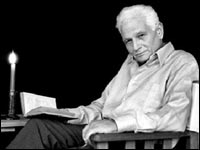 في حاشية أو ذيل على حاشية كتبتها هيلين سيكسوس، "صديقة" جاك درّيدا (1930 - 2004) منذ ثلاثة وثلاثين عاماً (يومها، في 1995)، ووسمتها بـ"عِلم"، الفعلية والمصدرية الصيغة في الفرنسية - وطُبعت حاشية الصديقة وحاشية الصديق تحت وسم مشترك هو "براقع"، أو"أشرعة"، على التذكير في الأولى والتأنيث في الأخرى -، يكتب درّيدا تعليقة على قول بولس الرسول في رسالته الى أهل كورنتس: "ولسنا كموسى الذي كان يجعل برقعاً على وجهه لكي لا يتفرس بنو إسرائيل في غاية ما يُبْطَل، بل أعميت بصائرهم لأن ذلك البرقع نفسه باقٍ الى يومنا هذا غير مكشوف عند قراءة العهد العتيق إذ هو بالمسيح يُبطل" (...) وحين يرجعون الى الرب يُرفع البرقع" (...) فإن كان إنجيلنا محجوباً فإنما هو محجوب عن الهالكين" الذين فيهم إله هذا الدهرِ قد أعمى بصائر الكفرة...".
في حاشية أو ذيل على حاشية كتبتها هيلين سيكسوس، "صديقة" جاك درّيدا (1930 - 2004) منذ ثلاثة وثلاثين عاماً (يومها، في 1995)، ووسمتها بـ"عِلم"، الفعلية والمصدرية الصيغة في الفرنسية - وطُبعت حاشية الصديقة وحاشية الصديق تحت وسم مشترك هو "براقع"، أو"أشرعة"، على التذكير في الأولى والتأنيث في الأخرى -، يكتب درّيدا تعليقة على قول بولس الرسول في رسالته الى أهل كورنتس: "ولسنا كموسى الذي كان يجعل برقعاً على وجهه لكي لا يتفرس بنو إسرائيل في غاية ما يُبْطَل، بل أعميت بصائرهم لأن ذلك البرقع نفسه باقٍ الى يومنا هذا غير مكشوف عند قراءة العهد العتيق إذ هو بالمسيح يُبطل" (...) وحين يرجعون الى الرب يُرفع البرقع" (...) فإن كان إنجيلنا محجوباً فإنما هو محجوب عن الهالكين" الذين فيهم إله هذا الدهرِ قد أعمى بصائر الكفرة...".
فيخلص الى أن "النور" لو كان "كَشَف" البرقع، أو الغطاء، أو الحجاب، أو الستر - على قول العربية الكثير أو المتكثر - عمن أو ما لا يطيق البصرُ النظرَ إليه، إلا "متسلحاً" (على قول فرويد بموضع آخر من الحاشية) بما أو من يُبطِل التبرقع واحتجابَ المعنى الحي، فكيف لا يبصر النظر ما يمثل من تلقاء نفسه، أو عارياً وظاهراً؟ على خلاف زعم إدراك حقيقة الأشياء حيث هي، وفي نفسها. وهو زعم يستأنفه الفكر أو تاريخه، ويُعيد فيه ، فيحمل الحقيقةَ (والصدق والصواب) على المطابقة والاتفاق والثواء في النفس.
ويذهب دريدا - على خطى مارتن هايدغير، أحد "ينابيعه" الأقرب - الى أن قراءة "عِلم"، أي حاشية هيلين سيكسوس على شفائها الجراحي من قصر النظر وارتفاع الغشاوة عن بصرها ومباشرتها الدنيا مذ ذاك بشفيَها ولمسها، هذه القراءة لا تحصل في لغة (فرنسة) ثاوية في نفسها، على وجه ثواء الميت في قبره. فاللغة تتعدى حالها، وما هي عليه، الى آتيها، وتوجّهها عليه، وسفرها إليه. فهي تُقرأ في لغة آتية. ومعنى هذا أننا نقرأ "متأخرين"، وما نقرأه إنما نقرأه "متأخراً"، أو "فائتاً" حاضرَه الذي لا يُدرك حاضراً إلا ميتاً.
فماذا يرث الوارثون، على هذا: أي إذا كنا يخاطب بعضنا بعضاً (وهذا يصدق في "محاورة النفس نفسها" على قول ابن رشد) ووجهنا الى الآتي فنفهم متأخرين وبعد الفوت؟ فلا نحضر نفسنا ولا تحضرنا هذه، ونحن وإياها دوماً على بَيْن وفوت. ويجيب دريدا مستشهداً "فعلاً لا يُحاكى، قوامه أن نعرف كيف نرث من غير أن نرث، وأن نجدد ابتكار الأب والأم"، أو الآباء والأمهات، على ما جاء في التنزيل القرآني. وليس السبيل الى هذا "نهجاً" أو "منهاجاً". فهذا مدرج المحاكاة ووراثة الميراث. ولا "امتلاكاً" للنفس، أو قياماً وانتصاباً بـ"محلها" و"حيث" هي وإشغالاً له، على قول يتردد في خُطابة "نقدية" وتاريخانية عربية شائعة.
ومثال هذا الفعل "تقدمةُ" (على معنيي الوقت والهبة) لباسٍ أو ثوب، وهذا من جهاز العرس وثَقَل البيت وأهله، "تعصى عرواته الفك أو الفرط، وعلى شرط أن يكون غير مسبوق، ومنيعاً أو قريباً من المنعة(...)، فريداً، متين الحياكة ومرن الخيوط المشدودة كلها بعضها الى بعض، من غير بقية". ويمضي صاحب الحاشية على بسط الكناية (النسج والحياكة) وعلى تكثير عراها وربطها بكنايات قريبة أو بعيدة، على مثال عُرف به، ووسم "كتابته" بميسه. فالثوب - وهو يكني به عن الشعر أو الكتابة أو المخاطبة أو الحادثة أو الحياة -، صورته ومعناه في عروته وخياطته ونسجه.
ولكنه (والشعر على صورته) يتماسك، ويصل بينه وبين نفسه ما يصل بينه وبين الحادثة أو الواقعة التي يقع عليها القول (الشعري أو "الثوبي") ويتناولها. فهو يتصل بها على معنى العروة والنسب والتعلق، ويقوم فيها على معنى المكث والإقامة والتحصن، من طريق عمل كتابي يستدين دَيْنه من عمل "حقيقي" يحدث "في العالم"، ويقع على جسد واحد، ويقوم مقام المرجع الفريد. (والأفعال العربية: يتماسك ويصل ويتصل ويقوم، تؤدي كلها فعلاً فرنسياً واحداً tenir، يصرّفه الكاتب على معانيه من طريق اللزوم أو حروف التعدية أو صيغة الانعكاس). وتعريف فرادة الحادثة هو صدورها عن غير اللغة، ومفارقتها اللغة. وينهض التوقيع بالاسم العَلَم علماً عليها. فالتوقيع هو بمنزلة الحاشية من الثوب: هي منه ولكنها خيطت على طرفه وحده.
فصاحب التوقيع ليس من المتن، لا هو ولا الاسم العلم الذي يعرف به. وحين يوقع باسمه نصه، وقعه حقيقة أم "حل" فيه من طريق نسجه وحياكته، فهو ينأى بنفسه، وبالحادثة التي تصل بها الكتابة، من متن الكتابة من غير أن يخرج منها أو ينسل. وذلك على شاكلة حاشية الثوب.
وفي محاورة (متخيلة) مع محاور قد يكون صاحبة الحاشية التي تذيلها حاشيته، ينكر المحاوِر على تعليقة دريدا تحفظها عن رسالة بولس، وتمييز "رسول" يسوع ختانَ الجسد ("في اللحم") من ختان القلب ("بالروح")، من غير أن يبلغ التحفظ مبلغ الإنكار الصريح والجهير. فمقالته البينيلوبية (نسبة الى بينيلوبه، زوجة عوليس ملك إيتاكا وصاحب خدعة حصان طروادة، وكناية عن حياكتها النهارية التي تحل عراها ليلاً في انتظار "رجعة" زوجها غير المأمولة)، بحسب محاوره المتخيل، تطعن في الختان على قدر ما تطعن في المخالفين عليه. وهذا شأنه كذلك في الحجاب المدرسي (الإسلامي). فكيف يخلص من الطعن والطعن على الطعن، ومن الإنكار والإنكار على الإنكار (وهذا تمثيل على "المطاعن" الرائجة في درّيدا، وما يذهب إليه تشارلز تايلور، صاحب كتاب جامع في "ينابيع الأنا"، على سبيل المثال)، الى "فرض مقارن ومتماسك" تترتب عليه "سياسة" يساس بها الحجاب والتشادور الإسلاميين والقلنسوة اليهودية في الهيئة المدرسية العلمانية والديموقراطية؟
والحق أن صاحبنا لا "يخلص" من المطاعن على المطاعن - وهو ما يسميه "التفكيك"، بين مزدوجات، تحفظاً عن التثبيت على أصل والنسبة الى طريقة - الى فرض متماسك، ولا الى سياسة. فالمدرسي - الزمني، على قوله، والعلماني والديموقراطي، تنتسب بقضها وقضيضها الى "ثقافات" القميص (الشعائري اليهودي) والحجاب (أو البرقع) وغطاء الرأس (البولسي، نسبة الى مار بولس الرسول صاحب "الرسائل"(، وترتيب المرأة والرجل على مراتب وفروق جوهرية، وتمييز الختان الجسدي من ختان القلب والروح، وحمل الحقيقة والصدق والصواب على هتك الحجب والرؤيا رأيَ العين... وهذه كلها مواريث، على معنى المحاكاة والتقليد، وعلى معنى المسبوق والمتواتر والحياكة على مثال ناجز ينتهي الى غاية ووقت.
ودرّيدا، وهو يكتب ما يكتب في القميص الشعائري (والهُدب بذيله "بخيط السَّمْجونيّ"، على قول سفر العدد)، وفي أشباهه من الشعائر والمعتقدات التي تصل موسى النبي بفرويد ولاكان من طريق بولس وأوغسطينوس وابن ميمون وهيغل ونيتشه وهايدغير، دريدا هذا يعرج على قميصه هو، القميص الأبيض من غير هُدْب الذي أهداه إليه جده وخصه به واصطفاه من دون ذريته في بلدة البيار الجزائرية، واستعاره أبوه في بعض احتفالاته، ورده إليه وحفظه هو في خزانة ثيابه. وتعريجه على القميص الموروث يصل بينه وبين أبٍ "يبتكره" الابن الذي شارف، يومها، الشطر الثاني من عقده السابع. ويلمح "الابن" وهو يعلق على شفاء صديقته من عيب بصرها، و"حدادها" على اشتباه الأشياء والمرئيات جراء "المعجزة" التقنية العلمية (عملية "اللايزر"(، الى انتظاره خبراً طبياً ومخبرياً ينهي إليه أمراً هو مناط حياة وموت. وقد يخمن القارئ، غداة وفاة الرجل، في الخبر الطبي والمخبري المرض الذي أودى به، وظهرت أعراض إصابته به في الأيام الأخيرة من 1995.
فتصل كتابة الكاتب، أو "حياكته" (وهي كنايته الفلسفية والخطابية الأثيرة التي يُتبعها بصفة "الإرسال" لا الى غاية أو حد)، بين صدور القميص عن أمر شرعي توارثه الأهل الى يوم "الابن"، جاك دريدا نفسه، ولكن على وجه تلبية النداء ("ها أنا ذا"، أي "لبيك") والاشتراك فيه والاجتماع عليه، وبين رعاية القميص، والعلاقة الفريدة به، شعيرة تخص وارث القميص ولا يشاركه أحد فيها. فيروي موقّع المتن المكتوب، شأنه في عمل طويل سابق موسوم بـ"البطاقة البريدية"، أن قميصه الأبيض هذا لا يسافر معه، ولا يترك خزانة الثياب. وهو لا يلبسه الى كنيس لم ييمم إليه، ولم يرتده منذ خمسين عاماً. ولكنه يخرجه من خزانته عشية كل سفر، وهو كثير الأسفار والترحال، ويلمس بياضه الذي مال الى صفرة، ويقرأ في كتاب أبيه.
فالقميص الستر أو الحجاب لا يستر "شيئاً"، على خلاف ظن بومبيوس، قائد الحملة الروماني على هيكل أورشليم الثالث وعلى "غلاة" اليهود في الثلث الثالث من القرن الميلادي الأول، وعلى ضد حسبانه أن الستارة على قدس الأقداس إنما تحجب عن الأبصار ما يخطفها ويثبتها على يقين لا يتزعزع. فإذا بالستر لا يستر ما يصدق أن يسمى مباشرة ومن غير واسطة، أو ما يقع عليه اسم. فـ"الأصل" المفترض، أو الأول المحتجب وركن "الكونيات - اللاهوتيات"، إنما هو "أثر"، على قول درّيدا في "الصوت والظاهرة" (أول مقالاته، وهو تعليقة على "أصل الهندسة" لادموند هوسِرْل). والأثر هذا ليس "لا شيء" أو عدماً.
فهو يحضر التلبية المتقدمة (وقتاً وهبة) والمتأخرة عن نداءٍ، القرينةُ عليه هي التلبية. ويقوم الأثر من التلبية مقام الأمر أو النهي. ورأس النهي (الابراهيمي) هو النهي عن القتل. فما يفترض أصلاً أو مصدراً تنشأ مصدريته عن توجيهه مخاطَبه، وإثباته إياه مخاطَباً، الى وجه "المرء الآخر" (على قول أحد "ينابيع" دريدا الأغنى، إيمانويل ليفيناس)، وأمره إياه ألا يقتله.
ويقع صاحبنا من القميص الشعائري، أو من "علم" صديقته، على ما يقع عليه من قراءة كتب تاريخ الفلسفة الكبيرة (وقراءته محاورة "فيدر" لأفلاطون ذهبت مثالاً طاغياً، وهي منقولة الى العربية)، أو الكتب الدينية، أو أعمال التحليل النفسي (الفرويدي)، أو شعر الشعراء ورسوم الرسامين الفنانين، أو حوادث الحياة "العجيبة العاديّة"، على قوله. و"تحاكي" كتابته، على مثال "براقع" أو "أشرعة" ("براقع - أشرعة"؟) بنية المعنى التي يقتص عملها في "الكتابات" على أنواعها، منذ بيانه الفلسفي الموسوم بـ"الكتابيات" أو الحَرْفيات" ("غراماتولوجيـا") في 1967.
وعلى هذا، فالطريقة المنسوبة الى الرجل ليست تقنية تنقّل بين الموضوعات والأعمال، وليست دعوة مرسلة الى "الشك" وإعماله في البدائه والمسلمات والمصادرات، على ما ينسب إليه "دعاة" عرب يحلمون أنفسهم "تفكيكيين" أو "مفككين" من غير تحفظ ولا كتابة ولا حوادث. فهو وكتابته وحياكته وحوادثه ووراثته وفرادته، واحد. والمتُّ اليه بعروة التلمذة، وليس بعروة الطلب أو الدرس أو التلبية ("ها أنا ذا")، انتساب الى مصدرٍ وأول، أي الى ما لم ينفك الرجل ("الآخر") يبث فيه "الفرق" أو التقدمة المتأخرة من غير تضاد ولا اتفاق.
الحياة 2004/10/12