| | - "والغَرَبُ: الذهاب والتَّنحي عن الناس.
وقد غَرَبَ عنا يَغْرُبُ غَرْباً، وغَرَّبَ، وأَغْرَبَ،
وغَرَّبه، وأَغْرَبه: نَحَّاه."
-- إبن منظور. "لسان العرب" -
- "وهناك تقدَّم غُرابٌ جليلٌ من الأيام الخوالي الطاهرة."
-- إدغار ألن بو. "الغراب" - |
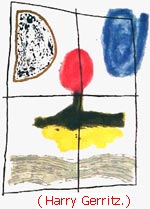 خلف نافذة الغرفة المضطجع أنا فيها بِسَأمٍ شديد في ظهيرة بالغة السوء لا تتيح أية إمكانية سوى كراهيتها، حطّت حمامة على الهوائي المنصوب على السقف المجاور. وخلف الهوائي ثمة سماء زرقاء تكسوها سحبٌ بِيضٌ، وقمة شجرة جوز هند عجوز بدت كما نخلة عتيدة أمام الموت، في الباطنة.
خلف نافذة الغرفة المضطجع أنا فيها بِسَأمٍ شديد في ظهيرة بالغة السوء لا تتيح أية إمكانية سوى كراهيتها، حطّت حمامة على الهوائي المنصوب على السقف المجاور. وخلف الهوائي ثمة سماء زرقاء تكسوها سحبٌ بِيضٌ، وقمة شجرة جوز هند عجوز بدت كما نخلة عتيدة أمام الموت، في الباطنة.
بقيت الحمامة لوحدها، تنظر إلى الأنحاء ببعض الوجل. قلت في نفسي أن الأمر قد يكون انتظارُ عشقٍ لتوأم الروح. لبثت الحمامة لوحدها، إذاً، مدة حوالي عشر دقائق، قبل أن تحط حمامة أخرى لتُزامِلَ الأولى لمدة سبع دقائق على الأقل، ثم حطّت حمامة ثالثة، وأنا أرقب.
تقديري البشري، أي غير العارف وغير الطيري، إلا أن الثالثة بمجرد ان حطّت طارت الثانية بهدوء، ثم طارت الثالثة بعدها بقليل، بهدوء مماثل، أو يكاد. وقد يعود ما حدث لاعتبارات أجهلها غير اعتبارات المكان والمساحة والمنافسة في منطق الحمام وحساسيته.
بقيت الحمامة الأولى لوحدها، إذاً.
ثم بعد حوالي ثلاث دقائق أخرى حطَّ غرابٌ ففرّت الحمامة "الأخيرة" -- والتي، في الحقيقة، كانت الأولى في الوصول إلى المكان -- في ذعرٍ فوري واضح أين منه الحركة البطيئة قليلاً (هكذا تخيلتها سينمائياً) في لقطتيْ مغادرة زميلتيها السابقتين.
وصار الغراب وحده في الأفق.
بصورة من الصور، لا أكره الغراب على نحوٍ مجّاني ومطلق، وإن كان قطعاً ليس من الكائنات الأثيرة لدي، فقد عشتُ، بتناقضات شتى، طفولتي معه في الباطنة على ساحل البحر وفي مزرعة الوالد. وقد اشتركنا، حرفيّاً، في الأكل والشرب من نفس حبّات المانجو وعذوق البلح والسواقي السائلة بعذب الماء وخير الطحالب والفطريات، فصار بيننا -- بين الغراب وأنا، عنيتُ -- شيء من "العيش والملح"، ولو على مضض وضيم واضطرار.
والحقيقة انه ضمن مغبَّات وارتباك علاقتي به، كشفتُ، نهاراً جهاراً وبحماقة متهورة، لرفاق الردح المبكر من الحياة عن حساسيتي السمعية والبصرية النشاز حين اعترفتُ بإعجابي بصوت الغراب، وعنقه وصدره - تحديداً، بذلك التغاير اللوني الباهت، وهو أكثر وضوحاً في حالة "الحناديل" منه في حالة الغربان، والذي كان يثيرني كثيراً، فلم أحصد سوى قهقهات ساخرة ونظرات تتهمني بالخبال (و"حَنْدَل"، بالمناسبة، كلمة عربية فصحى كما جاء في "اللسان"، وتعني طبعاً ابن الغراب أو الغراب الصغير، ومن الواضح انها حُرِّفَت قليلاً في الدارجة إلى "حندول"، ويبدو لي ان الأمر كان أصلاً تصغير تحقير - إذ حاشاهُ أن يكون تصغير تحبيب! -- دَرَجَ فصار، بالتعاقب، سائد القول).
إذاً، ضمن عدد من الملاسنات والمجادلات، حاول بعض الرفاق أن يهديني سواء السبيل بأن أجرى مقارنة لونيَّة بين الغراب وقاطني إحدى الحارات المعزولة على طرف القرية بغرض تأسيس وشيجة قربى بين الإثنين في مسعى كان يفترض أن يكون كفيلاً بإعادتي إلى جادة الصواب، فكانت الطّامة الأكبر، بنفس العفوية المفتقرة إلى أية مكابح، هي بوحي أني لا أكره أولئك القوم بصورة خاصة، وإن كنت، بما معناه، قد أشمئز من، أو مما يقال عن زَيْدٍ منهم، بالقدر الذي أكره، أو أكره ما يتردد عن، عمرو من غيرهم.
كان من الواضح أن الحديث ينبغي أن ينتهي عند هذا الحد، وقد انتهى عند ذلك الحد. ولا زلت سعيداً انه انتهى عند الحدّ ذاك، لأن تلك النهاية العاجلة تكفّلت خيراً بِمُحْتَمَلِ الشرّ الذي كانت مراجله على وشك أن تغلي لدى آخرين، ولديّ.
في الصبا، إذاً، كنت أحاول أن أفهم الغراب أو أتفهمه لأن الجميع في قريتي كان يكرهه، بل يمقته أيّما مقت، ولذا حدستُ، وإن يَكُ بصورة في غاية الاعتباط والجِزاف والعفوية والعناد الشقي فحسب -- أي بصورة لا أريد أن أدَّعي فيها أكثر من النَّزَقِ الساذج -- أن الأمر ينطوي على ظُلمٍ ما، ففي قريتي الشَّظُوفُ تلك كان في مقدورك، وأنت غَضٌّ يافعٌ، أن تتعرف، مبدئياً فحسب، إلى ثلاث كلمات كبيرة جداً وشائعة جداً في حديث الناس على شؤون الحياة وشجونها (وقد كان لدى صيّادو وفلاحو قريتي الكثير من الثانية والقليل من الأولى)، وهي كلمات ثلاث جِسامٌ ستسهم في رسم مسار بقية حياتك: "ظلم" و"ظالم" و"مظلوم".
هذا، في عود على بدء، على الرغم من أني، للمفارقة، كنت شاهد عيان يومي مخذول وخائب الأمل على الحقير الشائن مما كان يفعله الغراب بمزروعات الناس وأثمارهم وأسماكهم المجففة، بل حتى بثيابهم القديمة التي مزَّقها الكدح والضنى في البَرِّ وفي البحر، والمنشورة بكبرياء الفقراء وعنفوانهم على الحبال في الظهيرات الصبورة والمتقشفة، والتي كان الغراب يتعامل معها وكأنها، حسب تسمية اليوم، دورات مياه عمومية، وهذا الضرب من الإهانات المتغطرسة كان لا يطاق فعلاً.
والحق، ضمن هذه التناقضات، هو أيضاً أني كنت أتراجع في كثير من الأحيان، بيني وبين نفسي (في قليل من التردد)، وأمام الصِّبية أيضاً (في كثير من التأكيد)، وبصوت عالٍ عليّ المسارعة بالقول انه كان مُفعَماً بالمداهنة والاسترضاء، عن محاولة فهم الطائر البغيض أو التعاطف معه حين ينضمُّ موقفي "الغريب" من الغراب إلى أمثلة أخرى مما كان يقال سراً حول "غرابتي". وكان بعض ما يقال يصل إلى مسمعي، فيصيبني بحزن وكدر شديدين وتوق أشد لأن أكون "طبيعياً" ومقبولاً لدى رهط الصِّبية، وأن لا أكون منبوذاً ومعزولاً ووحيداً وموضوع قيلٍ وقال في أوساطهم.
أقول هذا على الرغم من، أو إضافة إلى، أني، كما ألمحتُ، لن أكفّ عن السخط على الغراب لمسارعته في التهام الأجزاء الناضجة من ثمار المانجو بمنقاريه الشرهين في مزرعة الوالد (فهو، إذاً، ليس بالغبيّ ما دام يعرف أين يكمن السُّكَّر في بواكير هدايا الصيف البيضاويّة التي تغلبها الحموضة، أليس كذلك؟)، وبهذا كان الغراب يفسد عليّ طقس "لقاط الهمبا" صباحاً وعصراً، خاصة في أول الصيف حيث "الهمبا" ألذ ما يكون بعد طول انتظار، وهكذا تراه أيضاً وقد فعل الفعل نفسه بالبلح، "الرّطب"، في العذوق.
أما التصرفات الاستفزازية المنكرة التي كان يقوم بها الغراب بعد أن تمتلىء حوصلته الآثمة، فقد كانت في غاية الوضاعة والغدر والخيانة، فيما يخص عالمي الصغير والكتوم إلى حد ما، فقد رأيت بالتدريج ان تلك التصرفات موجهة ضدي شخصياً، بكل عمد وتعمد، وكل تأكيد، وكل وقاحة وقلة أدب، على الرغم من موقفي "المسالم" (على الأقل) غالباً نحوه.
ألا يجد الغراب -- الذي أنا بالتأكيد لست صديقه الأفضل في كل الدنيا، ولكني، على الأقل، أكثر من يحاول أن يفهمه أو يتعاطف معه في قرية بأكملها -- مكاناً أفضل لفعل ما يفعله سوى على ما بذرتُ، إذ كنت أهرع متلهفاً في الصباح لرؤية باكورة ما زرعتُ، فأرى الخضرة الطالعة بالكاد من الطين وقد ذرق عليها الغراب الذي أفاق قبلي بنيّة مُبيّتة ولا شك.
ضمن هذه الوتيرة التي ازداد توترها مع مرور الأيام صار الأمر شخصياً بصورة صارخة وخَطِرَة، ولذا أصبح من الضروري، بالنسبة لي، الخروج من حالة شبه الحياد (على الأقل) ومحاولة الفهم (على الأكثر)، فتلك الاستفزازات الفظَّة كان أسوأ ما فيها الطعن في الظهر، حيث أنها نكران شيء من الجميل الذي أتحمل بسببه الكثير، ومقابلة قليل من الخير وحسن النوايا بكثير من الشر وسوء النية، ولهذا كان من المستحيل الصبر عليها إلى الأبد.
لم يكن الغراب يريد أن يساعدني، ولا أن يساعد نفسه، بل كان مصرّاً على مواجهة حاولتُ طويلاً أن لا تحدث - على الأقل، ليس بتلك الصورة المتطرفة، فقد كانت هناك مناوشات محدودة ومتفرقة بيني وبينه قبل ذلك.
هكذا، إذاً، اندلعت شياطين الجحيم في براكين ظهيرة من أحد أيام الصيف الحارقة، فقادت إلى مجزرة كبيرة سأندم ليس كثيراً، لكن دوماً، لأني كنت من ارتكبها بساديّة مجنونة، ففي فورة من الغضب الجارف على استهتار الغراب واستخفافه بي، وبمزروعاتي الصغيرة، بل - وهذا هو الأنكأ-بموقفي "المعقول" منه، سُقْتُ سبعة غربان إلى مصرعها مباشرة، وبتصويبات أقل إحكاماً أوقعتُ جراحاً بالغة بتسعة من الضحايا التي سارعتُ، ومن دون أدنى تردد، إلى إطلاق رصاصات الرحمة على رؤوسها من مسافة مُتَشَفِيَةِ الحُنق في قُربها، ببندقية "الكَسْر" الشهيرة لدى صِبية السبعينات.
يا للهول! ستة عشر كائن قتيل على يدي مخلوق صغير؟! لم يكن في وسع شروط الحياة، فيما يخص البشر والطير معاً، أن تقود إلى ما هو أفضل مما حدث في تلك الظهيرة البعيدة.
لكني، بعد أن سال حمّام الدم شعرت بإنهاك يفوق ما يفترض أن ينجم طبيعياً عن الجهد البدني والذهني الذي بذلته في أثناء تنفيذ المذبحة، وبحلول العصر كنت أرتجف في حمى شديدة.
وفي تناقض آخر أتذكره جيداً، حرصت على أن لا أبلغ الصَّبية بمحصول القتل الوفير هذا، على الرغم من أني لو أخبرتهم بشأن مجزرتي فإن الأمر كان سيسهم بالتأكيد في تحسين صورتي لديهم، وقد كنت في أمسِّ الحاجة إلى ذلك. ثم إن توقيت الإصابة بالحمّى عقّد الأشياء بالنسبة لي، إذ أن ابتلائي بها، بعد اقتراف الجريمة مباشرة تقريباً، لا يمكن أن يكون "صدفة" حسنة في منطقي عهد ذاك، وفي فلسفة قرية أكثر من نصف سكّانها خرافات وأساطير وقصص وحكايات، بدءاً من ظهور جَمَلٍ بلا رأس التهم ليلاً أحد الصّبية الأسلاف، ومروراً بالجنيَّة الشريرة التي تحاول ابتلاع القمر غُبَّ الخسوف، ووصولاً إلى إمكانية نشوب حرب ضَروس وخاطفة ينتظر كل التاريخ، منذ بدئه، نشوبها في أية لحظة بين "بحرنا"، نحن سكّان الساحل، و"بحرهم" الغامض الذي لا نراه، أي أولئك القاطنين في الصحراء والجبال - يا للطوفان الذي لا نوح ينقذ أحداً منه هذه المرة، والذي كنت أتوقعه كلما هاج البحر!.
ومع ذلك، أو إضافةً إليه، كانت هناك أسباب أخرى لعدم التباهي بأمر المجزرة الرهيبة، وإبقائها سرّاً على الرغم من انه لم يكن في مقدوري أن أفلسف الأمر يومها، وليس من حقي أن أفلسفه اليوم بأثر رجعي من مسافة بعيدة ولغة ووعي مختلفين. لكني أعتقد - وإن كنت لا أُصِرُّ - ان من جملة الأسباب، على الأقل، هو أني اعتبرت آنذاك، في اتساق مع أشياء أخرى مما كنت أَخبِره عن نفسي خلال تلك الفترة تحديداً، أني لم أكن فخوراً جداً بما حدث على الرغم من كل شيء، وان المسألة برمتها - صالحة كانت أم طالحة -- كانت شخصية، وبغض النظر عن موقف القرية الجماعي من الغراب. وقد تمت تصفية الحسابات بصورة شخصية، وانتهى الأمر الخاص الذي هو ليس من شأن الآخرين في شيء.
............................................
...........................................
...........................................
لكن، حقاً، أهذا زمان "الغراب"؟. صورة إدغار ألن بو المعلّقة في الأفق؟!
أهو المشهد نفسه، والمنطق نفسه، من مُجَز الصغرى إلى لوس أنجيليس، وحتى يرث الأرض العصر الجليدي القادم؟!
............................................
...........................................
...........................................
جلبت لي الواقعة الغرابيّة في الظهيرة هذي ذكريات شتى أشركتكم فيها، وكم أنا حزين لأن الغراب، اليوم، لم يُتِحْ لثالثة الحمامات الاستمتاع بمقعد مؤقت، حرج، ومرتبك أصلاً، ولا يزال يتربع على المكان منذ نحو ساعة، لدرجة أنني فكرت، ضمن المشاعر المتناقضة إياها (والتي قطعاً تجدد تناقضها اليوم)، في القيام بشيء ما لإجباره على المغادرة.
لكني تراجعتُ عن فكرة طرده، واخترت، عوضاً عن ذلك، أن أجيء إلى الطاولة لكتابة هذه المادة، والتي ما إن أنهيتها حتى عاجلتُ بنظرة عبر النافذة، فكان الغراب قد رحل من تلقاء نفسه.
رَحَلَ، ولكن إلى أين؟!
ربما - ربما، فقط -- إلى تلك القرية البعيدة الغافية على صدر السنوات العسيرة.