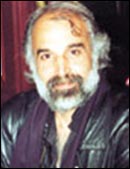 ما بين المنفى والمكان الأول، يقيم الكاتب العراقي جبار ياسين، الذي حاز مؤخراً جائزة (كتاب عبر الحدود) الإيطالية، انه في هذا المكان المعلق ما بين الأرض والسماء، حيث لم يتوقف عن التساؤل عن معنى الكتابة.
ما بين المنفى والمكان الأول، يقيم الكاتب العراقي جبار ياسين، الذي حاز مؤخراً جائزة (كتاب عبر الحدود) الإيطالية، انه في هذا المكان المعلق ما بين الأرض والسماء، حيث لم يتوقف عن التساؤل عن معنى الكتابة.
في باريس، التقيناه مؤخرا وكان هذا الحديث.
* سنبدأ الحديث بالموضوع الراهن، زرت العراق بعد سقوطه مرات عديدة، وكما قلت لي، لا تحس بأي رغبة في العودة والإقامة النهائية هناك، أولا، كيف وجدت العراق خلال زياراتك المتكررة، ثانيا ماذا يعني لك هذا القرار؟
هناك جانبان، الجانب الأول الذي يتعلق بعودتي إلى العراق، فهي كانت كما لو أني تركت طفلا، وعدت بعد زمن طويل لأجده قد شاخ. الطفل هو الطفل ذاته لكنه لم يعد نفسه. وبالتالي أنا غريب عليه وهو غريب عليّ لكنه الطفل ذاته وأنا الشخص ذاته الذي ترك هذا الطفل. بالتالي هذه المعادلة ان صحت التسمية من الصعب حسمها. بعد 29 عاما من الحياة في بلد آخر ومحيط آخر وزمن آخر وفي حالة فكرية وروحية أخرى، بدا لي منذ الأيام الأولى لعودتي إلى العراق أن حياتي هناك لم تعد ممكنة لأني لا أمتلك غير الحالة العاطفية، والحالة العاطفية وحدها لا تخلق حياة لأن الحياة أعقد من ذلك، لأن الحياة هي الذاكرة، العلاقة مع الأمكنة، العلاقات مع البشر، هي الإحساس بالفضاء والإحساس بمرور الزمن. هناك كل شيء تمّ ونما بمعزل عني، وبالتالي أنا غريب في هذا الحيز الزماني والمكاني، لكني فقط، مرتبط به برابطة الدم. وهذه العلاقة (القبلية)، لا تكفي وحدها لخلق منظومة حياتية. وإذا خلقت منظومة حياتية فهي تبدو لي غريبة لأنني لا أعيش حياتي فقط انطلاقاً من قرابة الدم. لكن مع هذا وجدت العراقيين في حالة أفضل، في حالة روحية أفضل، وبخاصة عن المرة الأولى التي زرت فيها العراق منذ سنتين. في لحظات الانتقال التاريخية في حياة الشعوب هناك حالة من الدهشة وحالة كبيرة من الأمل، حالة خيالية من الأمل غير واقعية أبداً، فالعراقيون كانوا يتصورون أن كل شيء سيتحقق في فترة قياسية. لا ننسى أن العراق عاش ما يقارب 5 شهور بدون دولة وبدون منظومات رسمية وبدون مؤسسات، واستطاع أن يحافظ على إيقاع حياتي بالحد الأدنى بدون أن تحدث مشكلات اجتماعية كبرى، كحرب أهلية، وذلك عائد إلى حالة الاندهاش وبسبب حالة الأمل المطلق بالمستقبل وهذا بحد ذاته بالنسبة إلي، وبما يتعلق بالعراقيين، يبدو لي حالة إيجابية، وانطلاقا من هذا فأنا ما زلت حتى اليوم على الرغم من أن الحالة العراقية تراجعت كثيرا في الفترة الأخيرة أجد أن المسار التاريخي بكل عناصره النفسية والتاريخية والاجتماعية الخ، قد بدأ، من هنا أنا متفائل بالحالة العراقية وأعتقد، من حقيقة واحدة، أن التاريخ حين يبدأ صيرورة وحين يبدأ مسارا فإنه كالريح لا يمكن القبض عليها.
* تحدثت عن الحالة العاطفية، ألا يمكن أن نتحدث أيضا، عن حالة حنينية ما، إلى أي مدى يلعب الحنين دوره في تكوين الشخص كما في الكتابة، في صوغ كل منظوماته الفكرية والعاطفية؟
الحقيقة عشت أكثر من 29 عاما في قلب الحنين، والحنين هو هذا العالم الذي عشت فيه لحظة خروجي من العراق العام 1976 حتى لحظة عودتي في العام 2003. الحنين منظومة كاملة، وأردفه بالأمل، الحنين هو نوع من الأمل، أمل بتحقق عودة الماضي، هو حالة غير واقعية لكنها عاطفيا تعيد تنسيق الزمن بطريقة شخصية، فردية، كما لو كان زمناً حقيقياً. على صعيد الأدب، الحنين هو النتاج أو المحل الطبيعي للذاكرة، وبالتالي خلال كل تلك السنوات استطعت أن أعيش حياتي اليومية وحياتي الأدبية عبر هذا الحنين، أي محاولة إعادة تصوير هذا الواقع الذي عشته وحالة الانفصام بين الواقعي والعاطفي التي كنت أعيش فيها ما يقارب الثلاثة عقود، لذلك إذا قرأت أعمالي القصصية أو حتى المقالات تجد أن هناك عنصراً أساسياً فيها هو عنصر الذاكرة ومحاولة استعادة الذاكرة، وأستطيع أن أضيف عنصراً آخر هو عنصر الازدواجية: ازدواجية الشخصية، أي الثنائية.
بين الأرض والسماء
* ولكن هذه الذاكرة جعلتك تعيش بين ضفتين. إذا عدنا إلى كتاباتك، نجد أنك لم تحسم إلى أي ضفة تنحاز، لم تجد الحل الأخير. هناك ذاكرة تشدك إلى المكان الأول، وهناك واقع راهن يشدك إلى المكان الحالي. من هنا، انك تقيم بين ضفتين، هل يستطيع الكائن والكاتب أن يبقى طيلة حياته بين هاتين الضفتين؟
الحقيقة هناك بشر أسوياء يولدون في بلدان ويعيشون فيها ويموتون فيها، وهناك بشر من نوع آخر، هم عشيرة المنفيين الذين يعيشون بين حالتين، بين ضفتين كما قلت، أولئك يفقدون سويتهم لحظة خروجهم من البلاد، يعيشون واقعا <<افتراضيا>> ويبقون في هذه الافتراضية، هم أشبه وإذا استعرنا استعارة مسيحية من تعرضوا إلى خطيئة أصلية، وبالتالي فهم سيحملون هذه الخطيئة حتى نهاية حياتهم، ومثلما لا يمكن عودة التاريخ، لا يمكن أيضا عودة المعرفة إلى حالة الجهل، فالمنفى هو أشبه بحالة اكتشاف الثمرة المحرمة وبالتالي لحظة الاكتشاف هي لحظة معرفة ومن الصعب التراجع عن المعرفة. أعتقد أن أولئك المدانين أو بتعبير شكسبير الذين يعيشون بين السماء والأرض، يبقون طوال حياتهم هكذا بين سماء وأرض، بين ضفتين. وفي الوقت عينيه، فإنهم يعانون معاناة من نوع خاص لا يمكن فهمها عبر التنظير، ربما يمكن فهمها عبر الرواية عبر الأدب، أكثر مما نستطيع فهمها عبر شرح الحالة، لماذا؟ لأننا نتعرض إلى حالات يومية، حالة معايشة يومية، وفي هذه المعايشة يجدون أو يعيشون انشطار وجودهم، وهذا الانشطار الوجودي هو في الوقت عينه أمر لا يطاق لكنه بشكل أو بآخر ثمن المعرفة، وأعتقد أن البشرية في العقود الأخيرة بدأت تشهد بازدياد قبيلة هؤلاء المنفيين، هؤلاء المدانين إلى الأبد، ولسوء الحظ ان ظاهرة المنفى تصبح يوما بعد يوم ظاهرة عالمية.
* تشير في كلامك إلى أن في المنفى أفقا معرفيا، إلى أي حد كان فعلا أفقا معرفيا في تجربتك الحياتية والكتابية؟
هو أفق معرفي يومي وليس أفقاً معرفياً بالمعنى السائد. هو أشبه بمعرفة النار، أي انه في الحالة اليومية هناك شعور وإحساس بالواقع يختلف كليا عن شعور المواطن غير المنفي. هو أشبه بالمعرفة التي يكتسبها الشخص الذي يتناول المخدر ليصل إلى حالة وجدانية، حالة معرفية محسوسة، ولكن أحيانا من الصعب التعبير عنها خارج نطاق هذا الكائن. بهذا المعنى فإن المنفى أشبه أيضا بجحيم دانتي، في هذه الجمالية حيث بياتريس تتجول في المنفى وترى هذا المشهد الجحيمي لكنها بياتريس الجميلة، إنه اللعب بين الجمال المطلق والعذاب المطلق.
* ولكن برغم هذه المعرفة اليومية جاءت بعض كتاباتك لتحاول أن تسأل المكان الأول، ألا تجد ولن أقول إنه نوع من التناقض بل نوع من الانزياح والابتعاد عن هذا الأفق الجديد؟ تحاول الكتابة دائما أن تعيد أو أن تصوغ من جديد تركيب المكان الأول والذاكرة؟
هناك أكثر من مكان أول، في حالة المنفي هناك مكانان اولان، مكان واقعي ومحدد هو مكان الولادة، وهذا لا يمكن الحياد عنه، ومكان آخر هو مكان لحظة الوصول إلى المنفى وهو مكان واحد في أكثر من مكان، هو لحظة الصدمة مكان اللحظات المتصادمة، هنا العذاب الحقيقي. كتبت كثيرا عن المكان الأول وما زلت أكتب، ولا أعتقد أن أي كاتب منفي يستطيع الابتعاد واقعيا عن مسقط الرأس. لكن هذا المكان الأول يتغير، يأخذ صورة غير واقعية، ذاكرة انتقائية تعيد صوغ الأشياء، تترك ما لا نحب وتحتفظ بما نحب وبين الأمرين تعيد أيضا صياغات الأشياء بطريقة تخلق نماذج ثالثية، وسيطة. هذا المكان الوسيط هو الذي يصبح المكان الحقيقي.
* يجرني كلامك إلى فكرتين، أولا ألا تزال تعتبر نفسك شخصا منفيا، وثانيا هل أن الكتابة هي التاريخ أم الجغرافيا؟ مثلما يتساءل كارلوس فوينتس في أحد أبحاثه حيث يميل إلى اعتبارها جغرافيا. أنت إلى أي فكرة تميل؟ هل السرد، ولنستعمل الكلمة العربية، عندك تاريخي أم جغرافي؟
انتهى منفاي لحظة عدت إلى العراق في شهر مايو من العام 2003، لحظة دخولي إلى بغداد بالتحديد. لحظة عبوري الفرات اكتشفت أن منفاي قد انتهى وبكيت حينها بكاء مرا، لأن منفاي قد انتهى وودعته. لكني بعد ان تركت العراق بعد شهر من زيارتي، اكتشفت أن منفاي قد أخذ صورة أخرى، أصبح أكثر تعقيدا، أصبحت أمام خيار، عشت 27 عاما في منفى إجباري كان هو المنفى الحقيقي، بعد عودتي إلى فرنسا اكتشفت أنني بين حالتين، بين خيارين، وفي هذا الاختيار أصبح منفاي معقدا، أنا أخشى الآن أن أفقد مكان منفاي كما فقدت مكاني الأول. نضالي اليومي الآن هو أن أخلق حالة متوازنة بين المكان الأول كذاكرة والمكان الذي أعيش فيه كذاكرة وكواقع، لأن لي ذاكرة في هذا المكان. العملية معقدة ولا يمكن شرحها إلا عبر السرد. هنا نصل إلى الجزء الثاني من السؤال، الأدب هو جغرافيا لكنها جغرافيا تتشكل من التاريخ، لأن الجغرافيا هي بنت التأريخ، لنأخذ مثلا حالة أوروبا إنها ليست الحدود التي تفصلها عن العالم العربي والإسلامي أو عن العالم السلافي وما إلى هنالك، بل هي هذه الحدود التي تمتد إلى أفريقيا وآسيا وأفغانستان عبر التاريخ، عبر رحلة المقدوني وعبر الحروب الصليبية وعبر الكولونيالية وعبر الحروب التي أعقبت ذلك، عبر رحلات المستكشفين والسياح والعلماء وعبر الفكر الخ. فالجغرافيا بهذا المعنى لها بعد تاريخي، أي ان بعدها الأصلي هو التاريخ، في حالة المنفي أيضا كما في حالة الأدب، فإن جغرافية الأدب هي تاريخية الأدب بالمستويين، بالمستوى العام للأدب كعلم مثلما يقول بارت أو كحالة فردية، لأنه كذلك قبل أي شيء. في الواقع إن الأدب هو تجوال، من هنا يكون جغرافيا، لكنه عبر التجول في الأدب نكتشف الطبقات المتعددة كما في بابل حيث يعتقد الناس أن هناك بابل واحدة، في حين هناك أكثر من بابل، هناك طبقات لها. في الأدب أيضا هناك طبقات متعددة تحددها في ما بعد مستويات القراءة.
طبقات الكتابة
* كيف تشكلت هذه الطبقات في أدبك، أين وصلت بها، بمعنى آخر، كم ساهمت رحلتك في تشكيلها؟ أين وصلت بالكتابة؟
لم أصل بعد، أنا أحاول أن أصوغ أسئلة يشاركني بها بعض القراء، ليس أكثر من هذا. هذه الطبقات تخرج مني وأنا أحاول أن أطرحها على الآخرين كأسئلة. الأدب لا يعطينا إجابات، هو حالة سردية، أي أن نقص، أن نقول، لكي نضاعف الأسئلة، وكلما تضاعفت الأسئلة، نصل بذلك إلى تنقيتها لكي نصل في ما بعد إلى السؤال الجوهري، وهو السؤال ذاته الذي يطرحه الجميع منذ بدء الأدب كفعل اجتماعي: لماذا نحن هنا؟
* حزت مؤخرا جائزة من إيطاليا، ما هي هذه الجائزة، ماذا ستقدم لك؟
الجوائز لا تقدم شيئا، إنها اعتراف القراء إذا صح التعبير، نوع من تحية القراء لما كتبته وهذا بحد ذاته أمر مسر. هناك لعبة الجوائز أيضا كما تعلم، والتي تمنح لأسباب مختلفة، جائزة (كاتب عبر الحدود) (التي حزتها مؤخرا) هي جائزة سنوية تمنح للمرة السابعة في مدينة (تريستا) الإيطالية وهي مدينة ذات تقاليد أدبية عريقة، وقد عاش فيها العديد من الكتّاب... وهي تمنح لكاتب تقديراً لمجمل عمله الأدبي. حازها قبلي أمين معلوف وأمبرتو إيكو ومونتالبان وخوان غويتيسولو وغيرهم، منحت تقديراً لعملي الأدبي ودوره في إضاءة دور المنفى، الذي يشكل اليوم ظاهرة عالمية. فمن أسباب منحي الجائزة هو دوري في إضاءة نقاط معتمة في حالة المنفى اليوم. ما الذي تضيفه الجائزة لي، لن تضيف شيئا، ربما جعلتني أكسب أصدقاء جدداً أو قراء لا أكثر. تساهم أيضا في ترجمة كتبي إلى لغات أخرى، لكنني مسرور بالتأكيد.
* ألا تجد أنه من المستغرب اليوم، في حالة الأدب العربي، أن يتم الاعتراف بالكاتب قبل أن يتم الاعتراف به في بلاده، أو بالأحرى قبل قراءته؟ كيف تفسر هذه الظاهرة؟
للآسف هي حالة أصبحت عربية وأعتقد أنها امتداد للكولونيالية، ما يدل على أننا لم نتحرر بعد عبر ثورات حركات التحرر الوطني. الأمر ليس حكراً علي فقط، لو أخذنا مثلا حالة الياس خوري مع روايته (باب الشمس)، لقد حققت مبيعات كبيرة باللغة الفرنسية أكثر مما حققت كتبه كلها من مبيعات في العالم العربي. كذلك الحال مع صنع الله إبراهيم الذي يعتبر كاتباً ذا سمعة طيبة في فرنسا. حالة تعبر للأسف عن حالة الخمول الثقافي المطلق في العالم العربي وانعزالية الثقافة عن المجتمع وانعزالية المثقفين عن بعضهم وعن عدم قدرتهم لحد اليوم على ترسيخ تقاليد ثقافية. نحن الآن في معرض الكتاب في باريس وأنت شاهد على ما تراه، لا نستطيع مقارنته بأي معرض للكتاب في أي بقعة من بقاع العالم العربي. تشعر هنا بأنه مكان للقراء الحقيقيين وليس مكانا للنزهة. انه مكان لاكتساب المعرفة. ولنكن واقعيين، ربما هذا سبب تفوق الغرب علينا.
* هل تعتبر أن الكتابة فقدت معناها في عالمنا العربي اليومي، لماذا نكتب؟
لم تفقد جدواها، القضية لا تتعلق بالكتابة بل بالقراءة، الكتاب غير موجود. سيستمر الكتّاب بالكتابة ونلاحظ أن عددهم في ازدياد في العالم العربي، لكن المشكلة في أن الأدب كعملية اجتماعية لا يمكن أن يكون له جدوى دون قراءة.
(باريس)
السفير
12 ابريل 2005-04-12