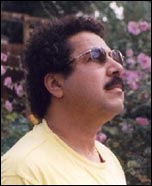 سننطلق في هذا المقال من فرضية أساسية نعتقد انها صحيحة إلى أبعد حد ممكن فيما يتعلق بالإبداع الفني. ومن فرضية نعترض في ضوئها على الرأي الشائع بأن هذا الإبداع في مجال الشعر موقوف على اللغة، إذ هو خرق لنظامها المتواتر، وتجديد لبنياتها، ثم تشكيل متراكب لمستوياتها المختلفة.
سننطلق في هذا المقال من فرضية أساسية نعتقد انها صحيحة إلى أبعد حد ممكن فيما يتعلق بالإبداع الفني. ومن فرضية نعترض في ضوئها على الرأي الشائع بأن هذا الإبداع في مجال الشعر موقوف على اللغة، إذ هو خرق لنظامها المتواتر، وتجديد لبنياتها، ثم تشكيل متراكب لمستوياتها المختلفة.
إن الإبداع تفاعل بالعالم، يتم في إطار مجالات تخيلية لا يمكن أن تكون جاهزة أو موجودة بشكل قبلي، وإنما هي شيء ناشئ بعد هذا التفاعل، وقادر على أن يتبلور بأدوات تعبيرية مختلفة ومتعددة.
ولذلك فإن المبدع الحق هو القادر على أن يتفاعل خارج ما هو موجود ومتواتر ويومي، في مستوى التصورات البشرية والياتها المعهودة. إنه شخص يقيم بينه وبين مظاهر الكون علاقات جديدة لا يمكن أن نلمسها لدى غيره من المبدعين، ولذلك فإنه حين يريد التعبير عن هذه العلاقات يجد نفسه بإزاء أدوات تعبيرية عليه أن يغيرها باستمرار، أن يتصادم مع بنياتها الجاهزة، ويسعى إلى أن يجد لنفسه طريقا خاصا عبر هذا التصادم وذلك التغيير.
إن الإبداع من وجهة النظر هاته قائم على التفاعل والتصور أولا، ثم على التعبير ثانيا. فينتج عن ذلك أن التقليد تقليد للتصورات التي لا نعدم أن نجد لها ألفاظا وتراكيب مختلفة في مستوى السطح، ولكنها جامدة أو ميتة في مستوى العمق، إذ تفتقر إلى التفاعل الذي يصح أن نسميه في هذا المقام تجربة أو معاناة فنية.
لقد نشأ عن هذا التقليد في مستوى التصور، ما يمكن أن نسميه بلاغة لفظية، يعتقد أصحابها أن اللغة موجودة بالشكل الذي هي عليه، وأن الشاعر لا يعدو أن يكون قد أدرك داخل هذه اللغة بعض علاقات التشابه والتضاد، ثم صب ذلك في قوالب قد تميزه عن غيره من الشعراء، ولكنه بالرغم من ذلك ليس هو ما هو، وإنما هو ما هو غيره. أي أنه ينقل هذا اللفظ من معنى إلى معنى، أو يستعير هذه العبارة لغير ما وقع لها في أصل اللغة.. الخ إن هذه البلاغة جهاز يخنق الإبداع الفني، ويوقف فعاليته، ويمارس ضده رقابة لغوية تشجب التخيل الشعري وترتد به إلى القوالب المعجمية الجاهزة.
إننا نزعم في إطار الفرضية السابقة أن الإبداع موجود قبل التركيب اللغوي، بل قبل أن تنتظم معطياته داخل مجالات تصورية محددة. إنه يوجد في إطار العلاقة التخيلية التي يقيمها المبدع بالعالم من حوله. ولذلك فإن مفهوم القارئ الذي نسعى إلى تأسيسه وإلى التعبير عنه في هذا المقال ليس قارئا تقليديا منفصلا عن المبدع، ومتوخيا أن يعكس جهازا مفاهيميا غريبا عن علاقة هذا المبدع بالعالم ؟ وإنما هو قارئ يحاول باستمرار أن يقيم مع العالم العلاقة التخيلية والتفاعلية نفسها التي تمثلها المبدع وعبر عنها ثم حاول نقلها إلى غيره. وذلك ما يمكن توضيحه من خلال الترسيمة التالية
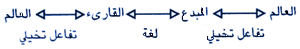
إن هذه الترسيمة تقفنا بشكل واضح على أن اللغة تقع في موقع وسط بين المبدع والقارئ؛ ولذلك فإنها مجرد وسيلة لإدراك العالم المتخيل لدى الشاعر، دون أن تكون جهازا تاما لمحاولة استيعاب مجمل ما يكتشفه هذا الشاعر من تصورات غير موجودة قبل اكتشافه المبدع.
إن العالم بالنسبة للمبدع هو الأصل، والتفاعل التخيلي قدرة خارقة على اكتشاف معرفة جديدة وأصيلة داخله. ثم يأتي التعبير اللغوي وغير اللغوي ليجانس بين المعرفة المتخيلة والوسيلة القادرة على أن تعبر عنها. ولذلك فإنه يصح أن نعتبر المعرفة التخيلية التي يكتشفها المبدع عن طريق تفاعله بالعالم مجالا لإدراك معان تصورية هي أصل الإبداع بالنسبة اليه. وتكون اللغة بعد أن تتغير معالم بنيتها، ومعطياتها الجاهزة، غلافا لهذه المعاني، ووسيلة لنقلها إلى القارئ.
وهنا لابد من أن نقف عند عبد القاهر لنشرح أمورا لابد من شرحها، إذ ينسجم تصورنا لمجال التخيل وللغة هذا المجال مع المفهوم العام الذي أسسه للمعاني الأول والمعاني الثواني.
يقول :
" الكلام على ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده... وضرب أخر أنت لا تصل منه إلى الفرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلل اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الفرض...
وإذ قد عرفت هذه الجملة، فها هنا عبارة مختصرة، وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى. تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل اليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت لك" (1).
إن هذا الضرب الثاني من الكلام هو لغة الإبداع الفني بامتياز، ولكن المسألة لا تقف عند هذا الحد من تقسيم الكلام إلى ضربين، بل تتعدى ذلك الى اعتبار المعاني الثواني أصلا لهذا الإبداع ومنطلقا اليه. ومن هنا يصح اعتبارها أولية بالنسبة للشاعر او الفنان، إذ هي مجال تخيله ومدار تصوراته وبالتالي فإن معرفته الإبداعية وتفاعله بالعالم مرتبطان ارتباطا حيويا ومنتجا بهذه المعاني الأولية. ولذلك فإنها (مجاز واستعارة وكناية وتمثيل) بالنسبة للقارئ أو المتلقي. أما بالنسبة للمبدع، فإنها بمثابة معرفة مكثفة عن طريق التخيل، لا يمكن التعبير عنها إلا بما عبر عنها به. أي انها ليست خرقا أو تغييرا لنظام اللغة إلا من زاوية نظر معجمية أو نحوية مرتبطة بالملتقى وبالعادات اللغوية التي تشبع بها. في حين انها بالنسبة للمبدع نظام قائم بذاته يختلف عن اللغة اليومية بشكل جذري، ويمتح مكوناته من مجال التخيل لديه. ومن هنا يكتسي هذا النظام صبغة الغموض، والتصادم بالقواعد المتواترة، ثم تصبح معطياته مفاجئة تثير لدى القارئ ردود فعل متنوعة ومختلفة الى حد التنافر أحيانا.
إن بلاغة المفاجأة قائمة في رأينا على الدهشة الجمالية التي نحسها ونحن نكتشف مع المبدع معانيه الأولية التي هي معان ثانية بالنسبة لأفق انتظارنا الجاهز والمرتبط كما قلنا قبل قليل - بعاداتنا اللغوية. أي أن المفاجأة التي سنعتبرها هنا مصدرا للمتعة الجمالية، تكمن في إدراك مجال التصور لدى المبدع واكتشافه انطلاقا من المعطيات اللغوية التي تعكسه في نوع من التماثل الحيوي والمتميز عند كل مبدع أصيل ومتفرد. يقول سيف الرحبي:
ذكرى الحاضر (2)
وحيدا، وخلف الجبال البعيدة في الذكرى
... سادرا أرقب المغيب
هذا الدم المنساب على أجنحة طائر
ثعبانا يفترس النهار بعينيه الدامعتين بالسواد
وخلفه الأكمة يلعب النمر مع صغاره، مضيئا
طلائع هذا الليل القادم
بمخالب أكثر حنانا من جسد امرأة
وحيدا من غير أمل
ومن غير رغبة
هكذا... هكذا
حتى اختفي مع سكان مدينة
غرقت في البحر
أو اختفي في كأس.
وأول ما يفاجئنا في هذا النص عنوانه المتميز الذي لا يمكن أن يتقبله جهاز اللغة اليومية لدينا، إذ يصطدم هذا الجهاز بعلاقة التناقض بين :
ذكرى =/= الحاضر
على أساس أن الذكرى زمن يرتبط من الناحية الدلالية بالماضي الذي نستحضره، والحاضر زمن لم ينته بعد.
إن هذه الدهشة الأولية أمر قد نستطيع تبريره في إطار البلاغة العربية القديمة، وذلك على اعتبار أن كلمة (الحاضر) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون، إذ كل حاضر لابد له من أن يصبح ماضيا. ولكن هذا التبرير غير كاف بالنسبة إلينا، لأنه يفسر لنا آلية المجاز المرسل، دون أن يبررها هي نفسها، اعتمادا على أنها معنى متفرع عن تصور أولي وأصلي لدى الشاعر، لم يخرق به اللغة المتواترة، بقدر ما عبر في أصالة تامة عن معرفة متخيلة واكتشاف إبداعي لا سبيل إلى نقله أو ترجمته إلا عبر علاقة التناقض المشار إليها أعلاه. إن زمن الشعر زمن عمودي، يوقف اللحظة الحاضرة، ويتجه بها نحو العمق،(3) وذلك بهدف تدمير الزمن السطري، وتحويله إلى زمن ذاكري وذلك ما يفاجئنا لدى سيف الرحبي -إذ أدرك في مستوى إحساسه الجمالي أن الزمن بمعناه الفيزيائي المتداول زمن عابر تمحي في إطاره اللحظة الحاضرة لتحل محلها لحظة لاحقة، في حين أن زمن الفن زمن مطلق، تمثل اللحظة منه ديمومة متوقفة لاحدوا لها. ولذلك فإن:
ذكرى: + زمن + ماض
الحاضر: + زمن + حاضر
تصور أولى نابع من زمن الشعر، وتركيب لغوي يفاجئنا بعلاقة التناقض التي تجمع بين عنصريه الدلاليين، ثم نندهش بإزاء هذه العلاقة ونسعى إلى تبريرها بأشكال مختلفة، والأصل فيها أنها عبارة نابعة من صميم التصور الفني للزمن. والمفاجأة الثانية أن الزمن يتوحد بالمكان حتى لا تناقض بينهما.
يقول:
... وخلف الجبال البعيدة في الذكرى
وهي عبارة قد نحملها على الاستعارة فنقول انه استعمل الجبال بمعنى الذكريات المتراكمة كأنها قطع الجبال الراسخة... فنفاجأ مفاجأة معجمية لا نعدم أمثلة لها عند كثير من الشعراء. ولكن الأمر عند سيف الرحبي لا يقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى قلب نظام دلالي راسخ ومتمكن بالنسبة للغة الإدراك والتواصل اليومي ونعني بذلك نظام :
مكان Vs زمن
الذي يصبح لديه:
مكان ~ زمن
أي أن علاقة التناقض في لغة الإدراك تصبح علاقة شبه تساو أو انسجام في لغة التصور. ولذلك فإنه لا حدود للمكان كما أنه لا حدود للزمن، ثم لا حدود تفصل بين الزمن والمكان فيما يفاجئنا به شاعر (الربع الخالي).
ولذلك فان الشعور بالوحدة بإزاء هذا المطلق، شعور حاد وقوي، يواجهه الجسد الذي لا حدود لحركته هو أيضا، إذ تتداخل الحواس لدى الذات الشاعرة، وتختلط الى الدرجة التي تصبح معها علامات الجسد ووظائفه ذات توجه مركزي يتحدد في التفاعل بهذا المطلق واستيعابه ضمن مظاهر أخرى من مظاهره الأساسية التي لابد من أن تتكامل مع مقولة :زمن Vs مكان.
لقد انعكس الشعور بالوحدة الحادة بشكل واضح في قوله :
(وحيدا...)، ثم تأكد هذا الشعور بشكل غير مباشر عن طريق إيراد هذه الكلمة في بداية القصيدة، أي بعد العنوان : (الزمن المطلق ~ذكرى الحاضر)، وبجوار الجملة الدالة على (المكان المطلق ~ خلف الجبال البعيدة في الذكرى لم. وهو ما قد يبرر التفاعل الذي أشرنا اليه قبل قليل، والذي يتلخص في محاولة استيعاب الذات لزمن لا نهاية أو بداية له، ولمكان غير خاضع لمفهوم الحدود الجزئية أي:
فلابد ان تكون هذه الذات قد حطمت حدود حركة الجسد للتفاعل مع عالم لا حدود له هو أيضا. فنفاجأ بذلك
في قوله : سادرا أرقب المغيب !
فالذي نعرفه أن الذي يرقب لابد له من أن يكون متيقظا قد استنفر حواسه ليلاحظ أو يدرك هذا الذي يرقب. أما أن نكون سادرين ونحن نرقب فعبارة لا يمكن أن تفسر في مستوى لغة الإدراك إلا في إطار علاقة التناقض التي ستتشاكل مع تناقض عناصر الجملتين السابقتين في هذا المستوى؟ ثم تنسجم انسجاما تاما مع تفسيرنا لهذا التناقص على أساس أنه انصهار للمكونات الدلالية المتناقضة ضمن تصور شعري وجمالي يجعل حركات الجسد حركة مطلقة ومتفاعلة مع عالم مطلق.
أي أنه كان بإمكانه أن يقول :
سادرا أرقب..
حالما أرقب...
نائما أرقب...
ولكنه ليس بإمكانه أن يقول :
يقظا أرقب...
إنها حال الشعر، أي حال الجسد الذي لا حدود له في تفاعل مع عالم لا حدود له.
وستجيب (البلاغة) التعليمية بأن (سادرا) لا تعدو أن تكون استعارة تمثيلية هي للربيئة والعين الذي هو في حال بين اليقظة والنوم، والذي لابد له من أن يغالب نومه... الخ فلا مفاجأة إذن. إلا أن كلمة (المغيب) تفيد بأن التصور أصلي بالنسبة للشاعر، إذ نقف من خلالها على أن الذات منسجمة انسجاما تاما مع ما تتفاعل به، ثم هي معبرة عن هذا التفاعل بما يتشاكل معه في المستوى الدلالي تشاكلا تاما وحيويا إلى أبعد حد ممكن، فلا نقل إذن ولا استعارة، وإنما هي معان أولية معبر عنها بلغة أولية هي لغة الشعر المفاجئة للغة الإدراك :
سادرا ارقب ~ بين النوم و اليقظة ~ الذات
المغيب ~ بين الليل والنهار ~ العالم
ويزداد هذا العالم الذي لا حدود له اتساعا وشمولية حين ينضاف إلى عنصر الحركة عنصر اللون ليشكلا مقولة دلالية توازي مقولة : زمان VS مكان، فتتشاكل معها داخل مجال التصور، وتنصهر بمجمل جزئياتها في إطار تفاعل الذات مع العالم، وفي إطار اللغة المعبرة عن هذا التفا لحى. إن كلمة (المغيب) تفيد وقت الغروب ومكانه في آن واحد. أي أنها داخلة في إطار مقولة : زمان VS مكان الدالة - كما قلنا فيما يخص (الجبال والذكرى) - على تناقض دلالي في مستوى الإدراك، وعلى تداخل يحطم حدود هذا التناقض في مستوى تخيل الشاعر ليتم تفاعل ذات لا حدود لها مع عالم لا حدود له.
وذلك ما يتأكد بشكل أكثر حدة وتوترا حين نتعرف على أن (المغيب) لا يعني فقط زمن غروب الشمس أو مكانها الذي هو الأفق المترامي أمام الشاعر السادر والمتيقظ، وإنما يتعدى ذلك ليشمل حركة الشمس ولون الأفق أيضا:
سادرا أرقب المغيب
هذا الدم المنسرب على أجنحة طائر
فنستخلص شيئين اثنين :
أولهما أن (المغيب) ينساب ويتسلل - أي انه ليس زمنا ومكانا بقدر ما هو حركة.
والثاني أنه بمثابة دم يسيل ويمر فوق أجنحة طائر، أي أنه محمر حمرة شديدة يخالطها بعض السواد.
ومن هنا تنبثق المقولة الثانية التي أشرنا قبل قليل إلى تشاكلها التام مع مقولة الزمن والمكان، ونقصد بذلك مقولة :
حركة VS لون
ولعل التفسير المعهود سيدعي أن الشاعر لم يزد على أن شبه الشمس الغاربة بالدم المنساب، وأن الجامع بينهما إنما هو الحمرة. ولكننا من منظور بلاغة المفاجأة نصر على أن (المغيب) و(الدم المنساب) عبارتان مختلفتان لمظهر واحد من مظاهر الكون، هو الغروب الذي يتفاعل معه الشاعر في اطار تدمير الحدود الإدراكية بين الحركة واللون. وذك بدليل استعماله لاسم الإشارة (هذا). أي أن الأمر ليس تشبيها بقدر ما هو استعمال عبارتين أصليتين ونابهتين من مجال تصوري واحد هو حركة الغروب ولونه. وهو ما نقف من خلاله على أنه لا حدود بين: وقت الغروب ومكانه وحركته ولونه، ثم لا حدود بين الغروب ( +حمرة +حركة: انسياب الشمس في الأفق) وبين الدم المائع (+ حمرة + حركة انسياب الدم على أجنحة طائر). أي أنه بإمكاننا أن نقول:
- سادرا ارقب المغيب المنساب على أجنحة طائر.
- سادرا ارقب الدم المنساب على أجنحة طائر.
ولكننا سنكون في هذين التعبيرين بصدد تدمير الحدود بين عنصري مقولة واحدة هي مقولة : حركة VS لون.
في حين أن الشاعر يسعى في مستوى التخيل الجمالي إلى تغييب الحواجز بين مقولات إدراكية قد تكون متباعدة في مستوى لفة العقل إلى أبعد حد ممكن. ونعني بذلك الحدود الإدراكية بين : الزمن VS المكان، الحركة VS اللون والتي تصبح لديه حدودا متداخلة تنم بشكل واضح عن تفاعل ذات مطلقة مع عالم مطلق.
فكما أن الزمن لا حدود له : ذكرى الحاضر (زمن زمن) والمكان والزمن متداخلان : الجبال.. الذكرى (مكان ~ زمن) وحركة الجسد حركة مطلقة : سادرا أرقب ~ (حركة ~ حركة) كذلك لا حدود بين الحركة واللون : المغيب، دم منساب (حركة ~ لون، لون ~ حركة ).
بل لا حدود بين اللون واللون كما سنتعرف على ذلك بعد قليل، وبعد أن نؤكد على أن المقولتين متداخلتان في إطار المطلق التخيلي عند سيف الرحبي. أي أن النظام الدلالي :
زمن VS مكان VS حركة VS حركة VS لون
يصبح في مستوى التخيل :
زمن ~ مكان ~ حركة ~ لون
ليعكس بشكل حيوي وأصيل تفاعل هذا الشاعر مع مظاهر الكون انطلاقا من تخيل مطلق لا حدود ضمنه بين الذات والعالم من حولها. وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالرسمة التالية :
عالم ~ ذات
إن تداخل المقولتين السابقتين وحده الذي يفسر تداخل عناصر اللوحة الرائعة التي يرسمها الشاعر للمغيب:
هذا الدم المنساب على أجنحة طائر
ثعبانا يفترس النهار بعينيه الدامعتين بالسواد، أي أن المغيب دم ينساب فوق أجنحة طائر. وهو ما يقتضى كون الفضاء البعيد بمثابة ذبيحة يتقاطر منها دم محمر، ويبتعد بها طائر خرافي سيسقط بها جهة الظلمة. ولكن هذه الذبيحة نفسها بمثابة ثعبان يفترس النهار ويغتاله بما يتقاطر من عينيه من دمع أسود أو ظلمة !.
وذلك ما يقتضي أن نقول: إن هذه اللوحة المتخيلة عن طريق الإبداع الفني الجميل، تدل بشكل واضح على تداخل المقولتين السابقتين، وعلى أنه لا حدود في الوقت نفسه بين مكونات كل مقولة على حدة.
وتفصيل ذلك أن الفضاء ذبيحة وثعبان في آن واحد، أي أن بعضه يغتال بعضا، أو أنه يغتال نفسه.
كما أن النهار يغتال النهار، إذ المغيب دم منساب على أجنحة طائر، وثعبان يفترس بعينين دامعتين بالسواد.
أي أن زمن الغروب يغتال زمنه.
وكذلك اللون يتداخل مع اللون ويغتاله، أي أن الدم المنساب من الغروب ( + حمرة + مشوبة ببعض السواد) هو نفسه الثعبان الذي تدمع عيناه بالسواد (+ ظلمة الليل الطالع + سقوط الشمس الغاربة).
بل يصح أن نقول إن الحركة تغتال الحركة ضمن هذه اللوحة الجميلة والمرعبة، إذ الدم المنساب على أجنحة الطائر هو نفسه الثعبان الذي يفترس النهار. فلا ندري ضمن هذا التداخل، هل الطائر هو الذي يغتال الثعبان، أم أن الثعبان هو الذي يذبح الطائر.
إننا بإزاء مشهد لا حدود له، يعبر به الشاعر عن عالم لا حدود له، بلغة لا حدود لها. وتكمن المفاجأة المدهشة، في هذه اللغة التي لا نعرف حقيقتها من مجازها، والتي نستطيع ان نسميها بلاغة المطلق عند سيف الرحبي.
يقول :
وخلف الأكمة يلعب النمر مع صغاره، مضيقا طلائع هذا الليل القادم بمخالب أكثر حنانا من جسد امرأة.
فنفاجأ بأن الفضاء بعيد الغروب قد تحول إلى أكمة، وبأن القمر نمر يلاعب أشباله التي هي النجوم المهيأة للطلوع، فيشع من هذا اللعب نور مصدره مخالب النمر التي تداعب الأشبال في حنان غريزي يفوق حنان جسد المرأة ! إن هذه اللوحة الجديدة تتداخل مع اللوحة السابقة إلى الحد الذي لا نستطيع ضمنه أن نفصل بينهما. وذلك لأن فضاءهما وزمنهما متداخلان، بنحو ما أن حركتهما ولونهما مختلطان ومتكاملان.
فالفضاء البعيد الذي اغتال بعضه بعضا قد تحول الى أكمة أو أدغال متداخلة لا نتبين معالمها، إذ أصبحت مجالا تصوريا لا حدود له بعد أن غربت الشمس. كما أن الزمن في ديمومة مستمرة لانستطيع أن نحدها بالدقائق والساعات، وذلك لأن النهار الذي اختيل هو نفسه الذي تحول الى ليل بحكم هذا الاغتيال نفسه. وكذلك لون الظلمة البادية مستمد لا محالة من عيني الثعبان الدامعتين بالسواد، أو من حمرة الدم التي تحولت إلى سواد بعد أن مر عليها بعض الوقت. والشيء نفسه بالنسبة للضوء المنبعث من مخالب النمر، إذ لا يعدو أن يكون بديلا لضوء النهار الذي اغتاله الثعبان بعينيه الدامعتين.
أما تداخل الحركة فمن الممكن تأويلها عن طريق تنظيم مصادرها المتعددة داخل اللوحتين، وذلك وفق الشكل التالي:
- فضاء اللوحتين: السماء البعيدة ~ أكمة
- زمنهما: المغيب ~ طلائع الليل
- لونهما: حمرة ~ سواد
- الحركة:
أ- دم ينساب على أجنحة طائر
ب- ثعبان يفترس بعينيه
ج- نمر يلاعب صغاره بمخالبه
فتكون الشمس الساقطة الى المغيب هي الطائر الذي ينساب الدم على جناحيه، وتكون بدايات تحول الأفق المحمر الى سواد ممتد، ثعبانا يلتهم نور هذه الشمس، ثم يكون النمر مهيأ مع صغاره ليحل محل الشمس، وكأنه قد افترس الطائر المتقاطر دما.
إنه منتهى التداخل وقد عبر عنه الشاعر بلغة من طبيعته، أي بلفة تتداخل إشاراتها، حتى كأنه لا حد يفصل بينها كي يجعل هذا التدليل أو ذاك إلا على هذه الحركة أو تلك. ثم كيف تكون المخالب أكثر حنانا من جسد المرأة، إلا أن تكون الحيوانات متميزة بغرائز قد تفوق عواطف الإنسان، أو يكون الإنسان متميزا بعواطف غريزية تفوق غرائز الحيوان أو تقترن إليها؟ انه لابد من أن نفاجأ بهذا التقابل الذي يتحول إلى تداخل مطلق عند سيف الرحبي، والذي تعكسه إضافة الحنان إلى الجسد بشكل جمالي موفق
ودقيق:

لقد ذكرنا سابقا بأننا في هذه القصيدة بإزاء ذات متفاعلة مع العالم عن طريق تخيل يمحو حدود الذات وحدود العالم في آن واحد. فينتج عن ذلك أن هذه الذات لابد لها من أن تتحرر من جزئيات الحياة اليومية لتستطيع بناء هذا التخيل. وفي تخليها عن الارتباط بالجزئي والعابر
تصبح وحيدة ومغربة داخل العالم المتخيل الذي تبنيه، إلى الحد الذي تتنازل ضمنه عن سائر رغباتها الطبيعية وسيولها العادية، كيما تقيم علاقة التفاعل الذي أشرنا اليه.
إن الذات التي لا حدود لها لابد من أن تكون وحيدة في عالم لم لا حدود له:
وحيدا من غير أمل
ومن غير رغبة
وذلك في مستوى الجزئي واليومي والمعهود. أما في مستوى الإبداع فإن الرغبة الأكيدة هي هذا الإبداع نفسه، هي هذه الذات المطلقة، الباحثة في عالم مطلق، عن لغة لا حدود بين دوالها ومدلولاتها:
هكذا... هكذا...
حتى اختفى مع سكان مدينة
غرقت في البحر
أو اختفي في كأس
فهل من الممكن أن تفرق المدن في البحار؟
إنه الفضاء الذي لا حدود له.
وهل من الممكن أن يختفي الإنسان في كأس ؟
انها الذات التي لا حد يضبط حجمها وحركتها.
إن ما يفاجئنا لدى هذا الشاعر العربي المتميز هو هذا العالم المطلق الذي يدخلنا اليه عن طريق ما سميناه عنده بلاغة المطلق.
ولعل النص الذي قدم به ديوانه : (رجل من الربع الخالي) يشهد هو أيضا على هذا الذي نقول، إذ (عروق الشيبة) مركز غضب سحيق.. ومدى مترام، وصحراء صحراء، ثم تحولات للجن وهذيانات السحرة، وسماء مقفرة بكماء، وعالم تقيم وسطه الحياة قسمتها
الأخيرة (4).. وتتفاعل معه ذات كتبت قصائد هذا الديران `لي لاهاي ومسقط وبينهما باحثة عن لغة لا حدود لها كالربع الخالي.