(قراءتان في ديوان "نهر بين جنازتين" لمحمد بنيـس)
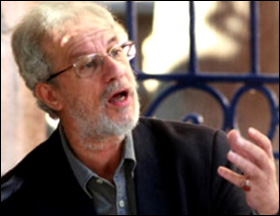 شعر مقطَّر، أكثر مما هو مـكـَّثف، هذا الذي يكتبه تيَّار المعنى مُمثلا في محمد بنيس (فاس، المغرب، 1948)، يتنزَّل على الصفحة مثل قطرة، تاركاً فوقها تلوّناتٍ قزحية وانعكاساتٍ لا تتاح رؤيتها دائماً بسهولة، من ثمة خاصِّيتها الهوائية وطبيعتها السيّالة بتوافق ليس فقط مع شكلها لكن مع محتواها أيضاً، حيث لا يمكن اختزالها في نمط واحد من التعبير، بل هي تجرِّب أنماطاً عديدة تـُشكـِّل نظام الكلام الشعري. والماء، كما الفراغ، رمزان حاضران هنا بقوّة.
شعر مقطَّر، أكثر مما هو مـكـَّثف، هذا الذي يكتبه تيَّار المعنى مُمثلا في محمد بنيس (فاس، المغرب، 1948)، يتنزَّل على الصفحة مثل قطرة، تاركاً فوقها تلوّناتٍ قزحية وانعكاساتٍ لا تتاح رؤيتها دائماً بسهولة، من ثمة خاصِّيتها الهوائية وطبيعتها السيّالة بتوافق ليس فقط مع شكلها لكن مع محتواها أيضاً، حيث لا يمكن اختزالها في نمط واحد من التعبير، بل هي تجرِّب أنماطاً عديدة تـُشكـِّل نظام الكلام الشعري. والماء، كما الفراغ، رمزان حاضران هنا بقوّة.
محمد بنيس الأستاذ، الكاتب والمترجم لمؤلفين من بينهم برنار نويل وملارمي، يمتلك فكرة عن التأليف الشعري بوسعنا نَعْتـُها بالتشكيلية، بـَيْدَ أن كتابته تمضي إلى مَا هُو أبْعَد من التشكيل المحض: إنها كتابة تـَمْزج بين الذاكرة والإحساس، الحنين والشهوانية، الألوان والعطور. لذلك يَتموضع كلامه، أحياناً، خارج نطاق استعمال الأفعال كما في إشارته إلى "ذبْذباتٌ سريعة لا من الكلمات هيَ ولا منَ اللاكلمات"، دليلها القصيدة ولاشيء غير القصيدة، ويشار إليها هنا عبر لغة شعرية واصفة في القصائد المعنونة "أهبط"، التي لا يمكن أن نراها كموضوعة النزول إلى العالم السفلي لدى كل من هوميروس [في "الأوديسا"] وفرجيل [في "الجورجيات"] بل كـ"موقف الكتابة" ـ "ليل عَلى ليل" يُسَمِّى "لكل شَاعِر متاهته". ومتاهة محمد بنيس مصنوعة من أنهار تتسع في المجهول، لكنها تتضمن "اللفظ الشعشعاني". ليس القسم الثاني من الديوان نشيداً مثل الأول بل مرثية: مرثية جنائزية، مبنية مثل تأمّـُل معماريّ بَهيٍّ بـ"أحجار أعمدة مُشرّبةٍ / بأصْفـَى زُرْقةِ الأرواحْ"، و"قبابٌ بين أسوار/ تطوفُ بجَزعها وعقيقها". هل هو مُعْجَمٌ شديد البهاء؟ كَلا: إنه بالأحْرى ابتهال لموتى الشاعر وأشباحه "حيثُ يكتملُ العراء" والهويّة التي يتحمل مسؤوليتها مِثـْل طريق صَالح للإبحار.
نحو الصمت
إن الفكرة الرِّيلكوية عن القصيدة كنشيد ووُجُود في آن واحد يتم اسْتـَدعاؤها في قصيدة "سيِّدون" لكن بكيفية تـَشَاركية أكثر مِمَّا هي فردانية. وتـُشكـِّل قصيدة "حروف" نـَسَقاً مختلفاً، لأنَّها تبتعد عن قصائد نـَثر أخرى له ولأنَّها تـَنْحو منحى تركيبَّياً يُمركزُ قـُوة الخطاب في طول المدى الكامل للجملة التي تكوّن وحدتها. هكذا تبدأ دورة باتجاه الصمت "من جهة البهاء"، مثال ذلك الحركات الإحدى والعشرون لـقصيدة : "لكَ هذا الوَهْب"، إذ أن ما يمتلك الدلالة هو استقلالية المقطع أكثر من تنامي الأبيات. وفي هذا السياق يكتسي المقطع الحادي عشر من هذه السلسلة قيمة شعرية خاصة حيث يقع التوكيد على أن:
"الكتابة أنقاضٌ
كل مرة
في انحلالها
تلمع.."
كذلك في المقطع الثاني عشر حيث: " الظلـَم مترادفة"
وفي الرابع عشر :
" لمْ يجئْ وهباً
ذلكَ
الضوءُ بينَ أزرقينْ".
لقد "انْحَجبَ البعدُ والعمقُ" بالنسبة إلى بنيـس في لغة مستبطنة على نحو رفيع. وهو ما يخلق تلك الوحدة النغمية التي نلمسها في كل تغيرات النبرة الصوتية لديه. وما يلفت الانتباه في القصائد الأخيرة هو القسم الثاني من قصيدة "ربما"، المبنية على أسئلة، وغنائية قصيدة "ظهور" التي توحّد بين الكلام والمنفى، والإتقان الشكلي في قصيدة "قطرة"، إحدى القصائد الأكثر اكتمالا. محمد بنيس – العارف الكبير بالشعر العربي الحديث الذي كرس لدراسته أربعة مجلدات، حلل فيها بنياته وإبدالاتها – نجح في أن يجمع في هذا الديوان بين وحدة عالمه الشعري وتنويعات صوته، صانعاً في تركيب هائل سلسلة سريعة من الإحساسات الحية والمتنوعة، التي تتخذ فيها المعاودة الممكنة للموضوعات صياغة جديدة.
تحوّلات
إنه، إذن، شعر تحوّلات، لا يخفي مرجعياته المتصلة بجغرافيا محددة سبق وتناولها علم أسماء مجاري المياه، وهي تؤكد المسار الناصع لصاحبه، الذي يندمج أكثر فأكثر في الجماعة الشعرية المتوسطية. وقد احترم لويس ميغيل كانيَادا الإخراج الشكلي لمختلف نماذج الخطاب الشعري المستخدمة هنا، وعرف كيف يعثر لها على مفتاح للحجم يتناسب في لغتنا مع الأصل العربي، - وهو ما لم يكن أمراً سهلا -، حتى يجعل التركيب البصري للصفحات مرئياً باعتباره عنصراً غير لساني على غرار كاليغرامات أبولينـير ومؤلفات القدماء ذات التشكيلات البصرية.
*****
أنقاضٌ، في انْحلالهَا، تلمَع (**)
ميغيل كاسَادو
لعل أوَّل ما يأسرنا عندما نقرأ ديوان "نهر بين جنازتين" لمحمد بنيس، في هذه الترجمة الاسبانية، هو أننا لا نعثر في ترجمة لويس ميغيل كانيادا على سيرورة المعنى ولا على صعوبة التركيب الإيقاعي فحسب، بل نقف، إضافة إلى ذلك، على بنية للقصيدة مبتكرة إلى حد بعيد ولا مثيل لهَا. قطع متشذرة، يتداخل الشعر فيها بحرية مع النثر؛ وقصائد مطولة تعمل فجواتها الداخلية، كما تعمل وقفاتها وفضاءات البياض فيها على نمو غريب للنص؛ وقصائد مركبة أحياناً من عمودين بشكل مُتزامن. ويُظهر محمد بنيس في هذه القصائد كيف يَصِير الشعر فكراً، تحليلاً، بحثاً، مكاناً لاتخاذ موقف، دون أن يتخلى في الوقت نفسه عن تجذير اختياره الشعري. إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار بعض أعماله الشعرية السابقة - مثل "هبة الفراغ" ، بترجمة لويس ميغيل كانيادا أيضاً، أو "ورقة البهاء"، الذي قرأته في ترجمة فرنسية لمنير سرحاني وبرنار نويل - فسنكتشف من خلال هذه القطع نفسها سمة شكل خصوصي، فما يَصِلُ بين هذا العمل وذاك هي الخُيوط التي تركب إيقاعاً متبايناً يؤلف نسيجاً يخترق الحياة ويمتزج بها. إنه مشروع ذو رَوْنق عجيب - ولا ينبغي لي أن أتأخر في الإفصاح عنه - بأبعاد رهَانه وبالمكانة البارزة التي يحتلها في الحداثة الشعرية العربية. نحن نتحدث عن شاعر متفرد بأدق معاني الكلمة. لكن القارئ نفسه هو من ينبغي أن يقدر قيمته. وأود الآن أن أشير ببساطة إلى إحدى القراءات الممكنة لهذا العمل الذي نقدّمه.
يُفتتح "نهر بين جنازتين" باستشهاد لهولدرلين: «دلفٌ هاجعةٌ، فأيْنَ يضجّ المَصيرُ العظيم؟» هكذا يظل كل شيء مُحاطاً بسؤال عن معرفة تقترب من الحياة، معرفة مفقودة، أو لم يَعُدْ لها مركز محدّد، وصَوْتها لم يعد مسموعاً أو أنه يُسمَع على نحو مُلتبـس. تستحضر القصيدة الأولى هذه الصعوبة بعنوانها "بعيد"، وهي تنشئ إنصاتاً بقصد البحث عن إجابة: إنصات إلى برودة الخريف، إلى الماء، إلى الريح، إلى ما يمكن أن يعثر فيه ذلك السؤال على صداه. نحوه يتوجه النصّ، وهو يقدِّمُ نفسه كصَمْتٍ في حاجة إلى أن يمتلئ: «وعندَ سطح النهْـر كنتُ تركتُ وجهَ اللوْح يغمُرهُ الرنين».
إن النهر الذي يجسد، بالفعل، في عنوان الديوان، فضاءات الإنصات هو نهرٌ ذو مجرى واقعي، يَمُرّ محمَّلا بالمَاء، مع ضفتين مأهولتين بحيوانات ونباتات وأطفال يلعبون، بيد أنه غَيْرُ محدّد جغرافياً - قد يكون سبو، نهر فاس مسقط رأس الشاعر، وقد يكون النيل أو الفرات أو أيَّ نَهْر آخر. «عجباً - يكتب بنيس- ها إنَّ لي أنهاراً في نَهْر أو نَهْراً في أنهار». النهر دائماً ملموس، لكنه في الآن نفسه رَمْـز. إنه التيَّار وحوادث التدفق، لكنه أيضاً ما يَنْعَكِس فيه؛ أي أنه مكان للتأمل، ذاكرة حية عن الطفولة، مجال تجري فيه قرون من التاريخ، امتداد لباطن ربما تكمن فيه منابعُه السريّة، التي هي "منابع نوم". فالنهر هو ما يجري ويمضي بلا توقف - كما تقول الاستعارة التقلِيدية - ولكنه بقدر ما هو خاصة آثار وترسبات بقدر ما هو غير ثابت ولا يدل على شيء، يتدفق وفق نقلة ما بعد حداثية تسمح بالقبض على الإحساسات وإرهاف التأمل كحركة تظهر كل مرة نسيجَ وحدهَا وكل مرة عابرة.
«كـُلما، أقبلتُ على النَّهر طافتْ بي جغرافية الزمن» تقـُول إحدى القصائد، كما لو أنَّ ذلك المَرْقب - المشهد ينفتح على حضور التاريخ، عَلى بعيد ينتسب هو الآخر إلى الزمن: تسير القوافل من ألف عام على ضفة النهر، يتوحَّد غبار الصحراء في الخطاب مع الماء. يصبح التقليد منصهراً في الطبيعة والأشياء بطريقة غير منفصلة، ويضم إليه الواقع بعد أن يتشكل. ومع ذلك، فمعالم الواقع آلت إلى خراب، جَسَدُه لم يَسْلم من الانتهاك، والأحاسيسُ أضْحت غامضة: «هل هو الذهَبُ الذي لمعتْ / دوائرُ شكلهِ / أمْ وحدَة الأشباح». يبقى السؤال مُعلقاً، رغم أن نبرته الرثائية تظل تفرض نفسها طوال النص، وجوهر التقليد، أعني اللغة، تـُستحضر بهذه النبرة: « ولي لغة / تضاءُ بوجْدهمْ / شذراتُ دَمْع لا تزالُ معَلقاتٍ / في شقوق الرّوح».
على أن اللغة أيضاً، باعتبارها خيطاً موجِّهاً، هي إبْحارٌ، كلماتُ نهـر- «هيأتُ للعيْنـيْن مركبة منَ الكلماتْ / ونفختُ في طرُقي / اتبعي نهْـري / مداك»: أمكنة لمساءلة الهوية، الذاكرة، مساءلة ما هو جماعي مشترك، فاللغة العربية إذن تمتد، كما النهر «فيما وراء التخوم»، وفي هذا المجال بالذات يبلغ صوت بنيس أقاصيهِ الأكثر جفافاً والأكثر صلابة: «إلى حيثُ النشيدُ يَفيضُ في لغةٍ لنا / منْ قبلُ ماتتْ / أوْ تموتُ على لحَافٍ تختفي / بين الزّوايا / مثلَ منبوذٍ تطاردهُ الذئابْ». هكذا يقـرّبنا بنيـس من الجانب الآخر من عنوان الديوان: «أصْغي لبرْدِ الضّاد بينَ جنازتيْـن / ومَنْ هنا / أعطَى لأهلكِ كلَّ هذا الموت».
تحيط الجنازتان بهذه اللغة - النهر، سواء أكانتا جنازتيْ ثقافة الشاعر أو جنازتيْ أهله، أكانتا تشيران (كما ورد من قبل) أوْ لا تشيران إلى العالم العربي في المشرق - الفرات - وإلى المغرب - سبُـو-. فهذه الصلة بين اللغة والموت تختلطُ علينا وتشوّش على إدراكنا. كان فيتجينشتاين يعتقد أن «إبداع لغة ما يعني إبداعَ نمط حياة»، لكن يبدو وكأن محمد بنيس يقول لنا إن لغة شَبَحيَّة يمكن أن تمتد في الوجود من غير أن تكونَ ذات صلة بشكل من أشكال الحَياة، إذ أن فقدان الحياة هذا، الذي يُبـقى اللغة مثبتة كألم، يُحوَّل اللغة إلى فضاء أنقاض يغدو من العسير مَعَها الاستمرارُ في تسمية حَاضر تبخَّر هو نـَفـَسُه في الهواء. دُوَارٌ وجوديٌّ يصيب أزمنةً وأفكاراً. ذلك ما تلحّ عليه القصائد نفسها : «لي لغة تورّثني سماءَ الموْت».
ليست اللغة وحدها هي التي استحالت إلى فضاءٍ للموت، ولكن الموت يتكاثر من حولها بنفس التزامنات السابقة: النهر يتدفق، يغرق، يجلب حياة ومعاناة، طفولة وشيخوخة، توحّداً واجتماعاً، بَيْدَ أنَّ الموت لا يكف عن أن يطال كل ما حوله، وكذلك الميتات الفورية، الشخصية، ميتات الأقارب، هي نهاية مطلقة كل مرة. غير أن ما يبعث أكثر على القلق - ولربما الأكثر أصالة في الكتاب - هو أن الحركة المتعددة للقصائد، وإنتاجها لذاتيات متعددة، ينتج عنها أيضا تعددُ تجربة تكون فيها الحياة فارغة ثم توضع في علاقة مع الموت. وهنا، حينما يظهر أنت الذي يبدو انعكاساً للأنا، يَبْرزُ هَاجسُ العَدَم، هاجسُ الهويَّة المستحيلة، الذي بإمكانه أن يُلغي حتى بهجة الرفقة والتشابهات: « تأبّـد فينا غيابٌ وما بيننا غيرُ وجهٍ»، «سينفصلُ الوجهُ عن وجْههِ ثم تسقط قطعة برْدٍ على شفتيَّ».
على هذا النحو، لا يتأكد التعدد كاستكشاف وتعرّف، بل إنه سرعان ما يبدأ في التحول إلى إحساس يشبه التصدّع، يشبه جوفاً عميق الغور، حتى عندما يأخذ الصيغة الايجابية التي تبعث على القيام بفعل، وتدفع إلى السرعة: « إهبـطْ يا محمدُ اهبـطْ / لا تفتـشْ عن قدميْكَ أوْ صَدركَ/ اهبـطْ إليْك»، و«الجَـْوزاءُ» هي، في هذه الحالة، الدليلُ الذي يتحكم في وجْهَة السفر.
وعندما نصل إلى قراءة «إنّ هذا الموتَ موتُ أناً»، ونضع «جنازة / في/ الحلق/ » يكون كل شيء قصَدَ موضعه وغيّر مكانه: فالنهر هو اللغة، لكن الجنازة لأجلي أنا. يظهر الموت كفضاء متميز للتعدد، كنقطة يتبدد فيها التعدد ويتجذر، يتجمد، ولا يعود يحركه تدفق التيار : « أماميَ جثتي تتذكّـرُ الدمَ فوق صمْتِ مخدةٍ / جرحٌ هنالكَ ليْسَ يعكسُ / غيْـرَ شاهدَةٍ محوْتُ نقوشَها». أكيد أن هذا الوصف يوازي طبيعة المجرى الذي تملكه الحياة والنظرة إليها معاً، لكنها تحوّرُ أيضاًً نموذج العالم الذي نستشفه تحت علامة النهـر. إن الحياة بالفعل ستستمر باعتبارها مساراً يضم جميع الاتجاهات، سلسلة لا حدّ لها من الاختلافات، لكنها ستكون كمسار موحَّد، مزيج لكل ما هو غريب يبدو أنه لا يمكن أن يقيم بينه حواراً : « كيف أظلّ أنكـرُ / أنّ وجهي لستُ أعرفهُ / غريبٌ / عنكَ هذا الوجهُ / أنتَ أخي / عدوّي / ماثلان معاً أماميَ هاربَانْ ». هو المجرى مجموع مناطق فراغ، وكل الأقاصي تتسع.
مع ذلك، وفي نفس القصيدة المذكورة، حيث تمت الإشارة إلى موت أنا، يعود النهر، لاحقـاً، إلى الجريان كأنه المتطابق، وتأتي إقامة "جنازة في الحلق" لتتحول إلى شرط للتجدد والبعث: «لغة/ لنَا أوْ لِى تطلُّ/ عليّ ثانية/ ونحنُ معاً نُصاحبُ نوْبة العُشاقْ» - يبعث صوتُ الموسيقى الأندلسية النفسَ الجديد في اللغة نفسها. فقسوة النقد والتحليل تنفتح على الأمل في حياة جديدة للغة.
لذلك أريد قبل الختام، أن أشير على الأقل إلى ثلاثة أشكال يتخذها هذا الانبعاث للحياة في الديوان، ثلاثة أشكال لا تـَرد بالطبع ضمن ترتيب أو تدرج أو تطور مُعيّـن ، وإنما ممزوجة بصورة ثابتة وحاسمة للموت. الشكل الأول، يتبدّى عبر المزج المنظم للحظات، فهو الذي يمحو الحدود الزمنية، خالقاً زمنية غير محكومة بالمتتالي والمتقطع، كما لو أنه الديمومة البرغسونية، لكن على نحو أكثر انصهاراً في الطبيعة، حيث تعترض الكتابة على الموت بـ"وُريْقـات" الدفلى أو تحليق "أسراب الخطاطيف".
الشكل الثاني يحيل على مستهل الكتاب المشار إليه: «من البَعيد /- قيل عنه -/ كأنَّه صِنْوُ/ الغِنَاءْ»، ذلك أن القصيدة تـُريد أن تكون صوت المصير الذي تساءل عنه هولدرلين؛ أي أن القصيدة تنصت إلى ما حولها والى الداخل، وبالإنصات تصنع صوتاً : «بَعيدٌ يستضيءُ بصَوْته». وبقدر ما تتمكن القصيدة من التحوّل فعليّاً إلى صيغة لهذا التمرين، لهذا البحث الذي هو اكتشافٌ أيضاً، بقدر ما تصل الصيرورةُ إلى قمَّتها في وصف تضعُه في نسق آخر: حيث العدم لن يتضمن بالضرورة ما كان فقداناً وتفجّعاً، وإنما حالة صحْو يمكن من خلالها استشفاف عالم مُغاير.
أما الشكل الثالث فيَبْقى مَصُوغاً من لدن بنيـس هنالك حيث يأسُ صمويل بيكيت يصنع طاقة : «الكتابة أنقاضٌ / كلّ مَرةٍ / في انْحلالهَا / تلمعُ».
الأنقاض التي، في انحلالها، تلمع، لعله تعريف جميل للقصيدة ولاستمرارنا أحياء أيضاً. يردُ على ذهني الآن النقاش الذي كان لديدي - هوبرمان Didi-Huberman مع بعض نصوص بازوليني عن بقاء الحُبَاحب في عصرنا على قيد الحياة، فأتعرف في الانعكاس المشع لهذه الأنقاض على نفس اللمعان الواهن، لكن المقاوم حتى الحد الأقصى، لهذه الحشرات الصغيرة جداً. إنه نقاش - حرفي ورمزي في آن واحد - حول إمكانية أو استحالة الأمل. نقاش نلعب فيه - ليس مجازياً - بالحياة ذاتها، إن كان علينا أن نسلّم أننا، بفضل الشبيبة العربية، نمتلك اليومَ حماساً أكبر لإمكانية تحقيق هذا الأمل.