إن الارتفاع بالنِّقاش والتحليل من الوزن إلى الإيقاع، ومن قياس العروض إلى نسق الخطاب، يقتضي اختراق تَصوُّراتٍ عروضيّةٍ وبلاغيّةٍ إستحالت إلى عوائق إبستيمولوجية
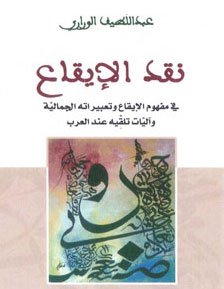 1.
1.
الإيقاع، أكثر الكلمات التي لها تأثيرٌ سحريّ، إذ لا يمكن أن يُحدَّد معناها تحديداً كاملاً. لم يأل كثيرٌ من علماء الشعر والجمال والبلاغة، ومن منظِّري الخطاب، وواضعي أوفاق النظر الشعري قديمه وحديثه، جهداً في تحديدها دون جدوى. أرادوا تحديدها، لكن دون كبير نجاح، وسنحاول نحن بدورنا. كتب الشاعر بول فاليري في أحد دفاتره: 'كلمة (إيقاع) هاته لا تبدو لي واضحة، ولم أستعملها البتّة'. وبمثل ذلك أوحى أحد أهمّ شعرائنا في العصر الحديث، وهو عبد العزيز المقالح، بقوله: 'إنّ قوانين اللاوعي التي نجهل أسرارها تتدخل في صوغ هذا الإيقاع'. ومع أنّ هذا)الإيقاع) نُحسّه من الجهات جميعاً: في خفقان القلب، مساقط الماء، دقّات الساعة، تعاقب الليل والنهار، أطوار القمر، عودة الفصول، الرقص على الموسيقى، وأيضاً ـ كما هنا ودائماً ـ في الكتابة وفق تواضعنا على تسميته بـ'الإيقاع الشعري'. لكن، هل نتحدّث طبعاً عن الشيء نفسه؟ بالطبع، لا. إنّ الإيقاع ليس لاشيء بالتأكيد، ولا موضوعاً يُراد الإمساك به. السؤال لا يمكن أن يُطْرح هكذا: ما هو الإيقاع؟ بل، بالأحرى: ما الّذي ندعوه إيقاعاً؟ غالباً ما تعتبر صعوبة تعريف المفهوم عرضاً، قبل أن يُعْرف ما هو. الرِّهان يكون باستكشافه، وبقدر ما يكون محتجباً يكون مُهمّاً للغاية.
2.
عبر مسارات شتّى، نقف أمام تلك الجهود المدهشة التي بذلها علماؤنا القدامى، في مستوياتٍ ورؤىً مختلفة، من أجل بلورة مفهومٍ خفيٍّ وزئبقيٍّ مثل مفهوم الإيقاع الذي دلّوا عليه بعبارات متنوّعة ومتباينة بحسب الأوضاع المحلّلة، وبحسب أوضاع التلقّي وآليّاتهِ (العروضية، البلاغية والموسيقية ـ الفلسفية) المتنوّعة من حقْلٍ إلى حَقْل، من عصْرٍ مُعْطى إلى آخر. لكنّ تلك الجهود ظلّت متفرِّقة، ولم يحصل بينها حوارٌ نظريّ شامل يتجاوز الصعوبات المنهجية والمعرفية القائمة والمفترضة، فلم تظهر أيّة نظريّة حاولت أن تُقدّم إطاراً مُوحّداً لدراسة الإيقاع، وتبدأ ممّا توقّفت عنده نظريّة الخليل وتفوّقت فيه داخل إطار علم العروض. وهكذا، فقد كانت 'نظريّة' الإيقاع الوحيدة والمتاحة هي 'النظرية القَدَميّة' التي كانت تُقدّم الوزن، وتُقارِبه 'زمانيّاً' بوصفه هو الأساس، وليس الإيقاع. وبالتالي، ظلّت أنساق النّظْم مُجرَّد معايير مُتّفق عليها تُنظِّم الوحدات غير الدالّة: التفاعيل، وعدد المقاطع. ومثل هذه الخُطاطة لا تؤُثِّر في ماهية الصوت، ولا المعنى، بحيث إنّ الوزن الشعري نفسه مُستقلٌّ، جوهريّاً، عن المعنى.
لقد أقام الخليل بن أحمد نظامه على أساس المتحرك والساكن، وقام باستقراء ناقص للشعر العربي أسّس في ضوئه قواعد العروض العربي المعياري التي شكّلت 'نظرية' في إيقاع الشِّعر العربي، ثُمّ تحوّلت إلى 'معتقد' جامد، بعد أن بات فرضيّاتها مُقرّراتٍ ذهنيّة ضاغطة وسابقة عن الواقع الشعري وتجديداته. باتت 'النظريّة' مجرّد نظريّة للبيت، وتُطْرح صراحةً كـ'نظريّة مجرَّدة للإيقاع'، أي نظريّة الإيقاع المجرّد. وهكذا لم تستطع أن تُطوِّر نفسها، فتخلّفت عن تتبُّع حركة التطوُّر الإيقاعي ووصف كشوفاته التي تمّتْ في أكثر من عصر، في المشرق والمغرب. وقد ثبت لنا أنّ علماء العروض لم يزيدوا على الخليل ويُضيفوا إلى علمه مسائل ذات اعتبارٍ كانت تفرضها واقعة القصيدة العربية وتاريخيّتها، بل 'أقاموا بِناءً فِكريّاً بعيداً عن الزمان والمكان، فلا هو يُمثّل أوزان العرب القدماء، التي زادوا ونقصوا فيها، ولا هو يُمثّل أوزان المحدثين التي أنكروها وأهملوها'، بتعبير محمد شكري عياد. مثلما حصل أنّ هؤلاء لم ينفتحوا على معارف عصرهم وأفكاره، ولا على بعض الحقول التي كانت تشهدا تطوُّراً مستمرّاً ولافتاً، ولاسيما في علم الموسيقى وعلم التجويد.
كان التصوُّر العروضي 'المُجرَّد' لإيقاع الشعر العربي هو السائد، وهو ما ساهم في الحيلولة دون تبلور التصوّرات الأخرى الممكنة. وكان بعضٌ من هذه التصوّرات يتفتّقُ ويعِدُ بنتائج مذهلة، لكنّها انتهت إلى عْصرٍ بدا غير مُهيّإ لاستقبال الأعمال الواعدة واستثمارها، بعد أن تفشّتْ في فضاء الثقافة العربية العالمة آليّات النقل والاجترار والتلخيص، وغنمت كتبُ المُقلّدين، في علومٍ شتّى، صمت العقل وروحه المبدعة فأخذت تشقّق الأبواب وتكثِّرها وتُردّد صورها منفصلةً عن بعضها البعض، بلا إنتاجيّة ولا طعم. مثلما اجترّ العروضيّون أنفسهم نظريّة الخليل وقتلوها شرحاً، وانتهى أهل البلاغة إلى أن جعلوا منها علماً كُلّياً، وشقّق بعضهم منها ووجدوا البديع في كلِّ صيغةٍ بها شيئاً من الغرابة مُحسِّناً بديعيّاً، وأطلقوا عليه إسْماً من الأسماء، ممّا أحال الكلام في البديع ومحسّناته إلى صورةٍ غثّة أفقدَتْه حيويّته، وقد درسوا وجوهه خارج ما ابْتُكِرت من أجله عند الأُوَل. كان ذلك إيذاناً بنهاية مرحلة خصيبة من ابتكار العقل العارف والمخيِّلة المُلْهمة، وتجفيفاً لمنابع الإيقاع وتشهّياته الثَّرة، وعطباً بالغاً لإمكان قراءته وتأويله. وهل الإيقاع غير ذلك الخيط الرفيع، العابر واللامرئيّ والمتعدّد، الذي كان يشدُّ العروضَ والمحسِّنات الصوتية ووجوه البديع بعضها ببعض، بقدرما يُطلق المعاني في محتمل الكلام والكتابة، باستمرار؟ مع ذلك، واجه نظام الخليل وقواعده العروضيّة نقداً يتفاوت في حدّته بين القدماء من المستدركين (الأخفش، الجوهري، حازم وسواهم) والمحدثين من أصحاب 'موسيقى الشعر' في العصر الحديث (إبراهيم أنيس، محمد شكري عياد وسواهما)، بحيث أُنْجزت دراسات كثيرة في إطار علم العروض، أكثرها وقع في أسر التكرير والاجترار، والقليل منها انفتح على العلوم الإنسانية (علم اللغة، علم الأصوات، علم الموسيقى، العلم المقارن..)،، فأضاء جوانب مهمّة من نظام الخليل. وإذا كانت الأخيرة قدّمت نفسها بوصفها تيسيراً لعلم العروض، أو دراسة علميّة جديدة له، أو بديلاً لأسس نظامه الإيقاعي، واستطاعت أن تطرح فهماً جديداً للمسألة الإيقاعية في النظرية والممارسة، إلّا أنّ طموح معظمها الأوّلي أعماها عن استبصار مفهوم الإيقاع في علاقته بالوزن، وبالمعنى، وببناء أجروميّات الخطاب الشعري، فكانت غالباً ما تختزل هذه البحوث، المُفيدة بالتأكيد، إلى مُجرّد فرضيّاتٍ لا تهمُّنا إلّا في تفسير طبيعة الوزن وضبط بنيته العامّة.
3.
في مقالته 'مقولة الإيقاع في تعبيرها اللساني'، داخل الإرث الأدبي والفلسفي الإغريقي ـ اللاتيني الذي انفتح عليه علماء المسلمين في الموسيقى والفلسفة، يعود الفرنسي إميل بنفينيست إلى جذور المقولة ليكتشف العلاقة اللّطيفة المعقودة بين الإيقاع وحركة الأمواج 'المنتظمة'؛ وهو ما ينتبه إليه، تجوُّزاً، فريزر، بقوله: 'عندما نقف على شاطئ البحر نراقب الأمواج تتكسّر على الرمل لتعود من جديد، نجد ثمّة تشابُهاً أساسيّاً في حركة كلِّ موجة، لكن ليس من موجتين تتكسّران في شكل متناظر تماماً. وقد ندعو هذا التشابه في اختلاف حركة الأمواج بالإيقاع'. ما ميّز تحليل بنفينيست هو أنّه عاد إلى المعاني المختلفة لكلمة (إيقاع) عند كثيرٍ من المؤلفين الإغريق، من أمثال لوسيب، وديمقريطس، وهيرودوت، وأرسطو، وأخيراً أفلاطون، منتهياً إلى أنّها تدلُّ على 'الشكل المميّز، الصورة المتناسبة، التنظيم'، كما تعني 'الترتيب المتميّز للأشكال داخل الكُلّ'، و'الكيفية الخاصة للجريان'، أو تُحيل على 'شكل الحركة الذي يكتمل فيه الجسد الإنساني وهو يرقص' كما لدى أفلاطون. يشقُّ علينا أن نعرف أنّ هذه المعاني الأوّلية لكلمة (الإيقاع) تظهر أبعد ما تكون عن الاستعمال المعاصر للكلمة نفسها. إنّ ما نقصده، اليوم، بـ (الإيقاع) ليس، في نهاية المحصّلة، إلّا نتاج سلسلةٍ من الامتدادات في حقل من الأنشطة الإنسانية وخواصّ الكائن، والّذي يتّسع أكثر فأكثر. هكذا، كما يُثْيت بنفينيست، 'نُسْقط، من جهة النظام الإنساني، الإيقاع على الأشياء والأحداث'.
والتعميم اللِّساني لاستعمال الكلمة يُعدُّ، هنا، شَرْطاً وليس نتيجة، لوحدة الإيقاع بين الإنسان والطبيعة؛ فاستخدام اللُّغة هو الّذي يَصُوغ وجود تفكيرنا، وليس العكس. والإنسان هو الّذي يُسْقط خُطاطات فكره على العالم، وليس العالم الذي يفرض 'إيقاعاته' على الإنسان. وإذا كان لنا من حُكْمٍ على هذا التعميم المتعسِّف، فإنّما علينا أن ندين لعالم اللُّغة بنفنيست بهذا الاكتشاف، وهو يقول: 'بعيداً عن التمثيلات التبسيطيّة التي تُوحي بها الإثيمولوجيا السطحية، وبمنأى عن تأمُّل لعبة الأمواج على الضفّة حيث اكتشف الهيليني البدائي 'الإيقاع'، فإنّنا، على العكس من ذلك، نتكلّم المجاز عندما نتحدّث عن إيقاع الأمواج. وقد لزم تأمُّلٌ عميقٌ في بنية الأشياء، ثُمّ في نظريّةٍ للقياس تُطبَّق على وجود الرقص ومنحنيات الغناء، لكي نتعرّف على مبدأ الحركة الموقَّعة ونُحدِّده. فليس هناك من 'طبيعيٍّ' أقلّ من هذا التدشين الحثيث، بجهد المفكِّرين، لمقولةٍ تبدو لنا ملازمةً، بالضرورة، للأشكال المتمفصلة للحركة التي يشقُّ علينا الاعتقاد بأنّنا وعَيْنا بها منذ الأصل'.
4.
أدرك هنري ميشونيك قيمة عمل بنفينيست الذي 'خلخل وقوّض ليس مفهوم الإيقاع فحسب، بل وإدماجه في نظريّة الدليل'، وهو ما ساهم في بلورة هذا المفهوم داخل شعرية الخطاب التي جعلها ممكنةً، بحيث 'تُحلّل القصيدة باعتبارها كاشفةً عن اشتغال الإيقاع داخل الخطاب'. بوصفه كتنظيمٍ، و'تشكُّلاتٍ مخصوصة للمتحرّك'، أو كـ'ترتيبٍ مميّزٍ داخل الكلّ'، و'شكْلٍ من الحركة'، يكون الإيقاع قد هجر التعريف الجامد الّذي أبقاه داخل الدليل وأولويّة اللسان، وصار بإمكانه أن يلج إلى الخطاب، ويتوهّج. داخل نظريّة الإيقاع التي جعلها بنفينيست ممكنةً، لا يكون الخطاب استعمالاً للأدلّة، بل فعّالية للذّوات. وانطلاقاً من عمل الأخير، قدّم هنري ميشونيك نفسه عملاً خلّاقاً أضاء من خلاله الإيقاع وتشهّياته وأبعاده شديدة الرهافة، في كتابه ذائع العطر 'نقد الإيقاع: الأنثروبولوجيا التاريخية للغة'.
يؤسّس ميشونيك لنظرية جديدة للإيقاع انطلاقاً من غياب الإيقاع في المعنى، والمعنى في الإيقاع، أي ما يكون به 'الإيقاع يوتوبيا المعنى'، و'تشكيلاً للتلفظ بقدر ما للملفوظ'، لمّا يصير الإيقاع في المعنى والذات، والذات والمعنى في الإيقاع، وعليه يكون 'الإيقاع هو الدالّ الأكبر'. ويُرشدنا إلى أنّ نقد الإيقاع لن يكون فحسب نقداً لنظريات الإيقاع. فهذا الأخير لن يكون ممكناً، وضروريّاً، إلا ببناء نظرية للإيقاع تؤسس الإيقاع في اللغة كخطاب. وفي نقد الإيقاع نقْدٌ للشعرية، سواء المحصورة في الشكلانية والبنيوية التي تتخلّى عن نظرية المعنى ـ الذات والتاريخ، وتقيم داخل نظرية الدليل وأولوية اللسان، أو الشعرية التاريخية للخطاب والذّوات، أو شعرية اللغة التي تقوم على أنساق الأدلّة؛ فيما هناك شعرية الخطاب التي يراها بأنّها غير المكتمل النظري، وتتعاضد مع لسانيات الخطاب التي لا تزال تؤسس لنفسها؛ فهي ليست لها أدلة مادامت أنها ترى أنّ التواصل، والقصيدة كأيّ خطابٍ، يتجاوزُ الأدلّة. وهو ما حرّر الإيقاع بعد أن جرّدته منه نظريّتا الإيقاع المجرَّد والشكل من حيويّته، عبر إعطائه الأسبقيّة كمبدإٍ لنسق الخطاب. وفي هذا المستوى من التحليل المتطوّر للإيقاع، الذي يأخذ به في إطار التعارض بين الشعر والنثر وبدون أن يلتبس بالبيت وبالوزن، نتعرّفُ على ثلاثة أصنافٍ من الإيقاع مشتبكةٍ بالخطاب: الإيقاع اللساني (إيقاع الحديث داخل أيّ لغة، إيقاع الكلمة أو المجموعة، وإيقاع الجملة)، والإيقاع البلاغي (المتغيّر وفقاً للأعراف الثقافية، العصور الأسلوبيّة، والسجلّات)، ثُمّ الإيقاع الشعري بوصفه تنظيماً للكتابة.
في الشِّعر، يُراهن ميشونيك على النظر إلى الإيقاع مُتفاعلاً مع المعنى والذات داخل الخطاب، بوصفها عناصر تبادلُيّة، وأيضاً متحوِّلة تبعاً للخطابات والوضعيات. فعلاقة الإيقاع بالمعنى وبالذات، داخل الخطاب، تُحرّر الإيقاع من مجال العروض. يقول: 'إذا كان الإيقاع داخل اللغة، داخل الخطاب، فهو تنظيم (ترتيب، تشكيل) للخطاب. ومثلما لا ينفصل الخطاب عن معناه، يكون الإيقاع غير قابلٍ للفصل عن معنى هذا الخطاب. إنّ الإيقاع تنظيمٌ للمعنى في الخطاب. وإذ هو تنظيمٌ للمعنى، فلن يكون قطّ مستوى متميّزاً، متجاوراً؛ كما أنّ المعنى يتمّ داخل كل أنساق الخطاب وعبرها'. وهو ما يُبرّر لماذا يُلحُّ ميشونيك على أن يعُدّ الشعر، وليس البيت، هو الممارسةُ النوعيّة للإيقاع؛ وبالتالي، المجالُ الذي يُميّز درس الإيقاع. إلى ذلك، يُنبِّهنا إلى أنّ الإيقاع يتعرّضُ لخطرين:
ـ إمّا أن يكون الإيقاع مُفكَّكاً كموضوع، كشكل إلى جانب المعنى، والذي يُعرف بتكرار ما قد قيل: حشو، تعبيريّة.
ـ وإمّا يكون مفهوماً بمصطلحاتٍ سيكولوجيّة تُموِّهه حين يتمُّ النظر إليه كأنَّه غير قابلٍ للوصف، ومستهلكٌ داخل المعنى أو الانفعال.
وبما أنّ الإيقاع 'ليس دليلاً'، فإنّه يرفض الدلائلية، ليخلق دلائليّة مُضادّة، طالما أنّهُ 'غير قابلٍ للاختزال إلى الدليل. بل هو يتمُّ في اللغة'. وبالنتيجة، يقول: 'أُعرّف الإيقاع داخل اللُّغة كتنظيمٍ للسّمات التي من خلالها تُنْتج الدوالّ، اللسانية وعبر اللسانية ( في حالة التواصل الشّفوي خاصّةً)، عِلْمَ دلالةٍ نوْعيّاً، مُغايراً للمعنى المعجمي، الّذي أُسمّيه الدلاليّة: أي القيم الخاصّة بخطابٍ، وخطابٍ مُفْرد'. وهو ما يجعل الإيقاع يهجر مجاله التقليدي، وينفتح، باستمرار، على جميع دوالّ الخطاب وعناصره البانية الّتي لا تعمل مستقلّة عن بعضها البعض، بل هي تعمل ككُلٍّ، ممّا يجعلها تُؤسِّس في تضافُرِها المحورين الاستبدالي والمركّبي الّذين يقومان بتحييد مفهوم المستوى كما تصوّرتْه نظريّة الدليل وثُنائيّته. إن دالّ الإيقاع يشتغل في قلب الدلاليّة وهي تُحرّر المتواليات الصغرى كما الكبرى داخل الخطاب الشّعري. لذلك فالإيقاع يتأبّى على كلِّ قياس، كما الدلاليّة.
في 'سياسة الإيقاع، سياسة الذّات'، يواصل ميشونيك مجهول البحث في الإيقاع ونقده. فبعد أن بحث حركة الكلام داخل الكتابة وكشف كيف يُحرّر الإيقاع الذات، يضع التصوُّرات التي تحكم علم الاجتماع والتحليل النفسي ولا تُخلي مكانها لأحد، موضع سؤال مُجدَّداً، فيما هو يعلن أنّ الأدب والفنّ غير قابلين للفصل عن تمثُّل المجتمع، بطريقةٍ تُفكِّر في الجماعة والمؤنّث. من البدء، يُقدّم العمل نفسه باعتباره مُخطَّطاً نقديّاً لمجموع صيغ الفكر التي صنعت المشهد القفافي الفرنسي والأوربي، وحتى الأمريكي، منذ الستينيّات من القرن الفائت، بما في ذلك النظريات، والبنيوية تحديداً، التي همّشت الشعر وألقت به جانب الانزياح والجنون، وقادت إلى الاعتقاد بـ'موت الذّات' ووضعت القصيدة والخطاب خارج تاريخيّتهما.
يقودنا ميشونيك، عبر هذا المسار، إلى أرسطو الذي عبّر، بشدّة، عن التعاضد بين الشعرية، الأخلاقيات والسياسة. نسيان هذا التعاضد هو النسيان نفسه للذّات. من هنا، يحاول ميشونيك أن يجعل من تفكيره في الذّات 'سياسةً' للذّات، شارطاً بأنّ ما تحتاج إليه القصيدة هو ذات القصيدة، من ذاتٍ إلى ذات. هذه الذّات النوعيّة ينبغي أن يكون مُفكَّراً فيها باستمرار. يقول: 'هذا التفكير ضروريٌّ لنا كلِّنا، حتّى وإن لم يُعْرف. إنّها ديمقراطية القصيدة، تلك التي تسعفنا للتفكير في مقولة الفكر الشعري وعبره بما يسمح له بأن لا يُحوِّل التمثُّل السائد للغة فحسب، بل أن يعيد اليوم، وبشكل آخر، اكتشاف الوشيجة المنسية بين اللغة، الشيء الأدبي، الأخلاقي والسياسي. كما بين الإيقاع والذّات وشيجة تتأتّى ممّا نعني به في الفكر الشعري اكتشافَ الإيقاع، بالمعنى الذي لا يكون فيه تتابعاً شكليّاً بل تنظيماً للذّات. إنّي أعرّف الشعر أو الفكر الشعري كاكتشافٍ للذات، مثلما للذّوات بِشكْلٍ غير محدود '. ولا تنفصل الذّات، عنده، عن القيمة التي يأخذها بمعنىً مزدوج: فرضيّة العمل الذي يتبادلانه معاً، والأثر الذي يكون لبعضهما على الآخر. فالقيمة، داخل النصّ الأدبي، هي سمة الذّات، مثلما هي نفسها عناصر لنوعيّة النص. كما الذّات، بدورها، ليست ذاتاً سيكولوجيّةً ولا موحَّدة، طالما أنّ القصيدة لا تنتجُ من الأدلّة، وأنّ النوعية ليست بحثاً عن الأصالة. فهي غير ذات التحليل التفسي التي إذا كُنّا جميعاً نمتلكها، فإنّ ليس لجميعنا، في المقابل، ذات القصيدة. هكذا، يستنتج ميشونيك: 'داخل الشِّعرية، تُظْهر القيمة أنّه لا توجد نظريّةٌ للذّات بدون نظريّةٍ للغة. فضِدّاً على الدليل وتداعياته المُطمئنّة، تُخْلق القيمة غير قابلةٍ للفصل عن الشعريّ (الفكر، الأسلوب ـ كما لو أنّ هناك فكراً بلا أسلوب، وأسلوباً بلا فكر)، وعن السِّياسي'.
وهو يستعيد فكرة هيروقليطس عن الإيقاع، يُبْرز ميشونيك أنّهُ 'للمرّة الأولى، منذ أفلاطون، يمكن للإيقاع داخل اللُّغة أن يتجلّى كتنظيمٍ للحركة في الكلام، وتنظيمٍ للخطاب عبر الذّات، وللذّات عبر خِطابها. ليس ثمّة من صَوْت، ولا من شَكْل، بل الذّات'. فلا يوجد تَمفْصلٌ مُزْدوجٌ للُّغة، إنّما الدوالّ فحسب. وفي فهمه، يرى أنَّ الدالّ يُغيِّر المعنى، بحيث لا يتعارض مع المدلول، وأنّ الخطاب يُنْجز داخل علم الدلالة الإيقاعي والتطريزي ـ الّذي لا يتِمّ بحسب الوحدات المفكَّكة للمعنى ـ وداخل فيزياء اللُّغة، منتبهاً إلى تماسّ الصوت والجسد في المكتوب.
بالنتيجة، ومن منطلق اعتبار الإيقاع تنظيماً ذاتيّاً للتاريخيَّة، يُميِّز ميشونيك بين المنطوق والشفويّ، ويرى أنّه لا يوجد نموذجٌ ثُنائيٌّ، شفويّ ومكتوب، للدليل يتحكّمُ بالصوت ويُجسِّده مكتوباً؛ بل نموذج ثُلاثيّ، منطوق ومكتوب وشفويّ. وإذا كان الشفويّ مفهوماً كأولوية للإيقاع والتطريز في التلفُّظ، فهو مع ذلك خاصية ممكنة للمكتوب كما للمنطوق، وليس بالضرورة أن تكون مُحاكاة المنطوق شفويّةً. وفي هذا المعنى، لا يعدُّ ميشونيك الشفاهيّةَ حفريّاتٍ مفقودة، بدعوى اختفائها المزعوم في العالم الحديث، وينتقد الفكرة المهيمنة التي أشاعها عنها، إلى أيّامنا، ولتر أونج من خلال كتابه 'الشفاهية والكتابية'.
من شعريَّة الإيقاع إلى سياسة الإيقاع، يُعطي ميشونيك للإيقاع رُؤْيةً جديدةً لم تكن له، إذ تتداخل الذّات في القصيدة بالقيمة وبالدالّ، وهو يعني بسياسة الإيقاع، هنا، ذلك 'الجريان الداخلي الّذي يتمُّ بين القصيدة والأخلاقيات والسياسيّ'، بشكل غير قابلٍ للفصل. إنَّهً اكنشافٌ، بالفعل.
5.
رغم وفرة الدراسات التي أُنْجزت بصدد الإيقاع، وبخاصّةٍ داخل 'نظريّات' الشعر العربي قديمه وحديثه، إلّا أنَّ أكثرها وقع سجين العروض ومعاييره الاصطلاحيّة الثابتة، ولم تنفلت بالنتيجة من الخلط بين الإيقاع والوزن. في المقابل، هناك دراساتٌ قدّمت تصوّراتها للإيقاع خارج ما استقرَّ عليه العُرْف النقدي، بعد أن تسلّحت بمناهج في الوصف والتحليل جديدة ومبتكرة، بما في ذلك التي أنجزها محمد شكري عياد، وكمال أبو ديب، ومحمد العياشي، وسيد البحراوي، وحسن الغرفي، وعلوي الهاشمي، ومحمد مفتاح، تمثيلاً لا حصراً.
الإيقاع ليس الوزن، إنّه أشمل من الوزن. لكن، لا يزال الالتباس بين الإيقاع والوزن حاصلاً في أذهان الكثير من الدارسين إلى اليوم، إذ ما فتئ يعتقدون بأنّ هذا هو ذاك بعينه، وأنّ معناهما واحد. فإذا كان الوزن ظاهرةً صوتيّةً تنشأ من تساوي أجزاء البيت الشعري وتردُّدها على مسافاتٍ أو مقادير موزونة متساوية أو متناسبة في الكمّية، فإنّ الإيقاع يضمُّ النسق الصوتي الذي لا يُخْتزل في الوزن فحسب، وإنّما يشمل القافية والنبر والتنغيم والتكرار وتوازي المقاطع وسوى ذلك من المحسّنات البديعيّة، إلى جانب النسق الدلالي الذي يخصُّ حركة المعنى ودلاليّته التي تُحوّل بنية القصيدة ببعديها الزماني والمكاني، ومجاليها الشفوي والمكتوب. ولهذا، فالوزن ثابتٌ قابلٌ للقياس، فيما الإيقاع مُتعدّد ولا يقبل العدّ ولا القياس. الإيقاع هو كلٌّ، لا إيقاع خارجي وآخر داخلي.
إنّ الإيقاع، وهو يُنظّم معنى الذّات، يكفُّ عن أنْ يكون له تَمفْصلٌُ مزدوج؛ عدا أنّه ليْس صوتيّاً أوْ وزنيّاً فحسب. إنّه يوجد في الخطاب كنسق يجعل الذات الكاتبة تحضر فيه بكثافتها، ويسهم في وضع المعنى داخل اللا ـ وحدة، لأنّ الوحدة لا تكون إلّا دليلاً، والإيقاع لا يقبل باختزاله إلى دليل. الإيقاع ليس دليلاً؛ فهو 'لا يُحاكى أو يُضيف فقط، بل إنّه يُصارع المعنى أيضاً، ويكشف الصراع داخل بنية القصيدة، ولم يكن الإيقاع ليستطيع أن يقوم بهذا الدور، لو كان مُجرّد إشارة بسيطة ذات دلالة وحيدة ومُتّفق عليها كإشارة المرور. الإيقاع ليس إشارة بسيطة، إنّه نظامٌ إشاريٌّ مركّب ومُعقّد'. فالإيقاع هو تتابع الأحداث الصوتية في الزمن، ممّا يُنظِّم معه أصوات اللغة تنظيماً مخصوصاً يميّز نظامها الصوتي، إلّا أنَّ وظيفته تنظيميّة 'تقوم بدور التنسيق والانسجام بين بنيات النص الشعري'، فيجعلها كُلّاً مُتماسكاً، أكثر ممّا هي 'ترصيعية يتوخّى من ورائها إحداث تناغمٍ جرسيٍّ لا غير'.
إذا كان الوزن يضع إيقاع البيت داخل البنية، الصّوتية، فإنّ الإيقاع لا يكون إلّا داخل نسق الخطاب، فيكون إيقاع الخطاب تركيباً لكلّ عناصر الخطاب، بما فيه عناصر الإبلاغ الشعري(المقام/ الباثّ/ المتلقّي). هكذا، يمكننا أنْ نستقصي إيقاع قصيدة التفعيلة مثلما النّثْر منْ مكان شعْريّة الإيقاع كتصوّر إجرائي يفترض اللّسانيات والبلاغة وشعرية الخطاب في آن، لأنّ ما من كتابة فجّرت دالّ الإيقاع كهذه القصيدة. فالنّحو، نحو القصيدة، يُشكِّل جزءاً تأسيسيّاً منْ إيقاعها، ومن دلاليّتها.يظهر الإيقاع غير منْفصل، ألْبتّة، عنْ التّركيب، والمعنى، والقيمة داخل القصيدة؛وهو يرتبط بأصغر وحدة {صامتية، مصوّتية، مقطعية، معجمية}، وبأكبر وحدة /وحدات الخطاب المتغيّرة الّتي تتضمّن وحدة الجملة.وترجع أولويّة الإيقاع، المتجرّد من العروض، إلى الأولوية التجريبية للْخطاب على اللّسان. من هنا، لنْ تعود الوحدة الإيقاعية في نصّ قصيدة النّثر هي التّفعيلة كما يحصل في أشْكال أخْرى من الشّعر العربي قديمه وحديثه، بل تصبح الوحدة هي الجملة اللّغوية بوصفها تركيباً دلالياً لا وزْنيّاً، وتتوزّع القصيدة إلى 'أبيات' تتحرّك وفْق 'حركة المعْنى' بما تُشيعه من ضروب وتلوينات بلاغية ودلالية بحسب موقعها في نسق الخِطاب، لا وفْق قوانين وزنية قارّة وقبْليّة.
الإيقاع أهمُّ في نسيج اللغة، مُشْتبكاً بدوالّها جميعاً، إذ هو اللّا متوقَّع الذي يتجاوز القياس، والمتّصل ـ المنقطع، والجديد داخل المكتوب، كما الحياة. وهو، لذلك، 'بالغ الأهمّية داخل اللُّغة بدلاً من أنْ يُزجَّ به في العروض، العروض الّذي يقيس الأزمنة التي ليست لأحد، لأنّها ليست لا زمن المعنى، ولا زمن الذّات'. فإذا كان العروض يُسعفنا في ضبط البنية الوزنية للبيت الشعري، فإنّ ليس له ما يُقدّمه في تحليل إيقاع الخطاب باعتباره المجموع التركيبي لكلّ العناصر التي تُسهم فيه، والتي تتمظهر في كلّ مستويات اللغة الشعرية: العروضية، التطريزية، التركيبية والدلالية، التي تُحدّد دالّ الإيقاع وطبيعة اشتغاله داخل القصيدة. لا يُعرَّف الإيقاع بوصفه وزنيّاً، أو صوتيّاً، أو نبريّاً فحسب، وإنّما يتعدّى ذلك إلى الخطاب بأكمله، حيث يمكن أن يستند إلى الأبعاد الدلالية للنّظْم بمفهومه البلاغي، وذلك تبعاً لحركة المعنى وفعاليّته في تنظيم الذات داخل خطابها، المفرد والمختلف. ذلك ما يجعلنا نعتقد بأنّ الإيقاع دائماً ما شكّل مختبر المعاني والرؤى الجديدة التي لم تكفَّ الذّوات، من عصر إلى آخر، عن السعي إليها في تواريخ تفرُّدها الخاصّة. هناك تاريخ لإيقاعاتٍ أو 'عُقَدٍ إيقاعيّة' لكلّ شاعرٍ مُجيدٍ من شعراء العربيّة وغير العربية؛ فالإيقاع ليس عنصراً شكليّاً أو مستوى أو حليةً أو مُضافاً، بل هو مبدأ بانٍ ودلاليٌّ يتشكّلُ عبر مسار إنتاج القصيدة لمعناها وقيمها المخصوصة.
6.
من الإيقاع إلى نقد الإيقاع. لسنا نقصد بـ'نقد الإيقاع' إلّا نقداً للشِّعر، وسياساته، ولتاريخ ممارساته الأدبية عامّةً. ولن يأخذ ذلك النّقد معناه وضرورته إلّا عندما يكون استقصاء لمختلف القضايا التي تهمّ، جوهريّاً، مفهوم الإيقاع وتعبيراته الجمالية بحسب الأوضاع المحلَّلة: من العروض إلى نقد الشعر، ومن البلاغة إلى نظرية الإعجاز، ومن الموسيقى إلى الفلسفة، من مَنْظورٍ يرتفع بمستوى التحليل من البيت إلى الخطاب، ومن التأمُل إلى النظرية، ويُفكّر في الكتابة من داخل تاريخها وشروط إنتاجها الخاصّة. هكذا، فإنّ نقد الإيقاع، بهذا المستوى من الاعتبار، هو نقد 'النظريّة' نفسها، واختراقها بالتّالي؛ وذلك بمقتضى من إشكاليّةٍ مغايرة تستوعب قضايا الجهاز العروضي، فيما هي تسعى إلى تجاوزها عبر طرحها لتصوُّرٍ جديد لمشكلات الإيقاع في الشعر العربي وتاريخيّته.
إنّ الارتفاع بالنِّقاش والتحليل من الوزن إلى الإيقاع، ومن قياس العروض إلى نسق الخطاب، يقتضي اختراق تَصوُّراتٍ عروضيّةٍ وبلاغيّةٍ إستحالت، مع تكريسها باستمرار، إلى عوائق إبستيمولوجية بالفعل. بهذا الفهم، ومن مكانٍ آخر: يقول دولوز وغاتاري: "من المعلوم جدّاً أنَّ الإيقاع ليس قياساً، أو توقيعاً، ولا كان مُطّرداً حتّى (...) القياس دوغمائي، لكنّ الإيقاع هو نقد". وهكذا، فإنّ نقد الإيقاع يتمُّ كاستراتيجيّة، وهذا النّقْد لا زال جارياً.
**
من كتاب يصدر نهاية هذا الشهر تحت عنوان: "نقد الإيقاع: في مفهوم الإيقاع وتعبيراته الجمالية وآليات تلقّيه عند العرب".