(1)
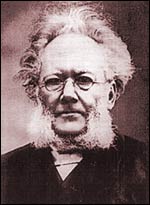 في أيلول الماضي، شارك المخرج العراقي الراحل عوني كرومي، بالندوة الفكرية التي عقدت على هامش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحت العنوان الأساسي "التجريب وتقاليد الكتابة المسرحية".
في أيلول الماضي، شارك المخرج العراقي الراحل عوني كرومي، بالندوة الفكرية التي عقدت على هامش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحت العنوان الأساسي "التجريب وتقاليد الكتابة المسرحية".
واختار ضمن هذا الإطار محوراً بعنوان "كتاب المسرح الحديث والتمرد على التقاليد"، وقدم بحثاً جدياً وعميقاً. أودعه خبرته المسرحية، وثقافته الواسعة، وأفكاره الطليعية.
كانت هذه الندوة آخر ندوات عوني كرومي، وكانت مقاربته هذه آخر المقاربات، قبل أن يرحل، ويخلف وراءه إرثا طليعياً وتجريبياً، في مجموعة من الأعمال المسرحية التي وقعها، وقدمها في عدد من البلدان العربية والأوروبية.
ننشر هنا نص البحث كاملاً في حلقتين:
أود أن أوضح بدءاً إنني لا استخدم كلمة التمرد هنا بالمعنى القدحي لها فانا أتعامل مع التمرد باعتباره حالة جدلية، وكذلك الأمر مع التقاليد، التي اعتبرها أساساً لا غنى عنها للانطلاق إلى ذرى التقدم والتطور، والكف بالتالي عن التعامل معها كموروث مقدس لا يجوز المساس بثوابتها من جهة، أو عدم الاكتراث بها وتجاهلها بغطرسة لا مبرر لها. إنما يجب أن نعمل على استغلالها.
فالتمرد في المسرح حالة من حالات إعادة إبداع الذات، تنزع إلى البحث والتقصي وعدم الرضوخ والاستكانة إلى المألوف والجاهز والمستهلك... فالتمرد على سكون التقاليد وعدم إعادتها لذاتها، هو ما ندعوه بالتجريب الذي يقود إلى الثورة على الذات والواقع، مع أنه حالة فردية، ولكنه مرتبط بشروط العمل والبيئة الثقافية للعصر، مثلما حدث في ستينات القرن الماضي وشمل مجتمعات ودولاً ونظماً مختلفة ومتنوعة كانت تعيش في مرحلة التكيف والاندماج على نطاق واسع لذا جاءت الستينات تمرد على كل ما هو تجميلي وتخديري وإيهامي..
إن التمرد على التقاليد المسرحية كان وما يزال ديدن العديد من المبدعين والطليعيين في المسرح. تنحو نحو النماء والتطور رفض الإنسان بأدوات التغيير عبر مراكمة الخبرة والبحث الدؤوب. لإدراك كنه الظواهر وطابعها المتناقض والإجابة بالتالي على أسئلة وتحديات الطبيعة والواقع من خلال السعي المتواصل لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية والتكييف الخلاف مع قوانين الطبيعة الموضوعية، وبدون هذا الطموح يتحول المسرح إلى بركة راكدة وآسنة...
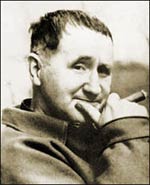 وتتمثل التقاليد المسرحية بالمناهج، والطرق والأساليب المسرحية التي تسيطر في فترة ما، على الحركة المسرحية هنا أو هناك، وتمثل خلاصة للتجربة المسرحية أو لتراكم الخبرة عند الفنانين أو داخل اتجاه مسرحي معين. ويمكن دراسة هذه التقاليد إما على أساس الحقب الزمنية أو المجتمعات والحضارات البشرية أو حسب الأشكال والنماذج المقدمة في المسرح من خلال النص وهو الشكل الأكثر تواصلاً وثباتاً من عناصر المسرح حيث وصلنا ورغم كل الظروف إبتداء من نشأة المسرح وحتى اللحظة الراهنة على العكس تماماً من العرض المسرحي الذي لم يتنفس الحياة إلا مع مرحلة التسجيل المعاصرة بواسطة الأفلام والصور وأجهزة الفيديو أو من خلال التطور المعماري لأبنية المسرح.
وتتمثل التقاليد المسرحية بالمناهج، والطرق والأساليب المسرحية التي تسيطر في فترة ما، على الحركة المسرحية هنا أو هناك، وتمثل خلاصة للتجربة المسرحية أو لتراكم الخبرة عند الفنانين أو داخل اتجاه مسرحي معين. ويمكن دراسة هذه التقاليد إما على أساس الحقب الزمنية أو المجتمعات والحضارات البشرية أو حسب الأشكال والنماذج المقدمة في المسرح من خلال النص وهو الشكل الأكثر تواصلاً وثباتاً من عناصر المسرح حيث وصلنا ورغم كل الظروف إبتداء من نشأة المسرح وحتى اللحظة الراهنة على العكس تماماً من العرض المسرحي الذي لم يتنفس الحياة إلا مع مرحلة التسجيل المعاصرة بواسطة الأفلام والصور وأجهزة الفيديو أو من خلال التطور المعماري لأبنية المسرح.
لقد كان دائماً التمرد على التقاليد يولد تقاليد جديدة تشق لها طرق مختلفة نحو الانتشار الواسع في الدراما.
وكثيراً ما كان التمرد بالذات في الجوانب الاجتماعية والأخلاقية يواجه بشجب عنيف. لأن التمرد أيضاً يحمل في جوانبه قوة تدميرية إذا لم يكن مترافقاً بوعي وحكمة وتجربة وصبر وتأني وشفافية، وهنا تكمن المخاطر إذا
لم يكن التمرد مرتبط بإدراك لمعنى الحياة.
لأن الإحباط واليأس والعجز تقود إلى التمرد، من أجل إثبات الذات والقدرة على البقاء والتطور، بالذات في المراحل التي يعيش فيها الإنسان والفنان المتناقضات الأساسية للتفكك الاجتماعي.
إن التمرد في المسرح يعني التحدي لاتجاهات ثابتة معينة تكون مع مرور الزمن حركة طليعية تأخذ على عاتقها تعميق المواقف الحداثية أو التجديدية أو الطليعية وترتبط هذه المصطلحات مع الأسماء أو الفترات الزمنية وكثيراً ما تفرز هذه الحركات حركات فنية مركبة نطلق عليها تسميات عديدة الطليعة والطليعيين، الحداثة والحداثيين، التجديد والمجددين أو الدادائية أو السريالية أو التعبيرية. هذا يرتبط بالزمان والمكان وماهية التقاليد التي يتم التمرد عليها والتي هي نتيجة لما جاءت به طبيعة المجتمع والثقافة وتاريخ المسرح في هذا البلد أو ذاك.
اصطدم سعي المسرح إلى التغير الاجتماعي بالكثير من الأشكال والتقليد المسرحية، التي أصبحت تشكل عائقاً جدياً أما هذا المسعى ويعتبر الفنان بيتر بروك واحداً من أبرز من أخذوا على عاتقهم القيام بهذه المهمة بالمزيد من الجرأة والإصرار. فلقد أدرك بروك أن المسرح الكلاسيكي، بأشكاله التقليدية ومضامينه المترهلة والشائع، لم يعد قادراً على التعبير عما يعتمل في المجتمع من نوازع ورؤى جديدة، تبحث لها عن أشكال مناسبة، تستجيب لتمردها على ثوابت المجتمع القديم واعتباراته ومعاييره لأن التخمة قد حلت وأصبح المسرح عاجزاً عن تنفيذ مهماته لذات يعتقد أن الوقت قد حان وأصبح من الجوهري ضرورة إعادة اكتشاف جذور المسرح والتجربة الإنسانية معاً. لأن التمرد لا يعني إسهام التحدي فقط للمؤسسات الفنية إنما للفن المسرحي ذاته.
وإن التمرد المسرحي يجلب معه دائماً مسرحاً طليعياً يرتبط بالسياسة. ونوعاً مسرحياً يحاول أن يوجد ويقدم نفسه على أنه لون جديد من الحياة.
إن حركة التمرد لها بداية، ولكن ليس لها نهاية تظهر عندما تبرز أسماء المبدعين المدافعين عن حالة التمرد والثورة.
إن إبسن الذي اتسم بالتحدي للأزمات والتناقضات والمناطق المعتمة اجتماعياً والتي لم تسلط عليها الأضواء في ذلك الزمن. رفض الطابع التمثيلي أو التصويري للغة عندما قرر التخلي عن الشعر الدرامي وأن يكرس نفسه للكتابة باللغة المحكية والسهلة التي يتكلمها الناس في حياتهم الواقعية لأنه كان يرغب في تصوير كائنات إنسانية وبهذا حرر الكلمة من أغلال الاتجاهات الفلسفية والدينية و،مزج بين الخبرة الراهنة القائمة على التزامن كما أن هناك الكثير من الظواهر التي ثار عليها في حينها أصبحت تقليداً درامياً له وجوده الخاص. مثل إقامة بنية حقيقية على الخشبة مشابهة للحياة وهذا أهم ما ميزه وأصبحت من بعده شيئاً مسلماً بوجوده.
إن التمرد يطمح إلى التغيير وإعادة التكوين ويأخذ شكله من الزمن الذي يظهر فيه والمكان والمجتمع لأن التمرد على الأشكال والمضامين نسبي ففي بلد ما يعتبر ما هو تمرد على الأشكال في بلد آخر يعتبر هذا الفعل أو الشكل مستهلك وتم تجاوزه. لأن المسرحيات الأكثر تمرداً هي التي تطرح مفاهيم سائدة للتساؤل، وبهذا تثير السخط من المحافظين والتقليديين وتتهم بالانحطاط والابتذال وعدم الفهم... كما أنها تهدد قيم المجتمع السائد لأنها تتصدى للأزمات العميقة وتقترب من المحرمات وهذا ما حدث مع إبسن ذاته.
التمرد يسعى لكي يكون الفن المسرحي مواكباً من حيث "الموضوع والشكل" المجتمع الذي يتخطى التقليدية.
ولكن التمرد على المسرح القديم، يعود في الحقيقة إلى نهايات القرن التاسع عشر حيث انفلتت المحاولات الأولى للتمرد على الإبسينية بالرفض المتعدد الجوانب "للطبيعية" والعمل على إنهاء الوهم على المسرح، وهم تحقيق الواقع والطبيعة بأدوات الواقع والطبيعة، وهم خلق الخلفية التاريخية من خلال الملابس والديكور، وهم تحقيق الشخصية عبر الاندماج وإعادة بناء الحياة على المسرح ببناء مشهد على الخشبة "مشابهاً للحياة" ارتبط التمرد المسرحي عبر العصور بظهور السياسات الراديكالية أو الثورة أو من خلال الابتكارات والتجارب الفنية والاكتشافات العلمية والاجتماعية. التي غيرت الأهداف الرئيسة للفن ووظائفه واستثماره في حياة الإنسان إلى جانب تغير العلاقات القائمة بين منتجي المسرح والجمهور المسرحي، بين الفن الذي لا يهدف وبين الفن غير المفهوم... إن التمرد على الأشكال الفنية يحمل بذاته بذرات التمرد اللاحقة ويقدم الدليل على إمكانية التطور... فإبسن هو من مهد للتعبيرية كشكل مهم في تأريخ المسرح العالمي. وإذا كان الوهم يتحقق في خلق التجاعيد والمساحيق فأن التمرد استثمر الماكياج المبالغ فيه لإبراز الطابع المسرحي. أي النزوع إلى التعبيرية والرمزية من خلال تمثيل شخوص عبر الدمى والعرائس مثلاً.
إن التمرد يعلم ويعرف الفنان ماذا يعمل لأنه يقود إلى الانفتاح والحرية والتعرف على الآخر فهو يعني الرفض في أوسع أبوابه كما هو متعارف عليه بهدف خلق تقاليد جديدة في (المشاهد المسرحية، الكتابة المسرحية، بناء العرض المسرحي، التمثيل، والتلقي. والعلاقة مع الجمهور).
أشكال التمرد المسرحي
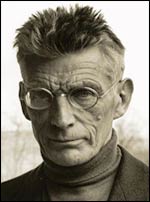 إن الشجاعة التي يتميز بها الفنان المسرحي المتمرد مؤلفاً، مخرجاً، ممثلاً، كانت تدفعه إلى التجريب والتجديد وعدم الوقوف والرضا وعدم الركون إلى ما هو قديم ومألوف، والعمل مهما تغيرت الظروف بروح البحث والاكتشاف، حيث سعى الكتاب الدراميون المعاصرون إلى اختبار قدرتهم على التجدد والتطور، ليس فقط لأن المسرح هو المكان الوحيد الذي يتلقى فيه الكاتب تأثير عمله مباشرة وبلا حدود، وإنما لأنه كذلك مكان للحوار والنقاش والتجريب وتبادل الآراء والخبرات.
إن الشجاعة التي يتميز بها الفنان المسرحي المتمرد مؤلفاً، مخرجاً، ممثلاً، كانت تدفعه إلى التجريب والتجديد وعدم الوقوف والرضا وعدم الركون إلى ما هو قديم ومألوف، والعمل مهما تغيرت الظروف بروح البحث والاكتشاف، حيث سعى الكتاب الدراميون المعاصرون إلى اختبار قدرتهم على التجدد والتطور، ليس فقط لأن المسرح هو المكان الوحيد الذي يتلقى فيه الكاتب تأثير عمله مباشرة وبلا حدود، وإنما لأنه كذلك مكان للحوار والنقاش والتجريب وتبادل الآراء والخبرات.
إن الخزين الفني الذي منحه إيانا "المتمردون على التقاليد كان وسيلة مهمة في تطوير الرؤية المسرحية والمنهج والوسيلة لإغناء العمل الفني والإبداعي. وكان مصدراً ملهماً للطفرة التي حدثت في المسرح والتي انطلقت منذ بداية الستينات من القرن الماضي.
لم تكن الستينات من القرن الماضي نقطة تحول بالنسبة إلى المسرح والثقافة في أوروبا فحسب إنما شمل ذلك شتى أنحاء العالم، بكل معسكراته ونظمه السياسية والاقتصادية في الدول الاشتراكية والرأسمالية ودول عدم الانحياز أو ما يطلق عليه دول العالم الثالث. فلما انتهت الخمسينات مع نهاية الحرب العالمية الثانية حتى كان كل ما هو منطقي وعقلاني قد وصل إلى حالة من العجز والعقم. ودخلت الثقافة والمسرح في صراع بين ما هو منطقي وعقلاني قد وصل إلى حالة من العجز والعقم. ودخلت الثقافة والمسرح في صراع بين ما هو تقليدي وحديث بين ما هو أكاديمي وما هو تجريبي وبين من يطور عروضا كبيرة في الهواء الطلق هادفاً إلى تحطيم الانفصال التقليدي بين الممثلين والجمهور. وبين من يعمل في داخل المختبرات المسرحية المغلقة وبين ما هو غربي وشرقي يخضع لتأثيرات المعسكر الاشتراكي من خلال الواقعية الاشتراكية التي لم تكن في الظاهر سوى إعادة فهم الثقافة في أنها جزء من بنية التعليم والتهذيب البرجوازي. وبين ما هو شكلي غامض.
ووصل التجريب ذروته في إعادة تقديم العمل المسرحي بأشكال مختلفة وصياغات متعددة، مثلما فعل بيتر بروك مع منطق الطير "اجتماع الطير" حيث عمل على إعداده في أكثر من بلد ومكان ومثلته سبعة مجاميع مختلفة، كانت مسؤولة عن سبع صياغات للعمل وقدم العمل في الليلة الأخيرة بثلاثة أجزاء، يبدأ الأول في الثامنة من المساء والثاني في منتصف الليل والثالث في الفجر، أول العروض كان ارتجالياً وثانيهم كان هادئاً وملتزماً بالنص، أما الثالث ذا طابع احتفالي.
 ففي هذه الفترة ظهرت اتجاهات متعددة ومختلفة وفي بعض الأحيان متناقضة، فهذا يرفض ان يقدم صورة وثائقية والآخر يرفض ان يكون مسرحه تعليماً والآخر يبحث عن المتعة من خلال التعليم والتعلم وبعضهم يسعى لمشاركة المشاهد للحدث أو انتظار لحظة التطهير.
ففي هذه الفترة ظهرت اتجاهات متعددة ومختلفة وفي بعض الأحيان متناقضة، فهذا يرفض ان يقدم صورة وثائقية والآخر يرفض ان يكون مسرحه تعليماً والآخر يبحث عن المتعة من خلال التعليم والتعلم وبعضهم يسعى لمشاركة المشاهد للحدث أو انتظار لحظة التطهير.
وحول البعض الكتابة المسرحية وبناء العرض إلى شكل يراد منه ان يكون تجربة فريدة تقوم على جمع المختلط معا، وضع المختلف جنباً إلى جنب حتى تحدث تلك اللحظة المتمثلة بالمواجهة كما تجسدها مختلف صور الاختلاف والتناظر كما يعتقد بيتر بروك.
فإذا ما أخذنا الصراع الدائر في مسرح الدول الاشتراكية بين متحفية ستانسلافسكي وتجريبية بيرتولد بريخت أدركنا كم كانت الشقة واسعة بين اتجاهات المسرح ولكن كيف سقط الجميع أيضا في وهم التشابه، فالحداثة والتقليدية أخذت أشكالاً أخرى وأسست منطلقات مغايرة عما كان يحدث في الغرب الذي شهد محاولات بيتر بروك في الستينات بالبحث عن المسرح الاحتفالي والشامل، كما شهد إعادة الأشكال الشعبية المسرحية ذات الصبغة الجماهيرية، مثل مسرح الكوميديا ديلارتي من خلال عروض بلوش في فرنسا التي تجمع بين فكرة المتعة والتسلية والمسرح الموجه الملتزم بقضايا الإنسان..
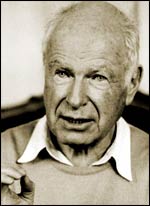 كانت الستينات تقع، حداً فاصلاً بين دراما ما بعد الحرب ودراما المجتمعات، التي تسعى من جهة لبناء مجتمع التكافل الاجتماعي وبين المجتمع ذي العلاقات الاشتراكية، بين الصراع من أجل مجتمع الرفاه الاجتماعي كل حسب طريقته ومرحلة البناء الجديد والانقلابات التي لم ير فيها المواطن العادي في بلدان العالم الثالث أي تأثير على مستوى حياته وتطور وتفتح شخصيته.. وضعت فترة الستينات المسرح الحديث في غرب أوروبا الذي سعى عن موقع جديد في قتل الاعتيادية في التلقي والطروحات التحررية، بابتكار مضامين وأساليب جديدة تستفز المشاهد وتثير لديه رغبة النزوع إلى مساءلة الواقع والخروج من دائرة التلقي السلبي والخامل لما يدور على خشبة المسرح من خلال ما كتبه صموئيل بيكيت ويوجين يونسكو وما تركه جان بول سارتر..
كانت الستينات تقع، حداً فاصلاً بين دراما ما بعد الحرب ودراما المجتمعات، التي تسعى من جهة لبناء مجتمع التكافل الاجتماعي وبين المجتمع ذي العلاقات الاشتراكية، بين الصراع من أجل مجتمع الرفاه الاجتماعي كل حسب طريقته ومرحلة البناء الجديد والانقلابات التي لم ير فيها المواطن العادي في بلدان العالم الثالث أي تأثير على مستوى حياته وتطور وتفتح شخصيته.. وضعت فترة الستينات المسرح الحديث في غرب أوروبا الذي سعى عن موقع جديد في قتل الاعتيادية في التلقي والطروحات التحررية، بابتكار مضامين وأساليب جديدة تستفز المشاهد وتثير لديه رغبة النزوع إلى مساءلة الواقع والخروج من دائرة التلقي السلبي والخامل لما يدور على خشبة المسرح من خلال ما كتبه صموئيل بيكيت ويوجين يونسكو وما تركه جان بول سارتر..
لهذا تأثر المسرح في هذه الفترة بثلاثة اتجاهات:
- مسرح الدراما ـ العبث لدى بيكيت الذي يعتمد على السخرية والتهريج المبكي والمضحك حيث قدم العالم على المسرح في صورته الذاتية المغلقة.
- ويونسكو الذي أكد على عبث الحياة واللغة التي تتحول الكلمات فيها إلى جثث قاتلة ومعيقة.
- وباتجاه بريخت في مسرحه السياسي النقدي الذي يسعى إلى التغيير الاجتماعي ذي الأبعاد السياسية، والذي تألق فيه مع فرقة مسرح البرلينر انسامبل في باريس ولندن.
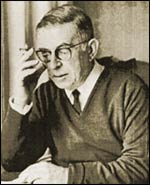 إن كتاب المسرح الحديث بالمسرح الطليعي حاولوا ان يجدوا من خلاله أجوبة على الأسئلة السياسية والاقتصادية التي ترتبت على التغييرات الحاصلة في بنية الحكم والاقتصاد والأيديولوجية.
إن كتاب المسرح الحديث بالمسرح الطليعي حاولوا ان يجدوا من خلاله أجوبة على الأسئلة السياسية والاقتصادية التي ترتبت على التغييرات الحاصلة في بنية الحكم والاقتصاد والأيديولوجية.
لقد فهم الجميع الطليعية في المسرح بمعنى التغيير والثورة بدون التمييز بين التمرد في الشكل أو التمرد على المضمون والمعنى.
كانت اهتمامات المسرحيين في هذه الفترة موزعة بين خيارات عدة، بين ان يمثل المسرح لديهم حالة من حالات التمرد والرفض والتغيير، أو يكون جزءً من أدوات إشاعة القيم والمصالح التي يعبر عنها الفكر السائد بين ان يسهم في حفر الوعي على إدراك مشاكل الفرد الاجتماعية السياسية أو يكتفي بالتفسير الحرفي للنصوص مع استفادته القصوى من الانجازات التقنية الحديثة.
بين ان يكون المسرح فعالا ويمتلك جذوره وخصائصه وبين مسرح يعتمد على الترجمة للنص والفكرة ويتأثر بالمسرح الوهمي، بين مسرح يعتمد على الاحتفالية التي شاعت في المسرح الأوروبي وبين المسرح الواقعي الذي يعنى بالفرد ومعاناته الداخلية وبين مسرح متقدم فنياً وجمالياً وبين مسرح متقدم فنياً وجمالياً وبين مسرح هابط يعمل على خلق التسلية والترفيه.
وتميز المسرح الطليعي بابتعاده عن التناول المباشر للقضايا السياسية والاجتماعية، واختار ان يكون تمرده على مجتمعه من خلال شخصياته السلبية الأسيرة للملل والضجر والمنتظرة بكل معنى العبث، ولكن المسكونة من ناحية ثانية بأحلامها الحارقة في تغيير العالم بأسلوبها وطريقتها الخاصة، من خلال لغة مشحونة بالشاعرية والتأويل والترميز.
وعموماً توجه كتاب المسرح لما بعد الابسينية في المقام الاول للاهتمام بالإنسان المسجون داخل شرنقة ذاته وداخل عالم موحش محاط بالفوضى.
وأتت أعمالهم لتدين الأيديولوجيات والأفكار الشمولية وحاولت تحطيم صرح كل المثاليات التي يعيش الإنسان على وهم تحقيقها، وكانت المواضيع المتنوعة والأساليب الفنية المختلفة هي سمة كتّاب ومسرحييِّ هذه المرحلة الذين حاولوا ان يجربوا جميع الأشكال، ويحطموا الحواجز بين الأساليب، مستفيدين من الوقائع الحية المعاصرة. ومن الأساطير والأعمال الكلاسيكية التي تحاول تسليط الضوء على التاريخ المعاصر من خلال عملية إعادة قراءة التاريخ القديم، وكذلك من الأجناس الأدبية المختلفة مثل القصة والشعر والملحمة من اجل ان يتجاوزا الصيغ الكلاسيكية التقليدية للعمل الدرامي، حيث استثمر المونتاج والتزامنية في الحدث والبناء الملحمي واستغلت وسائل وطرق الاتصال الحديثة من فيلم ووثيقة وسلايد والبحث في الجزء عن الكل لتشتيت الحدث والابتعاد عن السببية، محاولين تقديم نوع من المسرح الذي يعتمد على الواقعية. ومن اجل ان نعطى صورة واضحة عن المسرح المعاصر اخترنا واحداً من أهم المسرحيين المعاصرين، والذي يشكل علامة مهمة من علامات مرحلة ما بعد الابسنية، وهو هاينر ميللر الذي اعتمدنا في عملنا الأخير على أفكار وشخصيات ومواقف من أعماله، والذي أطلقنا عليه اسم (ليلة السكاكين الطويلة بغداد 2003) والذي تعاملنا معه من منطلق الأخذ والإسقاط والتجريب. كاتب استطاع ان يقرأ الواقع كأنه تاريخ.
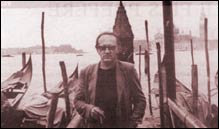 في أيلول الماضي، شارك المخرج العراقي الراحل عوني كرومي، بالندوة الفكرية التي عقدت على هامش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحت العنوان الأساسي "التجريب وتقاليد الكتابة المسرحية".
في أيلول الماضي، شارك المخرج العراقي الراحل عوني كرومي، بالندوة الفكرية التي عقدت على هامش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحت العنوان الأساسي "التجريب وتقاليد الكتابة المسرحية".
واختار ضمن هذا الإطار محوراً بعنوان "كتاب المسرح الحديث والتمرد على التقاليد"، وقدم بحثاً جدياً وعميقاً. أودعه خبرته المسرحية، وثقافته الواسعة، وأفكاره الطليعية.
كانت هذه الندوة آخر ندوات عوني كرومي، وكانت مقاربته هذه آخر المقاربات، قبل أن يرحل، ويخلف وراءه إرثا طليعياً وتجريبياً، في مجموعة من الأعمال المسرحية التي وقعها، وقدمها في عدد من البلدان العربية والأوروبية. ننشر هنا الحلقة الثانية والأخيرة.
هو واحد من أهم كتاب جيله ممن نطلق عليهم كتّاب ما بعد "بريشت". ولد في 9 يناير 1929 في مقاطعة سكسونيا، استفاد كثيراً من الأدب الكلاسيكي مع أنه يعد من أكثر الكتاب تجاوزاً لشكل المسرحية الكلاسيكية، حيث امتاز بلغة فصيحة وبلاغة عالية وأسلوبية منحوتة.
فاللغة عند "هاينر ميللر" تعني الكثير وقد تكون هي صورة الفعل أو ما يمكن أن نسميه بالإيماء اللغوي، هو من جيل طحنته الحرب وجسد مآسيها من خلال التناقضات الاجتماعية، وإن كان شغله الشاغل إعادة بناء ألمانيا، وكان الصراع على أشده بين مختلف المعسكرات والأطراف، فالبعض كان يراهن على قدرته لإعادة الثقة بالإنسان لتحقيق المعجزة الاقتصادية. حيث دخل المجتمع الألماني عهداً لم يتمكن فيه الألمان بعد من استيعاب ماضيهم وهضمه، عاش هذا الجيل الجوع والتشرد والعمل المضني في إعادة البناء المادي والروحي، حاول بطريقة نقدية أن يعالج عقدة الذنب، التي ما زالت حتى يومنا هذا تشكل هاجساً وكابوساً أثقل كاهل مبدعيه وما زالت هذه الصراعات قائمة وتفاقمت بعد سقوط جدار برلين، حيث تساءل الألمان:
"كيف يمكن لنا أن نعيش في زمن فقدت فيه كل الأيدلوجيات مصداقيتها والأفكار الكبيرة بريقها وشاخت الأحلام التي كانت تعدنا بمملكة الحرية، لذا جاءت أعمال "هاينر ميللر" تعبيراً عن ضياع هذه الأحلام من خلال خيبة الأمل من النموذج الاجتماعي الذي لا يعتمد على الإنسان بقدر ما كان فيه الإنسان مستلب الإرادة والقدرة فقد ظهر أمام الإحداث التاريخية والالتزامات الاجتماعية.
لقد سعي "ميللر" أن تكون مسرحياته دعوة إلى الكفاح من أجل تحرير البشر بطريقة إنسانية متحدياً وكاشفاً طبيعة المجتمع الجديد وأزماته، التي هي صورة من أزمات المجتمع الاستهلاكي. فشخصياته عبارة عن أناس محبوسين في متاهات العلاقات وتشعباتها، يعيشون حياة يومية مبتذلة ويجترون فيها أحلامهم الخاوية، شخصيات تعيش مهزلة أبدية، عاجزة عن الكلام، تعيش مواقف اليأس والضياع الذي لا مخرج منه.
لقد حاول أن يسلط الضوء على حقائق المجتمع من خلال إعادة دراسة التاريخ واكتشاف قيمه وتأكيد خصائصه على مستوى الأحداث والنصوص التي أعاد كتابتها. وكان يؤكد دائماً على رفضه لفكرة نهاية التاريخ، ويرى أنه يسير ولا يتوقف عند خاتمة ما، يتحرك وتتحرك معه الأوضاع وتتغير، ولكن هذه الديناميكية تتحرك على محور واحد وثابت، وهو يطلق عليها "بنية التاريخ الأساسية" وهي التكرار المستمر لعالم الظالم والمظلوم، فمسرحية "الموقعة" التي استغرق العمل بها أكثر من عشرين عاماً وبأشكال متعددة إلى أن وصل إلى رؤيته الأخيرة في عرض المسرح الشعبي، هي عبارة عن مشاهد مسرحية حول الحرب العالمية الثانية، وبالذات عن دور النازية في ألمانيا وما أحدثته من دمار وخراب، فهي ليست حكاية واحدة، بل صور وحالات ومواقف تعبر عن القسوة اللاإنسانية التي مارسها النازيون في الحرب مع أنفسهم وضد الآخرين، وعن الازدواجية التي عانت منها النازية كأفراد وكنظام. ولم تتخذ المسرحية الوثائق مادة أساسية لها رغم أنها توثق لفترة زمنية محددة. كان همها الأساسي هو شحذ الوعي بالتاريخ وذلك ليس لأن المسرحية تاريخية، إنما التاريخ يعيد نفسه بأشكال مختلفة، وفي أماكن متعددة وبأساليب متنوعة. وما زالت الفاشية تمثل إلى يومنا هذا تهديداً حقيقياً للإنسان وهنا اختلف "ميللر" مع "بريشت" في معالجة ذات الموضوع، حيث اعتمد "بريشت" على الوثائق في تحليله للنازية والتعريف بها.
لم يتقيد "ميللر" بنوع واحد في أسلوب تقديم العمل المسرحي إنما جرب العديد من الأشكال المسرحية، واستفاد في بداية مسيرته بخصائص المسرح الألماني وفكرة "بريشت" حول المسرح ودوره ووظيفته الاجتماعية والسياسية. وبالرغم من تعدد الأشكال المسرحية التي كتب فيها إلا أنه ظل متميزاً في استعارته واستدلالاته للتاريخ أو النص المسرحي، الذي عمل على إعادة كتابته وصياغته كقراءة جديدة قائمة بذاتها.
بالرغم من أن الإنسان كان يمثل المحور الأساسي في جميع مسرحياته إلا أن أعماله مرت بأكثر من مرحلة:
المرحلة الأولى: مرحلة البناء الاجتماعي، والتي حاول فيها أن يقدم نموذجاً لتفكير الإنسان المبادر المضحي بنفسه من أجل الآخرين، والذي بمقدوره أن يتحاور ويتفاعل نقدياً مع مشروع السلطة، بحيث يقدم الإشكاليات التي يجب أن تعمل السلطة على حلها لصالح الشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة في الحراك الاجتماعي. كما أنه أكد على أن القوانين الاجتماعية تحتاج إلى وعي متقدم يسهم بفعالية في عملية البناء الجديد. لقد فهم، أن الثورة الاجتماعية هي حوار دائم وصيرورة ترفض الثبات والجمود.
المرحلة الثانية: عبارة عن إعادة دراسة التاريخ واكتشاف قيمه وتأكيد خصائصه على مستوى الأحداث أو النصوص التي أعاد كتابتها، وإن كان موقفه من التاريخ لا يخلو من غرابة، فالبرغم من أنه يستخلص منه قوانينه إلا أنه يتخذ في نفس الوقت موقفاً متناقضاً معها.
لقد ظهرت الأحداث في نصوصه مكثفة تكثيفاً عالياً إلى درجة يصل التجريد فيها في بعض الأحيان إلى مجرد رموز وإشارات. لهذا امتازت مسرحياته بقوة تعبيرها وبلغتها التي تقربها من الأعمال الأدبية الخالصة إضافة إلى بعدها الدرامي.
وأهم ما يميز مسرحياته هو دورها الملموس في التحريض والنقد الاجتماعي ونستطيع القول بأنه ساهم في تطوير المسرح السياسي والتحريضي إذ تناول بمسرحياته مواضيع معاصرة مثل بناء الاشتراكية والحياة الجديدة في المجتمع الاشتراكي. كما كتب وأعد مسرحيات، استلهمت موضوعاتها من أحداث الثورة الاشتراكية وتاريخ النضال الثوري والسياسي في العالم، مثل مسرحية "سمنت" و"مبادرات" "وكوميديا النساء" وجميع هذه المسرحيات تتحدث عن أزمات بناء الاشتراكية. وأثارت هذه المسرحيات العديد من النقاشات والتساؤلات والنقد سلباً وإيجاباً، بسبب آرائه الجريئة والواضحة، حيث يعتقد أن من أبرز مهمات المسرح في المجتمع الاشتراكي هو ديمومة الجدل بين السلطة والقاعدة، هذا الجدل الذي يجب أن لا ينقطع وإلا فان تجاهل التناقضات واختلاف الرؤى بين الطرفين راهناً، سيجعلها تظهر في المستقبل بصورة أشد خطراً وأكثر استعصاء على الحل.
إنه يعرض السلبيات بهدف الوصول إلى الإيجاب والموازنة بين الحقوق والواجبات وتجسد مسرحية مبادرات (ضاغط الأجور) أبرز مثال على تناوله هذا حيث جسد فيها أزمة عامل في مجرى دفاعه وصراعه في تثبيت العلاقات الجديدة في المجتمع، حيث كان الفعل الرئيسي والحاسم يكمن بين أفكار الإنسان وسلوكه العملي والتناقض بين ما يراه وما يقال عنه.
وهو في كل هذا يقدم الثورة الاشتراكية في بنائها النظري والتطبيقي الهادي البطيء لكن خلف هذا الهدوء يكمن عنف تكوينها ومسارها الذي يحتدم تحت سطحها، (عنف الصراعات وتناقض المصالح) وكان كما يقول هاينر ميللر عن بحثه هذا أنه يمنح شخصياته أسلوباً تستطيع أن تعبر من خلالها عن علاقاتها بالآخرين فالمسرحية لم تكن قصة شخص واحد مبادر إنما تشكل قصة لمجموعة أشخاص إنها شخصيات تفكر بشكل أصعب مما تستطيع أن تعبر لهذا نجد أن النجاح لا يتحقق بالجهد الذاتي وبالانفصال عن الآخرين إنما بالارتباط بهم.
لقد تمسك هاينر ميللر بالواقعية إلى جانب استلهامه للتراث فالواقعية بالنسبة له تجاوزت الضفاف التي يحددها النظام لذا نراه طوع الأحداث التاريخية الكبيرة لتصبح أحداثاً معاصرة تاريخية.
فمن خلال التاريخية يسلط الضوء على الحياة اليومية المعاصرة، وقد استغل المثيولوجيا الإغريقية كمادة أساسية في العديد من مسرحياته ليعبر من خلالها عن تدهور وسقوط الطبقات المسيطرة أو النظم الشمولية.
كما أنه سلط الضوء على أزمات عصره مجسداً ما يكلفه الكفاح من ضحايا وشهداء في صراع البشرية مع مستغليها.
ماكنة هاملت
أما أهم سمة لمسرحياته الأخيرة وخاصة "الموقعة" و"ماكنة هاملت" فهي العنف والقسوة كيما يشاكس اعتياد الناس على رؤية العالم في المسرح أجمل مما هو عليه في الواقع ولم يجازف أحداً قبله وبمثل هذا الوضوح في عرض مشاهد التعذيب والقسوة على المسرح فهو يريد أن يحدث صدمة لدى المتفرج بحيث تعرض الجروح قبل التئامها ومعالجتها، هذا يعني بالنسبة له عرض الأزمة على حقيقتها بدون رتوش، فهو ينظر إلى وظيفة الدراما ليست كما عند أرسطو في إثارة الخوف والشفقة وإنما في إثارة الخوف والغضب لأنه يعتقد أن أكثر ما يخيف في عصرنا هذا هو التغيير. وهو يؤمن أن مهمة المسرح هي تغيير عقلية المشاهدين وعرض الحقيقة بشكل غير مألوف وغير معروف ومحسوس في الحياة.
إن التمرد على تقليدية الكتابة المسرحية تكمن في التعامل مع النص باعتباره يعبر عن حالات يقف الفرد في داخلها عاجزاً عن الإشارة اليها أنه أي الفرد مندهش ومتحسس في حالة مرغم عليها.
إن مسرحيات هاينر ميللر تعرض حالات وشخوصاً في وضع اعتراضي على استمراريتها تقدم لنا الرعب كأنه مسيرة للتحول من الميلاد إلى الموت كنموذج يدفع إلى التفكير والتساؤل.
كتب هاينر ميللر عن التداخل بين أزمات وفضاءات مختلفة تنتهي في خروج الشخصية من جلدها فلقد حاول أن يقدم نفسه من خلال علاقات متناقضة تتراوح بين الرفض والقبول كان يسعى في محاولات هذه إلى الإفلات من هذا العصر والزمن الصعب، الذي يتربص بالبشرية لأنه يعتقد أن الزمن الذي يعيشه والنظام الذي يتعامل معه هو عبارة عن ماكنة قمعية تشل قدرة الإنسان على مواجهة مصيره بدرجة عالية من الوعي بالذات، ومواجهة التحديات التاريخية.
لذا يحاول هاينر ميللر أن يظهر تمرده من خلال قدرته على التواري في ثنايا النص بحيث يصبح من الصعوبة بمكان وضع اليد عليه من قبل الرقيب.
كانت أعماله التي تعتمد المادة الأدبية التاريخية تغوص في أعماق الظلة السياسية وظلمة الواقع الاجتماعي لقد كانت أعمالاً ترفض الأيديولوجية وتمجد الإنسان وهو القائل:
(لقد أردت أن أكون نفسي، نفسي لا غير إن سيرة حياتي ليست إلا جسوراً تمتد ما بين العصور الجيليدية والمستقبل).
لقد استوعب هاينر موللر الكثير، من التجارب الطليعية ابتداءً ببريشت وانتهاء بجان جينيه إن أهم ما أحدثه ميللر من تغيير على البنية المسرحية هو خروجه على تقاليد الحكاية وجعل النص عبارة عن تشكيلة غير متكاملة، يحتمل الصور والاقتباسات والارتجال وكل ما يساعد على تجسيد موضوعاته. يستخدم هاينر ميللر تكنيك المقاطع الدرامية وينتقل من التقريرية إلى الدرامية ويعتمد فيها على رسم الصور والرؤى المفزعة مستوحاة من الواقع أو من عالم الخيال كالأشباح مثلاً.
المثقف العاجز
حاول ميللر تقديم صورة المثقف العاجز عن مواجهة هذا القمع. وكتب أعمالاً بدت وكأنها تمثل قطيعة مع الفكر التنويري للمسرح الوهمي فجاءت أعماله المسرحية أشكالاً أدبية تتميز بصعوبة كبيرة خلال عملية التجسيد يتداخل في نصوصه وبالذات (ماكنة هاملت) السرد والوصف والحوار الذاتي وتوجيهات الإخراج.
إنه يحاول أن يمزج بين قصيدة النثر والقصة القصيرة وحتى الموسيقى والمسرح الصوري الذي يعتمد على التعبير الجسدي وفي إطار هذا التداخل ينقلنا هاينر ميللر إلى عالمه التمردي بين فضاءات مختلفة تتداخل فيها الحوارات والشخصيات فيما بينها، في محاولة جذرية لنسف أطر المسرح التقليدي كافة وإكراهات القيود الإيديولوجية.
لا يمكن حصر "ميللر" إذن داخل اتجاه فني أو قالب درامي تقليدي، فهو يبتعد ولا يلتقي مع أي شيء ثابت يتخفى تحت الأقنعة واللعب بالألفاظ وتغيير الدوافع، على الرغم من أن الموضوعة واضحة محددة، مما يكسب أعماله ثراء وسحراً، إلا أنه استطاع أن ينشئ عالمه الفني وأن يرسي له قواعد فريدة بعد أن خرج عن طوق التقليد والثوابت والقوالب الجامدة. إن المتابع لأعمال هاينر ميللر سواء بالقراءة أو المشاهدة يجد نفسه في حالة شعورية مزدوجة، فهو ينجذب إلى أعماله وفي الوقت نفسه يجد بينه وبينها حاجزاً فأعماله تقرب وتبعد وتنفر وترعب، ما يوقع الإنسان في حيرة من أمره لكنه يجد نفسه في نهاية المطاف مجبراً على المتابعة.
وفي مسرحيات السبعينات والثمانينات سيطرت عليه فكرة انتقام الضحية من جلاّديها، فحاول رسم أبطال مذنبين أو مصابين بعقدة الإحساس بالذنب الندم وهو ما يعتبر بذرة أعماله الدرامية. لقد حاول دائماً أن يضع مسافة تفصل بينه وبين شخصيته ولا يضع حلاً أو إجابة لأزماته إنما يتركها مع صراعاتها دونما قرار أو نهاية معلقة.
لا توجد في مسرحياته توقعات لنهايات سعيدة إنما يطل منها بصيص خافت من الأمل وهو يعكس طموحاته نحو عالم جديد خال من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان.
يبرر هاينر ميللر سبب تخليه عن العناصر والأشكال الدرامية التقليدية واستخدامه أشكالاً وصوراً غير مألوفة في الدراما بقوله إن العالم لا معقول وغير منطقي فلماذا نلتزم نحن بمعايير العقل والمنطق، لذلك اعتمد على الوصف في إبراز الصورة والتوتر الدرامي ولم يلجأ إلى البناء التقليدي ولم يكتب دراما بالطرق المتعارف عليها. فمسرحه عبارة عن شخصيات محددة وحدث ينمو إلى أن يصل إلى الذروة.
هو يكتب قطعاً مسرحية صغيرة ثم يضفرها معاً بمهارة عالية وبطريقة يتيح بها للمشاهد فرصة الاشتراك في إنتاج العمل.
يعمل على الحفر الدائم داخل ذاته محاولة منه للوصول إلى هويته لا ليؤكدها ويعتزّ بها وإنما كي لا يعود إليها مرة ثانية.
إن حلم هاينر ميللر إلى تغيير العالم لا يتوقف عند الإنسان كفرد وإنما يتخطى ذلك إلى تغيير الكون كله فهو يريد السيطرة على العوالم الثابتة في بنية التاريخ الحافل بالظلم والقهر. إنه يريد أن يخلص العالم من القهر والاستبداد وإذلال النفس البشرية.
وينتقد ميللر ازدواجية الثورة التي قامت من أجل مقاومة الظلم فتحوّلت هي نفسها إلى مصدر للظلم، أن جميع مسرحياته مركّبة ولقد كتبت عبر مراحل مختلفة وبعض أجزاء نصوصه كتبت على مراحل استغرقت ثلاثين عاماً فهو لا يهمه أن يستعير من مادة كتبها في أوقات لا ينتمي إلى زمن الأحداث.
إنه يحاول أن يترجم الفكرة إلى صورة لأنه يعتقد أن الشيء الوحيد الذي يولده الفن هو إيقاظ الشوق إلى وضع مختلف للعالم وهذا الشوق هو مصدر الثورية التي تعتمد عليها الروح المتمردة لأنه يعتقد أنه ما دامت الحرية توازي المساواة والعكس صحيح فهناك ثمة ظروف تجعل من النجاة خيانة للموتى ومن ناحية أخرى سيكون استحسان الموت الذاتي ضرورة سياسية، فالواقع أشد سوءاً ولكن ربما أكثر قدسية بالنسبة للسياسي الواقعي.
إنه يسعى في عروضه لأن يتيح للمشاهد فرصة مراقبة أكبر كمية من الكوارث من دون الإحساس بالثقل أو الانزعاج.
إنه يعتقد أن باستطاعة المرء استشراف الحياة المقبلة من خزائن الماضي لأنه يعتقد أن كل نص جديد يرتبط بعلاقة ما مع كمية من النصوص القديمة، وبمؤلفين آخرين، تتغير النظرة إليهم من خلاله (أي النص الجديد).
إن الصراع التراجيدي يتكوّن من خلال اختراق الزمن للعبة، لأن هاينر ميللر يعتبر المسرح لعبة ذات وقائع وأن اختراق الزمن لهذه اللعبة فربما تنشأ حالة تراجيدية ولكن خلقها ليس ممكناً لأنه يعتقد أن الجمهور أو مشاهدي المسرح يرفضون استساغة المسرح على كونه واقعاً مستقلاً ولا يتصور واقعه المكرر فهو يقف بالضد من المذهب الطبيعي أو الطبيعية لأنه يعتقد أنها كادت أن تقتل المسرح باستراتيجيتها المزدوجة.
أما ما يثير اهتمامه في المسرحيات التعليمية أنها تحمل في داخلها تركيبة تراجيدية تقدم العالم من خلالها وتضعه وسط التساؤلات.
لقد كانت أعمال هاينر ميللر تعلن عن سقوط المعنى وتشتت الهدف وضياع القصد. فهو يعتقد لقد حلّ زمن التراجع عن مسألة تفريغ العالم ولكنه لم يستسلم للموت لأن حياته كانت الشيء الوحيد الذي يمتلكه حقاً.
لقد أراد هاينر ميللر لمسرحه أن يكون مزيجاً من كل الكتّاب المتمردين ابتداء من شكسبير وحتى بريشت وأن يلتحق بهم متمرداً حزيناً متسائلاً يقول: أين ذلك الصباح الذي رأيناه بالأمس؟
لقد قال بيتر بروك عنه: "لقد كان ميللر ينظر إلى العالم وكأنه ينظر إلى أصدقائه، وكانت هذه النظرة مليئة بالسخرية والمرح والتفهم والشفقة، نظرة إنسانية عميقة تكمن قوتها أنها نظرة ستبقى لنا ومعنا".
لقد عكست حياته تناقضات الحياة والتاريخ التي حاول أن تكون مادة إبداعية لأعماله
المستقبل - الخميس 13 تموز 2006