( 1 )
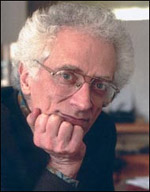 ما هو كلّيّ الحضور غيرُ مدرك. فمع أن تجربة القراءة تعدّ أمراً مألوفاً جداً، إلا أنها مجهولة إلي حد كبير. فالقراءة عملية طبيعية يبدو، للوهلة الأولي، أن ليس ثمة شيء يقال عنها.
ما هو كلّيّ الحضور غيرُ مدرك. فمع أن تجربة القراءة تعدّ أمراً مألوفاً جداً، إلا أنها مجهولة إلي حد كبير. فالقراءة عملية طبيعية يبدو، للوهلة الأولي، أن ليس ثمة شيء يقال عنها.
عُرضَتْ مسألة القراءة، في الدراسات الأدبية، بمنظورين متعارضين. يُعني المنظور الأول بالقراء وتنوّعهم الاجتماعي والتاريخي والجمعي أو الفردي. ويتعلق المنظور الثاني بصورة القارئ كما تمثّلت في نصوص معينة: القارئ بوصفه شخصية character أو بوصفه مرويّاً عليه . وبأيّ حال، هناك منطقة غير مستكشفة تقع بين المنظورين: إنها ميدان منطق القراءة. وعلي الرغم من أنه غير متمثّل في النص، فإنه مع ذلك سابق علي التنوّع الفردي.
ثمة بضعة أنماط من القراءة. وسأتوقّف هنا لمناقشة أحد أكثر الأنماط أهمية: وهو النمط الذي نمارسه، عادة، حينما نقرأ رواية كلاسيكية أو بالأحري ما سمّيَ بالنصوص التمثيلية. إن هذا النمط الخاص من القراءة، وهذا النمط حسب، هو الذي يتجلي بناءً.
علي الرغم من أننا لم نعد نعزو الأدب إلي المحاكاة، فإننا ما زلنا نعاني من مشكلة التخلّص من طريقة معينة في النظر إلي العمل التخييلي، طريقة متأصّلة في عادات كلامنا، إنها رؤية ندرك من خلالها الرواية بموجب التمثيل، أو نقل الواقع الذي يسبقها. سيكون هذا الموقف موقفاً إشكالياً حتي إذا لم يحاول أن يصف العملية الإبداعية. وحين يشير إلي النص نفسه، فإن إشارته مجرد تحريف. إن ما يوجد، أولاً وبشكل أساسي، هو النص نفسه، وليس ثمة إلاّ النص. إننا نبني، من خلال قراءتنا، عالماً متخيلاً عن طريق إخضاع النص إلي نمط محدد من القراءة. إن الروايات لا تحاكي الواقع، إنها تبدعه. وصيغة ما قبل الرومانسيين ليست ابتكاراً مصطلحياً بسيطاً، ويتيح لنا منظور البناء وحده أن نفهم علي نحو تام كيف يؤدي ما سمّيَ بالنص التمثيلي وظيفته.
وعند توفّر الإطار الذي نسعي إلي تحقيقه، يمكن لمسألة القراءة أن تُقرَّرَ علي النحو الآتي: كيف يجعلنا نصٌّ ما نبني عالماً متخيلاً؟ وأيُّ جانب من النص يحدد البناء الذي ننتجه حين نقرأ؟ وبأية طريقة ننتجه؟ فلنبدأْ بالقضايا الأساسية.
الخطاب المرجعي
إن الجمل المرجعية فقط هي التي تتيح للبناء أن يتحقق، وبأيّ حال، ليست الجمل كلها مرجعية. إن هذه الحقيقة معروفة لدي اللسانيين والمناطقة، ونحن لا نحتاج إلي أن نتمعّن فيها.
إن الاستيعاب عملية تختلف عن البناء. خذْ مثلاً الجملتين الآتيتين من رواية أدولف Adolphe: عرتُ أنها كانت أفضلَ منّي، وازدريتُ نفسي لكوني غيرَ جدير بها. وإنه لسوء حظٍّ فظيع ألاّ نكون محبوبين حينما نحبّ، والأدهي من ذلك أن يحبَّنا شخصٌ ما من الأعماق، في حين أننا لن نعد نحبّه .
Je la sentais meilleure que moi, je me mژprisais d'گtre indigne d'elle. C'est un affreux malheur que n'گtre aimژ quand on aime; mais ce n'est un bien grand d'گtre aimژ avec passion quand on n'aime plus.
إن الجملة الأولي جملة مرجعية: فهي تثير حدثاً (مشاعر أدولف)، والجملة الثانية جملة غير مرجعية، فهي حكمة. وتعيّن المؤشرات القواعدية الاختلاف بين الجملتين: تستدعي الحكمة صيغة المضارع للغائب، ولا تتضمن تكرار الصدارة ? anaphora (كلمات تشير إلي أجزاء سابقة من الخطاب نفسه).
إن الجملة أما أن تكون مرجعية أو غير مرجعية، وليس ثمة مستويات متوسطة بينهما. وعلي أية حال، فإن الكلمات التي تؤلف جملة ما ليست متشابهة كلها بهذا الصدد، ويعتمد ذلك علي الاختيار المعجمي، وستكون النتائج مختلفة جداً. ثمة تقابلان مستقلان يبدوان مهمين هنا: الأول العاطفي مقابل غير العاطفي، والثاني الخاص مقابل العام. فعلي سبيل المثال، يشير أدولف إلي ماضيه كونه au milieu d'une vie trs dissipژe وسط حياة مزعزعة جداً. تثير هذه الملاحظة أحداثاً ممكنة الإدراك، ولكن بطريقة عامة إلي حد بعيد. يمكن للمرء أن يتخيل، بسهولة، مئات من الصفحات تصف هذه الحقيقة نفسها. في حين، في الجملة الأخري:
إنني أجد في أبي أنه ليس رقيباً عليَّ، وإنما هو مجرد ملاحظ بارد ولاذع، يبتسم أولاً بعطف، وسرعان ما ينهي المحادثة بصبر نافد .
Je trouvais dans mon pre, non pas un censeur, mais un observateur froid et caustique, qui souriait d'abord de pitiژ, et qui finissait bient™t la conversation avec impatience,
عندنا هنا قِرانٌ للحوادث العاطفية بمقابل الحوادث غير العاطفية: ابتسامة، لحظة صمت، وهما واقعتان قابلتان للملاحظة، عطف ونفاد صبر وهما افتراضان (مسوَّغان، ولا شك) حول فورة مشاعر يمتنع علينا ملاحظتها مباشرة.
وعلي نحو اعتيادي، سيتضمّن النص التخييلي أمثلة من سجلات الكلام كلها، (برغم أننا نعلم أن توزيعها يختلف طبقاً لحقبة الفكر ومدارسه، أو حتي بوصفه وظيفة لتنظيم النص الشامل). إننا لم نذكر الجمل غير المرجعية في نمط القراءة الذي أسمّيه القراءة بناءً (فالجمل غير المرجعية تعود إلي نمط آخر من القراءة). وتفضي الجمل المرجعية إلي أنماط مختلفة من البناء تعتمد علي درجة عموميتها وعلي عاطفية الحوادث التي تثيرها.
المرشحات السردية
إن مزايا الخطاب المذكورة حتي هذه النقطة يمكن أن تتعيّن خارج أيّ سياق: إنها ملازمة للجمل نفسها. إلاّ أننا، في القراءة، نقرأ النصوص إجمالاً وليس الجمل حسب. وإذا ما قارنّا الجمل من وجهة نظر العالم الخيالي الذي تساعد في بنائه، فإننا نجد أنها تختلف ببضع طرائق أو بالأحري تختلف طبقاً لبضعة مقاييس. وفي التحليل السردي، من المتفق عليه الاحتفاظ بثلاثة مقاييس: (1) الزمن، (2) وجهة النظر، (3) الصيغة.
ونقف هنا، مرة ثانية، علي أرضية مألوفة نسبياً (أرضية كنتُ قد عُنيتُ بها سابقاً في كتابي الشعرية) والآن فإنها ببساطة مسألة النظر إلي المشكلات من وجهة نظر القراءة.
1 ــ الصيغة: إن الخطاب المباشر هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الاختلافات بين الخطاب السردي والعالم الذي يثيره: فالكلمات مطابقة للكلمات، والبناء مباشر وفوري.
وهذه ليست هي حالة الأحداث غير اللفظية، ولا حالة الخطاب المتحوّل. ومن جهة معينة، فإن "المحرر" في رواية أدولف يقرّر:
إن مضيِّفنا الذي كان يتحادث مع خادم من نابوليّ، يخدم ذلك الأجنبي [أي، أدولف] من دون معرفة اسمه، أخبرني أنه لم يسافر بدافع حبِّ الفضول علي الإطلاق. إذ أنه لم يزر الأطلال، ولا المواقع الطبيعية، ولا الآثار الباقية، ولا الرجال من أتباعه .
Notre h™te, qui avait causژ avec un domestique napolitain, qui servait cet ژtranger [i. e., Adolphe] sans savoir son nom, me dit qu'il ne voyageait point par curiositژ, car il ne visitait ni les ruines, ni les sites, ni les monuments, ni les hommes".
يمكننا أن نتخيل المحادثة بين المحرر ـ الراوي والمضيّف حتي لو كان من المستبعد أن الأول يستخدم كلمات (لتكنْ باللغة الإيطالية) مطابقة لتلك الكلمات التي تعقب صيغة (أخبرني أنه). إن بناء المحادثة بين المضيّف والخادم، الذي كان مستثاراً كذلك، غير محدد إلي حد بعيد، وهكذا فإن لدينا حرية كبيرة إذا ما أردنا أن نبنيَه بالتفصيل. أخيراً فإن المحادثات والفعاليات الأخري التي يشترك فيها أدولف والخادم غامضة تماماً، وليس ثمة شيء غير صورة غامضة.
يمكن أن تُعدَّ أيضاً ملاحظات الراوي الخيالية خطاباً مباشراً، علي الرغم من كونها علي مستوي مختلف (عالٍ). هذه هي الحالة بشكل خاص إذا ما كان الراوي ممثَّلاً في النص كما في رواية أدولف. والحكمة التي استثنيناها، من قبل، من القراءة بوصفها بناء، تصبح مهمة هنا، ليس لقيمتها بوصفها ملفوظاً ژnoncژ (أي، عبارة) ولكن بوصفها تلفّظاً ژnonciation (أي قولاً يتضمن متكلماً وظروفه). إن حقيقة أن أدولف كونه راوياً يصوغ حكمة في شقاء الكائن المحبوب تخبرنا شيئاً ما حول شخصيته، ومن ثمّ تخبرنا شيئاً ما حول العالم الخيالي الذي هو جزء منه.
2 ــ الزمـن: إن زمن العالم التخييلي (زمن القصة ) مرتّب كرونولوجياً. وبأي حال، فإن الجمل في النص لا تحترم هذا الترتيب مطلقاً، ولا يمكنها ذلك من ناحية قواعدية، ولذلك فإن القارئ يتولي، من دون وعي، مهمة إعادة الترتيب كرونولوجياً. وعلي نحو مشابه، تثير جمل معينة بضعة أحداث متمايزة مع أنها متشابهةً (السرد المتكرر)، ففي هذه الجمل نعيد تأسيس تعدد الأحداث عندما نبنيها.
3 ــ وجهة النظر: إن رؤيتـنا للأحداث التي يثيرها النص تحدد عملنا في البناء. وعلي سبيل المثال، وفي حالة الرؤية المنحرفة تماماً، فإننا نأخذ بنظر الاعتبار:
- الحدث المروي،
- موقف الشخص الذي يري الحدث.
وعلاوة علي ذلك، نحن نعرف كيفية التمييز بين المعلومات التي تقدمها جملة ما وتتعلق بموضوعها، والمعلومات التي تقدمها الجملة وتتعلق بالذات التي تتكلم فيها، وهكذا يمكن لمحرر أدولف أن يفكر في الأخيرة حسب، كما في تعليقه علي القصة التي قرأناها:
أنا أكره ذلك الغرور المشغول، فقط، برواية الشرّ الذي ارتكبه، الغرور الذي يمتلك الإدعاء بأنه يوحي بالعطف والمغفرة حينما يصف نفسه، الذي يحوم بدَعَةٍ فوق الأطلال، ويحلل نفسه بدلاً من أن يطلب المغفرة .
Je hais cette vanitژ qui s'occupe d'elle-mگme en racontant le mal qu'elle a fait, qui a la pretژntion de sa faire plaindre en se dژcrivant, et qui, planant indestructible au milieu des ruines, s'analyse au lieu de se repentir.
يبني المحرر الذات الراوية (الراوي أدولف)، ولا يبني موضوع السرد (الشخصية أدولف، وإلينور).
نحن،عادة، لا ندرك كيف تكون القصة مكررة، أو بالأحري، كيف تكون القصة مسهبة، ويمكننا، في الواقع، أن نقرر، تقريباً وعلي نحو قاطع، أن كلَّ حدث يروي مرتين في الأقل. وفي أغلب الحالات، تعدّل المرشحاتُ المذكورة في أعلاه هذه التكرارات: فمن وجهة معينة يمكن للمحادثة أن يعاد إنتاجها كلها، ومن وجهة أخري، يمكن أن يشار إليها بإيجاز، ويمكن للفعل أن يلاحَظ من بضع وجهات نظر مختلفة، ويمكن أن يُروي في المستقبل وفي الحاضر وفي الماضي. وفضلاً عن ذلك، يمكن لكل هذه المقاييس أن تتحد معاً.
يؤدي التكرار دوراً مهماً في عملية البناء. ويتعين علينا أن نبني حدثاً واحداً من أوصاف عدة له. تتنوع العلاقة بين هذه الأوصاف المختلفة، مطوِّفةً من الاتفاق التام إلي التضاد الصريح. وحتي أن وصفين متطابقين لا ينتجان، ضرورة، المعني نفسه (ينظر مثال ملائم لهذه الحالة في فلم كوبولا (مخرج أمريكي شهير) المحادثة The Conversation). إن وظائف هذه التكرارات تتنوع بشكل متساوٍ: إنها تساعد علي تثبيت الوقائع كما في التحري البوليسي، أو إنها تساعد في دحض الوقائع. وفي رواية أدولف، فإن حقيقة أن الشخصية نفسها تعبّر عن نظرات متضادة حول الموضوع نفسه وبزمنين مختلفين يكونان قريبين من بعضهما بعضاً، إن هذه الحقيقة تساعدنا علي فهم أن حالات الذهن لا توجد في ذاتها ولذاتها، بل توجد، بالأحري، في العلاقة بالمحاوِر والمشارك. وقد عبّر كونستان نفسه عن قانون هذا العالم بالطريقة الآتية:
إن الموضوع الذي يهرب منّا مختلف، ضرورةً، عن الموضوع الذي يلاحقنا .
L'objet qui nous ژchappe est nژcessairement tout diffژrent de celui qui nous poursuit.
لذلك، إذا ما تعيّن علي القارئ أن يبني عالماً متخيلاً من خلال قراءته النصَّ، فإن علي النص نفسه أن يكون نصاً مرجعياً، وفي أثناء القراءة، ندع خيالنا يشتغل ويرشح المعلومات التي نتسلّمها من خلال أنماط الأسئلة الآتية:
- إلي أيِّ مديً يكون وصف هذا العالم صحيحاً (الصيغة)؟
- متي تقع الأحداث (زمن)؟
- إلي أيِّ مديً تحرّف مراكزُ الوعي المختلفة القصةَ من خلال الأشخاص الذين تُروي عليهم (الرؤية)؟
وبأيّ حال من الأحوال، وفي هذه النقطة فقط يبدأ عمل القراءة.
التدليل والترميز
كيف نعرف ما يحدث حين نقرأ؟ من خلال الاستبطان، وإذا أردنا أن نؤكد انطباعاتنا الخاصة، يمكننا دائماً أن نلجأ إلي أوصاف قراء آخرين لقراءتهم الخاصة. ورغم ذلك، فلن يكون وصفان للنص نفسه متطابقين. فكيف نفسّر هذا التنوّع؟ من خلال حقيقة أن هذه الأوصاف لا تصف عالم الكتاب نفسه، بل تصف هذا العالم كما تحوّله نفسية كل قارئ. يمكن أن ترسَم درجات هذا التحويل علي النحو الآتي:
- وصف المؤلف
- العالم الخيالي الذي يثيره المؤلف
- العالم الخيالي الذي يبنيه القارئ
- وصف القارئ
ويمكننا أن نتساءل عمّا إذا كان، حقيقة، ثمة اختلاف بين الدرجة (2) والدرجة (3)، كما هو ممثّل في التخطيط. فهل ثمة شيء لا يمثّل بناءً فردياً؟ ومن السهل تبيُّن أن الإجابة ينبغي أن تكون إيجابية. وكل شخص يقرأ رواية أدولف يعرف أن إلينور عاشت أولاً مع Comte de Pxxx، التي تركته وذهبت لتعيش مع أدولف، لقد انفصلا، وفي ما بعد التحقت به في باريس، إلخ.... ومن جهة أخري، ليست ثمة طريقة للتثبّت، وباليقين نفسه، من كون أدولف ضعيفاً أم أنه مجرد رجل صادق.
إن السبب في هذه الثنائية هو أن النص يثير الوقائع طبقاً لصيغتين مختلفتين، سأسميهما طريقة التدليل وطريقة الترميز. تدلّ الكلمات في النص علي رحلة إلينور إلي باريس، وترمّز عوامل أخري في العالم الخيالي ضعفَ أدولف المطلق ، وتلك العوامل نفسها تدلّ عليها الكلمات. فعلي سبيل المثال، فإن عجز أدولف عن أن يصون إلينور في المواقف الاجتماعية إنما هو عجز دالٌّ، وهذا في الواقع يرمّز لعجزه عن الحب.
إن الوقائع المدلول عليها تـُفهم: وكل ما نحتاج إليه هو معرفة اللغة التي يُكتب بها النص. والوقائع المُرمَّزة تؤَوَّل، وتختلف التأويلات من شخص لآخر.
ونتيجة لذلك، فإن العلاقة بين الدرجة (2) والدرجة (3)، كما هي موضحة في أعلاه، هي علاقة الترميز (في حين أن العلاقة بين الدرجة1 والدرجة2 ، أو العلاقة بين الدرجة3 والدرجة4 هي علاقة التدليل). وعلي أية حال، فنحن لا نعني بالعلاقة الفريدة أو الفذة، بل نعني، بدلاً من ذلك، بمجموعة من العلاقات المتغايرة الخواص. أولاً، عندما نقرأ فنحن نمارس الاختزال دائماً: فالدرجة (4) هي دائماً (تقريباً) أقصر من الدرجة (1)، في حين تكون الدرجة (2) أغني من الدرجة (3). ثانياً، نحن غالباً ما نرتكب أخطاء. وفي كلتا الحالتين، تفضي دراسة العلاقة بين الدرجة (2) والدرجة (3) إلي إسقاط نفسي:
فالتحويلات تخبرنا عن الذات القارئة. فلماذا يتذكّر الشخص (أو حتي يضيف) وقائع معينة ولا يتذكّر غيرها؟ ولكن ثمة تحويلات أخري تمدّنا بالمعلومات عن عملية القراءة نفسها، وهذه هي التحويلات التي ستكون محطَّ عنايتنا الرئيسة هنا.
من العسير عليَّ القول عما إذا كان الوضع الذي ألاحظه في أغلب الأنواع المختلفة من فن القصة إنه وضع عام، أو إنه محتوم تاريخياً وثقافياً. وبرغم ذلك، فمن الحقّ القول إن في كل حالة من الحالات يتضمن الترميزُ والتأويلُ (الحركة من الدرجة 2 إلي الدرجة 3) تحديداً للفعل. فهل تستدعي قراءة نصوص أخري، قصائد غنائية lyrical علي سبيل المثال، جهداً ترميزياً مبنياً علي فرضيات مسبّقة أخري (علي سبيل المثال تشابه عام)؟ لا أعرف، وهذه الحقيقة تبقي ذلك في فن القصة، فالترميز يبني علي إقرارٍ، أما صريحٍ أو ضمنيٍ، بمبدأ السببية. ولذلك، فالأسئلة التي نوجّهها للأحداث التي تكوّن الصورة الذهنية للدرجة (2) هي كالآتي: ما سببها؟ وما تأثيرها؟ ومن ثمّ، نضيف أجوبتها إلي الصورة الذهنية التي تكوّن الدرجة (3).
لِنسلّمْ بأن هذه الحتمية هي حتمية كلية، وما هو غير كليّ، بالتأكيد، هو الشكل الذي تتخذه في حالة معينة. ويكمن الشكل الأسهل، برغم أننا نادراً ما نجده في ثقافتنا بوصفها معياراً للقراءة، في بناء حقيقة أخري من النمط نفسه. وربما يقول قارئ لنفسه: "إذا ما قام جون بقتل بيتر (واقعة موجودة في القصة)، فلأنّ بيتر نام مع زوجة جون (واقعة غير موجودة في القصة)". إن هذا النمط من التعليل، وطبيعة إجراءات قاعة المحكمة غير مطبقة، جدياً، علي الرواية، ونحن نفترض بأن المؤلف لا يخدعنا، وأنه يزودنا (يدلنا) بجميع المعلومات التي نحتاجها لفهم القصة (تكون رواية أرمانس استثناء). والشيء نفسه صحيح حين تنصبُّ العناية بالتأثيرات وبما بعد التأثيرات: كتب عديدة هي تتمات لكتب أخري، وتطلعنا علي نتائج الأحداث في العالم الخيالي الممثَّل في النص الأول، وبرغم ذلك، فإن مضمون الكتاب الثاني لا يُعدّ، علي العموم، ملازماً للأول. وهنا مرة ثانية، تختلف ممارسات القراءة عن العادات اليومية.
حين نقرأ، نحن نشيّد أبنيتنا عادة علي نوع آخر من أنواع المنطق السببي، فنحن نبحث عن الأسباب والنتائج لحدث معين في مكان آخر، وفي عناصر لا تشبه الحدث نفسه. ثمة نمطان من البناء السببي مألوفان جداً (كما لاحظ أرسطو من قبل): يدرك الحدث بوصفه نتيجة (و/أو سبباً) أما لسمة ذاتية أو لقانون موضوعي أو كلي. وتتضمن رواية أدولف أمثلة هائلة لكلا النمطين من التأويل، وهما مندمجان في النص نفسه.
وهاهنا قطعة تبيّن كيفية وصف أدولف لأبيه:
لا أتذكر، خلال السنوات الثماني عشرة الأولي من حياتي، أنني عقدتُ محادثة معه... ولم أكن أعرف، في ذلك الحين، ماذا كان يعني التهيّب .
Je hais cette vanitژ qui s'occupe d'elle-mگme en racontant le mal qu'elle a fait, qui a la pretژntion de sa faire plaindre en se dژcrivant, et qui, planant indestructible au milieu des ruines, s'analyse au lieu de se repentir.
تدلّ الجملة الأولي علي واقعة ما (غياب طول المحادثات). وتجعلنا الجملة الثانية نتأمل هذه الواقعة بوصفها واقعة رمزية لسمة ذاتية، وهي التهيّب: إذا تصرّف الأب بهذه الطريقة، فلأنه هيّاب. فالسمة الذاتية هي سبب الفعل. وهاهنا قطعة للحالة الثانية:
لقد ناجيتُ نفسي بأنه لا يلزم أن أكون متسرعاً في شيء، إذ أن إلينور لم تكن متهيّئةً بصورة كافية للاعتراف الذي كنتُ أخطط له، وكان من الأفضل الانتظار لمدة أطول. والراجح أننا، علي الدوام ومن أجل العيش بسلام مع ذواتنا، نخفي جوانب الضعف والعجز الجنسي تحت زيِّ الحسابات والأنظمة: وهذا ما يرضي جانباً من أنفسنا الذي هو، إذا جاز القول، المتفرّج علي الجانب الآخر .
Je me dis qu'il ne fallait rien prژcipiter, qu' Ellژnore ژtait trop peu prژparژe ˆ l'aveu que je mژditais, et qu ilvalait mieux attendre encore. Presque toujours, pour vivre en repos avec nous-mگmes, nous travestissons en calculs et en systڈmes nos impuissances ou nos faiblsses: cela satisfait cette portion de nous qui est, pour ainsi dire, spectatrice de l'autre.
وهنا تصف الجملة الأولي الحدث، وتقدم الجملة الثانية السبب: أي قانوناً كلياً للسلوك الإنساني، وليس سمة ذاتية فردية. ويمكن أن نضيف أن هذا النمط الثاني من السببية هو النمط المهيمن في رواية أدولف: إن الرواية تبيّن قوانين نفسية وليس حالات نفسية فردية.
بعد أن نبني الأحداث التي تؤلف قصة ما، نبدأ بمهمة إعادة التأويل. ولا يمكّننا هذا الإجراء من بناء "هويات" الشخصيات حسب، وإنما يمكّننا من بناء النظام الأساسي من القيم والأفكار في الرواية. وإعادة تأويل هذا النمط ليس أمراً اعتباطياً، إذ تتحكم به سلسلتان من التقييدات، تكون السلسلة الأولي منهما متضمَّنة في النص نفسه: فلا يحتاج المؤلف إلاّ إلي أن ينتهز بضع لحظات ليعلّمنا كيف نؤول الأحداث التي أثارها. وهذه هي حالة الفقرات التي استشهدنا بها أولاً من رواية أدولف: حالما كوّن كونستان بضعة تأويلات ذات طابع حتمي، أمكنه أن يمتنع عن ذكر سبب الحوادث المتلاحقة، فنحن تعلّمنا درسه، وسنستمر بالتأويل بالطريقة التي علّمنا إياها. إن لمثل هذه التأويلات الجلية وظيفة مزدوجة: فمن جهة أولي، تخبرنا بالسبب الذي يختفي وراء واقعة معينة (وظيفة تفسيرية)، ومن جهة ثانية، تدخلنا في النظام التأويلي الخاص بالمؤلف، ذلك النظام الذي سوف يشتغل خلال مجري النص (وظيفة تفسيرية واصفة).
وتنجم سلسلة التقييدات الثانية عن السياق الثقافي. فإذا قرأنا أن فلاناً قطّع زوجته إرباً إرباً، فإننا لا نحتاج إلي إشارات نصية كي نستنتج أن هذا الصنيع هو صنيع وحشي حقيقة. وهذه التقييدات الثقافية، التي هي ليست إلاّ أشياء مألوفة في المجتمع ("مجموعة" من الأشياء الكامنة فيه)، تتغيّر مع الزمن. وتتيح لنا هذه التغيرات أن نستجلي سبب اختلاف التأويلات من حقبة إلي أخري. فعلي سبيل المثال، مادامت ممارسة الحبّ غير الشرعية لم تعد دليلاً علي الفساد الأخلاقي، فإننا نواجه مشكلة في فهم الإدانات التي يوصَم بها عدد كبير من بطلات الرواية في الماضي.
إن الشخصية الإنسانية والأفكار هي كيانات تترمّز من خلال الفعل، ولكن يمكن أن يُدلَّ عنها أيضاً. ولقد كانت هذه، بدقة، هي الحالة في الفقرات التي اقتُبستْ من قبلُ من رواية أدولف: فالفعل يرمّز الخجل عند والد أدولف: وعلي أية حال، عبّر أدولف في ما بعد عن الشيء نفسه بقوله: كان أبي خجولاً، وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للحكمة العامة. وهكذا يمكن للشخصية الإنسانية والأفكار أن تثار بطريقتين: طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. وسيقارن القارئ، في أثناء بنائه، الأجزاء المختلفة من المعلومات المتحصَّل عليها من كل مصدر، وسيجد أنها أما متماثلة أو غير متماثلة. ويختلف الانسجام النسبي لهذين النمطين من المعلومات اختلافاً كبيراً خلال مجري التاريخ الأدبي، ومن نافل القول إن همنغواي لم يكتب مثل كونستان.
وعلي أية حال، يتعيّن علينا أن نميز بين الشخصية الإنسانية المبنية بهذه الطريقة والشخصيات في رواية معينة: وإذا جاز التعبير، ليست لكل شخصيةٍ شخصيةٌ. فالشخصية الروائية جزء من العالم الزمكاني المتمثل في النص حسب، فهو/هي يبدو للعيان في اللحظة التي تظهر فيها الأشكال اللغوية المرجعية (أسماء العلَم proper names، والتركيب الاسمي nominal syntagm، والضمائر الشخصية personel pronouns) في النص بخصوص الوجود المجسّم. وليس للشخصية الروائية مضمون في حد ذاتها: فالشخص يعرَّف من دون أن يوصف. إذ يمكننا أن نتخيل نصوصاً ـ وهي موجودة فعلاً ـ حيث تكون فيها الشخصية الروائية محدودة إلي هذا الحد: وجود فاعل لسلسلة من الأفعال. ولكن، حالما تظهر الحتمية النفسية في النص، تصبح الشخصية الروائية موقوفةً علي الشخصية، فهو يفعل بطريقة معينة، لأنه خجول، وضعيف، وشجاع... الخ. ولا توجد الشخصية بهذا الشكل إلاّ وتسري عليها حتميةٌ من هذا النمط.
إن بناء الشخصية هو تسوية بين الاختلاف والتكرار. فمن جهة أولي، ينبغي أن تكون لنا متواصلية: إذ يجب علي القارئ أن يبني الشخصية نفسها. وتعطي هذه المتواصلية سلفاً في هوية اسم العلم، فهي وظيفته الأساسية. وفي هذه النقطة، يصبح أيٌّ (أو كلٌّ) من التأليفات ممكن: إذ ربما تبيّن كل الأفعال سمة الشخصية نفسها، أو ربما يكون سلوك شخصية معينة سلوكاً متناقضاً، أو ربما يغيّر ظروف حياته، أو قد يخضع إلي تحوير أساسي في الشخصية... وثمة أمثلة كثيرة جداً ليس من الضروري ذكرها. وهنا مرة أخري، تكون الاختيارات مؤشراً علي تاريخ الأساليب أكثر مما هي مؤشر علي طبائع المؤلفين.
إذن يمكن للشخصية أن تكون نتيجةً من نتائج القراءة، فهناك نوع من القراءة يمكن أن يخضع له كل نص. ولكن في الواقع، إن هذه النتيجة ليست اعتباطيةً. فليس من قبيل المصادفة أن تكون شخصية موجودة في رواية من القرن الثامن عشر ورواية من القرن التاسع عشر، ولكن غير موجودة في المأساة الإغريقية أو الحكاية الشعبية. فالنص يتضمّن، علي الدوام، اتجاهات استهلاكه الخاص.
البناء موضوعةً:
تنجم إحدي الصعوبات في دراسة القراءة عن حقيقة أن القراءة عسيرة جداً علي الملاحظة: فالاستبطان ملتبس، والبحث الاجتماعي ـ النفسي مضجر. وبناء علي ذلك، نجد، بشيء من الوضوح، عمل البناء ممثَّلاً في العمل التخييلي نفسه، وهو المكان الملائم جداً للدراسة.
يبدو البناء موضوعة في العمل التخييلي، لأنه من المستحيل الإشارةُ إلي الحياة الإنسانية من دون التنويه بهذه الفعالية الأساسية. فكل شخصية يجب أن تبني، استناداً إلي المعلومات التي تتسلّمها، الوقائع والشخصيات التي تدور حولها، وهكذا فهي تماثل، علي نحو دقيق، القارئ الذي يبني العالم الخيالي بمعلوماته الخاصة (النص، وإحساس الشخصية بما هو محتمل)، وهكذا تصبح القراءة (علي نحو محتوم) موضوعة من موضوعات الكتاب.
وعلي أية حال، يمكن لموضوعاتية thematics القراءة أن تكون مؤكدة تقريباً، ومستثمرة كذلك بوصفها تقنية في نص معين. وفي رواية أدولف، تكون هذه الحالة موجودة بشكل جزئي: فما يُؤكَّد عليه في هذه الرواية هو حالة ترددية الفعل الأخلاقية حسب. فإذا ما رغبنا في استخدام العمل التخييلي لدراسة البناء، يجب أن نختار نصاً يظهر البناء فيه موضوعة من الموضوعات الأساسية. ورواية ستاندال المعنونة أرمانس مثال ممتاز علي ذلك.
وفي الواقع، تخضع الحُبكة الداخلية للرواية للبحث في المعرفة. فبناء أوكتاف الخطأ يؤدي وظيفة نقطة انطلاق الرواية: فاستناداً إلي سلوك أرمانس (تأويل يستنتج سمة شخصية من فعل ما)، يعتقد أوكتاف بأن أرمانس مولعة بالمال. وتتوطّد إساءة الفهم الأولية هذه، علي نحو واضح، حينما تُتبَعُ بإساءة فهم ثانية، متساوقةً مع ما يعاكس إساءة الفهم الأولي: فأرمانس تعتقد الآن بأن أوكتاف مولع بالمال ولعاً شديداً. ويؤسس هذا الخلاف الأولي نموذج الأبنية التي سترد. وفي ما بعد، تبني أرمانس مشاعرها نحو أوكتاف بشكل لائق، ولكن الأمر يستغرق من أوكتاف عشرة فصول قبل أن يكتشف أن مشاعره من أرمانس تدعي حباً، وليس صداقة. وعلي مدي خمسة فصول، تعتقد أرمانس بأن أوكتاف لا يحبها، ويعتقد أوكتاف بأن أرمانس لا تحبه طيلة الفصول الخمسة عشر الأساسية من الكتاب، وتتكرر إساءة الفهم نفسها باتجاه نهاية الرواية. والشخصيتان تقضيان وقتهما كله بحثاً عن الحقيقة، وبكلمات أخر، تقضيان وقتهما في بناء الوقائع والأحداث حولهما. وليست العُنّةُ هي السبب في النهاية المأساوية لعلاقة الحب كما يقال غالباً، بل السبب هو الجهل. فأوكتاف ينتحر بسبب بناء خطأ: إذ يعتقد بأن أرمانس لم تعد تحبه. وكما قال ستندال بإيحاء:
إنه يفتقر إلي القدرة علي الفهم الثاقب وليس إلي الشخصية .
ولعلنا ندرك من هذا الموجز أنه يمكن أن تتباين بضعة جوانب من عملية البناء. ويمكن أن يكون أحدها إما فاعلاً أو ضحية، وإما مرسلاً للمعلومات أو متلقياً لها، بل حتي يمكن أن يكون أحدها كليهما. وأوكتاف فاعل حين يدّعي أو يبوح، وضحية حين يتعلم أو يخطئ. ومن الممكن، كذلك، بناء واقعة ما (بناء المستوي الأول )، بناء آخر لشخص ما يبني تلك الواقعة نفسها (بناء المستوي الثاني ). وهكذا ترفض أرمانس فكرة الزواج من أوكتاف حينما تفكر في ما يمكن أن يظنه الآخرون عنها:
إن العالم سيعدّني مرافقاً لسيدة أغرت طفل البيت. ويمكنني أن أستمع إلي ما تقوله دوقة أنكر، أو حتي أكثر النساء احتراماً مثل الماركيزة سيسين التي تري في أوكتاف زوجاً لإحدي بناتها .
وبالطريقة نفسها يرفض أوكتاف فكرة الانتحار حينما يتخيل إمكانية أبنية الآخرين عنه:
عندما أقتل نفسي، تتعرض أرمانس للشبهة. وسيقضي الناس أسبوعاً في تقصّي أدقِّ ظروف هذا المساء، وكل واحد من هؤلاء السادة الذين كانوا حاضرين سيكون مفوَّضاً بإعطاء وصف مختلف لما حدث .
إن ما تعلّمناه في رواية أرمانس، قبل كل شيء، هو حقيقة أنه يمكن للبناء أما أن يكون صحيحاً أو خطأ، وإذا كانت جميع الأبنية الصحيحة متشابهة (وهذه الأبنية تمثّل "الحقيقة")، فإن الأبنية الخطأ مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة للأسباب التي تكمن وراءها: أي نقصاً في المعلومات المنقولة. والنمط الأبسط هو حالة الجهل الكلي: فإلي نقطة معينة من الحبكة، يحجب أوكتاف الوجود الفعلي لسرٍّ متعلق به (دور فعال)، وأرمانس، أيضاً، غير واعية بوجودها (دور سلبي). وفيما بعد ربما يكون وجود السر معلوماً، ولكن من دون أية معلومات إضافية، وعندئذ ربما يستجيب المتلقي عن طريق اختراع "حقيقتـ"ـه الخاصة (تشكّ أرمانس في أن أوكتاف كان قد قتل شخصاً ما). والوهم أيضاً يكوّن درجة إضافية من المعلومات الناقصة: فالفاعل لا يدّعي شيئاً، ولكنه يمثّل تمثيلاً سيّئاً، والضحية غير جاهلة ولا مجهولة، ولكنها تخطئ. هذا هو الموقف السائد إلي حد كبير في الرواية: تموّه أرمانس حبَّها لأوكتاف مدّعيةً أنها ستتزوج شخصاً آخر، ويعتقد أوكتاف بأن أرمانس تشعر تجاهه بالصداقة حسب. ويمكن للمرء أن يكون فاعلاً وضحية للزيف، وهكذا يحجب أوكتاف عن نفسه حقيقة أنه يحبّ أرمانس. وأخيراً، يمكن للفاعل أن يكشف الحقيقة، ويمكن للضحية أن تستوعبها.
الجهل، والتخيل، والوهم، والحقيقة: هنا في الأقل ثلاث مراحل يتخطّاها البحث عن المعرفة قبل أن يفضي بشخصية ما إلي بناء تام. وعلي نحو واضح، تكون المراحل نفسها ممكنة في عملية القراءة. وعلي نحو اعتيادي، يكون البناء الممثَّل في النص متشاكلاً بالنسبة للمرء الذي يعدّ النص نقطة انطلاقه. فما لا تعرفه الشخصيات لا يعرفه القارئ أيضاً، وبطبيعة الحال تكون التأليفات الأخري ممكنة أيضاً. وفي الرواية البوليسية، تمارس شخصية واطسون البناء شأنها في ذلك شأن القارئ، إلاّ أن شخصية شارلوك هولمز تبني علي نحو أفضل، وكلا الدورين ضروريان علي حد سواء.
قراءات أخري:
إن الخلل في بناء القراءة لا يشوَّه وجوده علي كل حال: فنحن لا نوقف البناء بسبب من معلومات ناقصة أو خاطئة. وعلي العكس، يقوّي الخلل، ومثل هذا الخلل فقط، عملية البناء. ورغم ذلك، من الممكن أن لا يظهر البناء، وأن تحلَّه الأنماط الأخري من القراءة.
لا توجد التعارضات بين القراءات، ضرورة، حين نتوقعها. فعلي سبيل المثال، لا يبدو أن هناك اختلافاً كبيراً بين بناء مستند إلي نص أدبي وبناء مستند إلي نص مرجعي، لكنه نص غير أدبي. لقد كان هذا التشابه متضمَّناً في الافتراضات التي قدّمتها في القسم السابق، وبعبارة أخري، فإن بناء الشخصيات (من المادة غير الأدبية) مشابه لبناء القارئ (من نص رواية ما). فـ العمل التخييلي لا يبني بصورة مختلفة عن الواقع . فكل من المؤرخ والقاضي يعيد تكوين الوقائع، يفعل المؤرخ ذلك علي أساس الوثيقة المكتوبة، والقاضي علي أساس الشهادة الشفوية، ومن حيث المبدأ، فإنهما لا يبدآن بشكل مختلف عن قارئ رواية أرمانس، وهذا لا يعني أن ليس ثمة اختلافات بقدر تعلق الأمر بالتفاصيل.
ثمة مسألة أكثر صعوبة عما ذُكِرَ في أعلاه، وهي مسألة تتعلق بالعلاقة بين البناء المستند إلي المعلومات اللفظية، والبناء المستند إلي تصورات أخري، إلاّ أن ذلك يقع خارج نطاق هذه الدراسة، فنحن نبني القديد المشوي من رائحة القديد، وعلي نحو مماثل، نبني صوتاً وصورة، إلخ. وجان بياجيه يدعو هذه الظاهرة " بناء الواقع ". وفي هذه الأمثلة، ربما تكون الاختلافات أكبر من ذلك بكثير.
لا ينبغي أن نتيه بعيداً عن الرواية لإيجاد مادة تتطلب نمطاً آخر من القراءة. فثمة نصوص أدبية كثيرة، نصوص لاتمثيلية، لا تفضي إلي أيّ بناء مطلقاً. ويمكن تمييز بضعة أنماط هنا. والنمط الأوضح هو نمط شعر خاص يُدعي بشكل عام الشعر الغنائي، الذي لا يصف الأحداث، ولا يثير شيئاً خارجه. وفي الحقيقة، تتطلب الرواية الحديثة قراءة مختلفة، فالنص ما يزال مرجعياً، غير أن البناء لا يظهر، لأنه بصورة ما يُعدّ ما لا يمكن حسمه undecidable. ويتحقق هذا الأثر عن طريق تفكيك أية أولوية من الأولويات الضرورية للبناء التي كنّا قد وصفناها. ولنأخذْ مثالاً واحداً علي ذلك فقط: لقد رأينا أن هوية الشخصية كانت مؤشراً علي هوية اسمها، وعلي وضوح هذا الاسم. لنفترض الآن أن الشخصية نفسها في نص ما أثارتها بضعة أسماء مختلفة علي التوالي: الأول جون ثم بيتر ثم الرجل ذو الشعر الأسود ثم الرجل ذو العينين الزرقاوين ، من دون أيّ إظهار لإشارة مشتركة بين التعبيرين، أو لنفترضْ مرة أخري أن جون لا يعيّن شخصية واحدة، بل ثلاث شخصيات أو أربعاً، إذ تكون النتيجة واحدة في كل زمن: لم يعد البناء ممكناً، لأن النص لا يمكن تقريره تمثيلياً. ونحن نري الاختلاف هنا بين استحالة البناء هذه والأبنية الناقصة التي ذكرناها من قبل: ونتحوّل من إساءة الفهم إلي عدم القابلية علي المعرفة. إن لهذه الممارسة الأدبية الحديثة نظيرها خارج الأدب: وهي الخطاب الفُصامي (الشيزوفرينيا). فالخطاب الفصامي يحتفظ بغرضه التمثيلي، مع أنه من خلال سلسلة من الإجراءات غير الملائمة (حاولتُ أن أصنّفها في مكان آخر) يجعل البناء مستحيلاً.
ليس هذا موضعاً لدراسة أنماط أخري من القراءة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن موضعها إلي جانب القراءة كبناء سوف يكون كافياً. وفضلاً عن ذلك، فإن من الضروري أن ندرك القراءة ونصنّفها بوصفها بناء إذا ما فهمنا أن القارئ يقرأ النص نفسه قراءاتٍ مختلفةً في الوقت نفسه، أو في أوقات مختلفة، بعيداً عن كونه واعياً للاختلافات النظرية التي تمثلها. ففعاليته طبيعية بالنسبة إليه لدرجة أنها تبقي غير مدركة. ولذلك، من الضروري تعلّم كيفية بناء القراءة سواء أكانت بناءً أو تفكيكاً.
( 2 )
حين نقرأ، نحن نشيّد أبنيتنا عادة علي نوع آخر من أنواع المنطق السببي، فنحن نبحث عن الأسباب والنتائج لحدث معين في مكان آخر، وفي عناصر لا تشبه الحدث نفسه. ثمة نمطان من البناء السببي مألوفان جداً (كما لاحظ أرسطو من قبل): يدرك الحدث بوصفه نتيجة (و/أو سبباً) أما لسمة ذاتية أو لقانون موضوعي أو كلي. وتتضمن رواية أدولف أمثلة هائلة لكلا النمطين من التأويل، وهما مندمجان في النص نفسه.
وهاهنا قطعة تبيّن كيفية وصف أدولف لأبيه:
لا أتذكر، خلال السنوات الثماني عشرة الأولي من حياتي، أنني عقدتُ محادثة معه... ولم أكن أعرف، في ذلك الحين، ماذا كان يعني التهيّب .
Je ne me souviens pas pendant mes dix huit premiڈres annژes, d'avoir eu jamais un entretien d'une heure avec lui ... je ne savais pas alors ce que c'ژtait que la timiditژ.
تدلّ الجملة الأولي علي واقعة ما (غياب طول المحادثات). وتجعلنا الجملة الثانية نتأمل هذه الواقعة بوصفها واقعة رمزية لسمة ذاتية، وهي التهيّب: إذا تصرّف الأب بهذه الطريقة، فلأنه هيّاب. فالسمة الذاتية هي سبب الفعل. وهاهنا قطعة للحالة الثانية:
لقد ناجيتُ نفسي بأنه لا يلزم أن أكون متسرعاً في شيء، إذ أن إلينور لم تكن متهيّئةً بصورة كافية للاعتراف الذي كنتُ أخطط له، وكان من الأفضل الانتظار لمدة أطول. والراجح أننا، علي الدوام ومن أجل العيش بسلام مع ذواتنا، نخفي جوانب الضعف والعجز الجنسي تحت زيِّ الحسابات والأنظمة: وهذا ما يرضي جانباً من أنفسنا الذي هو، إذا جاز القول، المتفرّج علي الجانب الآخر .
Je me dis qu'il ne fallait rien prژcipiter, qu' Ellژnore ژtait trop peu prژparژe ˆ l'aveu que je mژditais, et qu ilvalait mieux attendre encore. Presque toujours, pour vivre en repos avec nous-mگmes, nous travestissons en calculs et en systڈmes nos impuissances ou nos faiblsses: cela satisfait cette portion de nous qui est, pour ainsi dire, spectatrice de l'autre.
وهنا تصف الجملة الأولي الحدث، وتقدم الجملة الثانية السبب: أي قانوناً كلياً للسلوك الإنساني، وليس سمة ذاتية فردية. ويمكن أن نضيف أن هذا النمط الثاني من السببية هو النمط المهيمن في رواية أدولف: إن الرواية تبيّن قوانين نفسية وليس حالات نفسية فردية.
نظم الافكار في الرواية
بعد أن نبني الأحداث التي تؤلف قصة ما، نبدأ بمهمة إعادة التأويل. ولا يمكّننا هذا الإجراء من بناء "هويات" الشخصيات حسب، وإنما يمكّننا من بناء النظام الأساسي من القيم والأفكار في الرواية. وإعادة تأويل هذا النمط ليس أمراً اعتباطياً، إذ تتحكم به سلسلتان من التقييدات، تكون السلسلة الأولي منهما متضمَّنة في النص نفسه: فلا يحتاج المؤلف إلاّ إلي أن ينتهز بضع لحظات ليعلّمنا كيف نؤول الأحداث التي أثارها. وهذه هي حالة الفقرات التي استشهدنا بها أولاً من رواية أدولف: حالما كوّن كونستان بضعة تأويلات ذات طابع حتمي، أمكنه أن يمتنع عن ذكر سبب الحوادث المتلاحقة، فنحن تعلّمنا درسه، وسنستمر بالتأويل بالطريقة التي علّمنا إياها. إن لمثل هذه التأويلات الجلية وظيفة مزدوجة: فمن جهة أولي، تخبرنا بالسبب الذي يختفي وراء واقعة معينة (وظيفة تفسيرية)، ومن جهة ثانية، تدخلنا في النظام التأويلي الخاص بالمؤلف، ذلك النظام الذي سوف يشتغل خلال مجري النص (وظيفة تفسيرية واصفة).
وتنجم سلسلة التقييدات الثانية عن السياق الثقافي. فإذا قرأنا أن فلاناً قطّع زوجته إرباً إرباً، فإننا لا نحتاج إلي إشارات نصية كي نستنتج أن هذا الصنيع هو صنيع وحشي حقيقة. وهذه التقييدات الثقافية، التي هي ليست إلاّ أشياء مألوفة في المجتمع ("مجموعة" من الأشياء الكامنة فيه)، تتغيّر مع الزمن. وتتيح لنا هذه التغيرات أن نستجلي سبب اختلاف التأويلات من حقبة إلي أخري. فعلي سبيل المثال، مادامت ممارسة الحبّ غير الشرعية لم تعد دليلاً علي الفساد الأخلاقي، فإننا نواجه مشكلة في فهم الإدانات التي يوصَم بها عدد كبير من بطلات الرواية في الماضي.
إن الشخصية الإنسانية والأفكار هي كيانات تترمّز من خلال الفعل، ولكن يمكن أن يُدلَّ عنها أيضاً. ولقد كانت هذه، بدقة، هي الحالة في الفقرات التي اقتُبستْ من قبلُ من رواية أدولف: فالفعل يرمّز الخجل عند والد أدولف: وعلي أية حال، عبّر أدولف في ما بعد عن الشيء نفسه بقوله: كان أبي خجولاً، وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للحكمة العامة. وهكذا يمكن للشخصية الإنسانية والأفكار أن تثار بطريقتين: طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. وسيقارن القارئ، في أثناء بنائه، الأجزاء المختلفة من المعلومات المتحصَّل عليها من كل مصدر، وسيجد أنها أما متماثلة أو غير متماثلة. ويختلف الانسجام النسبي لهذين النمطين من المعلومات اختلافاً كبيراً خلال مجري التاريخ الأدبي، ومن نافل القول إن همنغواي لم يكتب مثل كونستان.
وعلي أية حال، يتعيّن علينا أن نميز بين الشخصية الإنسانية المبنية بهذه الطريقة والشخصيات في رواية معينة: وإذا جاز التعبير، ليست لكل شخصيةٍ شخصيةٌ. فالشخصية الروائية جزء من العالم الزمكاني المتمثل في النص حسب، فهو/هي يبدو للعيان في اللحظة التي تظهر فيها الأشكال اللغوية المرجعية (أسماء العلَم proper names، والتركيب الاسمي nominal syntagm، والضمائر الشخصية personel pronouns) في النص بخصوص الوجود المجسّم. وليس للشخصية الروائية مضمون في حد ذاتها: فالشخص يعرَّف من دون أن يوصف. إذ يمكننا أن نتخيل نصوصاً ـ وهي موجودة فعلاً ـ حيث تكون فيها الشخصية الروائية محدودة إلي هذا الحد: وجود فاعل لسلسلة من الأفعال. ولكن، حالما تظهر الحتمية النفسية في النص، تصبح الشخصية الروائية موقوفةً علي الشخصية، فهو يفعل بطريقة معينة، لأنه خجول، وضعيف، وشجاع... الخ. ولا توجد الشخصية بهذا الشكل إلاّ وتسري عليها حتميةٌ من هذا النمط.
التسوية بين الاختلاف والتكرار
إن بناء الشخصية هو تسوية بين الاختلاف والتكرار. فمن جهة أولي، ينبغي أن تكون لنا متواصلية: إذ يجب علي القارئ أن يبني الشخصية نفسها. وتعطي هذه المتواصلية سلفاً في هوية اسم العلم، فهي وظيفته الأساسية. وفي هذه النقطة، يصبح أيٌّ (أو كلٌّ) من التأليفات ممكن: إذ ربما تبيّن كل الأفعال سمة الشخصية نفسها، أو ربما يكون سلوك شخصية معينة سلوكاً متناقضاً، أو ربما يغيّر ظروف حياته، أو قد يخضع إلي تحوير أساسي في الشخصية... وثمة أمثلة كثيرة جداً ليس من الضروري ذكرها. وهنا مرة أخري، تكون الاختيارات مؤشراً علي تاريخ الأساليب أكثر مما هي مؤشر علي طبائع المؤلفين.
إذن يمكن للشخصية أن تكون نتيجةً من نتائج القراءة، فهناك نوع من القراءة يمكن أن يخضع له كل نص. ولكن في الواقع، إن هذه النتيجة ليست اعتباطيةً. فليس من قبيل المصادفة أن تكون شخصية موجودة في رواية من القرن الثامن عشر ورواية من القرن التاسع عشر، ولكن غير موجودة في المأساة الإغريقية أو الحكاية الشعبية. فالنص يتضمّن، علي الدوام، اتجاهات استهلاكه الخاص.
البناء موضوعةً
تنجم إحدي الصعوبات في دراسة القراءة عن حقيقة أن القراءة عسيرة جداً علي الملاحظة: فالاستبطان ملتبس، والبحث الاجتماعي ـ النفسي مضجر. وبناء علي ذلك، نجد، بشيء من الوضوح، عمل البناء ممثَّلاً في العمل التخييلي نفسه، وهو المكان الملائم جداً للدراسة.
يبدو البناء موضوعة في العمل التخييلي، لأنه من المستحيل الإشارةُ إلي الحياة الإنسانية من دون التنويه بهذه الفعالية الأساسية. فكل شخصية يجب أن تبني، استناداً إلي المعلومات التي تتسلّمها، الوقائع والشخصيات التي تدور حولها، وهكذا فهي تماثل، علي نحو دقيق، القارئ الذي يبني العالم الخيالي بمعلوماته الخاصة (النص، وإحساس الشخصية بما هو محتمل)، وهكذا تصبح القراءة (علي نحو محتوم) موضوعة من موضوعات الكتاب.
وعلي أية حال، يمكن لموضوعاتية thematics القراءة أن تكون مؤكدة تقريباً، ومستثمرة كذلك بوصفها تقنية في نص معين. وفي رواية أدولف، تكون هذه الحالة موجودة بشكل جزئي: فما يُؤكَّد عليه في هذه الرواية هو حالة ترددية الفعل الأخلاقية حسب. فإذا ما رغبنا في استخدام العمل التخييلي لدراسة البناء، يجب أن نختار نصاً يظهر البناء فيه موضوعة من الموضوعات الأساسية. ورواية ستاندال المعنونة أرمانس مثال ممتاز علي ذلك.
وفي الواقع، تخضع الحُبكة الداخلية للرواية للبحث في المعرفة. فبناء أوكتاف الخطأ يؤدي وظيفة نقطة انطلاق الرواية: فاستناداً إلي سلوك أرمانس (تأويل يستنتج سمة شخصية من فعل ما)، يعتقد أوكتاف بأن أرمانس مولعة بالمال. وتتوطّد إساءة الفهم الأولية هذه، علي نحو واضح، حينما تُتبَعُ بإساءة فهم ثانية، متساوقةً مع ما يعاكس إساءة الفهم الأولي: فأرمانس تعتقد الآن بأن أوكتاف مولع بالمال ولعاً شديداً. ويؤسس هذا الخلاف الأولي نموذج الأبنية التي سترد. وفي ما بعد، تبني أرمانس مشاعرها نحو أوكتاف بشكل لائق، ولكن الأمر يستغرق من أوكتاف عشرة فصول قبل أن يكتشف أن مشاعره من أرمانس تدعي حباً، وليس صداقة. وعلي مدي خمسة فصول، تعتقد أرمانس بأن أوكتاف لا يحبها، ويعتقد أوكتاف بأن أرمانس لا تحبه طيلة الفصول الخمسة عشر الأساسية من الكتاب، وتتكرر إساءة الفهم نفسها باتجاه نهاية الرواية.
والشخصيتان تقضيان وقتهما كله بحثاً عن الحقيقة، وبكلمات أخر، تقضيان وقتهما في بناء الوقائع والأحداث حولهما. وليست العُنّةُ هي السبب في النهاية المأساوية لعلاقة الحب كما يقال غالباً، بل السبب هو الجهل. فأوكتاف ينتحر بسبب بناء خطأ: إذ يعتقد بأن أرمانس لم تعد تحبه. وكما قال ستندال بإيحاء:
إنه يفتقر إلي القدرة علي الفهم الثاقب وليس إلي الشخصية .
ولعلنا ندرك من هذا الموجز أنه يمكن أن تتباين بضعة جوانب من عملية البناء. ويمكن أن يكون أحدها إما فاعلاً أو ضحية، وإما مرسلاً للمعلومات أو متلقياً لها، بل حتي يمكن أن يكون أحدها كليهما. وأوكتاف فاعل حين يدّعي أو يبوح، وضحية حين يتعلم أو يخطئ. ومن الممكن، كذلك، بناء واقعة ما (بناء المستوي الأول )، بناء آخر لشخص ما يبني تلك الواقعة نفسها (بناء المستوي الثاني ). وهكذا ترفض أرمانس فكرة الزواج من أوكتاف حينما تفكر في ما يمكن أن يظنه الآخرون عنها:
إن العالم سيعدّني مرافقاً لسيدة أغرت طفل البيت. ويمكنني أن أستمع إلي ما تقوله دوقة أنكر، أو حتي أكثر النساء احتراماً مثل الماركيزة سيسين التي تري في أوكتاف زوجاً لإحدي بناتها .
وبالطريقة نفسها يرفض أوكتاف فكرة الانتحار حينما يتخيل إمكانية أبنية الآخرين عنه:
عندما أقتل نفسي، تتعرض أرمانس للشبهة. وسيقضي الناس أسبوعاً في تقصّي أدقِّ ظروف هذا المساء، وكل واحد من هؤلاء السادة الذين كانوا حاضرين سيكون مفوَّضاً بإعطاء وصف مختلف لما حدث .
إن ما تعلّمناه في رواية أرمانس، قبل كل شيء، هو حقيقة أنه يمكن للبناء أما أن يكون صحيحاً أو خطأ، وإذا كانت جميع الأبنية الصحيحة متشابهة (وهذه الأبنية تمثّل "الحقيقة")، فإن الأبنية الخطأ مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة للأسباب التي تكمن وراءها: أي نقصاً في المعلومات المنقولة. والنمط الأبسط هو حالة الجهل الكلي: فإلي نقطة معينة من الحبكة، يحجب أوكتاف الوجود الفعلي لسرٍّ متعلق به (دور فعال)، وأرمانس، أيضاً، غير واعية بوجودها (دور سلبي). وفيما بعد ربما يكون وجود السر معلوماً، ولكن من دون أية معلومات إضافية، وعندئذ ربما يستجيب المتلقي عن طريق اختراع "حقيقتـ"ـه الخاصة (تشكّ أرمانس في أن أوكتاف كان قد قتل شخصاً ما).
والوهم أيضاً يكوّن درجة إضافية من المعلومات الناقصة: فالفاعل لا يدّعي شيئاً، ولكنه يمثّل تمثيلاً سيّئاً، والضحية غير جاهلة ولا مجهولة، ولكنها تخطئ. هذا هو الموقف السائد إلي حد كبير في الرواية: تموّه أرمانس حبَّها لأوكتاف مدّعيةً أنها ستتزوج شخصاً آخر، ويعتقد أوكتاف بأن أرمانس تشعر تجاهه بالصداقة حسب. ويمكن للمرء أن يكون فاعلاً وضحية للزيف، وهكذا يحجب أوكتاف عن نفسه حقيقة أنه يحبّ أرمانس. وأخيراً، يمكن للفاعل أن يكشف الحقيقة، ويمكن للضحية أن تستوعبها.
الجهل، والتخيل، والوهم، والحقيقة: هنا في الأقل ثلاث مراحل يتخطّاها البحث عن المعرفة قبل أن يفضي بشخصية ما إلي بناء تام. وعلي نحو واضح، تكون المراحل نفسها ممكنة في عملية القراءة. وعلي نحو اعتيادي، يكون البناء الممثَّل في النص متشاكلاً بالنسبة للمرء الذي يعدّ النص نقطة انطلاقه. فما لا تعرفه الشخصيات لا يعرفه القارئ أيضاً، وبطبيعة الحال تكون التأليفات الأخري ممكنة أيضاً. وفي الرواية البوليسية، تمارس شخصية واطسون البناء شأنها في ذلك شأن القارئ، إلاّ أن شخصية شارلوك هولمز تبني علي نحو أفضل، وكلا الدورين ضروريان علي حد سواء.
قراءات أخري
إن الخلل في بناء القراءة لا يشوَّه وجوده علي كل حال: فنحن لا نوقف البناء بسبب من معلومات ناقصة أو خاطئة. وعلي العكس، يقوّي الخلل، ومثل هذا الخلل فقط، عملية البناء. ورغم ذلك، من الممكن أن لا يظهر البناء، وأن تحلَّه الأنماط الأخري من القراءة.
لا توجد التعارضات بين القراءات، ضرورة، حين نتوقعها. فعلي سبيل المثال، لا يبدو أن هناك اختلافاً كبيراً بين بناء مستند إلي نص أدبي وبناء مستند إلي نص مرجعي، لكنه نص غير أدبي. لقد كان هذا التشابه متضمَّناً في الافتراضات التي قدّمتها في القسم السابق، وبعبارة أخري، فإن بناء الشخصيات (من المادة غير الأدبية) مشابه لبناء القارئ (من نص رواية ما).
فـالعمل التخييلي لا يبني بصورة مختلفة عن الواقع . فكل من المؤرخ والقاضي يعيد تكوين الوقائع، يفعل المؤرخ ذلك علي أساس الوثيقة المكتوبة، والقاضي علي أساس الشهادة الشفوية، ومن حيث المبدأ، فإنهما لا يبدآن بشكل مختلف عن قارئ رواية أرمانس، وهذا لا يعني أن ليس ثمة اختلافات بقدر تعلق الأمر بالتفاصيل.
ثمة مسألة أكثر صعوبة عما ذُكِرَ في أعلاه، وهي مسألة تتعلق بالعلاقة بين البناء المستند إلي المعلومات اللفظية، والبناء المستند إلي تصورات أخري، إلاّ أن ذلك يقع خارج نطاق هذه الدراسة، فنحن نبني القديد المشوي من رائحة القديد، وعلي نحو مماثل، نبني صوتاً وصورة، إلخ. وجان بياجيه يدعو هذه الظاهرة " بناء الواقع ". وفي هذه الأمثلة، ربما تكون الاختلافات أكبر من ذلك بكثير.
نمط آخر من القراءة
لا ينبغي أن نتيه بعيداً عن الرواية لإيجاد مادة تتطلب نمطاً آخر من القراءة. فثمة نصوص أدبية كثيرة، نصوص لاتمثيلية، لا تفضي إلي أيّ بناء مطلقاً. ويمكن تمييز بضعة أنماط هنا. والنمط الأوضح هو نمط شعر خاص يُدعي بشكل عام الشعر الغنائي، الذي لا يصف الأحداث، ولا يثير شيئاً خارجه. وفي الحقيقة، تتطلب الرواية الحديثة قراءة مختلفة، فالنص ما يزال مرجعياً، غير أن البناء لا يظهر، لأنه بصورة ما يُعدّ ما لا يمكن حسمه undecidable. ويتحقق هذا الأثر عن طريق تفكيك أية أولوية من الأولويات الضرورية للبناء التي كنّا قد وصفناها. ولنأخذْ مثالاً واحداً علي ذلك فقط: لقد رأينا أن هوية الشخصية كانت مؤشراً علي هوية اسمها، وعلي وضوح هذا الاسم. لنفترض الآن أن الشخصية نفسها في نص ما أثارتها بضعة أسماء مختلفة علي التوالي: الأول جون ثم بيتر ثم الرجل ذو الشعر الأسود ثم الرجل ذو العينين الزرقاوين ، من دون أيّ إظهار لإشارة مشتركة بين التعبيرين، أو لنفترضْ مرة أخري أن جون لا يعيّن شخصية واحدة، بل ثلاث شخصيات أو أربعاً، إذ تكون النتيجة واحدة في كل زمن: لم يعد البناء ممكناً، لأن النص لا يمكن تقريره تمثيلياً. ونحن نري الاختلاف هنا بين استحالة البناء هذه والأبنية الناقصة التي ذكرناها من قبل: ونتحوّل من إساءة الفهم إلي عدم القابلية علي المعرفة. إن لهذه الممارسة الأدبية الحديثة نظيرها خارج الأدب: وهي الخطاب الفُصامي (الشيزوفرينيا). فالخطاب الفصامي يحتفظ بغرضه التمثيلي، مع أنه من خلال سلسلة من الإجراءات غير الملائمة (حاولتُ أن أصنّفها في مكان آخر) يجعل البناء مستحيلاً.
ليس هذا موضعاً لدراسة أنماط أخري من القراءة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن موضعها إلي جانب القراءة كبناء سوف يكون كافياً. وفضلاً عن ذلك، فإن من الضروري أن ندرك القراءة ونصنّفها بوصفها بناء إذا ما فهمنا أن القارئ يقرأ النص نفسه قراءاتٍ مختلفةً في الوقت نفسه، أو في أوقات مختلفة، بعيداً عن كونه واعياً للاختلافات النظرية التي تمثلها. ففعاليته طبيعية بالنسبة إليه لدرجة أنها تبقي غير مدركة. ولذلك، من الضروري تعلّم كيفية بناء القراءة سواء أكانت بناءً أو تفكيكاً.
*تكرار الصدارة: تكرار كل كلمة أو عبارة واحدة في أوائل جملتين متعاقبتين لغرض بلاغي. عن: معجم علم اللغة النظري. د. محمد علي الخولي. (المترجم)
المصدر: الزمان
19/02/2002
إقرأ أيضاً: