ترجمة: صبحي حديدي
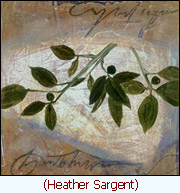 إذا أخذنا مثال النوع Genre كفكرة عن الشكل الأدبي، فإنّ علينا البدء من إدراك الحقيقة التالية: بمعزل عمّا نملك من نظرية ميكانيكية في الأنواع، تعمل ضمن تعريفات شكلية وترسم الحدود وتكشف الأنساق البنيوية الدقيقة، فإنّ فكرة النوع ضالعة بقوّة في أمر أقلّ قابلية للفهم، وأقلّ ملموسية في الشكل، هو بمثابة نمط في رؤية الواقع خاصّ ومستقلّ بذاته، وحدس بالقوي ذات الصلة، وحسّ مميّز للزمان والمكان، وسيكولوجية في الفعل وردّ الفعل لا تقبل المناقلة.
إذا أخذنا مثال النوع Genre كفكرة عن الشكل الأدبي، فإنّ علينا البدء من إدراك الحقيقة التالية: بمعزل عمّا نملك من نظرية ميكانيكية في الأنواع، تعمل ضمن تعريفات شكلية وترسم الحدود وتكشف الأنساق البنيوية الدقيقة، فإنّ فكرة النوع ضالعة بقوّة في أمر أقلّ قابلية للفهم، وأقلّ ملموسية في الشكل، هو بمثابة نمط في رؤية الواقع خاصّ ومستقلّ بذاته، وحدس بالقوي ذات الصلة، وحسّ مميّز للزمان والمكان، وسيكولوجية في الفعل وردّ الفعل لا تقبل المناقلة.
النوع، إذاً، هو دائماً أكثر من مجرّد تقليد أو اتفاق عريض مسبق حول الإجراء اللازم. إنه يمتدّ إلي سؤال ماهية الغنائي وماهية الملحمي وماهية الدرامي، وتلك أسئلة تشمل كامل جدل المواقف الإنسانية، وليس علي غرار الثالوث الهيغلي (1) . وفي المستوي الفكري لم يعد الآن مقبولاً اختزال هذه الأسئلة إلي ميكانيكيات محضة حول السمات الخارجية.
وهكذا فإنّ النوع لا يزوّد الفنان بأداة إبداع فحسب، بل بأداة فهم أيضاً، وهذه هي النقطة التي يتوجّب التشديد عليها. وفي نظريات الأنواع، كما في نظريات الشكل بصفة عامة، يميل النقد إلي حصر نفسه في وظيفة الشكل كقالب لصناعة القطعة الفنية، ويغضّ النظر عن، أو يغفل سريعاً، الشرط المعرفي المسبق وراء منفعة الشكل بأسرها. ومع ذلك فإنّ الشكل عموماً طراز في المعرفة قبل أن يكون قالب صُنْع.
وفي الأدب العربي نعثر علي طراز أنواعي واحد مستبدّ مهيمن هو القصيدة الغنائية. والتشعّب الثالوثي التامّ الذي نعرفه في الآداب الغربية غير موجود، ببساطة. ذلك لا يعني أنّ جدل المعرفة الأدبية لا يؤِثّر أبداً في الشعر العربي، لأنه حتى في مخطط إميل شتايغر حول مقولات النوع التي يسميها الغنائية و الملحمية و الدرامية ، تظلّ كلّ قطعة شعر واقعة بين هذه الحدود القصوي الثلاثة (2) ، حاملة بذلك عنصر توتّر حاضر في العمل الشعري المنفرد.
وفي ثالوث إميل شتايغر يكون للطراز الغنائي نظيره في الطفولة، والملحمي في الشباب، والدرامي في النضج. وهكذا فإنّ الغنائي هو أيضاً تعبير عن المزاج، والملحمي تمثيل للواقعة، والدرامي تركيب أو ركود للفهم. وكلّ ذلك يقود إلي ثلاثة ضروب من المعرفة هي العاطفية، والتشكيلية، والمفهومية.
وإذا توجّب أن توجد كلّ هذه الأبعاد في الأعمال الأدبية المنفردة، فإنّ الخصائص الحاسمة المميّزة للشعر العربي غنائية دون ريب، وهي تكشف عن مرحلة الروح الأبكر في تنوّع طَبْعها وفهمها العاطفي للعالم وللنفس. وإعراب الشاعر العربي عن طَبْعه يضع شعره في الحاضر أيضاً، أي يضعه في برهة الاستجابة العاطفية.
ومع ذلك فإنّ هذه الحقيقة ذاتها، القائلة إنّ النوع الغنائي يستأثر بالغلبة كقاسم مشترك في مجمل الشعر العربي، ينبغي أن تدفع الناقد إلي الاستنفار. ذلك لأنّ أية دراسة دقيقة لغنائية الشعر العربي سوف تكشف أنّ فكرة القرن التاسع عشر عن الغنائي بوصفه ذلك الانسكاب للعواطف الجامحة أو الانكشاف الصريح لنفس الشاعر، لا تنطبق علي الطراز الغنائي العربي. هنالك كَمّ كبير من التقاليد والأساليب، وكَمّ كبير من الطاعة للموروث الذي قد لا يكون سبب وجوده الجمالي واضحاً بصفة عيانية أمام الشاعر العربي. واحتفاظ الشعر العربي بصَدَفة نوع غنائي شكليّ يبدو وكأنه أجبر ذلك الشعر علي التكثيف والأَسْلَبة، ثمّ تحويل مفاهيم الموضوعات المتكررة ونواتات الأنواع الفرعية إلي كيانات شكلية راسخة، بثبات وأصالة، في الفكرة العربية عن الشكل الشعري بوصفه الغراء الخارجي الشكلي للقصيدة Qasidah نفسها.
وضمن هذه البنية المكثفة المؤسلبة يمكن لأشكال أخري قياسية، غير غنائية، أن تتطوّر ضمن إمكانيات ضيّقة للغاية. هذا، مع ذلك، لا يعني أنّ نطاق موضوعات القصيدة يستبعد كلّ ما هو غير غنائي (3) . المرء، بالأحرى، يستطيع القول - علي سبيل المفارقة في الواقع - إنّ التقييدات ذاتها تسري علي التطوّر المستقلّ لكلّ الصِيَغ ضمن القصيدة الواحدة، وقد تكون الصيغة الغنائية هي الأكثر تضرراً. وهكذا، وأيّاً كان أصل مظهر المزاج العاطفي في الشعر العربي، فإنّ طرازاً من الغنائية النقيّة قد أصبح نوعاً مجمّداً معقداً متّسماً بتوتّرات داخلية كبري لا سبيل إلي حلّها. لكنّ هذه التوترات، وبفضل صقل وأسلبة المكوّنات الشكلية للقصيدة، لا تُدرَك مباشرة، ولا تُفسّر، لأنّ التقاليد المتعارَف عليها لا تميل إلي تقديم المبررات. ولقد توجّب علي النقد الشكلي في الشعر العربي أن يواجه الحقائق الموجودة، وأكثرها بروزاً حقيقة هيمنة طراز أو نوع غنائي في الوجهة الشكلية، ومعه ذلك اللغز الواضح: القصيدة.
وفي متابعة طِباقنا الشاقّ هذا حول المواجهة الجمالية بين التراثَين الغنائيين الأوروبي والعربي، ينبغي أن نتذكّر قصيدة الـ Ode الغنائية البندارية غنسبة إلي الشاعر اليوناني الغنائي بندار Pindarف، والتي أدارت في أوروبا دولاب الحظّ لصالح الغنائية. وفي الواقع تمثّل هذه القصيدة شكلاً مختلطاً ذا أصل درامي واضح. وهي تتميّز بدرجة عالية من التعقيد البنيوي، وبمقدار معيّن من الثقل في الموضوع واللغة. وارتباط هذه القصيدة بالموسيقي في عصر الباروك قد لا يكون العامل الأقلّ أهمية في صعودها السريع.
كلّ هذه عوامل تتجمّع لتأكيد التفوّق الأنواعي لقصيدة الـ Ode العربية الأكبر، أو القصيدة . وإنّ الإلحاح علي التعقيد البنيوي هو علامة مميّزة في الأوساط الأدبية الكلاسيكية الجديدة ، العربية مثل الأوروبية. واكتشاف الكلاسيكية الجديدة الأوروبية المتأخر لعنصر العاطفة كخلاصة جوهرية ليس في الغنائية وحدها بل في الشعر بأسره، كان قد جذب الإستشراق الشعري نحو قصيدة الـ Ode العربية أيضاً. لكنّ النظرة الفاحصة تبيّن وجود بُعد خاصّ في إلحاح القرن الثامن عشر علي العواطف، الأمر الذي قد لا يرتبط بشكل قاطع مع فهم العاطفة عند شاعر رومانتيكي مثل بايرون مثلاً. حريّ بنا أن نرتاب في تأثير علم النفس الديكارتي (كتاب عواطف الروح 9461)، والذي قاد الكلاسيكية الجديدة إلي مورفولوجيا وفينومينولوجيا العواطف وتصنيفها، وهذا جانب انعكس علي نحو متحذلق في الرسم الكلاسيكي الجديد ذي التخطيطات السيكولوجية. وبذلك تُرجم إلي الإنكليزية كتاب دوفرينوا فنّ الرسم ، الذي يعرض علم النفس الديكارتي هذا، علي يد الشاعر درايدن دون سواه، ممثّل العواطف وممارس كتابة قصيدة الـ Ode. من جانبه صوّر لوبرون كتاب رسالة في العواطف ، (8961)، فضمّنه رسوماً تعكس النطاق التامّ للتعابير والعواطف.
على يد منظّري الفنون التشكيلية هؤلاء أصبح عنصر العاطفة اللونجيني غنسبة إلي لونجينوس Longinusف فرضية علمية جامدة التوصيف. ولعلّ علي المرء هنا أن يُخضع هذا الظهور الجديد لـ العاطفة - وفي ما يخصّ الجزء الأكبر من القرن الثامن عشر علي الأقلّ - إلي التيّارات الأكثر شكلانية في الكلاسيكية الجديدة والنزعة الأكاديمية. وسوي ذلك كانت أولي بشائر تحوّل الرومانتيكية الأوروبية قد بدت وكأنها وجدت علم جمالها الفتيّ في الشرق الإسلامي، وهذه حقيقة ليست بعيدة عن انقلاب أصحاب الفنّ الجديد إلي الشفافيات والرهافة الأسلوبية في الفنّ الياباني، أو حين بحثت التكعيبية عن نظيرها في التشويهات الجلفة للأقنعة الأفريقية.
ومثل الدم والبروق في الميلودراما المتأخرة، كان المطلب اللونجيني المتمثّل في امتلاك كلمات الشاعر بـ نوع من الجنون والروح المقدّسة قد أسفر غالباً عن موقف شعري قسري، حيث - في كلمات ييتس - يغرق احتفال البراءة ، وحيث الأفضل يفتقر إلي اليقين، والأسوأ مفعم بكثافة عاطفية ( المجيء الثاني ).
أو حيث تكون قصائد الـ Ode هذه، في كلمات أحد كبار ممتهني البلاغة العربية العالية (4) :
فكأنما هي في السماعِ جنادلٌ
وكأنما هي في القلوب كواكبُ
وثمة إغراء في هذا الانزلاق نحو مناقشة الغنائية العربية والشكل العربي للـ Ode عن طريق اللجوء السهل إلي الأواليات المعقدة الشاقة التي تقدّمها نظرية الشعر الكلاسيكية الجديدة. لكنّ التناظرات الشعرية العربية تتفرّع أبعد وأعمق رغم ذلك. والطبيعة العاطفية للشعر العربي القديم، والتي اجتذبت روح أوروبا الرومانتيكية المستفيقة، تنطوي علي صفة عتيقة Archaic، هي للغرابة الصفة التي صنّفها استشراق القرن الثامن عشر في باب القصيدة الرعوية.
هنالك، مع ذلك، توتّر مفهومي في فكرة القصيدة الرعوية التي يمكن أن تُطبّق قسراً علي سوسيولوجية المشهد الشعري العربي في أقدم مراحله. هذا التوتر ناجم عن تعذّر الإنطباق، أو التضادّ علي الأقلّ، ضمن مفهوم واحد بين البدائي والنبيل. يُضاف إلي ذلك أنّ التطوّر اللاحق للنظرة الرعوية إلي الإنسان والطبيعة جلب معه وضعية قَلْب لهذه المتعاكسات الظاهرة عبر نوع من التحويل المَسْخي: البدائي، من خلال فنون الأسلبة، يصبح تكلّفاً وشكلاً من التنقية الفائقة المنخلعة؛ في حين أنّ النبيل يتولّي افتراض وجود الفجاجة والسخف والتخلّف. وهكذا تنبثق من القصيدة الرعوية أنشودة رعوية من جانب أوّل، وتنبثق من جانب ثانٍ أنثروبولوجيا كاملة حافلة بالمتضادات، مثل المتوحش النبيل ، و الجميلة والوحش ، وما إليها.
والأساطير البطولية للأمّة هي الإقتران الآخر مع المفهوم الثقافي للعنصر العتيق. وكان عالم هوميروس عتيقاً بدرجة كبيرة، لأنّه احتوي علي امتزاج بين أسلوب ومخيّلة مُماتَين ثقافياً، ورؤية لشَفَق العالم التاريخي، وغبش تكوّن الأمّة التي كُتب عليها أيضاً أن تمثّل درجة الكلاسيكية القصوي.
وبمعزل عن عالم الأساطير العتيقة التي ظلّت القصيدة الأسطورية نوعها ووسيطها، انطوي الشعر الإغريقي المبكر علي عالم أكثر ملموسية تاريخياً، يخصّ الشاعر المحارب بقصيدته الغنائية الأقصر. والشاعر الإغريقي الغنائي العتيق يتحدث دائماً بضمير المتكلم. ونطاق موضوعاته ومخيّلته يدهشنا بمدي اقترابه من الشعر العربي الغنائي؛ وعالمه القائم علي مشاغل أرستقراطية وفروسية توحي أيضاً بتوازيات مع الشعر العربي الأرستقراطي والفروسي والغزلي، منذ عهود ما قبل الإسلام وشعراء القصيدة الطويلة، وصولاً إلي المتنبي. ألكايوس، مثلاً، يأخذنا إلي خزانة أسلحته ويعطينا وصفاً بتفصيل دقيق، من نوع التفصيل الشائع عند الشاعر العربي، كما حين نكون في حضرة النابغة الذبياني والمحاربين الغساسنة، وكذلك المتنبي في مديحه للملك الشهم (5) :
حَفَرْتَ الرُدينياتِ حتى طرحتَها
وحتى كأنّ السيفَ للرمح شاتمُ
وفي مناقشته أسلوب الأوديسة يلاحظ الناقد الألماني إريك أورباخ كيف نصبح مدركين لحقيقة أنّ الحياة في القصائد الهوميرية لا تسير إلا صحبة الطبقة الحاكمة، والآخرون يظهرون في هيئة الخدم والعبيد (6) .
هذا التقييد الطبقي أو التقارب الأرستقراطي واضح علي المنوال ذاته في الشعر العربي منذ أبكر مظاهره المسجّلة. ولم يكن شعراء من أمثال أمريء القيس وعمرو بن كلثوم أبناء أرستقراطية عليا فحسب، بل كانوا أيضاً شعراء صعاليك يبشّرون بالمُثٌل الفروسية التي تبشّر بها أميرة بدوية. وفي وسعنا العثور علي موتيفات صعلكة مميّزة كانت تناسب دخول الشنفرى - خلسة ربما - إلي ميدان الشعر الأرستقراطي (7) .
شاعر صعلوك آخر، هو تأبط شرّاً، يجمع البهجة الضارية بتلبية نداء الدمّ وأداء واجب الثأر الذي لا ينفصل البتة عن الشرف الفروسي والفخار كأساس لاحترام الذات. وقصيدته الشهيرة في الانتقام، سواء أكانت له أم نُسبت إليه، لم تفقد فتنتها وعنفها المتسامي حتى عند روح رقيقة مثل الشاعر الألماني غوتة. ولابدّ أنه يوجد في مثل هذا الشعر شيء جوهري وحاسم ثقافياً.
وفي مقالته الرائعة عن الأفكار الفروسية في العصور الوسطي ، كان جون هويزينغا قد لاحظ درجة معيّنة من الالتباس بين اللعب والعاطفة في تشكيل السلوك الفروسي إزاء المطامح الشخصية والفعل السياسي. وإنّ قبول أيّ سلوك هو في حدّ ذاته شكل من أشكال اللعب بصرف النظر عن جدّيته. وهكذا فإنّ هذا القبول الجدّي بفكرة الشرف كسلوك غير قابل للطعن، هو ما يخلق التكييف النفسي فوق العقلي. وهذه العاطفة، أو تهيّب قواعد الأخلاق السلوكية هو الذي جعل قواسم الشرف والمجد والثأر الأكثر فجاجة تكتسب بهاء الفضيلة والواجب (8) . وضمن هذا الاعتبار هنالك فارق ضئيل بين حرب البسوس ونزاعات أوروبا التي لم تكن لها نهاية في القرون الوسطي. قواعد الشرف والثأر هذه، التي تُغطّي بزخرف النبالة أو التعلّق بالقِيَم الروحية، هي إلي حدّ كبير داخلة في طبقات الوعي الاجتماعي في العصور الوسطي.
وضمن هذا السياق الوسيط كان الشاعر العربي في قلب الفكرة الأرستقراطية، سواء أكانت تخصّ القبيلة أو البلاط بعدئذ. وفي تطوّره من عرّاف إلي شاعر جوّال ـ فارس، بات من الصعب أن يتماهى إلا مع الخاصّة. ولم يكن مفاجئاً أنّ ابن عبد ربه أطلق علي مجمل الموروث الشعري العربي صفة ديوان العرب ، ليس بالمعني الإجتماعي العريض بل بمعني ديوان خاصّة العرب ، المخزن الثقافي الواعي للمنزلة والصفة (9) .
وفي غياب الدراما، والمسرح كما نعرفه اليوم وكما عرفه العالم القديم، كان محتماً علي الشعر الغنائي أن يتولي وحده دور التقاط التماسّ الحسّي مع الحياة، ويستعيد الإيمان في إمكانية معرفة العالم عبر الإحساس، وينجز ذلك التكافل الوجداني مع الحسّي الذي يجعل رؤية الحاضر ممكنة. والفنون التشكيلية في أوروبا المسيحية كانت ما تزال جزءاً من عمارة، طموحاتها كامنة في الغيبي. أمّا علي الجانب الإسلامي من التعبير التشكيلي فقد كان الغيبي قد انضمّ إلي المظهر الأقصى للزخرفة فأعطي تجريد كلّ تجريد، أي الأرابيسك الذي باتت وظيفته البصرية هي الترحال بعيداً عن الواقع وفقدان النفس في مخططات المتاهة الأبدية، والبحث الدائم والتطلّع إلي المستقبل وحده، ثم الخسران أو الإرتداد إلي الماضي: بحث وخسران، حيث لا مكان للحاضر. وكلّ شيء يصبح كما وصفه ابن الفارض (10):
وكفي عَزاماً أنْ أبيتَ متيّماً
شوقي أماميَ والقضاءُ ورائي
ولكننا إذا نظرنا إلي حال الشعر الغنائي الأوروبي في الفترة التاريخية للإحياء، وقارنّاه بحال النوع الغنائي في بلاد العرب الإسلامية، فمن الواجب أن لا تعمينا التشابهات والتناظرات العديدة. ذلك لأنه في الاعتبار الحاسم تاريخياً كانت سفينة الشعر العربي تبحر علي آخر موجة في مَدّها العالي، في حين أنّ السفينة الشراعية الفتية القادمة من منطقة البروفانس كانت تنبثق لتوّها من اللجة. وفي حين أنّ الشعر الغنائي العربي كان، في هذه المرحلة المتأخرة، يصقل المدركات الحسية ويدخلها في صميم التجريد الأسلوبي ويغلق آخر دائرة من دوائر الإستيعاب الجمالي، فإنّ تجربة البروفنسيال شعر التروبادور كانت صوتاً مُستجمَعاً من أصداء عديدة، ولن يطول الوقت حتى تتعاقب هذه الأصداء من جهة إلي أخري في أوروبا.
ولا بدّ لأيّة محاولة في تعريف طراز الغنائية العربية من أن تقودنا بالضرورة إلي طبيعة صوت الشاعر في القصيدة، إلي قناع Persona الشاعر. وكان مطلب النزاهة الشعرية قد نُوقش في النظرية الشعرية منذ أقدم العصور، وفي النقد العربي أيضاً، علي نحو واسع وإنْ كان يستند إلي نظام محدود. وفي بحثهم عن صوتهم الشعري الخاص كان الكلاسيكيون الجُدُد والرومانتيكيون الأوروبيون واثقين من العثور - في كنوز الإستشراق الشعري المكتشفة حديثاً - علي نمط أعلي لهذا الكيان المراوغ. وبعد نزعة الموضوعية الكلاسيكية الجديدة في الضمير الغائب المنضبط فلسفياً، وما تلاها من طراز آخر في الحضور الشعري عبر الحوار الدرامي، أصبح هؤلاء توّاقين من جديد إلي صوت الشاعر ذاته وهو يرتدّ إلي نفسه. كانوا يفتشون عن الـ أنا الشعرية العارية غنائياً. ولعلّهم، في سياق افتتانهم الإبتدائي بطبقات الغنائية العربية الأبكر، كانوا علي حقّ في التفكير بأنهم إنما اكتشفوا ظاهرة بالغة النقاء. و القناع الشعري، الـ أنا المؤكَدة عند الشاعر العربي الغنائي، تشكل في الواقع جانباً جوهرياً في النوع بأسره.
والقصيدة العربية الغنائية، التي تحدّد النوع الغنائي العربي في المستوي الشكلي، تعاني من طغيان هذه الـ أنا الوهمية؛ وهنا، في هذه القصيدة المحدِّدة للنوع، يكتسب انبناء المكوّنات الموضوعاتية والأسلوبية أهميته القصوي. وهكذا فإنّ النسيب كيان شكلي صحيح وتامّ في هذا النمط الأساسي من القصيدة، لأنه في المرثاة والقصيدة الساخرة ممنوع من بلوغ ذروة اكتمال شكله بسبب انعدام التطابق الموضوعاتي مع توجّه القصيدة العامّ إلي الحداد أو القدح. والنسيب الشكلي هو وحده الذي يمكن أن ينبني كمرثاة، لأنّ مختلف عناصره تُستخدم عندئذ بشكل حرّ في السياق الجديد للموضوع والمزاج. وأمّا في القصيدة الساخرة فإنّ الأغراض، التي يمكن ضمّ النسيب إليها، تكون محكومة بالإتجاه المحدد للسلبية الكامنة أساساً. وهنا يقوم عنصرا المفارقة والتهكم بتشويه التصريح الغنائي، فيتوقف عن تمثيله لحقيقته الخاصة - أنه تصريح عن تجربة - ويصبح مجازاً طريفاً، ونوعاً من الغنائية التطبيقية.
والشاعر العربي غير المعقد نفسياً، والذي فقد منذ زمن طويل نعمة الرؤيا الساذجة المخلِّصة، واصل الإلحاح علي مخاطبة نفسه. لكنّ النفس هذه كانت تتعرّض للمزيد من تقييد إمكانيات تجربتها. والحياة المدينية الجديدة سمحت بانطلاق عواطف خجولة ومبتذلة، أو متهورة وعجيبة، بحيث تبقي النوع في نهاية المطاف، الشكل وكليشيه المجاز الطريف الغنائي، وتُوّج لك كلّه بمغالطة صوت الشاعر المباشر، الـ أنا المنتمية إلي تجربة مضمحلة. وأصبح نادراً ذلك الشاعر الذي ظلّ، مثل أبي العلاء المعري (11) ، قادراً علي سماع وتمييز أصوات الشعر الأخرى، حتى بالرغم من مفارقة تقريع الذات:
إذا قلتُ المُحالَ رفعتُ صوتي
وإنْ قلتُ اليقينَ أطلتُ همسي
وضمن النوع بأسره، ولكن ضمن النسيب خصوصاً، استطاع الشاعر العربي أن يحافظ علي ما نحبّ تسميته بنزاهة النموذج النمطي. والهيبة التي طبعت هذه النزاهة يشهد عليها موت الشاعر الأموي وضاح اليمن. والحكاية في الأغاني تقول إنّ أمّ البنين، زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك، قصدت مكة للحجّ. وهناك أرسلت في طلب اثنَين من أشهر شعراء البلد، كُثيّر ووضاح اليمن، وقالت لهما: أنسُباني . وتملّص كثيّر عن طريق مدح إحدى وصيفات الملكة، أمّا وضاح اليمن فقد تجرأ وخاطب الملكة مباشرة، فقتله الخليفة جزاء فعلته (12).
وهكذا فإنّ كلّ سياق، وكلّ إطار، يترك علي نحو ما الانطباع بأنّ ما جري استيعابه لا يتجاوز فهم الهوامش، وأنه ما زالت هناك طرق تفضي إلي جنبات الداخل (*).
(*) تُرجمت، بتصرّف، عن:
Jaroslav Stetkevych
"The Arabic Lyrical Phenomenon in Context."
Journal of Arabic Literature, vol. vi-1975