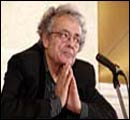 يقوم شعري كله، سواء في وزنه ونثره، على الشك العميق، لا مع العالم وحده، بل في ما يفترض انه الملاذ والملجأ- أي الشعر. وهذا مما يأخذه علي، أساسيا، بعضهم - أولئك الموقنون المؤمنون. وذلك بدءا من «أغـاني مهيار»، حتى أن من الممكن قراءة كتاباتي كلها في ضوء هذا السؤال: ماذا يقدر الشعر أن يفعل في ظلام العالم؟
يقوم شعري كله، سواء في وزنه ونثره، على الشك العميق، لا مع العالم وحده، بل في ما يفترض انه الملاذ والملجأ- أي الشعر. وهذا مما يأخذه علي، أساسيا، بعضهم - أولئك الموقنون المؤمنون. وذلك بدءا من «أغـاني مهيار»، حتى أن من الممكن قراءة كتاباتي كلها في ضوء هذا السؤال: ماذا يقدر الشعر أن يفعل في ظلام العالم؟
* أدونيس، من حوار مع عباس بيضون.
* * *
ائما ما اتهم أدونيس وشعره بأنهما صنوان للغموض، وأن فيهما ما يجعل الجمهور ينأى عنهما، ولا يلتقيهما إلا نخبة النخبة، على اعتبار أن التجربة الشعرية الأدونيسية، حملت في نسغها، تلك المادة الرؤيوية المشحونة بفيض من التراكيب الغريبة على الذائقة العربية المعتادة أصلا على أنماط وأساليب لغوية، تنهمك بها القصيدة، تكون مبالغة في مباشرتها أو وضوحها.
لقد حمل أدونيس كثيرا في مسعاه الفكري والشعري، ودون مبالغة، فإن الثقافة العربية الحديثة لم يثر فيها السجال حول شاعر، بقدر ما أثير حول أدونيس، وكان ذلك يبعث رائحة تقصي الجمهور عن منجزه، غير أن التجارب التي خاضها هذا الإشكالي بامتياز، كانت دائما تبوح بطاقة الشاعر الرائي، الشاعر الذي يذهب إلى أعماق الاندغام مع منجزه، وقد كانت تجارب أدونيس التي قدم فيها شعره عبر و بمختلف الوسائط، تفصح عن رغبة في كسر الطوق الذي نسجته رؤى قاصرة عن فهم التجربة الأدونيسية، ومتعلقة بعد، بأوهام لم تعد تحمل من سيرة بقائها، سوى بعض اثر يلوح في ظاهر اليد.
وفي هذا المنحى، قدم أدونيس شعره عبر تجربة جذابة في شكلها، وأصبحت أنموذجا يحتذى في مناسبات كثيرة لدى عدد كبير من شعرائنا، وإن كانت هذه التجربة مسبوقة، فإن أدونيس منحها حضورا جذابا، كان من نصيب الجمهور العادي أن يعيد النظر في مساحة قراءته لتجربة هذا الشاعر.
فقد قدم شعره بمرافقة الموسيقى والغناء في أكثر من مناسبة، حيث عزف إلى جانبه الموسيقار العراقي الشهير نصير شمة، الأمر الذي يؤشر على أن التجربة الشعرية الأدونيسية لا تنأى عن المتلقي العادي، وإن كانت في فحواها أقرب للمثقف النخبوي، إلا أن ضغائن النقد المسطح وما أثارته رؤى أدونيس وأفكاره من سجالات حادة بين المتفقين معها والمختلفين، حرمته في كثير من الأحيان من أن يصغى إليه بالشكل المطلوب لشاعر بقامته
* * *
تكتب زوجته ورفيقة عمره خالدة سعيد في تقديمها له عبر «كتاب في جريدة» الذي صدرت طبعة منه تحت عنوان «هذا هو اسمي»: «لا تستريح القصيدة عند أدونيس في شكل مستقر فقصائده تاريخ من البحث والتجاوز وإعادة النظر. والحداثة عنده ليست شكلاً يبلغه الشعر، بل مشروع تصور جديد للكون. وينهض الشاعر بمشروعه الكبير مستندًا إلى رؤية معرفية متكاملة للإبداع، ودوره في التاريخ، وموقعه من العالم».
يظل الاقتراب من شخصية أدونيس حافلا بالتساؤلات، وفي الطريق إليه، ثمة ألغام، تجاوزها يعني الاحتماء برؤية تنهض على المعرفة العلمية الجدلية، التي تحقق من خلال منهجها هذا، رحابة استثنائية في الوعي، فالقصيدة عند أدونيس، هي مبنى تتخلله حركة وجود متكامل يقوم على طرد اللحظة الساكنة، وإطلاق ما يكمن في ثبات الأشياء من حركة.
من هذا المبعث، بقي أدونيس محافظا على دائرة السجال المنفتحة حول مشروعه النهضوي الكبير، وقلة هم أولئك الذين يكرسون حياتهم للمشاريع الكبيرة، ويبنون مداميكها على التنوع والاختلاف وإثارة الأسئلة وبعث القلق في المعنى، وتحريك الساكن وهز شجرة القناعة، وأدونيس من هؤلاء الذين يبدو الاختلاف حوله مثل الاتفاق عليه، مشروع بذاته، ومشروع بفكره وإبداعه الشعري، الذي ما زال السجال محوره والجدل فضاءه الشاسع، والتحول سمته التي لا تتوقف عبر الزمن، والكشف مركزه.
فقبل أدونيس زمن، وبعده زمن، والذين يقفون في معاكسة هذا الفهم، يقفون في وجه الحقيقة التي يسمح لنا فضاء الشاعر هنا والمفكر هناك أن نختلف معه أو نتفق، لنبني ونسأل ونجعل من دعوة الاختلاف سمة نرفع بها بنياننا الذي ما زال يحاول الارتفاع.
على يديه نهضت قصيدة النثر، وكانت قبل ذلك تمشي على استحياء في المخيلة وفي التجربة وفي العلن الذي حقق قوة تجليه: أدونيس، ولأن قصيدة النثر ليست مجرد سياق فني تعتمل فيه قوة التغير في الشعرية العربية، وإنما هي مشروع نهضوي ينطوي على إقامة في مساحة من التحديث الفكري، وعلى نهضة العقل، وعلى خرق مفهوم التكريس والقداسة اللغوية، فقد مرت ( الحالة الأدونيسية ) بكثير من الظروف التي حاولت كبح طاقتها على صناعة التغيير في الوعي، وما زالت هذه التجربة تجد من يحاول الحد من تقدمها في برية الرطانة العربية، المأخوذة بولهها بما هو ثابت، والمكسوة بالخوف من التغيير.
* * *
في أمسية له بعمان، كانت هي الأولى على ما أعتقد، في أواسط تسعينيات القرن العشرين، وقبل أن يصعد منصته لإلقاء أشعاره، بعد أن قدمه عريف الأمسية، الكاتب إبراهيم العجلوني بكلمات مشحونة برؤى المتصوفة وأنماط كلامهم، سمع في أقصى القاعة، هتافا يندد بالأمسية وشاعرها ومن أحضره إلى هذا المقام، كانوا مجموعة من الشباب الذين بدأ ظهورهم بهذه النمطية من السلوك التكفيري يقفون في ذلك الأقصى، وجاءوا خصيصا لشتم الرجل، الذي وقف مبتسما بقامته الصغيرة وشعره المتناثر، وجعل يصفق لهم، دالا على أن أهمية هذا الارتباك الذي جاء بمثل هؤلاء الشباب للتنديد به، هو في حقيقته تأكيد على مشروعية ما يذهب إليه، لقد منحوه شرعية أن يكون مثلما أراد، لا مثلما يريدونه على طريقة «الجمهور عاوز كده»، فهم ومن يقفون في صفهم من مناوئين لما ينتجه أدونيس أو يراه، لا يريدون النظر في المرآة: إنهم عميان، وأن تنبيههم بالتصفيق الذي كان لحظتها يشبه التحية لهم، إنما هو لإعلان حالة من الزهو التي استطاع أدونيس من خلال سعيه لأن يكون مغايرا، أن يسهم بخلخلة سكونية الثبات في وعينا.
في شهادته عنه يقول جوزيبي كونتي: «أدونيس لا يعود إلى بيته، انه لا يقوم بالعودة إلى ذاته ولا برحلة عودة الروح في بحثها عن الجذور وحقيقتها. إن أدونيس هو عوليس جديد، لا يعرف حدودا، قطع الحبل الذي يربطه بالشاطئ، كالمصغي إلى أغنيات عرائس البحر، وكأنه قطع الحبال التي تشده إلى الصارية. انه عوليس المحب لهيجان الأمواج، وحركة البحر الاستعارية أكثر من أي حقل اخضر أو أية ارض أخرى..عوليس منفي، يسكن كلماته ومنفاه. ملك ايثاكا، شاعر شرقي يحمل المعرفة كاشفة الأسرار والتي بإمكانها الصعود بالخطى، حامل للغة تذهب إلى سرد قصص لا تعرفها أو لا تقدر على سردها، هذه الأمواج هي الأبطال الخالدون لحركة البحر الخالدة»..
بهذا المعنى الذي يحاول فيه شاعر فرنسي أن يقدم أدونيس من زاوية تشتمل الأسطورة، وتنهض على عتبة مفازة من الرؤى، يمكن استشفاف تجربة شاعر على هذه الشاكلة، وهو يحاول صوغ عالمه الذي يمضي للأمام لا للخلف، وكاشفا مستبصرا عمق ما يريد الوصول إليه.
أما الكاتب الفلسطيني فيصل دراج، فيرى أن أدونيس يضع «وباستمرار كلمة (الحقيقة) بين قوسين، قوسان دائما الحضور، لأنه و بمنطق الشعر فان البحث عن الحقيقة دائم ولامتناه، وهذان القوسان يمنحان (الحقيقة الشعرية ) وهي دلالة مضادة لدلالة (الحقيقة ) التي تدافع عنها أشكال معرفية».
في معطى ما قاله دراج، نكتشف أن الحقيقة عند أدونيس هي الشك، والبحث الدؤوب عنها، وفي فضاء آخر تقول رفيقة عمره خالدة سعيد: «عندما استعيد في ذهني اليوم مجلة (مواقف) وما كانت تمثله بحيويتها والتزامها كمغامرة جماعية ومعركة على جميع الجبهات الأكثر حساسية في الثقافة العربية، فان صورة تقفز إلى ذهني، صورة طفل عنيد وحالم، يركض وسط حقول طينية نحو مدينة مجهولة ليقرأ قصيدة أمام جمهور يجهله. مقدما بذلك على بدء تحقيق حلمه بتغيير مصيره باللجوء إلى قوة وحيدة هي الشعر، وفي ذات الوقت أرى اليوم رجلا ستينيا طفلا (ذات الطفل ) والذي بعد أن طور حلمه عبر مغامرة (مواقف) يحمل نفس الحلم العنيد إلى ضفاف الحوار الكوني».
هذا هو أدونيس، اكتشاف المعنى في الحقيقة الواقفة دائما بين قوسين، حالمين بان لا تكون الحقيقة هي الحقيقة ذاتها، وان يظل الفتى الذي بدأت سيرته عنتا ولن تنتهي إلا به، لكنه عنت معرفي، كاشف، يسبر ويحدق ويتأمل ويغوص ويفهم ويقرأ، عنت لا يفسر بل يفصح.
* * *
لقد كانت بدايات إشراق هذا الشاعر الخارج من رحم المغامرة، طالعة من مساء ريفي مشغول بالفاقة والعوز، قبل أكثر من نصف قرن، وبالتحديد في عام 1944، حين ألقى قصيدة وطنية أمام الرئيس السوري آنذاك، كان نظمها وهو في سن الثالثة عشرة، وكان وصوله لإلقائها معاناة بذاتها، تعرض فيها الفتى علي أحمد سعيد اسبر الذي لقب نفسه بأدونيس عام 1948، لضنك القدوم إلى محافظة اللاذقية من قريته ومهبط رأسه قرية قصابين، تحت مطر السماء وسيولها على الأرض، وفوق ذلك، كان على الفتى القروي الذي يرتدي زي الفلاحين في تلك المناطق، أن يتمكن من الوصول للمنصة وقول قصيدته التي بذل وقتا في نظمها، متأملا أن تحقق له معجزة ما، وقد تحققت المعجزة تلك، لكن بعد أن نظر إليه القائمون على الحفل الذي يحضره رئيس البلاد، بازدراء، وتركوه مهملا، لولا إشارة من الرئيس، سنحت له أن يتقدم للمنصة ويلقي قصيدته، وحين ينتهي منها، يسأله الرئيس عما يريده، فيطلب منه أن يتعلم، ليأمر بإرساله إلى المدرسة العلمانية في طرطوس، وهناك يجتاز مراحل التعلم الأولى بسرعة غير مسبوقة بين أبناء جيله، ثم ينتقل إلى الجامعة، هذا الذي تلقى دروسه الأولى في اللغة على يدي والده، فحفظ القرآن ودرس الشعر ونظمه مبكرا، ولم يكن له من قبل أن اقترب من سور مدرسة نظامية، ولعل قصيدته التي نالت إعجاب رئيس سوريا هي التي منحت قريته بعد ذلك مدرسة نظامية.
هذه الومضة السيرية عن أدونيس تعيدنا إلى مسلكه لاحقا في فتح أفق الكشوفات الحداثوية في الثقافة والفكر العربيين المعاصرين، وقدرته على قراءة هذه الفكر وتلك الثقافة بانتخاب فريد، منحه أفقا محملا بدلالات عاصفة في الرؤية وتطبيقاتها الفكرية.
فالوقوف أمام رئيس دولة في سن كهذه، وإنشاد قصيدة بين يديه، وجرأة الإقدام على ممارسة دور المنشد في مناسبة من هذا النوع، وبحضور مهيب لشخص الرئيس وأفراد من حكومته وأعيان البلاد، كلها تجتمع في شخصية الفتى الريفي، الذي بدت ملابسه التقليدية مزرية، بعد أن بللها المطر، وهو قادم على أقدامه منهكا ومتعبا.
لقد حقق المعجزة التي لم يحققها أحد من قبله في «قصابين» وفي القرى المجاورة لها ربما، ونال منحة دراسية في واحدة من المدارس الجيدة في ذلك الوقت، وأبدى تفوقا باهرا في تعلمه.
إنها إشارات تسوقنا إلى الحالم، الذي لم توقفه صعاب الحياة، والتي اقتحمها دون أن يكون مترددا أو هيابا، وهو ما سيكون ماثلا لكل من يعاين شخصية أدونيس من قرب أو في منتجه الشعري والفكري.
حين التحق بالخدمة العسكرية عام 1954، أمضى سنة من خدمته في السجن بلا محاكمة، وكان السبب انتماؤه للحزب السوري القومي الاجتماعي، والذي لم يستمر في الانتماء إليه، وأعتق روحه منه عام 1960، لان روحه القلقة تواقة لمنطقة كشوفات أخرى غير التي تستقر في مهابة الأيديولوجيا ولعنتها الأبدية، والتي تمنحه فرصة أن يحلق بمنابت أجنحته التي كانت بعد في بداية نموها، لينطلق بعدها إلى مسافة الحلم الذي يربض في حركة وجدانه، ويترصد اللحظة التي يخرج فيها منه، كلمحة ضوء ما زالت مستقرة في وعينا، ووارفة مثل شجرة عالية.
في سوريا لم يكن مقام أدونيس ظليلا، وكانت بالمحاذاة منه بيروت، التي تعج بحركة لا تضاهى في الثقافة والفكر والإبداعات الأخرى، كانت بيروت في تلك الحقبة وإلى وقت قريب، عاصمة للثقافة العربية، وبدت بيروت التي سيكتب عنها أدونيس بعد سنوات طويلة، نصا يلقيه في واحد من مراكزها الثقافية وهو مسرح المدينة، مثيرا ضغائن لبنانيين عديدين عليه، هي مدينته التي سوف يحمل فيها تضاريس روحه المتشوقة للانعتاق والتغيير والكشف والتفارق مع ما هو سائد، وهناك تبدأ رحلته، التي منحته الاسم الحركي الأول لمغامرة الحداثة، والتي ما إن يرد اسمها على أي لسان أو في أي وعي عربي، حتى يكون أدونيس في نار شتيمتها أو في مهبط مديحها النبيل.
في بيروت التي يصلها عام 1956، قادما من دمشق، يلتقي ادونيس رفاق الجمر الأوائل، ويشكل مع يوسف الخال، حالة استثنائية في تاريخ الحداثة العربية الشعرية، يصدران معا مجلة «شعر»، والتي تصبح لاحقا ملتقى لكل الحالمين، ويصدر العدد الأول منها بداية عام 1957، ولتؤسس «شعر» موقفا شعريا عربيا، يتفقد القصيدة العربية في منطقة النثر، والمغايرة، والاختلاف، والتحرر من تابوات كانت تربض فوق صدر الثقافة العربية وفكرها الذي ما زال إلى اليوم يرزح تحت وطأة التابوات ذاتها، ويحملها على جلجلة التغيير، تلك التي جوبهت بعواصف نقدية، ما فتئت نيرانها تهدأ، وكان أدونيس رأس الكارثة بالنسبة لمن وقفوا ضد تيار الحداثة التي جلبتها مجلته، تلك التي اتهم من يديرونها بأنهم هم مجموعة من ذوي العقد الإثنية والدينية، لتدمير الثقافة العربية الرصينة، الواقفة عند مسرودات الجاحظ، ومدائح المتنبي، وما بعدها هو مجرد هذيان، صار بعيد ومضة من الوقت، نوعا من تخريب للثقافة العربية وتدمير أصالتها وجزالة لغتها وانتهاك قدسيتها.
في اللقب الذي اتخذه علي احمد سعيد اسبر، «أدونيس»، تكمن رغبة صاخبة بتجاوز المألوف والسائد، وصياغة صيرورة تتمكن من معانقة المدهش، وتحتمي بقناع الأسطورة، تلك التي تبدو في الأفق غائبة عن وعي التوظيف الأيديولوجي، لكنها في مرماه، يستبد بها، ويتمكن منها لتوظيفها، والحقيقة التي لم ينج منها هذا اللقب في مبتدأ إطلاقه على صاحب «مفرد بصيغة الجمع» و«أغاني مهيار الدمشقي» «والكتاب» بأجزائه الثلاثة، تشي ولو من بعيد أن علي اسبر اختاره من باب التمثل بالأسطورة السورية، التي تقول بان «أدونيس» هو اله الخصب والمطر والنبات، وهذا البعد، تكمن في محمولاته إشعاعات الأفكار التي تمثلها أفراد الحزب القومي السوريين الذين أعادوا في معطى فكرتهم عن سوريا أو سوراقيا، الانتباه إلى تراث سوريا الطبيعية والتفاعل معه ومحاولة استخدامه في أدبياتهم رمزا ومعنى وتفكيرا.
لكن «أدونيس» الذي يخرج من الحزب، يبقى ممتثلا لشهوة الفكرة التي يحملها معنى أدونيس الإله، أدونيس الخصب والنماء، ولا ينأى عنه، بل يتمسك به، كإرث يصبح الانفصام عنه انفصاما عن معطى التجربة الكاملة للشاعر والمفكر والكاشف والرائي، ويغيب في لحظة الانشداه أمام بعث أدونيس الشاعر الرؤيوي، كل ما من شانه أن يوظفه أيديولوجيا، ويصبح لقب أدونيس مفردة تحتمي بتوق صاحبها إلى أن يكون حركة في دائرة التغيير والخصوبة والنماء داخل ثقافة، حركتها ثابتة، وقد توضح هذا الفهم في رؤية أدونيس لاحقا، حين وضع رسالته في الدكتوراة بهذا المنحى «الثابت والمتحول»، ولتشكل فضاء شاسعا ومديدا لبعث أفكار التجديد في الروح العربية ومدها بكل ما يسعى إلى أن يعيدها إلى منبت انعتاقها، خصبا ونماء.
توقفت مجلة «شعر»، لأنها كان يجب أن تتوقف، ولأن مساحة حركتها استنفدت في تعاطي الحداثة الشعرية والفكرية من زوايا أثارت غبارا كثيفا في عيون الذين وقفوا ضدها، وجعلت حالة من الشقاق تتلبس أفرادها القائمين عليها، وتفرد بعضهم بالصيغ التي يرى أنها الأكثر مراسا في صقل الرؤية الحداثوية، فانفرد أدونيس بإصدار مجلته «مواقف» عام1968، التي لم تكن في مرمى حيويتها كما كانت مجلة «شعر» وتوقفت هذه المجلة لاحقا، دون أن تترك ذلك الأثر الذي ما زالت «شعر» تحكيه إلى اليوم لنا.
غادر أدونيس بيروت عام 1985 للإقامة في باريس، لأن الحرب الأهلية اللبنانية كانت مشتعلة، وفي باريس بدأت رحلة جديدة له مع الكتابة والترجمة، وما زالت باريس إلى اليوم ملاذه الذي يلقي على كتفيه رأسه، ومن باريس، نرى أدونيس حاضرا في الثقافة العربية بقامته المديدة.
وفي واحدة من الشهادات العذبة عن أدونيس يقدم الشاعر قاسم حداد أفقا آخر، يكون فيه الشاعر أدونيس شخصا وشاعرا في لحظة واحدة، يقول: «على الصعيد الشخصي، لا يمكن تفادي القول إن لأدونيس شخصيته الآسرة، التي لا يستطيع المرء نسيانها بعد اللقاء الأول. فلأدونيس قدرته السحرية على منحك شعورا بالحميمية معه، وبالنسبة لي أعتقد دائماً بأن للشاعر شخصية لابد من التقاطها للوهلة الأولى، شخصية تسهم في صوغ تجربة نص الشاعر وامتزاجه بهواء الحياة. سوف تظل شخصية أدونيس من بين أندر الذين صادفتهم من حيث طبيعتهم الإنسانية التي تتيح لك الشغف بها عندما ترغب. فطوال سنوات صداقتي بأدونيس، لم أسمع منه كلمة سوء في حق شخص آخر، رغم تفشي حمى أجواء الكلام العام، من هنا أعتقد بأن للجانب الشخصي في تجربة أدونيس دوراً حاسماً في محبة الكثيرين له، وستجد نفسك مأخوذاً به كصديق استثنائي. وإذا كان لأدونيس أن يشعرك بحقك في الاختلاف معه، فمن المتوقع منه، أيضا، ألا يفرط في هؤلاء الأصدقاء الذين يحبونه ويحترمونه ويضعون تجربته الإبداعية في مكانها اللائق والمناسب، متشبثين بحقهم في الحب وحقهم في أن يتكلموا عن الحب والحرية.. بحب وحرية أيضاً. وألا يكونوا عرضة للاستعداء لأي سبب».
جريدة الرأي الأردنية 20/5/2005