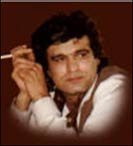 ثمة من يسأل بريبة عن السبب الذي يجعل الشعراء يتكاثرون ويتدفقون، كما لو أن طوفاناً شعرياً يحكم العالم منذ طوفان الخليقة البابلية..؟ وهو سؤال ينطوي على مشروعية واضحة خاصة إذا ما جرى تنقيح صياغته ليتصل بتكاثر عدد الشعراء العراقيين كتوصيف تمثلي لهذا الطوفان وليأخذ، بعد ذلك، شكل سؤال جدلي : لماذا تتكاثر سلالة المتنبي والجواهري، مثلاً بينما تندر أو تنحسر سلالة ابن خلدون وعلي الوردي على سبيل المثال!
ثمة من يسأل بريبة عن السبب الذي يجعل الشعراء يتكاثرون ويتدفقون، كما لو أن طوفاناً شعرياً يحكم العالم منذ طوفان الخليقة البابلية..؟ وهو سؤال ينطوي على مشروعية واضحة خاصة إذا ما جرى تنقيح صياغته ليتصل بتكاثر عدد الشعراء العراقيين كتوصيف تمثلي لهذا الطوفان وليأخذ، بعد ذلك، شكل سؤال جدلي : لماذا تتكاثر سلالة المتنبي والجواهري، مثلاً بينما تندر أو تنحسر سلالة ابن خلدون وعلي الوردي على سبيل المثال!
غير أن مقاربة تكاثر الشعراء بالطوفان، ليست مجرد بلاغة لفظية! فالطوفان والشعر توأمان في الملحمة العراقية المستمرة منذ كلكامش إلى طوفانات الدم المتدفق باستمرار تحت حد فادح لسيوف الطغاة والغزاة على الحد ذاته، وهو توأم طوفان الدموع ، منذ مراثي المدن السومرية مروراً بمجرى دموع الشيعة في عاشوراء، وصولاً إلى نهر الدموع العراقي في القرن العشرين وما بعده!
وليكن أن لا أهرامات في بلاد النهرين ولا شيء من بنيان الأقوام السالفة بقي صامداً في وجه الزمن سوى الكلمات التي تبني مجداً لا ينهدم، والدم والدموع اللذين يديمان هذا المجد.
لكن مجد الحضارات ليس في بنيانها المادي فحسب على الرغم من أن الفيلسوف الألماني أوزوالد شبنغلر يرى أن أساس بقاء الحضارات هو قوة المادة التي بنيت منها صروح الأولين.. ولهذا بقي من حضارة المصريين الأجساد المحنطة والحجارة القوية، فيما لم تبق من طوفانات العراق، منذ أتونابشتم، سوى الملاحم التي استعارها الإغريق منذ هوميروس!! لماذا نريد من النهر أن يكون جبلاً ومن الصلصال أن يصبح صخراً، ألا يكفي الطين والماء لتدوين المجد..؟
صحيح أن كثرة الشعراء العراقيين في الداخل والخارج كثرة مخيفة.. حتى أنها صارت طرفة يرددها بعض العرب: كل عراقي شاعر إلى أن يثبت العكس..!
من هذا الباب نقول أن الشعر بدا وكأنه حمار الفنون، وبدا شكله ـ منذ قصيدة النثر ـ الأنسب لمن لديه لواعج ومشاعر ويوميات محبة وكراهية يريد تدوينها على الورق، وهذا لا يضير فالكتابة حرية فردية وشأن شخصي، ومن يكتب كراهيته على الورق مثلاً، خير ممن يصدرها لنا بوسائل أخرى أكثر عنفاً.
بيد أن الشاعر ليس حامل الربابة الذي يدور بحثاً عن سلطان يمدحه أو امرأة يتغزل بها، إنه صوت يأتي من مكان آخر ترتج لمقدمه عروش الطغاة وتستهدي بمصباح خياله عقول الفلاسفة ، ولنتذكر أن الفيلسوف الألماني الآخر هايدغر قد خصص بحثاً مهماً عن الشاعر هولدرلين وقرأ ريلكه أيضاً، وقال جملته الشهيرة: أه لو يتعلم الفلاسفة من الشعراء! حتى أنه صار يستشهد بشعر هولدرلين كما يستشهد مسيحي بالكتاب المقدس.. وكان نيتشه شاعراً أيضاً ولا داعي للتذكير بأن الفكر الألماني لا يمكن عزله بأية حال عن الشعر، والتجارب هنا أكثر من أن ترصد، ولنتذكر أيضاً أن شعراء اليونان مهدوا لفلاسفتها فهوميروس وسوفكليس وإسخيليوس كانوا مبشرين بربيع العقل الإغريقي ، كانوا هم آباء الفلاسفة، حملوا فوانيسهم ليكمل الطريق فلاسفة اليونان الذين جاءوا بعدهم ليشيدوا أثينا..
هذا في الثقافة الأوروبية، أما التراث العربي فلا يخلو من قرائن مماثلة فنحن نعرف أن أبا العلاء كان ذا رؤية تأملية خاصة للعالم، وكانت لأبي العتاهية فلسفته كذلك، ونتذكر قراءة الصولي لشعر أبي تمام...
لكن الموضوعية تقتضي أن نقول أيضاً أن الكثرة الكاثرة من الشعراء اليوم.. هم زبائن شعر يرتادون عالم الشعراء ويتبضعون منه وربما يبيعون منه لاحقاً، وربما لهذا ظل الشعر يستهوي الجميع وكأنه مآل للباحثين عن المجد الزائف أو الوجاهة الاجتماعية وسواهما، مع أنه لدى الشعراء ـ الشعراء الداء الذي لا دواء له! فقد طوى المتنبي تحت جنحيه أكثر من ثمانمائة شاعر عاصروه، ورنقوا حوله، لكنه طار بعيداً ووحيداً في سماء يعرفها مردداً:
وما الدهر إلا من رواة قصائدي
إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا
ودع كل صوت غير صوتي فإنني
أنا الطائر المحكيُّ والآخر الصدى.
غير أن غالبية الشعراء اليوم يحاولون انتماء للمتنبي ولا يجسدون مثل هذا الانتماء سوى بتصدير المآزق الشخصية عبر الشعر بدل أن يشحنوه بتجاربهم، وعليهم هنا أن يتذكروا الرائع أبا نؤاس صاحب أكبر تجربة حياتية متجسدة في أشعاره التي لا ترقى إليها تجربة في الشعر العربي القديم وتضاهي غالبية الحديث أيضاً!
بقي شيء أساسي وهو أن من الواضح أن من يطرح التساؤل عن كثرة الشعراء ودور الشعر، يعبر عن استياء ما يتعلق بكون الشعر أضحى بمثابة البنية المهيمنة في الثقافة العراقية والعربية عموماً، البنية التي تضغط بقوة على القاعدة حتى لا تدعها تنتج إلا ما يقاربها، وحتى تتراجع مع طغيانها البنى الأخرى ولا سيما البنية الفكرية.. هذا الكلام يصح إلى حد ما ولكنه لا يعفي أحداً من المسؤولية المشتركة في طبيعة النظر إلى الشعر، وحتمية أن يعاد النظر إليه لا بوصفه غناء وأحاسيس ودلالات جمالية فحسب، بل بوصفه منظومة خطاب مركب يستدعي تحليلاً عميقاً، لكن القصور مستفحل ـ مع الأسف ـ في نظرة عدد وافر من المثقفين والسياسيين للشعر جعلهم يحملون عنه انطباعاً خفيفاً وفهماً يقترب من السذاجة، وخلطاً وعدم تمييز يعبر عن تجاهل أو جهل ثقافي بأهم نشاط في تاريخ الثقافة العربية؟
هل استطاع هؤلاء مثلاً أن يقرأوا الجواهري بوصفه ديوان العراق! ومساراً لتحولات و صيرورة الإنسان العراقي حتى قبل قيام الدولة العراقية إلى نهايات القرن العشرين؟ واستفادوا مما تسلطه هذه التجربة المفصلية من ضوء على الشخصية العراقية خلال قرن، مثلما نقرأ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق لعلي الوردي مثلاً؟
يبدو أن مثقفينا الآن يكابدون من فكرة غياب الأب في الفكر العربي، ذلك أنهم يبحثون عن إباء ولكنهم يصطدمون دوماً بعقدة كلكامش ولا يستطيعون إنشاء أثينا جديدة أو حتى دخول أثينا القديمة ربما بسبب خطأ أفلاطون بطرد الشعراء من جمهوريته!
ليس من ضير إذن أن يكون جلجامش الأب الأول ولنقرأه آلاف المرات ولنقرأ أحفاده وسائر سلالته.. وأه لو يتعلم الفلاسفة من الشعراء.