مقدمة:
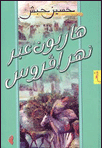 ظهر هذا الكتاب، وهو الديوان الثاني للشاعر، بعد فترة قصيرة من وقوع الأحداث الدامية التي شهدتها مدن القامشلي وعفرين وحلب السورية، حتى لَيُخيل لقارئ الكتاب أنَّ الشاعر كان في حكم الذي يتوقع أو يتنبأ بأنَّ أمراً جللاً لا بدَّ واقع في هذه المدن تصطبغ فيه سماواتها والأرضين بلون الدم الكردي الزكي الأحمر القاني. قرية شيخ الحديد التابعة لقضاء عفرين هي مسقط رأس الشاعر ومسارح طفولته وشبابه وموطن أهله وذويه.
ظهر هذا الكتاب، وهو الديوان الثاني للشاعر، بعد فترة قصيرة من وقوع الأحداث الدامية التي شهدتها مدن القامشلي وعفرين وحلب السورية، حتى لَيُخيل لقارئ الكتاب أنَّ الشاعر كان في حكم الذي يتوقع أو يتنبأ بأنَّ أمراً جللاً لا بدَّ واقع في هذه المدن تصطبغ فيه سماواتها والأرضين بلون الدم الكردي الزكي الأحمر القاني. قرية شيخ الحديد التابعة لقضاء عفرين هي مسقط رأس الشاعر ومسارح طفولته وشبابه وموطن أهله وذويه.
يُلفت الكتابُ النظرَ إلى تمسك الشاعر وبقوة بذكرياته وأقواها عادة تلكم المتعلقة بالأب والأم والأشقّاء والتربة التي تركهم عليها أحياء. ثم وجدانه نفسه جدَّ قريب من طفلته الأولى ( هيفا ) وأم هيفا اللتين شاركتاه المنفى والمُغتَرَب وقسوة البعد عن الأهل والوطن.
وما دام الشاعر كردي الأصل والدم فلا عجب أن نراه يُمجد شعراء كردستان والقبائل الكردية التي عاشت في المنطقة في العهود الموغلة في القِدم. بل ويذكر بفخر انتصارات الميديين في حروبهم ضد الغزاة. بل ويذكر أسطورة كاوة الحدّاد الكردي الذي بطش بالملك الدموي المستبد.
أستعرض الكتاب وما جاء في أهم مفاصله :
إلى أبويه أهدى حسين محمود حبش هذا الكتاب الأنيق الطبع والغلاف ( 88 صفحة متوسطة القياسات ) والذي يضم إثنتين وثلاثين قصيدة. أجل، إلى أبويه أهداه في وقت أصبح الشاعر فيه أباً لطفلة وطفل يُعمّقان لا شكَّ فيه حب وتكريم الأبوين ويجدان هما فيه جسراً يربطهما بأصلهما وبدماء الأجداد. بأطفالنا نتممُ دائرة الوجود.
ابتداء… لا بدَّ من أنْ ألفت النظر إلى ظاهرة رصدتها في شعر حسين محمود حبش أُثبّتها لكيما أُساعد قارئ شعره على ملاحقته وفهمه بشكل جيد، ثم إنصافاً للشاعر وتقويماً لأسلوبه وطريقة معالجته لموضوعات شعره. أعني قدرته على الحركة والتعبير في ثلاثة مستويات : مستوى التعبير بالكلام الواضح ومستوى التعبير الرمزي - السوريالي وأخيراً مستوى التعبير بالكلام غير المكتوب لكنه الكلام المفهوم الذي يستنبطه القارئ ويفسره حسب اجتهاده (كلام ما بين السطور وذاك المخفي في صدر الشاعر أو حتى الغائب عن وعيه ). يمكن تشبيه هذا المستوى من التعبير بحركة سمكة تسبح في الماء قريباً من سطحه، إذ يرى المُشاهد على سطح الماء خطوطاً دائرية وأخرى مستقيمة تتبع حركة السمكة في الماء لكنه لا يرى هذا المخلوق المائي المتحرك، هنالك ما يدل عليه حسب.
القراءة المتأنية للديوان جعلتني أستنتج أن لدى الشاعر خصيصة أخرى مُضافة هي قدرته، على مستوى القصيدة، على القيام بانتقالات رأسية ما بين المستويات الثلاثة آنفة الذكر صعوداً ونزولاً. فالكلام الواضح قد يصبح فجأة سوريالياً أو أن يختفي وراء السطور أو أن يغوص في صدر الشاعر. كما أن لديه المقدرة على القيام بانتقالات أفقية خلال قصائد الديوان. أقصد تمكنه من خلط منطقتي اللون الأخضر والأحمر أو الانتقال الأفقي المرن من هذا القطب إلى القطب الآخر. التحام الابن - الأب من خلال الإنسان الجوهر بالثورة وقضية تحرر الأمة الكردية المشتتة والممزقة.
إذن يتوزع الشاعر في هذا الديوان من قصائد النثر بين قطبين حادين أحدهما أخضر والثاني أحمر: يكون في القطب الأول إبناً باراً وأباً حانياً، شديد الحنو. ويكون في القطب الثاني المقابل ثورياً يحمل الراية المثلثة الألوان حاثاً على الثورة، مرتكزاً على التراث القديم والحديث للشعب الكردي وأمجاده النضالية وموروثه الثقافي الثوري. يكرس القطب الأخضر لوالده (قصيدة في مديح أبي) ولأمه (قصيدة تراتيل أمي) ولأخيه محمود (قصيدة محمود الصغير ينصب الفخاخ للقبّرات) ولطفلته الأولى هيفا (قصيدة دَناني…
دَناني) ثم قصيدة (دموع هيفا). أما القطب الأحمر فهو مكرّس لقضية الفخر بالانتماء الأصيل للعِرق القومي الكردي وتأريخه المجيد مُذ ما قبل المسيح حتى زمن الشاعر (شيركو بيكس) العراقي المعاصر. في مساحة هذا القطب نجد قصيدة (فجيعة النزول من جبل آغري) وقصيدة (هاربون عبر نهر إفروس) وقصيدة (الرحابة الطليقة لأوقيانوس
اللهب).
في يد يحمل الشاعر إبنته هيفا ويرفع بالأخرى راية التحرير. لا تناقض بين الأحمر والأخضر أبداً، أبداً. يلتحمان في جيل جديد مولود في المنافي يُعدّه الآباءُ فيلقاً آخر لرفع علم التحرر والإعتاق وكسر الحدود المصطنعة.
أما المنطقة الوسطى ما بين هذين القطبين فقد تركها الشاعر للماء والبحر الذي يخشاه،
لأسباب نجهلها، حيث غطى هذا الموضوع 12 صفحة موزعة على أربع قصائد هي (فرات) و (هاربون عبر نهر إفروس) و (هتاف الماء) ثم قصيدة (مساهمات البحر). كما كرّس الجزء الآخر من هذه المنطقة لسياحات غير محدودة في الأزمنة والأمكنة مطوّفاً في حديقة يابانية تارةً وبين عالم الحيوانات الأليفة تاراتٍ أُخَر.
قصيدة " تراتيل أمي "
رسم الشاعر في الجزء الأول من هذه القصيدة الذي أسماه (ترتيل الرؤية) لوحة بالغة الروعة والدلالة. فقد وضعنا الشاعر وجهاً لوجه أمام أُمهاتنا الغائبات عنّا والمؤمنات بالغيب وما يحمل الغيب لهنَّ من خيالات وتداعيات فيختلط الأمر عليهن حتى ليغدو الوهم والتخيّل واقعاً يرينه رأي العين. إذا كان الإبن بعيداً بجسمه عن أُمه التي أنجبته فإنه مع ذلك سيبقى ذلك الإبن الذي حملته وهناً على وَهنٍ ومن ثم أنجبته فأرضعته حتى إستوى صبياً فشاباً يافعاً فأباً لطفلين. أعاد الأمانة أخيراً لأبويه بتخليدهما فيما أنجب. أكمل دورة الحياة. كيف تنسانا أُمهاتنا، كيف؟ نقرأ هذا المقطع ولنستمتع بسحر هذه اللوحة الإنسانية المفعمة بالدفء واللون والخيال وكثافة الحميمية العائلية :
ترتيل الرؤية
في هذا الصباح، كانت أُمي تجلس في البيت وحيدةً
تُرتّقُ بنطال أخي محمود الممزّق من شقاوة البارحة
إنغرزتْ الإبرةُ في إصبعها، سال الدم حارّاً على الخيط، تلطّخَ البنطال
وتشوّشت أفكار أُمّي
أقسَمت لأبي ولكل الجيران
إنها رأتني أو رأت ظلّي أو رأتني دون ظلي أمرُّ أمامها هذا الصباح
وحين رأتني،كما قالت،
إرتبكت من اللهفة وكادت أن تعانقني
لكنَّ الإبرة خانتها وإنغرزت في الإصبع.
أرأيتني كنتُ حقّاً هناك،
أم كان قلب أمّي؟
هل هناك ما هو أروع من هذا التتابع في السرد اللفظي المباشر المتناسب مع درجة التوقع والأمل والإغراق في الظن تحت وطأة قدرة بعض حواس الإنسان على الخداع والإيهام. نقرأ ثانية سطر التدرج في الأماني التي تتحول في عين الأم إلى حقيقة أو نصف حقيقة أو حتى إلى بعض الحقيقة:
إنها رأتني أو رأت ظلّي أو رأتني دون ظلّي أمرُّ أمامها هذا الصباح
إنها رأتني… أو رأت ظلّي… أو رأتني دون ظلّي…
إذا تعذّرت رؤية الحضور الكامل للإبن فلا بأس من رؤية ظله…رؤية شيء يدل عليه، أو حتى رؤيته ناقصاً… دون ظله. ماذا يتبقى للمرء إن فقد ظله ؟ والظل لا يكون إلا في الشمس نهاراً أو تحت ضوء المصابيح ليلاً. تريد الوالدة أن ترى إبنها الغائب والمتغرّب بأي ثمن، ليلاً أو نهاراً.
وحين رأت الأم إبنها في عالم لا يمتُّ لعالم الحقيقة بصلة، هالها الأمر ففقدت السيطرة على حركات أصابعها فوخزتها الإبرة وسال الدم فاصطبغ بنطال أخيه بلون دم أمه. في انفتاح الجرح رمز ودلالة وجودية بالغة العمق مفادها أن الشاعر أراد بذلك أن يلفت نظر الوالدة أنَّ ما يتراءى لها هو أمر غير حقيقي. أرادها أن تفيق من أحلامها الخادعة فصدمها أو صعقها بألم الوخزة ثم بحرارة الدم الذي جرى على نسيج ملابس ولدها الآخر. الولد الصغير محمود هو البديل وهو القادر في أنْ يجعل الوالدة تسلو الشاعر المغترب البعيد أو أن يساعدها على نسيانه إذ تتعزى به. فلماذا تتهرب الأم مما هو واقع وتجنح إلى عالم الأخيلة البعيدة عن واقع الأمور؟
في المقطع الثالث الذي أسماه (ترتيل الشغف) ينجح الشاعر حسين في هندسة لوحة تنضح دفئاً وعفوية لبيت ريفي وأجواء قرية كردية سورية فيجمع بين عناصر ومكونات الطبيعة المتوفرة في القرية من رُقُم وطين وحجر وحديد ثم لا ينسى أن يوشح هذا التشكيل المادي الطبيعي بإطار روحي ديني فيذكر الإمام علي وسجادة الصلاة. حس التوازن بين ما هو مادي وما هو روحاني حس سليم وقوي لدى الشاعر. هو متوازن دائماً سواءً على صعيد القصيدة أو على مستوى الديوان ككل، كما وجدناه متوازناً بين اللونين الأخضر والأحمر. نقرأ بعض ما جاء في هذا المقطع:
الرُقيمات المرسومة على جدران بيتنا الطيني،
الكحل الأصفر،
صورة العائلة المعلّقة باعتناء قرب صورة الإمام علي،
بقايا الوشم على صاج الخبز الحديدي،
الحجر الكبير الهادئ أمام الباب والمتأهب دائماً لاستقبال الضيوف،
الرفوف الضاجّة بالجرائد القديمة،
…
السجّادة المُعلّقة دائماً للصلاة،
الضحكة المقدسة التي أدّتْ كل هذا الشغف، وكل هذا التعب،
هي ضحكة أمي.
ضحكت الأم أخيراً حين أفاقت فلم تجد شيئاً من ولدها حسين، لا حسيناً بظلٍّ ولا حسيناً دون ظل. خيال مُضلل ووهمُ من لا يريد أن يفقد الرجاء: الأمل، قوة التأمل في الأمل هي قوة قاهرة عابرة للزمان والمكان.
أنتقل الآن من المساحة الخضراء إلى نقيضها المتوحد معها والمندمج فيها: عالم البقعة الحمراء.
قصيدة " الرحابة الطليقة لأوقيانوس اللهب"
في تنقلّه في هذه القصيدة من مستوى الكلام المباشر والمُعبّر بوضوح عن نفسه إلى مستوى التعبير بالأسلوب الرمزي - السوريالي الغامض حيناً والشديد الغموض أحيانا، تظل لغة الشاعر الثالثة التي نحسُّ بها ولا نراها، نقرأها بحروف ليست مكتوبة، تظلُّ اللغة المسيطرة والسائدة على جميع ما عداها من حروف ولغات وأصوات. تنتقل معه من سطر لسطر ومن فكرة لأخرى ومن مقطع لآخر. إذ قد جعل الشاعر من هذه القصيدة إنسكلوبيديا مصغّرة لتأريخ الأمة الكردية التي ينتمي إليها. عِلماً أنَّ قراءة التأريخ هي في نهاية المطاف
مغامرة إستكشافية حصيلتها ونتائجها ليست بالضرورة تامّة الوضوح. فضلاً عن ذلك قد
لا تكون منطقية أو مقنعة.كما أن بعض مفاصل التأريخ هي من الغموض بمكان. وعليه فقد فرض التحرك في مجاهل التأريخ المتفاوتة المضامين والتفاصيل، فرض على الشاعر توظيف أساليب ومستويات شتى من أشكال التعبير ومن آليات الاقتراب من هذه المضامين والتفاصيل والتماس معها ومحاولة إستقرائها وإستنطاقها وإجلاء العتمة والغموض عن بعض جزئياتها.
لم يشأ الشاعر أن يترك شيئاً من تأريخ أمته، فلقد أشار حتى إلى موضوع الأكراد اليزيدية في معرض كلامه عن (الكلي الأعظم) فذكر نبيهم (ملك طاووس). هذا فضلاً عن ذكره الصريح لأسماء قبائل كردية عاصرت عهود ما قبل الميلاد ( كاساي - خالدي - ميدي - كوتي ). ولعل هذه القبائل أو بعضاً منها كان قد شارك في الحروب التي دارت رحاها على الأرض الميدية لطرد الغُزاة الأجانب. وذكرى حروب التحرير هذه هي التي جعلت الشاعر المتأجج بالتوق إلى الإنعتاق والمُفعم بالكبرياء القومي أن يتذكر أسطورة
(كاوة الحداد) الذي قتل في الحادي والعشرين من شهر آذار (النوروز، عيد الربيع) الملك الطاغية الشرير( الضحّاك) مربي الأفاعي وقاتل أبناء كاوة الثمانية (ذكر الفردوسي هذه المعلومات في كتابه الشهير شاهنامة). رموز التحرر موجودون في الواقع كما هم موجودون في الأسطورة. إننا بأمس الحاجة إليهم غالبين أو مغلوبين. لقد كان وسيبقى (سبارتاكوس) قائد ثورة العبيد في روما رمزاً لثورة المقهورين ضد قاهريهم والمظلومين ضد ظالميهم… رغم فشل ثورته تلك.
إذا رجع الشاعر إلى رموز تأريخه القديم فإنه لم ينسَ ذكر أسماء شعراء كرد كبار(أحمد خاني - فقي تيران - ملاي جزيري).
سأنقل بعض مقاطع هذه القصيدة لأعطي القارئ فرصة لكي يتابع معي سياحة الشاعر عَبر التأريخ.
لن نموتَ ما دام السمر مرَّ فينا
تعالوا إلى الإحتفال : نوروز …
…
تعالوا لنرقص بالأبيض والأخضر والأحمر
والشمس المُحرِقة في منتصفها
هامات الجبال تتدلى وكأن العراك يتقدم في التناوب الحر
مُستقدماً الخواص العالية لخصالنا وأفكارنا المقلقة لهم !
تعالوا
كاوا سبارتكوس الكُرد
تعمّدوا في ماء مطرقته ورحابة ناره
تعالوا لنزاول التراجيديا
وندخل مع الإغريق - بعد حرب دامية - في صفة الحب
تعالوا
إندحرَ جبروت الإسكندر الكبير ذي القرنين المفتولين
وبقيت أبواب ميديا منيعة تفوح بنار الثورة والقيامة.
ثمة قصائد أُخَر تنتمي إلى هذا العالم الثوري وتندرج ضمن القصائد التي ترفع راية كفاح الأمة الكردية من أجل الحرية والإنعتاق ثم التوحّد. أخص منها بالذكر قصيدة (فجيعة النزول من جبل آغري) والقصيدة الأخيرة في الديوان (مدارات الاغتباط).
المنطقة الثالثة
في المنطقة الثالثة البيضاء التي تتوسط ومن ثم تعزل عالمي قصائد اللونين الأخضر والأحمر، لفتت نظري قصيدة (حسرة)، إذ أحسست فعلاً بهذه الحسرة يطلقها الشاعر الذي عاش وما زال قومه وأهله يعيشون في بلد يُسمى وطناً ولكن من باب المجاز !!! هم فيه أقلية لا تمارس حقوقها التي كفلتها الشرائع ومبادئ الحرية ولوائح حقوق الإنسان. يُراد منها ولها أن تكون مقطوعة الجذور مجردة من تراثها القومي والثقافي بل وحتى من لغتها.
كيف لا يتجاوب القارئ مع حسرة شاعر يُحس أنه يعيش بلا وطن، وإنه يتمنى أن يكون له بيت كبقية خلق الله يكتب اسمه واسم أبيه على لوحة معدنية يعلقها على بوابة هذا البيت. إنه مخنوق لا يستطيع أن يمارس في الوطن - اللاوطن أبسط طقوسه وعاداته القومية. لا يتعلم أولاده لغة أجدادهم العريقة. لا يعترفون بها هناك !!
نستمع إلى صوت الشاعر المتحسّر :
ليس لي وطنٌ أخطُّ على جدرانه بطبشور الطفولة :
" عاش وطني "
ليس وطنٌ أتجرّعه في الصباح مع فنجان القهوة،
مع شروق الشمس وتساقط الدفء عليه
ليس لي وطن أكون رئته ويكون رئتي
أكون بحّته ويكون صوتي
أكون الشقي المُشاكس المتمرد العنيد
ويكون الحكيم العاقل الرؤوف الواسع القلب.
ليس لي وطن أكتب على نحاس بيت من بيوته:
هذا بيت حسين حَبَش
أهلاً بالأصدقاء.
ليس لي وطنٌ أسكرُ في حاناته حتى الهزيع الأخير من الليل
أتسكّع في دروبه ويتسكع هو في قلبي
ألبسه ويلبسني
…
يحضرني في هذا المقام بيت شعر للمتنبي :
بِمَ التعللُ لا أهلٌ ولا وطنٌ
ولا نديمٌ ولا كأسٌ ولا سَكَنُ
أجلْ، إنها صرخة مدوية لكنْ بشكل حسرة. صرخة تشبه الزلزال الخجول، المؤدب، الصامت يصفق بها الشاعر وجوه المنافقين الثرثارين الذين يملأون الآفاق نهاراً وليلاً بزعيقهم المُداجي والكاذب عن حرية الإنسان وعن حقوق الإنسان. فلنصرخ عالياً مع الشاعر، أيها الناس :
(ليس لي وطن)
القصيدة " البيضاء " الثانية هي (قطيع الوعول يموت من الظمأ)، وهي القصيدة الأولى في الديوان.
القصيدة حوار صامت دافئ مع النفس الكئيبة - الحزينة - المتحدية - الثائرة يستعرض الشاعر خلاله مشاكل الملاجئ والمنافي والمنفيين والمهاجرين والتاركين بلدانهم قسراً. الشاعر هنا يمثل حالةَ وصوت هؤلاء جميعاً. لا ينصب من نفسه قاضياً أو محامياً للدفاع ولكنه يعرض الحالة ويستعرض طبيعة المشاكل التي تأتي بعد اللجوء والتغرب والابتعاد عن الأهل. يتكلم هنا حُسين عن محنته فأجده يعبر عمّا يجيش في صدري وفي صدور الملايين من أمثاله وأمثالي الذين أجبرتهم حكومات بلدانهم على الهرب من جحيم التعسف والاستبداد والتفرد بالسلطة وسحق الآخر رأياً ومُعتقداً وجسداً أحياناً. إنه يرسم لوحات حية لما يعانيه هذا الهارب والمنفي وما آل إليه حاله وما طرأ عليه من تحولات في المسلك والعادات فرضتها عليه طبيعة الأرض الجديدة والأجواء الجديدة المختلفة عن تربة وأجواء بلده الذي انسلخ عنه هارباً بجلده. لوحات صادقة وجريئة يخطها الشاعر بثقة وصراحة لا تعرف اللف والدوران. هكذا عرفته جريئاً مقداماً منذ ديوانه الأول (غَرِقٌ في الورد / أزمنة للنشر والتوزيع / عمان 2002 ).
لماذا لا نستمع إلى ما قال الشاعر نفسه في هذه القصيدة ؟ :
تركنا خلف ظهورنا قطيع الوعول يموتُ من الظمأ
ألّفنا قصصاً وأدرنا وجوهنا إلى المنافي البعيدة خلف البحار
شممنا الغربة فآلفتنا
نسينا ورود حبنا الأول هناك في خزائن الأشجار
ولم نعدْ نتذكّر حبال الغسيل التي اشتاقت إلى ثيابنا
لم نعدْ نردد كلمة " أُمّي" العزيزة على قلوبنا
تيبّسنا، جفّت ينابيعنا على طاولات القضاء
…
تركنا خلف ظهورنا قطيع الوعول يموت من الظمأ،
أصابنا الصدأ
ولم نُدركْ بعد بأننا تعطّلنا في منتصف العمر،
وبأننا إنحدرنا إلى الغياب وأرواحنا تواطأت مع الخواء والفراغ
أنشتاق يوماً إلى عصافيرنا التي تركناها هناك
أنشتاقُ يوماً إلى شقاوة الأصدقاء
أنشتاق يوماً إلى أهلنا وصورة أختنا الكبرى ؟!
ما أكبر هم الشاعر وأعمق خوفه من احتمال أن تنسيه الغربةُ أهله وشقيقته الكبرى التي لا شكَّ في أنها كانت تقوم بالنسبة له مقام الأم الوالدة.
في قصيدة (الحديقة اليابانية) يتجلى مرةً أخرى عشق الشاعر للطبيعة ولاسيما عالمي النبات والحيوان، وهو الأمر الذي كنتُ قد أشرتُ إليه في دراستي السابقة عن ديوانه الأول مار الذكر. يدخل هذه الحديقة فيمارس طقساً دينياً ذا دلالة قدسية. يذكر أولا صلوات وتراتيل البوذيين في معابدهم وصومعاتهم في رؤوس الجبال. من ثم يُشير إلى جزء من آية قرآنية (إني أنا ربُكَ فاْخلع نعليك إنك بالوادي الُمقّدس طُوى / سورة طه، الآية 12). لكنَّ هذا الشاعر المترهب المتعبد الخاشع لا ينسى، وهومتسربل بهذه الأجواء الروحية العالية، رسالته الحقيقية : رسالة أمتّه في الإنعتاق من ربقة الاستعباد والقهر والتمييز العنصري فيربط الشيء بالشيء مُعرّجِاً على بطولات الساموراي اليابانيين.
تقول القصيدة :
الأشجار المنحنية على القوس الأخضر لينبوع الماء
تُمسّد بظلها وجه المسلّة المزروعة فوق هواجس الصخرة
كقامة " يوكيو ميشيما "
وكأنها تقود وراءها فرقة فرسان من " الساموراي "
إلى معترك الكبرياء وساحة الدم
شعاعٌ من القلب ينخطف كإله ويمتزج مع النداءات الكثيفة
للعصافير كقصائد " باشو "
أو ترنيمات المؤمنين في المعابد البوذية المنزوية
في ضلوع الجبال
…
تدخل الحديقة اليابانية تودُّ أن تخلع نعليك
كأنك تدخل صلاة…
…
أو كأنك تصيرُ وتراً عاشقاً
يغفو على صدر قيثارة قديمة
بلا تخوم ولا أطراف.
ختام
في قصيدة " مدارات الاغتباط " يضع الشاعر حسين محمود حَبَش نفسه أمام قرّائه رمزاً وداعية لحقوق أُمته الكردية ومدافعاً صُلباً عنها لا تلين له قناة. إنه يقدّم في هذه القصيدة، وهي خاتمة الديوان، أُنموذجاً للرجل والشاعر الذي وهب شعره وحياته لقضايا أمته المصيرية الكبرى. لا حزن ولا اكتئاب في هذه القصيدة. إنها شعلة (بروميثيوس) وناره الأبدية التي تضيء ظلام الدنيا. وإنها نار وضربات مطرقة (كاوة الحداد). ونجد فيها أصداء أصوات وصرخات شعراء الكرد الكبار وساستهم المناضلين متحدية وعالية النبرة:
اغتبطي يا خيام الغفوة فإننا أرهفنا السمع للغيَّ
وإحتدمنا مع البطش
نقاومه ويقاومنا،
نعانده ويعاندنا…
حتى أوصلنا القمم إلى القمم
والجهات إلى الجهات
وربطنا الهواء بالهواء…
موقدين فوانيس المشارف البعيدة.
…
اغتبطي فإننا عريّنا اليأس من مشاربه
وخلعنا أنياب النمور الشرسة
أنذرنا الرقباء وأقمنا مأدبة الياقوت فوق كمين الخسارات.
شكر وتقدير : المعلومات الخاصة ب " كاوة الحدّاد" وقتله الملك الضحّاك والتي وردت في كتاب "شاهنامة" للفردوسي… زودني بها مشكوراً الصديق حسن ذو الفقار.
نيسان ( أبريل ) 2004
( ديوان شعر للشاعر حسين محمود حبش.
الناشر: سنابل للنشر والتوزيع، مدينة 6 أكتوبر،
جمهورية مصر العربية. الطبعة الأولى 2004 ).