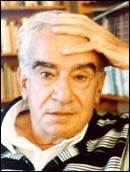 كلّما قرأتُ فؤاد رفقة شاعراً، خلته جالساً في صومعة تارة، وبين أحضان الطبيعة طوراً، متأملاً، غارقاً في صمت عميق، يناجي أرقّ ثنايا الاعماق، كي يغرف منها عذوبة القصيدة، قصيدته التي يرسلها الى المتلقي مغلّفة بما يشبه سحر اللقاء الاول وشغف العبارات الاولى المتبادَلة بين حبيبين. كأن على قارئه ان يوافيه الى شعره بعد أن يكون ألقى عنه جميع أثقال الغضب والعبثية والصراخ. كأن عليه أن يأتي الى قصيدته مسالماً، هادئاً، وديعاً، او لعلّه يخرج على هذه الحال من قراءته. ذلك أن قصيدته تبدو منبثقة دوماً من مواطن السكون رغم ما يعتريها من وجع وقلق وحزن. هو غالباً الوجع الخافت، والقلق الورع، والحزن المتسامي. كأني بفؤاد رفقة يطوّع الألم، يروّضه، يهذّبه، يحوّله لعبة قدرية يقبلها في صبر ويجاريها: "تحت شمس طريّة/ على ورق الياسمين/ أن تغسل العيونُ/ حبّات المطر،/ وفي غابة الجروح/ أن تُبرّد القطراتُ/ جرح الاسئلة"، بعض مما يقوله في مجموعته الشعرية الصادرة حديثاً تحت عنوان "كاهن الوقت"(*). ولمَ يربط الشاعر بين "كهنوت" ووقت؟ أتراه شاء إسدال نفحة "قدسيّة" على الوقت؟ وهل يودّ بالتالي معالجة الوقت، بل معضلة الوقت، بشيء من التأمّل والتطهّر والصلاة؟ ربما الإيجاب هو الرد على هذين السؤالين، أقلّه لأن المناخ المخيّم على المجموعة الجديدة ايضاً هو نفسه المناخ التأملي الهادئ الذي أشارت اليه بداية هذه المقالة. وأكثر، إنه المناخ التأملي، الصوفي، الزاهد، الشديد التقشّف: في قاعة باردة الابواب/ بلا سراج/ وحيداً يسهر الشاعر/ حتى مجيء آخر". ويقول في قصيدة أخرى: "عيناه نجمتان/ واحدة في منسك الفكر/ واحدة في منسك الشعر (...)". وليس زهد رفقة زهداً عادياً ومألوفاً، بل هو الزهد المتّسم ببعدين مهمّين يرخيان بثقلهما في قوة على بنية القصيدة ونسيجها الداخلي. البُعد الاول والجوهري هو الحضور المحسوس والجليّ والمتعمّد للشعر، بحيث تقطن عبارتا "شعر" و"شاعر" قصائد كثيرة في المجموعة. حتى القصيدة، يودّ رفقة تذكيرها بالشعر وبكيانه الشاعر. في خضم الشعر، يهجس بالشعر والشاعرية، حتى يكاد يبدو الشعر له درعاً قوية يحتمي بها من قهر ومعاناة وحزن: "في ساقية الجرح، ساقية الشعر(...)"، "في رؤى الحطّاب/ تبقى الشمس شمساً/ لا تغيب؟/ إنه العرّاف،/ وهج الشعر،/ درويش الدروب"، "(...) وفي عيون الشعراء/ يفرش المرثيات". والبعد الثاني المخيّم بظلاله على معظم المجموعة يتمثّل في هَجْس آخر، لكنّه ليس الهجس الايجابي المنجّي والمبلسم الذي اوحاه رفقة في هجسه بالشعر، بل هو الهجس المضني والقاهر الخاص بمعضلة الزمن، بأفول حتمي سيضع نقطة النهاية للأعمار. وكم يبدو الشاعر متعبا من تراكمات الوقت، من آثاره الالزامية على الكيان البشري عمقا وظاهراً: "الوقت ضبابية الذاكرة/ الوقت غشاوة العين/ الوقت طنين الآذان/ الوقت شحوب الصوت/ الوقت زيزقة المفاصل/ الوقت رجفة الكلمات/ الوقت جسد يخربش الجسد". ولعل اكثر ما يترجم هنا ثقل الوقت على الشاعر تكرار العبارة الدالّة عليه مرات عديدة. وهذه القصيدة ليست وحدها المرآة التي تعكس مرارة الشعور بالشيخوخة او في الاقل دنوها: "رغم التجاعيد/ لم يمدّ الحصير/(...) لم يقعد/ يخاف ان يستريح/ فيسقط/ كطائرة من ورق/ عند سكوت الريح". انه الخوف من دنو الرحيل، من الغفوة الاخيرة، من الصمت النهائي. لكن، هل يحاول الشاعر تأقلماً مع ما يسمى خريف العمر؟ بل هل يحاول ابتداع بعث ما من ذاك الخريف، بعث متخيل ومنسوج على نَوْل تأملاته وعوالمه الحميمة: متقاعد/ تحت فروع التوت/(...) لا ساعة في يده/ ولا اجراس،/ لديه الوقت أن يتأمل/(...) ان يعيش الوقت:/ ولادته الثانية .
كلّما قرأتُ فؤاد رفقة شاعراً، خلته جالساً في صومعة تارة، وبين أحضان الطبيعة طوراً، متأملاً، غارقاً في صمت عميق، يناجي أرقّ ثنايا الاعماق، كي يغرف منها عذوبة القصيدة، قصيدته التي يرسلها الى المتلقي مغلّفة بما يشبه سحر اللقاء الاول وشغف العبارات الاولى المتبادَلة بين حبيبين. كأن على قارئه ان يوافيه الى شعره بعد أن يكون ألقى عنه جميع أثقال الغضب والعبثية والصراخ. كأن عليه أن يأتي الى قصيدته مسالماً، هادئاً، وديعاً، او لعلّه يخرج على هذه الحال من قراءته. ذلك أن قصيدته تبدو منبثقة دوماً من مواطن السكون رغم ما يعتريها من وجع وقلق وحزن. هو غالباً الوجع الخافت، والقلق الورع، والحزن المتسامي. كأني بفؤاد رفقة يطوّع الألم، يروّضه، يهذّبه، يحوّله لعبة قدرية يقبلها في صبر ويجاريها: "تحت شمس طريّة/ على ورق الياسمين/ أن تغسل العيونُ/ حبّات المطر،/ وفي غابة الجروح/ أن تُبرّد القطراتُ/ جرح الاسئلة"، بعض مما يقوله في مجموعته الشعرية الصادرة حديثاً تحت عنوان "كاهن الوقت"(*). ولمَ يربط الشاعر بين "كهنوت" ووقت؟ أتراه شاء إسدال نفحة "قدسيّة" على الوقت؟ وهل يودّ بالتالي معالجة الوقت، بل معضلة الوقت، بشيء من التأمّل والتطهّر والصلاة؟ ربما الإيجاب هو الرد على هذين السؤالين، أقلّه لأن المناخ المخيّم على المجموعة الجديدة ايضاً هو نفسه المناخ التأملي الهادئ الذي أشارت اليه بداية هذه المقالة. وأكثر، إنه المناخ التأملي، الصوفي، الزاهد، الشديد التقشّف: في قاعة باردة الابواب/ بلا سراج/ وحيداً يسهر الشاعر/ حتى مجيء آخر". ويقول في قصيدة أخرى: "عيناه نجمتان/ واحدة في منسك الفكر/ واحدة في منسك الشعر (...)". وليس زهد رفقة زهداً عادياً ومألوفاً، بل هو الزهد المتّسم ببعدين مهمّين يرخيان بثقلهما في قوة على بنية القصيدة ونسيجها الداخلي. البُعد الاول والجوهري هو الحضور المحسوس والجليّ والمتعمّد للشعر، بحيث تقطن عبارتا "شعر" و"شاعر" قصائد كثيرة في المجموعة. حتى القصيدة، يودّ رفقة تذكيرها بالشعر وبكيانه الشاعر. في خضم الشعر، يهجس بالشعر والشاعرية، حتى يكاد يبدو الشعر له درعاً قوية يحتمي بها من قهر ومعاناة وحزن: "في ساقية الجرح، ساقية الشعر(...)"، "في رؤى الحطّاب/ تبقى الشمس شمساً/ لا تغيب؟/ إنه العرّاف،/ وهج الشعر،/ درويش الدروب"، "(...) وفي عيون الشعراء/ يفرش المرثيات". والبعد الثاني المخيّم بظلاله على معظم المجموعة يتمثّل في هَجْس آخر، لكنّه ليس الهجس الايجابي المنجّي والمبلسم الذي اوحاه رفقة في هجسه بالشعر، بل هو الهجس المضني والقاهر الخاص بمعضلة الزمن، بأفول حتمي سيضع نقطة النهاية للأعمار. وكم يبدو الشاعر متعبا من تراكمات الوقت، من آثاره الالزامية على الكيان البشري عمقا وظاهراً: "الوقت ضبابية الذاكرة/ الوقت غشاوة العين/ الوقت طنين الآذان/ الوقت شحوب الصوت/ الوقت زيزقة المفاصل/ الوقت رجفة الكلمات/ الوقت جسد يخربش الجسد". ولعل اكثر ما يترجم هنا ثقل الوقت على الشاعر تكرار العبارة الدالّة عليه مرات عديدة. وهذه القصيدة ليست وحدها المرآة التي تعكس مرارة الشعور بالشيخوخة او في الاقل دنوها: "رغم التجاعيد/ لم يمدّ الحصير/(...) لم يقعد/ يخاف ان يستريح/ فيسقط/ كطائرة من ورق/ عند سكوت الريح". انه الخوف من دنو الرحيل، من الغفوة الاخيرة، من الصمت النهائي. لكن، هل يحاول الشاعر تأقلماً مع ما يسمى خريف العمر؟ بل هل يحاول ابتداع بعث ما من ذاك الخريف، بعث متخيل ومنسوج على نَوْل تأملاته وعوالمه الحميمة: متقاعد/ تحت فروع التوت/(...) لا ساعة في يده/ ولا اجراس،/ لديه الوقت أن يتأمل/(...) ان يعيش الوقت:/ ولادته الثانية .
ولا يلبث فؤاد رفقة وفياً في مجموعته الحديثة لمناخات الطبيعة والريف و"الدروشة" توأماً للبساطة. شأنه شأن شعراء وصوفيين كثر يؤوبون الى الطبيعة ملاذاً يرتاحون بين أرجائه ويأنسون به. يقول: "جرّته الينابيع/ لقمته عشبة البراري/ رداؤه الغيم". وفي مكان آخر: "من خربته يقرأ النجوم/ تحولات الشجر (...)". وتتداخل في نصه عناصر الطبيعة وأشياؤها بواقع الحياة البشرية، ومن هنا التمازج بين الطبيعة (الورق، الخريف) والانسان (الذاكرة، الجسد) يستعير تحولات الطبيعة مجازاً لتحول الكائن البشري، فحين يقول: "قبل أوانه/ على سلاسل الذاكرة/ يتساقط الورق/ هذا الخريف"، ويقصد بالطبع تساقط "أوراق العمر". واذا كانت تعابير "أسوار التجاعيد" و"الشتاء الكبير" و"بلا سراج نورس الفجر" تجسد ذروة الحزن على بهتان العمر وخفوت بريقه، فإن نوراً آخر لا يخفت: "(...) وفي عينيه/ نجمة الشعر تضيء:/ نجمة المصير". هكذا تعبر نصوص فؤاد رفقة العين والوجدان مثلما يعبر السمعَ حداء شجيٌ رخيم .
حنان عاد
جريدة النهار
7 / 8 / 2004
كاهن الوقت
فؤاد رفقة
31 تشرين الاول 2000
بَرّيّةٌ،
دربٌ شاردة
في اتجاه الافق:
نقطة على شفة الغيب
1 تشرين الثاني 2000
مكتب،
اوراق واقلام،
يتأملها:
لماذا الشّعر؟
على الحائط صورتُها
زمن الحب
قصيدته الاخيرة
31 كانون الثاني 2000
الوقت ضبابية الذاكرة
الوقت غشاوة العين
الوقت طنين الآذان
الوقت شحوب الصوت
الوقت زيزقة المفاصل
الوقت رجفة الكلمات
الوقت جسد يخربش الجسد
16 آب 2001
كل يوم تطلع الشمس
تغيبْ،
فلماذا
في رؤى الحطّاب
تبقى الشمس شمساً
لا تغيب؟
إنه العرّاف،
وهجُ الشّعر،
درويش الدروبْ
19 آب 2001
انسام ليّنة
دخان يعبر السطوح،
مع الدخان افكاره تشرد
يخاف ان يعرف
الى أين
23 كانون الثاني 2001
شعاع هزيل،
أنسام متعبة
على كرسي عتيق
تحت الشجرة،
على امرأة لن تعود،
يتساقط الورق
يتساقط...
24 كانون الثاني 2002
مع الفصول
على كتف الارض
ابداً يتنزهان،
في يده قنديل لا ينطفىء،
في يدها قنديل لا ينطفىء،
توأمان قديمان:
عكازةُ الموت،
عكازة الحياة
26 كانون الثاني 2002
على حافة النهر
تحت جذوع التين والرمّان
في الحلم ابداً يلعب،
يلعب طفل
مع رفاق
يسكنون الجذور الآن،
رائحة القمر
27 كانون الثاني 2002
من جفنة
في خربة صوفيّة
وردة بيضاء،
للشمس تقدم النذور
عند الفجر،
وفي المساء
تحت فضاء كثيف الاقدار
تقرأ النجوم
1 نيسان 2002
من أزمنة داكنة القشور
لا قدمٌ،
لا تائه في الجوار،
وحدها نبعة الماء
تحت صفصافة خربته
تغسل عينيه عند الفجر،
وفي الليل
تمد له الحصير،
معه تسهر
9 آب 2002
خلف ريف الحدقةْ
أفق، نجمٌ، وميضٌ
يوقظ البحّار - يمضي
في مياه المد والجزر
وريح قلقةْ.
صوبَ غيم الشّعر
يجتاز المدى
للمحرقةْ
26 آب 2002
تعود للنّكَرْ
تمشي هنا - هناك، هائماً
رفاقُك الصّورْ،
توقظ في الحجر
دعساتك القديمهْ،
مشاعلاً ترمّدت
في موقد العُمُر.
كغيمة مثقلةٍ
بالحزن، بالهزيمهْ
تعود، يا بيدر،
تعود للنَّكرْ
29 آب 2002
في الحلم يتحوّل الى شاعر
الى كاهن
الى قديس
والقديس الى شجرة
تحت فروعها يركع
يحرق البخور،
وعند الشّفق،
يفتح عينيه،
يتمرأى،
يرى حطّاباً
في رأسه ريشةٌ
من قنافذ الهنود الحُمْر
5 كانون الثاني 2003
من خيم الليل
الى بساتين الحور والقصب
تعود الشمس،
من جبال الشمال
الى عشّها
في سهول الجنوب
تعود البجعة،
من شتاء الجذور
في ظلمة الارض
الى الغصون
تعود الاوراق،
ومن الرماد
بعد انطفاء الجسد
لماذا
لا يعود الجسد؟
5 كانون الثاني 2003
من خيم الليل
الى بساتين الحور والقصب
تعود الشمس،
من جبال الشمال
الى عشّها
في سهول الجنوب
تعود البجعة،
من شتاء الجذور
في ظلمة الارض
الى الغصون
تعود الاوراق،
ومن الرماد
بعد انطفاء الجسد
لماذا
لا يعود الجسد؟
23 تشرين الاول 2003
متقاعد
تحت فروع التوت
امام بيته
يمد رجليه،
لا ساعة في يده
ولا اجراس،
لديه الوقت ان يتأمل،
بعين بدائية
ان يرى الضباب
لديه الوقت
ان يعيش الوقت
ولادته الثانية
27 آذار 2003
على جدارٍ نعوةٌ
من زمن،
لا احد يقرؤها
يغوص في حروفها
فينحني
كزهرة ريحية،
كسنبلهْ
لمنجل يحصدها،
في إصبع المذراة يرميها
لريح مقبلهْ.
على جدارٍ نعوةٌ
يقرأها
يقرأ فيه اسمه العاشق
جرحَ الجلجلهْ.
من مجموعة " كاهن الوقت " دار نلسن 2004
من رفاق "شعر" وخارجها
لعلّ فؤاد رفقة هو من الشعراء الذين رافقوا مجلّة "شعر" من البداية، وافترقوا عنها من البداية أيضاً. والذي يقرأ أعداد هذه المجلة، في مرحلتيها، يلاحظ هذا الحضور والغياب معاً، فنجده من خلال بعض قصائده وبعض ترجماته، وكأنه ضيف زائر على المجلة، لا كواحد من المؤسسين والموجهين لسياساتها، كما هو يوسف الخال وأدونيس وأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا، وحين فتح رفقة نافذة على الشعر الألماني الذي اهتمّ به تخصصاً وترجمة للعربية. فنقل وعرّف ب"هلدرلن، ونوقاليس، وتراكل، من الرومانسيين، وصوفيي الطبيعة الألمان"، كانت اهتمامات مجلة شعر مشغولة ب ت اس اليوت وولت ويتمان وإدغار ألن بو في شعراء الحداثة الإنجليزية الأمريكية، وبرامبو وسان جون بيرس وأبولينير وأنطونان آرتو وأراغون وهنري ميشو وسواهم من شعراء الحداثة بصيغتها الفرنسية، فضلاً عن أندريه بريتون كمؤسس للسريالية، وتريستان تزارا كمؤسس للدادائية.
وحين تقرأ النتاج الشعري لفؤاد رفقة، وتتلمس اتجاهه الحداثي من خلال هذه الأشعار، تجد أنه شديد الانسجام مع اختياراته في ترجماته عن الألمانية، فهو على غرار هلدرلن ونوقاليس مجدد متفلسف هادئ متأمل في أعماق الليل والغابة، والريف وعناصر الطبيعة، أصل من أصول حداثته، وليس المدينة التي عدّها شارل بودلير سبباً أساسياً من أسباب توليد قصيدة النثر وما اتصل بها من معاني الحداثة الشعرية في الغرب.
وعلى خلاف ما كان عليه رفاقه في مجلّة شعر، بخاصة منهم الخال وأدونيس والحاج في بداياته، فلم يكن فؤاد رفقة يميل إلى التنظير الحداثوي والنقد المرافق للإبداع الشعري. كان يكتفي بنشر نصوصه الشعرية، وبالتعريف المقتضب ببعض من يترجم لهم من شعراء ألمان. لم يدّع تأسيس أو امتلاك نظرية في الحداثة الشعرية على غرار ما هو أدونيس مثلاً، وإن كانت متغيّرة بل متقلبة (كما هو رأيه المتغيّر بقصيدة النثر مثلاً وبشعرائها)، بل راقب عن بعد، وبصمت وهدوء يسيطران على طبعه كما على نصه، ما جرى من سجالات نقدية حول الحداثة الشعرية، على صفحات مجلة شعر ومجلة حوار ومجلة مواقف ومجلة الآداب وملحق النهار الثقافي وصفحاتها الثقافية.. وظل صامتاً أو شبه صامت ومتأمل لغاية مطلع الثمانينات من القرن الماضي، حيث بدأ ينشر نتفات نقدية وتأملية مختصرة على الصفحة الثقافية من جريدة النهار، مشيراً لذاته فيها تحت اسم "بيدر" .. واختيار فؤاد رفقة لاسم بيدر ليقوم مقامه في النبذة أو النصّ المنشور، هو اختيار ذو دلالة توصل إلى بعض سمات شخصيته الأدبية، وربما كان ذلك مفتاحاً لها. فالبيدر هو ما يجمع عليه سنابل الحقل لتدرس بالنورج ويفصل فيها الحب عن القش وتذرّى بعد ذلك في اله
واء. والبيدر تعبير ريفي زراعي، ودالّ على الأصل الريفي بل الرعوي للرومانسية على العموم، في مقابل المدن، أمّ تيارات الحداثة الشعرية ومدارسها. فاختيار فؤاد رفقة لكلمة بيدر، اختيار ريفي بالتأكيد، ويظهر من البداية وكأنه يسلك ضد اتجاهات الحداثة، كما طرحت في مسرح التعامل الإبداعي والنقدي في فرنسا على الأخصّ، ولدى بعض رموزها في الشعر العربي الحديث والمعاصر، بخاصّة منهم من ذكرنا من جماعة مجلّة شعر.
وسوف يظهر ذلك جلياً من خلال صفحات كتاب رفقة "أمطار قديمة"، الصادر له مؤخراً عن دار النهار للنشر (أيار 2003)، والذي هو جمع وتنسيق وتبويب لنصوصه القصيرة وتأملاته المقتضبة في الشعر والحياة والحرب والرفاق، وقد وزّعها على أزمنة أربعة: أزمنة الشعر وأزمنة الضيق وأزمنة الحريق وأزمنة الرفاق. وهذه الأزمنة تظهر على صورة أسفار في شعاب الأرض وقفارها. أو جداول تنساب في أصولها في الينابيع المخبوءة في صدر الشاعر، إلى مصبّاتها لتضيع في البحر، ليبقى الشاعر من بعدها، على حد قوله يتأمل في الجوّ باسقاً يدور، فوق الينابيع يدور، وفي ريش أهدابه شعلة الجنون".. ثم، وغيمة من الكآبة تزنر رأسه، يتذكر أن هذا الباشق كان صديقه أيام عزلته الطويلة في مغاور الجبال.
أزمنة الشعر
يبدأ فؤاد رفقة أزمنة الشعر بالنقد. هو ليس بناقد، ولكنه صاحب نظر في النقد، وإذا تتحرك في ذاته طويّة الناقد، تراه يزدوج في حوار يحاور فيه نفسه..
".. ما مهنتك؟
- النقد
- ما النقد الذي تمارسه؟
- النقد الشعري.
- وما غاية هذا النوع من النقد؟
- غايته تفسير عالم الكلمة الشعرية وأبعاده قدر المستطاع".
لكنّ ما يفعله رفقة في كتابه، ليس ممارسة النقد بتفسير عوالم الكلمات الشعرية، كما يرى، بل تسجيل نقدات في النقد، وابداء آراء مقتضبة ينتهي منها إلى أن الكلمة التفسيرية للشعر التي يلفظها النقد، تبقى لاهثة خلف الومضة الشعرية، فالنقد ليس عملية تأسيس وبناء نقدي مواز للتأسيس الشعري - وهو كذلك برأينا - بل هو تفسير للشعر ولهاث خلفه.
أما الشعر، بالنسبة له، فما هو؟
- "هو تأسيس للحقيقة على هذه الأرض".
وهذا الغموض في تعريف الشعر وتحديد ماهيته، يجعل فؤاد رفقة أسيراً له، فهو كما في تعريف النقد مضطرب وضبابي، تراه في تعريف الشعر في اضطراب وضبابية ويكاد يقول باستحالة القبض على هذين الطائرين الغامضين للعملية الإبداعية فيقول: "... لكأن الغرض من التعليق على النتاج الشعري إقامة الحواجز بينه وبين القارئ وليس العكس".
ومع ذلك تراه يضع ما يشبه النصائح لتربية الناقد، فيشترط له الموهبة، والانفتاح على التيارات النقدية ومرافقته للرحلات الكيانية للشاعر في مراحل حياته، وخلوّه من القبلية، والتحرك في إطار الشمولية المفترضة للشاعر.
وتراه على حذر ومسافة من النزعة العلمية الجديدة لتركيب الشعر ونقده معاً. إنه حذر من التجريب الشعري (وهنا مفصل الانفصال رفقة نصاً ونظراً عن جماعة مجلّة شعر)، بل تراه يتكلّم بقسوة هجومية على انحدار وهج الشعر نحو النعاس بسبب اهتمامه المطلق بالعنصر التركيبي واللهاث وراء الغرائبية في اللغة والصورة وغياب العالم الداخلي في الحروف والكلمات، فتأتي القصيدة ركاماً في شكلانية جافة لا تصل حتى إلى الأذان والعيون".
- وما السبيل للخروج من هذا القحط الشعري؟
- "الخلاص يكون في العيون النقيّة".
- وما العيون النقية؟
الأرجح أنّ فؤاد رفقة يميل للعودة للأصول بمعنييها: الأصول في الطبيعة، والأصول في الينابيع الحيّة للتراث، المشرقي منه بخاصة، لذلك لا نراه يحتفل بالنظريات الحداثية والتجريب الحداثي احتفالاً كبيراً، وهو ما عرف به الغرب على العموم، بل هو يرى في الكثير من التجارب الحداثية الغربية والعربية أشجاراً بلا تربة، ويلاحظ أن كلمات بعض التجارب العربية غريبة النبرة "كما لو أنها مترجمة"... كل ذلك جزء من اليباس الشعري في "لغتنا الحاضرة" تسيطر فيه القبلية والمافياويّة والغرائزية، في الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام.
ويظهر أن رفقة يشكو من ظلم إعلامي ما لحق به في تجربته لذا يشير إلى ما أشار إليه في علاقات (مافياوية) في الصحافة المرافقة لتجارب الحداثة الشعرية العربية.. وهي مسألة كان يشكو منها أيضاً خليل حاوي الذي بدوره بدأ مع مجلة شعر ثم ابتعد عنها بعداً كاملاً ووجه إلى جماعتها نقداً قاسياً.
زمن الشعر كما يرى إليه رفقة هو زمن طوباوي، فالآلهة تنفخ في الطين فيحضر الشاعر، وكلمات سماوية يسكنها السماوي ويضيء.. لذا، وفي ما يشبه غضّ النظر عن إضافات الثقافة على الشاعر، تراه ينتبه للشعر الأول، للشعر البكر والخام الطالع ما قبل الحداثة بل ما قبل الثقافة بمعناها التراكمي.. لتجارب الشعر الجاهلي مثلاً، للقصيدة النشيد والاحتفال الإلهي... يقول بنبرة نبويّة: "في تلك الأيام.. أيام الشعر - كان الشاعر شفة الله ورايته"... وهكذا فإن فؤاد رفقة يكاد يظهر بريئاً من تجريبية مجلة شعر ومثاقفاتها... بل يكاد يقف في الخط المقابل لذلك. وهو يقسم مراحل تطوّر الشعرية إلى خمس:
المرحلة الميتولوجية وهي مرحلة تداخل الآلهة مع البشر، والمرحلة النبوية، والمرحلة اللاهوتية، والمرحلة الحضارية، والمرحلة الأخيرة السائرة، المرحلة التجريبية وهي أسوأ المراحل برأيه"عندما صار الشعر علماً، معادلات، تجارب شكلانية، أشكالاً هندسية، حداثة، في هذه المرحلة، مرحلتنا الحاضرة، يعيش الشاعر في النسيان، نسيان الإلهي واثاره دون أن يعي ذلك".
لا يفوت فؤاد رفقة أزمة القصيدة المعاصرة، وسببها برأيه "نسيان المنبع". والمنبع هو "أفق الوجود"، والقصيدة الحديثة هي الحدث والحديث مع من؟ مع الذات ومع القارئ، والتجاوز تجاوز في الشعر من الشعر وإليه. والحداثة الحقيقية ما هي؟ هي ألاّ تكون حديثاً كما يقول. كيف؟ "هي الرجوع إلى المناخ الكلاسيكي" وما الكلاسيكية المقصودة؟ "هي الفعل الشعري النموذجي المستمر في الوجود البشري عبر المراحل الزمنية".
ورفقة عدو الشكلانية والتجريب، لا يسأل عن الكيف في الشعر بل عن التجربة.. وينتقد التجاوز الشكلاني (عندنا) واللهاث وراء الجديد.. فالشاعر ينتقي أشكاله كما ينتقي ثيابه.. كما ينص على بعض الشعر الإنجراف في التجربة الكيانية إلى التجربة المختبرية. وأخطر سؤال يطرحه رفقة عبر خطراته النقدية هو: "هل في المستطاع خلق أية قصيدة، بمعنى الشعر، غير تراثية؟.. هنا يفهم الشاعر التراث على أنه البيئة التي ينبت فيها الشاعر ولا يستطيع أن ينبتّ عنها، أو الفضاء الذي يحلق فيه طائر الشعر وليس في استطاعته التحليق إلاّ فيه... لكنه يدعو أيضاً إلى "لطم التراث"، محاورته، معارضته، من خلال الطيران فيه.. "فالتراث الحيّ لا يعيش إلا بهزّات تخض الجذور..".
وهنا أيضاً مفترق بين رفقة وبعض شعراء مجلّة شعر كأنسي الحاج مثلاً، وهو ينهي فقدانه باعتبار الشعر حريّة، لذا لا يعارض قصيدة النثر، ويركز على العالم الداخلي للقصيدة، ثم يعتبر الشعر قرين الصمت الإلهي كما فعل هولدرلن بانتحاره، أو قرين العزلة المقدسة كما فعل ريلكه أو قرين الموت المبكر كما حصل لنوفاليس أو قرين الانتحار كما فعل تراكل... أو قرين تغيير الحياة كما دعا ريلكه.. وهؤلاء هم شعراؤه المختارون، الألمان، وهذه هي الدروس المقتبسة منهم.
أزمنة الضيق وأزمنة الحريق
يبدأ رفقة تأملاته في أزمنة الضيق بقول للألماني هلدرلن: "إنما في البيت يودّ البقاء من في صدره الأمين إلهيا يحمل، وحراً أريد، ما يسمح الوقت، تفسيرك وغناءك أنت يالغات السماء كلها".... وأزمنة الضيق هي أزمنة الحرب والموت واللاحرية.
وهي أزمنة عربية اليوم، ولعلّ لها جذوراً في الماضي.
يفسّر رفقة ظهور الباطنية في التاريخ العربي والإسلامي بسبب الاضطهاد والنقص في حريّة الرأي والمعتقد. وهو من خلال حوار مع ذاته، المسماة بيدر، ينتقل من التراث إلى المعاصرة، ومن الخوف إلى انعدام الحريّة، فالخوف لدى العربي قديم، وربما عاد لأيام المأمون، الذي شجّع العقلنة، لكنه اضطهد المعارضين له، ويتنقل بين العرب واللبنانيين، ويهجو الفريّسين والمرائين، بنبرة تارة تأملية، وتارة عاطفية انفعالية، وفي بعض الأحيان خطابية مباشرة "... كم مرة بكيتم لضياع الكروم والأنهار؟.. قلوبكم المقاصل وسواعدكم المطارق والجنازير".. وفي نقداته التي يسوقها على غير انتظام، ولنقل بعفوية وبلا منهج، يحلو له أن يعود، بين نبذة وأخرى، إلى هيغل (الألماني) ونظريته عن تحقق المطلق في التاريخ، أو هلدرلن بشاهد شعري، ويبقى الأساس في أزمنة الضيق، فقدان الحرية.
في أزمنة الحريق يتابع بيدر حواره مع نفسه، ويسمّي نفسه أيضاً الحطّاب.. ومن هنا، من هذا الاسم الريفي، الرعوي، تظهر نزعة فؤاد رفقة في نبذ الحرب الأهلية ونقد مسوّغاتها وأطرافها، واعتبارها جنوناً وأصحابها كواسر بشرية.
وما الذي يرغبه الريفي النقي الجبلي من ذلك؟ لا شيء، سوى العودة للأصل النقي.. للريف أو للجبل، للغابة فوحوشها أقل وحشية في البشر المتقاتلين.
كان بيدر يلجأ أحياناً في الحرب إلى فسحة ثقافية شبه آمنة في مطعم ثقافي قرب الجامعة الأمريكية في بيروت هو "مطعم فيصل". يسجل رفقة عنه ذكريات ثقافية هادئة "حيث كان الوقت وسيعا" كما يقول. ثم غيرت الحرب الأماكن والأزمنة، وغاب مطعم فيصل كما غابت بيروت.. وابتعد بيدر إلى الجبال.. غاب عن بيروت ليمتدح ابنة الباروك وصنين والجبل اللبناني مدائح إنجيلية وتبشيرية لها نكهة الأناشيد القديمة ولغتها .. أيتها البخورية الطالعة، يا امرأة في بلادي لن تعرفي السواد.. فافرحي يا بنت صنين، على المداخل ارفعي الأجراس، مدّي الشعانين.. ترنّمي بالغيم يا ابنة الباروك، وعلى صنين اتكئي وسرّحي الجدائل..."
أزمنة الرفاق
أزمنة الرفاق هي الأكثر حميمية في كتاب رفقة.. ولكنها تتسم بما اتسمت به سائر الأزمنة في الاختصار وعدم الغوص في أصول المواضيع والبقاء على حدود الأفكار والعلاقات. فنحن أمام كتاب مريح، بعيد عن النظريات والافتراضات ذات البراهين، ولكنه قريب من سرديات الحياة، ورؤوس الأفكار والعلاقات. إن أزمنة الرفاق، هي مراث لرفاق عرفهم رفقة معرفة إبداعية وحياتية، وكتب فيهم بعد الموت. وتبدأ بيوسف الخال، من خلال رسالة متخيلة أرسلها يوسف الخال إلى بيدر، من وراء الأبدية... ويستعرض من خلالها ما يشبه سيرة الرجلين من خلال أيام البدايات في بداية الخمسينات حيث كان يجمع بينهما في الجامعة الأمريكية شارل مالك الأستاذ في الفلسفة، وأحلام التجديد الشعري من خلال مجلّة فاتحه الخال في تأسيسها باسم "شعر" نقلاً عن تجربة بالاسم نفسه تأثر بها الخال في الولايات المتحدة الأمريكية... وينتقل بعد ذلك إلى ليالي خميس مجلة شعر المضيئة حيث كان الخال فيها "هو الصامت الأكبر" كما يقول رفقة... ثم فصل ما بين الرفيقين ذهاب رفقة إلى ألمانيا لمتابعة الدراسة، وخلال وجوده هناك سكتت مجلة شعر... وتنتهي الرسائل المتخيلة من الخال بالموت... والشاعر.. الشاعر الجبّار بعبارته.
وفي رسالته لخليل حاوي مرثية.. مرثية كما لو هي للزمان الجميل. زمان مطعم فيصل ومقهى الهورس شو وحدائق الجامعة الأمريكية، وذلك قبل خراب كل شيء، وانتحار خليل يوم الأحد مساء السادس من حزيران سنة 1982م، حيث انتحر شاعر كان ينضج طول عمره للموت والهبوط إلى الرحم الكبير.
ومثل ذلك يفعل رفقة، في مراثيه لسائر الرفاق: يوسف حبشي الأشقر، وميشال بصبوص، والياس أبوشبكة، وحبرا ابراهيم جبرا، ورياض فاخوري... لينهي أمطاره القديمة، الناعمة كرذاذ يسقط على رؤوس الجبال، بحزن المراثي.
جريدة الرياض 22 يناير 2004
ويبوغرافيا :بالألمانية
http:// www.bsz-bw.de/eu/lyriktage/ sieben/rifka.html
http://www.agw-lernmotivation.de/homepage/hardenberg/lesart/inhalt/rifka/