ترجمة وتقديم: صبحي حديدي
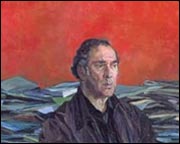 مَن يصدّق أن هارولد بنتر، هذا الضمير اليقظ الحيّ الناشط أبداً في عشرات القضايا السياسية، تعرّض ذات يوم لتهمة الإبتعاد عن السياسة في مسرحياته وقصائده؟ العجب يزول سريعاً، ويصبح تفهّم التهمة نتيجة منطقية إذا تذكر المرء مقدار الأصالة في تلك النصوص التي لم تكن تسلم قيادها لتحليل لا يلحظ السياسة على السطح من جهة أولى، ويصاب من جهة ثانية بالكثير من الارتباك إزاء أدب يشتغل على الصمت، ولكنه يستنطق شعرية الصمت؛ ويكشف مفردات الذعر الإنساني البسيط من الوجود العاتي، دون أن يكون وجودي الفلسفة؛ ويلتقط دقائق الحيثيات في الموقف البشري اليومي، دون أن يكون طبيعيّ النزعة؛ كما ينحرف كثيراً، وعن سابق قصد، بعيداً عن واقعية الواقع دون أن يغرق البتة في أيّ استيهام فانتازي استعراضي أو شطحة سوريالية مجانية.
مَن يصدّق أن هارولد بنتر، هذا الضمير اليقظ الحيّ الناشط أبداً في عشرات القضايا السياسية، تعرّض ذات يوم لتهمة الإبتعاد عن السياسة في مسرحياته وقصائده؟ العجب يزول سريعاً، ويصبح تفهّم التهمة نتيجة منطقية إذا تذكر المرء مقدار الأصالة في تلك النصوص التي لم تكن تسلم قيادها لتحليل لا يلحظ السياسة على السطح من جهة أولى، ويصاب من جهة ثانية بالكثير من الارتباك إزاء أدب يشتغل على الصمت، ولكنه يستنطق شعرية الصمت؛ ويكشف مفردات الذعر الإنساني البسيط من الوجود العاتي، دون أن يكون وجودي الفلسفة؛ ويلتقط دقائق الحيثيات في الموقف البشري اليومي، دون أن يكون طبيعيّ النزعة؛ كما ينحرف كثيراً، وعن سابق قصد، بعيداً عن واقعية الواقع دون أن يغرق البتة في أيّ استيهام فانتازي استعراضي أو شطحة سوريالية مجانية.
وليس غريباً أن يدخل إلى الإنكليزية، وإلى قاموس أكسفورد أيضاً، اصطلاح الـ Pinteresque المنحوت من اسم بنتر، والذي يفيد ذلك المناخ الدرامي الإنساني الخاصّ، المعقد والبسيط، المحليّ والكوني، الفردي والجمعي، الرحب العريض والضيّق حبيس الحجرة الواحدة، في آن معاً. ولم يكن بغير مغزى أن الأكاديمية السويدية توقفت عند هذا النحت مراراً وهي تطري بنتر، الفائز بجائزة الأدب للعام 2005، بل وتستزيد حين تنحت مصطلحاً ثانياً هو "الأرض البنترية" Pinterland، ذات "الطبوغرافية المميزة، حيث تتمترس الشخصيات خلف حوارات مباغتة، وبين سطور تهديداتٍ لا حلّ لها يكون ما نسمعه علامات على كلّ ما لا نسمعه".
والحال أنّ الأكاديمية بدت وكأنها طربت لقرارها منح بنتر جائزة الأدب، فأخذت تتغنى بقرارها في غمرة إغداق المديح على فائز كبير يستحقّ كلّ المديح في الواقع. فالرجل أحد كبار أدباء هذا العصر، وهو على الأرجح أعظم كاتب مسرحيّ حيّ في اللغة الإنكليزية، وهو الذي ردّ المسرح إلى عناصره الأساسية، مثل الفضاء المغلق والحوار الصاعق والأنماط البشرية التي تخلق الدراما الكثيفة حين تتصارع وتتقاطع وتتلاقي وتفترق، ضمن خطوط حبكة في الحدود الدنيا، وتنويع عريض لأساليب مسرح العبث والمسرج الطبيعي والواقعي وتقاليد الفرجة. هذا فضلاً عن دوره في إغناء مدارس الإخراج المسرحي، والسيناريو السينمائي والتمثيلية الإذاعية.
كذلك قد لا يعرف الكثيرون أنّ بنتر بدأ شاعراً، بل وكانت القصيدة هي أوّل منشوراته، قبل أن ينخرط أكثر فأكثر في الكتابة المسرحية والتمثيل والإخراج. وقصيدته "السنة الجديدة في ميدلاندز"، والتي كُتبت في مطالع الصبا، تذكّر كثيراً بمشهد الحانة في قصيدة ت. س. إليوت الشهيرة "الأرض اليباب". وأمّا قصيدته "سأمزّق قبعتي الفظيعة"، 1951، فإنها تمثّل أوضح البواكير على موضوعة الإحتجاج العميق التي ستهيمن على أشعاره بعدئذ:
في سَكْنَة عدائية ذاتَ زمن ليس لأحد
الأصمّ وحده يسمع والكفيف وحده يفهم
الأميال التي أتلمّس طريقي عليها
كلّ الأرواح ستسكنني، وستشربني كلّ الشياطين.
وغنيّ عن القول إنّ معظم قصائد تلك المرحلة كانت تعكس مناخاً درامياً واضحاً، وكانت بذلك تنذر بالخيار الرئيسي الذي سيقتفيه هذا الفنّان الكبير: المسرح.
ومحاضرة نوبل وثيقة جبارة جديدة تبرهن من جديد أنّ بنتر ليس واحداً من أعظم أدباء عصرنا فحسب، بل هو أيضاً أحد أنقى وأشجع وأنصع ضمائره من حيث انحيازه الدائم إلى قضايا الإنسان في وجه القوّة الغاشمة. وهذا الإنتماء إلى قضايا الإنسان، وربما إلى ما بات يطلق عليه الليبراليون السعداء اسم "القضايا الخاسرة" إجمالاً، ليس أمراً طارئاً على مسار حياته، وهو أبعد ما يكون عن رفاه بعض النجوم في ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان وركوب الموجة كلما لاح أنها عالية ورائجة: من تشيلي إلى كردستان إلى فلسطين إلى البوسنة وصولاً إلى العراق مؤخراً.
وقد لا يعرف الكثيرون أنّ التضامن مع أكراد تركيا في ما يتعرّضون له من قمع واضطهاد سياسي وثقافي وإنساني هو بين القضايا الأساسية التي تبنّاها بنتر وسلّط الضوء عليها. وكان بنتر قد رافق الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميللر في رحلة إلى تركيا، في عام 1985، لكنه بدل السياحة والاستجمام ذهب يحقق في انتهاكات حقوق الإنسان والتقى بعشرات المعتقلين السياسيين السابقين. وأثناء حفلة أقامتها السفارة الأمريكية على شرف ميللر، وبدل عبارات المجاملة واللباقة الدبلوماسية، ألقى بنتر خطبة عنيفة استعرض فيها طرائق أجهزة الأمن التركية في تعذيب السجناء، حتى أنّ السفارة لم تجد وسيلة أخرى لإسكاته سوى طرده من الحفلة، فكان أن لحق به ميللر تضامناً. وكانت تجربته في تركيا، ومع الأكراد بصفة خاصة، قد أوحت له بكتابة مسرحية "لغة الجبل".
وبرز مجدداً بقوّة في إطار حركة الإحتجاج البريطانية ضدّ الحرب على العراق. وخلال لقاء مناهض للحرب في مجلس العموم البريطاني ألقى بنتر كلمة بليغة نارية، جاءت فيها عبارته التي ستذهب أمثولة عند مناهضي الحرب: "لقد قال بوش إننا لن نسمح أن تظلّ أسوأ أسلحة العالم في أيدي أسوأ قادة العالم. ولقد نطق بالحقّ: أنظر إلى نفسك في المرآة، لأنك أنت الأسوأ". وفي حديقة هايد بارك، أثناء التظاهرة الحاشدة ليوم 15/2/2003، قال: "الولايات المتحدة وحش منفلت من عقاله. والبربرية الأمريكية سوف تدمّر العالم ما لم نواجهها بحزم. إنّ البلد تحكمه ثلّة من المجاذيب المجرمين، ومعهم بلير بوصفه السفاح المسيحي. إنّ التخطيط لمهاجمة العراق عمل من أعمال الإبادة الجماعية عن سابق تصميم".
ولد بنتر سنة 1930 في هاكني، وهي منطقة عمالية صغيرة قرب إيست إند في لندن. وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية جرى إخلاء المنطقة، وعاد ثانية إلى لندن وهو في الرابعة عشر، وسيقول إنه لن ينسى أبداً مشاهد القصف الجويّ التي عاشها، والتي ستجعله مناهضاً للحروب بصفة عامة، وتدفعه إلى رفض أداء الخدمة العسكرية (أشفق القاضي عليه فاكتفى بتغريمه 30 جنيهاً بدل السجن). في عام 1950 بدأ ينشر في مجلة Poetry التي كانت تصدر في لندن، باسم مستعار هو هارولد بنتا. ثمّ عمل ممثلاً ثانوياً في الـ BBC ، وبعد أربع سنوات من التجوال في إرلندا والمسارح الريفية كتب "الحجرة" لصالح جامعة بريستول (وأنهى النصّ في أربعة أيام!)، ثمّ كتب تمثيلية للإذاعة بعنوان "ألم طفيف"، إلى أنّ أنجز أولى مسرحياته الطويلة "حفلة عيد الميلاد"، وتوالت بعدها نصوصه المسرحية الكبيرة التي جعلت منه أحد أعظم مسرحيي هذا العصر. وهو يعيش بين لندن وباريس، ومتزوّج من المؤرخة الشهيرة ليدي أنتونيا فريزر.
والناقد البريطاني مارتن إسلن (صاحب الكتاب الشهير الرائد عن مسرح العبث) ترك لنا هذا النصّ المدهش في امتداح لغة بنتر المسرحية: "حوار بنتر منضبط متراصّ كالشعر الموزون، أو أكثر ربما. كلّ مقطع صوتي، وكلّ تصريف، وتعاقب طويل أو قصير للأصوات، والكلمات، والجمل، محسوب بعناية لكي يبدو بديعاً. وإنّ التكرارية على وجه أدقّ، وانقطاع الإتصال، وحَلَقية الكلام العاديّ العامّي، تُستخدم هنا كعناصر شكلية تتيح للشاعر أن يؤلّف الباليه اللغوي الخاصّ به".
محاضرة نوبل
الفنّ، الحقيقة، والسياسة
في عام 1958 كتبت التالي:
"ليس ثمة تمييزات فاصلة بين ما هو واقعيّ وما هو غير واقعيّ، ولا بين ما هو حقيقي وما هو زائف. إن أمراً ما ليس بالضرورة حقيقياً أو زائفاً؛ إذ يمكن أن يكون حقيقياً وزائفاً في آن".
وأعتقد أنّ هذه التأكيدات ما تزال مقبولة اليوم، ويمكن بالفعل أن تنطبق على استكشاف الواقع من خلال الفنّ. وهكذا فإنني ككاتب أظلّ مقتنعاً بها، ولكني لا أستطيع ذلك بوصفي مواطناً. يتوجب عليّ، كمواطن، أن أسأل: ما الحقيقيّ؟ ما الزائف؟
وفي الدراما تكون الحقيقة مراوغة على الدوام. المرء لا يعثر عليها أبداً، لكن البحث عنها إلزاميّ. ومن الواضح أنّ البحث هو الذي يحرّك المحاولة. البحث مهمة المرء. ويحدث مراراً أن يتعثر واحدنا بالحقيقة في العتمة، وغالباً دون أن يدرك أنه فعل. لكنّ الحقيقة الفعلية هي أنه لا يوجد البتة شيء اسمه الحقيقة يمكن العثور عليه في الفنّ المسرحي. هذه الحقائق تتحدى بعضها البعض، وتنأى عن بعضها البعض، وتعكس بعضها البعض، وتهمل بعضها البعض، وتناوش بعضها البعض، وتتعامي عن بعضها البعض. وأنت تشعر بعض الأحيان أنك تقبض في يدك على حقيقة اللحظة، ثمّ تراها تنزلق من بين أصابعك وتضيع.
وغالباً ما يُطرح عليّ سؤال حول كيفية ولادة مسرحياتي، فلا أملك جواباً. كذلك لا أستطيع أبداً تلخيص مسرحياتي، ما خلا أن أقول إنّ هذا ما يجري فيها. هذا ما تقوله. هذا ما تفعله.
ذلك لأنّ معظم المسرحيات يستولدها سطر هنا، أو كلمة أو صورة هناك. الكلمة المعطاة تعقبها الصورة عادة. وسأضرب مثالين في سطرين هبطا إلى رأسي من السماء، تتبعهما صورة، وأتبعها أنا.
المسرحيتان هما "الإياب" حيث السطر الأوّل هو: "ماذا فعلت بالمقصّ"، والثانية هي "الأزمنة الخوالي" حيث السطر يقول: "داكن".
لم تكن لديّ معلومات إضافية في الحالتين.
في الحالة الأولى من الواضح أن أحدهم يبحث عن مقصّ ويسأل عن مكان وجوده لدى شخص يرتاب في أنه قد سرقه. ولكني كنت أعرف، على نحو ما، أنّ الشخص المخاطَب لايكترث أبداً بالمقصّ أو حتى بالسؤال ذاته.
مفردة "داكن" اعتبرتُ أنها وصف لشعر ما، شعر امرأة، وكانت جواباً عن سؤال. وفي الحالتين وجدت نفسي مجبراً على اقتفاء الأمر. هذا يحدث بصرياً، بخفوت بطيء للغاية، من خلال التنقل بين الظلّ والضياء.
ودائماً ما أبدأ المسرحية عن طريق تسمية الشخصيات: أ، ب، ج.
وفي المسرحية التي صارت "الإياب" رأيت رجلاً يدخل إلى غرفة مقفرة ويطرح سؤاله على شاب أصغر سناً يجلس على كنبة قبيحة ويقرأ في جريدة سباق. وعلى نحو ما ساورني شكّ بأن أ كان أباً وأن ب كان ابنه، ولكني لم امتلك الدليل. ولقد تأكد هذا بعد قليل حين توجه ب (الذي سيصبح ليني) إلى أ (الذي سيصبح ماكس) قائلاً: "دادي، هل تمانع في أن أغيّر الموضوع؟ أريد أن أسألك شيئاً. ما اسم العشاء الذي تناولناه من قبل، ماذا كان اسمه؟ ماذا تسميه؟ لماذا لا تبتاع كلباً؟ أنت طباخ كلاب. بصراحة. أنت تظن أنك تطبخ للكثير من الكلاب". وهكذا، ما دام ب ينادي أ بـ "دادي" فقد لاح لي معقولاً تماماً أن أفترض أنهما أب وابن. واضح كذلك أن ا كان أيضاً طباخاً، ولم يكن يُنظر إلى طبخه باعتداد. هل كان ذلك يعني عدم وجود أمّ؟ لم أكن أدري. ولكن، كما حدّثت نفسي آنذاك، بداياتنا لا تتلاقى أبداً مع نهاياتنا.
"داكن". نافذة واسعة. سماء مسائية. رجل، هو أ (سيصبح ديلي فيما بعد)، وامرأة هي ب (ستصبح كيت فيما بعد)، يجلسان ويحتسيان شراباً. "بدينة أم نحيفة"؟ يسأل الرجل. عمّ يتحدثان؟ ولكني عندها ألمح امرأة واقفة قرب النافذة، هي ج (التي ستصبح أنّا فيما بعد)، ضمن وضعية أخرى من الضوء، تدير ظهرها لهما، وشعرها داكن.
إنها برهة غريبة، برهة خلق شخصيات لم يكن لها وجود حتى تلك اللحظة. ما يعقب هذا يكون متقطعاً، غير أكيد، أو حتى محض هلوسة، رغم أنه أحياناً قد يكون أشبه بانهيار ثلجي لا يمكن إيقافه. وموقف المؤلف عجيب هنا. ففي معنى أوّل هو ليس مرّحباً به من جانب الشخصيات. إنها تقاومه، وليس من اليسير العيش في كنفها، ومن المحال تعريفها. ولا ريب أنك لا تستطيع الإملاء عليها. وأنت، إلى درجة ما، تلعب معها لعبة لا تنتهي، القط والفأر، الأعمى معصوب العينين، والاستغماية. ولكنك في النهاية تكتشف أنك أمام بشر من لحم ودمّ، لهم إرادتهم وحساسيتهم الفردية، ويتألفون من أجزاء مكوِّنة ليس في مقدورك تبديلها، أو استغلالها، أو تحريفها.
وهكذا فإنّ اللغة في الفنّ تظلّ تحويلاً بالغ الغموض، ورمالاً متحركة، ومنصة بهلوان (ترامبولين)، وبحيرة متجمدة يمكن أن تتكسر تحت قدميك، أنت المؤلف، في أية لحظة.
ولكن البحث عن الحقيقة، كما قلت، لا يمكن أن يتوقف. لا يمكن إرجاؤه أو تأجيله. لا بدّ من مجابهته، وجهاً لوجه، في البقعة المطلوبة.
المسرح السياسي يقدّم مجموعة مشكلات مختلفة تماماً. ينبغي تحاشي الوعظ أياً كان الثمن. الموضوعية ضرورية. ينبغي السماح للشخصيات بأن تتنفس هواءها الخاص. ولا يستطيع المؤلف حجزها أو حصرها لكي يشبع ذوقه الخاص أو مزاجه أو عصبيته. ينبغي أن يكون مؤهلاً لمقاربتها من زوايا مختلفة، من نطاق منظورات تامة وغير مكبوتة، وأن يأخذها على حين غرّة، بين حين وآخر ربما، ويمنحها مع ذلك حرّية أن تسلك الدرب الذي تشاء. هذا لا ينجح دائماً. فبالطبع، السخرية السياسية لا تلتزم بأيّ من هذه القواعد السلوكية، بل تفعل العكس في الواقع، وهذه تحديداً هي وظيفتها.
وأظن أنني، في مسرحيتي "حفلة عيد الميلاد"، سمحت لنطاق عريض من الخيارات أن يفعل فعله في غابة كثيفة من الإمكان، قبل التركيز ختاماً على فعل إخضاع.
"لغة الجبل" لا تزعم النطاق ذاته من العمليات. إنها تظلّ وحشية، قصيرة، وبشعة. لكن الجنود في المسرحية يستخرجون منها بعض المرح. فالمرء أحياناً ينسى أنّ من السهل انقلاب التعذيب إلى مصدر ملل. إنهم، لهذا، يحتاجون إلى ضحكة ما لكي تظل معنوياتهم عالية. وبالطبع، تأكد هذا في وقائع "أبو غريب" في بغداد. "لغة الجبل" تدوم 20 دقيقة فقط، لكنها يمكن أن تتواصل ساعة بعد ساعة، كرّة بعد كرّة، فيتكرر النسق ذاته مرّة بعد أخرى، دواليك، ساعة بعد ساعة.
"من الرماد إلى الرماد"،من جانب آخر، تبدو لي وكأنها تجري تحت الماء. امرأة غريقة، يدها ممدودة من خلال الأمواج، تتهاوى بعيداً عن الأنظار، تتطلع إلى الآخرين، ولكنها لا تجد أحداً، لا فوق الماء ولا تحته، ولا تعثر إلا على ظلال، انعكاسات، وطفو. المرأة شخص ضائع في مشهدية غرق، امرأة عاجزة عن الفرار من القدر الذي بدا وكأنه ينتمي إلى الآخرين وحدهم.
ولكن حين يموت الآخرون، ينبغي أن تموت هي أيضاً.
اللغة السياسية، كما يستخدمها الساسة، لا تقتحم أياً من هذه المناطق لأنّ غالبية الساسة، وفق ما نملك من أدلة، لا يهتمون بالحقيقة بل بالسلطة وصيانة السلطة. ولصيانة تلك السلطة، من الجوهري أن يبقى البشر جاهلين عن الحقيقة، وأن يعيشوا وهم يجهلون الحقيقة، حتى حقيقة حيواتهم ذاتها. وما يحيط بنا، إذاً، هو تطريز هائل من الأكاذيب، نقتات عليها.
وكما يعرف كل فرد هنا، كان تبرير غزو العراق هو أن صدام حسين امتلك كتلة شديدة الخطورة من أسلحة الدمار الشامل، بعضها يمكن إطلاقه خلال 45 دقيقة، فيتسبب في دمار مريع. لقد أكدوا لنا أن هذا الزعم حقيقي. ولقد تبيّن أنه ليس الحقيقة. وقيل لنا إن العراق يقيم علاقة مع "القاعدة" ويشترك في المسؤولية عن فظائع 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في نيويورك. أكدوا لنا أنّ هذا الزعم حقيقي. تبيّن أنه ليس الحقيقة. وقيل لنا إن العراق يهدد أمن العالم. أكدوا لنا أنّ هذا الزعم حقيقي. تبيّن أنه ليس الحقيقة.
الحقيقة شيء مختلف كل الاختلاف. الحقيقة هي كيف تفهم الولايات المتحدة دورها في العالم وكيف تختار تجسيده (...)
الولايات المتحدة ساندت، وفي كثير من الحالات استولدت، كل دكتاتورية عسكرية يمينية في العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. أنا أشير إلى إندونيسيا، اليونان، الأرغواي، البرازيل، باراغواي، هاييتي، تركيا، الفيليبين، غواتيمالا، السلفادور، وتشيلي بالطبع. والأهوال التي أنزلتها الولايات المتحدة بتشيلي سنة 1973 لا يمكن محوها ولا يمكن غفرانها أبداً. مئات الآلاف من حالات الموت شهدتها هذه البلدان. هل جرت بالفعل؟ وهل جميعها حالات تُنسب إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟ الجواب هو: نعم لقد جرت تلك الحالات، وهي تُنسب إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولكنك أنت لم تكن تعلم بها.
لم تحدث قط. لم يحدث أي شيء قط. حتى حين كانت تحدث، فإنها لم تكن تحدث. لم يكن الأمر موضع اكتراث. لم تكن له أهمية. لقد كانت جرائم الولايات المتحدة منهجية، ثابتة، خبيثة، لا ندامة فيها، ولكنّ قلة من الناس تحدثوا عنها. الفضل في ذلك يرجع إلى أمريكا. لقد مارست استغلالاً للسلطة يكاد يكون سريرياً على امتداد العالم، وكانت في الآن ذاته ترتدي قناع القوّة المدافعة عن الخير في العالم. وهذا فعل في التنويم المغناطيسي لامع، شديد النجاح، وطريف أيضاً.
أقول لكم إن الولايات المتحدة هي، دون شك، العرض الأكبر على الطريق. قد تكون وحشية، لامبالية، احتقارية، قاسية لا ترحم. ولكنها أيضاً ذكية جداً. إنها بائع جوّال يعتمد على نفسه، لكنّ البضاعة التي يبيعها هي حبّ الذات. إنها تجارة رابحة. إستمعوا إلى كلّ رؤساء أمريكا على التلفزة ينطقون عبارة "الشعب الأمريكي" كما في الجملة التالية: "أقول للشعب الأمريكي لقد حان الوقت للصلاة وحماية حقوق الشعب الأمريكي وأطلب من الشعب الأمريكي أن يثق برئيسه في العمل الذي ينوي القيام به نيابة عن الشعب الأمريكي".
إنها حيلة براقة. اللغة تُستخدم عملياً لإبقاء العقل بعيداً. وعبارة "الشعب الأمريكي" توفّر حشيّة وثوقٍ شهوانيةً حقاً. لا حاجة لك إلى التفكير. استلقِ على الحشية فقط. قد تخنق الحشية ذكاءك وملكة النقد عندك، ولكنها مريحة. هذا بالطبع لا ينطبق على 40 مليون أمريكي يعيشون تحت خطّ الفقر، وعلى مليونين من الرجال والنساء مسجونين في سجون هائلة شبيهة بالـ "غولاغ"، منتشرة على امتداد الولايات المتحدة.
أمريكا لم تعد تعبأ بالنزاع متوسط الشدّة. وهي لم تعد ترى مبرراً لأن تكون كتومة أو حتى مخادعة. إنها تضع أوراقها على الطاولة دون خوف أو محاباة. إنها ببساطة لا تلقي بالاً إلى الأمم المتحدة، والقانون الدولي أو الإنشقاق النقدي، وتعتبرها غير ذات صلة. ولديها كذلك خروفها الصغير المربوط خلفها، أي بريطانيا العظمى المنبطحة البليدة.
ما الذي أصاب حسّنا الأخلاقي؟ هل امتلكنا مثل هذا الحسّ في أيّ يوم؟ ما الذي تعنيه هذه الكلمات؟ هل تشير إلى مصطلح يندر استخدامه هذه الأيام: الضمير؟ الضمير الذي لا يكون مسؤولاً عن أفعالنا الشخصية فقط، بل عن مسؤوليتنا المشتركة إزاء أفعال الآخرين؟ هل مات هذا كله؟ أنظروا إلى خليج غوانتانامو. مئات الناس محتجزون هناك بلا تهمة، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بلا تمثيل قانوني أو محاكمة، بمثابة موقوفين إلى الأبد بالمعنى الفني للكلمة. هذا الهيكل الخارج تماماً عن القانون يواصل البقاء في تحدّ صريح لمواثيق جنيف. وما يُسمى "المجتمع الدولي" لا يسكت عليه فحسب، بل يكاد يتناساه أيضاً. وهذه الإهانة الإجرامية ترتكبها دولة تعلن نفسها "زعيمة العالم الحرّ". هل نفكر في ساكني خليج غوانتانامو؟ ماذا تقول وسائل الإعلام عنهم؟ ما الذي قاله وزير الخارجية البريطاني؟ لا شيء. ماذا قال رئيس الوزراء؟ لا شيء. لماذا؟ لأنّ الولايات المتحدة قالت: انتقاد سلوكنا في غوانتانامو يشكل فعلاً غير ودّي. إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. وهكذا أغلق بلير فمه.
غزو العراق كان فعل لصوصية، وإرهاب دولة فاضحاُ، يكشف عن احتقار مطلق لمفهوم القانون الدولي. كان الغزو عملاً عسكرياً عشوائياً أوحت به سلسلة أكاذيب قائمة على أكاذيب، وتلاعب بوسائل الإعلام ثمّ بالجمهور تالياً. وهو فعل يسعى إلى توطيد الهيمنة الأمريكية العسكرية والاقتصادية على الشرق الأوسط، تحت قناع زائف هو التحرير، بعد افتضاح كل الذرائع الأخرى. تأكيد بديع لقوّة عسكرية مسؤولة عن مقتل وتشويه آلاف وآلاف الناس الأبرياء.
لقد جلبنا على الشعب العراقي صنوف التعذيب، والقنابل العنقودية، واليورانيوم المستنفد، وأفعال الجريمة العشوائية التي لا تحصى، والبؤس، والتدهور، والموت، ونطلق على هذا كلها اسم "جلب الحرية والديمقراطية للشرق الأوسط".
كم من الناس ينبغي أن تُقتل قبل أن تستحق صفة القاتل الشامل أو مجرم الحرب؟ مئة ألف؟ أظن أن هذا الرقم يكفي ويزيد. ولهذا فإنّ من العدل تقديم بوش وبلير أمام محكمة جرائم الحرب الدولية. لكن بوش كان ذكياً، لأنه لم يصادق على بروتوكول المحكمة. وإذا وجد أي جندي، أو حتى سياسي، نفسه خلف القضبان فإن بوش سوف يرسل المارينز. ولكن بلير صادق على البروتوكول وهو لهذا متوفر للمحاكمة. وفي وسعنا ان نتبرع بعنوانه للمحكمة إذا شاءت: 10 شارع داوننغ، لندن.
الموت في هذا السياق عديم الصلة، مع ذلك. بوش وبلير، كلاهما، يضعان الموت في آخر اعتباراتهما. لقد قُتل 100,000 عراقي بفعل القنابل والصواريخ الأمريكية قبل أن يبدأ العصيان في العراق. هؤلاء الناس ليسوا في عداد الزمان. موتهم ليس في الحسبان. إنهم أصفار. إنهم حتى غير مسجلين في خانة الموتى. "نحن لا نقوم بإحصاء الأجساد"، قال الجنرال الأمريكي تومي فرانكس (...) الدم قذر. إنه يوسخ قميصك وربطة عنقك حين تلقي خطبة صادقة على شاشات التلفزة.
هنا مقطع من قصيدة بابلو نيرودا "إنني أشرح بضعة أشياء":
وذات صباح أخذ كل ما يحترق،
كل ما يُضرم في الدروب
يقفز على الأرض
يبتلع الكائنات البشرية
النار منذ اليوم
والبارود منذ اليوم
والدم منذ اليوم
قطاع طرق مسلحون بالطائرات والمرتزقة
قطاع طرق بخواتم في الأصابع ودوقات
قطاع طرق في ركابهم رهبان سود يبصقون التبريك
هبطوا من السماء لذبح الصغار
وسال دم الأطفال في الشوارع
دون جلبة، مثل دم الأطفال.
بنات آوى من طراز تحتقره بنات آوى
حجارة تعضها الأشواك الجافة وتبصقها
أفاع تمقتها الأفاعي.
وجهاً لوجه، معك، رأيت دماء إسبانيا
تعلو مثل طوفان
لتغرقك في موجة واحدة
من الكبرياء والخناجر.
يا جنرالات الغدر الخونة:
أنظروا بيتي الميت،
حدّقوا في إسبانيا الكسيرة:
من كل بيت يسيل المعدن الذائب
بدلاً من الزهور
ومن كل مقبس في إسبانيا
تنبثق إسبانيا
ومن كلّ طفل قتيل تطلع بندقية ذات عيون
ومن كلّ جريمة يولد الرصاص
الذي سيعثر ذات يوم
على عين الثور في قلوبكم.
ولسوف تسألون: لم لا يتحدث شعره
عن الأحلام وأوراق الشجر
والبراكين الكبرى في بلده الأمّ.
تعالوا وانظروا الدم في الشوارع.
تعالوا وانظروا
الدم في الشوارع.
تعالوا وانظروا الدم
في الشوارع.
(...) إن حياة الكاتب نشاط شديد الهشاشة، يكاد يبلغ درجة العري. وليس علينا أن ننتحب جراء هذا. الكاتب يحدد خياره ويلتزم به. ولكن من الصحيح أن يقول المرء إنه منفتح على كل الرياح، التي يكون بعضها قارساً حقاً. المرء في العراء على حسابه، متشبثاً بغصن. لا ملجأ لك، لا حماية، إلا إذا كذبت، وبالطبع فإنك في هذه الحالة تكون قد صنعت حمايتك بنفسك، ومن الممكن القول إنك بذلك صرت سياسياً.
لقد أشرت إلى الموت مرات عديدة في هذه الأمسية. وسأقتبس الآن قصيدة لي عنوانها "موت":
أين عُثر على جسد الميت؟
مَن عثر على جسد الميت؟
هل كان جسد الميت ميتاً حين عُثر عليه؟
كيف عُثر على جسد الميت؟
مَن كان الميت؟
مَن هو الأب أو الابنة أو الأخ
أو العمّ أو الأخت أو الأمّ أو الابن
للميت وللجسد المُنتَبذ؟
هل كان الجسد ميتاً حين انتُبذ؟
هل انتُبذ الجسد؟
ولكن مَن الذي انتبذ؟
هل كان جسد الميت عارياً أم مرتدياً ثيابه استعداداً لرحلة ما؟
ما الذي جعلكم تعلنون جسد الميت ميتاً؟
هل أعلنتم جسد الميت ميتاً؟
كم كانت وثيقة معرفتكم بجسد الميت؟
كيف عرفتم أن جسد الميت كان ميتاً؟
هل غسلتم جسد الميت
هل أغلقتم عينيه الإثنتين
هل دفنتم الجسد
هل تركتموه منتبذاً
هل قبّلتم الجسد...
وإذ نتطلع في المرآة نخال أن الصورة التي تواجهنا دقيقة. ولكن لو تحرّكنا مللمتراً واحداً، فستتغيّر الصورة. والحال أننا ننظر في نطاق من الإنعكاسات لا نهاية له. ولكنّ على الكاتب في برهة ما، أن يحطم المرآة ـ إذْ على الجانب الثاني من تلك المرآة تشخص الحقيقة إلينا.
إشارة:
في المقاطع التي لا تظهر في هذه الترجمة يقدّم بنتر المزيد من التفاصيل عن جرائم الولايات المتحدة قبل غزو العراق، وهي معروفة القارىء وموثقة ولهذا رأينا اختصارها. وبالطبع، تقصد بنتر التشديد عليها مجدداً في هذا النصّ بالذات، حيث تدخل محاضرة نوبل في الأرشيف الرسمي لمئات الجامعات ومراكز البحث الأمريكية.
****
أشعار
قصائد مبكرة
القزم
رأيتُ القزم في قلب الفضاءات الرنانة،
تلك الليلة أعلى الذروة المزبدة.
ثمة الشجر المنحني، وثمة الوحش الصامت،
أسفل الرياح.
وأبصرتُ الرحّالة واقفين لابثين،
تغشاهم سكنة الموت، لابثين في التوابيت
ذلك المقام الساكن،
الأيدي متشابكة، والقبعات الطويلة شاخصة.
1950
مرج هامستد
ها أنني، المستلقي على العشب، أستلقي
في قلب البرهة الصافقة بالرعد،
أقتلع الصوت
في التخم الأخضر.
حجارة في رحم الثمرة،
وعالم تحت العشب،
وحيداً أسفل الوحيد.
جسدي يستهلك الخطوط
الموصى بها، في خطّ النهار البياني.
ألاحظ النملة البنّية
في أدغال شفرات النبات.
أنا بياض بؤبؤ عيني، أحذف
النملة من مرتبة القدرة،
أُنْقِصُ حميّة البذور
هذه اللحظة القاطعة.
تحت الذبابة الشفيفة
تخطو معادلة الحشرة إياها
فوق زجاج الكلمة المستدق،
وتصدر إرشادات للفراغ.
مكائد خارجية: قرقعة
الغاب؛ تجارة الضجيج
المستطيلة؛ ثمّ وقفة تلك
الأغصان العالية.
1951
الدراما في نيسان
وهكذا صار آذار متحفاً،
وتحرّكت ستائر نيسان،
أسافر في المعرض الخاوي
إلى آخر المقاعد.
في الديكور الربيعي
ينصب الممثلون الخيام،
وعلى ذبالة الضوء
يبدأون مسرحيتهم.
صرخاتهم في الظلام المغطى بالمساحيق
تتجمع في الحداد على
سفراء الأجنحة.
وثمة لوازم ودعامات تحت المطر
هي رماد الدار
وحجارة القير التي لا تُحصى
في غمرة الخضرة.
أنتقل إلى الفاصل المسرحي،
وقد اكتفيت من هذه الفرقة.
1952
أنتَ في الليل
عليكَ، وأنت في الليل، أن تصغي
إلى الرعد والهواء المشّاء.
وأنت، على ذلك الشاطئ، سوف تتحمل
ما تأتي به الأجواء العاتية.
كلّ ما عزّز الأمل
سوف يتهاوى على لوح الإردواز،
ويكسر شوكة الشتاء
الذي يصخب عند قدميك.
ورغم أنّ المذابح اليتيمة تحترق،
والشمس المتلكئة
تجعل النسر ينبح،
فإنك سوف تطأ سراطاً مستقيماً.
1952
مسير على وتيرة انتظار
مسير على وتيرة إصغاء.
مسير على وتيرة انتظار.
إنتظرْ في غمرة الشتاء
المصغي، وسِرْ صحبة العشب.
إسترحْ عند كأس الانتظار.
سرْ صحبة فصل الأصوات.
عدّدْ شتاء الزهور.
سرْ صحبة فصل الأصوات.
إنتظرْ قرب كأس أبكم.
1953
ضياء النهار
ألقيتُ حفنة بَتلات على ثدييك.
وها أنت، وقد أصابك ضياء النهار بالندوب،
تستلقين صريعة البتلات.
وها جلدك يحاكي الغضارة، ورأسك
يتلفّت في كلّ جهة،
وتغمرك خرائب الزهور.
الآن أجلبك من الظلمة إلى رابعة النهار،
راصفاً بَتلة فوق بتلة.
1965
****
قصائد سياسية
لقاء
إنهم موتى الليل
موتى الأزمنة السالفة يتطلعون
صوب الموتى الجدد
السائرين حثيثاً إليهم
ثمة نبض خفيض للقلب
حين يتعانق الموتى
أولئك الذين ماتوا في سالف الأزمنة
وأولئك الذين ماتوا من جديد
السائرين حثيثاً إليهم
يتبادلون البكاء والقُبَل
إذْ يلتقون اليوم مجدداً
للمرّة الأولى والأخيرة.
آب/ أغسطس 2002
بعد الغداء
تتقاطر المخلوقات الأنيقة في ساعات ما بعد الظهر
لكي تتشمّم صفوف الموتى
وتتناول غداءها
كلّ هذه المخلوقات الأنيقة العديدة
تقتلع من التراب ثمار الأفوكادو المتورّمة
وتحرّك الحساء الكثيف بعظام ضالّة
وبعد الغداء
تسترخي المخلوقات كسلى وتنفق الوقت
في تسكاب الخمرة الحمراء في جماجم لائقة
أيلول/ سبتمبر 2002
اللهم باركْ أمريكا
هاهم ينطلقون من جديد،
اليانكي في استعراضهم المدرّع
يصدحون بأناشيد الفرح
وهم يخبّون على امتداد العالم الكبير
يسبّحون بحمد إله أمريكا.
المزاريب سُدّت بالموتى
أولئك الذين لم يتمكنوا من الانضمام إلى الصفّ
أولئك الذين رفضوا الغناء
أولئك الذين فقدوا أصواتهم
أولئك الذين أضاعوا اللحن.
وللراكبين سياط تقطع.
يتدحرج رأسك على الرمال
رأسك بركة في القاذورات
رأسك لطخة في التراب
كَلّتْ عيناك وأنفك
لم يعدْ يشمّ سوى رائحة الموتى
وهواء الموتى عابق تماماً
برائحة إله أمريكا.
كانون الثاني/ يناير 2003
قنابل
لم يعد ثمة كلمات تُقال
وكلّ ما تبقى لنا هي القنابل
التي تتفجّر من رؤوسنا
كلّ ما تبقى لنا هي القنابل
التي تستنزف آخر قطرة في دمائنا
كلّ ما تبقى لنا هي القنابل
التي تصقل جماجم الموتى
شباط/ فبراير 2003
ديمقراطية
ليس ثمة مهرب
الأعضاء الذكورية الضخمة مُشْهَرة
وستخترق كلّ ما يقع عليه البصر.
إحرصْ على مؤخرتك. (2)
آذار/ مارس 2003
نشرة الأحوال الجوية
سوف ينطلق اليومُ ببداية غائمة.
وسيكون الجوّ رطباً
ولكنْ على امتداد النهار
سوف تسطع الشمس
وسيكون الجوّ جافاً ودافئاً في فترة ما بعد الظهيرة.
في المساء سيضيء القمر
وسيكون منيراً تماماً.
ولكن ستهبّ، كما يتوجب القول،
ريح خفيفة
ستتلاشى تماماً عند منتصف الليل.
لن يحدث أيّ شيء آخر.
هذه هي نشرة الأحوال الجوية الأخيرة.
آذار/ مارس 2003
كرة قدم أمريكية
هلليلويا!
الأمور على ما يرام.
لقد مرّغناهم في القذارة.
لقد مرّغناهم في القذارة التي طرحتها مؤخراتهم
وطرحتها آذانهم العاهرة.
الأمور على ما يرام.
لقد مرّغناهم في القذارة.
لقد ماتوا اختناقاً في قذارتهم!
هلليلويا!
تبارك الربّ على كلّ الأشياء اللذيذة.
لقد مرّغناهم في قذارتهم العاهرة.
إنهم يأكلونها.
تبارك الربّ على كلّ الأشياء اللذيذة.
لقد جعلنا خِصِيّهم كِسَراً من التراب
جعلناها كِسَراً من التراب العاهر.
فعلناها.
والآن أريدك أن تقتربي منّي،
وأن تقبّليني في فمي.
آب/ أغسطس 1991
ــــــــــــــــــــــ
(1) القصائد المبكرة من مجموعة Collected Poems and Prose, Faber and Faber, London 1991 والقصائد السياسية ظهرت مجتمعة في كراس بعنوان War، صدر في لندن سنة 2005 عن الدار ذاتها.
(2) تجدر الإشارة إلى أنّ صحيفة الـ "غارديان" البريطانية اليسارية كانت قد اعتذرت عن نشر هذه القصيدة في حينه، فنشرها بنتر في أسبوعية "سبكتاتور"... المحافظة!
*******
شعرية الصمت
ذات يوم، خلال مقابلة على إذاعة الـ BBC، وجّه كنيث تينان نقداً إلى هارولد بنتر لأنه لا يتناول الأفكار ولا يستزيد في كشف شخصياته، فردّ بنتر بأنه إنما كان يسعى إلى دفع شخصياته نحو "الحافة القصوى لحيواتهم، حيث يعيشون في وحدة بالغة". واهتمام بنتر ليس منصباً على "البروليتاريا المناضلة" الخاصة بالواقعيين الإشتراكيين، ولا حتى على فكرة مجردة عن "الإنسان"، بل هو بالأحرى يبحث عن التجربة الملموسة للكائن البشري. شخصياته لا يُعثر عليها خلف المتاريس ولا خلف وشاح السلطة. إنهم أفراد وحيدون خائفون نكصوا إلى عزلة حجراتهم ليتأملوا. إنهم ملوك ومستشارون، ولكن دون امتيازات. إنهم جميعاً، تحت الجلود، مخلوقات ترتعد هلعاً من الصمت الذي يكتنف وجودها.
وفي مناسبة أخرى شرح بنتر وجهة نظره كما يلي: "أنا مهتمّ بالناس في المقام الأوّل: أريد أن أقدّم للجمهور بشراً أحياء، جديرين بذلك الاهتمام لأنهم في حالة وجود أساساً، ولأنهم موجودون، وليس بسبب من أيّة حكمة أخلاقية قد يستمدّها الكاتب منهم" (1)
وبذلك ينبغي أن تنبثق تجربتنا الدرامية من إقرارنا بالمخلوقات الزميلة لنا، وليس بسبب من إجماعنا على ما يحدث أن تؤمن أو لا تؤمن به تلك المخلوقات. والمؤلف عايش حلم المسرحية مرّات لا تحصى قبل أن يحوّلها أخيراً إلى شكل ومادّة. في البدء يدخل الجمهور إلى حلم المسرحية ببراءة مقارنة، لكنه سرعان ما يبدأ في العثور داخل تلك المسرحية على نتف وأجزاء من حياة المرء الشخصية. والعثور داخل الأحلام المنفصلة على نقاط تماسّ كهذه هو منتهى الإتصال الجمالي. وأخيراً، ليست هنالك حكمة وعظية يمكن استنباطها من مسرحيات بنتر، ولا توجد خريطة طريق في علم الواجبات الأخلاقية تقودنا في أرجاء عمله وتذكّرنا أنّ الحلم الذي نحلمه له صفة جماعية.
أطروحة هذه السطور هي أنّ موهبة بنتر الدرامية الخاصة تكمن في موهبة الألسن، والقدرة على الإصغاء وإعادة إنتاج صوت الصمت. مسرحياته تكشف عن تبادل إيقاعي بين الصوت والصمت، هو الذي يتولى الإيصال حين لا يُفترض في الإيصال أن يكون ممكناً. وفي كتابه "تاريخ الشكل في الأدب الألماني" شرح كلوبستوك كيف أنّ "الكيفية غير المبنية على الكلمات تتحرّك في القصيدة مثل الآلهة في معارك هوميروس، فلا يبصرها إلا القلّة". ولعلّ إسهام بنتر الأعظم هو اكتشاف تلك الكيفية في لغتنا، وإحياء ما أسماه ريلكه "اللغة حيث تنتهي اللغة".
وأما إسهام بنتر الخاصّ فهو أن يسند ألسنياً ذلك النوع من التوترات التي لاح أنها تحرّك شخصياته من الداخل. الجملة المتشظية، والعبارة المتروكة معلّقة، والوقفة غير الملائمة، تصبح كلها مظاهر خارجية لقلق داخلي، ولرَيْبة أعمق. والصدام التنافري للغة في "البوّاب"، مثلاً، لا يؤشر فحسب على الصدام الذي ينشأ بين شخصية وأخرى، بل كذلك في داخل كل شخصية. وجهود الكلام المرتبكة التي تعقب هذه المواقف تشير إلى حاجة ماسة عند الشخصيات للتعريف بذواتها. فإذا جازت إعادة صياغة تعريف كلاوزفيتز للحرب، فإنّ اللغة تصبح استمراراً للتوتر بوسائل أخرى. وهايدغر يذكّرنا أنه في مناسبات كهذه تبدو اللغة مَلَكة تمتلك الإنسان، لا العكس.
غير أن هدف "استمرار التوتر" قد لا يكون دائماً تبادل المعلومات. فعلى النقيض، تذهب بعض شخصيات بنتر إلى الإطالة بمقدار ما، بغية تفادي تعرّف الآخرين إليها. والأصوات التي تتبادلها هذه الشخصيات هي فعل إعاقة، ومناوشة هدفها تحاشي المواجهة الأكبر. وبنتر يصف هذه الإستراتيجية على النحو التالي: "الإتصال بين البشر مفزع في حدّ ذاته، إلى درجة أنّ البشر يستعيضون عنه بالكلام المتقاطع، وبمواصلة الحديث عن أشياء أخرى بدل تلك التي في صلب وشائجهم".(2) وأحد مصادر المراوغة حول التواصل يمكن أن يُستمدّ من المستويات المتعارضة للمعرفة أو الذكاء. ففي "حفلة عيد الميلاد"، مثلاً، يستطيع ماكان وغولدبرغ التشويش على ستانلي بسبب تلميحهما الدائم إلى قوى غير معروفة أو أحداث خافية لكنها ذات مغزى. أو يستطيع ميك، في "البوّاب"، البقاء متقدماً على دافيز بسبب ذكائه الأرفع ونباهته. لكنّ مصدر التملص الأهمّ يصنعه فزع الشخصية من أنّ انكشافها، أو الإفصاح عن دخيلتها، يجعلها تحت رحمة أولئك الذين يعرفونها. دافيز، مثلاً، لن يعترف البتة بالكثير حول سيدكب، الأمر الذي سيكشف أوهامه. ولهذا فإنّ كلّ ما سيقوله، أياً كانت أهميته، يظلّ جزءاً من محاولته الأعرض للوقوف على تفاصيل حيوية تخصّ الآخرين، والإبقاء على أسراره هو حبيسة نفسه.
وحين نتفحص خطوط الحوار الفردية التي استجمعها بنتر، فإننا قد لا نلحظ مغزى خاصاً فيها. إنها تبدو لغة بشر عاديين ذوي مشاغل عادية. ولكننا إذا تفحصنا الشذرات ذاتها ضمن السياق الإجمالي للمسرحية، فإننا سنكتشف أنها تتخذ فحوى مضافاً. نبدأ، على سبيل المثال، في اكتشاف المرجعيات المتقاطعة التي تحيك نسيجاً تلميحياً، هو النسيج الذي سيخدم بدوره في تكوين سياق لحوادث أخرى كانت، سوى هذا، معزولة. ورغم أنّ "حقيقة" حوار ما قد تبدو قابلة للنفي أو المساءلة بفعل "حقيقة" حوار آخر، فإنّنا مع ذلك ندرك وجود إيقاع حاذق وراء الحوار التلاسني للشخصيات، هو الإيقاع الذي لم يكن جلياً في البدء. والمحظوظون الذين أتيح لهم أن يشاهدوا زيرو موستيل وبرغس مريديث يؤديان "في انتظار غودو"، صُعقوا من توازن واتزان السطور، ذات السطور التي بدت ميتة غير مترابطة على الصفحة المطبوعة. الظاهرة نفسها تتكرر حين تضجّ الحياة في حوار بنتر على الخشبة. والإنتباه ذاته الممنوح للتفاصيل، والذي بدا تافهاً في سيرورة القراءة، يشفر على الخشبة عن صعود وهبوط في مقدار التشويق. الوقفات تجبر الجمهور والشخصيات، معاً، على اعتبار الإستجابة المتوفرة ممكنة. والوقفات، بالتالي، ليست فارغة بل طافحة بالترقبات الباحثة عن التحقق.
والجمال الحاذق في لغة بنتر اليومية ينبع من قدرتها في أن تحكي لنا المزيد عن الشخصيات التي تستخدم تلك اللغة، أكثر من قدرتهم هم أنفسهم على إخبارنا. ومثل كلّ الشعراء الغنائيين يبدأ التزام بنتر الأوّل من "كيف" يكون التواصل، وليس من "عمّ" يدور. وإذا بدت تلك اللغة الدنيوية غامضة مصابة بالفزع، فهذا لأنّ حيوات الناس الذين يستخدمون لغة مستنفدة هي بدورها غامضة مصابة بالفزع. والواقعيّ يشرع عادة في استخدام لغة المشاع فينجح في إعادة إنتاج ما يظنّ أنه لغة المشاع. المفارقة أنّ نجاح بنتر في توليف آذاننا على الأنماط اليومية للخطاب إنما يمكننا من استرداد مستويات الغرابة والغموض الموروثة في التجربة الإنسانية المشاع. فهذا سبيل لواقعيّ يقودنا إلى يقينية الأحشاء، وذاك سبيل لواقعي آخر يقودنا إلى ظاهراتية الروح.
* * *
النقد الذي وجّه إلى بنتر انصبّ في الواقع على ما لم يفعله، وليس على ما فعله. معظم هذا النقد افتقر على الدوام إلى تحسس الجوهر في ما يفعله بنتر حقاً. ولعلّ أكثر هذا النقد جدية ومنهجية صدر عن فكتور أمند، في خمسة اعتراضات خاصة.(3) الأوّل، يساجل أمند، أنّ بنتر يُدخل الرموز ثمّ لا يستكملها (بوذا، في "البوّاب" يمكن أن يصلح مثالاً). صحيح أنّ بنتر يدخل عدداً من اللارموز، أي تلك الرموز التي لا تشارك في الإيصال. ولكن يجب أن نفهم أنّ هذه اللارموز جزء من النظرة الكونية للمسرحية، وهي نظرة كونية انهارت فيها التناقلات وانكسرت الرموز، لكي نستخدم تعبير تيليش. ثانياً، يعتبر أمند أنّ بنتر يفرط في الغموض، وهو نقد مرتبط بالأوّل وتكمن خلفه رغبة في أن يبدو العالم واضحاً، سواء أكان كذلك أم لم يكن. من الصحيح، مع ذلك، أنّ بنتر يطمس، غالباً وعن سابق قصد، بواعث وخلفيات شخصياته. لكنّ السؤال يظلّ ما إذا كان المؤلف يعفّ عن هذا أم ينفخ الحياة في موقف يكون الغموض أحد عواقبه الطبيعية. الدراما هي أن نطلق إلى الخارج تلك المشاعر الدفينة في الداخل، والمرء يرتاب في أنّ غموض مسرحيات بنتر يعكس محاولة من جانبه للإستجابة بوفاء إلى المجهول في اسم كوننا وطبيعته. وبنتر لن يلجأ إلى حيلة "الإله من الآلة" deus ex machina، ولا إلى إرادة سرية أو ابن عمّ ضائع من أجل كشف النقاب عن الشبكة العنكبوتية للتجربة الإنسانية.
انتقاد أمند الثالث قد يكون مبتسراً. ففي ما يخصّ اهتمام بنتر بمسألة الإيصال، هنالك الكثير من الأمور التي يقوم بها المرء في إيصال اللا ـ إتصال. بنتر، حسب أمند، يجازف بتكرار نفسه. وقد يصحّ أنّ المرء لا يستطيع إيصال اللا ـ إتصال على نحو أصيل دائماً، ولكن في وسع المرء أن يستمرّ في إيصال مختلف بواعث أولئك الذين لا يرغبون، او لا يستطيعون، التأثير في الإيصال. وفي الحالتين ينبغي منح بنتر الحقّ في تطوير زمنه وطرازه بنفسه.
التهمة الرابعة ضدّ بنتر قد تكون مبررة. يستخلص امند أن شخصيات بنتر ليست "وضيعة" في تركيبها فحسب، بل هي "وضيعة" في النفس أيضاً. وقد يسأل المرء: وما المشكلة في هذا؟ هل على جميع الشخصيات أن تتحلى بمكانة أرسطية؟ كلا، بالطبع. قد تكون شخصيات سوفوكليس أظهرت الوضعية المأساوية للإنسان في صراعه مع الآلهة. لكن شخصيات بنتر تُظهر لنا مفارقة أن نكون في وضعية حرب مع أنفسنا، في زمن يشهد أفول الآلهة. الكاتبان، سوفوكليس وبنتر، يخدمان جمهورهما جيداً، كلٌّ على طريقته.
النقد الأخير الذي يسوقه أمند هو أنّ بنتر صاحب مقاربة سلبية للقِيَم. وخلف هذا الإعتراض تختفي دعوة من أجل القيم "الحقة" والأفكار "الحقة"، أو حتى النوع "الحقّ" من السياسة. لكن بنتر يرفض مبادلة ربحه الجمالي في مقايضة صاخبة على ساحة السوق. ولعلّ من الخير أن يتذكر المرء ملاحظة هرميس ترسميغيستوس بأنّ الأشياء في الأعلى هي صورة عن الأشياء في الأسفل. والفنان الصادق مع رسالته قد يجد من الضرورة، في عصرنا هذا، أن يعمل وفق ما أسماه هوبر "الإفشاء السلبي".
والحال أنّ بنتر، كما ينبغي على كلّ فنان وفيّ لرؤيته الخاصة، يحمل ريبة خاصة تجاه النقاد. وفي مقالته "الكتابة للمسرح" يلاحظ أنّ الفارق بين "حفلة عيد الملاد" التي استمرت أسبوعا و"البوّاب" (4) التي عُرضت طويلاً هو أنه استخدم النقطة في الثانية وخطّ الإعتراض في الأولى، للإشارة إلى الوقفات وانقطاعات الحوار. وتابع بنتر أنّ النقاد لم تخدعهم حقيقة أنّ المرء في الحالتين لا يسمع النقطة ولا خطّ الاعتراض، وسرعان ما التقطوا الفارق. والحقّ أنّ بنتر يلجأ إلى الهزل لإيضاح موقفه، بالرغم من نيّته الجادة في تبيان عدم اكتراثه بالنقد. الحقيقة الأكثر أهمية هي أنّ النقاد كانوا بالفعل قد أصغوا إلى تلك الوقفات. كانوا يصغون إلى الفراغات القائمة بين الكلمات، بصرف النظر عما إذا كان بنتر هو الذي وضعها. وكما يتوجب على الفنان أن يصدر مجموعة أحكام نقدية حساسة، كذلك يتوجب على الناقد أن يدوزن نفسه مع نوع القرارات التي اتخذها الفنان بالفعل. ويمضي بنتر في شرح السيرورة الإبداعية كما عاشها:
"أنت ترتب وأنت تصغي، مقتفياً ما استجمعته من دلائل، عبر الشخصيات. ويحدث أحياناً أن يتمّ العثور على توازن ما، حيث الصورة يمكن أن تستولد الصورة بحرّية، وحيث تصبح في الآن ذاته قادراً على إمعان النظر في الموقع ذاته الذي فيه تصمت الشخصيات وتختبئ. وهي عندي تصبح الأشدّ جلاء في غمرة ذلك الصمت بالذات".(5)
ومن واجب ناقدي بنتر أن يعيدوا تركيز انتباههم على ما يفعله بنتر وليس على ما لا يفعله. يجب أن يتطلعوا إلى ما هو وراء لغته لاكتشاف ما يتمّ قوله حقاً.
* * *
لاحظ محلل نفساني بريطاني أنه "توجد في سفر عاموس نبوءة بأنّ زماناً سيأتي حيث يصيب الأرض جوع، 'ليس الجوع إلى الخبز ولا العطش إلى الماء، بل إلى استماع كلمة الرب'، وهذا الزمان أتى الآن، وهو عصرنا الراهن".(6) لعلّ هذه ساعة جوع للإستماع. وطراز الإستماع الضروري لمعايشة تامة لمسرح بنتر ليس مسألة بسيطة، لأنّ لغة بنتر ليست بلاغة الإخراج بل بلاغة التواشج. في وسع كلمة واحدة، تماماً مثل حصاة تُلقى في بركة، أن ترسل عدداً لامحدوداً من الحلقات. والكلمة الواحدة لا تقود إلى أخرى فحسب، بل يحدث أيضاً أنها غالباً تحرّك ركود تجربة منسية عن العذاب أو المتعة. ولكنّ الحصيلة ليست المزيد من اللغة بل المزيد من الصمت. هذا هو الصمت الذي ينطق رغم أنه، كما يصفه ماكليش في "فنّ الشعر":
بلا كلمات
مثل تحليق الطير.
كذلك رأينا أنّ سيرورة بنتر الإيصالية لا تتضمن بلاغة الإخراج بقدر بلاغة الملمح الصامت. وفي عام 1968 أثناء برنامج خاص حول الممثل على قناة CBS، عاد بنتر بالذاكرة إلى عهد كان فيه عضواً في فرقة السير دونالد ولفيتس. وبعد أن عارض ا لأسلوب المتكلّف لتلك الفرقة، شرح بنتر استراتيجيته الخاصة من أجل "استغلال البرهة الدرامية. هنالك لحظات تكون فيها الحركات دقيقة وبالغة التفاهة من حيث المظهر ـ كما حين تحرّك كأساً من هنا إلى هناك. هذه برهة كبيرة. إنها في قلب حالات الصمت حين يتوقف الناس عن الكلام مع بعضهم البعض، ثمّ يعاودون الكلام". ورغم أنّ وسائله قد تختلف، فإنّ اتجاه بنتر في "استغلال البرهة الدرامية" يضعه في قلب التراث الدرامي الغربي، وضمن فكرة المسرح كلّها في ذاتها.
ومحاولة استرجاع شعرية الصمت ليست حكراً على بنتر، إذ يسجّل نورمان أو. براون الاهتمام المبكر الذي أبداه أبولونيوس بـ "لوغوس" الصمت، مبدأه العقلي. وأن يسمع المرء "عقل" الصمت يعني امتلاك آذان تسمع ما يُترك حبيس ما لا يُقال. ثمّ يطالبنا أبوليونيوس، بعدئذ، أن "لا نعجب من أنّني أعرف كلّ اللغات ما دمتُ أعرف ما لا يقوله البشر".(7) ولا بدّ لتاريخ تثمين الصمت الأحدث عهداً أن يضع في الحسبان هذا التأكيد من ريلكه:
الصمت. مَن يلتزم الصمت بحماس متقد
هو الذي يلمس جذور الكلام.
والمرء كذلك يفكر في الحركة التي دشنها جان ـ جاك برنارخلال العشرينيات، ودعت إلى "مسرح صمت" للإفصاح عن تلك المشاعر التي لا يمكن أن تحملها اللغة. وفي "المسرح ومُضاعَفه" يساجل أنتونين أرتو من اجل لغة صامتة للملمح، معتقداً بوجود "شعر حواسّ مثل وجود شعر لغة، وأنّ هذه اللغة المحسوسة التي أشير إليها هي المسرحية بالفعل، إلى درجة أنّ الفكر الذي تعبّر عنه يقع خارج نطاق اللغة المنطوقة". لكنّ بنتر يشتغل دون فنّ تأليف مسرحي (دراماتورجيا) مكرّس للصمت عن سابق وعي. وتراثه لا ينتمي كثيراً إلى تراث ستانيسلافسكي و"النصّ الثانوي" بوصفه سوابق الصمت في مسرح الـ"كابوكي" والإيماء. أنساق الصمت في مسرحياته ليست مبرمجة، بل هي درامية. الفارق هنا هو بين النظرية والتطبيق، وبين فلسفة التجربة والتكنيك المُصاغ في أتون التجربة.
ولقد ساجل سارتر وآخرون بأنّ فنان العصر ينبغي أن يكون "ملتزماً"، بحيث يُطلب منه هذا او ذاك من أشكال الإلتزام. غير أنّ العنف الاجتماعي، ذاته، يتوجب في أزمنتنا أن يُقتلع من نفسية البشر الأفراد. وطبيعة "الإلتزام" عند بنتر، إذا تعيّن على المرء استخدام المصطلح، هو البحث في الداخل وليس البرمجة في الخارج. وكان ييتس قد تساءل، بحكمة، عن السبب الذي يجعلنا نوزّع الأوسمة على الجنود حين يخوض الفنان معركة داخل نفسه أشدّ شجاعة وأشدّ عزلة. وشجاعة بنتر الخاصة تكمن في محاولته أن يقول ما يلوح أنه أبعد من القول.
الفعل الإبداعي لم يكن يسيراً في أيّ وقت، ولعلّه بات أكثر صعوبة في عصر تعاني فيه لغتنا ونفوسنا من غثيان الموت. وبنتر يصف بدقة كيف أنّ غثيان الموت هو حصة الفنان الذي تكون اللغة موهبته.
ولديّ شعور آخر قويّ بخصوص الكلمات التي ترقى إلى صعيد ليس أقلّ من الموت. مثل ذلك الثقل للكلمات يواجهنا يوماً ويغيب عنّا في يوم آخر: كلمات تُقال في سياق هذا التغاير، وكلمات أكتبها أنا أو الآخرون، حصيلتها ليست سوى اصطلاحات بالية ميتة، وأفكار تتكرر وتتبدل بلا توقف حتى تصبح مبتذلة رخيصة بلا معنى. وهكذا، من السهل أن تطغى حال الغثيان هذه فيتراجع المرء وينتهي إلى الشلل. وأتخيل أنّ معظم الكتّاب عرفوا شيئاً من نوع الشلل هذا. ولكن إذا كان من الممكن مجابهة الغثيان، والمضيّ معه إلى خواتيمه، والتنقّل منه وإليه، فإنّ من الممكن القول إنّ شيئاً قد وقع، أو حتى إنّ شيئاً تمّ إنجازه.(8)
ومواجهة هذا الغثيان هو المشكلة الحاسمة في هذا العصر. فالفنان لا يستطيع علاح عظامنا الرميم أو يصلح نسيج حياتنا الخَلِق، ولكن قد يكون في مقدوره أن يجعلنا نظلّ بشراً في غمرة ذلك الصمت الذي يكتنف فضاءاتنا اللانهائية. عندها، فقط، تقترب الحياة من الكتابة التي اسماها بنتر "طراز احتفاء".(9)
ـ فصل من كتاب:
James R. Hollis, Harold Pinter : The Poetics of Silence. Southern Illinois University Press, 1970, pp. 122-136.
يُنشر الملفّ بالاتفاق مع فصلية "الكرمل" الفلسطينية، العدد 86، شتاء 2006.