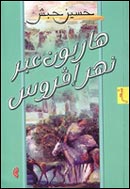 أصبحت قصيدة النثر أكثر استجابة للمشاعر، وأكثر استجابة لطرح الأسئلة والحقائق، في عصر باتت العدالة فيها شريدة وعمياء. حيث الموت يتناسخ ويتكاثر عبر مسالك متنوعة، وما على الشاعر إلا أن يدافع عن الخسارة، لأنَّ القصيدة مقيمة في المجهول ـ لا في اللغة ـ القصيدة ـ تستقصي وجودها، لترقى بمقامها إلى مقاصد الألم.
أصبحت قصيدة النثر أكثر استجابة للمشاعر، وأكثر استجابة لطرح الأسئلة والحقائق، في عصر باتت العدالة فيها شريدة وعمياء. حيث الموت يتناسخ ويتكاثر عبر مسالك متنوعة، وما على الشاعر إلا أن يدافع عن الخسارة، لأنَّ القصيدة مقيمة في المجهول ـ لا في اللغة ـ القصيدة ـ تستقصي وجودها، لترقى بمقامها إلى مقاصد الألم.
ففي الماضي القريب كانت الثورات تواكب تحررها وتجددها على صعيدي الوطن والقصيدة. فتحررت الأوطان، ولم يبقى هناك انقطاع عن الوجود الفعلي فيه، مما جعل للهوية وجوداً مستقراً. زاحم هذا الاستقرار شهوة الحرية والتجدد من جهة القصيدة. فالشعراء أعادوا دورة الزمن، بالحفر في أساس القصيدة الجديدة، للخروج من عتمة القصيدة التقليدية إلى نهار الحياة والتجديد. وأولى هذه الخطوات ـ بالنسبة لسوريا ـ كانت من خلال الشعراء علي الناصر، وأورخان ميسر. ثم أوصلها إلى شكلها الأخير الشاعر محمد الماغوط. لكن قصيدة النثر في سوريا، لم تبق عند تجربة الماغوط، فمنذ أواخر الستينات، وأوائل السبعينات، بدأت هذه القصيدة أكثر تألقاً من خلال الشاعر الكردي سليم بركات، الذي أوصلها إلى مصاف الأناشيد الخالدة.
وطالما الشعر الحديث مرتبط بالألم، بالفقد، بالخسارة، بالوطن، بالحرية، بالمرأة، بالظلم، وخاصةً في أمةٍ أغلب مبدعيها داخل السجون، أو خارج الأوطان. فمن نجا من السجن ومن المنفى، فإنه لن ينجو من القدر. هذا ما حصل للشاعر رياض الصالح الحسين، الأصم والأخرس، الذي توفي في إحدى المشافي السورية، بسبب خراب في دورته الدموية في الثمانينات، تاركاً ورائه أربعة مجاميع شعرية لا تقل إبداعاً عن تجربة أي شاعر كبير في العالم.
بالطبع هناك أسماء أخرى ساهمت في مسيرة هذه القصيدة، وربما أدونيس الشاعر والمنظِّر، كان وما زال أهم صوت في العالم العربي، عند الكلام عن قصيدة النثر. لكن في زحمة الشعراء، نتمسك بأكثر الشعراء تأثيراً وإبداعاً. فعندما نقول لبنان، نتذكر مباشرة أنسي الحاج، وهذا لا يعني إلغاء لشوقي أبي شقرا، أو إلغاء لشاعر مبدع كعباس بيضون. وعندما نقول العراق نتذكر سعدي يوسف. وعندما نقول البحرين، نتذكر قاسم حداد. وعندما نقول الأردن نتذكر أمجد ناصر. والحال هكذا في جميع الأقطار.
وكأن القصيدة التي ستكتب ستكون تابعة لمدرسة شعرية بعينها، أو لتجربة شعرية صارت معروفة وراسخة. ورغم ذلك نقرأ قصيدة متألقة هنا، وديواناً شعرياً متألقاً هناك.. فالحياة صعبة والقصيدة صارت أصعب، في زمن يسود فيه الموت و"الحروب" على الأجساد والأرواح. فمن أجل الأوطان سال دم كثير، ومن أجل القصيدة سال حبر كثير. والرحلة دائماً في بدايتها، وكأنها صخرة سيزيف. فمرحلة الثائر/ المقاوم ما زالت إلى الأرض/ الوطن، ورحلة الشاعر ما زالت إلى المعاني. إنه واقع حائر، يدير الصمت باحتمالاته المتواشجة، وما القصيدة سوى محاولات أولى لفهم الكون الجديد.
حيث في الماضي القريب، كانت القصيدة الكلاسيكية قد رأت أعناق الثوار في المشانق، إبان الحكم العثماني لسوريا، كما رأت ـ فيما بعد ـ أعناق وأجساد الثوار معلقة ومرمية في المعتقلات والشوارع، إبان الاحتلال الفرنسي.. في الاحتلالين كانت صوت القصيدة الكلاسيكية مواكبة للثورة وللثوار.
أمام هذا التراكم الشعري الفعال، ظهرت في مدينة حلب، في الثلاثينيات، الشرارة الأولى لقصيدة النثر، لشاعرها خير الدين الأسدي، وخاصة في قصيدته التي تقول: "من نهر النار، شربت النور". حيث استطاع هذا الشاعر مع صديقيه الشاعرين أورخان ميسر وعلي ناصر، وضع حجر الأساس لمشروع قصيدة مغايرة.. وظلت مدينة حلب مصدر مفاجآت للحداثة الشعرية منذ الثلاثينيات وحتى الآن.
ففي التسعينات تحديداً، عادت هذه القصيدة إلى الصدارة، عندما تبنى الناقد محمد جمال باروت مشروع إحياء قصيدة النثر، حيث استطاع وبجدارة خلق جو إبداعي من خلال جماعة طلاب جامعة حلب. وبرز في تلك الفترة مجموعة من الشعراء منهم حسين درويش، محمد فؤاد، حسين بن حمزة، صالح دياب، عبد اللطيف خطاب، مها بكر، عمر قدور، وحسين حبش.. وبشكل تدريجي بدأ باروت ينسحب من النضال الذي بذله لصالح قصيدة النثر، والذي أكده بكتابه النقدي "الشعر يكتب اسمه"، ليتواصل مع مشاريع فكرية بعيدة عن الشعر وبراءته وأحلامه.
وبسبب التواصل مع تلك الفترة ـ التسعينات ـ سأحاول تقديم شاعر لم يستطع طباعة شعره حينذاك، رغم أنه لم ينقطع عن الكتابة يوماً واحداً، وهو الشاعر حسين حبش، الذي صدرت مجموعته الثانية "هاربون عبر نهر إفروس" حديثاً، والمسبوقة بـ "غرق في الورد" عام 2002.
ولد الشاعر حسين حبش في قرية "شيخ الحديد" التابعة لمحافظة حلب، من أبوين كرديين، وهي نفس القرية التي ولد فيها الشاعر الكردي الراحل حامد بدر خان، صاحب المجموعة الشعرية المتميزة "على دروب آسيا". وطالما التاريخ لا يتواصل إلا على أجساد ضحاياه، فالتاريخ السوري بدأ بحلب، واستمر هذا التاريخ النضالي حتى نالت سوريا استقلالها في عام 1946 ، بعد أن سلخ منها لواء اسكندرون، وضمته تركيا رسمياً إليها. هذه الفنتازيا بأعمالها المعقولة واللامعقولة تجعل القصيدة محتجة عبر مسيرتها المتواصلة. فاللغة الشعرية حينذاك كانت هي لغة "نحن"، بما تحمله الكلمة من شعارات ثورية، هذه اللغة التي انقرضت تماماً في شعر التسعينات، بل تحولت اللغة الشعرية من "نحن" إلى "أنا" كما انمحى الخارج لمصلحة الداخل، لتتحول الشعارات إلى جمالية الكلمة.. لكن مع الشاعر المبدع حسين حبش، يتواصل القديم مع الحديث، التقليد مع التجديد، الهم الذاتي مع الهم القومي، وخاصة في قصيدته "فجيعة النزول من جبل آغري"، الجبل الأشم الذي ما زال شاهداً على الثورات الكردية، بدءاً من ثورة بدر خان باشا في عام 1812، الذي أعلن استقلال إمارة بوتان عن الدولة العثمانية، ومروراً بثورة الجنرال إحسان نوري باشا، الذي أبقى علم كردستان يرفرف فوق الجبل ـ جبل آغري ـ من عام 1927 إلى عام 1930. وربما أفضل من كتب من كتب عن هذا الجبل هو الروائي التركي ـ الكردي الأصل، ياشار كمال، في روايته "إنتفاضة جبل آغري" التي تؤكد أن كردستان المتدفقة بالخيرات، لم تتدفق إلا بالموت للكردي منذ الدولة العثمانية، وحتى الدولة التركية الحالية.. فحسين حبش المراقب للثورات في كردستان يرى عبر تراكم التاريخ، نزول هؤلاء الثوار إلى حفلات الإعدام الإجبارية:
أيها الحبل المعني حجراً حجراً
صخرة صخرة، عشبة عشبة
بهذا الألم العظيم.
الشيخ سعيد، حاجي آختي
سيد رضا، مظلوم دوغان،
والجنرال شريف باشا
المنتدب إلى مؤتمر الصلح
حاملاً مواثيق الكرد في جعبته الأليفة..
كلهم أوقدوا شموعاً فوق صدرك الجريح
وانطفأت أجسادهم
بزعاف الموت وأعواد المشانق.
في هذه الهاوية لم يبق للشعر وللإنسان سوى نور أعمى، عاجز أن يريه أمجاد أجداده، ومكان هارب من الموت. أمام هذه الحقائق، ماذا بإمكان الشعر أن يفعله؟ أن ينتهك الحدود بين الماضي والحاضر؟ بين الموت والحياة؟ أم يبقى سفراً في الذات عبر حقائق التاريخ المتراكم؟ إنها أسئلة فقط، تجاري إخفاق الحقيقة في إعادة الحرية المغمى عليها هنا وهناك سواء في ساحة القصيدة، أو في أرض الوطن/ كردستان. ففي السابق، كانت القصيدة تعود مع الثوار من القتال منتصرة أو مهزومة.. وكان الشاعر في مشروعه الإنساني ضد كل أعداء الإنسانية، متجاوزاً قوميته، لتزهر الإنسانية جمعاء بأشجار الحرية التي زرعتها قصائد لوركا، وبابلو نيرودا، وناظم حكمت...
إن مجموعة "هاربون عبر نهر إفروس" للشاعر حسين حبش، تتميز بتجذرها بالذات المرتبطة ببعدها الإنساني، مع إزاحة الستار قليلاً على الحيز السياسي من خلال فضاء من الحلم، تساعد القصيدة لانتهاك مسافة استثنائية لبناء الواقع الغرائبي الجديد.
أصابنا الصدأ
ولم ندرك بعد بأننا تعطلنا في منصف العمر،
وبأننا انحدرنا إلى الغياب وأرواحنا تواطأت
مع الخواء والفراغ.
بهذا الوضوح، بهذه الحقيقة الجارحة، تمضي القصيدة إلى لعبة جديدة، يحوز فيها الشاعر ماضيه المعبأ بذكريات مسقط رأسه ومنزل طفولته، من خلال تصالحه مع الألم. وبذلك تكون القصيدة إقامة في الغياب، وسفراً في الذات عبر العائلة، كما في قصيدة "في مديح أبي":
ما زال أبي بسرواله الفضفاض
وقميصه المطرز من رائحة التراب
وجبهته الواسعة كحقل قمح،
ما زال ينظر بعينين
متلهفتين وعاشقتين
إلى أشجار الزيتون الخضراء
ويقيس المسافة بسكَّر الشوق
بين "شيخ الحديد" و "بون"
التي حفظ اسمها عن ظهر قلب.
تختزن هذه القصيدة المادة الأساسية الخاصة بسيرة الشاعر الشخصية، المرتبطة والمتواصلة بسيرة العائلة، بلغة عفوية تساعد على تفريغ شحنة الشوق، وتسريبها عبر آلية الأمل، من خلال مكان بعيد خاضع لشروط الجغرافيا، فالمكان يقع في الماضي، والزمن نهر يخترق سدود الذاكرة. لهذا لا يتوقف حسين حبش عند قصيدة "في مديح أبي"، بل يتواصل مع "العائلة" من خلال قصيدة "تراتيل أمي"، وفيها يعكس رؤيته لأمه المنتظرة. تقول القصيدة:
في هذا الصباح، كانت أمي تجلس في البيت وحيدة
ترتِّق بنطال أخي محمود الممزَّق من شقاوة البارحة
انغرزت الإبرة في إصبعها، سال الدم حاراً على الخيط، تلطخ البنطال
وتشوَّشت أفكار أمي.
أقسمت لأبي ولكل الجيران،
إنها رأتني أو رأت ظلي أو رأتني دون ظلي أمر أمامها هذا الصباح
تبرير هذه المسافة الشاسعة بين "شيخ الحديد" السورية، ومدينة "بون" الألمانية، هي محض حقيقة تراه قلب الأم بكل تأكيد.. وقصيدة "تراتيل أمي" بأجزائها الثلاث: ترتيل الرؤية، ترتيل الشوق، ترتيل الشغف، ما هي إلا محاولة لاسترداد الجميل من الحياة، حتى ولو بالذكريات:
الرقيمات المرسومة على جدران بيتنا الطيني،
الكحل الأصفر للباب،
صورة العائلة المعلقة باعتناء قرب صورة للإمام علي،
بقايا الوشم على صاج الخبز الحديدي،
الحجر الكبير الهادئ أمام الباب والمتأهب دائماً لاستقبال الضيوف،
الرفوف الضاجة بالجرائد القديمة،
المصباح الذي يتفلسف كثيراً بلسان ضوئي طويل،
السجادة المعلقة دائماً للصلاة،
الضحكة المقدسة التي أدَّت كل هذا الشغف، وكل هذا التعب،
هي ضحكة أمي.
الشاعر حسين حبش أسير ماضيه، يتمسك به ليعيد إلى حاضره بعض الحياة.. طالما المنفى حزنٌ وألمٌ وموتٌ بطيء.. والقصيدة استجابة لهذه المرايا التي تعكس هامش هذا الوجود، وخدعة لترميم الواقع الغارق في الظلام والرعب، رغم مشاعل الدم، ومشاعل الحبر.
هامش: هاربون عبر نهر إفروس ـ سنابل للنشر والتوزيع
جمهورية مصر العربية عام 2004