الإهداء
إلى والديّ
***
شكر وتقدير
إلى الأستاذ الفاضل الدكتور إبراهيم السعافين الأب، الإنسان، الدي أطلّ على أوجاع الروح، فربّت عليها، وأشرف على طاقات الدّرس، فنبّه وشجّع.
الشكر للمشرفيْن الكريميْن عضويّ لجنة المناقشة:
الأستاذ الدكتور: هاشم ياغي
والدكتور: سمير قطامي
لتفضلهما بمناقشة هذا البحث.
والشّكر قبل ذلك وبعده، لكلّ من آمن بأن لديّ ما أقوله.
***
الملخص بالعربية
أنسي الحاج وقصيدة النثر
إعداد : رانه مصطفى نزّال
إشراف: الأستاذ الدكتور: إبراهيم السعافين
أثارت قصيدة النثر في الأدب العربي الحديث، منذ الإعلان عن وجودها، جدلاً واسعاً لدى المبدعين والدارسين والنقّاد، ومبعث هذا الجدل طبيعة شكلها الذي لا يلتفت إلى الأوزان التقليديّة المعروفة (البحور)، ولا إلى التفعلية التي قابلها الخصوم بشيء من التسامح، وربّما كان للسجال الفكري، بين الأنصار والخصوم، دورٌ كبير في إذكاء هذا الجدل، واتهام الذين تبنّوا هذه القصيدة مباشرة، أو خفية، بالقيام بأدوار مشبوهة تجاه تراث الأمة، وفكرها، وعقيدتها. وفي إطار الضجيج الزّاعق توارت الدراسة العلميّة الموضوعية لطبيعة هذه القصيدة التي يطمح أصحابها أن تكون جنساً أدبيّاً قائماً برأسه، مثلما تراجعت إلى زوايا الإهمال، الدّراسة الموضوعيّة للبذور الأولى لنشأتها، وطبيعة تطوّرها، منذ البدايات شبه الناضجة، على أيدي الروّاد إلى أشكال تطوّرها على أيدي أجيال لاحقة، أو محاولة الوقوف عند ملامح نضجها، وعناصر الفوضى التي تجعل المفهوم ملتبساً، والجنس مضطرباً. وليس أجدى على دراسة هذا الجنس: قصيدة النثر، من التصدّي لدراسة رائد هذه القصيدة: أُنسي الحاج.
وقد توسّلت الدراسة بالمنهج التأريخي في تتبّع نشأة قصيدة النثر، والمنهج التحليلي النقدي في دراسة نتاج الشّاعر أُنسي الحاج الذي يمثّل صوتاً خاصاً في مسيرة الشعر العربي الحديث، والذي أعلن ولادة هذا الجنس الأدبي في مقدّمة ديوانه الأول: "لن".
وتوصّلت الدراسة إلى أن الشّاعر أُنسي الحاج، قد جعل قصيدة النثر قضيته الخاصة التي أعمل فيها أدواته، وتحدّيه، وقاموسه، وصوره، وتراكيبه، ففتح بذلك، آفاقاً واسعة من المغامرة التي اقترنت لديه بالحريّة... حريّة الإنطلاق بالشعر العربي إلى فضاءات دلاليّة، ولغويّة جديدة، وعدم الارتهان للشكل الشعري المبني على بحور الخليل، والتفعيلة.
***
طفولته وحياته
أُنسي لويس الحاج، شاعر لبناني. من مواليد قرية قيتوله قضاء جزين في جنوب لبنان. ولد عام 1937م. حصّل دراسته الإبتدائية والثانوية في بيروت. في الليسيه الفرنسية أولاً ثم في مدرسة الحكمة. احترف الصحافة منذ عام 1956م حيث عمل في جريدة الحياة ، لكنه انتقل، في العام نفسه، إلى جريدة النهار حيث يشغل منصب رئاسة تحريرها في الوقت الحاضر. أسس القسم الثقافي في جريدة النهار، ثم الملحق الأسبوعي الذي استمر في الصدور من عام 1946م حتى عام 1974م. ويتولى حالياً مسؤولية الصفحات الثقافية في مجلة "النهار العربي الدولي" .
ساهم عام 1958م في تأسيس مجلة شعر . له الدواوين التالية: "لن" ، "الرأس المقطوع" ، "ماضي الأيام الآتية" ، "ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة" ، "الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع" ، "خواتم" ، "الوليمة" ، كما جمع مادته الصحفية في كتاب "كلمات.. كلمات.. كلمات" بأجزائه الثلاثة.
يقول أُنسي الحاج عن طفولته: "لا أذكر طفولتي تماماً. أنا في نسيان إرادي، بعد موت أمي، قرّرت أن أتعامل مع الواقع على أساس تجاهله". عام 1945م ولمّا يتجاوز السابعة من عمره مُني أُنسي الحاج بفقد أمه، فطلع نهار دفنها على شجرة تين وطفق يضحك. وظلّ وجدانه يضج بالفقد، وأعماقه عامرة بالغياب، غياب الأم التي ستظل سرّاً غامضاً وقدسيّة مُطهّرة حاول الاستعاضة عنها برفقة ابن خالته الذي كان يلعب وإياه في البساتين، ويهرب معه من المدرسة، ليذهبا إلى البحر، والذي سرعان ما التهمه الموت أيضاً، وهذه المرة كان الداء داء السرطان، فشهد معه أنسي الألم الشرس الذي أحاله من شخص قوي يملأ دنياه إلى آخر ضعيف لا حول له ولا طول، ولمّا مات أعلن أنسي فجيعته، وأطلق على العصر اسم: "زمن السرطان" .
في طفولته، قلّت مطالعاته الأدبية، وكان أكثر ما يقرأ قصص المغامرات التاريخية، والروايات البوليسيّة و"ما ليس له علاقة بالتغذية الأدبية الرسمية" على حد قوله، فطالع أول ما طالع جرجي زيدان، وتوفيق يوسف عواد، وإلياس أبو شبكة، وفؤاد سليمان، وفي صباه كان له موقف من قراءة جبران خليل جبران يقول: "بعكس كلّ أولاد جيلي، كنتُ كلّما هممتُ بقراءته يعروني اكتئاب شديد، كنتُ أنفر من تكراراته، ولهجته الواعظة". .
وقد أفادته اللغة الفرنسية، التي يتقن، في الإطلاع على الأدب الفرنسي، وبخاصة الشعر؛ منه فقرأ كلاً من بودلير ورامبو اللذين ظلّ وفيّاً لهما، ومعجباً بهما. أما بداياته الأدبية فقد كانت في منتصف الخمسينيات، حيث نشر في كلّ من "الحكمة" و"الأديب" قصصاً قصيرة. ثم انخرط في تجربة مجلة شعر التي بدأ فيها ناقداً ومترجماً بنشره قصائد أندريه بريتون وتعريفه به . ثم تجاسر فنشر قصائده الأولى التي أعلنت عنها المجلة يقولها: "لأنسي الحاج نتاج شعري جديد" سرعان ما ضمنه ديوانه "لن" بمقدّمته التنظيرية عن قصيدة النثر، مستفيداً في مقولاته النقدية عنها من كتاب سوزان بيرنار ، وقد أثارت هذه المقدمة ضجّة انقسم فيها النقّاد والقرّاء بين مؤيد ومعارض لقصيدة النثر كجنسٍ أدبي.
يصدر أُنسي الحاج عن حس عميق بالخيبة التي يقاومها "بتصريف الإحتقان الخانق بالشعر الذي يحرّره، وهو هنا يشبه الدادئيين الأول" ، الأمر الذي يؤكد تأثره بمقولات السريالية وأخذه عنها وبخاصة فيما يتعلّق باعتماده الصورة الشعرية التي تتعمّد صدم الحواس واستخدام اللغة الفنية بتنافرها الصوري، والبصري واللفظي وأسلوب الكتابة الحرّة الآلية الذي يقوم على التداعي والاستقاء من آراء عالم النفس "فرويد" وبخاصة فكرة اللاشعور، ورفض سيطرة العقل على الحواس والعواطف، والإعتراف بأن التناقض أصيل في الذات الإنسانية، وأن الإمعان في الغوص فيه مفضٍ إلى حالة من التصافي التي تتصالح فيها المتناقضات "إذ ثمة نقطة، إذا بلغها الفكر، بطل التناقض" ، والسريالية التي ترى في الحبّ –كحالة شعورية- خلاصاً من واقع طاحن المرأة فيه هي الوسيلة، وتنظر إلى العالم بعيون الطفل الذي يحسّ الأشياء ولا يعيها وتعتمد الضحك الأسود في سخريتها من الواقع والعالم. هذه المبادئ السريالية انسجمت وتناغمت مع دواخل أنسي الحاج المحتقنة والضالة التي تدفعه ليقول: "كأننا ونحن في هذا العالم، لسنا منه، كأننا لسنا من أحد، ولا ملاذ لنا".
وفي مقالاته الصحفيّة التي نشر –وينشر- يرفض أنسي الحاج السياسة التي تُمارس على أرض الواقع، والتي تتحكّم بمصائر الشعوب، وينظر إليها على اعتبار أن السياسة الحقّة بمفهوم المسؤولية ما هي إلاّ الجهد المبذول من قبل الساسة، الذي يسعى إلى تحسين واقع الناس ويحقّق
آمالهم بعيش كريم، وحياة رغيدة، لذا ينبرى في مقالاته لخوض معركة ضد السياسة بشكلها الواقعي المُعاش، واضعاً يده على مواطن الضعف والخلل، يقول في أعقاب الخامس من حزيران عام 1967م: "الحقيقة أن سياسة الدولة اللبنانية مبنيّة على فلسفة الضعف، والاستكانة من جهة، وعلى اللفظة الخطابية، الرتيبة، والكاذبة، من جهة أخرى، مبنيّة على الجبن" ، كما لا يتوانى عن كشف الخديعة في السياسة الدولية التي تتعامل مع قضية الشرق الأوسط بمعيارين الأمر الذي يعالجه بقوله: "اليوم يناقش مجلس الأمن قضية فلسطين، ولبنان يتحوّل إلى فلسطين ثانية، هل كانت كل هذه المحنة لكي تستعاد فلسطين، ويضيع لبنان؟ أم ليضيع الإثنان وتنتصر إسرائيل وحدها؟".
وفي مقابل خيبته من الواقع السياسيّ نتلمّس إيمانه بالفرد وإنسانيّته يقول: "إذا كنا متخلّفين بالصواريخ، فلدينا الإنسان".
هذا الفهم للواقع الذي يمكّنه من تشكيل رؤية لا تخدع نفسها، ولا تنحاز إلى الأماني في مقابل الحقيقة، وإن كانت جارحة "فهو الجرح العميق الملؤه القهر والغضب" ، الذي به تتحوّل المرارة إلى فعل مواجهة ومجابهة، من أجل معالجة الواقع بأبعاده السياسية والاجتماعية، وهذه الأخيرة عند أنسي هي الأساس الذي تضمن معالجته إحداث التغيير في البنية السياسية والاقتصادية في المجتمع، ومقالاته فيما يتعلّق بالحرية كمفهوم إنساني دليل على رؤية تؤمن بضرورة التغيير الاجتماعي، وترى قطبيّ هذه العملية –الذكر والأنثى- في صراعهما مسؤولين عن تحقيق أفق إنسانيّ ينسجم وطبيعة العصر والتحدّيات التي تعرض لهما فيه. وما سؤال أُنسي: "هل يا تُرى يقوم العرب من قبر الماضي؟ أم يتألف المستقبل على أنقاضهم؟ والمثقفون العرب الذين بدأوا يدركون أن السؤال لم يعد هل نبدأ؟ بل كيف؟" ؛ إلاّ وعيٌ على خطـورة المـرحلة،
وضرورة التغيير، وبسبب من هذا الوعي تعرّض أنسي الحاج لأكثر من محاولة اغتيال أثناء محاضرات كان يلقيها منافحاً عن الحرية، وحاضاً على تحقيقها. وهي حرية تذكّر واستحضار –إن جازت التسمية- للماضي الحضاري للأمة دون تبعيّة مستلبة للآخر، حرية تؤكد هويتها وتثبتها معاً. يقول: "العلّة في الداخل، داخل الروح العربي، داخل التراث والفكر، وما لم تعالجها بالثورة عليها فسنظل مهزومين." وما حديثه هذا إلاّ رفض لعصور التكلّس والانحطاط التي استكانت فيها الأمة، وجمّدت تراثها ورضت بالخمول في مقابل الفعل والتغيير.
الشعرية، وقصيدة النثر
ظلّ الخلاف قائماً بين اللغويين والنقّاد حول مفهوم الشعر، وتمييزه عن النثر. ولا يزال هذا الخلاف عثرةً –حتى أيامنا هذه- أمام كل من يُعنى بدراسة الأدب والشعر وسائر الفنون الكتابية.
وفي محاولة للتوصّل إلى رأي يوفّق بين آراء النقّاد –قديمهم وحديثهم- خصّصنا هذا الفصل لعرض بعض الأقوال والتعريفات حول مفهوم الشعريّة والشعر للتحقّق من وجود منطقة تتوسّط الشّعر والنثر، مما يؤكد وجود قصيدة النثر ويعزّز مفهومها.
فما الشعر؟ وكيف يفترق عن النثر؟
وما هي قصيدة النثر؟
أ. الشعر والنثر
لم نلحظ أي خلاف في عصر الجاهليّة حول معنى الشّعر، فقد كان العلم الذي أجمعوا عليه، غاية كلّ عربيّ لما حظي به الشعراء من مكانة بين قبائلهم. فكان أوّل خلاف ملحوظ بظهور الإسلام وبدء نزول القرآن، حين وقف العرب ذاهلين أمام آياته، فانقسموا بين قابلٍ لكونه شعراً ورافضٍ لهذه التسمية.
وكلمة "شعر" في كلام العرب من الفعل الثلاثي: شَعَر، فقولنا:
"شعر به: علم به، وفطن له، وعقله".
وليت شعري ملائماً وله وعنه وأصنع: أي ليتني أشعر. والشعور إدراك من غير ارتباك فكأنه إدراكٌ متزلزل وتارةً يعبّر عن اللّمس، ومنه استعمل المشاعر، ولما كان حسّ اللّمس أعم من حسّ السّمع والبصر، قيل فلان لا يشعر وشعرتُ (بفتح العين): علمتُ.
وشَعُرتُ (بضم العين): صرتُ شاعراً.
ويعرّف قدامة بن جعفر الشعر بأنّه: "قولٌ موزونٌ مقفّى يدلّ على معنى، وقولنا (موزون) يفصله ممّا ليس بموزون، إذ كان من القول موزون وغير موزون، وقولنا مقفّى فصل بين ماله من الكلام الموزون قوافٍ وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع، وقولنا (يدلْ على معنى) يفصل ما جرى من القول على قافيةٍ ووزن مع دلالة على معنى ممّا جرى على ذلك من غير دلالة على معنى".
ويتضح في هذا التعريف اشتراط الشعر بالوزن والقافية والدلالة على المعنى، ولا يمكن اعتبار هذه الشروط حدوداً كافية لتحقّق الشعر، لأنه لو سلّمنا بذلك دخل تحت هذا التعريف مئات الأراجيز التي قيلت في علوم اللّغة والمنطق والعلوم الأخرى، إذ نُظمت على أوزان الشعر والتزمت القافية ودلّت كذلك على معنى، وهي ليست من الشعر لأنها مخاطبات عقلية لا علاقة لها بالحسّ والشعور، وبذلك لا يكون هذا التعريف جامعاً ومانعاً ولا يمكن الاعتماد عليه. ويتفّق اللغويّون من أصحاب المعاجم على أن الشّعر "غلب على منظوم القول، لشرفه بالوزن والقافية" .
ومن ذلك نتحصّل أن القول فيه المنظوم وغير المنظوم، وكذلك في المنظوم ما هو موزون ومقفّى، وما هو غير موزون ومقفّى، وفي ذلك يقول ابن رشيق القيرواني معرّفاً الشاعر: "الشاعر سُمّي شاعراً لأنّه يشعر من معاني القول، وإصابة الوصف، بما لا يشعر به غيره، وإذا كان إنما يستحقّ اسم شاعر بما ذكرنا، فكلّ من كان خارجاً عن هذا الوصف فليس بشاعر، وإن أتى بكلام موزون مقفّى" .
فإذا اعتبرنا كل كلام موزون مقفّى هو شعر، فلا بدّ أن يكون قائله شاعراً، وبنقض هذه النتيجة نتوصّل أن من الكلام الموزون المقفّى ما لا ينتدرج تحت الشّعر.
وفي الحالات التوفيقيّة التي نجد مثلها عند الفارابي، فالقول إذا كان مؤلفا مما يحاكي الشيء، ولم يكن موزوناً بإيقاع فليس يعدُّ شعراً، ولكن يقال له قولٌ شعريّ، فإذا وزن وقسّم أجزاءً صار شعراً، وفي كلامه هذا إقرارٌ بالقول الشعريّ واعتراف بأن الشعر عند العرب متحصّل بروحه، وهي – أي هذه الرّوح- " دفعت حسّان بن ثابت ليقول عن ابنه الذي وصف طائراً لدغه: " ملتف ببردة حَبرة"، " قال ابني الشعر وربّ الكعبة" " .
ونخلص- مما سبق- إلى أن البلاغة العربية قد جعلت الوزن والقافية من شروط تحقّق الشعر، فلا يكون الشّعر إلاّ بهما، ولا يُقيماه وحدهما، إذ لا بدّ من اجتماع المعنى والخيال، مع اعترافٍ بوجود قولٍ منظوم، وآخر شعريّ.
وقد افتقر النقّد الأدبي إلى النظر في تجارب النقّاد العرب الكبار، وبخاصّة عبد القاهر الجرجاني، صاحب نظريّة النّظم التي يرى فيها أن :" الدّاء في هذا ليس بالهيّن، ولا هو باليسير، بحيث إذا رمت الجلاد فيه وجدت الإمكان فيه مع كلّ أحد مسعفاً، والسّعي منجماً، لأن المزايا التي تحتاج روحانّية، أنت لا تستطيع أن تنبّه السامع لها، وتحدث له علماً بها حتى يكون مهيئاً لإدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة لها، ويكون له ذوق وقريحة، يجد لها في نفسه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه، والفروق أن تعرض المزيّة على الجملة، ومن ذا تصفّح الكلام، وتدّبر الشعر فرّق بين موقع شيء منها وشيء" .
ويمكن تفهّم اشتراط الشعر بالوزن والقافية لارتباط الشعر بالغناء في تراثنا العربي، بل وفي تراث الأمم الأخرى. وفي ذلك يقول ابن رشيق القيرواني : " الغناء حلّة الشعر إن لم يلبسها طويت " ، والعروض العربي إنما قُنن على أساس سمعيّ رسّخته رواية الشعر، فروعيت فيه – من أجل حفظه وإنشاده – " المدد الزمنّية والإعداد المتساوقة في الحركات والسّكنات، والتي عبّر عنها لفظ الوزن أدقّ تعبير، ثم جاءت القوافي لتثبت النغم، وتؤكّد على الصّدى الخارجيّ مولّدة موسقةً متكررّة بثبات".
وقد حصل إلتباس بين مفهوميّ الإيقاع والنغم على اعتبار تقاربهما، فيؤكّد المخزومي ، أن للخليل بن أحمد الفراهيدي معرفة بالإيقاع والنغم، وتلك المعرفة أحدثت عنده علم العروض، بينما يقول الخليل – واضع علم العروض – في الجذر الثلاثيّ وَقَعَ : " وَقَعَ المطر، وَ وَقْع حوافر الدّابة يعني : ما يُسمع من وقْعه" ، مما يثبت أنّه لا وجود للفظة إيقاع عنده، ولعلّ قولة الفراهيدي حين سمع مدقّات القصّارين في البصرة: " لأضعنّ من هذا أصلاُ لم أسبق إليه" تؤكّد مما ذهبنا إليه من اقتران ِ مفهوم الإيقاع بالنغم عنده.
ونجد في النقد المعاصر بعض النقّاد يرفضون أوزان الفراهيدي كمعيار للشعر، يقول عبد العزيز المقالح: " نظام الخليل لا يصلح لوصف إيقاع القصيدة نفسها، ناهيك عن القصيدة الجديدة " ، ومحمد العيّاش ينظر إلى علم الأوزان الخليلية على أنه "أضرّ بعلم الإيقاع الشعري عند العرب" حيث دمج لفظة الإيقاع بلفظة النغم الذي هو "صوت لابث زماناً على حدّ ما من الحدّة والثقل محنون إليه بالطبع. والإيقاع: جماعة نقرات بها أزمنة محدودة المقادير لها أدوار متساوية الكمية" وفي هذا التعريف تشابه بين تعريف النغمة والإيقاع موسيقياً، وتعريف الوزن والإيقاع شعرياً فتردّد الظاهرة الصوتية على مسافات زمنية محدّدة النسب يشابه الكلام في الشعر الذي " يستغرق التلفّظ به مدداً من الزمن متساوية الكمية " ، وهذا الخلط بين المفهومين مسئول عن اشتراط الإيقاع في الشعر بالوزن والموسيقى الخارجيّة اللذين هما شكل من أشكال الإيقاع التي تبنى عن طريق تكرار التفعيلات بعدد متساوٍ في البيت الشعري، بحيث تتشابه في الأشطر تمام التشابه فقرّ في الوجدان العربي أن الشّعر ما قيس ببحره، مّما دفع القرطاجي إلى توزيع أغراض الشعر على بحور تحـاكي هذه الأغراض بما يناسـبها من الأوزان، "فإذا قصد الشـاعر الفخر حاكى
غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة " ، ولهذا غاب مفهوم الإيقاع الذي هو "أسبق من الوزن، فهو كالعين، والوزن كالبصر، ولّما كان البصر وظيفة العين. كان الوزن وظيفة الإيقاع" ، ولنعترف بأن الإيقاع من أكثر المفاهيم غموضاً إن قديماً وحديثاً أننا لا نجد تعريفاً واضحاً له فهو: "لفظة ملتبسة إلى حدّ ما" ، إلاّ أن النظر إلى الإيقاع على اعتبار أنه الوزن، فيه مغالطة تقود إلى مثل هذه الأحكام "الوزن أو الإيقاع المنتظم عنصر أساسي من عناصر الشعر لا غنى عنه، ومن المغالطة التعامل معه وكأنه قيد محض" ، وفي هذا الكلام قصر لمفهوم الإيقاع ضمن حدود المستوى الصـوتيّ المتحـقّق بالوزن.
وقد أخذت الدراسات الحديثة على عاتقها مسؤولية الكشف عن المستويات الإيقاعية الداخلية، فأكّدت كون الإيقاع "مجموعة أصوات تنشأ من المقاطع الصوتية للكلمات، بما فيها من حروف متحرّكة، وساكنة." ، وأنه "التواتر المتتابع بين حالتي الصوت والصمت، أو النور والظلام، أو الحركة والسكون، أو القوة والضعف، أو الضغط واللين، أو القصر والطول، أو الإسراع والإبطاء... فهو يمثّل العلاقة بين الجزء والجزء الآخـر، وبيـن الجزء وكلّ الأجـزاء الأخرى للأثـر الفنـي والأدبـي" .
وفي الدراسات النقدية الغربية نجد الإيقاع عند والت ويتمان "موج لبحر النص" ، وعند ريتشاردز" نسيج يتألف من التوقّعات والإشباع، أو خيبة الظن أو المفاجـآت التي يولّدها
السياق" الأمر الذي يؤكد أن "الإيقاعات لا تحصى ولا تقنّن، ولا تخضع لتصنيف" ، فالإيقاع "تلك الهندسة، والديناميكية الداخلة للكائن ، والتي تعطيه شكلاً، ومن ذلك نخلص بأن الإيقاع نتاجٌ غير مقصود ومؤشرْ دلاليّ على جوّ النص، فالفارق بين الشعر والنثر مردّه الأصيل – في ضوء ما سبق- إلى "طريقة استعمال اللغة" لا الوزن، إذ شعريّة النصّ مولّدة من صراع يختزل في أقصى مداه بين ذات المبدع ومحيطه لينعكس في جدليّة بين هذه الذات والواقع تتمخّض عن أشكال إبداعيّة، وأنماط كتابيّة تولّد بنيتها وإيقاعها الفريدين والخاصين معاً.
وإذ نسأل مجدداً ما الشعريّة؟ نقول : "إنها الخرق المنظّم لشفرة اللّغة، لتتمثّل فكرة الإنحراف التي تنقض النظرية الشعرية المتوكئة على المجازات الكلاسيكية" ، فعمليات "اللغة تتمثّل في التداخل بين المحورين التركيبي الذي تقوم عليه علاقات التجاوز، وبالتالي تلك العمليات ذات الطابع التأليفي، والمحور الثاني الاستبدالي، والذي عليه تنمو العمليات ذات الأساس التشبيهي، وهي المكوّنة لجميع التنظيمات الاختياريّة. وصياغة أية رسالة إنما تتكئ عليه لعبة هذين المحورين، وبخاصة الوظيفة الشعريّة" .
فهل ينظر إلى اللّغة الشعرية على اعتبار أنها اللغة المجازية في ضوء ما سبق؟
يقرر تودوروف أنّ اللّغة المجازيّة تُحقّق ما يُطلق عليه الخطاب الأجوف الذي يجذب الانتباه إلى الرسالة في حدّ ذاتها، بينما تُحضر لنا اللّغة الشعرية الأشياء نفسها. ويقرّب تصوره هذا بتحويره لمثلث "أودون " و"ريتشاردز" نحو الشكل التالي :-
| " اللغة العادية – التصوّر المجرّد |
| |
| اللغة المجازية – الكلمة | | اللغة الشعرية – الشيء |
| الجنس | الخصائص الصوتية | الخصائص الدلالية |
| 1- قصيدة النثر | - | + |
| 2- نثر منظوم | + | - |
| 3- شعر كامل | + | + |
| 4- نثر كامل | - | - |
وهذا الجدول يقودنا إلى ما قاله تودوروف "إذ من أجل أن تحدّد الشعر، لا يكفي أن نقول كيف يختلف عن النثر، إذ أن الشعر والنثر يمتلكان نصيباً مشتركاً هو الأدب" .
وقد سبقه إلى هذا عبد القاهر الجرجاني بتأكيده على أن "مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه،..... ثم اعلم أن ليست المزّية بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هي على الإطـلاق ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها
الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واستعمال بعضها من بعض" .
وهذه الخصائص هي التي تحقق الشعريّة من حيث هي "نص متعة: بضعك في حالة ضياع، ذلك الذي يُتعب ( وربما إلى حدّ الملل)، فإنه يجعل القاعدة التاريخية، والثقافية، والسيكولوجية للقارئ تترنّح، ويزعزع كذلك ثبات أدواته، وقيمه، وذكرياته، و يؤزم علاقته باللّغة" .
وبانتفاء الشعرية المعتمدة على الوزن بمعناه العروضي وبإقرار ننتزعه من أقوال القدماء، ويصّرح به المحدثون أنّ من الكتابة ما هو ليس بالشّعر ولا بالنثر، وأن ارتباط الشعر بالوزن والقافية إنما كان لتعلّق الشعر بالغناء وليشر شرطاً يُحددّه الشعريّة، بل تنتج الشعريّة عن البنية الكليّة للنص بمجموع علاقاته وانسجامها، وما يحدّد الشعر أو النثر هو طريقة استخدام اللّغة وتوظيفها، بذلك نستقبل قصيدة النثر، وندخل في بنيتها، وإيقاعها، ولغتها، ومعجمها، وصورها، وسائر خصائصها الفنيّة من حيث هي جنسٌ أدبي فيه شعرية، وخصائص فنيّة، وسنحاول فيما يلي تتبع نشأتها في الحركة الأدبية العربية، بالعموم وبداياتها عند أنسي الحاج بالخصوص.
ب. قصيدة النثر
البحث عن جذور النهضة الشعرية الحديثة في الحركة الأدبية العربية المعاصرة يرتد إلى "القرن التاسع عشر إذ يمكن العثور على تململاتها الأوليّة السّاذجة في بعض ما أنتجه أحمد فارس الشدياق، ونجيب المداد" ، ونعثر على تعليق كتبه نجيب شاهين جاء فيه "يظهر أن الشعراء آخر من يفكّر في خلع القديم الخلق والتزّين بالجديد" ، الأمر الذي يشي بفكر ناقد يدعو إلى الأخذ من الآخر الغربي والانفتاح عليه عبر فعل المثاقفة، وفي هذه الحركة الأدبية نجد جـبران
خليل جبران من أبرز الداعين إلى التجديد، ونلمس هذا في نتاجه الأدبي، وفي تأثيره على مدرسة المهجر التي يؤكد فيها أحد أعلامها "ميخائيل نعيمة" أن الأوزان، والقوافي "ليسا من ضرورة الشعر" ، وتُوجَت ثورة الشعراء المهجريين على القيود الشكلية، بانفلاتهم من قيود الوزن، والقافية، فإذا بنوع جديد من الشعر يظهر في الأدب العربي يحمل اسم "الشعر المنثور" أو "النثر الشعري" الذي يقول فيه محمد عبد الغني حسن : "وقد يكون في النثر الشعري ما في الشعر من خيال، ولكنه خلو من قيود الوزن والقافية " .
وقد وسّع جبران مسافة الشعر المنثور، والنثر الشعري فوضع فيها كتباً كاملة، فكتابة "العواصف" و"البدائع والطرائف"، وكتاب "الريحانيات" لأمين الريحاني أعلى ما وصل إليه الشعر العربي المنثور في عصر النهضة.
ومن أهم الإضافات التي أضافتها مدرسة المهجر لحركة الشعر العبي الحديث أحياؤهم لمفهوم الأدب المهموس، واعتمادها الشعر ككيان عضوي، وتعاملها معه كمتن، ومثل هذه الدعوات ترافقت مع حضّ كالذي مارسه طه حسين بقوله: "لا ضير على الشباب المسلّح بالثقافة، والعلم من التجريب، والخوض في غمار الحياة الشعرية، ليخرجوا بإيقاعاتهم الخاصة" ، وحين نأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظروف السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي مرّت بها الأمة العربية، والانفتاح على الآخر الغربي سواء من خلال البعثات الدراسية، أو من خلال أجهزة الإعلام وحركة الترجمة، فإن هذا المناخ فجّر حركة الحداثة العربية، التي تواكبت مع خطاب نقدي تنظيري يشمل أشكال الحركة الأدبية كلها، ويرفض الحدود الفاصلة بين هذه الأشكال.
وها هي " "جماعة أبولو" تنادي بالشعر المنثور، في حين بقيت القصيدة العربية داخل إطار عمود الشعر" . و"المقترب الجبراني بشّر باستعادة الماضي ضمن تغيير لغة الحاضر، معيداً بذلك للنثـر إيقاعه، واضعاً إياه في أزمنة الفعل- الحـركة" ، وقد اسـتمر هذا التصعيد
إلى أن وصلنا مجلة شعر اللبنانية، التي فتحت آفاق التجريب الأدبي عن آخره، وفيها نشهد البدايات الحقيقة التي أعلنت ميلاد قصيدة النثر.
المصطلح والدلالة:
قصيدة النثر "ترجمة لمصطلح فرنسي الأصل (Poemeen Prose) وجد لتحديد بعض كتابات رامبو النثريّة الطافحة بالشعر كـ (موسم في الجحيم) و(الإشراقات). وإن تكن لها أيضاً أصول عميقة في الآداب كلها، بما في ذلك العربية، ولا سيّما الدينيّ والصوفي منها" .
وقد ألغت قصيدة النثر الوزن، وانبثقت من استفزاز المألوف الشعري في جمعها بين متناقضين في الظاهر هما الشعر والنثر، وقد طرحت منذ البداية إشكالية التسمية، يقول جان كوهين:
مصطلح قصيدة النثر ظاهر التناقض، وعلينا إعادة تعريفه" ، ويقترح تسميتها بالقصيدة الدلالية إذ تنمي الجانب الصوتي، وتكثّف الجانب الدلالي.
كما تؤيّد سوزان برنار مُنظّرة قصيدة النثر الفرنسية، ما في التسمية من لبس إلاّ أن البحث في خصائص قصيدة النثر يؤكد أنها تسعى إلى:-
- الاستفزاز المحيل إلى ضدين: قصيدة ونثر حتى في التسمية.
- البناء العام المقترن بالفوضى المنظمة.
- الإشراق الداخلي المستمد من خصائص مشتركة بين الشعر والنثر، الأمر الذي يُكسب التسمية هوية، ويحدّد دلالات خاصة بهذا الجنس وبالتالي يصار إلى قبولها، وإنما حالها حال كل مصطلح جديد يحتاج الوقت الذي يَمَنحُه تاريخه، ووجوده. وإذ تستند قصيدة النثر على شيء يثبت شعريتها، وفنّيتها، فإنما تسعى إلى إعادة النظر في مفاهيم الشعرية والإيقاع بمفهومه الشامل كونه:-
1. " الأسبق من العروض إل أن الوزن أشمل.
2. من الصعب تحديده في أطر لأنه شخصي ومتغيّر.
3. لا يظهر الإيقاع الداخلي مجسّداً بالإنشاد، بل بالقراءة وما يترتّب عليها من مزايا.
4. هو مهمة فنيّة، تأليفاً وجمالية، استجابة وقراءة، وتلقياً.
5. ثراؤه في هدم الأسوار بين الشعر والنثر، للانتفاع بالإيقاعات المختلفة المولّدة عن هذا الهدم.
6. سيظل الخلاف حوله طويلاً، لأنه مركز تقاطع لعدّة قضايا تجمعها كلمة واحدة، هي الأخرى لم تجد مكاناً في الاصطلاح والمفهوم من مثل: الشعرية.
7. لكل قصيدة نثر إيقاعها الذي تصنعه المنهجية سواء على المستوى الدلالي أو الصوتي أو التركيبي" .
وبالمقارنة بين ما حاوله أدونيس في تحديد معايير لقصيدة النثر بقوله:
- " يجب أن تكون صادرة عن إرادة وتنظيم واعية فتكون كلاَََ عضوياً.
- هي بناء فني متميّز يفرض نفسه كشيء لا ككتلة لازمنية.
- الوحدة والكثافة المحقّقين عبر تركيب إشرافي" .
وهي خصائص مستقاة من كتاب سوزان بيرنار، صاغها بلغته، ولم تقترب القرب الكافي قصيدة النثر، وفي الوقت الذي يحسب لحاتم الصكر اقترابه، ووصفه لأطر تبرز المصطلح، وتناقش دلالته. فإننا نحيل أنفسنا إلى كتاباته التي تقترب من قصيدة النثر، ونبحث عن الجذور والبدايات .
الجذور
1. النص القرآني الكريم:
ترى ما الذي حدا بعرب الجاهلية أن يصنّفوا معجزة البيان القرآني الكريم على أنها شعر و"هم الذين يقيمون للكلام الموزون المقفّى سوق عكاظ، ويعلّقون النفيس منه على أستار الكعبة، وهم الذين أورثونا من رجز الشعر وقصيدة ما جعلنا نسهر جراه ونختصم." منذ أن وقف الملك الضليل يبكي من ذكرى حبيب ومنزل ؟
عرب الجاهلية الذين خشعت أبصارهم لمّا سمعوا الذكر وعصف بهم الذهول لما في الآي الكريم من بيان يأخذ مجامع القلوب فكانت استجابتهم الفطرية الأولية "إن هذا لشعر". فيردّ الوليد بن المغيرة: "والله ما منكم أعرف بالأشعار، ولا أعرف برجز الشعر وقصيده مني، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، إن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، ومغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه، وإنه ليحطّم ما تحته."
النص القرآني الذي نقل الثقافة العربية من الشفهيّة النقليّة إلى الكتابيّة المحققة ومن المسموع إلى المكتوب، و"الذي غذّى كتب التراث العربي النقدي بالمقارنات بينه وبين النص الجاهلي، فذا كتاب "مجاز القرآن" لأبي عبيدة، وكتاب "معاني القرآن" للفرّاء، و"مشكّل القرآن" لابن قتيبة، وفيه "النظم سبك خاص بالألفاظ، وضم لها بعضها البعض"، والخطابي في "بيان إعجاز القرآن"، وفي "نقائض جرير والفرزدق" لأبي عبيدة، و"حميدة أشعار العرب" للقرشي، وكتاب "نقد النثر" لقدامة بن جعفر، "والصناعتين" لأبي هلال العسكري. وهذه القراءات في مجملها تنقسم إلى قسمين، قسم يصر على قدسية نص القرآن، وآخر يراه نصاً ثقافياً وفيه رؤية كونية شاملة" ، ففتح النص القرآني الآفاق الشعرية على أشكال جديدة من التجريب الأدبي غير محصورة أو مقصورة على الوزن و القافية، والذي كان- بفضل من رؤيته الشمولية، وتغيّره لطبيعة الرؤية داخل الإنسان – حجر الأساس في الفكر الصوفي، والكتابة الصوفية.
2. الصوفية
التصوف "نزوع إلى التوحد، نابع من رغبة كمونية في تلاقح الذات والزمن، والمكان بالحلول، الذي به تتناغم وينتفي توترها" .
والكتابة الصوفية نوعان :
- الكتابة الصوفية المذهبية ومثالها " الشريف الجرجاني".
- الكتابة الصوفية الشعرية ومثالها كتابة "النفري" وتمتاز الكتابة الصوفيّة الشعرية بتحقيقها لما يسميه "بول ريكور" التنافر الدلالي•، الذي يجمع الأضداد، ليفاقم الرغبة في النزوع إلى التوحد، ويزاوج بين هذه الأضداد في الدلالات لينجم عنها الحلول في معنى إشراقي وضّاء، يغمر، ويفيض، ويملأ الذات المعذبة في أشواقها، والوابلة في عذاباتها، بالرضا، ويحقق لها غاية أمانيها الحلول، أنها كتابة "الأقرب إلى التعبير الإيحائي من سائر الشعر العربي" .
وقد تنبّه جماعة مجلة "شعر" إلى طبيعة الكتابة الشعرية الصوفية، وبخاصة "أدونيس" الذي عثر على مخطوطة "المواقف والمخاطبات " لـ"النفري" فكتب في ضوئها عن الخصائص الشعريّة في هذه الكتابة، وعن أفق التجريب المشرع الذي صار له جذره التراثي الأكيد بفضل منها –أي الكتابة الشعرية الصوفية-.
ومما لا شك فيه ان تقاطعاً هاماً بين " قصيدة النثر" و"الكتابة الإبداعية الصوفية" يجمع بينهما، من حيث نزوع كل منها إلى:
- التضاد، الدلالات تتولد منه، وتتآلف به المتناقضات.
- الكثافة والاختزال.
- الإشراق الناجم عن تتابع التوتر، وتصاعده، فما أن تنتهي الزفرة الداخلية، حتى تشرق المعاني الإيحائية المعبأة في النص داخل المتلقي.
- الاعتماد على البعد الدلالي، والإيحائي لا الصوتي الوزني.
- الكتابة الشعرية الصوفية وقصيدة النثر خيارات ذوات معذبة، يضنيها الحنين إلى الخلوص من الوحدة، والى الحلول في الآخر، الذي هو عند الصوفيين، الآخر الشامل، الكامل، والحقيقة العظمى، وهو عند كتاب قصيدة النثر الآخر الذي يخلص من الوحدة، والعذاب، والتنازع أو الصراع الداخلي، فيفرغ كاتبها شحنة الفوضى، والإحساس باللاجدوى، والعبث في كتابة تحمل فوضاها، ونظامها معاً.
3. السريالية
(في زيورخ التقت جماعة من البائسين، المتعبين من ويلات الحرب، ممن تعذب أرواحهم حالة الفزع واللاجدوى، والعبث، والخيبة التي ولّدتها الحرب بكل مآسيها. ومن بينهم الشاعر الروماني "ترستان تزارا" الذي اختار اعتباطياً اسم "دادا" للإعلان عن ثورة لا هدف لها، إلاّ عرض ما هو سخيف، وقد انضم فيما بعد لهذه الحركة كلّ من "بول ايلوار" و"لويس أراجون" و"أندريه بريتون" الذي أطلق تسمية السرياليّة، المأخوذة من اسم آخر رواية ألّفها "جيوم أبو لينير"، والتي اعتمد في كتاباته على منطلق اللاوعي، والهذيان، والضحك الأسود، وأسس الكتابة الآلية، وأفاد من آراء عالم النفس "فرويد"، فتداعت بذلك القواعد الصارمة للكتابة والتعبير، وحلّ التفجّر محل التسلسل.)
وفي الحركة الأدبية الغربية، تركت السريالية بصماتها القوية، وأثّرت لفترة طويلة في أشكال الكتابة الأدبية، وما زالت، وقد التقت "قصيدة النثر" مع السريالية، في تكسيرها للحدود بين الأشكال الأدبية، وإطلاقها العنان للاواعي، وإصرارها على أن الحقيقة في الوجود إنما هي في الإنطلاق خلف المشـاعر والأحاسيس، ورفض سيطرة العقل. وأن الجـمال إنما هو النقطة
التي يستيقظ فيها اللاوعي يقظة يلتقي فيها مع الوعي .
والنماذج الغربية من قصائد النثر وبخاصة عند "رامبو" تكشف عن عذابات وتشظّي وفوضى، تخففها كتابة محمومة، في كتابة لاغائية، ولا توصل إلى أي مكان. في حين تتشكّل قصيدة النثر العربية على أرضيّة الإحساس بالعبث، واللاجدوى، والفوضى، واللامعنى، والقهر الذي يصهر الكائن المحكوم عليه بالوحدة والفناء في ظل واقع طاحن. إلاّ أن إشراقاً يلتمع في فضاء هذه القصيدة، مرجعه العميق صوفيّ، وأُنسي الحاج يختار قضية يهجس بها، لتظلّ تصعد عذاباته، وترقى بذاته في مراتب التطهّر، حتى ينزع عنه ثوب الوحدة والفناء ويحلّ في الآخر محققاً طموح الالتقاء، فزاوجت بذلك قصيدته بين الصوفية والسريالية، فكانت ثمرة هذه المزاوجة قصائد نثر فوضوية، ومخنوقة، ومعذبة، توّاقة للاقتراب من الآخر والتوحّد به في ظل يقظته على حقيقة فناء كل شيء، الروح والجسد والعالم .
البدايات (بدايات قصيدة النثر ):
"في نهاية عام 1957م، تنبّه بعض شعراء مجلة "شعر" إلى نماذج نشرها "محمد الماغوط " في مجلة المجلة اللبنانية، وكان أنسي الحاج –فيما يبدو- أول من تنبّه لها، وفي شتاء عام 1958، أقام خميس شعر أمسية لـ"محمد الماغوط" كانت بمثابة اعتراف بتكريس قصيدة النثر" ، والمحاولات الأولى في كتابة قصيدة النثر كانت على الأغلب "محاولات جورج حنين من مصر، وأورخان ميسر من سورية، ونماذج ألبير أديب في مجموعته "لمن ؟" الصادرة عام 1953م، ثم مجموعة نقولا قربان عام 1955م، ونماذج فؤاد سليمان، والياس خليل" .
وقد نشر محمد الماغوط أول قصيدة نثر له عام 1954م، في "مجلة "الآداب" اللبنانية، وكانت بعنوان "النبيذ المرّ"، إلى أن أصدر مجموعته "حزن في ضوء قمر" عام 1959م، فلفت انتباه شـعراء مجلة "شـعر" كما سلف" ، أما أُنسـي الحاج فقد بدأ بنشـر بعض ما كتبه
أواخر عام 1957 م ، وقد علّقت عليه مجلة "شعر" بقولها :" لأنسي الحاج نتاج شعري من نوع جديد" ولم تُسمّ المجلة النتاج في حينها، إلى أن وقع تجمّع مجلة "شعر" على كتاب "قصيدة نثر من بودلير إلى أيامنا" للكاتبة الفرنسية "سوزان برنار" بتنظيره النقدي لقصيدة النثر، فأخذوا عنه.
ويرد "أنسي الحاج" على سؤال وُجّه له عن البادئ بكتابة "قصيدة النثر" بقوله:
"أدونيس هو المنظر الأول لقصيدة النثر في اللغة العربية، ومجموعة "الماغوط"، "حزن في ضوء قمر" صدرت قبل "لن" بعام كامل. لكن "لن" هي أول مجموعة ضمّت قصائد نثر عرّفت عن نفسها علناً بهذا الإسم، وبشكل هجومي، ورافقتها مقدّمة جاءت بمثابة بيان." ، فكانت هذه البداية بمثابة الإعلان الرسمي عن قصيدة النثر.
وبعد أن عرضنا للمصطلح، والجذور، والبدايات ندخل عالم قصيدة النثر عند أنسي الحاج، ونتعرّف قضاياه ومضامينه.
تكشف الدراسات النقدية للإنتاج الأدبي بعامة، والشّعري بخاصة أن البعض من الشعراء تشكّل المدينة ظاهرة أو قضية في شعرهم، وأن البعض الآخر تشكل القرية في هذه القضية، أو المرأة، أو الطبيعة، أو الموت، أو البحر .... وخلافه. وعند أنسي الحاج لا تشكل أيّ من القضايا السابقة قضيته. فلا هو يهجس بالمدينة، ولا القرية، ولا المرأة، ولا الطبيعة، ولا البحر، ولا أي من هذه. وإنما قضيته الحب. قضية معنوية، بعيدة عن المعالم الخارجية، أو الأوصاف الظاهرة الملموسة أو المحسوسة. وباسم هذه القضية هدّم عن سبق إصرار وترصّد كل الأوصاف المتفق عليها سلفاً، وحارب تقليديّة الصورة، ودخل في قلب العالم المتفكّك والمتفسّخ، واستبدل برانيّة العالم، بجوانيّة العلاقات التي يعيد إنشائها، ويبينها وفق حاجاته العميقة. إنه الحصار الطوعي الذي هو أسيره، والذي فيه ينبش عن خلاصه، بمفردات تتداخل بعضها ببعض ولا تتلاحق على حدّ تعبيره، فيتلمس جراحة المتقيّحة، ويغلق على ذاته الدائرة فيسجنها عمداً، ويبتعد عن كلّ العلاقات الخارجيّة مع العالم، فلا هو يصف الجمادات ولا هي تظهر في شعره ظهوراً خارجياً، ولا هو يهجس بها؛ فلقد انسحب أنسي الحاج من العالم الخارجي المضيء، الثابت المستقر، إلى عتمات الجسد حيث التشوشّ الفظيع، وحيث النظام المؤسس للإنهيار، فأدرك ضمن حدود جلده وَحَدته، وتيقن من أن حلفه مع جسده باطل ومتداع. فكان شعره تعبيراً عن التفكك، والانهيار ببعديه الروحي والجسدي، إنه الانهيار تحت وطأة ألم السرطان الساحق، رمز الموت الفردي المؤلم الذي لا يُقهر، والذي يعذّب الضحية، ويفترسها عضواً عضواً، إنه الرمز الأكثر قدرة على التعبير عن القدر الأعمى اللامنطقي. المتوحش، والعنيد، والذي لا يُقاوم، والسرطان فظاعة مواجهة هذا القدر بشكل فردي أعزل، إنها الوحدة القاتلة، والقاسية، والجدار يضيق، يحاصر ذات أنسي، وهو يفاقم هذا الحصار، ويرحّب بهذا الضغط الطاحن، ويستقبله ساخراً سخرية مرّة، متمنياً كسر طوق الوحدة، عبر فعل التوحّد، عبر فعل الحب. وفي لغة تشهد على صراع عنيف ما بينها وبينه، السبب فيه رفضه للكلمة المخطّطة، الممتلكة من الجميع، والسائغة الدلالة والرائجة معاً، فزعزع –تحت وطأة وعيه على اللغة- هندسـتها المعروفة، وحمّل لـغته نوازعـه، وحيويتـه، وعبأ صـوره بما هو داخلي، بعد أن
قطع علائقه بالخارجي. ولا خلاص من لعنة هذا العالم إلا بوهم خلاصي وهو وهم الحب، وهو مدرك فجيعته، فجاء شعره مرهقاً، مُراً، مُوغلاً في الوحشة والغرابة، ومتوهجاً بالموت حُباً.
ويتعامل أنسي الحاج مع ذاته على ذات آثمة، فالإحساس بالإثم هو المحرك لها، والخطيئة تستنطق عذاباته، وتثير آلامه، وتطلق ندمه الذي يأمل أن يخفّف فداحة الإثم، فيقول :
"......أنا المعتق بالخطيئة " .
وينظر إلى ذاته نظرة دونيّة فيها عزلة وانكسار وحقد وندم، فيقول:
"كلّ ما أذكر أنني في الخندق ألتهم جسدي
فيموت فأحشو جثتي ندماً ".
فالحياة ساحة حرب، وهو محشور في خندق، خائف وجائع، وجوعه يدفعه إلى التهام جسده، وهنا يبرز الإحساس بالإثم الذي يدفعه إلى الإتنحار أو الموت، ولا تنقذه رغبة الحياة فيه إذ يموت ثم يملأ الجثة ندما، الجثة التي يعيها وينسبها إليه بياء المتكلم، فالخطيئة والندم هما المحركان لذاته تجاهها.
ولا نتعثر في شعره على أيّ بادرة في التصالح مع الذات، والرّفق بها، فيظل يعاملها بقسوة وخشونة وتقريع، بانتظار الموت الذي تستحق، وما يكرّس هذه العلاقة بالذات فوضويّتها وصدقها، وبراءة عفويتها التي تقابل بالترصّد والتربّص من الآخرين، الذين يمارسون فعل التقييم لها، وتصرّ هذه الذات –كرد فعل– على السقوط والفوضى والتفكك معلنة الاستهانة بسخرية وألم، فيقول:
"ذكّرتكم من طبائع الكائنات أن تضرّ نفسها"
وقد فعلت قوى الواقع فعلها في ذاته، التي قابلته –أي الواقع- بسلبية واستسلام وهشاشة، فلم تواجهه بهدوء وثقة، بل انسحبت تحت وطأة الإحساس بالإثم الذي كرّسه الواقع والآخرون، إلى الظلمة، فتوارت الثقة بالذات ليحلّ مكانها الخوف والقلق، ولتظلّ هذه الذّات تحتقن تحت وطأة المداميك الواقعية التي تطالبها بالتغير والتبدل، وفق أنظمتها لينفجر الإحتقان في الكتابة التي تصف الذات، وخيبتها، فيمارس عالمه شعرياً الأمر الذي يعصمه عن ممارسته واقعياً، فيقول:
"سأختنق
فهذا هو الأفضل
هذا هو الشعر
والجواب "
فيقدّم جوابه على سؤال القلق تجاه الحياة، والناس بالاختناق وهذا ما يحدث تماما في جميع حالات المعاناة المتوترة إننا نكف عن التصرف كقضاة وناقدين، ونضحي أبرياء قابلين للتأثّر.
إننا أمام ذات فزعة وقلقة ومتوترة، يحكمها غياب الأمن والثقة اللذين يفقرانها إلى الهدوء والاستتباب، ولو كانت غير ذلك لاختارت شكلاً أدبياً للكتابة غير قصيدة النثر التي وجدت فيها ضالّتها من الشّرود والانعتاق، والتوق إلى حرية غير محكومة بوزن أو تفعيلة. وبهذا التصوّر يمكننا فهم خياراته الإبداعية، والاقتراب من مجمعه ولغته، وصوره ودلالاته، فجميعها محكومة بهذا الفزع، وتلك الرغبة في الإنعتاق من الجسد والروح معاً عبر فعل الندم على الوجود، وعبر تصريف الاحتقان ونثر أشلائه فوق الورق نصوصاً خائفة وملتهبة.
أ. الزمان
لا يهدف أنسي الحاج في شعره إلى بناء عالم جديد على أنقاض عالمه المتآكل، وشعره بعيد عن أي غاية، فلا غايات يهدف إلى تحقيقها من خلاله، فالغاية تستلزم إرادة، ونظام، وبناء، جمالية قصدية، وهذا ما لا يجده في نفسه، فلا يمكنه قوله .
والحرية هي أزمته التي تلحّ عليه، وحريته بالذات ما يدفعه إلى العزلة: عزلةٌ وجدانية وروحية عميقة، تنفيه عن آليات الانسجام، والتواصل والانفتاح. فيضيّع مفاتيحه مع الجماعة بيده، ويظل في عزلته ووحدته، التي يحكمها خوفه من الزمن من طبيعة علاقته به فيصرخ :
"لماذا يكون لكل خطوة للأمام ثمن ندفعه من أغلى مناطق في كياناتنا، ألكي تتم الحضارة، حين تكتمل، على قبر الإنسان وقد مات كلّه ؟
هذا هو سبب شدّي ما أشده من الماضي فيما أنا أسير.
هذا هو سبب توجّسي من المستقبل فيما أنا أنظر بغضب وتمزّق......."
وفي علاقته بالزمن ارتهان للموت يدفعه للسخرية من نفسه في محاولة للتخفيف من وطأته، ومغالطة مخاوفه، مؤكداً بذلك فزعه من الموت والزمن حين يقول:
"بدأت بقولي : أخاف
وأقول الآن : هيّا"
يخلخل أنسي الحاج –عن قصد- علاقته بالزمن فيُكسّر ثوابته يقول:
"لكنّ فمي ارتوى قليلاً
وهو يروي لمن يريد
ماضي الأيام الآتية "
إنها مقاومة سلطة الزمن، ورفض الاعتراف بسطوته، والارتداد إلى زمن ماضٍ كان يجد فيه الأمن، ويحس بالهدوء، وينعم بالاستقرار بوجود من يحب، ومن يتصالح بهم مع الزمان.
وتكثر في نتاجه الشعري - المفردات التي تتحدث عن العلاقة بالزمن، من حيث هي علاقة مرفوض برافض، فالأول ساحق، والثاني رافض، خنوع، خائف وحاقد فيقول:
"أسحبك نحو زمني الكريه "
فالعلاقة بينه وبين الزمان علاقة قهرية، لا ودّ فيها ولا انسجام.
وإذا كنا في "لن" نتلمس الاعتراف والصرخة الأولى العالية التي تأبى الإنصياع والاستسلام، ولا تعترف بوطأة الزمن، نجد هذه الصرخة في دواوينه التالية تتحول من صراخ حاد إلى تردد وصدى، فتقل حدتها ولا يقل عنفها، بل تظل وعلى امتداد نتاجه الشعري تتحرك ضمن ذات المخاوف، يفعّلها الفزع، الذي تقاومه الذات بالإنكار، ولا نجد بدائل طوباويّة عن الأشياء التي تفتقر إليها ذاته، فلا يبني لنفسه زمنا بديلاً، ولا يتصور علاقة أرحم مع زمن متخيّل، ولكنه يقاوم الزمن كما يقاوم كل ما يرهق روحه عبر فعل الحب، إذ به يعلن أن (لن يرفع زمن عليك صوته) ، وفي الحب فقط تتحول علاقته بالزمن من علاقة مقهور إلى علاقة قاهر، ومن مستلب إلى حرّ وفاعل، فيعش بفضله – كما (يعيش الحجر تحت الماء) ، والصورة تكشف عن الإحساس بالغمر والثقة معاً، السكون الآمن، والهدوء العميق الذي يحسه الحجر حين يعش تحت الماء الغامر، وتتبع دلالات اللفظتين يكشف عن عالم زمني يستعيض به عن عالمه الزمني الواقعي بفعل الحب.
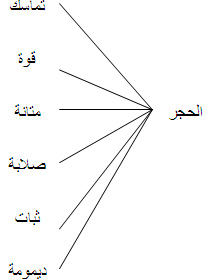
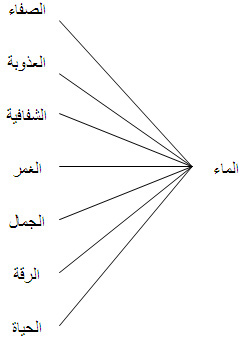
فيقاوم بالحب الزوال والفقد الذي يسلب الأحبة، ويستجلب به الديمومة والخلود.
ب. المكان
تكشف الدراسات النقديّة للأجناس الأدبية بعامة، والشعريّ منها بخاصة عن تشكّل المدينة أو القرية كظاهرة أو قضية في النتاج الأدبي -كما أسلفنا-، بينما لا نجد عند أنسي الحاج أي ذكر لحنين أو شوق لمكان، فهو يصدر في موقفه من المكان عن حقد دفين مردّه التنكر لسطوة الأمكنة، والرغبة في التخلص من هذه السطوة، فلا نعثر في شعره على حميميّة وألفة تجاه مكان يستذكره ويعود إليه، كما لا نجد أوصافا حسيّة لمكان يتحدث فيه عن خصائص وسمات، أو شخوص ارتبطوا به يقول :
"والأرض لا مكان لها "
"الأرض منزل بلا عتبة"
مؤكداً رغبته في التخلص من سطوة المكان التي ترهقه وتضغط عليه، أنها عزلته ووحدته المحاصرتين، إنه يقاوم المكان شعرياً –في كتابته-، ينفيه ويعلن رفضه وتمرّده عليه، يقول:
"نزلتُ،
وانحنيتُ على الأرض
قرّرت أن أعقرها بمخيلتي "
وشخصية المكان وأوصافه غائبة في شعره، فلا مقاهي، ولا منازل، ولا سقوف، ولا ضجيج للمدينة، ولا صخب، ولا فنادق أو مرافئ أو محطات. فلا نكاد نتعرّف على مكان يتحدث عنه، إذ يعبّر في أغلب الأحيان بمفردة الأرض .
والعلاقة بينهما علاقة قسوة وانسلاخ، يقول:
"أنظّف البيت من متاعه، أنفخ القسوة على الدّار
أنتظرك في وطنك مذبحتي"
وكأنه ضحية المكان الذي ليس بمكانه ولا تربطه به أيّة رابطة إلاّ انتظار مذبحته -خلاصه– فيه، وهذا يقودنا إلى همّه الذي يتفجر منه شعره، وقضيته التي تشغله وتؤرّقه: الحرية، ومواجهة الوحدة التي يزيدها بؤس المكان مرارة، فلا عجب من التنكر له إسقاطه، كلّ الذات تنفتح على ذاتها بعيداً عن المكان الذي يشكل بعداً لا واعياً، إذ لا نعثر على تمحور حوله في أي من نصوصه، فلا نقع على قصيدة تحمل عنواناً مكانياً، ولا نصّ يُبنى على خصومة بينه وبين مكان ما، فلا مكان في شعره إلاّ مكاناً واحدا ًابتدعته مخيّلته ليجد فيه ملاذه، إنه المكان –المرأة /الحب.
ج. الحب- المرأة
"المرأة حاضرة عندي منذ وفاة أمي. ومثل كل يتيم. لست فريداً بهذا الموضوع. رافقت آلام أمي. وكنت أتعجّب كيف يتحول المرء من شخص جميل ومالئ دنياه إلى مريض فجأة وضعيف ثم يموت. هذه الصدمة جذرية في حياتي، وهي بأساس كل شيء آخر، من حب المرأة إلى كره المرأة، ومن فهم الحياة إلى حلم الحياة عوض عيشها، أو بالإضافة إلى عيشها. وكأن الواقع قدر ما هو بشع وحقير لا يمكنك أن تعيشه بوعيك، علي أن تخترعه بحلمك " .
الأم التي صنع غيابها غياب المرأة الحسي، فعاش أنسي الفقد صانعاً مثاله على هيئة المفقود المتشكلة في بؤرة وعيه، ليصطرع في أعماقه المثال والواقع، المعنوي والحسي، الروحي والجسدي ولينتصر المثال، فتغيب المرأة كحس، ولتتفاقم حدّة الصراع ما بين الخطيئة والإثم، وفعل التطهر، فيتقرب من المثال الذي يطهّر من الخطيئة ليقول:
"أريد أن أتوقف عن الرثاء وكالأم أركع" .
ويضفي القدسية، والروحانية على الأم المثال، فهي تمسّح صادق بوده لو يتطهر به، ويتصالح مع ذاته الآثمة، جاعلاً من الأم المثال قدس الأقداس:
"أيها الرب
أحفظ حبيبتي
أيها الرب الذي قال لامرأة: يا أمي"
ويتجلى المثال في كل شفيف، وعذب فـ"الابتسامة أم" ، وهي التي كمثال تستوطن أعماقه، وتحتلها إلى الحد الذي يسلّم معه بوجودها، ويقر إقراراً لا يحتاج إلى تصريح أو اعتراف، فهي فيه كما الهواء، والماء اللذين بدونهما تنتهي الحياة، فلا يتجاوز عدد المرات التي يذكر فيها مفردة الأم خمـس مرات في دواوينه، ولأجل بلوغ المثـال، والخطوة بغفرانه بعد فعل الخطيئة
-الخطيئة الأولى– خطيئة الأب آدم، يمارس ماسوشية عنيفة تجاه ذاته متمنياً محوها، علّ الغفران يغمره يقول : (صغرتُ أمام الألم حتى عادت أمي من الموت لتحميني) .
إنه صراع الخطيئة –التكفير في ثنائياته، الحب – الجسد، العيش - الحياة، الواقع - النموذج.
"فيا أيتها الأم الأولى
أيتها الحبيبة الأخيرة"
الأم المثال، الروح، النموذج، الحبيبة في قدسيتها التي تدفعه إلى قول: ( أريدك يا إلهي دائماً مثل هذه الأم) . الأم الحب الذي قلّ ذكره للفظتها، فكأنه يربء باللفظة التي تُقال، ويدخرها في أعماقه كنزا سريّاً، وحميمية جارحة، لكن اللفظة حتى تكتب، تخرج عن طوعه، وتفيض لتغمر في حالة لا يمكنه معها استخدام مفردة أُخرى، تقترب من أعماقه التي يسجنها الإحساس بالإثم والخطيئة، فيفجر توتره، وعذابه في فجوة تنفرج لها أعماقه المضطربة فيقول: "أنا الرجل الأم" . وعلى الرغم من محاولة الإتزان، يظل موج الخطيئة يتجاذب روحه، فلا يرى في الكون إلا فعل الخطيئة، وما غاية الوجود إلا التطهر، ووسيلته الألم، تفعيل الألم، والاستزادة من فاعلية الجرح، إذن الماسوشيّة طريقة لطلاّب التطهر، فالذات ملعونة بخطيئتها، والإثم يرهصها، وغياب المثال يسحق أعماق الشاعر، والوحدة تأكل خلاياه، وما العدوانية التي يُتهم بها الشاعر، والمشاغبة إلا أقنعة لضدهما من الضعف والهشاشة، والاستكانة والاستسلام للخيبة المريرية، والواقع بقدرته على السحن.
إنه الطفل الذي لن يكبر، ينضج من غير أن يكبر ، الطفل الذي يبحث عن مثاله، عن أمه في صور النساء "إن المرأة هي أمي. إذن أمامها أسـتطيع أن أكون طفلاً بكل راحة، دون قمع
ذاتي .كل طفلة تستطيع أن تكون أمي" ، هذه الطفولة المستمرة في بحثها عن المثال، التي لن تكبر إلا لحظة التقائها بالنموذج، بالتكفير، ستظل ترفض المرأة كذات، كحس وحتى كعنصر جمالي، إذ تغيب هذه المرأة، فلا نجد امرأة ذات كيان اعتباري، مستقل في شعره، الأمر الذي يعلنه بقوله:
"لا تعنيني المرأة الواقعية، لا أريد أن أراها، أريد المرأة التي في رأسي" .
هذه الثنائية بين الأم المثال والمرأة الواقع توقفه عند نقطة تماس حادّة، فيقترب من المرأة حذراً في تهيب ووَجلْ، غير واثق من الواقع لبساطة تناقضه مع المثال، غير مطمئن إلى المرأة لافتراقها عن الأم، عاجز عن الوثوق بها، وبالواقع الذي تمثله، الأمر الذي يقربنا من فهم إيروسيّة الحب عنده، وابتعاده عن الجانب الحسّي منه يقول :
"- حين أسترخي جوارك، لم تأكلني يا سيدي؟ هذه ليلتي الثانية، للآن لم تلمسني .أما أفتنك، آه! لماذا لا تأكلني ؟
لأبقى في انتظارك، ابعدي".
وفي قصيدة (خطة) ، صراع الواقع والمثال في علاقته بالمرأة التي تصرخ وهو يضرع، ومكانها البيّن يضاد مكانه الخبيء، كل هذه التضادات حتى لا تراه فيجيء فتهرب .هذا الواقع الذي يشرخ إمكانية تعامل الشاعر معه، فيرتد في حُلميّة ظامئة إلى الرحميّة، متمنياً إلى رحم أمه، حيث المثال فيقول :
"عوض أن تُقبل من أمك تزوجها" .
ويقول:
"ركض وفتح وقفز وهبط وصعد وراح .
وفتح.
ودخل .
وفي الصالة السينمائية المظلمة جلس وعاد إلى بطن
أمه "
والخطيئة عند أنسي الحاج قائمة على إحساسه بالظلم الذي أوقعه آدم على حواء، حين ألقى اللوم عليها، واتهمها بغوايته، وأنها دفعته ليأكل من الشجرة التي حرّم الله، فطرد من فردوسه إلى الأرض، ليظل به التحنان، ولترتهن عودته إليه بتطهره من الإثم على الأرض، وينفي أنسي الحاج الجزء المتعلق بدور المرأة فيها، فعنده إبليس أغواهما، وهي استكانت أما آدم فقد أكل من الشجرة، فحقّ عليه العقاب. وهذا التصور متفق مع النص القرآني الذي يروي الحادثة، فيحمل آدم وحواء وزر الإصغاء إلى الشيطان الذي هو عدو لهما، قال سبحانه :
( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة، وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ) . وديوان (الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع) تفصيل لتصوره هذا، الذي يعيده فيه الاعتبار للأنثى، مسقطاً التهمة التاريخية التي أثبتها آدم عليها، فقد "حضنت عذابها لتحضن معذبيها" ، وليصفها بقوله :
" أنتِ التي تغيّر الحياة بجهل صاعق
أنتِ المضمومة
تغيرين الحياة دون انتباه
بعري النقاء الذي لا تستسلم الأسرار
إلا لشهوته
هي قصتك
قصة الوجه الآخر من التكوين"
وسبيله للخلاص من إثم الأب الذي يعذّبه ويعترف به معلناً "..أنا المعتق بالخطيئة" ، مقاومة الحس، والحب الوجداني العميق الذي يتطهر عن المطالب الحسية، فتذوب الذات وجْداً، وتهيم في مراتب من العشق المطهّر بفضل من العذابات التي تعيشها، ذات تقاوم نوازعها، وغرائزها، التي تفتك بها، فيزهر الحب الذي هو(زهرة الشفقة) ، فتكون النتيجة :
"أحبك سلفاً
أفتحي، أغلقي معطفك .."
فالحب :
"خلاصي أيها القمر
الحب هو شقائي
الحب هو موتي أيها القمر"
إن التطهر بطقوسه الماسوشيّة، الذي تتهدم أسوار العزلة، ويتماها في الكون فيغيب عن الزمان والمكان ليسبح في هيام يشبه هيام الصوفي المتعبد، والمنعتق من أوحال الجسد، والطامح في النور، الصاعد إليه عبر مجاهداته، ليخلص من أوهام الدنيا وأرجاسها، هذه تقابلها عند أنسي إيروسيّة المحبّ الذي يفنى بالحب ليتطهر، حب أرضي يائس لا هو يعرف فيه محبوبته فيحميها، ويمتلكها ويذوذ عنها، لأن المحبوبة واسطة لا غاية، وسيلة لا حقيقة أو مطلب، فالمرأة في شعره واسطة لا وجود، والحب الحسي يعذّبه من حيث يذكره بالخطيئة يقول:
"جسدك يعطيك بئراً، وجسدي سيفاً
ابكي يا أسرار الأبواب"
ما هي إلا زفرات محمومة ينفثها في الصراع الحسي الروحي يقول:
"دون أن نلدهم نشمّ أبناءنا
آه ! ما أجمل العبد الهارب !
باكراً نلتقي
بجسمين أبيضين نفلح ظل الأسوار"
والحب عنده وهمٌ يفاقم نزوعه إلى الحياة، حتى لا يغرق بصمت في وحدته، فيعطي، ويتشظّى، ويتعذب، ويغار غيرة قاسية، يعذب بها ذاته، ويجلدها بنيرانها علّها تتطهر "فالجبل أخفّ حملاً من الشوق، والأرض أقصر من الغيرة " ، الغيرة التي يعلنها كحقيقة ساطعة بقوله : "وأغار" ، وبها يستزيد من فاعلية الألم و "ولهذا السبب تسحب الغيرة نَفَسي، تبكيني الثقة " .
والحب عنده فعل حركة في مواجهة السكون والوحدة، فعل الحياة في مواجهة الموات، موات الذات التي تأكل نفسها تحت وطأة إحساسها بالإثم، إنه الفعل الذي تحل فيه الذات المحبة في فعل اتحاد بالكون، يردّ للكون والوجود مغزاه المتمثل في التطهر. الحب الذي في جانبه الحسي ارتداد المرحلة الرحمية، وفي إغماضته وغفلته تماس مع الفردوس المفقود، والمثال، وبالحب من حيث هو "لوعة رغبة العاشق في القبض عند المعشوق على شيء لا وجود له" ، يتحقق تطهّره .
أما في تصوره الواقعي للعلاقة بين الرجل والمرأة فإنه يرى "المرأة مع الديمومة، والرجل مع العبور" ، وحلم بإزاء هذا الواقع متمثل في إقامة توازن بين الموقفين، وعلى الرجل دور يستدعي يقظة وعيه، ليحارب ما يفسخ العلاقة بين الرجل والمرأة واقعياً، فيرفض الحب الذي يمارسه الرجل على أنه "كمية الجهد المبذول لتبشيع جمال امرأة يعذّبه" ، والعالم عنده محتاج إلى أنوثة أكثر .
وفي توتر، ترتسم العلاقة الواقعية بين الرجل والمرأة، مردّ هذا التوتر إلى صراع المثال والواقع عنده يقول:
" قامت وذهبت
لأنها وجدته مرتاحاً
ففكّرت ليس في حاجة إلى وجودها.
وهو كان مرتاحاً
لأنها جاءت
لأنه لا يريدها أن تذهب" .
تناقض حادّ بين الأم المثال والمرأة الواقع، بين الأم التكفير والمرأة الخطيئة، هذا هو الحب عنده.
د. الدادائيّة والسرياليّة :
(كلمة دادا) تعني (نعم – نعم) في الروسية والرومانية، وتعني (حصان خشبي) في الفرنسية، ويراد بها عبارة ساذجة في الألمانية. هذه الكلمة (العبثيّة) التي لا تشير إلى شيء إلاّ إلى حالة فكرية تكونت منذ عام 1912م . ولعل همَّ هذه الحركة الأساسي السعي إلى تفجير الأطر الضيقة للمفاهيم السائدة . لذلك فإن "بدايات الدادا، يقول تزارا، لم تكن بدايات الفن، بل القرف" ، من نتائج الحرب العالمية الأولى التي كرست إفلاس عقلانية القرن التاسع عشر، والثقافة البرجوازية المرتبطة بها، فاعتبرت نفسها حركة هدم وتدمير.
هذه الحركة كاتجاه وقوة هدم نلمسها في كتابة أنسي الحاج الشعرية، ونجد جذوراً لها في أعماقه، وأسساً تنبني عليها رؤيته ومواقفه، يقول : "ألف عام من الضغط، ألف عام ونحن عبيد وجهلاء وسطحيون لكي يتم لنا خلاص علينا – يا للواجب المسكر!- أن نقف أمام هذا السد"، ويتابع :"حتى تقف أي محاولة انتفاضية في وجه العبيد بالغريزة والعادة، لا تجدي غير الصراحة المطلقة، ونهب المسافات، والتعزيل المحموم، والهسترة المستميتة على المحاولين ليبجّوا الألف عام، الهدم والهدم والهدم، إثارة الفضيحة والغضب والحقد " ، وفي موقف دادائي محض يقول: "أول الواجبات التدمير" ، لقد ضرب صفحاً عن الماضي، مبرزاً بذلك قول ديكارت "لا أريد حتى أن أعرف أنه كان رجال قبلي!" ، هذا الموقف الرفضيّ، والعبثي عبر عنه أنسي في كتاباته متفقا في ذلك مع الدادائية التي فقدت الإيمان بالماضي، وأعلنت عبثها واعتقادها بأن الحياة تتأكد في الضدّ، وهذا بالضبط ما نجده في ديوان (لن) تحديداً، في لغته وصوره وبنيته، إنه صراع العبث والإيمان، يقول:
"أناديك أيها الشبح الأجرد، بصوت الحليف والعبد، والدليل، فأنا أعرف. أنت هو الثأر العائد،
هـ. المسيحية
شكلت التربية المسيحية دواخل أنسي الحاج، ولعبت دوراً واضحاً في تكوين موقفه، وزاوية رؤيته، يقر بذلك في قوله: "مسيحي أنا" ؛ فالإيمان بالله، واليقين بوجوده، والإرتهان له ولرحمته. معانٍ تشربها منذ صباه، وعبّر عنها في كتاباته، التي ترجمت تصوّراته للحياة والموت، والبعث، يقول: "لا أؤمّن للزمن، ولا لجسدي، ولا لعقلي، ربما فقط لله، لأن لديه رحمة وعقله أكبر من عقلي، ويستوعبني) ، وقوله: " الله يلحظ سقوطي ويحتويه. إنه معي حتى لو كنت ضده، الشيطان ناقص الحب، وحتى لو فهمني فإنه لا يشعشع فهمه بالغفران، بل يستغله بعقله" ، وتعليقا على قوله (ربما) في الجملة الأولى؛ فإن هذه الربما تفسّر الكثير من قلقه الوجودي، وفزعه من الحياة، والعذاب الروحيّ والجسديّ المقدّر فيها، وتكشف عن تشكّك ديني، نابع من حاجة ذاته الملتهبة، والقلقة، والمتشككة إلى الأمان والرحمة التي تخفّف أورامها يقول: "تلام الآلهة كيف تخترع الخطيئة، وتعرّض الإنسان الضعيف لحبائلها، ثم تعاقبه على الوقوع؟" ، إنه موقف الوجل الذي يجاهر بضعفه، وقدرة غرائزه على الفتك به، والتمكّن منه، واستسلامه لها، ووقوعه في حبائلها، وهو الضعيف المحتاج إلى الرحمة، والعفو، والغفران، لا الرصد، والتصيّد، والمعاقبة –بحسب تصوّره– الذي يقترب فيه من موقف القدرية الإسلامية، التي تقلل من شأن الإرادة الذاتية، ما دام كل شيء في العالم، وفي الحياة الإنسانية محدداً تحديداً مسبقاً بقدر، فتسقط بذلك حريّة الإرادة، وقدرة الإنسان على الاختيار، وتحمل مسؤولية هذا الخيار العقلي، والنفسي الوجداني معاً، الأمر الذي يدفعه إلى سؤال ذاته: "لو استطاع الإنسان التخلّص من الندم على الماضي، ومن الأمل بمستقبل ما يلي الموت، هل كان يستغني عن فكرة الله؟ " ، إنه المحتاج إلى الإيمان برحمة الله، واستيعابه البشر الضعيف، العالق في حبائل الخطيئة، والغارق في أوحالها، "أنا المعتّق
بالخطيئة" ، هذه الخطيئة التي فعلت فعلها في دواخل أنسي الحاج وانبثقت منها حرقته، ومرارته، وتفاقمت وحدته لتصل إلى حدّ القطيعة بينه وبين الخارج، فالخارج برّانيّة تتمظهر في طبيعة شخصه العملي، مقابل تلك الجوّانية العميقة حيث حريته الداخلية التي يحرسها بعزلته المحصنة بإدراكه المفجع لعالمٍ بلا ملامح، هو المأسور بنزوعه إلى المطلق، والإلتحام بالكون، في واحديّة لا انفصام فيها، لذا يعيش بدوافع للحياة القلقة، وبفزعٍ حاسم من البداية كما من النهاية، فانفصم بذاته ذاتين، واحدةٌ للخارج، وأخرى للداخل، وأفرزت الأولى واقعه الاجتماعي، والاقتصادي، والحياتي المعاش، أما الثانية فله، لحريته، يقول: "وتبقى حريةٌ في الداخل، في نواة الظلمات، من يعطيني إياها؟ " ، هذا الانفصام النفسي تفجّر في لحظات الظمأ إلى التقاء الذاتين، كتابة متشظيّة، ولاغائية، والحبُ وحده من نسائم من الجنة –بحد تعبيره– وبالحبّ المعذّب، والمؤلم، تصعّد الروح آلامها، فتخفّف من وزر الخطيئة، وتتلمّس الغفران، عبر صلب الذات فوق صليب الحب، ليحمل خطاياه من وحل الأرض إلى مغفرة السماء.
وتؤثر التربية المسيحية، كما تبرزُ تأثّراً بالفكر المسيحي وبخاصة فيما يتعلق بالإحساس بالخطيئة، والإثم، يقول: "هناك في حياتي قبرٌ عزيزٌ ليس بكبير كل الذين هم أفضل من غفرانهم يغسلني، وندمي يغسلني، ومع هذا لا أشقى ولا أرتاح" ، "لأن واجب المسيحي أن يحافظ على الجدّ والوقار والتوبة والتألّم تكفيراً عن خطاياه" .
أما رقّة المسيح –عليه السلام– ورحمته، فتروقان له، ويرى فيهما قوة، فقد ذهب المسيح إلى الطرف الآخر من القوة: على أقصى الضعف، الذي هو رقّة، وشفافيةٌ، فمن يصفع الخد الأيمن منك أدر له الأيسر، ويشابهه أنسي حين يقول :
" وفي ترابي المخمّر بالسرّ والحريّة
سأحتضن برحمي المجنونة
جميع الذين قتلوني"
أما الطقوس الدينية المسيحية، فتظهر تأثيراتها في صوره، ومفرداته، فالصلبان، والأجراس، والعُماد والأب، والابن، والروح القدس، وعيد الشعانين، والأناجيل، ويسوع، والمزامير، يصوغ معانيه الداخلية بواسطتها، يقول:
"ويتناول النهار على نهدي العشيّة الأب والابن والروح القدس."
"وحملت الهاوية
فلما رأتك اعتمدت في نهر الأردن"
" يسوع ! ديكك لا يصيح"
"الصلبان طُبعتْ بالنار ودقّت على الصدور"
" وأشعلوا في الغيوم الدوريّة الخمور والتعاويذ وملفات العماد"
" إلى حدود الشراع داخل ثوب الركض رايتك تشعننين
فارسي الحب ! "
" تخاطبك الأناجيل بالأسماء المختارة "
"ليل نهار تقرع أجراس النجدة في الأحشاء "
ويعيد أنسي الحاج توظيف قصّة الصلب ليتحدث عن الشجرة قائلاً : " يوم الصيف ! الشجرة، الشجرة التي تمردت على الطبيعة فهجرتها وغدت لنا أثيراً ونظرات وحنيناً وعناقاً. التي حملت صليبنا ورمته من فوق الجبال، وتبعتنا سريرا لنا، ولقاء، وعبرنا، لكل السعادة "
إنها الشجرة التي تنحاز إلى فعل الحب بعد فعل الصلب، والسعادة لا في الإثم ولا التكفير، بل في الحب الذي هو غفران.
وهذه الأصداء للتربية المسيحية، تتنازع ذاته التي تخوض الحياة، بقسوة القدّيس على ذاته، ودراية الرحّالة بدروبه، وشهادة الحكيم على خبرته، ليواجه الحياة بسخطه، ونزقه، معلناً عن أمنياته برحمة الله، واستيعابه، ومغفرته لذاتٍ آثمة، حانقة، تقابله بانكسارها، وخيبتها وعذابها.
بيني وبينك طفلتي المسلية، وامرأتي، فليشف منجلك حصادي! لكنك صلب كالرّبا، فاحش، أخرس، وخططي بلا مجاديف. أسدل رأسي على جبيني فتمدحني عينك الوحيدة من أسفل النهار يتركني الليل يحميك !"
ودراسة اللغة عند أنسي الحاج تؤكد تأثره بالحركة الدادائية في الموقف من الحياة وأخذه عن السريالية التي هي سلوك، وطريقة تفكير ونمط يلتقي مع الدادائية السابقة لها في الموقف الخاص من الحياة، والرفض للمفهوم المنطقي والعقلانيّ و"السعي للتخلص من الرؤية التقليدية التي استعاضت عنها" بصوريّة هي شكل إشارات معبرة بحد ذاتها دون أن تكون مدركة عقلانياً وقد عرفها أندريه بريتون، كمفهوم في بيان السريالية الذي صدر في عام 1924م على أنها "آلية لنفسانيّة صادفية، يمكننا أن نعبّر بواسطتها، إما كتابة، أو شفويا، وإما بأي طريقة أُخرى عن سير عمل الفكر الحقيقيّ، ما يمليه الفكر في غياب أي مراقبة يمارسها العقل، وخارج أي اهتمام جمالي أو أخلاقي" ، وبهذا المفهوم كسر أنسي الحاج تقليدية التفكير والنمط، فتكسرت عنده اللغة المألوفة، وغامت الأفكار، وتشكلت الصور السريالية في شعره وكتب كتابة حرة آلية، تساقط منها وعيه ممتزجاً بلا وعيه يقول:
"أرى الغيم علقاً مدهوناً بالزجاج (أسناني!) أرى الطوفان خلاص البر أرى نوح تريكة"؛ قبّعتي يوسف الحسن، فابعد فأبعد وعينك عليّ. أدوخ على انهزامك ووراءك كلابٌ محررة. أدوخ على انهزامك ثم أفيق، وأرنبة أنفي ساحة لك ! ومئة ألف ملاك" . وفي ديوانه (لن) تحديداً، مضامين لاغائيّة، فوضوية، عبثية، هدميّة، مبرأة حتى من الجمال، وصوره سريالية متلاحقة، متدافعة يقول: " الخضاب بعيد عني، والحب لا أراه وأنا المُرجَعُ أسقطُ على الركبة والراحة، آه ! كل هذه الرياح بيننا! أشمّك بلا خضاب، وأحبك كثيراً، المسافة ترفعك في خيالي وأصير كرة." ، غرائبية الصورة، وغوصه على المعنى العميق الذي يلتقي فيه الوعي واللاوعي بحسـب تعبير السرياليين، يؤكد
مفهومه السريالي للحياة، ومقاومته للفكر الليبراليّ بأشكاله الاستعمارية، والاستيطانية، ووسائله المتعددة من وسائل الاتصال ووسائل الإعلام، وفرض الهيمنة بأشكالها الفكريّة، والثقافيّة، والسياسيّة، والعسكريّة، نقاط تلاقٍ بين أنسي الحاج والسريالية كمفهوم ينطلق من (وجوب تحطيم كل ما هو سريع العطب) ، ووسيلتها ( الفن في اشتراكه مع النشاط الاجتماعي الثوري، وسعيه مثله الى البلبلة وتدمير المجتمع الرأسمالي ) ، ولعلّ تعبير بلبلة يناسب شكل الكتابة التي يمارسها أنسي الحاج، يقول :
"النازلة نهر العصور
الأغنية المحرّمة
أيقونة الحظّ
أصابعي تفتح لكِ جناح السنة المقبلة ! "
في توقه للحرية، ورفضه وجوه الموت الاجتماعيّ والأخلاقيّ و الأدبيّ يلتقي مع السريالية في ذات التوق الانسانيّ أصلاً، فيتفق معهم في :
1- "النص على أهمية الحلم ومنطقة اللاشعور في الإنسان وهنا تظهر قيمة التعاليم الفرويديّة يقول:
"على رأس المدرج يموت ماء العدد الأكبر حين تسألك :
(أنت؟ ) فتقع عنك مليون ورقة صفراء .
وإذا كنتَ محلي دع ملائكة الظلام تتموج نحوك على مهل.
حدث مراراً ما يشبه هذا، لكن حركة لانهائيةٌ وجديدة أمام الشمس، فكنتُ – مشحوناً بالمناورات – ابتلع ذكرياتي"
2- إن الفكر الإنساني قادر على أن يبلغ حالة تتصافى فيها المتناقضات، يقول:
"الساعة هي الليل بعد الليل والنصف. لحبيبتي بيت فوق الليل. لبيتها غرفة في منتصف الليل. تنظر من هناك فلا تراني. تمشي حيث أمشي فلا تراني. تضيء فلا تراني. وتنام في التأجيل. تحلم بالنافذة، وتخاف أن يحتلها النسيم" .
يقول: "وكما العاقل عقله يجنّنه، كذلك فإن المجنون جنونه يهديه
والرابح يخسر والخاسر يربح"
3- التفرقة بين الذات والأنا؛ فلأنا هي الشيء الظاهر، أما الذات فهي الأعماق، التي تدور فيها المعارك بين غريزة الحب والرغبة –حسب ما يقول فرويد– وهي المنطقة التي يريد السرياليّ أن يستملي منها وحيه دون رقيب من عقل أو قانون خُلُقي" يقول:
"نرفع الغطاء، ندنو من الهيكل، وندخل على ما نستسلم إليه، في سؤدد عتماتنا المحلّقة بأجنحة الغيب، الى نورٍ أنقى، سعادة تبحث عن عينيها"
وأكثر ما يشبه أنسي الحاج في مضامينه (بول ايلوار) شاعر الحب الذي يتميّز بين السرياليين بإيمانه بحقيقة الحب، وأنه الطريق الأوحد من هذا العالم. الحب تجربة متحرّكة يعيش الإنسان في وسطها وينمو ويتغيّر، والشعر هو الرائد الوحيد الذي يهدي إلى الحب. أما المرأة فهي سر الوجود. المرأة حالّة في كل مكان مثلما تمتد صفحة السماء، هي الجزء والكلّ معاً. "وما العشق إلا حالة متجدّدة في استمرار، حالة مثل الحياة لا تعرف النهاية، وهو في كل مرّة ولادة جديدة " ، ولكن "هل تنفجر النفس العاشقة تحت ثقل العصر؟، إذ ذاك يكون الخلل في العاشق نفسه، وليس في العشق ... العاشق الحقيقي فيه ما هو أكثر من إنسان" ، وبالمرأة يتحرّر، ويتطهّر ويجيب حين تسألهُ :
"- وأين تكون؟
أكون فيك، من وريد السماء إلى وريد الأرض"
" أنت المدعوة، لك قدمان في الصدى وفَقْد أعمى، وحذاء يُطلَق بصمت. التمثال يبتدئ والخلوة تحضّ الشهوة : تضافرت وأصبحت النبع والنهر والبر والعشب والرقاد" .
(وقد تأثر السرياليون تأثراً كبيراً بالخفائية أوالباطنية، النظرة القائمة المفرقة الحدسيّة، في ما وراء العقلانية، المعرفة المتعالية، التي يؤسس بها ميتافيزياء كونية. غير أن هذا التأثر تمّ بدءاً من فقد رؤية العالم العقلانيّ، ومن تأمّل خاص في اللغة) . هذه اللغة الخاصة بصورها السريالية حاضرة في كتابة أنسي الحاج، وصوره مشبعة بروح الباطنيّة التي تشي بتأثرات صوفية لا عن تماس بالصوفية، بل عن تشابه في الموقف من الكون بين الصوفيّة والسريالية، فالصوفيّ بروحانيّته، وحالة الوجد التي يعيشها، والسريالية هروب من الواقع، بالحب، وبكل ما يغيّب الوعي، يقول : "فلتعصف الرياح لم تعد عاطلة، ولتُزح أسواري . ألقوا المرساة وافتحوا المحيط لعينيّ، وأنت ! تهلل أنت، فحيحي" .
"الرحلة المفتوحة الصمّاء، الخشبة الغابة الذائعة في الخشبة، وكل شيء رائج هناك" .
"جزيل الشكر للذين بين نافذتي ونوافذهم خطّ رغبتي يتشمّس في ضوء القمر" .
هذه الأصداء السريالية في موقفه، ولغته، ومضامينه، تكشف عن تأثّر بهذا النمط الفكريّ وأخذ عنه، وصدور منه، وما الصورة السريالية في ديوانه (لن) و (الرأس المقطوع) إلا علامة واضحة على سريالية الشعر عنده .
هذه الصورة التي تحولت إلى وعي سريالي عميق يُعبر عنه بلغة استبدلت الصورة السريالية،
بأخرى تجريدية كثيفة، إذ يقول :
" أغلقوا الباب علي
سيظل بيني وبينه فاصل كلمة
ولن أقولها لأفتحه ".
أ. بنية القصيدة:
المصطلح والدلالة
(تشتق كلمة بنية في اللغات الأوروبية من الأصل اللاتيني (Stuere) الذي يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما، ثم امتد مفهوم الكلمة ليشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعماريّة ) .
وفي التراث العربي النقدي تحدّث النحاة (عن البناء مقابل الإعراب فكأنه الهيكل الثابت لشيء) . وبخاصة عند عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن البنى النحوية. وعند قدامة بن جعفر في قوله : "إن بنية الشعر إنما هي التسجيع والتقفية" . وصحيح انه قصر المفهوم في حدود الإيقاع الموسيقي المباشر إلا أن ما يعنينا هنا، التفاته إلى كلمة بنية. ويمكننا القول بأن البنية (صورة الشيء التي تسمح بفهمه، وإدراك تكوينه، وطريقة تشغيله) ، وتنكشف بالتحليل الداخلي لكل ما؛ والعناصر والعلاقات القائمة بينها، ووضعها والنظام الذي تتخذه) . هذا الكلّ هو البنية التي تُعدّ هيكل الشيء الأساسي أو التصميم الذي أقيم طبقاً له.
ولمّا كان هدف الشاعر في إبداعه (تنظيم تجربته وبالتالي إعادة الاتزان إلى الأنا) ، فإننا نسلّم بما قاله كمال أبو ديب عن كون الشعرية (حركة استقطابيّة، بمعنى أنها فاعلية تُنتزع من سديم التجربة، واللّغة مادة متجانسة تفعل فيها عن طريق تنظيمها، وترتيبها، وتنسيقها حول أقطاب، وتدقيقها حول قطبين يفصلهما، بدورهما ما أسميته مسافة التوتر، هكذا تكون الشعرية التجسـيد الأسمى لخلق الثنائيات الضدية، أحد أوجه الاسـتقطابية الأبرز، وتنسيق العالم حولها
( تجربة، ولغة، ودلالة ، وصوتاً، وإيقاعاً). ودراسة الشعر عبر تاريخه تُظهر أنه:
1. تناول لهذا اللامتجانس . 2. تنظيم له في قطبين يسود كلاً منهما تجانس نسبي ويسودهما، من حيث هما مكونان لبنية واحدة، توتر داخلي حاد ، فالبنية إذن تصوّر تجريدي من خلق الذهن ، وليست خاصية للشيء ، وهي نموذج يقيّمه المحلّل عقلياً ليفهم على ضوءه الشيء المدروس بطريقة أفضل وأوضح، (موجودة في العمل بالقوة لا بالفعل ، والنموذج هو تصورها ، وكلما كان أقرب إليها وأدقّ تمثيلاً لمعالمها كان أنجح ، إذ هي شيء وسيط يقوم في ما وراء الواقع).
أما الشكل فهو على هذا الاعتبار ليس سوى الشكل الناجم عن قوانين الصياغة، مبادئ التكرار والقوالب التي توضع فيها عناصر معيّنة، ويقود التمييز بينه وبين الموضوع إلى طبيعة المادة المزدوجة للأدب وهي اللغة، حيث نجد فيها أولاً جانباً طبيعياً يتصل بالظاهرة الصوتية، وجانباً آخر رمزياً يتمثّل في قدرة هذه المادة على إثارة تصورات ذهنية دلالية.
وما تقسيم سوزان برنار لقصيدة النثر إلى (القصيدة الشكلية أو الدائرة، والقصيدة الإشراقية أو القصيدة (الفوضوية) ، إلا تقسيم يعتمد نتائج قراءة قصيدة نثرية ما على الملتقي، وإن كان يشي حديثها عن قصيدة النثر كـ(وحدة كثيفة، وموضوعاً تتداخل عناصره فيما بينها، وتتحدّ بموجب المنطق الخاص بالقصيدة ) ، بالصراع الذي يجعل من القصيدة تتحرك ضمن قطبين أو محورين يحددان حركتها، ولعلّ هذا ما قصدته في حديثها عن (الحيويّة الخاصة –بقصيدة النثر– الناشئة من اتحاد قوتين متناقضتين: قوة فوضوية، وقوة تنظيمية فنية) ، الأمر الذي يستدعي التمييز بين البنية من ناحية، والأسلوب من ناحية أخرى، فالبنية تتصل بتركيب النص، بينما يمسّ الأسلوب النسيج اللغوي المكتوب به فحسب) .
والتنبّه لعلاقات الحضور والغياب في النص هي علاقات معنى ورمز، فهذا الدال يدل على ذلك المدلول، وهذه الحقيقة تقتضي الأخرى وهي أن الحادثة ترمز لفكرة، وتلك الفكرة توضح نفسية الشخصيات وهكذا. فإن تتبّع التوتّر الحاد الذي يُحدِثُ مسافة الفجوة، والناشئ عن علاقات (الحضور والغياب) في النص، كفيل بالكشف عن المحورين اللذين يتحرّك بهما النص، إذ به تتنامى القصيدة، وتتابع حركتها حول محوريها محقّقة انسجامها، وتوازنها.
وبتوسّل هذه المعايير التي تعتمد (اتجاه ريتشاردز وامسبون في تتبّع المبنى وقدرة القصيدة على القول، وأصحاب هذا الاتجاه يقررون خصائص اللفظة في الشعر، وخصائص الأسلوب الشعري، وأنه تركيبي يؤلّف بين المتباعدات، والمتناقضات، وأن المعاني الشعرية تنشأ من الصراع بين ما هو منطقي، وغير منطقي، وهم يرون الوحدة في القصيدة وحدة عضوية أو وحدة مغزى، وفي أقوال بروكس في هذا الشأن: "إن بناء أحسن القصائد هو بناء (تناقض) لأن مواد القصيدة يقوم بينها التجاذب والمقاومة والصراع، وأحسن بناء ما بلّغ هذه المواد المتنافرة المتصارعة درجة التوازن" . نلج إلى الحديث في البنية عند الشاعر أنسي الحاج.
البنية عند أنسي الحاج:
انطلاقا مما سبق فقد كشف تحليل حاتم الصكر لقصائد أنسي الحاج عن بنية قصيدة (فتاة فراشة فتاة) . والمتمثّلة في التنازع ما بين قطبي الصحو والحلم أو ما أسماه بالحلم والواقع . في الوقت الذي لم يعلن فيه عن بنية قصيدة (خطة) ، والتي تناولها بالبحث في كتابه (ما لا تؤديه الصفة) ، وإن أشار إلى الضديّة والثنائية بين قطبيّ الرؤية والاختفاء في حديثه عن الحرب بين صراخها، وضراعته، ودعوتها، واختفائه، فالخوف يمنعه من إظهار نفسه خشية أن يظهر فتراه فتهرب.
وبالإستعانة بالمنهج النقدي التطبيقي الذي يستضيء به كمال أبو ديب في معالجته للنصوص الأدبية، ضمن مفاهيم (الفجوة: مسافة التوتّر) والحضور والغياب في جدلية تلتحم بها بنية النص، فإننا نقترب من نصوص أنسي الحاج لنتماس مع بنيته فنضيئها في معالجة نقدية لثلاثة من نصوصه. أولها بعنوان (لو كنت مكاني)، يقول:
" لو كنت مكاني
يتكلّمون يتكلّمون
ويتكلّمون
يسكتون يسكتون
أوّاه ! أرجوكم ! تكلّموا ...
كلامهم كان يجب أن يريح
ولا يريح
سكوتهم كان إذا يجب أن يريح
ولا يريح!
وتفترض أن بين كلامهم وسكوتهم
استراحة
تُريح حقاً،
تتوقّف لتكتشف
أن هذا الملجأ هو أيضاً
مقصوف بكلامك أنت الذي لا جواب عنه
وبسكوتك أنت الذي لا سؤال عنه !
لو كنت مكاني
لعرفت أن تتصرّف كي تتخلّص
وهو هذا ما يقهرني
فأنا كنت أريد
وأنا أنا
أن أكون أنت !....."
تتشكّل بنية النص في إطار تأكيد المفارقة الضديّة الجذرية بين الأمنية الحقيقية، فالأمنية: (الكذب لأن الكاذب يقدّر في نفسه الحديث) ، والمفارقة تنبع من كون الأمنية لا تُحدّد إلا من خلال الواقع، وتتجسّد هذه المفارقة في رؤية المتحدّث الذي حين يتكلّمون يتمنّى لو يسكتون، وحين يسكتون يتمنّى أن يتكلّمون، والكلام الذي كان يجب أن يريح جاء نقيض الأمنية فلم يُرح، والسكوت الذي كان يجب أن يرح لم يُرح، وكلامه الذي ضده صمتهم إذ لا جواب منهم على كلامه، وصمته الذي ضده الكلام.
هذه الثنائيات تتبلور في صورة فعلية حادة في قوله استراحة التي لا تجسّد ثنائية ضديّة واحدة فلا تولّد توتراً بضديتها لكلمة ثانية بل هي تحمل توتّرها بنقيضها الذي تُحيل إليه ألا وهو التعب، والتوتّر الناجم من ضدية المكان الذي هو فيه مقابل المكان الذي الآخر فيه والذي لا يكون هو فيه، وما يقهره عجزه عن التصرّف مقابل الآخر الذي يتقن التصرّف في مثل هذا الموقف، والتوتّر في مقارنته بين الذات والآخر، فالنص إذاً يستقي بنيته من كثافة الثنائيات الضديّة، ومن مسافات التوتّر التي يخلقها في العبارة نفسها من جهة، وفي لغة التضاد الموّلدة بين العبارة ونفيها من جهة ثانية.
وتبرز مسافة التوتّر في المقطع الأول بتكراره المأزوم لكلمة يتكلّمون وكان من الممكن أن يستمر هذا الكلام المنسجم عن كلامهم لولا الفجوة التي أحدثها بقوله: حبذا لو يصمتون !.
وفي توازٍ دلالي وتركيبي مع المقطع الثاني إذ الكلام يقابل الصمت وبنفس العدد المتكرّر
ثلاث مرات، وحبّذا في الجملة الأولى التي تقابل الرجاء في الجملة الثانية، ليأتي المقطع الثالث بعد بياض يفصل المقطعين، وفيه ينفجر التوتّر في العبارة الواحدة التي تسير في جملتها منسجمة ثم يقطعها التوتّر بنفيها، وإذ تتوازى مفردة (كلامهم) مع (سكوتهم).
وجملة (كان يجب) مع (كان إذن يجب)، وقوله (يريح) و(لا يريح) توتّر بنفي الإنسجام الأول بضده في الثاني، وقوله (ملجأ)، والملجـأ فيه الأمن والحماية، ولكن التوتّر يتصاعد في كون الملجأ مقصوفاً. ويتابع النص عبر علاقات التوازي التي تكشف عن النظام، وتماسك داخلي مستمد من إيقاعات التوازي هذه، التي يكتسبها النص بتوازياته المنسجمة أو اللامنسجمة والتي نجدها في:
- التجانس والتنامي على الصعيد الدلالي متحقّق بتكرار الكلمات.
- اللاتجانس على الصعيد الدلالي بذكر الكلمة ونفيها.
وفي نهاية النص تتغيّر الحركة جذرياً، فالأمنية المرجوة عبر ثنائيات الضديّة، تتحوّل إلى وحدانية البعد أي من ترابط العلاقات إلى انتفاء الترابط، ويبدأ هذا الإنفصام بصيغة (لو) التي تمثّل أمنية بفعل آخر غير ما هو عليه الواقع، والتي تشكّل نسقاً في حركة ثلاثية مستمدة من الفعل (كنتَ ، كنتُ ، أكون).
فيشرق العنوان في ضوء ما سبق (لو كنت مكاني) فالأمنية التي يخدع بها نفسه يحقق توازنها في مقابل الواقع الذي يعجز عن التعامل معه بلغته التي هي لغتهم المضادة للغته، وبعيداً عن المبالغات تحرّك النص معتمداً على منطقه، وخالقاً توتره في بنية استقامت، وحقّقت له التوازن في جدل الأمنية والحقيقة.
القصيدة الثانية التي سنتناولها بالدرس تحمل عنوان (السقوط) يقول:
"السقوط
- أنا من يسقط
من حافة عينيك
- حملوني إلى السهول
وسقطت من حافة عينيك
- أخذوني إلى النوم
وسقطت من حافة عينيك
- رفعوني كسبع الطير وسندوني
وسقطت من حافة عينيك
- أمسكوني وأغمضوا عينيّ
وأبعدوني ،
- فرحتُ إلى الأبد من حافة عينيك
اسقط إلى اللقاء"
التوتّر في هذا النص تخلقه الضديّة بين اللإرتفاع والهبوط، العلو والأرض فالسقوط من علوٍ حافة عينيها، وعلى المجاز لعينيها حافة يسقط منها، وهو مستمر في مثل هذا السقوط مولّداً توتره. حملوني بعد السقوط من حافة عينيك إلى السهول ولكنه تابع السقوط. ويسير النص في لغة متجانسة تؤخر انفجارها الغامر، الذي يبدأ بالتململ معلناً تحولّه إلى هدير، إذ فجأة تخرج القصيدة من سياق النص الذي يقطعه فقط حديثه عن حافة عينيها التي يسقط منها. في مقابل انسجام اللغة المتجانس في حديثه عمّا يفعلونه به فقد حملوه إلى السهول، وأخذوه إلى النوم، ورفعوه كسبع الطير، وسندوه، وأمسكوه وأغمضوا عينيه وأبعدوه كلّ هذا لئلا ينتحر واقعاً من حافة عينيها. فينفجر التوتّر في آخر القصيدة، ليدفق مكونها الشعري بتحولّها عن اللغة المتجانسة إلى لغة لامتجانسة حولّت سقوطه إلى لقاء، واستبعاده عنها تحوّل إلى عنصر مشاركة بفاعلية تمتـد إلى الأبد، وعلاقة التضـاد هنا ضـمنية تتأسـس ضمن علاقة نفيه لذاته عنها ومسـاندة
الآخرين له في ذلك، فتتعمّق الفجوة، وتتفاقم مسافة التوتّر الذي ينفرج فتتلاشى الفجوة ويتحقق التوازن له بالإلتقاء بها، ومواصلته السقوط.
والنص يتحرّك بين قطبيّ النفي والإتحاد، فعلاقة ذاته بالآخرين علاقة نفي واستلاب، أما علاقته بالمحبوبة فعلاقة توحّد. وإنها ثنائية الفراق واللقاء، فراقه عنها هو لقاء بهم، ولقاؤه بهم فراق عنها، والجدل يتحقق بالتقائه الأبدي بها، والذي به يتغذّى لقاؤه بهم، فيرفد الأول ويعمّقه. هذا الذي يحقق الإنسجام في المبنى ويشكّل وحدته.
يقول في قصيدة بعنوان (تعريف):
" كان الفجر روح الليل
والعمر سهماً مسمومًا
ولمّا انقشع الجبين وتطهّر السهم
تحطّمت الدنيا
وران الهدوء أياماً
وعاد الجحيم
بلا فجر ولا مساء بل بدوام ذاته المتعاظمة
وبلا قوس ولا سهم
بل بعينيّ تحدقان في الرعب تحديق ولد عجوز.
وبين الدهر والدهر
كانت تقطع عليّ اشتعال رأسي
نشوة أمجدها ولا أملكها
وهربٌ سائر على قدري.
الحب زهرة الشفقة
السماء سقف السجن
ولكن لا شيء يخنقني
لن غرفتي بلا جدار
ومعلّقة بين الأرض والسماء
الجمال مفقدي جمالي
والشعر التام نسيان الشعر
ولكن لا شيء يوقفني
لأن غرفتي المعلّقة
مطوقة بأمواج الأحلام
تعلو في هدوء حتمي
تعلو بلا رحمة
تعلو حتى النهاية.
أقوم
ولا أنادي
أنزل بين النور والظلام
وقد تعانقت في صدري الحياة وأشباحها.
ومن رأسي إلى رأسي
أرتمي
ولا تعرفني بعد اليوم عيناي."
النص يولّد توتره ابتداءً من الجملة الأولى (كان الفجر روح الليل) فالنور والظلام ما بين
الفجر والليل، والروح التي تطلع من الجسد فيموت. يطلع الفجر الذي هو روح الليل؛ فيموت الليل.
والعمر سهماً مسموماً، واو العطف على جملة (كان) تجعلها وكان العمر سهماً مسموماً، والعمر: الفترة التي يعيشها المرء منذ الولادة إلى الموت، هذا العمر سهم مسمومُ يُصوّب على حامله فالحياة حرب، فيها أقواس تطلقها يد القدر كأعمار مسمومة في أجساد الناس.
والضديّة بين العالم العلوي الذي يطلع فيه الفجر فيموت الليل، العالم السفلي الذي تُصوّب سهام القدر المسمومة على أحيائه مانحة إياهم حياة قصيرة مسمومة فالثنائية بين العالم العلوي والسفلي، الأرض والسماء. والذي (لمّا انقشع)، وانقشع هنا تستخدم للضباب أو الغباش في الرؤية، والجبين هو مقدّمة الشيء وأعلاه، فلمّا (انقشع الجبين)، فكأن غباشاً كان يحجب الرؤية، لما انقشع وتطهّر السهم من سمّه بأن نفثه في الجسم الحيّ، تحطّمت الدنيا، فانتهت حياته. كما انتهت حياة الليل فمات. إذن هي النقلة من عالم الحياة إلى ما بعد الحياة، من موت الحياة إلى البعث.
و(ران الهدوء أياماً)، الفعل (ران) يحيل إلى قوله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم)• وران بمعنى غطى وطمس. والهدوء بعد ضجيج التحطّم استمرّ أياماً تذكرنا بأيام الخلق الستّة التي استوى بعدها الخالق على العرش. والنص يتألف من ستة مقاطع تُعادل أيام الخلق الستة. مسافة التوتّر بين الهدوء والضجيج وأيام الخلق ومقاطع النص، و(ران) الذي هو طمس لوضوح الرؤية وتغطية لملامحها، ليتبعها قوله (وعاد الجحيم)، إنه جحيم ما بعد الموت، (بلا فجر ولا مساء بل بدوام ذاته المتعاظمة التوتّر ما بين الوقت الدنيوي، الوقت في العالم السفلي، والوقت العلوي ما بعد الموت، البعث؛ فالوقت أزلي وبلا ملامح تُقسّمه إلى فجر ومساء.
و(بلا قوس ولا سهم)، التوتّر بين العمر المحدود في الدنيا المحدود والعمر الذي بعد الموت
حيث لا قدر يقذف بسهامه المانحة للحياة .
(بل بعيني) إحالة على قوله تعالى (فبصرك اليوم حديد)• لهول ما يشهد، ويرى. والتوتر ما بين ولد وعجوز حوله الهول إلى عجوز يحدّق، والجسم الذي صار عيونا من شدة الفزع.
و(بين الدهر والدهر) توتر بين زمن الحياة وزمن البعث بعد الموت، بين هذين الدهرين، دهر ما قبل الخلق، ودهر البعث، نشوة تقطع اشتعال رأسه قال تعالى (واشتعل الرأس شيبا)•• توظيف لمفردة اشتعل التي جاءت في القرآن الكريم بلطف المعنى الذي ترسمه الصورة في إعجاز فذّ. والتوتّر في هذا المقطع بين تمجيده للنشوة وحرمانه من امتلاكها، ومحاولته الهرب في مقابل القدر الذي لا مهرب منه. إنه الحب الذي هو إشفاق على العالم، والسماء هي الحرية في مقابل الأرض التي هي سجن سقفه السماء. (ولكن لا شيء يخنقني)، فعل إرادة ذاتي ضد القدر، والسبب أن غرفته بلا جدار، "الفجوة مسافة التوتّر" في مفهوم الغرفة التي لها جدران في تصوّرنا، بينما غرفته بلا جدران، وهي غرفة معلّقة، فلا هي في الأرض، و لا هي في السماء. والجمال يفقده جماله، إذ رغبته في تملّك الجمال بحسب المقاييس الأرضيّة تفقده جماله بحسب مقاييس السماء التي تخبطه خبط عشواء في صراعٍ حاد، فلا هو يصل الى الأرض ويقرّ فيها وفق معاييرها، ولا هو في السماء لينجو. و(الشعر التام نسيان الشعر)، التوتّر بين مفهوم الشعر من حيث هو حفظ، مقابل الشعر عنده الذي هو نسيان الشعر. و(لكن لا شيء يوقفني)، مجدّداً فعل الإرادة في مقابل القدر، لأن غرفته معلّقة ما بين السماء والأرض، بين الأعلى والأسفل، بين النور والظلام. يطوقها أمواج، والموج يغمر ولا يطوّق، لكن الموج هنا يخلق (فجوة: مسافة توتّر) ظاهر ويطوّق غرفته، فيحميها بطوقه لا بغمره إياها.
هذه الغرفة التي تعلو لتخرج على مفاهيم الأرض الدنيوية معاً، تعلو في هدوء حتمي بثقة والغرفة لا تعلو إذ يفترض أنها ثابتة في الأرض بفعل الجاذبية لكن غرفته تعلو، بلا رحمة، غير
محتاجة للرحمة، تعلو حتى النهاية، التي تخلصها من سجن الأرض، وتبلّغها السماء. عندها (يقوم)، فعل إرادة يُذكر بالقيام من الأجداث والبعث، ولكنه يبعث ولا ينادي صاحبته وولده وبنيه ولا من كان يعبد، مُحيلاً إلى قوله تعالى (نادوا شركائكم الذين زعمتم)•، فينزل بين النور والظلام، وما بعد الحياة من أشباح، والحياة مكشوفة له، متعانقة في صدره، ومن رأسه إلى رأسه، من رأسه في الدنيا، إلى رأسه فيما بعدها، يرتمي والارتماء نقيض القيام، يرتمي وهو المنهك، المتعب، يرتمي في مكانه. إنها ثنائية الارتماء في مقابل القيام في جدلية تحقّق التوازن والانسجام ضمن بنية النص الكليّة القائمة على قطبي الفعل/ القدر؛ فالارتماء تحت وطأة التصوّرات الأيديولوجية، والوقائع الدنيوية بما تحمل من مفاهيم جماعية، عُرفية، ودينية يقاومها بالقيام كفعل إرادة يواجه به القدر. فيضيء الداخل بهذه الطريقة العنوان الذي هو (تعريف) به، وبطريقته في مواجهة الحياة، والناس، في ضدية الأنا /الآخر، الأنا بما تمليه عليه من إدراك لتنازع الضوء والعتم في ذاته، والآخر الذي يرفض هذا التنازع فيُخطئه، ويجرّمه، ويَعدِه بالجحيم، الآخر بمفاهيمه عن الدنيا والآخرة، وهو بما هو صراع بين الملائكة والشيطان، لا يتحقّق له التوازن إلاّ بفعل الإرادة الذاتي الذي يتحدى قدريّة الآخر، ويعلن ارتمائه بين النور والظلام، مُعلقاً ومجهولاً لا تعرفه ذاته بعد اليوم.
وبإتباع مفهوم (الفجوة: مساقة التوتّر) أضاء النص عتمته عبر المخطط التالي:
| الرقم | المقطع | إحالات وتكثيف | (الفجوة: مسافة التوتر) | الثنائية |
| 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. | كان الفجر روح الليل
والعمر سهماً مسموماً
ولمّا انقشع الجبين وتطهّر السهم تحطمّت الدنيا
ران الهدوء أياماً وعاد الجحيم بلا فجر ولا مساء بل بدوام ذاته المتعاظمة
وبلا قوس ولا سهم بل بعينيّ تحدّقان في الرعب تحديق ولد عجوز
وبين الدهر والدهر كانت تقطع اشتعال رأسي.
قوّة أمجدها ولا أملكها وهرب سائر على قدري
الحب زهرة الشفقة
السماء سقف السجن ولكن لا شيء يخنقني لأن غرفتي بلا جدار
معلّقة بين الأرض والسماء الجمال مفقدي جمال والشعر التام نسيان الشعر ولكن لا شيء يوقفني
لأن غرفتي معلّقة مطوّقة بموج الأحلام تعلو في هدوء حتمي
تعلو بلا رحمة تعلو حتى النهاية
أقوم ولا أنادي أنزل بين النور والظلام
وقد تعانقت في صدري الحياة وأشباحها
ومن رأسي الى رأسي
أرتمي
ولا تعرفني بعد اليوم عيناي | قانون الأرض انبلاج الفجر بعد الليل.
القدر يوجّه سهامه المسمومة واهباً عمر الحياة.
زال الغباش وانكشفت الحقيقة القدرية، والموت، تطهّر السهم من سُمه. (كلا بل ران على قلوبهم)، أيام الخلق الستة، والسابع استوى فيه سبحانه على العرش.
والقصيدة تتألف من ستة مقاطع.
بالاستواء على العرش عاد جحيم الحياة، وهو الجحيم بعد البعث، جحيم دانتي جحيم الجزاء.
الوقت أزلي. لا قدر ولا عمر محدود فيما بعد الموت. (فبصرك اليوم حديد) الرعب والفزع اللذين (يشيب لهما الولدان).
بين دهر ما قبل الحياة ودهر ما بعد الحياة أي في الحياة.
(واشتعل الرأس شيباً). الهروب من حتمية القدر. الحب إشفاق على العالم. فعل إرادة ضد كلّ ما يقف في وجهه، فعل ذات متمحورة حول مركزها.
فعل الإرادة مقابل القدر الذي يجعل الإنسان معذباً، شقياً.
حقيقته، غرفته معلقة كجوهرة المعلّق بين الأعلى والأسفل. ثقة بعلو غرفته وارتفاعها صوب قانون السماء.
تعلو متمرّدة على شرائع الرحمة النهاية الخاتمة.
إحالة إلى حالة القيام من الأجداث والبعث.
تمرّد على فعل المناداة فيما بعد الموت طمعاً في التوبة والغفران. مكان الإنسان. هُضمتُ في حميمية وعناق الحياة وما بعد الحياة. صراعه الذي يدور في رأسه. يسقط منهكاً، متعباً، فيرتمي.
المعرفة تمييز، والعيون من وسائطها، والذات تعرف جسمها بالحواس، التي أهمها العين. | التوتر بين النور والظلام. التوتّر بين العمر الذي هو الحياة والقتل الذي هو الموت.
انكشاف الحقيقة مقابل الموت وتحققها به. واجهة الدنيا الخادعة، تحطّمت.
الهدوء تصاحبه رؤية صافية والتوتّر هنا في الهدوء الذي طمس وغطّى على الرؤية. التوتّر بين الوقت بمفهومه الدنيوي، والوقت الأزلي ما بعد البعث.
العمر الدنيوي القدر فيه يحدد مكان وزمان الولادة ومدّة العمر. التوتّر ينشأ عن تناقضه مع مفهوم الحياة الأزلية بعد البعث.
التوتّر بين الولد والعجوز، وبين الجسم وأعضائه التي صارت عينان تحدّقان لهول المشهد. الاشتعال لا يقطع فالتوتّر على مستوى الصورة هنا.
التوتّر بين تمجيد القوة وحرمانه من امتلاكها، فلا هو يمتلكها ولا هو يتركها.
القدر لا مفر منه وهو يُصرّ على الهرب منه. السماء الحريّة والأرض السجن، وسقفها السماء.
السماء الأعلى والأرض الأسفل الغرف أربعة جدران وغرفته بلا جدار.
التعلّق لا هي هنا ولا هي هنا، وكأنها في الهواء. فلا تنتمي للأرض الأسفل، ولا تنتمي إلى السماء الأعلى.
الصراع بين الجمال الذي تملكه يفقده جماله الخاص، إذ تملّكه قانون أرضي، وعدم تملكه قانون سماوي علوي. وصراعه بينها، بين ما هي الأشياء عليه في الأرض وما هي عليه في السماء، وهو البشر، لا هو بالملاك ولا بالشيطان معلّق بينهما.
الشعر حفظ (والفجوة: مسافة التوتّر) عنده في كون الشعر نسياناً. الطوق للحصار والموج مدى والتوتّر ينجم عن تطويق الموج لغرفته والحلم ضد الواقع. التوتّر في العلو الذي هو ارتفاع ووعد بالجنة والنهاية التي هي تمزّق وانفجار في فراغ.
البعث بعد الموت النداء استغاثة واستجارة واللانداء استغناء وتمرّد ورفض لطلب العون.
النور ضد الظلام العناق للحبيب والتوتّر بين العناق الذي هو حسّ مادي والأشباح التي لا تُحس.
الإرتماء توتر مع القيام. إنكار عينه له، توتّر بين المعرفة والنكران. | الحياة/ الموت البعث/ الموت الأعلى/ الأسفل الملاك/ الشيطان الفعل/ القدر الأعلى/ الأسفل الطوق/ الحرية بعث/ موت النور/ الظلام الفعل/ القدر |
هذا التحليل للنص في ضوء مفهوم (الفجوة: مسافة التوتر)، يكشف عن صراع الذات في مواجهة القدر، عن فعل الذات ضد جَبَر القدر، وكثافة الثنائيات الضديّة، خالق لمسافات توتّر تولّدها هذه الكثافة، والتي انبنى النص في مدّ وجزر بين الذات الفعل/القدر الجبر، في ضوئها.
أ. البنية الإيقاعية:
البنية الإيقاعية مرتبطة بالبنية أساساً، والإيقاع مفهوم واضح جداً حينما يُطبق على الموسيقى، ولكنه يصبح مفهوماً غامضاً حينما نطبّقه على الشعر، وعلى النثر خاصة. فما هو الإيقاع ؟
الإيقاع المصطلح والدلالة:
الحسن بن أحمد بن علي الكاتب في كتابه (كمال أدب الغناء) يُعرّف الإيقاع على أنه:
"قسمة الزمان الصوتي، أعني مدّة الصوت المنغّم بنقرات، إما كثيرة، وإما قليلة، وكلّما خفّت النقرات كثر عددها في الزمان الأطول" ، وفي تعريفه حديث عن الإيقاع بمفهوم المَوسَقة المرتبط بالموسيقى الذي ظلّت الثقافة العربية الشعرية مرتهنة به، فقننّت علم العروض وفق معطيات صوتيّة مشتقة من رواية الشعر، وإنشاده مراعية (المدد الزمنية، والأعداد المتساوية في الحركات، السكنات مما يُعبر عنه لفظ الوزن تعبيراً دقيقاً) ، مما جعل لفظة الإيقاع رهينة البعد الخارجي، أو الصوتي فقط. والإيقاع في حقيقته أبعد من ذلك من حيث هو التنبه والرصد للمتغاير، والمتضاد، المتنافر الذي يشذّ خالقاً مسافة التوتّر، والفجوة بتعبير كمال أبو ديب، المولّدة من (الانحراف الدلالي، أو التصويري، أو التركيبي) ؛ فالإيقاع (تواتر متتابع بين حالتي الصوت، والصمت، أو النور والظلام، أو الحركة والسكون، أو القوة والضعف أو اللين، أو القصر والطول أو الإسراع والإبطاء ....... فهو يمثّل العلاقة بين الجزء وكلّ الأجزاء الأخرى للأثر الفني أو الأدبي.)
وبذلك يتسع مفهوم البنية الإيقاعية ليشمل مختلف أنواع الاستجابات المنتظمة، دون أن يقتصر على الجانب الصوتي، الأمر الذي يخصّب البنية الإيقاعية بالمداخلة بينها وبين مستويات إيقاعيّة أخرى، أكثر اتصالاً ببنى النص الأخرى، كاللغة، والصورة، والرمز، والبناء العام، فتنمحي المسافة بين داخل النص وخارجه، أو بين شكله ومضمونه، فيمكن بذلك (الكشف عن عدد كبير من المستويات الإيقاعيّة المستترة، منها ما له طابع صوتي يتصل ببنية الإيقاع الخارجي صاعداً أو هابطاً منها، شاداً الصلة الجدليّة بين البنيتين، مثل إيقاع الحرف ومجموعاتها الصوتية فيما يسمّى بالرجع الصوتي أو الترجيع، وإيقاع حركات المدّ الداخليّة المتصلة بنظام التقنية في النص، ومنه ما له غير الطابع الصوتي، والمتصل ببنية اللغة في مستوييها الداخلي (كاللغة الشعرية، والصورة، والرمز ... الخ) ، لينشأ بذلك الإنتظام الذي يعني ضمنياً نشوء تمايز بين عناصر مكوّنة للكتابة ثم استغلال هذا التمايز لتوزيع العناصر في بنية يتشابك فيها التمايز باللاتمايز، بروز الظاهرة واختفاؤها، بصورة تؤدي إلى خلق نسق أو أنساق معينة توفّر هذا الشرط الذي أسميته الإنتظام) .
وبذلك يمكننا إنجاز عناصر تقرّب مفهوم الإيقاع من حيث هو بنية بقولنا:
- البنية الإيقاعية تعني انتظاماً معيّناً محسوساً أو مدركاً.
- لهذه البنية مستويان: مستتر وظاهر تربط بينهما علاقة جدل.
- المستوى المستتر، إن وجد، أكبر أثراً ولربما أشدّ تعقيداً من الظاهر نظراً لتشكّله في الخفاء، أي في لاوعي الفنان والمتلقي كليهما.
- ترتبط البنية الإيقاعية في مستوييها المستتر والظاهر بالبنية الكلية المحيطة، وبخاصة البنية اللغوية في مجاليها اللفظي والإيحائي.
- تتمثّل وظيفة بنية الإيقاع أساساً في تنظيم وظائف المخّ (بمعناها الواسع المتعدّد) لدى كل من الفنان، والمتلقي، بما يجعلهما في حالة شعورية واحدة، تكشف لها معاً عن واقع جديد على المستوى الخاص أو العام)، لم يكن من السهل اكتشافه لولا انتظام عناصره المبعثرة في سياق تلك البنية الإيقاعية.
- في النص الشعري يشكّل الإيقاع الصوتي (تجربة الأذن) المستوى الرئيس البارز غالباً، ولكنه ليس الوحيد دائماً، ولا الأهم بالضرورة.
- إن الإيقاع نفسه قد تتدرّج بنيته الصوتية في عدد من المستويات الإيقاعية تمتد بين الخارج/ الظاهر، والداخل/الخفي. مما يسمح له بالامتداد عميقاً في مجمل البنية الإيقاعية للنص (أي التشابك مع مختلف إيقاعات الحواس الأخرى) من جهة، وبمختلف البنى الرئيسية والجزئية من جهة ثانية) .
ومعالجة النصوص معالجة نقديّة تفيد من الأسس والعناصر السابقة، كفيل بتوضيح المفهوم، وتحقيق التطبيق له عند الشاعر أنسي الحاج الذي يقول في قصيدته (خطة) :
- كنت تصرخين بين الصنوبرات، يحمل السكون رياح صوتك إلى أحشائي.
- كنت مستتراً خلف الصنوبرات أتلقى صراخك وأتضرّع كي لا تريني.
- كنت تصرخين بين الصنوبرات: تعال يا حبيبي!
- كنتُ أختبئ خلف الصنوبرات لئلا تريني، فأجيء إليك، فتهربي.
هذه القصيدة تمثّل صلة الجزء بالجزء، والجزء بكليّة النص. والإيقاع الناجم عن تكرار (كنتُ) بضمير المتكلّم و (كنتِ) بضمير المخاطبة إيقاع متوازٍ، يمكن أن يشكّل ما يشبه الدورة الزمنية التي تصنع انتظاماً من تكرار التفعيلات، أما التوازي الكلّي فيتحقق بين المتكلّم والمخاطبة وبترتيب الجملتين بعد حذف المتكررات جملة المخاطبة وجملة المتكلّم نحصل على التركيب التالي:
- كنت تصرخين بين الصنوبرات، يحمل السكون رياح صوتك إلى أحشائي: تعال يا حبيبي!
- كنتُ مستتراً خلف الصنوبرات، أختبئ، أتلقى صراخك وأتضرّع كي لا تريني، فأجيء إليكِ؛ فتهربي.
وهنا نكتشف إيقاعاً ناتجاً عن التوازي في الدلالة والتركيب في آن معاً . فجملة تقابل جملة المرأة، وموقعه خلف الصنوبرات يقابل موقعها بين الصنوبرات، وصراخها يقابل ضراعته (الصلاة الهامسة) لئلا تراه، فيحدث ما يتوقع. هذا التوتّر بين صراخها وضراعته، ودعوتها واختفائه، تهرب إذ يجيء الذي يؤكده انتظام داخلي يحكم النص عبر توالي أجزاء الحدث، الذي يضبطه قطبيّ الوَحَدَة والنزوع للإلتقاء بالآخر، الوَحَدة واللقاء. وبعيداً عن الإنشاء والمبالغات أقام الشاعر نصه، وبنيته الإيقاعية مستنداً إلى :
- التكرار أو الإعادة: وفيه يكرّر الشاعر فكرته بألفاظ متنوعّة، أو بالألفاظ نفسها. كنتِ وكنتُ ، الصنوبرات، تصرخين، مختبئاً ومستتراً.
- إيقاع التعاقب أو النمو المتتالي: فالجملة الشّعريّة مؤلفة من أجزاء صغرى يؤدي أحدها إلى الآخر، وصولاّ إلى النهاية، والإيقاع ذو ميزة نثرية سرديّة يقترب من القصّ، بنبرة هادئة منسجمة متسلسلة. إذ يصوّر الحدث ما يحصل بينهما في رقعة مكانية ثابتة، ينمو الحدث بعد صراخها، وضراعته، ومناداتها تعال، واختباءه لئلا تراه، ولئلا يجيء، ولئلا تهرب. والحدث لم يتحقق، بل هو ما يحدث عادة، أن تراه، فيجيء فتهرب، وهو ما سيحدث لا ما حدث.
- الإيقاع الترابطي القائم على التضاد والتناقض الصراخ/ الضراعة، بين/ خلف، مكانها واضح وهو مستتر ضمن ثنائية اللقاء/ الفراق.
ويقول أنسي في قصيدة (لنذهب ) :
" قبل أن يمر حصان يرفس الطاولة.
قبل أن يقوم البشر ويسحب القطن من آذاننا.
قبل أن تعود الحياة والموت والحياة".
والعنوان في القصيدة جزء عضوي منها يدخل في بداية الثلاث.
"لنذهب قبل أن يمر حصان يرفس الطاولة.
لنذهب قبل أن يقوم البشر ويسحب القطن من آذاننا.
لنذهب قبل أن تعود الحياة والموت والحياة".
واللغة هنا في مستواها التركيبي لغة منسجمـة، ويتتابع فيها فعل الأمر بالذهاب، إلى أن تحدث الفجوة في الجملة الأخيـرة، قبل أن تعود الحياة والموت والحياة.
وتكرار التوازي يخلق إيقاعاً على المستوى الصوتي، والمستوى الدلالي يشحن شعرياًّ بالأفعال: "يمر"، "يقوم"، "تعود"، "يرفس"، "يسحب"، المتوازية في القصيـدة، فالنص قائم على وعي الشاعر على التناقض بين وجهي الزمـان: الأبـدي السـاكن المغلق كالدائرة، والتاريخـي المتحرّك الممتـد كالخـطّ، فالحـركـة، ما هي إلا حيرة النقطـة بين أن تكون خطاً مستقيماً، ومنحنياً دائرياً في الوقـت نفسـه، وفي هذه الحيرة بالذات يتقاطع الزمان والمكان في صراع خفي بينهما، وإنه ليقسّم حركـة الزمان اللامتناهية بهدف إخضاعها إلى حيّز المكان المحدود، في جدل بين السكون والحركـة، إخضاع الحركـة للسكون. في ثنائية هي السكـون/ الحركــة، والتوتر في "لنذهب" الأمر بالتحرك إلى مكان آخـر، و"قبل أن" ربطٌ للزمان بالمكان الذي يأمر بالذهاب إليه، "قبل أن يمرّ حصان يرفس الطاولـة"، لغة منسجمة تتحرّك وفق المحور الأفقي أو التعاقبي للغـة، وفيها فعل حركـة مرور الحصان، ورفسه الطاولـة. "قبل أن مجدّداً يقوم البشـر" فعل حركـة، و"يُسحب القطن من آذاننا"، ارتداد نحو الحواسّ وحسّهـا الماديّ المرتبط بالزمن المتحرك في مواجهـة الزمن الساكـن، قبل أن تعود الحياة التي هي حركـة الزمن، والموت الذي هو إيقاف لهذه الحركـة، والحياة التي هي بعث وتجديد لفاعلية الزمن، ومن مسافة التـوتـّر هذه، من ثنائية الحركـة والسكون تنامـى الإيقاع لا من اللغـة ولا من التصوير، بل من التوازي المقطعي، ومن الضديـّة الثنائية بين الحركـة والسكـون.
وفي نموذج آخر نتعرّف حركـة الإيقاع في قصيدته "باقٍ" يقــول:
باقٍ
"باقٍ ..
أسأت وداعك وما حَمـَلـْتُ دمعـَكِ.
أقلعـتْ عربةُ القـار والصّفـيح وما هتفتُ لـكِ.
تسمـّرتُ أُسلمنا إلى جحيمنـا.
باقٍ .
تذهبين . تمديـن يديك وتبكـين.
تعتمين، ذبيحـة كاملـة.
طاهرةً تمضين في اندفاعـة حبـّك
وأنـا، منذ أوّل دورٍ لي، أنحتُ ذكريات ! "
الإيقاع في هذه القصيـدة مستمـد من التكرار لفاتحـة المقطعـين في قولـه "باقٍ"، والحديـث في المقطـع الأول عنـه بصيغـة المتكلّم والحديـث في المقطـع الثانـي عنها بصيغـة المخاطبـة، والأفعال التي تـبقـي الحدث حيّاً وحيويـاًّ، وتكرار التوازي في قولـه: "أسأت، وما حلمـت" المتوازيـة نحويـاًّ مع قولـه: "أقلعـت، وما هتفـتُ". والمستوى الصـوتي المتحقق إيقاعـه في تكرار تذهبين، تمدّيـن، تبكيـن، تصمتيـن، تمضيـن، أمـا التـوتّر الذي يكشف حركـة الإيقاع وبنيـة النـّص، فقائم بين "باقٍ" والأفعال التي تؤكـد موقفه السلبـي من الفراق، "أسأت وداعـك"، "ومـا حملـتُ دمعـك" ، ... "تسمـّرتُ"، وأيضاً التـوتّـر في "باقٍ" و "تذهبيـن" من حيـث هي لقاء وفراق معـاً.
واللغـة في مقطعـيّ القصيدة الأول والثاني منسجمـة، والأفعال متوافقـة في تسلسلها الزمنـيّ. والفجوة تتحقق بيـن "باقٍ" و "أنحتُ ذكريات"، في ثنائية اللقاء والفراق، البقاء والفراق ووفق بنيتها يتشكـّل إيقاع النـص، الذي ولّدته لغـة منسجمـة، تؤجـل انفجارها، ليأتي التوازي المقطـعي، والدلالي، ويحقـّق مع "الفجوة: مسافـة التـّوتـّر" بنية النـص الإيقاعـيّة، ومن الواضح ارتباط البنية بالبنية الإيقاعـيّة، وارتهان كلّ منها بالأخـرى، إذ لم يـعد النصّ حدوداً بمقدورنا فصل أجزائها عن بعضها البعـض، بَـل هـو كيان عضوي اعتباري، يرتهن كل جزء فيه بالآخـر.
جـ. الأسلوب :
تـتبّع نتاج الشـاعر أُنـسي الحاج يكشف عن أساليب يعتمدها في كتابة النّـص، لينقل بها حركـة أعماقـه، ويبني بها معمـار قصيدته ومنهـا:
1. أسلوب القراءة البصـريّة :
ويعتمد هذا الأسلوب فعـل القراءة البصـريـّة ، الذي يمنح القصيـدة، اكتمالها، وعضويتهـا، فللبياض هنا دلالـة هامّـة، والمساحات المتروكـة في متن النص علائم تقتضـي تتبعهـا، والتنبؤ بهـا، وكأنهـا متروكـة ليكمل القارئ فراغهـا، ويصل بها أجزاء النص بعضها ببعض. يقول أنسي في قصيدة "هويّة" أولى قصائده في "لن":
" هويــّة
- أخـاف
-
-
-
- الصخـر الذي لا يضغط صندوقي، وتنتشر نظّارتاي.
- ابتسم، اركـع، لكن مواعـد السّـر تلتقـي والخطوات
- تشـع، ويدخل معطـف ! كلها في العنق. في العنـق
- آذانٌ وسرقَـة.
-
-
- أبحـث عنـك أنتِ أين يا لذة اللعنـة، نسلك
- ساقط، بصماتـك حفّـارة !
-
-
- يسلمني النوم ليس للنوم حافـة، فأرسم على الفراش
- طريقـة: أفتح نافذة وأطيـر، أختبئ تحـت
- امرأتـي،
-
- انفعـل
-
- واشتعل ! .."
الأرقام المدرجـة على الجهـة اليمنى هي الأرقام الافتراضيـّة التي تتعامل مع البنيـة المقروءة. إذ يتـرك مساحـة متعمّدة من البياض بيـن أخـاف والجمـلة الأولـى، هذه المساحـة دلّلنا عليها رقمـياًّ بثلاث جمل افتراضيـّة بيضاء أعطيناها الأرقام(2، 3، 4)، والتي تتبعها أربعـة أسطـر، تضمّنت ثمان جمل من بينها اثنتان معطوفتان على ما قبلهما، ثمّ مساحـة بياض أخـرى دلّلنا عليها برقمين (13، 14)، إذ هي أقـل من الأولـى، ألحقها بسطرين كتابيين، وكلمـة في السطر الثالث ضمنها أربـع جمـل، ثم مساحـة بياض أخـرى، أعطيناها الرقـم (18)، لتأتي جمـلة أخـرى ويتبعها فراغ أعطيناه الرقم (20) ثم جمـلة ثانية مؤلفـة من فعلها وفاعلها فقـط، والمختومـة بعلامـة تعجب كسابقتها. ونقطتين غير مجانيـّتين، بل لهما دلالتهما التي تضاف إلى أجزاء النـص.
وهذه المساحات البيضاء زمن تجري فيه أحداث مسكوت عنهـا، لم يقلها الشاعـر، بل أعطاها وجودها على البياض، وترك لمخيلـة القارئ تصورها، وافتراضها. وهي أحداث تطـول وتقصر بحسب مساحـة البياض التي تكشف عنهـا. وفي النص يتعمّـد أنسي إلغاء المفاهيـم المتفق عليها فيما يتعلّق بعلامات الترقيـم، وهذه سمـة من سمات شكل الكتابة عند أنسي الحاج. إذ يتعمّـد ترتيب الجمـلة بشكل غوغائي لا تساعد فيه علامات الترقيم على القراءة. ففي قصيدتـه "هويّـة" التي يبدؤها بفعـل متعدٍ "أخاف" والتي –عن قصد– يتبع الفعل والفاعل فيها بنقطـة تؤكد تغيّبه للمفعول بـه.
وفي المقطـع المكتـوب الثـاني يرتـّب أنسي الحاج جملته وفق خريطـة بصريـّة:
"الصخر لا يضغـط صندوقي وتنتشـر نظّارتاي.
أبتسم، اركـع، لكن مواعـيد السّر تلتقي والخطوات
تشـعّ، ويدخـل معطـف ! كلّها في العنق. في العنـق
آذانٌ وسَـرِقـَة".
بهذا الترتيب كتب مقطعـه، ولهذا الترتيب دلالتـه، فبـعد الخـوف، وبـعد مساحـة البياض، تـأتي هذه الصور المتدافعـة لتؤكـد خديعـة اللغة عند أنسي، فمن حيث تبدو لنا هذه اللغـة زاهـدة في المنطق، والترابط، عابثـة، قلقـة، نجدها منضبطـة لأداء دلالاتهـا، والإيحـاء بهـا، إذ يحافظ على زمنيـّة الأفعال حسـب توالي السـرد في النـص، ويتعمّـد التكـرار لخـلق الدلالـة، يقـول: "أبتسـم، اركـع." ، وفي هذا إقرار بفعـل الخـوف، وبأثره عليه إذ يستسلم لمخاوفـه، فيبتسم لها راضياً، ويركـع خاضعـاً، لكن فعـل الرفـض، والتمـرّد يبرز ويقاوم الوحدة الناجمـة عن الاستكانـة بالمواعـيد السريـة، التـي تشـعّ بفضلها ولها الخطوات، ويدخـل معطـف! جملة (يدخل معـطف) متبوعـة بعلامـة تعجّب تستوقف القارئ، فالشاعر هنا يلتقط أنفاسـه متعجّباً من فعل السحر الذي ولّده دخولها بالمعطـف. وأنها كلها كجمال مجتمعة في العنـق. علامة الترقيم النقطة ( . ) تؤكد هذا الفعل الساحر لعنقها الذي تجمّع فيه جمالها. ثم يأتي البياض محّملاً بتبعات اللقاء. وكأنه راوٍ يترك فراغاً دالاًّ، أثناء سرده للقصـة أو الحكايـة.
وهذا الشكل نجده أكثر ما يتكرّر عنـد أنسي في ديوانـه "لن"، وإن دلّ ذلك على شيء فإنما يدلّ على تمزق داخلي، وتمـرد يقاومه بمحاولة الاتصال بالآخـر، اتصالاً غير عادي أو مألوف، وتحريض هذا الآخر على فـعل الخلخلـة عبر تخريب نمط القراءة المعتـاد، إذ يبلغ عدد القصائد التي تتبع هذا الشكـل ثلاث عشـرة قصيدة من أصل ست وعشرين قصيدة وعناوينها "لأبقـى"، "البيت العميق"، "إحساس مرهـف"، "عفاف يباس"، "فصل في الجلد"، "للدفء"، "ترتيلة صغيرة"، "سفر التكوين والهجـرة" "على ظفرك إلى ضعفي"،"صياح يقف ويركض"، "الحب والذئب الحب وغيري".
بينما تقلّ في ديوانـه "الرأس المقطوع" القصائد التي تخضع لذات الشكـل إذ نعثـر على خمس قصائد من أصل ثلاث وثلاثـين قصيدة وعناوين هذه القصائد "بين أربعة رماح"، "الوداع"، "شهرزاد"، "ذكـرى"، "لهذا السبب"، في قصيدته "ذكـرى" يقـول:
" ذكـــرى
1. كم
2. هذا
3. اللّيل !
4.
5. كلّ نعامـةٍ تدفنـني" .
فالتذكّـر، والذكريات التي تُطيل ليله فيسأل عن هذا الزمن البطيء تحت وطأة هم التذكّـر بكم المختصّـة بالوزن، أو الثمن فكأن الليل وزن ثقيل. ثم يأتي البياض الذي أعطيناه رقم (4)، وفيه يفعل التذكّر فعـله. فتأتي النتيجـة التي تأخذ زمناً هو الزمن الأفقي بسيره الطبيعي، بخلاف الزمن العمودي النفسي الذي تثقل فيه وطأة الثواني، والدقائق، فتكاد لبطء سيرها تقـف. أهـو النسيان أو التناسي؟ -إذ تدفن النعامة رأسها في التراب هرباً من هـول المواجهـة. وهي إحالة لافتة إلى مفهوم العامة، أو الشائع من تصور جبن النعامـة. والقصيدة بشكلها المكتوب تستدعي قراءة بصريـّة يمكن معها وبها الاقتراب من النص كما هو واضح.
أما ديوان "ماضي الأيام الآتية" فيظل شكل البياض اللامكتوب مسيطراً وفاصلاً بين مقاطع القصائد غير المرقّمـة، فنحن لا نعثـر على ترقيم بالأرقام الهنديّـة (1، 2، 3، ...)، بل يقطّع أنسي قصائده بالأرقام اللاتينية. أما القصائد التي تتبع ذات الشكل فيه فهـي: "نمش الحظ"، "موعد"، "من عصر النهضة"، "السخرية الوفية"، "أنا جميل"، "السلام لجميعكم"، "وُلدتُ تحت برج الأسد"، "عناق الأوبئـة"، هذا البياض الذي يحضر في ديوان "ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة" يقــول:
" يا امرأة الشفتين المغرورقتين بالدموع ...
هم رأوا شراً بينهم
أنا رأيتهم".
ومن القصائد ذات الشكل المقروء في ديوانه هذا "تحت جفنيها"، "التي تلبس فستان الورد"، "يكتب ويقرأ"، "قبل أن يموت"، "فتاة فراشة فتاة" .
فتاة فراشة فتاة
1. حلمتْ فتاة أنها فراشة
2. وقامتْ
3. فلم تعد تعرف إذا كانت
4 .فتاة حلمتْ أنها فراشة
5. أو | 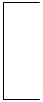 | أ |
6. فراشة تحلم أنها فتاة
7. |  | ب |
8. بعد مئات من السنين
9. يا أولادي
10. والهواء في الليل
11. فتاة وصبي يركضان كفراشة
12. تحلم أنها فتاة وصبي
13. فتاة وصبي يحلمان أنهما فراشة
14. واشتدت الريح على الهواء
15. تمزّقـت في الخارج
16. يا أولادي
17. فراشـة |  | جـ |
ويشكّل البياض مقطعاً أعطيناه الحرف (ب). وفيه فاصل زمني يوصل إلى المقطع الثالث، فيه جملة بيضاء، صامتة، جملة تحاول قول ما حصل بعد الصحوة من الحـلم.
أما "الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع" فلا نقع أو نعثر على هذا الشكل من القصائد إذ هو قصيدة تسخّر الأسلوب السرديّ في تشكيل مبناها ومعناها كما سنرى فيما يلي.
و "خواتمه" ذات الشكل الإشراقي، والحكم المسبوكة في قالب نثري فلا نقع فيه على قصائد ذات شكل يتطلّب فعل القراءة. وهو الكتاب الذي عاد به إلى النور بعد صمت طويل دام قرابة الخمس عشرة سنـة، معلناً تمحور ذاته، وخيبتها المفجعـة، ومحاولتها البائسة في القول المقطّـر والكثيف.
ويعـود في "الوليمـة" ليبعث البياض فيفعل فعله الصامت والجارح ضد الكتابة لنفسها. يقـول في قصيدته "الدائم الكــذب":
"ليس مما أفلَتُّ للمستقبل إلاّ قديم الرغبات، تلك الخزانـة
المتلألئة بالفراغ ...
... أما ما لم يُفْلتْ فإن قلتُه بين الحنين والحنين فمن
باب السلام على الذات الوحيدة.
ولا يتجدّد الرأس بتخضيب الشَعْر. الوداع".
البياض والفراغ فعل حضّ على القراءة، فعل رفض لأشكال وأساليب الكتابة التي قرّت، وتكرّست.
ونخلص مما سبق إلى القول بأن قصيدة النثر عند أنسي الحاج، قصيدة صامتة تُقرأ بالبصر. فقد كُتبت بشكل يستوجـب قراءتها، والوقوف على دلالات الرسـم والتشكيل فيها.
والاختلاف بين عدد القصائد التي تستخدم هذا الأسلوب في ديوانه "لن"، وبقـية الدواوين، التي قلّ فيها عدد القصائد التي اتّبعـت هذا الأسلوب مقارنة مع عدد القصائد الشكـلي في كل ديوان، يكشف عن تغيّر في نفسية الشاعـر، وتحـوّل من التمـرّد الغاضب، والرفض الذّي
تفجّر هدمـاً، وتقويضاً لدعائم الثوابت بأشكالها الاجتماعـيّة، والدينيّة، والكتابيـّة في ديوانه "لن" لتهبط موجة التمـرّد والغضـب في دواوينه الأخـرى، وتتحوّل إلى إدراك لفعل الواقع، ووعـي على قسوته، وخيبـة وخذلان حوّلا الشـّاعـر عن شكل القصيدة المقروءة بصريّاً إلى أساليب وأشكال كتابية أخـرى.
2. الأسلوب السـردي:
يستقيم هذا الأسلوب بتوظيفه خصائص فنّ القصّ، أو السـرد، ففيه نجد الحوار، ونجد الشخوص، والمونولوج، وتطوّر الأحداث الزمنيـ، والنتائج أو النهاية والخاتمـة، وأنسي الحاج بدأ حياته الأدبيـّة بكتابة القصـة القصيـرة وظلّت سماتها في قصائده، وظلّ به فـنّ السـرد تفتقه ذات ظمأى، ماؤها الالتقاء، والتحاور الذي يجسّـد نزوعاً محمومـاً للتقارب، دون أن يفلت منه زمام القصيـدة فيتمكّن أنسي من السـرد كأسلوب تعتمده القصيدة دون أن ترتد إلى أشكال النثر من مقالـة، وقصّـة، ورواية، وخاطــرة.
يقول في قصيـدة "الثـأر":
"مررتُ بالأرض التي سكنتها مذ هجرتها فسقطتُ
في شـوك، تسلّقت شجـرة، نظرت إلـى القريـة
التي رأتنا أنت تهزّيـن رأسـَكِ (أوّاه . أضنيتـك !)
وأنا أقنعـك أن العـودة شاسعـة لا تسـع الحمـّى،
قريـة حملتي الأزليّة نظرتُ إليها فرأيت الأهالي سعداء.
نزلت وانحنيت على الأرض
قرّرت عقرها بمخيلتي."
إنه السـرد لأحداث تسير ضمن تراتبيّـة زمنيـة، تمسك مفاصل القصيدة، وتلحم بعضها
ببعض، والمحبوبـة الصامتة الغائبـةُ لا تتحدّث، وكأنها غير موجودة أصلاً، والتذكّر لما فعلته القرية بهما، انتقامه من فعلها دعاه إلى عقـر القريـة من مخيّلتـه. بداية، أحداث، تسلسل، عقـدة، خاتمـَة. سـرد يقترب من القصّ الغرائبي الذي نجده عند زكريـّا تـامر•، ولكنه سـرد ينأى بنفسه عن القص بلغته، وتراكيبه، وشعريـته.
وفي الأسلوب السـرديّ أنسي الحاج يتحدث عـن نفسـه يقول في قصيدة "الحبّ والذئب، الحب وغـيري":
"لم أشعر إلا نادراً هكـذا.
برزت سمراء كأي فتاة ملوّنـة، غدوت مجذافها النظـري.
أما الرياح فكانت دائمـة، وكانت وحيدة الرئـة ..."
أهو هو يأمر: "فليذهب ملكوت القشعريرة
أبا الهول ! أبا الهول ! خذ صمتي وامنحني. يسوع".
أو يروي: "كان يتأمل من الثقب
ليرى إذا الحرب ستقـع. خرجت أنفاسه هجمتْ لتفتح
الباب وهي تصرخ (الصبر قبـر ! ... ) .
وفي نصّ "فتاة فراشة فتاة" يروي وكـأنه الأب أو الجـدّ الذي يحكي حكاية لأبنائه أو أحفاده، يقــول :
"وبـعد مئات السنين
يا أولادي ..." .
أو يصف: "البيت، الدخـان يتعانقان والظل
غائبان، أبسط قامتي على الشمس فأصبح من أشعتها.
لا حاجـة للزرع والنجـدة، لا حاجة لعرق الهارب، لا حاجـة
للقـرع للقـرع للقـرع .." .
ويقول واصفاًَ في قصيدته "وفاء العصافير" :
"أنساب كالماء بين الصخـور
جلست لأنظم
فرأيت الأوزان عصافيرَ تبكـي في أقفاصها.
أكان يمكن أن أتـرك العصفور حزيناً
من أجل أن أزيـّن بيـتي؟
وتـركت ألأوزان لأشداء القلوب
وكم أنا معجب ببراعتهم !
وكم يطربني الغناء المنظّم !
وكنت أودّ لـو أكون مثلهـم
ولكـنّ ما حيلـتي
إذا الله خلقني ضعيفاً أمام الحريـّة
فضيـّعت الأوزان وضيّعتني
ولم أربح غير وفاء العصافير".
هذا (المونولوج) شكل من أشكال السـرد تتحدّث فيه الذات عـن ذاتها، ومواقفها، وتفسّرها كما هو واضح في القصـيدة.
أمـّا الحوار فيغيب في ديوانه "لَن" ليطالعنا بأولـى قصائده الحواريـّة فـي "الرأس المقطـوع "والقصيـدة تحمل نفس العنوان، يقــول:
- "مـارد الصّيـن نفخنـي
- تتكلـّم ولا تنظـر
- المصابيح داخـتْ في السيـّارة .
- سيرانــي
- مــَن
- مـَن أعــرف في الشَـارع
- في البحـر
- في الشـارع ....
- آهلة باللّمس والنيران. بيضاء بالمطـر، ينزل
- من رأسك المقطـوع ...."
يتحاور هنا اثنان، شخصيتان افتراضيتان، فيدور بينهمـا حديث فيـه تداعٍ بلا انسجامٍ، ويغيب بينهما المنطق، والتحاور، وتعلن القطيعة بينهما، والتي تسببها الخيبـة والخذلان جرّاء واقع يستلب شخوصـه، وأناسه فيسلّمهم مادة لحريق الويلات بأشكالها، الحـرب، السياسـة، والسلطـة والحصاد: عيـون، وأنقاض، وبحار مرتفعات محترقـة، وقمح الأشباح.
وفي "الوليمـة" نقع على قصيدتـين يستخدم فيهما الشاعر الحوار كأسلوب من أساليب السـرد همـا "يوم بـعد المطـر"، "حركات العمياء" يقول في الأولـى:
- "أيـن ، مع الشـوق ؟
- إلـى الضفاف ، صفصافة."
إنه يسأل المحبوبـة فتجيب في حوارية. ولعلّ ندرة هذا الشكل من أشكال الأسلوب السـردي يثير سؤال لماذا ؟
وإجابته مرتهنة بالكشف عن نفسيّة الشاعر، فالحوار الوحـيد الذي أجراه مع آخـر كان حواراً مستلباً، مشروخاً، لا تواصل فيه، ومحاولته الخروج عن استلابـه إنما تتم عبر فعل الحبّ. ليتحوّل هذا الحوار إلى دفءٍ، وتوازن يفرّغ فيه عزلته إثر تعثـّر ذاته على شقها الذي تحاوره. إلاّ أن معرفة مسبقـة تقرّ في وجدانه بأن الحب خلاص واهم، أو هـو وهـم خلاص وتؤكـد مـا ذهبنا إليـه إجابـة المحبوبة في آخر القصيدة عن سؤالـه:
- "متـى نلتقـي
- في غياب آخـر"
إنه الواقع الذي يشرخ الحـلم، ويفسّخ الأمنيات، وأنسي الحاج لا يجالد ضـدّ هذا الواقع؛ بل يؤمن بأثره الضارب في أعماق النـفس، ويعترف بانتصاره في خيبـة تصـل حـدّ اللاألـم.
3. الأسـلوب الإشراقــي:
باصطلاح سوزان بيرنار قصيدة النثر قصيدة إشراقيـة تمحو حدود المكان والزمان كما سبق الحديث عن ذلك، فالأسلوب اللإشراقي إنما يقوم عـلى فوضويـة تغيّب الزمان والمكان، فيعتّم النـصّ ليشرق بدلالاته في المتلقـي، التي تومض فيه ومضاً مُسمتداً من كليّة النصّ، ومعتمداً على سير النص في انسجام يكسره عدم انسجام حادٍ يضيء عتمتـه. ويمكننا تقسيم هذا الأسلـوب إلـى:
1. الأسلوب الإشراقـي الموجز.
2. الأسلوب الإشراقـي المـمتـد.
أمـا الأول فمثاله قصيدة أنسي "إلى الصباح والنصـف" والتي هي أول قصيدة لـه تعتمد هذا الأسلوب، جـاء فيها:
"الباب مفتـوح أمامك مفتوح من الصباح
إلـى الصباح إلى الصباح والنصـف"
ومن الواضـح أنّ المعنـى هنا إنمـا أضاءته جمـلة كسرت انسجام، وعتمـة النصّ، فأشرقـت دلالاته الشعريـة في القارئ. إذ هو المنتظر من أجل الانتظار إلى الصباح والنصف.
وفي قــولـه: "لـون فمك رائحته تفـّاح"
هذا التنـافر بين المفردات يولـد تناغمـاً دلالياً يتسلّل منه المعنـى المسكوت عنه إلى القارئ فيغمره.
"إلـى الصباح والنصـف"، "أجمل القارئات"، "حتى مجيئي"، "مثل القمـر"، إلى "ذهب المجوس ورجعوا وقالوا" هذه القصائد إشراقيـة الأسلوب موجزتـه في هذا الديوان. لننتقل بعده إلـى "خواتم" الذي خصصـه ليكتب فيه بهذا الأسلوب يقــول:
" كلّ اللهب في هذه النظـرة المتحجـّرة "
" اليـد أعمـق من الفـم "
" الحب أعمـى، لذلك "يـرى" ما لا يراه المبصرون "
" شمسك الليلـة تُخفي أرضي تُظهـر سمائي "
" أيتها الصلاة غدونا وحدنا أنا وأنت، فما أكثرنا "
" النور لا يُـظهر بل يخـفي "
" الله أوّل الدمـع "
" في جفاف العـدل انتقام من شعـلة الظلام "
" في الابتسامـة أم "
إنها قصيدة الإيجاز والكثافـة والنمط الحكمـي، والتبليغ في رسالة سمتها البساطـة العميقـة، وسمتها التوتّر والثنائيّة الضديـّة.
يقول أنسي :
" بـعض الرجال لا يغدو إنسانياً إلا عندما يمارس ظلمـه "
" اسرق كلّ نفسك في كلمتك "
أما الأسلوب الإشراقي الممتـدّ :
ففيه تسير القصيدة متناميـة محمـّلة بشعريتها التي تتردّد في قول ما لديها، وتشير إليه إشارة إلى أن يصل بـه إلى حدّ يطلق فيه شرارة تشعل كامل النص. يقول في قصيدته " شفاء الينابيع":
" فيـا عطشانة أنتِ النبع
والينابيع شفـاه "
فتفيض القصيـدة في أعماق القارئ مشرقـة، ويشعـر سريانها في عروقه وهي تهيّؤه للفيض والإشراق الذي يُحدث لذة محنون إليها يقــول:
" فـأنا كنت أريـد
وأنا أنا
أن أكـون أنت"
وديوان "الوليمة" تصطبغ القصائد فيـه بصبغة هذا الأسلوب الإشراقي الممتد فتعثر فيه على: "تعريف"، "كلّ الحياة"، "يـا شَفيـر هاويتي"، "شفاه الينايبيع"، "السقـوط"، "إذا وعدتك
أيضاً"، "سمّيتـك سـرّيـّـة"، "كل قصائد الحب"، " لنذهـب"، "أخاف أن أعـرف"، "الأوّلـون الآخـرون"، "الغابـة الواعيـة"، "دغـوش الغياب"، "الباب الموصود"، "جاذبيّـة"، "الحركات العمياء"، "النجمتان"، "القـدر"، "رجـل يغوص"، "سحقاً للشعراء"، "من الألف إلى الياء"، "الدائم الكـذب"، "الهـارب"، "قمـر الشعـر"، "أيّتهـا التشابيه"، "منتهـى الواقعـيّـة"، "لـو كنت مكاني"، "الصـديق".
وتطبيق مفهوم: (الفجـوة: مسافـة التوتـّر)، يؤكد هذا الأسلوب الإشراقيّ كخاصيـة من خصائص قصيدة النثـر عـند أنسي الحاجّ، وهذا الأسلوب إنما ينبع من مطلب فـرديّ، متمـرّد على التناسقات التركيبيـّة، والإيقاعـية، الأمر الذي لاقى هوىً في ذات أنسي الحاج، فجعـلت تنسج قصائدها عـلى منواله.
4. الأسلوب التكراريّ :
للتكرار دلالته، وأشكاله، وأنسي الحاج يعتمد الشكـل التكراريّ مولّداً من خلالـه إيقاعات، ومـَوسَقـة تنجم عن تكرار مقطـع أو جمـلة أو تركـيب أو كلمـة أو حـرف. وكمثال على التكرار المقطعـيّ نستشهـد بقصيدتـه "خطّـة" يقـول:
"خطــّة
- كنت تصرخين بين الصنوبرات، يحمل السكون رياح صوتك إلى أحشائي.
- كنت مستتراً خلف الصنوبرات، أتلقّى صراخـك وأتضـرّع كي لا تـرَيـنِـي.
- كنت تصرخيـن بين الصنوبرات، تعال يا حبيبي !
- كنت أختبئ بين الصنوبرات، لئلا تـرَيـني، فأجيء إليكِ، فتهـربـي ".
التكرار في جمـل (1، 3) ، والجمـَل (2، 3) في الفعلين كـُنتِ وكـنتُ، وجمـلة الرجل التي تقابل جمـلة المرأة، وموقـعه خلف الصنوبرات يقابل موقعها بين الصنوبرات، وعلانيـة ظهورها وصراخهـا يقابله اختباؤه مستتراً عنها، ودعوته الصريحـة -تقابل دعوته الضارعـة ألاّ تراه. والسبب في ذلك معرفته المسبقـة للنتيجـة التي ستترتّب عى رؤيتها إياه إذ تراه فيجيء، فتـهرب. الأمـر
الذي يؤكـده تراتب الأفعال وتسلسلها، "تراني، فأجـيء، فتهـرب" المنصوبة جميعها لوجـود لئلا"، فالفعل لم يحصل ولكنه سيحصل فيما يتوقـّع ويعتـقد.
وفي نفس الديوان يكــرر لفظـة "خائـن" في قصيدة بعنوان "نشـيد البلاد"، يكـررها أربع مرات ما بين المقاطع، ويبدأ بها المقطع وكأن آخـر يتّهمه بالخيانـة. فنكاد نحسّ زوايا السجن الأربعة تطبق عليه وزاويتها القائمة لفظـة الخيانـة.
وفي "ماضي الأيام الآتـية" يكرّر اللفظـة المفردة يقــول:
" أيـة أشياء وراء الجبال
أيـة ذكريات لكـن في البلاد الحـارّة ؟
أيـة منازعات، ومضاجعات عـلى سواحل أوروبا المشمسـة.
أيـة التفاتات تهربكن من شهواتنا
أي بديل كنـتُ ... "
وفي نفـس القصـيدة يكـرّر:
" لم يقم حب إلا حبي.
إلا حبي.
لم يقم حب إلا حبي.
إلا حبي.
لم يقم حب إلا حبي. "
فكأنه الصـدى الذي يحاول بترجيعه أن يقنع نفسـه. فيتابع:
" أكـرّر
أكـرّر "
ويختم القصيدة بقوله:
" فـوق جسـدك
فـوق جسـدك
فـوق جسـدك الذي لا يتجسّـد "
وكل هذه التكرارات في قصيدة واحدة تعكس الصراع المحموم بينه وبين اللغـة التي بودّه لـو تقول ما يحمل، وليخفف من عجزها، ويشحنها بما يريد أن يكـرّر.
وفي نفس الديوان في قصـيدة "داناي" يكرر كلمـة و(آخـر) خمس مرات يتخللها مقطع مؤلف من جملـة واحدة ثم يتبعها بقوله:
"أكثـر ما ... أنه" خمس عشـرة مـرة.
ثم يتابع تكرار (آخـر) في أول المقطـع.
وفي قصيدته "النحـلـة" يكرّر سؤالاً يبدأ بـ (من) وهو تارة:
- من الغرباء
ويكرّرها في المقطع الثانـي.
- من الغرباء
ويخـتم في مقطعـه الأخـير بقوله:
- من الغريبـة.
لتتحـرّك القصـيدة في ثلاث دوائر تضيق، وتضيق إلى أن تصل مركز الدائرة.
وفي قصيدة "نمش الحظ" يبني القصيدة في مقطعها الأول على تكرارات مقطعية تبدأ بـ (جعلت) والقصيدة، يتألّف مقطعها الأول من سطريـن. والثاني من ستـة أسطر، والأخير من أربعـة أسطـر مبدوءة جميعها بـ (جعلتُ).
وفي قصـيدة "الأفكار تجيء من النـوم"
تبدأ القصـيدة بكلمـة "الأفكـار" التي يكرّرها أربـع مرّات، لتتحرك القصـيدة وفق موجـة تعـلو عنـد كلمـة أفكار ثم تنساب فيما يـليهـا.
وقصـيدة "الأيام والعمالقـة"
تبـدأ بقولـه: "أحب ذكـر الأيام التي" فتتحرّك القصـيدة حركـة دائريـة بحيث يقفل الدائرة في النقطـة التي ابتدأت فيها فيكـرّر خاتماً "أحب ذكـر الأيام الـتي"، مقابلاً بين الأيام التي كانت والأيام التي ستجيء. معلناً أنها ذات الرحـى الزمنـية، التي طحنتْ الماضيين ستطحـن الآتـيين.
والتكرار في ديوانه "ماضي الأيام الآتـية" سمـة تطغـى على قصائد الديوان بأكملـه، ففـي قصيـدة "ولدت تحت برج الأسـد" يقـول:
" كما تصنع الغابة وردة
كما تصنع الغابة وردة
كما تصنع المدينة عقرباً
كما تصنع رطوبـة الجدار
حشيشـة
بينها وبين الجـدار ".
ليبدأ مقطعـه الثاني بتكـرار جديـد:
" لمّا كنتٌ ولـداً
لمّا صرت ولـداً
لمّا ما أزال ولـداً ".
مقطعين يصـعّد بدايتهما بالتكرار، وكأنه يتحدّث عن عمـره الذي لم يتجاوز العـقد الثالث بعد حينها.
ومرّة أخـرى في قصيدة "أهذا أنت والقصّـة".
والتي تتحرّك وفق بناء موجيّ دائريّ مستمد من التكرار الناجم عن إلقاء حجر في بركة، فتنتج موجات تبدأ صغيرة، ثم تكبر فتكبر، حتى تتماهى في الماء. معتمداً على مقطع تكراريّ جاء فيه: " يرجع تاريخي إلى قرن خامس ".
والمقطع الثاني: " يعود تاريخي الى ... ".
والثالث: " يعود تاريخي إلى ...".
والرابع الأخير: "يرجع تاريخي إلى ...".
أما ديوان "الرأس المقطوع" فتطالعنا أولى القصائد التي تعتمد اسلوب التكرار بعنوان "لم" بقوله:
" لم يذكر
أنه شاشة حمراء
لأن قلب العالم أبيض
لم يقل
أنني أسود
من أجل الليل
حين ترجع العصافير "
تكرار التوازي وارد ما بين:
لم يذكر ............................ لم يقل
أنه .................................. أنني
قلب العالم أبيض ................. الليل أسود
لأن ................................من أجل
وهذا التكرار يمدّ القصيدة بتماسك داخلي، يلغي شكلها الخادع، الذي بالتفكّك واللاترابط.
أما التكرار التقابلي أو الضدي فنجده في نفس الديوان في قصيدة "هم الحواة والمصارعون":
" أنزلتهم عن الورق لأسمع زجاج فتاة.
يوجه درب. صرت أناول قرباني.
طلعتُ من الصخور، وتركت الأرض لدبابيس
الورق. "
نجد "أنزلتهم" مقابل "طلعت"، في فعل تضاد وتعارض إرادي بين الشاعر والآخرين.
أما قصيدة "الصمت العابر كالفضيحة" ؛ فنعثر فيها على التكرار الدائريّ إذ تبدأ بجملة ثم يختمها بذات الجملة، والتي هي سؤال يقول فيه: "ما العمل بالصمت؟".
وقصيدة "في العيون" تتعمّد التكراري التصعيديّ، إذ يكرّر حرف "لا" النافية، يقول:
" لا الحدائق الخيالية
المعلقة
لا المعادن المقسمة خلف الأصداء
لا حبل الوهن
لا تفقيس الصرخة
لا دحرجة البجع
لا سمنة الدويبات من البدء ...
لا جندلة النار والكناري ... "
هذه (اللا) التي تنفي جُمله كلّها. إذ كلّها لم تمنع تولّي زمان الصيد.
وهنا ينفرج التوتّر، ويخفت التصعيد باسترخاء الموجة العالية، حين أفرغ توتّره في نفيه
كلّ. لم يمنع تولّي زمان الصيد. وكل الذي يحاوله، ان يفني أغنية الوجود، ولأجلها يجلس مكشوفاً، نابضاً صامتاً. وفي "أغنية أدراج الرياح" ، يجيب عن سؤال بتكرار صيغة "ما دمتُ"، وكأنه إلحاح على الاستغناء عن أي وسائط خارجيّة يحتاجها في مواجهة الحياة. ثم يضاعف التكرار بأن "ما دمتُ أستعير" تتكرّر بنفس الصيغة مرتين في آخر القصيدة، وكأنها هبات ريح ثم تهدأ لتقوى أكثر فأكثر حتى تنتقل إلى مكان آخر آخذة معها أغنيته أدراج الرياح.
أما تكرار الحرف فمثاله في قصيدة "ما موت شعتقات" قوله:
" نهوّم جوعنا
نعود حيرتنا
نشمّ أبناءنا
آه
ما أجمل العبد الهارب !. "
فالصوت الصامت الناجم عن (نا) المتكرّرة يمنح هدوءاً وشفافية، وامتداداً مع الألف التي جاءت بعد حرف النون لتشكّل ضمير الجماعة (نا) المتكلّمين .
ونفس القصيدة يختمها بتكرار الفعل ثلاث مرات:
" خلقتُ
خلقتُ
خلقتُ كلّ شيء "
والتكرار هنا يؤكّد فعل الخلق في مواجهة القدر.
تكرار الكلمات عند أنسي إنما هو تأكيد وإلحاح في الطلب يقول:
"أترك التظاهر والإدعاء
أترك الوطن السطحي وأزقة الجدل"
أما تكرار الأسماء والضمائر فمعانيه ودلالته متعدّدة بحسب السياق. ومثاله:
" يا امرأة الثمرات والمعونات
يا امرأة الأحراج والبحار
يا امرأة ...
يا امرأة ...
يا امرأة ... "
فيستجدي ويستعطف بالنداء الموجه لها.
أما التكرار المقطعي فإنه عادة يقوم بخلق تشكيلات دائريّة أو حلقيّة أو موجيّة، يقول في "هاتفي لديها" . من ديوان (ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة؟) التي تبدأ بـ (جرس الهاتف) التي يكرّرها عشر مرات، في هيئة سلسلة من الحلقات، تصغر وتكبر حسب المقطع.
وفي هذا الديوان نعثر على شكل آخر من أشكال التكرار في قصيده (المتوهجة) التي تبدأ بصفات مُعرّفة يقول:
" الشبيهة ...
المتوهجة ...
المتسللّة ...
الصامتة ...
الراجعة ..
النازلة ...
المعطية ...
المعطية ...
النازلة
الراكضة
والصاعقة "
ختمها بواو العطف التي هدّأت ارتجاج الوصف والصوت. فكسر بها التوالي.
ويتكرر هذا النمط في قصيدته (غيمة شمس) من نفس الديوان يقول:
" اليد على خصرها تجعلها وردة
الهواء على وجهها يجعلها فراشة
الضحك يجعلها موجة
الحزن يبقيها شمساً خلف غيمة تحميها من اللصوص. "
وهذا التكرار يبدأ فيه من نقطة توتّر، لتنتقل في القوس إلى الطرف الثاني، فينطلق السهم بفضل من هذا الارتداد للوتر.
| | شمساً
موجة
فراشة
وردة | |
| يجعلها
يجعلها
يجعلها
يبقيها | | اليد
الهواء
الضحك
الحزن |
وتكرار الألفاظ أو المفردات سمة تَخُصُّ ديوان (ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة؟) ومثاله بحسب الجدول التالي:
| عدد مرات التكرار | الحرف ، المفردة، الجملة | القصيدة |
| 30 مرة
6 مرات
27 مرة
16 مرة | من
مولودة
ضد
الذي | أغار
السعادة
السعادة
السعادة |
وبافتتاحية استهلها بقوله "ساقاك حميمتان ..."، وختم القصيدة بذات المقطع "ساقاك حميمتان ..." فأغلق بذلك الدائرة، وختم من حيث بدأ. وفي قصيدة "المعطف في الصقيع كلمة"، يبدأ "بأكتب" التي يكرّرها ثلاث مرات في بداية مقطع القصيدة الأول، ثم يكرّر ( أإلى):
| (أإلى) | | |
| | 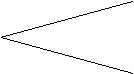 | ثلاث مرات في المقطع الثاني |
| (أإلى) | | |
| و يعود إلى (أكتب) |  | ثلاث مرات |  | في المقطع الثالث، |
| أكتب |  | ثلاث مرات |  | في المقطع الرابع، |
ويتابع عمودياً: أكتب!
أكتب !
أكتب !
أكتب !
ثم يكرر في خاتمة القصيدة هذه الكتابة المحمومة بأربعة أفعال هي :
|  |
" ليصبح ..
ليتم ..
ليتم..
ليكن .. "
وفي قصيدته (ابني الحبيب ) ، المؤلفة من ثلاث مقاطع تبدأ بسؤاله: (.. ما)
في المقطع الأول: ما أهم شعر سيكتب ...؟
ويكرّر السؤال في المقطع الثاني: ما أبسط الشعر الناعس ..؟
ثم يكرره في المقطع الثالث: ما أجمل الشعر أتركه ..؟
أما التكرار لفعل الأمر فمثاله قصيدة (باب الجارية) ، في نفس الديوان ، المؤلّفة من ثلاثة مقاطع يبدؤها بقوله: "افتح".
وتتشكّل القصيدة في ثلاث دوائر مبدوءة جميعها "بأفتح".
أما قصيدة "يكتب ويقرأ"، فيتوزّع الفعل المتكرّر (كانت) و(كان) سبع مرات لكل منهما في بدايات المقاطع الجُملية.
وفي ديوان "الرسولة بشعرها الطويل" تكرار مقطعي وجُملي، ولفظي يتداخل فيه السرد. يقول: "هذه قصة الوجه الآخر من التكوين" .
ويقول: " قادم من انتظارها لي
قادم من رجوعي إليها "
ويقول مكررا أفعال الأمر:
" إجلسوا الليلة
اكسروا الليل "
وأحـرف الجـر في تتابع : " في سـعـي ..
في ارتبــاط ..
في دهــشـة ..
في سـلام .."
وفي كـلّ مقطـع من قصيدته الطويلـة هذه نعثر على التكرار.
وفي "الوليـمـة" تكـرار توازٍ، وتكـرار تقابل.
ومثال الأول: قصـيدة "لنذهـب" يقـول:
" قبل أن يمـر حصان ويرفس الطاولـة
قبل أن يقوم البشـر ويُسحب القطن من آذاننا
قبل أن تعـود الحياة والمـوت والحيـاة "
وتكرار التوازي في كـلٍّ من (يمـر، يقـوم، تعـود، يرفـس، يسحـب)،
أمـّا قصيـدة "اللجج السحيقـة" ، فالتكرار فيها مقطـعيّ مبدوء بـ (قامت وذهبت)، التـي تفتح أربع مقاطع، يقول:
"قامت وذهبـت
لأنه لم يتكلّم
وكـان لا يتكلّم
لأنه لا يريدها أن تذهـب".
فيكـرر " قامت ذهبت
لأنـه ...
وكــان ..
لأنــه ... "
ونجد التكرار المقطعـي في قصائده "باقٍ" و "الرحـّالـة" في نفس الديوان.
وخلاصـة القول أن للتكرار عند أنسي الحاج أشكال، وأن القصيدة الواحـدة قد تعتمـد أكثر من شكل أسلوبيّ. سواء التكرار أو السـرد أو المقروء. وما تقسيمنا لهذه الأشكال إلاّ تقسيم يوضـح الطريقـة التي يستخدمها الشـاعر في كتابة القصيـدة.
ومن أمثـلة تعدد أشكال الأسلوب في القصيدة الواحدة عنـده قصيـدة "غـد"، يقول فيها:
( غــد
- هذا التعـب ..
- عندما أنظـر إلى الأعمـدة، من قاعدتها أم من أعـلى،
- تنبعث إلى حرارة لمزيد من الانطواء.
- هذا التـعب ..
- لا أستطيع أن أمـدّ يدي إلى وجهـك. وجهـك في عيـنيّ.
- ولا أصـل إلى عينيّ.
- هذا الهبـوط ...
- لا كشيء قديم، بل كشيء من المستقبل.
- في الغـد، الجديــد هـو بحــرا، كأنـّـه.
- وهذا التعب الغامـر ... خــذنـي. النـوم يا الهي!
- في ماء الإغماضـة الساخـن، في اللذة العفيفـة، والمطــر.
- السطـوح الداخليـة، والغلغلـة ... "
-- فالتكـرار في المقـاطـع ( أ ، ب ، ج ، د ).
-- والسـرد في حديـث الراوي عن نفسـه.
الأمر الذي يؤكّـد استخدامـه لأكثر من شكل وأسلوب من أساليب الســرد، بما يتـرك لمّـا في دواخـله من زفرات أن تتـصاعـد، بالتكرار، ليُخفف من وطأة الاحتقان، الذي يضغط أعماقـه، ويسجـن ذاتـه.
د. اللغـة والمعجم:
إذا ما اتّفقنا على أن اللغـة (كائن اجتماعي محافظ في جوهره، إذا هي ما قرّ في الأذهان وتعارفت عليه الجماعـة وفق اتّفاقات تاريخـية، اجتماعـية، وهي وسيط يقصد به التفاهـم والتواصل ببـعده الواقعـيّ والاجتماعـي، إلا أنّ اللغـة، ومن قلب الاتّفاق الاجتماعي عليها أن تخلق انحرافاتها لتولّد اللغـة الجماليـة، التي هي ضدّ اللغة التوصيليّة، مسببّة النشـوة المتأتّيـّة من انحرافها عن التقليد والعـرف) . وإذا ما كانت وظيفـة الشاعر مواجهـة (اللغـة اليوميّـة المتروكـة للإعتباطية والعـرف، ليكوّن لغته الشعرية، المضادّة لتلك النفعيّة) ، الأمر الذي يترتّب عليه أنه (خالق لغـة بمعنـى مـا) ، وبخاصـة (أن المادة الوحيدة التي يطرحها النص الشعري للتحليل هي لغتـه) .
فما اللغـة التي عبّر بها الشاعر أنسي الحاج عن دواخـله ؟
وما المجـرى الذي امتاح منه مفرداته ؟
وما الخصائص التي تمتاز بها تراكيبه اللغويّـة ؟
للإجابة على هذه الأسئلة لابدّ من التمييز بين الكتابة الصحفيّة والكتابة الإبداعيّة عنده.
1. الكتـابة الصحفيّـة:
هي مجموعة المقالات التي نشَرها أنسي الحاج في ملحق "النّهار" من عام 1960 والتي ضمنها كتابهُ (كلمات، كلمات، كلمات) الذي هـو عنوان صفحته الأسبوعية في الملحق، والمذيّـلة باسم (هاملـت)، فقد نشـر فيه مادّة هذه الزاوية من عام 1964م، حتـى احتجاب الملحق عام 1974م، حاذقاً منه ما نشره تحت اسم "اللحظات الحاسمـة"، وينضاف إلى هذه الصفحة،
ما نشَرَه في (النهـار) وفي (النهـار العربيّ والدوليّ) من عام 1984م إلـى 1987م، التي تشكّل بمجموعهـا مادّة كتابه (كلمات) بأجزائه الثلاث.
أمـّا مقالاته في مجلّد (الناقـد) فقد نشَرَها في كتابه (خواتم)، وتدخل في إطار كتابته الإبداعيّـة.
وهذه المادة الصحفية لا تشغل البحث الذي يختصّ بدراسة (أنسي الحاج وقصيدة النثر) إلاّ في الجوانب التي يستضاء بها في التعرف على رؤيته، ومواقفـهِ.
2. الكتـابة الإبداعـية :
كتبَ بها نصوصـه، وقصائده النثريّـة التي نجدها في دواوينـه:
"لن"، "الرأس المقطوع"، "ماضي الأيام الآتـية"، "ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة"، "الرسولة بشعرها الطويل حتـّى الينابيع"، و"خواتم"، و"الوليمـة".
ولقـَد كشفَت المقارنة ما بينَ القصائد التي نشـَرَها في المجلاّت الأدبيّة كمجلة "شعر" و"النـاقد" عن تغييرات، يجريها أنسي الحاجّ في النص قبل نشـره في الديوان، مرة يحذف أحرفـاً منـه، ومـرةً يحذف جملاً، وأخـرى مقاطع كامـلة، تحذف من النص، لتضاف مقاطع جديـدة بدلاً منـها.
ولا تدعـي هذه الدراسـة الوقوف على كلّ التغـييرات التي أحدثها أنسي الحاج في نصوصه بين تـلك التي نشَرها في المجلاّت والتي أعـاد نشرها في الدواوين، وإنما تكتفـي بالتمثـيل لتؤكـد ما ذهبت إليه المقـارنة:
- في مجلّـة " شعـر"، العـدد 14، السنـة 4، وربيـع 1960. نشـر أنسي ثلاث قصائد تحمل العناوين التّاليـة: "ترتيلـة مبعثـرة"، "الدفء"، "حالـة حصـار".
وفي قصيدة "ترتيلة مبعثـرة" كَتَب: (النثر إله يقرض أذنك وتحلقـين رجولته)، هذه الجملة حذفـهَا كاملة من القصيدة في ديوانه "لن".
أما قصيدة "للدفء" فقد أضاف عليها في الديوان جملة لم تكن موجودة فيها حين نشرها
في مجلّـة " شعـر" تقـول:
"عـوض أن تُقبـل من أمك تزوجهـا".
أمـا القصيدة التي تحمل عنوان "حالـة حصـار" فإن مقاطـع كاملـة تحذف من القصيـدة، وتستبدل بمقاطع أخـرى في صورتها في الديوان.
- كذلك الحال مع القصائد التي نشَرَهـا في مجـلة "شعـر" العدد 16، السنـة 4، خريف 1960م، والتي تحمل العناوين: "خطـة"، "البيت العمـيق"، "حوار"، "هويّـة"، فقـد غيّر ترتيب القصائد في الديوان فجعل "هويّـة" فاتحـة القصائد في ديوانه "لن" ثمّ نشـر "خطّـة" ، فـَ "حوار"، فـَ "البيت العمـيق"، في الوقت الذي أبقـى فيه قصيدة "خطة" على صورتها المنشورة في مجـلة "شعـر" فقـد غيّر في " البيت العَميق" كا سَيـلي:
| في الديــوان | في مجـلة شعـر |
| نبصقه ونـزرعه | نبصق اللحم ونزرعـه |
| نزرعـه لنخنقـه | نزرع اللحـم لنخنقـه |
- أما قصيدة "حوار" فقـد بقـيت على ما هي عليـه في المجـلّة.
غيّر في قصيـدة "هويّـة"، فقد حذف حرف الواو في الديوان من جمـلة: "يسلمني النوم وليس للنوم حافـة" فصارت: "يسلمني للنـوم ليس للنوم حافة".
ويكـرّر في الديوان جمـلة قالها مرّة واحـدة في مجـلة شعر "تعال أصـيح" يكرّرها مرتـين في الديوان: "تعال أصيح، تعال أصيح".
كمـا أنـه في المجـلة يقـول: "النصـر لا للعـلم"، فتصير في الديوان: "النـصر للعـلم". ويستخدم "كـي" في جمـلة: "وأتذكر هذا الحب بلا يأس" التي تصـير في الديوان: "وأتذكـّر هذا كـي أنجـب بلا يأس".
| في الديـوان | في مجلة شعـر |
| أعوي | أصرخ |
| أهرول | أركض |
| بلا طريق | وبلا طريق |
| الليل | بالليل |
| الغضب | و الغضب |
| -- | هؤلاء الجبهات |
| -- | لا مولاي ابقَ مكـانكَ |
وكمـا أنه نشر قصائد في مجـلة " شعـر" لم ينشرها في الدواويـن ومثال ذلك: القصائد الأربـع التي نشرها في مجـلة "شعـر"، العدد 17، السنـة، شتاء 1961م. وعناوينها "جريمـة الحرباء"، "ما وراء الحـسد"، "الفريق الثالث"، "نحن طفلان"، وهي قصائد يبدو أن أنسي انجرف فيها، محاولاً مجاراة التيار السياسي، فتحدّث عن ثورة الجزائر التي خصّص لها العدد المذكور من مجلـة "شعر". ولهذا أسقطها من الديوان.
وكذلك الحال مع قصيـدة "الخنزير البرّي"، المنشورة في مجلة "شعـر"، العدد 19، السنة 5، صيف 1961م، إذ يغير فيها ما بين القصـيدة في صورتها المنشورة في المجـلة وبينها في ديوان "الرأس المقطوع".
وعليه فإن الدراسة ستعتمد النصوص في صورتها في الدواوين كمادة لتحليلها النقـديّ.
واللغة عنده تجريديّة، ذات معجم شكّله الاستبطان الداخلي للذات، القراءة المنفتحـة على الآخـر الغربيّ، والترجمات الشعرية، وتركيبه اللغويّ يمتاز بخصائص وسمات تحقّق الإشراقيّة في النص الذي يتعمّد أن لا يقـول.
يقول أنسي: "الحياة حيّـة. العين درج. العين قصب. العين سوق سوداء. عيني قمع تقفز فيه الريح ولا تصيبه، هل أغوي ؟ الصراخ بلا حبل. هناك أريكة وسأصمد" .
إنها لغة غرائبيّة تعتمـد التجـريد. يقـول:
"ما سعـر رجل حزين ! التغضّن علامـة، الغضب إبحار. ورف الصرع تذيع الربيع، وعند الصباح تتعانق المذبحـة والظفر
وحسداً أخلع وجنتيّ
لكن الخوف ! " .
إنها لغـة تتساقط وتهـوي، ولا تلحق بأفكار ما، وإنما تصدر عن لاغائيـة "إذ لا يهـدف إلى بناء عالم جديـد عـلى أنقاض هذا العالم المتآكـل" .
يقـول : " لا تبدأ. سأضؤل، وأصمت، جناحـك. عينك الأفقيـّة! مولاي! لا! خذ قبـلي. " .
منطلقاً من أن "الكلمـة في الشعر ليست مجموعـة متآلفـة من الأصوات، تدلّ اصطلاحـاً على واقع أو شيء مـا، وإنما هي صورة صوتيـّة وحدسيـّة" ، تحقق "الخرق المنظّم بشيفرة اللغـة" . فيُعـاد بناء اللغـة وفق أسس تحـيد بالكلمـة عما وضعت له أصلاً. محدثة الانحراف اللغويّ "الذي يقـع في العلامات البنيويّـة، الدلاليـة، بين المفردات العجمـية." .
واللّغـة في ديوانـه "لـن" تقتـرب من طريقـة الكتابة الآليّة الحرّة عند "الدادائيين والسرياليين الأول" كمـا أشرنا سابقاً، يقول:
"هو ذا دهرنا، وهي المعاناة الآن وحدها. لأستمع. بدأت ولن تفهـم. خزائن الرحمـة ماعــت. جرفتها دموع المفترسين الأول. البر البحر الفضاء ..... الصلبان طُبعـت بالنار ودُقـَّت على الصّـدور، لـم تقوَ، دحرج هذا ، جـُنـَزْ ، العالم صنـدوق" .
لغـة محتقنـة، تتسارع وتتلاحق محقـقّة قوله "الأحرف تتلاحق" :
يقـول: "يتضارب ذهني، أحـلف أحـيّي وأغني. أقرأ .كل شيء في الهواء؛ وأنا الحياة سكـر مغليّ، مصقع. للعابي! رح إلى الشطّ، أيهـا الفكـر، تحللّ. الحياة ذبابـة ذبـابـة، طاقتي عينان رياضيتان.
أرفض العصـر! لا تشدوني! آخرون آخرون. أنا ظلّ أريـد هذا. مرحبـاً! أنت أيضـاً؟ ليس هنـاك أحد؟" .
وتتكسّر القواعـد التركيبية للجمـلة بحسب قوانينهـا المتعارف عليها، يقـول:
"تنزل نقطـة. بالماء أحنـيك؟ كان في حـلم صيـّاد سمكة، فجأة نطّت إلى الماء وكـرّرت أبـداً. يا لك! طفحتك في قلبي، اختلاطك في قلبي، رُقع ذراعيك في قلبي، عمود نور يصدر ويفرّ، أنت الوجع والضحك! إنني أربخ تحت آثارك المتلاشية" .
وفي قوله "تنزّل نقطة"، بحسب الأنساق اللغويّة المتعارف عليها، لا بد من تحديد نقطة وتعريفها بالإضافة ويؤكد هو رفض الإضافة بوضعه علامة الترقيم. التي تنهي الجملة.
"بالماء أحنيك؟" ترتيب الجملة في اللغة العربية يستدعي تسلسل الفعل، فالفاعل، فالمفعول به للفعل المتعدّي، وهو يخلخل هذه الأنساق ليدفع اللغة إلى تلبية احتياجاته النفسية، فيُقدّم الجار والمجرور على الفعل، ويضع علامة استفهام ولا سؤال.
"كان في حلم صياد سمكة"، خلخلة متعمّدة أخرى للأنساق للغوية، تاركاً للغة أن تنقذف انقذافاً. إنها لغة أشبه ما تكون بسيّال موجاتٍ تبثُها قناة تتعمّد تشويش البث، وكأنها ترسل شيفرة سرية. شيفرة ثوريّة، متمرّدة تصعق المشاهد العادي وتكشف له الوجه الآخر بتيار مشوش ومزعج. يقول:
"وصلت أمواج الدم الأسود إلى الحواجب، أنت تغرزين ونحن نسبح، نغرق ويحتل الأطفال دوائرنا" .
هي لغة التشوّش التي تطلب حريّة الفوضى، سيفه ضد العالم الخارجي، حيث النظام الذي يتمرّد عليه ويرفضه. هي لغة السقوط والانهيار والتفكك، لغة ترفض شكلها وهندامها المهذّب والمنسجم، المعافى وتتعرّى عن حقيقتها الداخلية، تخلع القناع فينكشف الوجه المعذّب، والمنشطر، والآثم، والمفكك، والسّادي. لغة تطلب القبح كغاية لا لتكشف عن مواطن الجمال فيه، بل لتحرّك سكون أصحاب الإحساسات الجاهزة. إنها الفوضى سلاح الشاعر ضد القوالب، والخطوط المرسومة مسبقاً، بها يُسقط سلطان الواجب والمطلق لتطلّ حريةٌ هي حرية الفوضى. والغوغائيّة اللغوية حاضنة فوضاه ومؤيدتها في فتح تفسّخ العالم الروحيّ والجسدي معاً، يقول:
"سنتلقاك لأنكِ اكتملت! إني باسمك اطلعهم على السر، باسمك أميتهم. ملفوف بأجنحتك حتى أصيرك، لأنوي وراءك في شيء. كم تغلغلوا! يا ملكي كم عيونهم نقّبت وانهاروا أمامها وعضّوا! تناسلوا متواعدين على الغلبة، وسقطوا بلا عيون لا نسل ولا فجر. ينتظم الانهيار أسواراً جديدة ستبقى"
إنها لغة السرطان الناهب لنسغ الحياة، لغة ترفض أمراضها، واعية هول الخطب، وشراسة المصاب، فتحاول لاهثة، مستفزة، مقاومة هذا القدر المؤلم والفرديّ، إذ هو مرض الوحدة القاتلة يقول:
"أسرطن العافية ، أهتك السرّ
عن غد السرطان"
لغة المرض الذي يأكل الروح ثم ينهش الجسد،
"يا قشّة البحر الوحيدة:
كسرتك لم أكسرك
سرطاناً أحوّل أسنة القاع إليّ، أذهب للباقي أضخّمه،
أفتح رمشه على جسده، ييأس، يجنّ، ويسرع.
لن"
ولكنه يحاول فكّ الطوق، وكسر الحصار لتخرج اللغة من وحدتها، وعزلتها الخانقة بكل فوضاها، وشواشها، وفقط ينجح حين يرسم الأخيلة يبلغ الآخر في قصائد من مثل:
"في أثرك"، "لأبقى"، "خطة"، "حوار"، "نحو لا أدري"، "ترتيلة مبعثرة"، "على ظفرك إلى ضعفي"، "الحب والذئب الحب وغيره"
وهنا تتجاوز اللغة في هذه القصائد اللغة تشوشها فتتسلسل، يقول:
" ألأنك موقتة؟ وقعتُ في التكرار، صرت أناديك "يا حبيبتي" ألف مرّة، يبست من طغيانك وفكّرت أن ألبّس بالرعد اشتعالي المترهل. النار، لكن! لا تُحشى، نسيت أن النار حريتك الناشبة في عنقي، أن ترابك لا يخترع، أن جناحي طيّ سرورك، يا فاعلة الجرح –استزيدك!– يا فاعلة الجرح في صدر منفاي، أتلوّى لتظفري في وتنيبي" .
وإذ تُعرب اللغة عن حرارة التوق إلى الإلتقاء، والاستعاضة عن قسوة الوحدة بحنو الإتحاد فإنها لغة تكثّر من أفعالها، لتكتسب الحيوية، والحرارة، والتوتّر، وتحذف الكثير من الإضافات والموضحات، حتى لتكاد الكلمات تأخذ بأعناق بعضها، دونما فواصل، مقرّبة المسافات ما بينها يقول:
" لم أؤذها
لست أراه ، أهي تراه ؟ وأنت ؟
لعلّك تعرفه .
أن تسكته . أول شيء : تسكته . تصوّر : يقف .
ويركض، يسيجني، ثم يدخل، يخرج ويتسلقني.
لم أستحقه ".
وهذا المقطع وحده يحتوي ستة عشر فعلاً من أصل إحدى وعشرين كلمة.
كما وأن اللغة في صورة وجملتها الاسميّة تتألف عنده من مبتدأ خبره يغعلب أن يكون جملية فعلية يقول على سبيل التمثيل لا الحصر:
- " الجياد تسرع ".
- " الباب يطرق ".
- " الحرب ستقع ".
- " الأحرف تتلاحق ".
ومن أجل تحقيق هذا التوق إلى الالتقاء فإن اللغة عنده تجعل من الفعل اللازم فعلاً متعدياً مباشرة على الضمير الذي كان حقه الإضافة فصار مفعولاً به ومن أمثلة ذلك قوله:
- " أحترق وببرود أدخلك ".
- " صرت أراك ".
- " أفكرك ".
- " ملفوف بأجنحتك حتى أصيرك ".
إنه في ديوانه هذا يلهب اللّغة بسياطه وهي "العبد الآبق" يجلده ليقول ما به، وليلحق ما يمور في أعماقه طالباً من اللّغة أن تكون على مثاله من التشوش، والحنق، والتمرّد. فتنضاف إلى المفردة عنده بذلك دلالات جديدة، على دلالاتها التاريخية، فيكسبها عبر تفاعلها مع العناصر
الأخرى كبناء درجة جديدة في سلّم الدلالات يقول:
"وفي العنق آذانٌ وسرِقَة"
فلفظة "آذان" التي تداهم القارئ بذخيرتها اللفظية السابقة تكسب دلالة جديدة، فالعنق هنا يحفها آذان، والآذان صوت النداء للصلاة، يرفعه المؤذن. وهو صوت الجمال يُرفع في النّاس عنده. أما "سرقة" فنحن نعرفها كفعل، ونعرف فاعلها. فكيف تتسق بالسياق؟ كيف تجتمع مع الآذان الذي هو الدعوة إلى الطهر، والنقاء، والعبادة بتقواها. إنها تسرق الناظر تسرق قلبه، وروحه.
المفردة عند أنسي الحاج مغلقة على ذاتها ومنفصلة عن زمانها، تظهر دلالتها في حضورها ضمن كليّة النص. الأمر الذي يفسّر شيوع كتابته للأسماء غير مُعرفّة، فالمفردة معرّفة بذاتها مستغنيةٌ ضمن سياقها عن أدوات التعريف اللغوية، والتخريب المتعمّد لأنساق اللغة، فالحذف لأحرف الوصل، ولأدوات الترقيم، والتقديم والتأخير، إنما يصبّ في غوغائيّة وفوضويّة اللغة وتشوّشها عنده، يقول:
"ليرى إذا الحرب ستقع"
يقول:
"جميع الفلاحين يحبون"
ويبدأ بحرف العطف في مطلع واحدة من قصائده قائلاً:
"فقد تملّكني الرّعب، لا أذكر".
ومادة الديوان اللغوية غنيّة بمثل هذه التجاوزات التي تؤكد ما ذهبنا إليه من فوضويّة، وتشوّش في اللغة.
وما ينبغي التنبه إليه جيداً في لغة أنسي الحاج خديعة اللغة عنده، إذ تعلن عن نفسها كلغة مضطربة، وبلا نظام خارجي فإنها تنتظم وفق بنية النص في نظام منضبط لا يحيد عن
أصوله وقوانينه الخاصة بالشاعر. وهي لغة أقدر ما تكون في إحالاتها على السريّ، والخفيّ في النص.
وبعد ثلاث سنوات طلع علينا أنسي بديوانه "الرأس المقطوع"، نلمح فوراً تغيّراً في اللغة إذ يحلّ محل التشوّش تسلسلٌ مستمدٌ من الأسلوب السرديّ، ومن انتظام النسق الزمانيّ داخل النصّ، يقول:
"كانت الصالة مغنية تجهل الرجال وتؤجّل الحكم في هذه القضية.
وقفز الخادم يتوجّه شعر رومنتيكي وبارك تلك الشجاعة وغادرها دون أن يضيف شيئا".
نلمح القص، والسرد، والتسلسل في الحدث والزمن.
ويقول: " قاطعه الأمير بجميع الوسائل، توجه إلى المسرحيّة حيث السائح يتأرجح على الحجارة. صعد إلى الأحداق وفرغ رشّاشه فانفصلت هالة.
وفي الصباح أصبحت فتاة مدرسة.
عاد الأمير فوافق. لكن الخبر لم يصله ...."
فهي لغة أقل تمزّقاً، وأكثر نزوعاً للتوحّد بالأخر، وأقلّ تمرداً، وإن اصطبغت بالصبغة اللازمة لها، والثابتة عنده، ألا وهي خلخلة الأنساق اللغوية المتعارف عليها، يقول:
" لكن إلى هنا فقط ويجب ان نذهب " .
والأصل قوله: " وعلينا أن نذهب ".
وفي قوله: " أيتها المرأة أخيراً " .
والأصل أن يقول : " أخيراً أيتها المرأة " .
وأداة الاستفهام كم هي للوزن، وهـو يستعملها خارج المألوف بقولـه:
"كم أريتـك لا يُخـفي شيئاً هذا التمثال".
والأصل استخدامه "كمـا".
وفي الديوان يتهكّم ويسخـر بكتابـة الكلمة في صورة إملائية خاطئة عن قصد هو التهكّم يقـول: "أيّهـا الحيكم" ، بدل قولـه "أيها الحكيم".
وحـين قال: "ألى الغـدُ يـا أعزئي !"
متهكّماً على حديث الأجنبي في القصيـدة والذي كان ينبغـي أن يكون "إلى الغد يا أعزائي".
ويستخدم لأول مرة (س) المستقبل أو التسويف فيقول:
" ستندلق، سترصّ " .
ويستخدم أسماء الديانات، والآيديولوجيات، والمدن، وفي طريقة تداعٍ، تسير على شاكلة طريقة الكتابة الحرّة الآلية التي تحدثنـا عنـها سابقاً يقول:
"من المسيحيين إلى العباقـرة إلى الفاشست إلى الماركسيت إلى الإغريق إلى البراهمة إلى الصارلييّن إلى الهوهويـيّن ..."
وقوله: " مـارد الصيـن نفخَنـي "
وقوله: " طروادة "
في الوقت الذي قلّت إلى حدّ الندرة الأسماء المذكورة في ديوانـه "لـَن".
وتقترب اللغة في هذا الديوان من القـارئ وتحاول أن تقنعـه ليقول:
" كما تـريـن كلّ كلمـة
أصدروا كلّ كلمة. "
وهي لغـة تتمحور حول موضوع الحبّ في إيروسيّـة• تقرّبهـا من التبسيط، والتوضيح فتتـسـلسل خفيفـة، ورشيقـة. مقارنة بلغتـه في "لَـن"، وبخاصّة لغته في "ماضي الأيـّام الآتـية":
"فجأة أخبرتني
واستغربتِ كيف صادف الإسم
وآلمني استغرابك فليس غير زوس
خليقاً بـك.
إله البرق والرياح والغيوم ...." .
حتـى في حديثه عن ذاته تشذّبـت حواف اللغة وأخذت تتحوّل إلى سلسلة، يقـول:
"قـلت: شعاع! حملنـي وجاوب: ماذا تشتهي؟
وأسـرع صبي من الصوف يجـرّ غيم الخرافات فدعاني ذلك للقول.
ولن يميّزني! فمحـوت القـول قائلاً: لا يكفيني" .
إننا لنحسّ بالفارق بين هذه اللغـة، ولغـة ديوان "لَـن"، يقـول:
"أصبحَ ارتحالي من فصلٍ إلـى فصـل
حجـة لتدبير الغداء بقصد ارتحالي آخـر.
وكما تتجـه الطيور بحكمـة
رحـت أدبّ من محيط إلى محـيط
من القمم إلى الأغصان
من ليل إلـى لـيل إلـى ليل
حتـى ضـُربت
بصيـت الجنون العـذب " .
وفي هذا الديوان يتوسّع المعجم فتستمـر ظاهـرة ذكر الأسماء، أسماء أشخاص، أسماء كائنات من الطبيعة، أسماء أشياء من المدنيـّة المعاصرة.
ومثال الأولى من قصيـدة "ناموا مع داناي" مطلعها الذي يقول فيه:
" يحمل رسالة تقول
أبو نواس هنا
أبو تمام
ابن الرومي
الشريف الرضي
الحلاج على حصان الحجّاج " .
والثانـية مثالها من نفس القصيدة الأسماء التي يذكرها: (تشارلي شابلن، هنري ميشو، برتـولد برخـت، جبران، دافنـشي، فيروز، بروتون، جـورج شحـادة، محمد فرعـون، داناي، فان غـوخ، شكسبير، رامبـو".
والثالثـة في قصيدة "محور الزئبق" إذ يذكر أسماء كائنات من الطبيعة من مثل: (القنافذ، العقارب، القبرات، الأحصنـة، النسـر، الصقـر، السرطان، الهدهد).
ونفس القصيدة يقول فيها: (مصـر، يونان).
أمّا المفردات التي تعبّر عن معالم أو أدوات مستخدمة في الحضارة المعاصرة فنجد منها: (الصمغ، شعشقـة الواجهات، المسدّس) .
في الوقت الذي ينفي عن نفسه القدرة على توظيف الرموز قائلاً:
" يصنفونك بالرموز وليتني
أحـسن وصفهم " .
وبالفعل الرمز على طريقة المدرسة الرمزيّـة غائب في لغـة أنسي الحاج وشعره.
إنها اللغة التي تؤكّد تمحور الشّاعر حول ذات أيروسيّة، ترى خلاصها في الحب، الذي يوحّدها بالآخر كما توحّد الصوفيّة عاشق الذات الألوهية بالله. هذا التمحور يأخذ شكله الأوضح، والأسطع في ديوان "ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة"، الذي يعلن فيه أنسي نفسه شاعر حب فيهـدي الديوان لها قائلاً: منكِ. ويقسّمه إلى قسمين:
1. أسير النهـر.
2. الكنار يطلق النار على نفسه.
وفي ثلاث وخمسين قصيدة وزّع مادته الشعرية. على جسومها سطّر لغته.
يقول في حديثه عن الحب كحالة أيروسية:
" انقلوني إلى جميع اللغات لتسمعني حبيبتي.
ثبتوها على كرسيّ وجهـوا وجهها إليّ
أمسكـوا رأسها نحوي فتركض إليّ.
لأني طويلاً وبّخـت نفسي ويأسي قد صار مارداً
أطيعـي دمعك يا حبيبتي فيطري الحصى
أطيعـي قلبك فيزيل السياج
ها هو العالم ينتهـي والمدن مفتوحة المدن خاليـة
جائعة أنت وندمي وليمة
أنت عطشانة وعيوني سود والرياح تلطمني " .
ويتابع بلغة أيروسيّـة:
" كان ضائعاً فلمّا وجدها
فرح على الأرض قليلاً
وطـار إلى السمـاء " .
إنها لغة تقول الهوى الأيروسيّ العنيف والأناني، الذي يهدّم ذاتََه، ويرتبط الحبّ فيها بالموت، فلا ينعم صاحبه بالاستقرار، ولا يلتذ بتملّك، وإنما يظل ينتقل من مرحلة إلى أخرى طامحاً في الخلاص وما الإندفاع، والإنفعال، والتمركز حـول الذات كما تدلّل لغـة الديوان إلاّ سمات الأيروسي الذي يقول:
1. " وما أحببتك إلا بدمار القلب " .
2. " أيتها المرأة يا حبيبتي دمّري دمري " .
3. " لن أغادر الحبّ لن أغادر حربي " .
4. " وما من راحـة تحت عهدك غير موتـك " .
5. " أتدمـر وفيكِ أدمّر كلّ امرأة " .
والأيروسية محاولة التطهّر من الإثم والخطايا التي تستبدل الله عند الصوفية بالمرأة في الأيروسية. فتتماهـى الذات وتتوحّد ذاتا المحب والمحبوبة.
يقـول :
- " أنا شعـوب من العشّاق " .
- " وحـين تمطر أنتظر مني المجيء فتجيئين " .
- " ودمي سأترك على الصخور
والشجر
ولسواحل الشمـس وكواحل الأدغال ....
فانظري إلى دمي ولا تقولي: كم حزين هذا
المنظر. بل قولي: كم هـو حي حبيبي وحبـه
في الجمر والشجر والبشر " . - " وتعطيني عيني فلا أرى غيرك " .
- " أسرعي أسرعي إلى المرآة.
سوف تريـن أنك متروكـة في نظـري " .
وفي المثال الأول نحن نقع على شموليّة الأنا، شموليّة تشابه شموليتها عند المتصوّفة.
وفي المثال الثاني تجسّد للإتحاد في المحبوبة كما هو الحال في الحلول عند المتصوّفة.
أما المثال الثالث فإحياء لصـورة بدائية كانت تمارسها الشعوب في طقس دمـوي يربط ما بين المحب وحبيبته، إذ تسقي الزوجة زوجها نبيذاً فيه بضع قطرات من دمهـا، كما أن أهل قريش كانوا يسكبون من دمائهم على الأوثان في طقس بدائي تعبّدي.
والمثال الرابع يصير العاشق مرآة معشوقـة وفيه من الصوفيـة قول ابن عربي:
وإن تبدى حبـيـبي بـأي عـيـن أراه؟
بعـينه لا بعـينـي فَليـس غيره يـراه.
واللغة في هذا الديوان تكشف عن تناقض بين الأيروسيّة والمسيحيـة التي تتصل مباشرة بالله، وتخلع حبه على الإنسان مقابل الصوفيّـة أو الأيروسيـة، التي تتمركز حول الإنسان جاعلة منه برزخاً إلى الله، وينتج هذا الصراع، كآبة، و قهر إذ لا ينتصر الجسد ولا تنتصـر الروح.
فماذا فعل بالذهب، ماذا فعل بالوردة ؟، (لقد فشل في حمل مجد الإثنين، وما اللغة في الديوان إلا تنفيس عن أيروسية محمومة وحادة وتوق إلى أغابيّة مسيحية قاهرة) ، إنها قوّة الذهب وصلابته في صراعها ضد اللين وعذوبة الوردة، إنه صراع دَفَع أسير النهر إلى إطلاق النار على نفسه.
وفي لغته في الديوان نبـرة تذكّر "بنشيد الإنـشاد" وبخاصّة في قصيدة: "ماذا صنعت بالذهب. ماذا فعـلت بالوردة ؟"، التي يُصرّ فيها على فعل الكينونة فيقول:
" سـوف يكون ما سوف يكـون
سـوف هناك يكون حبّنا " .
" وسـوف كثيراً نكـون " .
وما زال يـُعدّي الفعل اللازم في ديوانه يقـول:
" لـقد وقَعتُها وتهتهـا
لــقد غِرتهـا " .
وكذلك نلحظ تعليقـه للمعنى حين يقول:
-- " في يوم صار ! .. " .
-- " إن كتبت شعري فلأنـهن " .
وكأنه يترك للقارئ إكمال المشهد ويفتح نهاية الأشياء لمخيلة المتتبّع، والراصد للمعنـى والصورة على طريقـة الإخراج السينمائي الحديـث.
أمـّا الحكاية الخرافية فتتزيّن بحسّ ساخر متهكّم لصدورها عن ذات متمركزة حَول نفسها، تـرى الكونَ من خلالها.
وباختصار لغة ديوانه هذا، تمهّد لقصيدة الحب الطويلـة "الرسولة بشعرها الطويل حتـى الينابيع"، والذي تنتصر فيه المحبوبة وحبها فيهديها الديوانَ بقولـه: "مغلوبك" .
وليدعـو طالبـاً العـونَ :
" ساعدنـي
ليكـن فيّ جميع الشعراء
لأن الوديعـة أكبر من يدي " .
لغـة عذبـة تشفّ عن ماسوشيّـة تعيـد صياغـة قصـة التكوين :
" فالطريق حبيبتي
قادم من انتظارها لي
قادم من رجوعي إليها " .
" هي قصـتك
قصـة الوجه الآخـر من التكوين " .
لـقد قـرّ في ديوانه هذا على الحب ، فانساحت لغته لتغمـر الحالـة . يقـول :
" اسمح لي يا الله
أن أتذكـر خطيئتـي
أن أتذكـر عن جمـيع آبائـي
أن أتعذّب ندمهـم وأنهـار توبتهـم
أمـام حبيبـتي " .
ويقـول : " حبـك حيـّاني في الاضطراب واستقبلنـي
في اليقـين
أدخلـني وخلّصـني
حررنـي من الصراع الأحمـق وسقـاني
خمـر العـرس
صفـاني وأبدعـني " .
ويتابـع : " أغنـيك يا حبيبتـي
من أجل أن ألامس حياتهم شيئاً
ممـا تلامسـين حيـاتي
من أجل أغمرهم بالأسرار التي تضيء
القـلب وبالقـلب الذي يضيء الأسـرار
بـعض ما تغمريـن قلبي وأسراري "
بلغـة ما زال يعدّي فيها الفعل اللازم فيقول:
-- " اختبأتنـي
-- أطلّـتـنـي
صاحتـني " .
وفي ديوانه توظيف للطقوس المسيحيـّة من مثل قولـه:
" كللوا رؤوسكم بذهب الدخـول
واحرقوا وراءكم
احرقا وراءكم
احرقوا العالم بشمس العـودة " .
لينقل أنسي من هذه اللغة العذبة الشفيفة إلى لغة الإشراق، الموجزة في ديوانه "خواتم"، في مفردات سهلة صاغ معانيه، فتخلّصت لغته من شواشها ووصلت إلى نقاء، قربها من لغة النثر يقول:
-- " كل عبـارة خيانـة . " .
-- " الغنـاء تبرّج الشعـر " .
-- " الجارح أن الصمت لا يستطيع دائماً وحده التعبير عن الصمت " .
-- " الكلام إثبات الغيـاب " .
-- " بعض الشعـر: الخوف مصروخاً في وجهه " .
لتأتي "الوليمـة" بأجزائها الأربعـة: (يا شفـير هاويتي، سراج الليل، الهارب والوليمة) لتقول بيان الختام الشعر عند أنسي، بلغة قطّرتها الخيبة، فتخلّصت من توتّرها وصاغت هدوءها، وتركت عنها توتّرها وصاغت رقتها، وعذوبتها، وينسحب هذا الكلام على اللغة التي تقول حبه أو ذاته.
- " كان الفجر روح الليل
والعمر سهماً مسمومـاً
ولمّا انقشع الجبيـن وتطهـّر السهم
تحطّمـت الدنيـا " .
- " الحب زهـرة الشفقـة " .
- " أقـوم
ولا أنـادي
أنـزل بين النـور والظلام
وقد تعانقـت في صـدري الحياة وأشباهها
ومن رأسي إلى رأسي
أرتـمي
ولا تعرفني بعد اليوم عيناي " .
لغـة صَفتْ، عَذبتْ، ورَقـتْ يقول:
"هلّمي نتبادل هدايا ألغازنا، فما أطيب تسليمنا مفاتيحها واحدنا للآخر، أليس هو اكتشافاً لذاكرتنا الطبيعية، ذاكرة الشلاّلات؟"
إنها اللّغة التي صاغتها حكمة الأيام وتجاربها فتركت عنها عنف التمرّد، وقسوة الوحدة، وخيبة الذات لتقول الحبّ الذي هو وليمة الجائع:
- " أنت
أيتها المطـلة بيـن أعماق عينيها
يا امرأة السنابل
يا شفير هاويتي
تخترعين لي الحياة كلما انتهـت ...
حدودها انتظارنا
وقلبها وحدك يا حريـة " .
إنها الحريّـة يصل إليهـا. حريـة الحبّ التي كان يجأر منادياً إياها في ديوانه "لـَن"، موظفاً كل أدواته، وعلى رأسه اللغـة، والتي صورت قلقه ونوازعـه، وشواشه، وفوضاه، وتمرّده. ليصل بها إلى التدفّق العذب، والسيلان الشفيف. وبالمقاربة ما بين نص ورد في "لَن" وآخـر في "الوليمـة" يقول في الأوّل:
" رأيت مخزراً يحفر بطن حامل وخنزيراً تراوده فراشة. بصوت مرتفع
ذهبت في الطريق. نكحـت من بؤبؤي وعلى الورقة كتبت بياضاً.
العصافير صارت، لهذا السبب، تدعـوني لتغيير طريقي.
إن حكايتي سخيفـة أيّهـا الحدّاد " .
في مقابل نص من "الوليمـة" من قصيدة بعنوان "ورائـي" ، يقول فيهـا:
" أريدك صديقي أيّـها العالم
وعندما أنظـر إليك
أهـرب منك!
وإذا جـدّد الإلهام خَلْقـي
ونظـرت إليك لأراك بِكر المشاهـد
ألقـاني في محيط غـَريب
كلما توغّلت فيه تضاعفت غربتـي. " .
والمقارنـة ما بين النصين تؤكد ما ذهبنا إليه مِن:
- انتقال اللغـة من الشوّاش إلى العذوبـة.
- انشحان اللغـة بالشفافية عوض التـوتر في لغة ديوانه "لَن".
- خلخلـة أنساق اللغـة صارت تأتي في "الوليمـة"، عفـو الخـاطر، يقـول:
"أنا الذي كان يظنـّك تركض ورائي" . - تلاشت المفردات "المتواقحـة" –إن صحّت التسمية– لتحلّ محلها مفردة عذبة، متناغمة. يقول في "لـَن": تراوده ، في حين يستخدم في "الوليمة" "لم أفطن" .
وعن معجم أنسي نقول أنه يصدر عن معجم ذاتي، يمتاح أو يأخـذ من ذاته، وتتّسم مفرداته بانفلاتها، وانفصالها عن زمانها وتاريخها معاً، فتظل المفردة خارجيّة في حديثها عن العالم وأشيائه، يقـول في هذا المعنـى:
" اللفظة أيتها الأمواج الغبـار الطائر الأزهـار الألوان أيتها الأشيـاء
والعناصر يا أغصان النـساء وغرف الحـلم والأحداق رؤى الجلاتـين أيتها الدمعـة اركضوا إلى المجزرة قرقعـة عظمـي نشـيد يقظتكم اقطعوا الشـاعر ونسـلَه .
في الوقـت الذي تكتسب المفردة التي يتحدث فيها عن ذاته ثقلاً لأنها تخرج من أعمـاقـه ودواخلـه يقـول:
" تستـحقّ. كفكف هذا الحزن جلّس قامتـك. خذها، كلمتك السيـف .
ولا يدّخر وسعاً في شحن اللغة بوزن وثقل داخليـين يعبّران عن ذات متمحورة حول نفسها، فيستخدم صيَغَ المبالغـة، وأفعال الأمر، وتعدية الفعل اللازم، وحذف حروف العطف، وغيره من الخصائص التي دلّلنا عليها واستشهدنا بها في دواوينـه.
وعليه فإن اللغـة موظّفـة لرسم أعماق الشاعر، ورصدها، وتتبّع اللغة كاشف عن تغيّرات في بنية الشاعر الوجدانية، وعن نقـلة ما بين الشباب والنضج في الرؤية والموقف، تغيّر من التمـرد والرفض، والهدم، إلى الاعتراف بدور الواقع وأثره. هي لغـة ترسم صوراً ولا تنقل أخباراً. لغـة استعاضت عن شواشها وغوغائيتها بالرقّـة والخيبَة. لغة اكتسبت المفردة دلالات جديدة، ووظّفتـها في سياقات مغايرة لسياقاتها المألوفـة والمتعارف عليها. لغـة رفضت في بدايتها وبقوة الغنائيـة، وظلّت تجرّد وتجـرّد، إلى أن تقطّرت فارتدت إلـى غنائية رقيقـة وجدناها في ديوان "الوليمـة". غنائيـة ظلّـت بأسلوب أنسي الحاج في الكتابـة، ولا أدلَّ على ذلك من قولـه "فلأقـع في هواياه لا لأغرقَ بل لأجعَلـه، فجأة، يَفديني باختناقـه!" . خلخلـةُ متقصّدة لأنساق اللغـة، تحصّل عليها بإضافة ياء المتكلم، وهاء الغائب كضميرين اشتركا في فـعل واحد هـو (إيـّاه).
هـ. الصور الشعريـة:
1. مفهوم الصورة الشّعرية:
من المتفق عليه أن مفهوم الصورة الشعرية لم يكـن في الدراسات النقديّة التراثيـة العربية يتجاوز حدود البلاغـة الإجرائيـة، وإن الدراسات النقديـة الحديثـة قد اكسبته دلالات جديدة، وعمقاً وشمولاً.
وإذا كانت مقولـة (سيمونبدس) "الرسم شعر صامت، والشعر لوحـة ناطقـة" ، وما ذهب إليه الجاحظ إلى أن الشعر صياغة، وضرب من التصوير، وأنّ الصورة في الشعـر تقابل المادّة في الطبيعـة، كما يرى قدامـة بن جعفـر، فإن هذا النـظر النقديّ القديم للصورة قد شكّل أرضيّة انطلق منها النقد الحديث في دراساته للصورة الشعريّـة مؤكداً ما ذهب إليه الأقدمون.
يقـول (س. دي لويس) عن الشعـر والصورة: "رسم قوامـه الكلمات، إن الوصف والمجاز والتشبيه يمكن أن تخلق صورة، أو أن الصورة يمكن أن تُـقدّم إلينا في عبـارة أو جمـلة يغلب عليها الوصف المحض، ولكنها توصل إلى خيالنا شيئاً أكثـرَ من انعكاس متقن للحقيقة الخارجـيّة" ، ومن هنـا بالضّبـط انطلق النقد الحديث مستفيداً من التراث النقديّ الإنسانيّ، الذي تعامل مع الصورة من حيث هي وصف، وتشبيه، ومجازاً مضيفاً الإعتراف بانتقائية الصورة الشعرية، فاختيارها ملتحم بجذور التجربة المحسوسة للشـاعر، خاضع لخصاله الشّخصية، مؤكداً عضويتها، وفاعليتها في مبنـى النصّ الكلي فصارت (عنصراً حيوياًّ من عناصر التكوين النفسي للتجربـة الشعريّة، وتبلورها اللغوي في بنـية معقّدة متشابهـة لها نموّها الداخلي الفَرد وتفاعلاتهـا الفنـيّـة) ، متجاوزة بذلك المقولات النقديـة التراثيـة التي ترى كما يرى ابن جني "أن اللغة كلها مجاز" ، مؤكـدة أنّ من الخطأ أن ننظر إلى الصورة على أنها زخرفة وحسب". وإنما غدت وبحسب تعبير (نوفاليس): "تصوير للكنـه النفسيّ كما هي تصوير للعالم الداخلي" ، وصارت دراستها تتعمـّد تقصّي السيرة النفسيـة للصورة، واصطياد الرسالـة الكامنـة فيهـا.
2. الصورة الشعريّة عـند أنسي الحاج :
أ. الشعر عند أنسي الحاج شعر صوريّ، يعتمد الصورة، التي تتوزّع داخل النصّ على طريقـة (الكولاج) إذ يلتقط من مخزونه النفسيّ، والمعرفي صوراً، فيلصقها، جامعاً إيّاها في إطار القصيدة الواحدة، ضمن مبنى النصّ الكلـّي، يقـول:
"يجب أن أبكي، كيف نسيت أن الدموع تعكّر المرايا؟ المرآة غابة لكن الدمعة فدائي فلأسمعَ جـلبتك أيتها الرفيقـة! فلأرفع لواءك حتى تتقطّع أوتار كتفـي" .
وبالنظر إلى الجانب الإجرائيّ من الصورة بمفهومها البلاغيّ القديم. فإن الدموع تعكّر المرايا، فيها المرآة تشبه البحيرة بجامـع الصـفاء، والبحـيرة تتعكـر بما يقذف فيها، وهي هنا تتعكّر بالدمـع؛ دمـع الخطيئـة والندم الذي يعكّر صفـو المرآة البحـيرة.
هذا الجانب الإجرائي الذي يفكّك أجزاء الصورة، يتجاوزه النقد الحديث، باحثاً عن دلالـة
الصـورة ضمن المبنـى الكلي للنصّ، فتتحوّل من صورة جزئية إلى عضو فاعل في النصّ. الشاعر يشعـر بألم يدفعه إلى الرغبـة في البكاء، تصل حدّ الواجب، ليخفّف ويهوّن بذلك عن نفسه فيقول: "يجـب أن أبكـي"، ثم يذكّر نفـسَه: "كـيف نسيت أن الدمـوع تعكـر المرايا؟"، إلا أن السؤال يحتمل معـنيـين، التردّد عـن البكاء لوهلة، والتحريض عليه، والسياق الشكلي للنصّ يؤكـد هذا الأخـير، فتعكـير صفـو المرأة مطلب، وتعكيرهـا بالدمع غاية، فالمرآة غابـة من حيث هي انعكاس الواقـع اللاإنساني بجامع التضحيـة، والفداء، فليسمع جلبة الدمع الرفيق، رفيق العذاب، والمرارة، ولها للدمعة يرفع لواءها حتـى تتقطـّع أوتار كفه.
بهذا الكشف عن الصورة ودلالاتها داخل النص يمكن التوغّل في المنطقـة المسكوت عنها، والوصول إلى دهاليز الشاعر، والعثور على مفاتيح بواباته الغامضة والسريّة. لنقول بعد الاستئناس بالصـور الجزئية، وربطها ضمن الصورة الكليّـة أن أنسي الحاج في حاجـة للبكاء، الذي يخفف حدّة التوتر والاحتقان اللذين يعذبانـه، وأنه يحب الدمع الذي يعكـّر صفو المرايا بما هي انعكـاس للواقع، فالدمعة فدائي يواجه في الغابـة مصيرَه، فدائي يأمر الدمعة أن تصدر جلبتها، ويـأمر نفسـه برفع لواء الدمع حتـى تتقطّع أوتار كتـفه.
ومن الواضح أن الصور عند أنـسي الحاج إذا ما أخذت مجزوءة ، أو اقتطعت عن سياقها في النصّ، فإنها تبدو صورة غامضة بلا معنى، وأن الذي يكسبها دلالتـها موقعهـا في النصّ بكليّتـه. الأمـر الذي دفعنـا إلى تسميتهـا بالصورة (الكولاجيـة) يقـول:
"غموض وكَـلَـبٌ! تلك الواقعة يغطيها حَرُّ التفكير فيهـا. لن تقف على الشاطئ لتتأمّلَ البحـرَ بل لتخـوض بأحلامك في الأفق. لم لا يقابل العالق بينها؟ آه الجدار!
الفكـر فاقـد الاسم والزئبق مات والكلمات بنات " .
صورتَي الزئبَق مات والكلمات بنات، إلامَ ترميان في النّصّ؟
وبرد الصورتين إلى سياقهما في النصّ، تتكشّف لنا سيرتهما النفسيّة فيه، فالمنفلت والمتمرّد والباحث عن الحريّة وسط ركام الواقع ميّت، وهذا قدره، وأدوات التعبير خائبـة وخجـلة.
وإذ تؤكـّد هذه الوقفات المتتبّعة لطبيعة الصورة عند أنسي على الوقوف عنـد حدود الصورة الجزئيـة في النصّ، وضرورة إلحاق الصورة الجزئية بتلك الكليّـة، التي تنير عتمـة الأولى، وتضيء فضاء الأخيرة، يقـول أنـسي:
"رفعت ضحكك وهربت، من صداك سقطت كإجاصة، سماء جلدك لانت على وجعي. هاجع تحت سرعتك مسمّر بنظري وكلاب الصيد حنطها أزيز روحك. ذهبتِ وكلّ هبوب بساط لك. جميع أطرافك سفن ورياح" .
الصور الجزئية في هذه المقاطع:
- رفعـت ضحكك.
- سقطتُ كإجاصة.
- تحت سرعتك مسمّر بنظري.
- كلاب الصـيد حنطهـا.
- أزيـز مرحك.
- كل هبـوب بسـاط لـكِ.
- جمـيع أطرافك سفـن ورياح.
وتفكيك هذه الصور، وفصلها عن مبناها مقـتَل للنصّ الشعـريّ، وردّها إلـى مبناها فـيه، وسياقها، كاشف أبعادها النفسية عنـد المبدع، وناقل للملتقي إلى المساحة الإيحائية داخله، فمثلاً قوله: "رفعت ضحكَكِ"، قال "رفـعت"، ولم يقل "أخذت" مثلاً، وفي الأخـذ حرمان فكأنها رفعـت هماًّ أو عبئاً وأزاحته عنهُ، إذ يشعر أثناءَ وجودها معه بالثقل الذي رفعَته بهروبها؛ فسـقَطَ كإجاصة، اكتشفَ ما أصابَهُ، فكما الإجاصة تسقط عـند نضجها واكتمالها صوب مركز جاذبيتها الأرض، سقط هو من صدى الضحكة المتبقي، وكأنه اكتشف نضجـهُ واكتمال دورته الحياتية في فعل يشابه ما يحدث للإجاصة التي تعلن تمـام النضج بالسقـوط، فقـد صـارَ في تمام الحبّ بعد أن غابـَت .
و "جلدها سماء" بامتدادها وتشكّلاتها وتغيراتها، وحالاتها، جلدها سماء لانت، وفي الليل رقة ورفق، فكأنه أرض بور، وهي السماء التي تلين على وجع الأرض العطشى فتسقيهـا، وإنه جلدها الذي غطّى الأرضَ، غطّاه، وبه هجعة تراقب سرعتها، وعيون مسمّرة النظرات على غيابها السريع ناقلاً إلينا سلبيّته في مقاومة ذهابها.
أمّـا كلاب الصيد المختصّـة بقنص الفرائس، المدرّبـة على الإيقاع بها، فقد تحنّطت بفعل أزيز مرَحها، والأزيز صوت مزعـج فكأنّ لمرحها أزيز، أوقف فعل كلاب الصيد، وخلاّهـا محنّطـة.
ولقد ذهبتُ وهـو يبارك هذا الذهاب، فكلّ هبـوب بساط يحملها بعيداً، ذهبت وأطرافها سفـن ورياح؛ فكأن أقدامها رياح –ولم يقـُل ريـح-، والرياح في اللغة مختصة في الخير والريح للشر، استسلمت لها سفن الذراعَـين فصارت تجذّف باتجاهها بعـيداً عـنه.
والقطعـة السابقة لا بدّ من ردّها بصورها الجزئية للنص كاملاً، لتنكشفَ دلالات جديدة بحسب سياقها.
يقـول أيضاً:
" عندئذ تتهامس المرأة والخنجـر قرارات اللحظـة.
والأسبـاب تهـرب ...
عـن الصمـت الذي يهـدّد بالرسـوّ الفاجـر.
وحده في البـئر " .
صور ترسم لوحة سريالية، بعـيدة عن المنطق، يصعب تفسيرها وفق العلائق الخارجية للأشيـاء، يقـول في ديوانه "ماذا صنعت بالذهب ماذا فعـلت بالوردة ؟":
" كعنـق وردة
ابتهلت إلى حريّتي
التي
لم
تـقدر
أن تفعـل
شيئـاً " .
إنه شعر الصورة أو الشعر الصوريّ الذي يعتمد الصورة في تشكيل حالاته.
ب. الصـورة الداخليـة:
الصور التي تنتسب إلى العالم الخارجي كقولنا: (وحيد كشجرة ميتة)، والتي تحاكي العالم الخارجي بأشيائه وتتشبه به صور قليلة عـند أنسي الحاج، فالطبيعة والمرأة كشكـل أو كعنصر جماليّ خارجيٍّ غائبتان في شعره. ومن الصور القليلة التي تنتمي إلى العالم الخارجيّ قوله في ديوان "لَـن": "انتحبَ كسنبـلة يابسـة في الريـح" .
وفيها نمسّ نفسية الشاعر من خلال تصويره لحال السنبلة اليابسة التي تنتحب، معذَّبة تحتَ وطأة ريحٍ تتجاذبها وهي اليابسة، الهشّة، وحاله من حالها. ومقابل هذه الصور الخارجية نجد أنسي الحاجّ يعتمد الصور الداخلية والتي هي أقرب إلى عالمه وأكثر حميميّة بالنسبة له يقـول:
-- " أهرّّبُ هدفي وأصِلُ قبـله " .
-- " رفعتُ ضكك وهربت " .
-- " من يديّ سقطت حديقته " .
-- " مأخوذاً أيتها الملسوعة بمجاعتي " .
-- " من جثتي مهما كان الزمان تفوح الجنة وينساب جفاف الجحيم " .
-- " الأمر نبرتـي، أهشّم خطوي وظلّه " .
-- " وفحـيح صمغك الروحيّ " .
-- " حنجرتي الشياه الضالة رماد المراثي والمزامير شعره آكل القنديل أنفخ الشبح، أتسطّح على روابي الكلمة" .
-- " أطلعت من كبريائها ذئباً على وجهي
غاب وجهـي " .
هذه الصور الداخليّة، هي المسؤولة عن الغموض الذي يُتهم به شعر أنسي الحاج، وذلك لصعوبة تفسير هذه الصور ضمن شبكـة العلاقات الخارجيّة، التي تحتكم إليها الصور الخارجيّة عادةً.
هذه الصور الداخليّة تغيب في دواوين أنسي التي تتحدث عن الحب كموضوع ، وبخاصّة في ديوانه "الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع"، لتحلّ محلها صور خارجية، نمثـّل عليها من الديوان قوله:
" اغرس حبيبتي ولا تقتلـها
زوّدها أعمـار لم تـأت
عززها بأعمـاري الآتيـة
أبق ورقهـا أخضـر " .
ويقـول : " كاليابسـة انفصل عن الماء
كالشجـر اقتلع نفسه من اليابسـة
تحت الطمـع انشقّ " .
ويقول : " لم تحقد كناحيـة قاحـلة " .
- " وجههـا ينتظـر كالبحـيرة المسحـورة " .
- " كانت الفضائل تعبـر حـولي كخضاب مهزوم " .
تنتصر في هذا الديوان الصورة الخارجية إذ يتعانق الشاعر مع الآخر عبر الحبّ يقول:
-- " تسهريـن فيّ كسجينـةٍ " .
-- " تسهرين فـيّ كاللـهب في السراج
كالعناية فوق المسافـِر " .
-- " فأسير كسـيّد يحمل المفاتيـح " .
-- " أنتِ الخفيفة كريش النـّعام " .
-- " بالصدق كالسكـران " .
-- " ورياح الغيرةِ تسوقـني كالغبـار " .
-- " النهـر ضحكـة ولونها وردة " .
-- " كزنبقـةٍ ارتميتُ عـند قاعـدة عرشـك " .
-- " مـا أقل حبـي يظنـونـه كالسَّـيل " .
-- " فنشبـت كالرّمـح " .
-- " اختبأتَني كعصفـور من العاصفـة " .
-- " أطلّتني كجزيـرة للراصـد في أعـلى السـاريـة " .
-- " أقسم أن أنطفئ لسعادتك كنجوم النهـار " .
صور تنتسب إلى عالم المرئيـات، متّصلة بالعالم المحيط، تعرض شكلاً، وتقابل لوحة انطباعية، ومثل هذه الصور إنما تظهر في حديثه عن الحبّ، في مقابل الصور الوحشة الداخليّة، الغرائبية، والكولاجية، التي تكشف عن مساحة من البعد ما بينَه وبين العالم الخارجيّ، سببها وحدته، وعزلتهُ، وفقده الصلة، فمثلاً في قصيدته "نحـو لا أدري" :
أ. الصور الجزئية التي جاءت فيـه :
- الفسحة التي تطـوي نفسها وتنشـره.
- هودجيـة.
- ينعدم الطقـس.
- تبرأ اللفظـة.
- لا جرحَ على ملح قلبيَنـا.
ب. الصورة الكليّـة ضمن كليّـة النـصّ والتي تعضدها الصور الجزئيـة.
وتبدأ القصيدة بصوت من يطلب أن يحملَ من قبل الآخرين الذين يرفضون طلبه ، فيؤكد مستخدماً سين التسويف المستقبلية أن سيفعلون. ثمّ يتـجه بطلبه إلى الأنثى مخاطباً إيّاها (احمليـني) التي تحيل إلى عنوان القصيدة –الذي هو جزء منها– " نحوَ لا أدري"، والتي تؤكد أنه غير مهتمّ بتحديد الوجهة، الذي يريد أن يُحمل إليها، ولكنّه متأكدٌ فقط من أنه يريد أن يُحمل بعيداً عن هنا، عن الواقع، عن الحقيقة المنطقية، عن اللحظة الآنية، وفي خطابه الموجّه إلى الأنثى، لا ينتظر إجابة منها وكأنها غير موجودة، فيشرع في وصف المكان الذي يريد أن يُحمل إليه غير منتظر لإجابتها. فيقـول: "إلى الفسحة التي تطوي نفسها وتنشـرها"
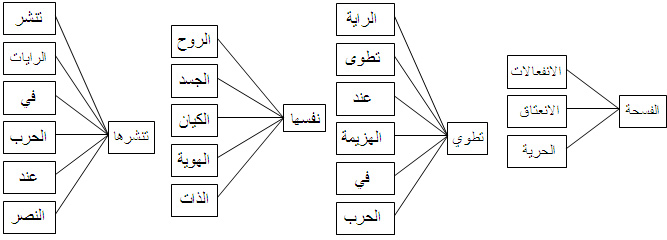
و يتابع وصف الفسحة بصورة جاء فيها: (هودجيـة وسريعـة)، هودجية نسبـة إلى الهودج، وهو ما يوضع على الإبل، وتقَرّ فيها النساء أثناء الرحلة في الصحراء، وفي حركة الهودج المرتبطة، بحركة الإبـل، إيقاع ثابت يعيل عليه الشاعر، وباستدعاء دلالات اللفظ فإنّ:
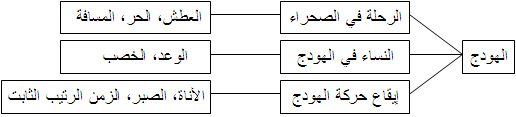
إنّها حركة الزمن المنتظمة في رحلته الصعبة، والشاقة، والمحملة بأمل الوعد، إلا أنّ صبر الشاعر قَد عيل، فاستخدامه للكلمة السريعةِ المعطوفة عى الهودجيّة، دعوة الانتقال السريـع، ليتابع وصف الفسحة التي هيَ "بلا نهاية ولا انفعال"، فكأنها الديمومة، والفردوس الموعود بما تمليه من سكون، وخلود، ليضيف: "في أقصى العيد حيث ينعدم الطقس وتبرأ اللفظة"، إنه زمن تنامي الفرحة واكتمالها، حيث يفقد الطقس سلطته وسطوته، فتنعدم علائمه فلا حرّ ولا قرّ، وتعود اللفظة إلى حالتها الأولى، البراءة بعد اتهامها بالعجز عن التعبير، وقد حدّد أنهما معاً، من غير أن يأخذ بعين الاعتبار موقفها، ولا ردّها على سؤاله الطلبي، إنها لتحمله بحنـو وفَرح معاً، وكأنها أمه فينطلقان بلا ماء إذ يستغنيان عن سرّ الحياة "المـاء"، في هذه الفسحة التي هي الحياة الأبيّـة فما حاجتهما إلى ما يحفظ الحياة، وهما الحياة، فيحلّقان بما في التحليق من أمل، وانعتاق، ومعانقة للنور، وبهذا المنظر النقديّ يتمّ التعامل مع الصورة الكليّـة ضمن بنية النصّ.
مصادر الصورة الذاتية:
الصورة عـند أنسي الحاج صورة داخلية تنتظم داخل إطار كليّة النصّ، وهي صورة تدرّجت من الغرائبية في ديوانه "لن"، فانتقلت إلى العالم الخارجي، لتشاببه وتتماس معه في حديثه عن الحب، ولكنها ظلّت صورة داخلية في حديثه عن نفسه، كما تبيّن لنا من خلال الدراسة النقديّة لِكُنْه الصورة عنده.
والسؤال الآن ما هي المصادر التي غذّت الصورة عنده، وحفظت لعواطفه وأفكاره أصالتها (فقدّمتها إلى الآخرين في صورتها الخاصّة، تلك الصورة التي تتولد تلقائياً مع الشعور نفسه أو الفكرة" ، فتتحقّق (الصورة الكاملة النفسيّة أو الكونيّة للشاعر حين يفكّر في أمر من الأمور تفكيراً ينم عن عميق شعوره وإحساسه، فيرجع إلى اقتناع ذاتي وإخلاص فنيّ ) .
1. المصادر الثقافيّة:
تتعدّد المصادر الثقافية التي ينهل منها الشاعر. إذ هي شبكة العلاقات التي تربطه بالواقع والمحيط به، والتي تُحدد زاوية رؤيته، وموقفه من الحياة، فيتعامل وبدمج ذاته بها، ومعها – مع إبداعه الذي هـو محصّلة التقاء سماتهِ وخصائِصـهِ النفسية بمحيطه وواقعه.
أ. الطقـوس :
ترتبط الصورة عنـد أنسي الحاج بالطقوس ببعديها؛ الطقوس البدائية والطقوس الدينية، وكمثال على الأولى يقول:
" ودمي سأترك على الصخـور
والشجـر
وسواحل الشمس وكواحل الأدغال ... " .
يستحضر الطقوس البدائيـة التي كانت بموجبها تقدّم الزوجـة لزوجها كأساً من النبيذ فيه قطرات من دمها، ليحـيى الحبّ بينهمـا ويدوم.
وكمثال عـلى الثانيـة قـولـه :
-- " تخاطبك الأناجـيل المختـارة بالأسماء المختارة " .
-- " أغمض عيني لأصـلـب وهمك عـلى شهـوتي " .
-- " عذراء تعالي، أردّك عذراء. " .
-- " وعلى المركب شهواتنا الطافـي فـوق آلام الاختيار
حملنا وطنـاً، وهرّبنا شعبـاً
وفي نجوم عيوننـا أسكنا الهواء الهـارب " .
-- " جسـدي يقـرع كالأجراس " .
-- " وينتاول النهـار على نهـدي العشيّـة الأب والابن والروح القدس " .
كما وأنه يوظّف الطقوس الهندوسية التي تفرض على المرأة التي يموت زوجها أن تُحرقَ معه، وفي نفـس النـّار التي تلتهمُ جثّتـه فيقول:
-- " وتستحقّيـن أن يضرمَ حبيبكِ النـار في جسده وينتحـر
احتجاجاً لأنك لا تعرفـين كم أنتِ وحدكِ ".
وفي إشارة إلى العمّاد المسيحيّ، وقصّـة تعميد السيّد المسيح عليه السلام في نهر الأردنّ يقول:
"وحملتُ الهاوية
فلما رأتك اعتمدتُ في نهر الأردن" .
1. القراءات لحضارات وأساطير الأمم السابقة:
الصورة عند أنسي الحاج تغتني بقراءاته المعرفيّة لحضارات وأساطير الأمم السابقة ومن ذلك قوله:
-- " يعود التاريخ إلى أيل وبعـل
طبعوني في جلجامش وتربّيـتُ
في أوغاريت
صور سيدون بيبلـوس
زارت معـيَ اليـونان
زخرفـني الفـرس واشترى العبرانيّـون
مقاطعَ من إنتاجـي
بسَطَني المصريّـون في تصـوير الكائنات الحيـّة
وامتزجـت بـي عشتروت عـن طريق الكـحْل " .
ونجدهُ يوظّف أيضاً قصّـة مصباح علاء الدين السحريّ فيقـول:
" لي ثقـة عمياء في الرباط الأسـود. أهو عيب عندكَ ؟
لكنه مصباح علاء الدين. ولولا خوفي أن أباغتك لقلت:
يداك تحملانه معي" .
فيكتسب المصباح وقصته دلالة جديدة في هذا التوظيف، ولا يظل عند حدود الدلالات التي نعرفها من يقظة المارد، واستجابته لعلاء الدي، وتلبية لشروطه الثلاث. فهي هنا مربوطة بالوثاق الأسود الذي يثق فيه الشاعر ثقة عمياء، فالصورة لونيّة، وهذا الرباط الأسود هو مصباح علاء الدين الذي يحقق للشاعر أمنياته، وهو الذي تستهجنه الأنثى التي يتحدّث معها في القصيدة .
أما حكاية ألف ليلة وليلة فإن أنسي الحاج يوظفها في نتاجه مرتين يقول :
" أزهرت فجأة شمسها
شهرزاد !
كتاب يصيح " .
وفي المرة الثانية يجعل من نفسه شهريار الذي يطلب من وزيره على عادته إحضار فتاة، فتتبرّع ابنة الوزير بأن تنوب عن بنات المدينة، فيقتلها والفارق ما بينه وبين شهريار أنها قتلته أيضاً، يقول :
" والفرق بيني وبين شهريار الأبله
أنها أيضا قتلتني" .
وقصة ديك الجن الحمصي الذي ذبح ورد من الوريد إلى الوريد يعيد توظيفها بقوله:
" هجم يذبح جدّه في حديقته، من الورد إلى الورد " .
ونجده يستدعي جنكيزخان في حس ساخر يقول:
" وعند رسام رأيت عتالاً برتقالياً يرفع برقبته
جنكيزخان " .
والأسطورة اليونانية التي ترسم آلهة نصفها حصان، ونصفها بشر يقول مستخدماً نفس الصورة: "كانت تهرب على فرس بنصف جسد" .
3. قصص وحكايات الأطفال:
في واحدة من أجمل قصائد أنسي الحاج، وأبسطها لغة وبناءً يرسم لنا صورة الحرمان من الطفولة، والشوق إليها رابطاً هذه العاطفة بحكاية (ليلى الحمراء والذئب)، فيتوسل الذئب في حديثه عن الحنين إلى الطفولة وافتقاده لها يقول:
"ويوم لم يعد
يأكلني الذئب لكي أنام
بكيت عشرين سنة
ومت من شوقي إليك
يا ذئب
من شوقي إليك" .
كما نجد حكاية (سندريلا) الفتاة التي تسحرها الساحرة، فتسحر الأمير بدورها، ولما دنت الساعة الثانية عشرة غادرته مسرعة حتى لا يزول فعل السحر، فتنكشف حقيقتها، فوقعت فردة حذائها، وبدأ الأمير رحلة البحث والتفتيش عنها إلى أن اهتدى إليها بفضل الحذاء يقول أنسي:
"التي تفقد فردة حذائها من أجل أن تهدي الأمير
إلى مصيره" .
وفي إشارة خاطفة إلى العبارة التي تكرّر للأطفال بأن العصفورة أخبرت الوالدين يقول أنسي: " لم تخبرني العصفورة وحدها " .
3. الأمثال الشعبية:
هنا يطغى حسّ السّخرية والتهكّم في الصورة التي تأخذ عن الأمثال الشعبية يقول أنسي: "عش ملكاً تكن قانعاً" .
يسخر من قولهم "عش قانعاً تكن ملكاً" في الأمثال الشعبية، فهو يرفض ما اتفقت عليه الجماعة من أمثال شعبية، تحضّ على الرضى والقناعة، والصبر.
4. الآيات القرآنية والأحاديث النبوية:
يدين أنسي الحاج بالديانة المسيحية. ولكنه قرأ النص القرآن، والأحاديث النبوية الشريفة وأفاد منها، وأعاد توظيفها في شعره ومن ذلك قوله:
" يهزها زلزالها ".
مُعيداً توظيف قوله تعالى: " إذا زلزلت الأرض زلزالها "*
ويوظف حكاية "إرم ذات العماد" التي وردت في النص القرآن قال تعالى:
" إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد "**
يقول أنسي: " كنز شداد بن عاد الذي
عمر إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
الغضب والطاقية " .
كما أنه يعيد توظيف قصة قوم صالح الذين عقروا الناقة، وهي المحرمة عليهم قال تعالى : " فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها "•، وظف أنسي الحاج هذه القصة توظيفاً دلالياً جديداً، فقد عقر بمخيلته قريته قال:
" نزلت وانحنيت على الأرض
قررت عقرها بمخيلتي " .
ويشير إشارة خفية إلى قصة النبي يوسف عليه السلام الواردة في القرآن الكريم فيقول :
" عرفت من في بئري " ، مشيراً إلى قوله تعالى: " قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة "**، أما قصة –موسى عليه السلام– والتي ترد في النص القرآني فإن أنسي الحاج يعيد توظيفها جاعلاً من نفسه شريكاً لموسى عليه السلام فيقول: (لم تخبرني العصفورة وحدها بل قرأت ذلك في لوح الوصايا الذي نسي موسى أن ينظر إليه، عندما لم يظهر له أحد ، .....
وقد وجدت اللوح تحت الكرسي الذي أكتب عليه، عندما دهمتني بلاهة العذاب بخرقة كلورفورم ألصقتها بفمي، فتخشّبت عيناي، ذهبت، ما أروع الطريق " .
وفي إشارة إلى الطوفان وقصة نوح عليه السلام يقول أنسي: ( ذلك النهار جاء الطوفان وجلس. لم تجد السفينة ما يحملها. ولم تجد أيّا منا لتحرمه الطوفان ) .
وللحديث النبوي الشريف أصداء في صور أنسي الحاج يقول:
( اطلب الرزق في سنابكها ) .
محيلا إلى الحديث ( اطلبوا الرزق في سنابكها ) .
ويقول أنسي: ( فقاسمني العلم بأن آفة العلم نسيان الجهل ) .
وقول أنسي: ( دفنت التطيّر والغربة عليك أمواجي ) .
والحديث النبوي يقول: ( لا طيرة ولا تطير ) .
الصورة اللونية:
في دواوين أنسي الحاج يقل استشهاده بالألوان، ويمكن حصر الصورة اللونية عنده فيما يلي:
- (نداؤه أحمر) .
- لست نورًا أبيض لكني، أطفي فراشتك مع هذا) .
- أحفظ منه بحنين تلك الخطوط الزرق) .
- (أيتها الإسفنجة الزهرية!) .
- ( إنه لم يذكر شاشة حمراء
لأن القلب العالم أبيض
لم يقل
إنني أسود
من أجل الليل
حتى ترجع العصافير) . - (هذه فتحة الحزام الأرجواني) .
- ستندلق على ظهرك أقواس قزح) .
- (أما خيط الدخان الأبيض فلا شيء يحدث لجلسته اليائسة منحدراً من وسيط تائه ومتصاعداً من وسيط أبدي الانحدار بركاناً في عصا من الحرير) .
- (على السرير الأحمر جبل يغالبه صبره. المرأة طازجة
عليه، جامدة.
على السرير الأزرق رجلاه العاريتان. يلحس
أبعادها ظهرها) . - هل كذب مثل كذبي؟ ....
يوحّد الروافد السود) . - (لو مرة كنتُ فراشة تخترق الأسود والحريق) .
- ( الذاكرة انقصف ظهرها! برقت، حمراء بالتصفيق) .
- ( بجسمين أبيضين نفلح ظل الأسوار ...) .
- ( القديسة الحافلة بخطاياها البيضاء ) .
- ( تنزاح ثيابك من أعضائي، أخضر وأيبس أخضر وأيبس ) .
- ( لن أتوقف
تحت القمر بالثوب الأبيض
غرقا) . - ( غيومي سود ) .
- ( جسدك أبيض وأسنانك بيضاء
والحبر أبيض
والأوراق بيضاء ) . - ( قلبي أسود بالوحشة ونفسي حمراء
لكن لوح العالم أبيض
والكلمات بيضاء ) . - ( الصفحة السوداء جنيّة تؤجل عمل اليوم إلى الغد) .
- ( العتم المثالي هو الذي يعتقد أن أحلى ما فيه عري الجسد الأبيض) .
- ( لا تلبسين ثياباً زرقاء
تلبسين الأزرق الذي في عيون الشعراء) . - ( وكانت مراكبنا سوداً ) .
- ( بياض الحمام ) .
- ( ونلج العدم الوردي ) .
هذه الصورة اللونية تكشف عن دلالات الألوان عند أنسي الحاج.
فالأبيض عند الطهارة والفضاء والسلام.
والأحمر لون الجنس والإثارة.
والأسود العتم والظلم والقتامة.
الأزرق البحر، والحلم، والأمنيات.
والحديث بالألوان المقترن بالأنثى مصحوب بألوان زاهية، متفائلة، الوردي، الأرجواني، الزهري. وفي مقابلها حين تنزاح ثيابها عن أغصانه فإن ورقه يخضر فرحاً وييبس جزعاً معاً.
أما الصورة التي تعتمد الشم كحاسة فلا نعثر عليها في نتاج أنسي الشعري. إلا حديثه عن رائحة الليمون. والتفّاح.
يقول:
- ( لون فمك رائحته تفاح ) .
- ( فنذهب في روائح الليمون ) .
إذن بالبصر أوقع في نفسه، من الروائح. واهتمامه بالصورة اللونية أكبر من اهتمامه بالصورة التي تعتمد الروائح في تشكّلها.
صورة الطبيعة :
المعجم الذي يصدر عنه أنسي الحاج معجم ترفده الطبيعة بمظاهرها المختلفة، من الشجر والحجر والبحر والسماء والكائنات.
وفي صوره فيض من التوظيف للطبيعة لا ككائن ولا كعنصر جمالي، بل تتمظهر وفق شروطه، وتستخدم وِفق آليته النفسيّة، وبما يعبّر عن خبرته وتجربته الخاصة، فشجر الأرز له حضوره في صورة أنسي الحاج. يقول:
( الأرز فاته القطار وإن بدا مساخراً ) .
( غابات الأرز مشجرة صافية ) .
( عمرها طويلاً كأرزة فتبعها مثل توبتي
شعوبٌ كثيرة ) .
( والغابات، والأنهار، والأشجار، والأزهار، والطيور، والضفادع، والتلال، والسهول، والوديان، والشلالات، والشاطئ، والموج، والنبع، والأجنحة، الصنوبرات، الفراش، الكناري، .... الخ ).
هذه تحضر في الصورة عند أنسي الحاج وتخدم دواخل الشاعر، وتكتسب دلالات بحسب سياقاتها النصية ومن أمثلة الصور التي تمتاح من الطبيعة عنده:
- ( إنني نهرها! أيتها المنتظرون لأنضج، اسفهكم بهذا النبع، فهو أميركم ) .
- ( كنت تصرخين بين الصنوبرات، يحمل السكون رياح صوتك إلى أحشائي ) .
- ( ضاج وباهظ طفوي على محط عصافيرك .. ) .
- ( ذيلك يصعق كالديك ) .
- ( أنتحب كسنبلة يابسة في الريح ... أمطري امطري في البعد،
سوف مالحة أرشفك من بحرك ) . - ( طلعتُ من الصخور وتركت الأرض لدبابيس الورق ) .
- ( وحيداً أنزل مع الندى
وحيداً أرتفع مع الهواء
ولا يكتمل قمر استراحتي ) . - ( يتنشّقها النهار. تستحمّ في مساقد الليل ) .
- ( قوية بفستان الورد
وقميص الهواء
ومعطف السماء البيضاء ) . - (كذاب هذا الصقيع، كذاب ذلك البحر التافه، كذاب أي انهماك كان: سوف أنساك. كذاب أنا، لو كان لي أن أنساك لما فعلت لأنكِ، أنت أيضاً، لست لي. وكيف أنسى من ليست لي) .
- لم تكن كما هي بل كما تسلّت بين غيوم الانبهار،
ولبثت بين سطور الأسفل والأعلى أشد احتداماً من
الشمس وأعمق من الخوف) .
أنها صور تمتاح من الطبيعة التي تشرّبها أنسي من محيطه الطبيعي، فلبنان شجر الأرز، والصفصاف، والصنوبر، والشجر، والأحجار، والبحر، والطيور، والحيوانات. - ( كتبوا النار بالزيزفون. وعند المساء لم يبق.
نفس العالم ونام) . - (كقمر الأغنية
جميلة كأزهار تحت ندى العينين
...
كالشمس تدوس العنب) .
الحرب:
تنعكس الحرب بآثاره، ودمارها، وخرابها، وبشاعتها في صوره، ولبنان كانت ساحة للحروب على مر التاريخ، وأنسي الحاج عاصر حروباً دامية حفرت في أعماقه بدءاً من القنبلة النووية وإلقاؤها على هيروشيما، وكان في السابعة من عمره حينها، مروراً بالحرب الأهلية اللبنانية التي صمت أنسي الحاج خلالها، ولم يكتب متعثراً مدة قاربت الخمس عشرة سنة، ومن صور الحرب في شعره قصيدة (البيت العميق) في ديوانه (لن) وقصيدة (عفاف يباس) في
نفس الديوان ومن هذه الصور التي تظهر في ديوانه :
- ( في الخندق التهم جسدي ) .
- ( تتعانق المذبحة والظفر وحسداً أخلع وجنتي ) .
- ( الصمت يشبه حروفاً سكين يركب بعضها بعضاً بالتصاق تحت غارة ) .
- ( ولسوف أكتشف لك سجناً
آه
من يخرجني منه) . - ( أنفلش قنبلة، قنبلة، قنبلة ) .
- ( أردت نعمة القدرة على القتل، لأفتن بالكلمات من نهرها حتى أبدها ) .
- ( أصابعي
كي تشرح فمك
تجذّف في الرصاص
وحين يحين موعدي .... ) . - ( أغصان أزلك جماجم قتلى ) .
- ( ووهجك كسل مسلّح ) .
- ( أسجنك كاللقمة ) .
- ( انتظرك في وطنك مذبحتي ) .
صور تكشف عن نفسية معادية للحرب، وعن كراهية لهال من حيث هي اضطهاد، تعذيب، ذعر، فزع.
صورة المدينة :
المدينة بمظاهرها الاستهلاكية، واختراعاتها العلمية، أدواتها، تظهر في صور أنسي الحاج، ونستنتج منها الطريقة التي يتعامل بها مع المدينة، ومن الصور التي يأتي فيها على ذكر المدينة قوله:
- ( تنتشر نظّاياري ) .
- ( النصر للعلم ! سوف يتكسّر العقرب ) .
- ( البر البحر الفضاء جمعت في الإصابة والعين ) .
- ( انتبه وتوقّف عن الضوضاء. قلت الموت عَلَمُ الثأر ) .
- ( أرى الغيم عَلَقاً مدهوناً بالزجاج ) .
- ( ورأس مسمار ) .
- ( فلتطر الأجراس فتطير المباخر ) .
- ( من متجر السر رجعت إلى القفر لأنسلخ ) .
- ( لو أطلع من توتري كقارة من البحر، ونيئاً أصبّ في عينيك ) .
- ( أو أهاجر نحو مرمى استنزل ) .
- ( ويصعد منك تيار الحريقة ) .
- ( أعلق فخذيّ على لافتة ) .
- ( نحن صيدليو عشية الهلاك الباتّة ) .
- ( سرطاناً أحول أشنة القاع إلي ) .
- ( أسرطن العافية ) .
- ( أشعل الغلام المُطل لفافة ) .
- ( طلعت من الصخور وتركت الأرض لدبابيس الورق ) .
- ( أسلمت رفاتي أحسست بوحي الكرسي وغدير ساعة الجدار )
- ( ينصلب على الزجاج كالعاصفة ) .
- ( نحن قشة عساكر الأمن وخفر الساحل ) .
- ( سأضرب لاأودية. الويل إن جَلست! ) .
- ( لك قدمان في الصدى وفندق أعمى )
- ( والأرز فته القطار وإن بدا مسافراً ) .
- ( الذي صاغني صيغة البطاقة ) .
- ( جرس الهاتف إذا الليل
هو الليل ) .
من الواضح أن له موقفاً سلبياً من المدينة، وأنه يضمر لها كراهية، فلا تظهر أدواتها في موطن محبّب، أو جميل، بل هي صور فيها استلاب لهذه المدينة، ومحاولة رفضها لا تصل حد التطرف الذي يمنعه من التعامل معها، بل هو يرفض روح المدينة التي تغرّب الانسان، ولا يرفض أدواتها التي إنما وجدت لراحته وخدمته، هذه الصور التي تخدم رؤية، وموقف الشاعر من الحياة والكون، والتي تبيّن عن رصد خفي للحقائق، والسرائر الداخلية في ذاته، والتي أمكننا عبر تتبعها التعرّف، والتيقّن من الطبيعة النفسية للشاعر، ومن زاوية رؤيته، فمن صوره استدللنا على غرائبية، وعبثية، وإحساس ممض باللاجدوى، ووقعنا على فعل مقاومة لمثل هذه الأعماق السرية في ذاته عبر فعل الحب، فذا أفق خرب يحاول أنسي الحاج مقاومته بالحب، عاكساً بؤس وبشاعة العالم في صور نابضة حيّة في غربتها، وغرابتها معاً.
خلاصة
أنسي الحاج شاعر متمرد شكل أخطر ظاهرة بين أفراد جيله، ليس فقط بالشكل الكتابي الذي ابتدعه ونظّر له: قصيدة النثر، بل وبآرائه ومواقفه الداعية للتمرد على كل أشكال السلطة والأنظمة.
وقد تبين لنا من خلال اضاءات سريعة على حياته الظروف، التي أحدثت لنا هذا التركيب النفسي المتسم بالغموض: طفولة تتوج بفقد الأم، مراهقة تبدأ بفقد الصديق ورفيق الصبا، ليظل الموت بعد ذلك خوفه، وقلقه وفزعه، الذي يقاومه بلا ما لا يروعه: العزلة، والحب عبر فعل الكتابة.
والعزلة عنده فعل بين الداخل والخارج، موازناً بين رغباته ونزعاته الداخلية، وبين متطلبات حياته ككائن اجتماعي، فالداخل حرية بينما خارج لا يعدو كونه وظيفة. ولا يمكن اعتبارها -العزلة- مأخذاً،، لأن في الواقع أشياء أخرى: جرأة خاصة، دموع واستعلاء، وألم يطبع بصمته الأبدية بعمق وتأكيد لا يمعن، وفي الواقع عمر ينقضي في تعقب نوازع مستحياة، وحرية مطلقة، وفي الواقع –أيضاً- دنو اجل وانتهاء، وسؤال الرحل الخائف؛ إلى أين تذهب بنا الحياة؟!
أما الحب عبر فعل الكتاب، فهو الملاذ الذي يرتجيه، ولا يرى في المرأة أكثر من وسيط موصل حالة الحب، ومتمم له، فشعره يكاد يخلو من أوصاف جسدية للمرأة، إلا لأداء وظيفة معنوية تتعدى هذا الوصف.
امتاز أنسي الحاج بثقافة ليست بأقل منه تناقضاً، وعدم اتزان، فنرى بعض معرفة بالتراث، والديانات، والأساطير، وأكثر ما نلحظ تأثره بثقافات غير عربية، ويؤكد ذلك إقتباسه من الأراء النقدية الفرنسية، واهتمامه ببعض شعرائهم مثل: رامبو، بريتون، ايلوار وغيرهم. وتأثره بالاتجاه السريالي، الذي تمثله في شعره صوراً وأسلوباً.
وقد كان لثقافته النقدية أثر واضح في كتابته الشعرية، يشهد على ذلك القصيدة ذات المضمون النقدي.
وفي توقه للحرية، صراع مع واقع يستلبها ويخنقها، تنازعت ذاته، وفي خصامها مع الواقع، انعزلت عنه، واختبأت في مكان سري منه، ليعاني انفصامه النفسي، وتراجع لا وعيه من وعيه، والذي ظل يلح طوال حياته وسيظل، مطالباً ذاته بالإلتقاء، باحثاً عما يمكنه من تحقيق التصالح، وإعادة الذات إلى توازنها النفسي ولو لحظياً، ليخالف ذاته غير قابل لأي تصنيف أو حكم يطلق عليه، مقدماً رؤى شعرية غير ثابتة، لتخرج القصيدة حاملة نقيضها، تشي باللاجدوى، واللامعنى، والخيبة المرة التي كانت في دواوينه الأولى سخط، وتمرد، ورفض، ثم حولتها الأيام حكمة وحنكة كسيرة، الأمر الذي يستتبع غيبة الزمان والمكان، ببعديهما الواقعي لينفتحا على الآخر الفني، في مناجاة حارقة تنادي الزمان والمكان، اللذين تتحد فيهما الذات مع نوازعها، فلا تأثم ولا تخطئ ولا تجأر طامحة في التكفير. قصر الفكرة، وصدق الانفعال، أهم ما يميز شعره، يرافق ذلك قدرة على نقل حمى الذات بكل قلقها وفزعها، وأمام هذه التجربة الكتابية لا نملك إلا التعاطف معها.
وقد اكتفى الدارس بمدخلات على تعاريف القدماء في مفاهيم الشعر وشروط تحققه، مع حياد تجاه قصيدة النثر والاكتفاء بالإقرار أن من القول ما هو ليس بالشعر ولا بالنثر وفي رؤية متواضعة نقدم فيها الشعر نقول:
الشعر حالة محاصرة للقارئ، رد فعل متكرر، وتوجيه له، ثم محاصرته في باحة معينة تنقل للمتلقي ذات الإيقاعات، التي تتردد في قلب الشاعر، واللغة هي أداءة الشاعر الصوتية المستخدمة لهذا الغرض.
واللغة من حيث هي أداة تعبير لنقل الواقع الداخلي الخاص إلى المتلقي، تكون مثل أنبوب بين وعائين (أو نحاول جعلها كذلك)، ولا يضيرنا شكل الأنبوب أو طوله، أو كل ما يتعلق به طالما أنه يخدم غايته المنشودة: التعبير.
والقصيدة قالب لغوي له موسيقاه الملائمة، وليست قالباً موسيقياً، أي أن الموسيقى،
والوزن الشعري يمثلان الإطار الذي يضبط، وينمق الصورة التي هي الجوهر.
والقصيدة موجودة في الواقع، والشعر اكتشاف هذا الموجود وتحديده، وتحسسه، والشاعر يمزج الحس الاستشعاري بالعقل، والذي مهمته نقل هذا الحس إلى واقع خطابي، أي أن الشعر قائم بدون اللغة أصلاً، فاللغة أداة عقلية. ويمكن أن يكون المرء شاعراً دون أن يكتب القصيدة للتعبير عن حزمة أحاسيسه المكتشفة (بكسر الشين)، وحزمة حسياته المكتشفة (بفتح الشين)، وقد يستخدم بذلك أي وسيلة أخرى، فقد يستخدم عينه –مثلاً– وفي هذه الحالة لا تكون مفهمومة للجميع، باعتبار أن اللغة المستخدمة، التي يفهمها الجميع هي اللغة الصوتية، والهجائية. وقد لا يستخدم شيئاً على الإطلاق، وهنا يكون الشعر قائماً غير معبر عنه، وهنا يكون شعراً وليس قصيدة. فالقصيدة إذن شعر معبر عنه بلغة متفق عليها في جماعة ما، وبما أن اللغة هي العربية هنا المتضمنة فنياتها، البحور، والتفعيلة؛ فيجوز أن نقول مثلاً أنه لا قصيدة بلا تفعيلة وبحور، ولكن من الخطأ القول أنه لا شعر بدون تفعيلة وبحور؛ لأن الشعر ومض داخلي، وانكشاف الحالة على الحس بلغة الإنفعالات وليس بالعربية أو غيرها، وصوغ الشعر في اللغة حالة انكشاف الحالة على الحس، ومن ثم العقل لغاية التعبير، وللتعبير شكلان:
الشكل الإنفعالي: وهو تعبير يهدف للتفريغ وحسب الشكل اللغوي: ويهدف إلى الإتصال بالغير، وهذا يتطلب لغة مشتركة مع هذا الآخر، وهنا يأتي دور الضبط الإيقاعي، والموسيقى للشعر، فبينما يكون الشكل منظماً ربما لمجرد التحبّب، ولفت الانتباه عن سابق تخطيط، فشعر أنسي الحاج –في ضوء ما سبق– شعر انفعالي، شعر ذات تخبط في الوجود حاملة نوازعها، وفزعها معاً، في شكل صادق في تصوير العصر اللإنساني، عصر قصيدة النثر الفوضوية، والرافضية، فالنظام القائم باستلابه للإنسان، سيستدعي هذه الكتابة الشعرية، المتخبطة، واللانظامية.
هذه المفاتيح التي يمكن بها الدخول إلى عالم أنسي الحاج الشعري، الطفل الذي ينضج ولا يكبر في كنف نفسية مختنقة مأزومة، تنغلق آفاقها إن ليش في الحقيقة؛ فبالتصور والوهم والتكرر، والذي ينتهي به كل ذلك: الإنكسار.
*****
| Abstract
Unsi EL-Haj and Prose Poem
by
Ranah Mustafa Nazzal
Supervised
Professot Ibraheem Sa`afeen Since the announcement of its existence, the prose poem of Modern Arab Literature provoked wide arguments with creators, scholars, and critics. These arguments were motivated by the form nature of this kind of poetry which is not based on neither well–known traditional meters, nor feet that were met by opponents with some leniency. It should be noticed that this intellectual rivalry between the opponents and proponents played quite a big role in kindling these arguments and accusing the ones, who adopted this poem directly or secretly, by having suspicious roles towards the nation's heritage, nation, and belief. During the surrounding circumstances of turmoil, the subjective scientific study to the nature of these poems was concealed. In addition to the decline of objective study to its first seeds of emerge and progress since the semi nature beginnings of the pioneers till the poem's developments by the later generations and with negligence to stop by its maturity features and elements of chaos that resulted in having ambiguous concept and unsettled variety: prose poem, will not be a success without confronting a study of its pioneer: Aunsi Al-Haj. The study resorts to the chronological approach in tracing the origin of prose poem, and to the critical analytic approach in studying the product of Aunsi AL-Haj, who represents a distinctive sound through out the track of Modern Arab poetry, and who announced the birth of this literary variety in the introduction of his first poetical work: "Lann". Eventually, the study comes to the conclusion that the poet, Aunsi AL-Haj, dealt with the prose poem as a personal issue in which his devices, challenge, diction, images, and structure were exposed. Moreover he gave way to adventure and Associate it with liberty… relived with Arabic poetry to a new lingual and semantic level: without being subjected to the poetic form which is built on feet and AL khalil Bin Ahmad meters. |
المصادر والمراجع والدوريات
أ . المصادر
- القرآن الكريم
- الكتاب المقدس، نشيد الإنشاء، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، ص985.
- ابن جني، الخصائص، ج2، تحقيق محمد علي النجار، ( د.ط)، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، ( د.ت )
- ابن رشد، تلخيص كتاب أرسطو في الشعر (الشرح الوسيطة)، نشرة لزينو في بيزا، نقحه عبد الرحمن بدوي، ط2، دار الثقافة، بيروت، 1937م.
- ابن سينا، فن الشعر في كتاب الشفاء، نشره مرجليوت، ط2، نقحه : عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، 1973م.
- ابن طباطبة، العلوي، عيار الشعر، شرح وتحقيق: عباس عبد الستار، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1982م.
- ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ط 3، دار إحياء العلوم، بيروت، 1987م.
- ابن المعتز، عبد الله، طبقات الشعراء، تحقيق : عبد الستار احمد فراج، ط 4، دار المعارف، مصر، 1981م.
- ابن المعتز، عبد الله، كتاب البديع، حققه وعلق عليه: كراتشكوفنسكي، ( د.ط ) لندن، 1931م.
- الحسن بن أحمد علي، الكاتب، كتاب عمال أدب الغناء، تحقيق: غطاس عبد الله خشبة، ( د.ط )، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1975م.
- الخليل بن أحمد، الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم المخزومي، ( د.ط )، دار الرشيد للنشر، بغداد، العراق، 1981م.
- أبو هلال، العسكري، كتاب الصناعتين، تحقيق: علي محمد الجابري ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ( د.ط )، القاهرة، 1952م.
- القاضي علي بن عبد العزيز، الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ( د.ط )، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة ( د.ت ).
- أنسي الحاج، لن، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 2، بيروت، لبنان، 1982م.
- أنسي الحاج، الرأس المقطوع، دار مجلة شعر، ط 1، بيروت، لبنان، 1963م.
- أنسي الحاج: ماضي الأيام الآتية، ط 1، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1965.
- أنسي الحاج، ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة؟، ط1، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، 1975م.
- أنسي الحاج، الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع، ط1، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، 1975م.
- أنسي الحاج، كلمات.. كلمات.. كلمات، دار النهار، بيروت، لبنان، 1988م.
- أنسي الحاج، خواتم، ط1، دار رياض الريس للكتب والنشر، قبرص، لندن، 1991م.
- أنسي الحاج، الوليمة، ط1، دار رياض الريس للكتب والنشر، قبرص، لندن، ط1، 1994م.
- حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الخطيب ابن الخوجة، (د.ت)، دار الكتب الشرقية، تونس، 1966م.
- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ط1، مكتبة القاهرة، القاهرة، 1969م.
- عبد الكريم النهشلي، الممتع في صنعة الشعر، تحقيق: محمد زغلول سلام، (د.ط)، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 1977م.
- قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، (د.ط) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ت).
- محمد بن سلام الجمجي، طبقات فحول الشعراء، شرحه وعلق عليه : محمود محمد شاكر، (د.ط) منشورات المؤسسة السعودية بمصر، مطبعة المدني، القاهرة، 1974م.
ب. المراجع بالعربية
- إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، (د.ط)، دار القلم، بيروت، لبنان، 1972م.
- إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ط2، دار الشروق، بيروت، لبنان، 1992م.
- إحسان عباس، فن الشعر، ط5، دار الشروق، بيروت، لبنان، 1992م.
- أدونيس (علي أحمد سعيد)، الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، ط1، دار العودة، بيروت، لبنان، 1978م.
- أدونيس (علي أحمد سعيد)، زمن الشعر، ط2، دار العودة، بيروت، لبنان، 1978م.
- أدونيس (علي أحمد سعيد)، سياسة الشعر، ط1، دار الآداب، بيروت، لبنان، 1985م.
- أدونيس (علي أحمد سعيد)، الشعرية العربية، ط1، دار الآداب، بيروت، لبنان، 1985م.
- أدونيس (علي أحمد سعيد)، الصوفية والسوريالية، ط1، دار الساقي، لندن، 1992م.
- أدونيس (علي أحمد سعيد)، مقدمة للشعر العربي، ط1، دار العودة، بيروت، لبنان، 1971م.
- أدونيس (علي أحمد سعيد)، النظام والكلام، ط1، دار الآداب، بيروت، لبنان، 1993م.
- أدونيس (علي أحمد سعيد)، ها أنت أيها الوقت، ط1، دار الآداب، بيروت، لبنان، 1993م.
- أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، ط2، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 1970م.
- اعتدال عثمان، إضاءات النص، ط 12، دار الحداثة، بيروت، لبنان، 1988م.
- الياس خوري، دراسات في نقد الشعر، ط2، دار ابن رشد، بيان، 1981م.
- الياس خوري، الذاكرة المفتوحة، ط1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، 1982م.
- ايجلتون، تيري، النقد والايدولوجية، ترجمة: فخري صالح، ط1، الفرنسية العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 1982م.
- باختين، ميخائيل، شعرية دوستوفسكي، ترجمة: جميل نصيف التكريتي، ( د.ط )، دار الشؤون الثقافية، توبقال، المغرب، بغداد، 1986م.
- بارت، رولان، درس السيمولوجيا، ترجمة: ط م، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1988م.
- بارت، رولان، لذة النص، ترجمة: فؤاد صفاء الحسين سحبان، ط1، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1988م.
- براد بري، مالكم، الحداثة، ترجمة: مؤيد حسن موري، ط1، دار المأمون، بغداد، العراق، 1987م.
- بريتون، أندريه، بيانات السريالية، ترجمة صلاح برمدا، ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سورية، 1978م.
- بيرمان، مارشال، حداثة التخلف، تجربة الحداثة، ترجمة: فاضل حتكر، (د.ط) مؤسسة عياد للدراسات والنشر، نيقوسيا، 1993.
- بيرنار، سوزان، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، ترجمة: د. زهير مجيد مغامس، ط1، دار المأمون، بغداد، العراق، 1993م.
- تاديه، جان ايف، النقد الأدبي في القرن العشرين، ترجمة: د. منذر عياشي، ط1، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنثر، 1993م.
- تودورف، تزفتيان، الشعرية، ترجمة: شكري إليوت ورجاء بن سلامة، ط1، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 1987م.
- تودورف، تزفتيان، نقد الشعر، ترجمة: سامي سويدان، ط1، منشورات مركز الانماء القومي، بيروت، 1986م.
- توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ط2، تربقال، الدار البيضاء، 1987.
- جاكو سبون، رومان، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد العربي ومبارك صون، ط1، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 1988م.
- جبرا ابراهيم جبرا، الحرية والطوفان، دراسات نقدية، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 1979م.
- جبرا ابراهيم، الرحلة الثامنة، دراسات نقدية، ط1، المكتبة البصرية، صيدا، لبنان، 1967م.
- حاتم الصكر، مالا تؤديه الصفة، المقربات اللسانية والأسلوبية والشعرية، قراءات، ط1، دار كتابات، بيروت، لبنان، 1993م.
- حسن الغرفي، البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، 1989م.
- حسين مروة، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، ط2، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 1976م.
- خالدة سعيد، حركة الإبداع، دراسات في الأدب العربي الحديث، ط1، دار العودة، بيروت، لبنان، 1982م.
- خليل شطّا بشر النحاس، رامبو رائد الشعر الحديث، ط1، دار دمشق سورية، 1983م.
- دور، اليزابيث، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة: محمد ابراهيم الشوش، ط1، مكتبة منجد، بيروت، لبنان، 1983م.
- دوبلبيس، الفون، السوريالية، ترجمة: هنري نجيب، ط1، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 1983م.
- ديشين، اندريه جاك، استيعاب النصوص وتأليفها، ترجمة: هيثم لمع، ط1، المؤسسة الجامعية لدراسات والنثر، بيروت، لبنان، 1991م.
- سامي مهدي، أفق الحداثة، وحداثة النمط، (دراسة في حداثة مجلة شعر)، ط1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، 1988م.
- سيمون هنري، تاريخ الأدب الفرنسي في القرن العشرين، ترجمة: بثينة صقر، ط1، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، 1961م.
- شاؤول، بول، كتابة الشعر الفرنسي الحديث (1900- 1980)، ط1، دار الطلبة، بيروت، لبنان، 1980م.
- صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، 1987م.
- طه حسين، تقليد وتجديد، ط3، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، حزيران 1984م.
- عبد العزيز المفالح، الشعر بين الرؤيا والتشكيل، ط2، دار طلاس، دمشق، سوريا، 1985م.
- عبد العزيز المفالح، أزمة القصيدة الجديدة، ط1، دار الحداثة، دار الكلمة، ليرون، صنعا، 1981م.
- عبد الله ابراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة الآخر، (مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة)، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1991م.
- عبد الواحد لؤلؤة، البحث عن معنى، ط3، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 1983.
- عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية المعنوية، ط2، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 1972م.
- عز الدين المناصرة، حارس النص الشعري، ط1، دار كتابات، بيروت، لبنان، 1993م.
- عز الدين المناصرة، الشعريات، (د.ط)، مكتبة برهومة، عمان، الأردن، (د.ت).
- عز الدين المناصرة، جمرة النص الشعري، ط1، منشورات الإتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، دار الكرمل، عمان، 1995م.
- عصام محفوظ، السوريالية وفضاءاتها العربية، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 1987م.
- علي حرب، نقد الحقيقة، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1993م.
- علي حرب، نقد النص، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1993م.
- علي شلق، النثر العربي، ط2، دار القلم، بيروت، لبنان، 1974م.
- غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين؟، (د.ط)، دار المعارف، بمصر، (ب.ت).
- فريزر، جيمس، أدونيس أو تموز، ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا، ط3، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 1982م.
- كستيلوت، ليليان، ايميه سيزر، ترجمة: انطون حمصي، (د.ط)، دار الثقافة، دمشق، 1970م.
- كمال أبو أديب، جدلية الخفاء والتجلي، ط3، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1984م.
- كمال أبو أديب، في الشعرية، ط1، مؤسسة الأبحاث العربي، بيروت، لبنان، 1987م.
- كمال أبو أديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، ط2، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1981م.
- كمال خير بك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ط1، دار الشروق، بيروت، لبنان، 1982م.
- كودويل، كورك، الوهم والواقع، دراسة في منابع الشعر، ترجمة: توفيق الأسدي، (د.ط)، دار الفارابي، بيروت، 1982م.
- كورك، جاكوب، اللغة في الأدب الحديث، الحداثة والتجريب، ترجمة: ليون يوسف، وعزيز عمانويل، ط1، دار المأمون، بغداد، العراق، 1989م.
- مجدي وهبه، معجم المصطلحات الأدبية، ط1، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 1981م.
- محمد بنهي، الشعر العربي الحديث، ط1، دار توبقال، الدار البيضاء، 1989م.
- محمد عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، ط3، مؤسسة الخانجي، القاهرة، مصر، 1969م.
- محمد العياشي، نظرية إيقاع الشعر العربي، (د.ط)، المطبعة العصرية، تونس، 1976م.
- محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، (د.ط)، ط3، دار العودة، بيروت، لبنان، 1982م.
- محمد مفتاح، دينامية النص، تنظير وإنجاز، (د.ط)، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1987م.
- مصطفى جمال الدين، الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعلية، ط2، مطبعة النعمان، النجف، 1974م.
- مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني، ط4، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1969م.
- مهدي المخزومي، الفراعيدي: عبقري من البصرة، ط1، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1969م.
- موريه. س، الشعر العربي الحديث (1800 – 1970م) لتطور أشكاله، وموضوعاته، وتأثير الأدب الغربي، ترجمة وتعليق: شفيع السيد وسعد مصلوع، (د.ط)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986م.
- ميخائيل نعيمة، الغربال، ط1، المطبعة العصرية، القاهرة، 1923م.
- هيدجر مارتن، ما الفلسفة؟ ما الميثافيزيقيا؟ ماهية الشعر؟، ترجمة: فؤاد كامل، محمد رجب، ط1، دار الثقافة، القاهرة، 1974م.
ج. الدوريات
- إبراهيم خليل، وحدة العقيدة بين النقاد العرب والنقاد الغربيين، مجلة الوحدة، العدد 49، 1988م.
- أحمد فرحان، حوار الحب والمرأة مع الشاعر اللبناني أنسي الحاج، نزوى، العدد الرابع، سبتمبر 1995م.
- أدونيس (علي أحمد سعيد)، تأسيس كتابة جديدة، مواقف، 15/أيار 1971م.
- أنسي الحاج، افتتاحية مجلة شعر، مجلة شعر، المجلد 4، العدد 38، السنة 4، ربيع 1967م.
- أنسي الحاج، الأسئلة المميتة، مجلة شعر، المجلد 7، العدد 27، السنة 7، صيف 1963م.
- أنسي الحاج، بيروت 1992: بين فنادق الثقافة وخنادقها، مجلة الناقد، العدد 41، شباط (فبراير)، 1992م.
- أنسي الحاج، الشهادة والاستشهاد، مجلة أدب، المجلد الأول، العدد 4، خريف 1962م.
- أنسي الحاج، ستالين الرهيب وموت اللبناني، مجلة شعر، العدد 40، خريف 1968م.
- أنسي الحاج، نقاش مفهوم الثورة، مجلة أدب، المجلد الثاني، العدد الثالث، آب 1963م.
- باشلار، غاستون، اللحظة الشعرية، مواقف، العدد 44، 1982م.
- حاتم الصكر، حلم الفراشة: حول الخصائص الفنية في قصيدة النثر، مجلة الأقلام، العدد 3، 4، السنة 27، 1992م.
- حاتم الصكر، الطريق إلى شعرية منحولة، مجلة الأقلام، العدد 12، السنة 27، 1992م.
- حاتم الصكر، قصيدة النثر في النقد العراقي، مجلة الأقلام، العدد 6، حزيران 1989م.
- حسين نصّار، عمود الشعر: منشؤه وتطوره، مجلة الأقلام، عدد خاص النقد الأدبي، 1980م.
- خالدة سعيد، لن لأنسي الحاج، مجلة شعر، المجلد 5، العدد 18، السنة 5، ربيع 1961م.
- خزعل الماجدي، شحنة التراث والنص الشعري، مجلة الأقلام، العدد 5، 6، السنة 27، 1992م.
- ديزيه السقال، انحراف المعنى في النص الشعري، كتابات معاصرة، المجلد الأول، العدد الأول، تشرين الثاني 1988م.
- شوقي بزيع، تجوال في مناطق غير مأهولة، مجلة الناقد، العدد 46، نيسان (إبريل) 1992م.
- صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، العدد 164، أغسطس (آب) 1992م.
- طراد الكسبي، قصيدة النثر، مجلة الكلمة، العدد 5، 1973م.
- عبده وازن، سيد الخيبة والتمرد في وليمة الكلام، مجلة الناقد، المجلد 70، العدد الثاني، آب، أغسطس، 1988م.
- علوي الهاشمي، متحرك الكون العربي، كتابات معاصرة، المجلد الخامس، العدد العشرون، كانون الأول 1993م، كانون الثاني 1994م.
- غازي بركس، في الشعر والشعراء، العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث، مجلة شعر، المجلد الأول، العدد 16، السنة الرابعة، خريف 1960م.
- فاضل تامر، قصيدة النثر نعم أم لا، مجلة الكلمة، العدد 3، أيار 1974م.
- كمال أبو ديب، الحداثة، السلطة، النص، مجلة فصول، العدد 3، 1984م.
- كمال أبو ديب، الغيبة والرؤيا: التجسيد الأيقوني، مجلة الأقلام، العدد 5، 1987م.
- كمال أبو ديب، في الصور الشعرية، مواقف، العدد 27، ربيع 1974م.
- محسن اطميش، اللحظية التنوع في موسيقى الشعر العراقي الجديد، مجلة الأقلام، العدد 11، 21، السنة 27، 1992م.
- محسن اطميش، تحولات الشجرة، مقال في موسيقى الشعر، مجلة الأقلام، العدد 1، 2 السنة 27، 1992م.
- محمد جمال باروت، حركة مجلة شعر 1957 – 1964م، مجلة المعرفة، العدد 275، 1985م.
- محمد خالدي، قصيدة النثر أمام الاحتدام اللغوي، مجلة الكلمة، العدد 5، 1973م.
- محمد أديب، قصيدة النثر بين الموهبة الفردية والرافد الغربي، مجلة الطريق، العدد 3، أيلول (سبتمبر) 1992م.
- منير العكش، اللغة الشعرية من الوسيلة إلى الأداء غير المحدود، مواقف، العدد 7، كانون الثاني، 1970م.
- نجيب شاهين، الشعراء المحافظون والشعراء المعاصرون، مجلة المنطق، يناير، 1920م.
- نهى بيومي حجازي، السريالية بين الواقع والذكرى، مجلة الفكر اللغوي، العدد 25، 1982م.
- نهاد خياطة، رأي في قصيدة النثر، مجلة الشعر، شتاء 1969م.
- نجوى نصره الايقاعات في قراءة السنيه، كتابات معاصرة، المجلد 5، العدد 14، آب (أيلول)، 1993م.
- هاشم شفيق، حوار مع أنسي الحاج، مجلة الوسط، العدد 91، 25/10/1980م.
- هاشم صالح، اتركونا أحراراً عندما يتعلق الأمر بالكتابة، مواقف، العدد 36 شتاء 1980م.
- هنري فريد صعب، قراءة في ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة؟، مواقف، العدد 30، السنة الثانية، تموز (آب) 1970م.
د. الجرائد
- جورج جحا، النظرية الشعرية عند اليون وأدونيس، جريدة الدستور، 29 أيار، 1992م.
- حاتم الصكر، قصيدة النثر والاحتمالات المؤجلة، جريدة القادسية، حزيران، 1986م.
- زياد أبو لبن، حوار مع الدكتور عبد القادر القط، التراث صفة مقابلة بالضرورة للمعاصرة، جريدة الشعب، شباط، 1992م.
- زياد العناني، النص واشكالية اللافهم، جريدة الدستور، 27 آب، 1992م.
- طاهر رياض، مرافئ، كلام.. كلام.. كلام، جريدة الرأي، 22 أيار، 1992م.
- عبد الجبار داود البصري، الشعر المقصود، قصيدة النثر، جريدة القادسية، 24 تموز، 1986م.
- عبد الله رضوان، في لغة الشعر، جريدة الدستور، 10 تشرين الثاني، 1989م.
- علي الشلاة، الشاعر العراقي حميد سعيد، جريدة الرأي، 10 تموز، 1992م.
- فاضل تامر، قصيدة النثر وقضية الإيقاع في الشعر، جريدة الثورة، 19 تشرين الأول، 1986م.
- فاضل تامر، قضايا الجنس الأدبي في الأدب الغربي، جريدة الدستور، 23 نيسان، 1992م.
- فخري صالح، تأملات في الرواية والشعر العربيين، جريدة الدستور، 17 تموز، 1992م.
- فخري صالح، الشعر الجديد والنقاد، جريدة الدستور، 5 حزيران، 1992م.
- فخري صالح، قراءات في أدب جديد، نقد الألم لعباس بيضون، جريدة الدستور، 21 تموز، 1989م.
- فخري صالح، قصيدة النثر العربية، بحثاً عن معيار في الشعرية، جريدة الدستور، 4 أيار، 1993م.
- محمد الأسعد، نثرية الشعر وشعرية النثر، جريدة الدستور، 6 آب، 1993م.
فهرس الدوريات
- الأديب
- الأسبوع العربي
- الحكمة
- شعر
- المقتطف
- النهار
الأسبوع العربي
- مجلة العالم العربي المصور، سياسة، أسبوعية.
- 6/1985.
- جورج أبو عضل، صاحب المؤسسة الشرقية للطباعة والنشر، رئيس تحريرها: ياسر هواري.
- بيروت.
- باريس: المكتبة الأهلية (رقم 210) –مكتبة تطوان- هارفورد (M.E.C) – مكتبة يافث التذكارية في الجامعة الأميركية (دوريات، رقم 210).
- صالحة: تاريخ الصحافة العربية، ص 119 – مروة: الصحافة العربية، ص 280.
الحكمة
- مجلة، ثقافية، شهرية، غير سياسية.
- 1951.
- معهد الحكمة. رئاسة تحريرها: فؤاد كنعان ثم جميل جبر، ثم الخوري خليل أبي نادر.
- بيروت – لبنان.
- دار الكتب اللبنانية، بيروت – ب مكتبة الجامعة الأميركية، بيروت – دار الكتب المصرية، القاهرة – مكتبة جامعة برنستين – مكتبة جامعة الروح القدس، الكسليك، لبنان 70. مروة: لصحافة العربية، ص 455.
- قرار رقم 1504، تاريخ 1/12/1951، ج. ر. ل.، المراسيم والقرارات الخاصة، 1951، ص 607.
النهار
- جريدة، يومية، سياسية.
- 4/8/1933 (نهار الجمعة).
- جبران التويني. انتقلت بعد وفاته إلى ابنه غسان.
- بيروت – لبنان.
- دار الكتب اللبنانية – مكتبة الجامعة الأميركية، بيروت – المتحف البريطاني، لندن – دار الكتب الأهلية، باريس – مكتبة الكونغرس، دائرة الشرق الأدنى، واشنطون – معهد اللغات الشرقية والإفريقية، لندن – المعهد الألماني للدراسات الشرقية، بيروت – المكتبة الشرقية البودليانية، جامعة أكسفورد.
- مروة: تاريخ الصحافة العربية.
- صدرت النهار بالفرنسية خلال الدورة الثالثة للاونسكو في بيروت، تشرين الثاني وكانون الأول سنة 1948.
المقتطف
- مجلة شهرية، علمية، أدبية.
- 1/5/1876 – 1952 (مجلد 118).
- يعقوب صروف وفهرس نمر.
- بيروت ثم القاهرة عام 1884.
- مكتبة الجامعة الأميركية، بيروت – دار الكتب المصرية، القاهرة – دار الكتب. اللبنانية، بيروت – المكتبة الشرقية في الجامعة اليسوعية، بيروت – مكتبة كلية المقاصد الخيرية الاسلامية، بيروت – مكتبة الجامعة اللبنانية، بيروت – مكتبة الآباء البولسيين، حريصا، لبنان – مكتبة دير الشرفة، درعون، لبنان – مكتبة جامعة الجزائر – مكتبة جامعة درهايم – مكتبة جامعة هارفرد، والافريقية، لندن – دار الكتب الأهلية، باريس (رقم 2772) – مكتبة مدرسة اللغات الشرقية، باريس – مكتبة جامعة برنسن، ألمانيا – مكتبة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت.
- طرازي، ج2، ص
- فهرس المقتطف – منشورات الجامعة الأميركية بمناسبة عيدها المئوي، 1967، في 3 مجلدات – داغر: مصادر الدراسة، ج2: 540.
شـعر
- مجلة، أدبية، شهرية للشعر تصدر في أربعة أعداد في السنة.
- 1957.
- يوسف الخال.
- بيروت – لبنان.
- مكتبة الجامعة الأميركية، بيروت – المكتبة الشرقية في الجامعة اليسوعية، بيروت – مكتبة كلية البنات الأميركية، بيروت – مكتبة جامعة هارفرد بالولايات المتحدة – مدرسة اللغات الشرقية والافريقية، لندن – مكتب جامعة برنستن، نيوجرسي، أميركا.
- قرار رقم 281، تاريخ 31/12/1956، ج. ر. ل، المراسيم والقرارات الخاصة، 1957، ص 38.
الأديب
- مجلة، أدبية، شهرية.
- 1942.
- البير أديب.
- بيروت – لبنان.
- دار الكتب اللبنانية – مكتبة يافث التذكارية في الجامعة الأميركية، بيروت – المكتبة الشرقية، بيروت – مكتبة كلية المقاصد الخيرية الإسلامية، بيروت – مكتبة الجامعة اللبنانية، بيرتو – مكتبة كلية البنات الأمريكية، بيروت – مكتبة جامعة روح القدس، الكسليك – المعهد الألماني للدراسات الشرقية – مكتبة جامعة الجزائر – مكتبة جامعة دورهام – مكتبة جامعة هارفورد، (M.E.C) – مكتبة مدرسة اللغات الشرقية والافريقية في لندن، مكتبة تطوان – مكتبة برنستن – المكتبة الأهلية في باريس – مكتبة جامعة أمستردام – مكتبة الآباء البولسيين، حريصاً – مكتبة جامعة بغداد – مكتبة جامعة الكويت – مكتبة جامعة القاهرة – مكتبة جامعة الاسكندرية.
- المقتطف، ج 106 (1945)، ص 73 و ج111 (1947)، ص 349.
- مروة: الصحافة العربية، ص 435.
فهرس الأعلام العربية
ابن رشيق (توفي سنة 749هـ - 1349)
عبدالله بن رشيق المغربي، ناسخ، من أهل دمشق، قال فيه ابن كثير: "كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية، وكان أبصر بخط الشيخ منه، إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه عبدالله هذا".
ابن سينا أبو علي (980 – 1037)
فيلسوف وطبيب وعالم من كبار فلاسفة الإسلام وأطبائهم. عرف بالشيخ الرئيس. ولد في أخشنه قرب بخارى وتوفي بهمذان تعمق في درس فلسفة أرسطو وتأثر بالأفلاطونية المتحدثة. له ميول صوفية عميقة برزت في "الحكمة المشرقية" وهي عبارة عن فلسفته الشخصية.
من مؤلفاته المطبوعة "القانون" في الطب "والشفاء" و"النجاة" و"الحدود" في الفلسفة والمنطق.
ابن قتيبة (213 – 276هـ = 828 – 889م)
عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد: من أئمة الأدب، ومن المصنفين الكثرين. ولد ببغداد وسكن الكوفة. ثم ولي قاء الدينور مدة، فنسب لها. وتوفي ببغداد. من كتبه "تأويل مختلف الحديث – ط" و"أدب الكاتب – ط" و"المعارف – ط" وكتاب "المعاني – ط" ثلاثة مجلدات "عيون الأخبار" و"الشعر والشعراء – ط" و"الإمامة والسياسة – ط" وللعلماء نظر في نسبته إليه، و"الأشربة – ط" و"الرد على الشعوبية – ط" و"فضل العرب على العجم – خ" في 40 ورقة، و"الرحل والمنزل – ط" رسلة، و"الاشتقاق – خ" و"مشكل القرآن – ط" و"المشتبه من الحديث والقرآن – خ" و"العرب وعلومها – خ" و"الميسر والقداح – ط" و"تفسير غريب القرآن – ط" و"المسائل والأجوبة – ط" في الحديث و"النبات – خ" فصول منه، و"الألفاظ المغربة، بالألقاب المعربة – خ" في القرويين (كما في تذكرة النوادر 109) و"غريب الحديث – ط" جزآن منه، في الهند. ومنه أجزاء مخطوطة في الظاهرية بدمشق، وجزء (هو المجلد الثاني) في شستربتي الرقم 3494 كتب في بغداد سنة 279.
أبو عبيدة معمر بن المثنى (728 – 823)
عالم باللغة والشعر من أهل البصر. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب وعنه أخذ أبو عبيد ابن سلام وأبو نواس جمع الكثير من أخبار العرب وأنسابهم. كان خارجياً شعوبياً وكتابه "المثالب" يطعن بأنساب العرب. من كتبه "حجاز القرآن في التفسير" و"كتاب الخيل"، و"نقائض جرير والفرزدق".
أحمد فارس الشدياق (1804 – 1888)
أديب لبناني من رواد الصحافة العربية الأوائل. ولد في عشقوت وتوفي استانبول. تعلم في مدرسة عين ورقة. سافر إلى مصر ومالطة وتونس، وأسلم. ثم قصد الاستانة حيث أصدر جريدة "الجوانب". جال في أوروبا. امتاز بمقدرته اللغوية وسهولة أسلوبه. من مؤلفاته "الجاسوس على القاموس"، نقد محيط الفيروز ابادي و"الساق على الساق فما هو الفارياق".
أدونيس (علي أحمد سعيد) (1930 - )
اسمه الكامل علي أحمد سعيد اسبر. ولد سنة 1930 في قصابين، وهي قرية جبلية في محافظة اللاذقية بسوريا. عاش حتى الرابعة عشرة في القرية، دون مدرسة. لكنه تلقى على ولده مبادئ القراءة والكتابة، ودرس على يديه الشعر العربي القديم, في الرابعة عشرة انتقل إلى المدينة ليتعلم على نفقة أول حومة استقلالية، وذلك بفضل قصيدة وطنية القاها ترحيباً بشكري القوتلي، رئيس الجمهورية آنذاك. وكانت هذه القصيدة أولى دلائل موهبته الشعرية المبكرة. أتم دروسه الثانوية في مدينة اللاذقية، والجامعية في جامعة دمشق، حيث نال الإجازة في الفلسفة سنة 1954. وفي هذه المرحلة الجامعية بدأ انفتاحه على الشعر العالمي.
مارس حياة الجندية سنتين، لمناسبة أدائه خدمة العلم بين سنتين 1954 – 1956. وهذه المرحلة أتاحت له تجارب مهمة حياتية نفسية، أثرت في نتاجه الشعري تأثيراً كبيراً. انتقل سنة 1956 إلى لبنان نهائياً، حيث استعاد جنسيته اللبنانية. وفي أواخر السنة نفسها، هيأ مع يوسف الخال إصدار مجلة "شعر" لتكون ناطقة باسم الحركة الشعرية الجديدة. وظل يصدرها معه حتى سنة 1936 حيث تخلى عنها. وكان لمجلة "شعر" بين 57 – 63 أثر حاسم أول في حركة الشعر العربي الجديد. يصدر منذ مطلع سنة 1969 مجلة "مواقف"، وهي مجلة ثورية شعارها "الحرية والإبداع والتغير". وينشر فيها الكتاب والمفكرون والفنون والشعراء العرب من مختلف البلدان العربية.
صدرت له المجموعات الشعرية التالية:
- "قالت الأرض"،
- قصائد أولى (بيروت، 1958)
- أوراق في الريح (بيروت، 1958)
- أغاني مهيار الدمشقي (بيروت، 1961)
- كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل (بيروت، 1965)
- المسرح والمرايا (بيروت، 1968)
أبو شبكة (1903 – 1947م)
إلياس أبو شبكة: مترجم يحسن الفرنسية، كثير النظم بالعربية لبناني اشترك في تحرير بعض الجرائد ببيروت. ونقل إلى العربية "تاريخ نابليون – ط" وقصصاً من مسرحيات "موليير" ونشر مجموعات من نظمه.
أمين الرحياني (1876 – 1940)
أمين بن فارس بن أنطون بن يوسف بن عبد الأحد البجّاتي، المعروف بالريحاني: كاتب خطيب، يعد من المؤرخين. ولد بالفريكة (من قرى لبنان) وتعلّم في مدرسة ابتدائية، ورحل إلى أميركا، وهو في الحادية عشرة. ودخل في كلية الحقوق، ولم يستمر. وعاد إلى لبنان سنة 1898م، فدرس شيئاً من قواعد العربية وحفظ كثيراً من لزوميات المعري. وتردد بين بلاد الشام وأميركا، ومات في قريته التي ولد بها. وكان يقال له فيلسوف الفريكة.
من كتبه:
"الريحانيات" أربعة أجزاء، مقالاته وخطبه، و"ملوك العرب" جزآن، و"تاريخ نجد الحديث" و"فيصل الأول" و"قلب العراق".
توفيق يوسف عواد (1911 – 1962)
ولد في قرية "بحر صاف"، من أعمال المتن في 13 شباط 1911. بدأ دراسته في مدرسة القرية "تحت السنديانة"، على يد رئيس دير ما يوسف، الذي كان يلقن الفرنسية إلى جانب العربية. ثم انتقل إلى مدرسة اليسوعيين في بكفيا، حيث قضى سنتين أو ثلاث سنوات.
تابع دراسته الثانوية في "كلية القديس يوسف" ببيروت حيث نال شهادة البكالوريا عام 1928.
ترك القرية في الثانية عشرة من عمره، وعاش في غرفة للأجرة طوال سنين.
بعد أن تخرج من الكلية، انصرف إلى الكتابة في الصحف، فكتب في "البرق" لصاحبها الأخطل الصغير، وفي "البيان" لبطرس البستاني، وفي "الراية" ليوسف السودا.
تولى خلال ثماني سنوات سكرتيرية التحرير في جريدة "النهار"، منذ تأسيسها على يد جبران تويني. وكتب فيها زاوية بعنوان "نهاريات" وامضاء "حماد".
وفي أثناء عمله في "النهار"، تابع دراسة الحقوق في الجامعة السورية.
عام 1941، أنشأ جريدة "الجديد"، التي باع امتيازها عام 1946 للمحامي محسن سليم.
مؤلفاته المطبوعة:
- ("الصبي الأعرج"، 1963م)
- ("قميص الصوف"، 1937)
- ("الرغيف"، 1938)
- ("الغذارى"، 1944م)
- ("قصص من توفيق عواد"، 1963)
- ("السائح والترجمان"، 1964م)
جبرا إبراهيم جبرا (1920 – 1995)
ولد في "بيت لحم" بفلسطين. درس في الكلية العربية بالقدس، وجامعة إكستر بإنجلترا. وجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية. درس الأدب الإنجليزي في "الكلية الرشيدية" بالقدس. وعمل رئيساً لنادي الفنون بالقدس. درس الأدب الإنجليزي في كلية الآداب والعلوم ببغداد، وحاضر في دار المعلمين العالية، وفي كلية الملكة عالية – بغداد 1951، ساهم مع الفنان جواد سليم في تأسيس "جماعة بغداد للفن الحديث".
أصدر ما يقرب من ستين كتاباً.
من كتبه:
- "صراخ في ليل طويل".
- عرق وقصص أخرى.
- تموز بالمدينة شعر.
- صيادون في شارع ضيق.
- الحرية والطوفان، دراسات نقدية.
- الفن في العراق اليوم.
- الرحلة الثامنة، دراسات نقدية.
- السفينة، رواية.
- الفن العراقي المعاصر، بالإنجليزية والعربية.
- جواد سليم ونصب الحرية، دراسة نقدية.
- النار والجوهر، دراسات في الشعر.
- البحث عن وليد مسعود، رواية.
- ينابيع الرؤيا، دراسات نقدية.
- لوعة الشمس، شعر.
- عالم بلا خرائط (مع د. عبد الرحمن منيف).
- السونيتات لوليم شكسبير، دراسة مع ترجمة أربعين سونيته.
- جذور الفن العراقي بالإنجليزية.
- الفن والحلم والفعل، دراسات وحوارات.
- الغرف الأخرى، رواية.
- الملك الشمس، سيناريو روائي.
- جذور الفن العراقي، بالعربية.
- البئر الأول، فصول من سيرة ذاتية.
- بغداد بين الأمس واليوم، دراسة عمرانية.
- أيام العقاب (خالد ومعركة اليرموك) سيناريو روائي.
- تأملات في بنيان مرمري، دراسات وحوارات.
- يوميات سراب عفان، رواية.
- معايشة النمرة، وأوراق أخرى.
- أقنعة الحقيقة وأقنعة الخيال.
جبران خليل جبران (1883 – 1931)
أديب لبناني كبير، شاعر مفكر، مجدد. ولد في بشرى وتوفي في نيويورك. من أركان النهضة الأدبية في المهجر. رئيس الرابطة التعليمية في نيويورك. برع في فن التصوير بعض تصاويره موجودة في متحف جبران في بشرى. له مؤلفات عربية وإنجليزية.
من كتبه: "الأرواح المتمردة"، "الأجنحة المتكسرة"، "النبي"، "يسوع ابن الإنسان"، "العواطف"، "البدائع والطرائف"، "المواكب"، "وآلهة الأرض".
حسان بن ثابت ( - 54هـ)
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي من أعرق بيوت الأنصار أمه خزرجية أيضاً.
ويعد حسان من المعمرين فقد روى أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وعاش ستين في الإسلام.
وكان في الجاهلية شاعر الخزرج ويهاج الأوس ولما قدم النبي إلى المدينة أسلم حسان وأبدع في الدفاع عن الإسلام بلسانه.
وفي عهد الخليفة عثمان كان حسان محباً للخليفة فلما قتل انضم للمطالبين بالثأر لعثمان فنظم قصيدته النونية العنيفة. وتوفي حسان في عهد معاوية سنة 54هـ بعد أن كف بصره.
أبو سليمان محمد الخطابي (931 – 889)
محدث وفقيه ولغوي من أهل ، من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر، من كتبه "معالم السنن" في شرح "سنن" أي داود "وبيان إعجاز القرآن.
طه حسن (1889 – 1973)
أديب وناقد مصري كبير، لقب بعميد الأدب العربي. ولد في الصعيد. فقد بصره طفلاً. درس في الأزهر والجامعة الأهلية بفرنسا. أسس جامعة الأسكندرية وتولى إدارتها 1942. وزير المعارف 1950، عمل على إقرار مجانية التعليم وأسس جامعة عين شمس. له أنتاج وافر يتوزع في الصحف والمحاضرات والكتب ويشمل الأدب والنقد والسيرة والقصة.
من مؤلفاته الكثيرة:
- ذكرى ابي يالعلاء" و"ابن خلدون" و"في الأدب الجاهلي" و"حديث الأربعاء" و"مع المتنبي" و"على هامس السيرة" و"الأيام" و"شجرة البؤس" و"المعذبون في الأرض"، وله ترجمات كثيرة.
عبد القاهر الجرجاني (توفي سنة 471هـ - 1078م)
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو بكر: وضاع أصول البلاغة كان من أئمة اللغة. من أهل جرجان (بين طبرستان وخراسان) له شعر رقيق. من كتبه "أسرار البلاغة – ط" و"دلائل الإعجاز – ط" و"الجمل – خ" في النحو و"التتمة – خ" نحو، و"المغني" في شرح الإيضاح، ثلاثون جزءاً، اختصره في شرح آخر سماه "المقتصد – خ" في الظاهرية، و"إعجاز القرآن – ط" و"العمدة" في تصريف الأفعال، و"العوامل المئة – ط".
أبو هلال الحسن العكسري (توفي بعد 1005):
أديب وشاعر، تعلم عن خاله أي أحمد العسكري.
من مؤلفاته: "كتاب الصناعتين: النظم والنثر" ذكر فيه كتاب "البيان والتبين" للجاحظ، وله "جمهرة الأمثال"، و"الفروق" في اللغة، و"ديوان شعر".
الجرجاني علي بن محمد (1339 – 1413)
متكلم أشعري وفيلسوف، عرف "بالسيد الشريف" علم في شيراز وسمرقند، كتب بالفارسية والعربية. له شروح في أصول الفلسفة والفقه والمنطق وعلم الهيئة.
من كتبه:
"التعريفات"، و"شرح مواقف"، "شرح السراجية" و"شرح مواقف" و"شرح السراجية" للسجاوندي. وله بالفارسية "الدرّة" و"الغرّة" رسالتان مشهورتان في المنطق نقلهما إلى العربية ابن محمد المعروف بابن الشريف (ت 1434) وشرح "الغرّة" نجم الدين خضر الرازي (ب 1446) والصوري.
قدامة بن جعفر (توفي سنة 337هـ - 948م)
قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج: كاتب، من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفة.
كان في أيام المكتفي بالله العباسي، وأسلم على يده، وتوفي ببغداد. يضرب به المثل في البلاغة. له كتب، منها "الخراج – ط" قسم منه، و"نقد الشعر – ط"، و"جواهر الألفاظ – ط" و"السياسة" و"البلدان" و"زهر الربيع" في الأخبار والتاريخ، و"نزهة القلوب" و"الرد على ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام".
عبد القادر القرشي (1297 – 1373م)
عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد محيي الدين: عالم بالتراجم، من حفاظ الحديث، من فقهاء الحنفية. مولده ووفاته بالقاهرة. له "العناية في تحرير أحاديث الهداية" و"شرح معاني الآثار للطحاوي" و"ترتيب تهذيب الأسماء الواقعة" في الهداية والخلاصة – خ" في يني جامع (782/3) و"البستان في فضائل النعمان" و"الجواهر المضية في طبقات الحنفية – ط" مجلدان، وهو أول من صنف في طبقاتهم. وله "المؤلفة قلوبهم" و"أوهام الهداية" و"رسائل، في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل".
محمد الماغوط: (1934 - )
من مواليد السلمية في سوريا. بدأ حياته الأدبية في الخمسينات. عمل في الصحافة في سوريا ولبنان الخليج. يكتب الشعر والمسرح وله نشاط إذاعي وتلفزيوني ومسرحي معروف، قدمت له عدة أعمال مسرحية في دمشق وفي بيروت. ارتبط اسمه الشعري بالقصيدة النثرية. ووصف بأنه بائس وظلامي الأفق: يدور الكثير من شعره حول الإنسان المستلب، المحاصر بظروف الفقر والتخلف والتعاسة.
له:
- حزن في ضوء القمر شعر بيروت 1959.
- غرفة بملايين الجدران شعر دمشق 1964.
- العصفور الأحدب مسرحية بيروت 1967.
- الفرح ليس مهنتي شعر دمشق 1970.
- المهرج مسرحية بيروت 1974.
- المارسيليز العربي مسرحية بيروت 1975.
- المجموعة الكاملة لأعمال الشاعر محمد الماغوط بيروت 1973.
ميخائيل نعيمة (1989 – 1949)
يعد ميخائيل نعيمة واحداً من أعمدة مدرسة المهجر، ولسان حال الرابطة القلمية التي تكونت في عام 1920 وانفض دورها في عام 1931، وضمت بين صفوفها "جبران خليل جبران" و"نسي عريضة" وايليا أبو ماضي" "نعمة الحاج".
ولد ميخائيل نعيمة في قرية "بسكنتا" بلبنان عام 1889 لأبوين أرثوذكسيين وتلقى تعليمه الأول في مدرسة صغيرة تشرف عليها طائفة الأرثوذكسية ثم انتقل في مرحلة تالية إلى مدرسة روسية ثم إلى دار المعلمين الروسية بالناصرة. وفي عام 1906 تخرج في دار المعلمين واختير في بعثة دراسية إلى روسيا. شد رحاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلتحق بجامعة واشنطن، ويتخرج فيها عام 1916.
يعد كتاب "الغربال" وكتاب "الغربال الجديد" زبدة ما كتب ميخائيل نعيمة في النقد الأدبي. وله ديوان شعري وحيد هو "همس الجفون".
نازك الملائكة (1927 – 1977)
شاعرة عراقية، ولدت في بيئة أدبية من أم شاعرة وأب شاعر، وجالست وهي طفلة، مجالس الأدب. تابعت دراستها في بغداد، ودخلت دار المعلمين العالية حيث حصلت على ليسانس اللغة العربية، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية وحازت الماجستير في الأدب المقارن. في سة 1947 نظمت أول قصيدة على التفعيلة الواحدة، ثم راحت تنظر لما أسمته بالشعر الحر. فأصدرت سنة 1962 كتابها النقدي المعروف "قضايا الشعر المعاصر" الذي أعيد طبعه حتى الآن عدة مرات.
لها:
- عاشقة الليل 1947.
- شظايا ورماد 1949.
- قرارة الموجة 1957.
- شجرة القمر 1968.
- مأساة الحياة للإنسان 1970.
- قصتي مع الشعر سيرة ذاتية بيروت 1973.
- الكتابة عمل انقلابي مقالات بيروت 1975.
- كل عام وأنت حبيبتي شعر بيروت 1978.
وقد صدرت هذه الأعمال وأعمال جديدة للشاعر ضمن مجلد "الأعمال الكاملة" بيروت 1977 وقد أعيد طبعه عدة مرات.
أبو عبد الله محمد النفري (توفي 354هـ، 965م)
متصوف عراقي، نسبته إلى بلده النفر بالكوفة. اشتهر بكتابيه: "المواقف" و"المخاطبات" في التصوف.
الوليد بن المغيرة (530 – 622م)
الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو ابن مخزوم، أبو عبد شمس: من قضاة العرب في الجاهلية، ومن زعماء قريش، ومن زنادقتها. يقال له "العدل" لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو "البيت" جميعها، والوليد يكسوه وحده. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية، وضرب ابنه هشاماً على شربها. وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم، فعاداه وقاوم دعوته. قال ابن الأثير: وهو الذي جمع قريشاً وقال: "إن الناس يأتونكم أيام الجج فيسألونكم عن محمد، فتختلف أقوالكم فيه، فيقول هذا: كاهن، ويقول هذا: شاعر، ويقول هذا: مجنون، وليس يشبه واحداً مما يقولون، ولكن أصلح ما قيل فيه "ساحر" لأنه يفرق بين المرء وأخيه والزوج وزوجته" وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر، ودفن بالحجون. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد.
فهرس الأعلام الأجنبية
أبولونير جويلم (1810 – 1918)
شاعر وكاتب قصة قصيرة وناقد فرنسي، فتح آفاقاً جديدة للتكعيبية والدادية والسريالية الحديثة. صديق لبيكاسو وبراكو. كتب الرسامون التكعيبيون عام 1913 ليشرح التكعيبية وأهدافها: بأنها تصور الحضور الكلي الآني. لذلك نجدهم يتجنبون الأساليب التقليدية للمنظور. كتب ديوانين شعريين بدون تنقيط بالإضافة إلى روايات ومسرحيات أراد القول أن الحياة المعاصرة تصهر القديم والحديث أو تفرض الترتيب على المبعثر كيفما اتفق. نظم الشعر الأصيل واستخدم الاستعارة الحديثة والتقليدية والتلاعب بالألفاظ ليدلل على هدفه. إنه ذو تأثير أدبي قوي على الجيل المعاصر من الشعراء الفرنسيين، وواضع مصطلح السريالية.
أودون (1907 – 1973)
ولد في يورك كائن لفيزيائي معروف. أكمل دراسته في جامعة أكسفورد واثر على عدد من زملائه من بينهم لويس ماك بنس وستيفن بيندر وقد شعرت هذه المجموعة بالحاجة إلى خلق أساليب شعرية جديدة ليعبر عن الرغبة المجموعة في اتجاه الوعي الاجتماعي والإصلاح السياسي، اشتهر شعره بالتلاعب بالألفاظ وتوظيف القوافي.
أندريه بريتون (1896 – 1953)
ولد عام 1896 في تانشبراي أورن في فرنسا، مؤسس السيريالية.
أبرز مؤلفاته: "جبل التقوى"، "الحقول المغناطيسية بالاشتراك مع فيليب سوبر"، "وضوح الأرض"، "بيان السيريالية"، "السمكة الذائبة"، "رواية شعرية"، "الاتحاد الحر"، "المسدس ذو الشعر الأبيض"، "الحب المجنون"، "بيانات السيريالية"، "المصباح في ساعة الحائط".
بدأ نشاطه عام 1919م يوم أسس مجلة أدب الدادائية مع لويس أراغون، وفيليب سوبو، ونشر عام 1924م بيان السيريالية الأول.
باختين (1895 – 1975)
باحث سوفياتي، ولد، في أول وتوفي في موسكو. نشر دراسات عدة تحت أسماء مستعارة وعندما غيبه الموت تكشف كواحد من أكبر المنظرين الماركسيين للأدب في القرن العشرين.
بحث في اللغة وكشف أسسها المادية الاجتماعية. ناقش معاصرية من اللغويين ونقض الكثير من مفاهيمهم كما نقض مفهوم التزامن عند دي سوسير ودل على مكمن الضعف فيه.
من أهم دراساته:
- الماركسية وفلسفة اللغة 1929، وقد نقل عام 1973 إلى الانكليزية وعام 1977 إلى الفرنسية.
- الفرويدية 1927.
- ديستويفسكي، الشعرية والأسلوب، 1929.
- الملحمة والرواية 1965.
- أعمال فرنسوا رابليه والثقافة الشعبية في العصور الوسطى في عصر النهضة 1965.
بارت (1915 – 1980)
ناقد ومنظر فرنسي. ولد في مدينة شيربورغ. أصيب في شبابه بمرض السل الذي عانى منه طويلاً، مات إثر حادث سيارة صدمته.
عمل في بوخارست 1948م، وفي الاسكندرية محاضراً في جامعتها 1949م، ثم عين مديراً للدروس في المعهد التطبيقي للدراسات العليا في باريس 1962م، وأخيراً دخل الكوليج دي فرانس أستاذاً فيها 1978.
يحتل بارت مركزاً أساسياً في حركة النقد الفرنسي المعاصر. خرج على الطرق التقليدية السائدة في السوربون.
عالم إشارات، مفكر وأديب، ارتكز في بحثه النقدية إلى الماركسية، والوجودية السارترية، والتحليل النفسي، والبنيوية، توقف عند السيميولوجية الأدبية منطلقاً من أعمال دي سوسير.
اهتم باللغة من حيث هي تجليات الوعي الجماعي.
له:
- "الكتابة في الدرجة صفر" 1953م (نقله إلى العربية د. محمد برادة)
- "أساطير" 1957م
- "حوار مع راسين" 1963م
- "دراسات نقدية" 1964م
- "عناصر السيميولوجيا" 1965م.
- "س/ز" 1970م
- "دراسات نقدية جديدة" 1972م
- "لذة النص" 1973م
- "بارت بقلمه" 1973م
- "مقاطع من خطاب عاشق" 1977م
- "الغرفة المضيئة" 1980م
بول ايلوار (1895 – 1952)
شاعر فرنسي، ولد في سان دنيس، سريالي.
من كتبه: "العيون الخصبة"، "عطاء للنظر"، "رغبة البقاء الجامحة".
رامبو جان آرثر (1854 – 1891)
يلعب هذا الشاعر الفرنسي دوراً هاماً كمبشر بالرمزية والسيريالية. ترك الأدب قبل بلوغه سن العشرين. إنه عبقري عنيد متمرد، هرب من المنزل في سن الخامسة عشرة بادئاً حياة تشرد دائم. بعد علاقة قصيرة مع فيرلين هجر الكتابة، وأعال نفسه بشكل مغامر بمزاولته أعمالاً متنوعة في ألمانيا، وجزر الهند الشرقية ومصر حتى استقر أخيراً في الحبشة، حيث تاجر بالعبيد والقهوة والسلاح. العمل الوحيد الذي نشره رامبو بنفسه كان "فصل في الجحيم" 1873 وهو عبارة عن سيرة ذاتية نفسية. كتب "الأنوار" عام 1871 ونشر عام 1886م يتألف من قصائد شعرية ونثرية أفضل قصائده المعروفة هي "القارب المخمور".
جان بول سارتر (1905 – 1973)
فيلسوف وروائي وكاتب مسرحي فرنسي، ولد في باريس، ودرس في المدرسة العامة الثانوية من عام 1924 – 1929م. درس الفلسفة في هامز عام 1931م وفي 1932 درس في برلين. عمل بعد عودته إلى فرنسا، لسنوات قلائل، في المدارس الفرنسية. كرس نفسه للكتاب فقط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
مقالاته الأولى ملخص لنظرية العواطف 1939، سيكولوجية الخيال 1940 لم تلفت الاهتمام نسبياً. روايته الأولى الغثيان 1938 ومجموعة قصصه القصيرة المودة 1938 جلبتا له اعترافاً فورياً ككاتب. يطرح كل منهما الأفكار الوجودية في التغريب والالتزام والخلاص عبر الفن بشكل دراسي.
يكشف في كتابه الفلسفي الهام الوجود والعدم 1943 شرط الإنسان بالنسبة لذاته وبالنسبة للعالم الخارجي وللأفراد الآخرين. عمم هذه المفاهيم في مقالتيه الوجودية 1946 ووضحها في روايته الثلاثية الطريق إلى الحرية 1945 – 1949.
فكرته الأساسية للكاتب الملتزم موضحة في مسرحياته التي تعالج قضايا أخلاقية.
شارل بيير بودليير (1821 – 1867)
كاتب وشاعر فرنسي.
ولد في باريس، سافر إلى الهند ثم عاد إلى باريس ليلتقي ديلاتروا ومانيه.
من أجود أعماله مجموعة شعرية بعنوان "أزهار الشر" ومجموعة "الجنة الاصطناعية و"أشعار صغيرة في النثر".
فرويد (1856 – 1939)
مؤسس علم التحليل النفسي. وهو ابن تاجر يهودي. ولد فرايبارج في الامبراطورية النمساوية – الهنغارية.
عام 1860 استقر أهله في فيينا حيث حصل علومه في المدرسة العلمانية، كان يتألم من النزعة المعادية للسامية عند رفاقه.
من أهم أعماله:
- "علم الأحلام" 1900م
- بسيكولوجيا الحياة اليومية 1901م
- "ثلاثة دراسات في نظرية الجنس" 1905م (بالألمانية)
- "خمسة دروس في التحليل النفسي" 1910م (بالألمانية)
- "مدخل إلى التحليل النفسي" 1916/ 1918م (بالألمانية)
- "حياتي والتحليل النفسي" 1925م
كوهان:
- ناقد وباحث فرنسي. اهتم بالمسألة الشعرية ورأى أن تحلل اللغة على مستويين:
الأول صوتي يشكل مصدراً أولاً للشعر. والثاني معنوي يشكل مصدراً ثانياً له. - منطلقاً من هذا التوضيح أمكنه أن يميز: القصيدة النثرية (أو قصيدة المعنى). وهي تترك الوجه الصوتي. القصيدة الصوتية وهي لا تعمل إلا على المنابع الصوتية للغة، وهذا ليس بالعمل الهام، في نظره، من هنا تسميتها بالشعر المنظوم القصيدة الصوت – معنوية، أي القصيدة الكاملة.
له:
- "بنية اللغة الشعرية" 1968م.
لويس أراغون (1897 – 1982)
أديب فرنسي من مؤسسي السريالية، شاعر وناقد وسياسي وشيوعي من رواياته "قروي باريس"، "الأحياء الجميلة"، "أسبوع الآلام" ومن شعره "عينا إلسا".
هنري ميشو (1899 – 1959)
ولد هنري ميشو في نامور عام 1899م. دراسة في بلجيكا. رحلة حول العالم. خالط الرسامين السرياليين. عاش بمعزل عن الحياة الأدبية.
من مؤلفاته:
- من أكون 1927م، "اكوادور" 1929م، "أملاكي"، "همجي في آسيا" 1932م، "الليل يتحرك" 1934م، "رحلة إلى غارابانية الكبرى" 1936م، "ريشة" 1983م، "في بلاد السحر" 1942م،
- اختبارات، تعزيمات" 1945، "هنا، بوديما" 1946م، "ممرات" 1950م، "الوجه باتجاه المزاليج" 1954م، "أعجوبة حقيرة" 1955م، "المشاغب اللامنتهي" 1957م، "سلام في التحطيم" 1959، "معرفة بواسطة المهاوي" 1961م، "رياح وغبائر" 1962م.
(الناشرون: غاليمار، فوركاد، منشورات أول النهار).
ينشأ صنيعه عن صدام عنيف بين نفسه والعالم "الثقيل"، "العدائي". و"القوى"، و"المظاهر" التي تجاوره، هي كثيفة، لا تدرك، وخادعة.
ومع ذلك فالشاعر لا يستسلم ليأسه وضعفه. انه يجيب على عداء العالم "بالتمرد".
وولت ويتمان (1819 – 1892)
ولد وولت ويتمان في لونج آيلاند من أبوين ينتميان إلى أصول إنجليزية وهولندية. عاشت عائلته في بروكلين بين عام 1823 و1833 حيث تلقى تعليمه الأولى، لكنه لم يكمل تعليمه واشتغل صبياً في مطبعة. وبعد اطلاعه المستمر الذي منحه خلفية ثقافية عريضة استطاع أن يعمل بالتدريس الذي تركه للعمل بالصحافة وتحرير المقالات في مجلة "لونج آيلاند". في تلك الفترة كان يقرأ بنهم كل ما تصل إليه يداه: الإنجيل وشكسبير وأوسيان وسكوت وهوميروس، وأيضا شعراء الهند وألمانيا القدماء، كذلك قرأ دانتي كله. أثرت هذه القرارات على شعره، وخاصة في مرحلته المتأخرة، وبدا هذا التأثير واضحاً سواء في المضمون أو الإيقاع، ثم اشتغل بالسياسة وكان من الرواد الأول الذين أرسوا دعائم الديمقراطية الأمريكية.
- ديوانه الشهير "أوراق العشب" الذي نشر في مقدمة نقدية له عام 1855.
- وديوان "دقات الطبل" 1865.
- كتب في عام 1871 دراسته التحليلية "آفاق ديمقراطية" ثم "الطريق إلى الهند" الذي جسد في فلسفته بأن تجديد الفكر الإنساني والجنس البشري لن يتم إلا من خلال الاتحاد بين حكمة الشرق الروحاني وحديثة الغرب الطاغية.
- وفي العشرين سنة الأخيرة من عمره استقر في نيوجيرسي.
- مات عام 1892م في العام التالي تاركاً ثروة شعرية ما زالت قيمتها تزداد مع مرور الأيام.
بول ريكور (1913 – 1976)
- فيلسوف فرنسي، ولد في فالنس، انطلق من طريقة مبنية على الظواهرية ليستخلص أفضل السبل المؤدية إلى استخدام الفلسفة والتحليل النفسي عند الإنسان ككائن أخلاقي.
- من كتبه: "كتاب وذئب"، "دراسة عن فرويد".
تودوروف:
- باحث وناقد من أصل روسي. يقيم في باريس ويعمل في مركز الأبحاث الوطني للعلوم (C.N.R.S).
- اختار ونقل إلى الفرنسية نصوص الشكليين الروس التي نشرت تحت عنوان "نظرية الأدب".
- بحث في بنية القول الأدبي، وأوضح معنى "الشعرية" وحدد القوانين العامة لولادة العمل الأدبي.
جاكسون (1896 – 1960)
- ولد في موسكو، وهو اليوم أستاذ في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.
- مؤلف عدة أعمال في جميع ميادين الألسنية، وفي نظرية الأدب. إلا أنه مارس نشاطه أيضاً في مجالات أخرى عدة: الانتروبولوجيا، الفولكلور، علم النفس، نظرية الأعلام الخ.
- مؤسس حلقة موسكو الألسنية (1951 – 1920) التي ذابت فيما بعد في حركة الشكليين.
- عاش بين عام 1920م وعام 1939م في تشيكوسلوفاكيا حيث كان أنشط الأعضاء في حلقة براغ الألسنية.
- كتاباه "القصيدة الروسية الحديثة" 1921 و"حول الشعر التشيكي" 1923 هما جزء من موروث الشكليين.
- خلال الحرب ذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث يعلم حالياً الألسنية العامة واللغات والآداب السلافية في جامعة هارفرد.
- اشتهر جاكسبون بتحليله الدقيق لما يسميه بوظائف اللغة، ورأى أن الوظيفة الشعرية هي التي تهيمن في الشعر على الوظيفة الاحالية الواقعية، مما يجعل الشعر يبدو غامضاً.
- كتب بأكثر من لغة كتابه الهام "مسائل في الشعرية"، المؤلف من نصوص كتبت خلال أكثر من نصف قرن (1919 – 1972). بعض هذه النصوص كتبه بالفرنسية والآخر بالانكليزية والالمانية والتشيكية.
من كتبه المنقولة إلى الفرنسية:
- "دراسات في الألسنية العامة" 1963م
- "مسائل في الشعرية" 1973م
- "ثماني مسائل في الشعرية" 1977م
- "ثلاثة دروس عن الصوت والمعنى"