 ليس ليوبولد سيدار سنغور "اكبر شاعر أفريقي باللغة الفرنسية"، كما قيل عنه فحسب، بل هو شاعر كبير خارج التصنيفات العرقية والجغرافية. وحصره ضمن الخريطة أو الهوية الشعرية الأفريقية قد يسيء إليه بعض الإساءة على رغم انصرافه إلى قضية "الزنوجة" وجعلها أشبه بالمشروع الشعري والثقافي والسياسي في الحين عينه. وإن كان سنغور يحتل مرتبة الصدارة في الشعر الأفريقي الفرنكوفوني فهو يحتل موقعاً مهماً في الشعر الفرنسي أيضا عبر مواصلته أولا المسار الذي كان استهله بول كلوديل وسان جون بيرس، والذي يسمى ب(الشعر الاحتفالي)، ثم عبر صهره اللهجة الأفريقية بلاغة وإيقاعاً في نسيج اللغة الفرنسية. فهو ظل دوما ذلك الشاعر الأفريقي الذي يكتب بالفرنسية والذي يصر (كما يعبر) على أنه يكتب أولا لشعبه. ويقول سنغور: "عبر ملامسة الشعب الأفريقي الفرنسي اللغة، ألامس الفرنسيين أكثر وكذلك البشر الآخرين الذين هم وراء البحار والحدود". ولعل سنغور استطاع عبر هويته الثنائية ولكن المتألقة والمتناغمة جوهريا (وربما ظاهرا) أن يؤسس "شعرية" أفريقية حديثة لا تتردد عن القبض على روح اللغة الفرنسية من غير أن تنفصل عن جذورها الأولى ولا وعيها الجماعي.
ليس ليوبولد سيدار سنغور "اكبر شاعر أفريقي باللغة الفرنسية"، كما قيل عنه فحسب، بل هو شاعر كبير خارج التصنيفات العرقية والجغرافية. وحصره ضمن الخريطة أو الهوية الشعرية الأفريقية قد يسيء إليه بعض الإساءة على رغم انصرافه إلى قضية "الزنوجة" وجعلها أشبه بالمشروع الشعري والثقافي والسياسي في الحين عينه. وإن كان سنغور يحتل مرتبة الصدارة في الشعر الأفريقي الفرنكوفوني فهو يحتل موقعاً مهماً في الشعر الفرنسي أيضا عبر مواصلته أولا المسار الذي كان استهله بول كلوديل وسان جون بيرس، والذي يسمى ب(الشعر الاحتفالي)، ثم عبر صهره اللهجة الأفريقية بلاغة وإيقاعاً في نسيج اللغة الفرنسية. فهو ظل دوما ذلك الشاعر الأفريقي الذي يكتب بالفرنسية والذي يصر (كما يعبر) على أنه يكتب أولا لشعبه. ويقول سنغور: "عبر ملامسة الشعب الأفريقي الفرنسي اللغة، ألامس الفرنسيين أكثر وكذلك البشر الآخرين الذين هم وراء البحار والحدود". ولعل سنغور استطاع عبر هويته الثنائية ولكن المتألقة والمتناغمة جوهريا (وربما ظاهرا) أن يؤسس "شعرية" أفريقية حديثة لا تتردد عن القبض على روح اللغة الفرنسية من غير أن تنفصل عن جذورها الأولى ولا وعيها الجماعي.
قد يكون سنغور عانى بعض المعاناة من ذلك الانتماء المزدوج الأفريقي والفرنسي وأخذ عليه البعض من مواطنيه ميله إلى الثقافة الفرنسية وإلى الرؤية السياسية الفرنسية متناسين تاريخه النضالي الطويل ضد الاستعمار والهيمنة الفرنسيين وضد "العبودية" الثقافية التي كانت تمارس في فرنسا علي الطلبة "الغرباء" وخصوصا الأفارقة عبر استدعاء "الغاليين" أسلاف الفرنسيين. كتب في إحدى قصائده الباكرة يقول: "يا الله، سامح فرنسا... التي تعامل أهل السنغال كمرتزقة، جاعلة منهم كلاباً سوداً للإمبراطورية".
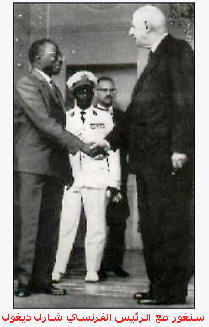 إلا أن سنغور الذي كان وفيا للثقافة الفرنسية التي نشأ في ظلالها، عاش نوعاً من الصراع الداخلي ضل يعتمل فيه حتى أيامه الأخيرة. فهو لم يستطع أن ينكر أثر تلك الثقافة على فكره وشعره ورؤيته السياسية لكنه لم يستطع أن ينسى أيضا "زنوجته" وتاريخه الزنجي المفعم بالمآسي والهموم. ولعل هذا الصراع هو مثيل الصراع الآخر الذي عاشه كذلك بين صفته السياسة وصفته الشعرية. وقد أثر حتماً صفة الشاعر مدركاً أن الشعر هو رسالته الأولى والأخيرة. وقد قال جهارا: "ليمت السياسي تماماً وليحيى الشاعر". لكن التجربة السياسية التي خاضها بدءأ من النضال ضد الاستعمار والكفاح من أجل الاستقلال وانتهاء بتوليه رئاسة دولة السنغال طوال عشرين عاما (1960 - 1980)، لم تكن خلوا من "فن" السياسة القائم على القسوة والتجاهل والتناقض. فهو مارس الرقابة على الصحافة خلال رئاسته الجمهورية وحارب خصومه السياسيين واعتمد في أحيان سياسة القبضة الحديد بغية ترسيخ القانون متناسياً نزعته الاشتراكية والديموقراطية وانخراطه في الصحافة الحرة أيام النضال.
إلا أن سنغور الذي كان وفيا للثقافة الفرنسية التي نشأ في ظلالها، عاش نوعاً من الصراع الداخلي ضل يعتمل فيه حتى أيامه الأخيرة. فهو لم يستطع أن ينكر أثر تلك الثقافة على فكره وشعره ورؤيته السياسية لكنه لم يستطع أن ينسى أيضا "زنوجته" وتاريخه الزنجي المفعم بالمآسي والهموم. ولعل هذا الصراع هو مثيل الصراع الآخر الذي عاشه كذلك بين صفته السياسة وصفته الشعرية. وقد أثر حتماً صفة الشاعر مدركاً أن الشعر هو رسالته الأولى والأخيرة. وقد قال جهارا: "ليمت السياسي تماماً وليحيى الشاعر". لكن التجربة السياسية التي خاضها بدءأ من النضال ضد الاستعمار والكفاح من أجل الاستقلال وانتهاء بتوليه رئاسة دولة السنغال طوال عشرين عاما (1960 - 1980)، لم تكن خلوا من "فن" السياسة القائم على القسوة والتجاهل والتناقض. فهو مارس الرقابة على الصحافة خلال رئاسته الجمهورية وحارب خصومه السياسيين واعتمد في أحيان سياسة القبضة الحديد بغية ترسيخ القانون متناسياً نزعته الاشتراكية والديموقراطية وانخراطه في الصحافة الحرة أيام النضال.
إلا أن سنغور ظل ذلك الشاعر والمثقف والأكاديمي خلال سنوات رئاسته العشرين واستطاع فعلا أن يؤسس الدولة الأفريقية الحديثة التي نجت من الاضطرابات الرهيبة التي عرفتها الدول الأخرى المجاورة أو البعيدة. وظل الشعب السنغالي يعتبره بمثابة الرمز الأول في السنغال "والوالد" كما كتبت مجلة "جون افريك؟ (أفريقيا الشابة) في العام 1998. وهكذا يمتدح الكاتب الأفريقي وول سوينكا (حائز جائزة نوبل) سنغور كرئيس أفريقي قائلا: "على المستوى السياسي عرفنا خيبات كثيرة. كل الديكتاتوريات التي تلت مراحل الاستقلال، جعلت الحكم الرئاسي الذي رسخه سنغور يبدو نموذجا للحكم الجيد".
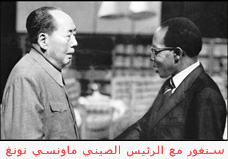 لا تنفصل تجربة سنغور الشعرية عن تجربته السياسية في معناها الرحب وليس في مفهوم "الرئاسة". فهو بدأ شاعراً ومناضلاً سياسياً في آن واحد، والشعار الشهير الذي رفعه (الحرية، الزنوجة، الإنسانية) ينتمي إلى الحقيقة الشعرية مقدار انتمائه إلى الهم السياسي والإنساني. وإن كان الشاعر الأفريقي ايميه سيزير (مواليد المارتينيك 1912) سياقاً إلى استخدام كلمة "زنوجة" في قصائده فإن سنغور هو الذي أعطاها معناها العميق والشامل جاعلاً منها مشروعاً سياسياً وإنسانياً، فإذا هي تعني في معجمه: "مجموع القيم الثقافية لأفريقيا السوداء". وجمع سنغور بين مفهوم "الزنوجة" ومفهوم "الكينونة" كاسراً حال الحصار التاريخي الذي عاشته المجتمعات الأفريقية سياسياً واجتماعياً.
لا تنفصل تجربة سنغور الشعرية عن تجربته السياسية في معناها الرحب وليس في مفهوم "الرئاسة". فهو بدأ شاعراً ومناضلاً سياسياً في آن واحد، والشعار الشهير الذي رفعه (الحرية، الزنوجة، الإنسانية) ينتمي إلى الحقيقة الشعرية مقدار انتمائه إلى الهم السياسي والإنساني. وإن كان الشاعر الأفريقي ايميه سيزير (مواليد المارتينيك 1912) سياقاً إلى استخدام كلمة "زنوجة" في قصائده فإن سنغور هو الذي أعطاها معناها العميق والشامل جاعلاً منها مشروعاً سياسياً وإنسانياً، فإذا هي تعني في معجمه: "مجموع القيم الثقافية لأفريقيا السوداء". وجمع سنغور بين مفهوم "الزنوجة" ومفهوم "الكينونة" كاسراً حال الحصار التاريخي الذي عاشته المجتمعات الأفريقية سياسياً واجتماعياً.
يصعب حصر سنغور في مشروعه "الزنوجي" التحرري وفي نضاله وهويته السياسية. فهو شاعر أولا وأخيرا وشاعر ذو مراس فريد في اللغة الفرنسية وذو جذور تضرب في عمق التربة الأفريقية والذاكرة الجماعية والتراث الشفوي واللاوعي العام. واستطاع سنغور عبر شعره أولا وعبر مواقفه السياسية والثقافية أن أيكون بمثابة الجسر بين حضارتين أو ثقافتين: الثقافة الأفريقية والثقافة الفرنسية، الثقافة الحديثة والثقافة التقليدية أو الشعبية.. وهكذا كان سنغور واحداً من رواد (الحوار) الحضاري الحقيقي القائم على الاحتجاج والرفض والسجال وليس على الإذعان والمماثلة. فهو إذ اعتمد لغة الآخر أو المستعمر فإنما ليكتب فيها ما يمثل حال القطيعة معه، وما يجسد أفكاره هو الذي كان طوال سنوات ضحية من ضحايا الآخر. لقد مثلت تجربة سنغور الطويلة ذلك اللقاء الثقافي الحقيقي، بل ذلك "المفترق" كما يحلو له أن يقول، "مفترق من يعطي ويتلقى" مفترق التعدد و"التهجين". لا يخفي سنغور تأثره بالشعر الفرنسي الحديث الذي كان دأب على قراءته منذ الفتوة مثلما لا يخفي تأثره بالتراث الشعري الشفوي الذي كان يتناقله الرواة والمغنون والشعراء الأفارقة ولم يتوان في أحيان عن إعلان هؤلاء نماذج يحتذيهم. وربما من هنا، من هذا الأثر العميق، تنبع غنائية سنغور التي تمثل الطابع اللافت في شعره. والغنائية هذه قد تكون نتاج ذلك اللقاء بين الثقافات، كالضمير المتكلم (الأنا) كما يقول الناقد الفرنسي جان لويس جوبير ليس معهودا في الشعر الأفريقي. وقد استخدمه سنغور مرسخاً نزعته الغنائية المنطلقة من " الذات" نحو "الآخر" القريب أو المختلف. والقصائد التي كتبها سنغور في باريس الثلاثينات تعبر عن أحوال العزلة والقلق التي كان يعيشها الشاعر الشاب الذي كان لا بد لمدينة عظيمة مثل باريس من أن تصدمه.
وعندما جمع سنغور أعماله الشعرية وضع قصيدته الشهيرة،In Memoriam في مستهلها. وهي أصلا القصيدة الأولى في ديوانه الأول "أغنيات الظل". ويقول سنغور في مطلعها:
"انه الأحد.
أخاف هذا الحشد،
حشد اشباهي ذوي الوجوه الحجرية.
من برجي الزجاجي الذي تسكنه آلام الصداع،
والأسلاف المتلهفون،
أتأمل السقوف والتلال يغطيها الضباب... ".
وفي وسط تلك الغربة لم يكن له إلا أن يستعيد بلاده الأولى التي يصفها ب (الجنة) "جنة الطفولة" أو "المملكة" التي، كما يعبر، عاش فيها واستمع إلى الكائنات الخرافية وهي تتحدث عبر الأشياء والعناصر. بدا ديوان سنغور الأول "أغنيات الظل " أشبه بالاحتفال ب (مملكة الطفولة) في ما تضم من طقوس وأغنيات وأناشيد وسهرات قروية ورواة وسحرة وأطياف هي أطياف الآباء والأجداد الذين يحضرون بشدة أصلا في شعر سنغور. أما الحكمة التي يمكن استخلاصها من ذلك الديوان فهي "التحسر على البلاد السوداء"، البلاد الأولى التي مهما ابتعد الشاعر منها تظل في طويته. الديوان الثاني "قرابين سوداء" كتب سنغور معظم قصائده متأثراً بأجواء الحرب العالمية الثانية وكان هو سيق إليها في عداد الجنود الفرنسيين واعتقل وشهد الويلات والمآسي. وإن بدا العنوان قريباً من النزعة الوثنية الأفريقية التي تشكل أصلا أحد مراجعه الشعرية فإن القصائد تدور على معاناة الجنود السود أو الأفارقة في تلك الحرب العالمية وقد اجبروا على خوضها. وفي هذه القصائد لا يتوانى سنغور عن (اتهام) أوروبا المستعمرة مستخدماً لهجة مباشرة حيناً ونشيدية حيناً آخر. إلا أن شعر سنغور اللاحق سيحفل بأصداء حياته الشخصية وبألوان الذكريات و الأحاسيس والرؤى. وسيكون الحب حاضرا في معظم دواوينه التالية. والحب لديه سيكون مزيجا من العاطفة والشهوة، من الوله والأروسية. ويتجلى شعر الحب في ديوان "اثيوبيات" (أو حبشيات 1965) حتى وإن تخللته القضية الأفريقية أيضا. ولن يخلو ديوان "ليليات" (1961) من شعر الحب كذلك، الحب الأفريقي، المتقد بنار الشهوة ولهب الغريزة الصافبة والبريئة أو الوحشية. ولعل من قصائده الغزلية- الشهوية قصيدة "امرأة سوداء" التي يخاطب فيها الحبيبة الأفريقية قائلا:
"أيتها المرأة العارية،
المرأة السوداء، رافلة بلونك الذي هو الحياة،
بمظهرك الذي هو الرونق
في ظلك نشأت
ونعومة يديك كانت تعصب عيني... ".
أما القصائد اللاحقة التي جمعها من ديوانين هما: "رسائل الشتاء" (1972) و"المراثي العظمى" (1979) فهي تعبر عن حياة ساكنة وهادئة يعيشها شاعر في "مقتبل " الشيخوخة، لكنها حياة غير خالية من القلق والتساؤل والحزن. إنها المراثي التي يكتبها الشاعر متحسرا عبرها لا على رحيل بعض الرفاق والأصدقاء (ضمنهم جورج بومبيدو زميل الدراسة) فقط وإنما على الزمن الذي يعبر إلى غير رجعة.
لعل ما يضفي طابع التماسك على أعمال سنغور الشعرية التي تبدو صنيع مراحل عدة هي المشيئة الصلبة التي انتهجها الشاعر ليبني نصبا شعرياً هو نصب أفريقيا السوداء بامتياز. ولعل كلمة "الزنوجة" تختصر هذا الطموح، الزنوجة بصفتها كينونة وجودية وشعرية ومشروعا إنسانيا وحضاريا. غير أن هذه "الزنوجة" لن تظل في ملت ى عن اللغة أو الأسلوب الشعري. فالشاعر سنغور طالما اضطلع بمهمة إحياء الأسلوب الزنوجي المشبع بالطرافة والفنتازيا، علاوة على طابعه المأسوي والرثائي والنشيدي. ولعل هذا الأسلوب الزنجي هو سليل الشعر الأفريقي الشفوي الذي تأثر الشاعر به وغرف من ينابيعه. وكان على سنغور أن يحمل إلى اللغة الفرنسية بعض المفردات والتراكيب والصور والمجازات التي لم تعهدها تلك اللغة، ناحتا إياها في أحيان أو مترجما إياها أو ناقلا إيقاعها لفظا وصدى. وكان يحلو للشاعر أن يعدد مظاهر أو مبادئ الأسلوب أو اللغة الزنجية ومنها: إيثار الكناية أو المجاز المرسل، استحسان الإيجاز، اعتماد مبدأ التجاور، التكرار... وفي مقدم هذه المبادئ تحل الصورة الشعرية التي يصر الشاعر على استخدامها في طريقة خاصة أو فريدة. ويرتكز مفهومه للصورة على اكتشاف قدرات الكلمة الشديدة الحضور في حضارة قائمة على الشفوي. يقول سنغور في هذا الصدد:
"الكلمة في اللغة الأفريقية هي اكثر من صورة. إنها صورة تماثلية لا تحتاج إلى المجاز أو التشبيه. ويكفي أن يشفى الشيء حتى يتبدى المعنى تحت العلامة. فكل شيء هو علامة ومعنى في الحين نفسه بالنسبة إلى الزنوج - ا لأفارقة ".
ومن خصائص القصائد التي كتبها سنغور أيضا ذلك الإيقاع الذي استخدمه سواء عبر اعتماد اللعبة الإيقاعية الفرنسية أم عبر استيحاء الإيقاعات الأفريقية المختلفة التي ظلت تصخب في ذاكرة الشاعر وفي أذنيه. وفي بعض القصائد لم ينثن عن تسمية آلات موسيقية أفريقية وكأنه يحاول استدعاء إيقاعاتها وأنفاسها وضرباتها داخل اللغة الفرنسية نفسها. يحتاج سنغور إلى أن يقرأ كشاعر مرة تلو مرة، كشاعر أفريقي يكتب بلغة فرنسية بهية وكشاعر فرنسي عرف كيف يجد "إكسير" العبارة ليمارس سحره على لغة هي لغته الأم وغير الأم في وقت واحد. وغداة غياب سنغور لا بد من استعادة ما قاله فيه الشاعر الأفريقي إدوارد مونيك الذي يعتبر من تلامذته "نحن لا نحتاج إلى أن نعود إلى سنغور، فهو هنا دوما". سنغور شاعر الزنوجة، شاعر القصيدة الإنسانية، شاعر المراثي والمآسي، شاعر الطرافة و"الهجانة" يظل هنا حقا، حاضرا ملء حضوره في تلك "الشعرية" التي أسسها وجعل منها دارا رحبة يلتقي فيها الغرب، وأفريقيا، الغرب والشرق على السواء.@
جريدة الحياة - لندن - السبت ديسمبر 2001
هوذا سنغور، يدخل يموته (مدنية الغد) وفقاً لتعبيره، واصفاً حياته وشعره بأنهما سير من (مدنية الطفولة) إلى (مدنية الغد). سير يمكن القول عنه، في تأويل آخر، بأنه ترحال من الشخصي إلى الجمعي، ومن نشيد الحرية الذاتية الذي يصدح يه الزنجي الفرد، آلة النشيد الشامل الذي يصدح به التحرر الزنوجي.
في هذا ما كان يدفع سنغور إلى أن يتحدث عن نوع من زنوجة الكلمات تتطابق من زوجة البشر، واصفا هذه الكلمات بأنها حبلى بالصور، وبأنها قائمة، جوهرياً، على الإيقاع، وبأنها تعبير عن الكائن الإنساني، وبخاصة عنة طاقاته الحية. خصوصاً أنها مشحونة بقوة سحرية طقوسية تحقق نشوة التفاعل و التعاطف والمشاركة.
لا تعنى زنوجة الكلمات، شعرياً، بالمفهومات ومختلف أشكال التجريد، كما هو غالبا شأن الكلمات في الشعر الأوروبي. و إنما تعنى بالمحسوس، المعاش، وبشكل ما هو جسدي وحركي. الصورة الشعرية هنا تنهض في مناخ من الانخطاف الصوفي ومن دهشة البراءة الأولى وحدوسها، مما يتجاوز العقلانية وآلياته. هكذا يميز سنغور بين السوريالية الزنجية والسوريالية الأوروبية. فهذه، غالباً، ذهنية تجريدية، وتلك صوفية، جسدية وقلبية.
(أنا من يواكب القصيدة لا من يخلقها). يقول سنغور، مشيراً إلى أن الشعر هو الذي يكتبه، وأنه ليس إلا تجسيداً ناطقاً بذلك الصوت الغريب الطالع من أعمال الزنوجة وتاريخها- يغني به،ويغني له.
برلين 21-12- 2001
(1)
يوم السبت الماضي، وأنا إلى جانب المهدي اخريف في لاس بالماس للمشاركة في مهرجانها الشعري العالمي، فاجأني، في الصباح، الشاعر السنغالي الصديق أمادو لاسين سال بأنه توصل بخبر غير مؤكد عن وفاة الشاعر ليوبولد سيدار سنغور. كان مضطربا وقلقا طيلة اليوم، والليلة الموالية، تابعنا نتف الأخبار الواردة من السنغال وباريس، ولكن الوفاة لم تتأكد. في بهو الفندق، كان الاستفسار عن الحالة الصحية ليوبولد سيدار سنغور. بيننا يدور الحديث عن السنوات الخمس التي رافق فيها امادو سنغور في فرنسا وفجأة أدركنا أن الشعراء الأوروبيين الآخرين الحاضرين، من البرتغال أو إنكلترا أو من أميركا اللاتينية أو من اليابان، لا يكادون يعرفون عن سنغور شيئاً. كان حديثنا عنه ! شبيهة بحديث عن اسم غريب عن الحركة الشعرية العالمية في القرن العشرين. الخبر وردود الفعل الأولية من طرف الحاضرين، أو بعضهم على الأقل، كانا اختبارا لمعرفة ما اصبح يمثله سنغور من قيمة شعرية في السنغال ثم في مناطق ثقافية وشعرية عبر العالم. الخبر، إذن، استدعى الحديث عن سنغور الشاعر، قبل الحديث عنه كشخصية سياسية بارزة في أفريقيا الستينات. الجانب الشعري هو ما جذبنا. الزنوجية. الشعر الأفريقي. الحضور السنغالي. والدعوة الفرنكوفونية. كل ذلك كان يمر في كلمات. وأحيانا يتشعب الحديث إلى مناقشات مطولة.
(2)
لم يكن سنغور غريباً عني في المغرب. قصيدة سنغور التي نحتها من نفس أفريقي، له ! النشيد والغناء، ومن تربية شعرية فرنسية ! عميقة الجذور، تأخذ أسسها من بودلير وملارمي، مثلت تجربة متفردة. كنا نقرأ شعره بلهفة الباحث عن جواب عن أسئلة تؤرق الشعر العربي الحديث. أحيانا كنت أفكر في رحلة احمد شوقي إلى فرنسا، وأعيد التفكير في مسارين متباينين لكل من شوقي وسنغور. الربط بين الاسمين لم يكن صدفة. ذلك اللغز الذي لا نفهمه حتى الآن عن عدم تبني احمد شوقي للقصيدة البودليرية والملارمية كان يظهر بصيغة أخرى في مسار ليوبولد سيدار سنغور. انه الشاعر الذي تبين، على اثر تفاعل ستوتر مع الثقافة الفرنسية، طريق تحديث ثقافة سينغالية، أفريقية، بكل انفتاح على الشعر الفرنسي، في اللقاء المباشر، في الجرأة على كتابة قصيدة مسبوكة بعناية الشعراء الرمزيين. في الستينيات كان سنغور اسماً شعريا يهيمن على الخطاب الشعري في فرنسا. وهو ما انعكس على الشعراء المغاربة (والمغاربيين عموماً)، الكاتبين بالفرنسية أو المطلعين على الثقافة الفرنسية. الشاعر محمد خير الدين كان على صلة وثيقة بسنغور. انه صديقه الذي يتقاسم معه هم كتابة قصيدة متمردة. ولكن سنغور كان مؤثرا في الحركة الشعرية بأفكاره أو بمنحاه الشعري. الزنوجية، التي صاغ فكرتها ودافع عنها إلى جانب شعراء أفارقة آخرين، وفي مقدمهم إيمي سيزير، أعطت الشعر الأفريقي لحظة ميلاد. بهذه الفكرة انتقل الشعر الزنوجي إلى مستوى وعي بالذات الأفريقية وبالعالم لم يكن معهودا من قبل. صوت ينادي على صوت. من الشعر الأميركي الذي اخذ الزنوج في كتابته والتغني به، وخاصة في أغاني البلوز، أو أغاني الجاز، إلى الشعر الأفريقي الذي أدرك أن القصيدة الأفريقية الحديثة هي قصيدة وفية لمفهوم الشعر في اللغات الأفريقية. كلمة الشعر، في السنغالية، مثلا، تعني الغناء. والشاعر هو مغني القبيلة أو مغني اللغة و في التمازج بين الصوتين برزت إلى الوجود فكرة الزنوجية وشعرها، بما أدهش الذائقة الشعرية الفرنسية والإنسانية. ولم تكن ثمة صعوبة في بروز هذا الصوت الشعري. استقبال جان بول سارتر لهذا الشعر بكتابة تقديم ل "منتخبات الشعر الجديد الزنجي والملغاشي بالفرنسية" التي أصدرها سنغور سنة 1948، أو أول ديواني للشاعر بعنوان "أغاني الظل"، كانا إيذانا بحركة كبرى ستشغل الحركة الأدبية في اكثر من مكان. ومنذ بداية القرن كان السعي إلى استكشاف الفني الأفريقي، من خلال التماثيل والأقنعة عاملا في التجربة التكعيبية. قبل ذلك، في القرن التاسع عشر، كان كل من بودلير ورامبو سباقين إلى إعادة الاعتبار للزنجية، في التصورين الحياتي والشعري على السواء.
(3)
كان سنغور يقول "أكتب بالفرنسية، لكني أفكر بالزنوجية الأفريقية" هل يمكن تحقيق زنوجية بلغة أوروبية؟ بعبارة أخرى ة هل الكتابة بالفرنسية تسمح للغيب الزنوجي (بتحوير عبارة هيدجر) أن يكون حاضراً في القصيدة؟ سؤال تصعب الإجابة عنه في ضوء النزعة الفرنكوفونية. وما دام سنغور كتب بالفرنسية فإن هذه الكتابة لم تظل محصورة في الممارسة الشعرية والثقافية الشخصية لسنغور. لقد أصبح رئيساً لجمهورية السنغال. وهو ما سمح له بجعل اللغة الفرنسية لغة رسمية للدولة، إلى الحد الذي جعله، ذات يوم، يمنع شريطا سينمائيا من العرض في القاعات بسبب خطأ إملائي وقع في كتابة عنوان الشريط على ملصقات الدعاية. أيضاً كان سنغور يعرف الزنوجية بأنها "مجموع قيم حضارة العالم الزنجي". بهذا التعريف كان سنغور يهدف إلى اختيار ثقافة تعبر عن "الهوية" الأفريقية. اختيار جاء على حساب ثقافة أخرى في العالم الزنجي. أي انه لم يكن محايدا بقدر ما كان قريبا من اختيار يتعارض مع تاريخ وثقافة أفريقيا الإسلامية. ولم يكن ذلك وحده ما دفع بأصوات أدبية إلى رفض فكرة الزنوجية، لاحقة، بعد أن أصبحت عقيدة، تخضع بدورها للثبوتية. الزنوجية التي لم تعد تستجيب لوضعي!ة أدبية في مجتمعات ما بعد الاستقلال. وعلى رغم أن سنغور دافع طيلة حياته عن الزنوجية فإننا نلاحظ أن الأدب الأفريقي، أو الأدب السنغالي، تخطى الزنوجية إلى عوالم اكثر سرية، لا تخلصه من هذه العقيدة في مجملها بل من اجل إلا تتحول الزنوجية إلى شعارات تتردد في عمل يتأسس على الحيوي. للفكرة تاريخها في التجربة الشعرية لسنغور. كان سنغور يتحدث عن أثر الشعر الأفريقي الشفوي في كتابة قصيدته. انه وعي شعري لم يتوصل إليه إلا بعد أن كتب شعرا يستلهم فيه الشعر الفرنسي ووقف على سؤال "كيف أكتب؟". سؤال المأزق الشعري لشخص اقتلعته الجغرافيا والتاريخ من قريته وهو ابن سبع سنوات ليلتحق بالمدرسة الفرنسية. وكان عليه، وهو ابن ثلاتين سنة، أن يقوم بإحراق قصائده التي كان كتبها حتى ذلك الحين ليعود إلى قريته وينصت إلى شاعرات القرية. مارون نديا، كومبا نديا وسيغا ضيوف، شاعرات شعبيات تعلم سنغور منهن كيف يكتب قصيدته، التي تحرص على المختلف. بأي اتجاه كان يسير سنغور؟ هل كان يدرك النموذج الأميركي اللاتيني، الذي تبنى الإسبانية والبرتغالية لكتابة أدب حديث أم كان فقط تحت تأثير البحث عن كلمة يقترب بها من بلده وثقافته فيما هو يبتغي إسماع صوته للعالم؟ وما لا يخفى، هو أن هذه القصيدة، المحملة بدعوة زنوجية، تعدت الشعري لتصبح شعارا سياسيا، كان له أثره في بلورة فكرة المطالبة بالاستقلال. وسنغور الشاعر هو نفسه سنغور السياسي، الذي ربط بين الدعوة الأدبية والدعوة السياسية. من ثم كانت الزنوجية رسالة سياسية تعتمد أساسا ثقافيا لمستقبل السنغال ومستقبل أفريقيا.
(4)
حضور الشعري الزنوجي في المغرب، وتأثيره في الحركة الشعرية التحديثية المغربية، كان مختلفة تماما عما نجده في السودان. رابطان لا بد من تذكرهما. أولا العلاقات الثقافية (والروحية) التي جمعت بين المغاربة والأفارقة عبر تاريخ طويل. فالسنغال كان حاضرا في المغرب مثلما كان المغرب حاضرا في السنغال. إن ليوبولد سيدار سنغور المسيحي لم ينسى قط أن ترسخ الإسلام، عبر سيادة الطريقة التيجانية في السنغال، واقع اجتماعي وديني في آن. ولذلك حافظ باستمرار على هذا الرابط في الصداقة المثالية بين المغرب والسنغال. أما الرابط الثاني فهو الفرنسية المنتشرة بين نخبة مغربية تبحث لنفسها عن قصيدة مختلفة عن التجربة والتقاليد الشعرية الفرنسية. في الدعوة إلى قصيدة تعتمد الشفوية والصوت. هكذا اقترب من سنغور شعراء مغاربة، وقد عثروا فيه على شاعر يطمح إلى بناء نموذج حضاري إنساني منفتح على المختلف في ثقافات وحضارات. رابطان إذا كان سنغور يترجمهما بتصور "الاتحاد الوثيق). بهذا التصور كان الشعر الزنوجي كما كان سنغور قريبين من المغرب، من التاريخ. الثقافي والروحي المشترك وقريبين من العالم. بذلك علينا أن نرى في الزنوجية، كما طورت أفقها عبر مراحل، لا كانغلاق أيديولوجي، مميت، ولكن كجذوة نار تصهر ثقافات في بؤرة التكافل والتعايش. فكرة تبدو في فترتنا الراهنة مبشرة بعالم يصعب أن يجيء، لأن العالم الذي أصبحنا نعيشه يخشى من هذا التكافل والتعايش. فما الذي كان يفكر فيه سنغور، وهو يسمع عن العولمة، أو وهو يعيش آخر أيامه بتزامن مع الهيمنة الأميركية على العالم؟
(5)
 ليوبولد سيدار سنغور شاعر أحب الشعر وأحب حرية بلده مثلما احب حرية أفريقيا وحرية جميع المضطهدين في العالم. سيعود العالم ليقرأ ما كتبه سنغور. وسيفهم هذا الإنسان الذي تخلى عن كرسي الرئاسة في منطقة لا يتوانى فيها أحد من الرؤساء عن التحول من رمز للتحرير إلى رمز للاستعباد. فضل سنغور أن يترك شعبه يختار النهج السياسي الذي يلائمه، وترك له رسالة الشعر الكبرى، المحبة. ومع رحيل سنغور نتذكر زمنا ثقافيا كان له الوعد بعالم إنساني. دفاع سنغور، الذي حافظ عليه، هو ما أعطاه قوة الرمز. واسم سنغور سيظل مقرونا بأسماء كبار شعراء القرن العشرين. وفي قصيدته يرتفع صفاء النشيد ليحتضن السماء والأرض، في حركة أبدية هي حلم أن نعيش شعريا، أحرارا في هذا العالم.@
ليوبولد سيدار سنغور شاعر أحب الشعر وأحب حرية بلده مثلما احب حرية أفريقيا وحرية جميع المضطهدين في العالم. سيعود العالم ليقرأ ما كتبه سنغور. وسيفهم هذا الإنسان الذي تخلى عن كرسي الرئاسة في منطقة لا يتوانى فيها أحد من الرؤساء عن التحول من رمز للتحرير إلى رمز للاستعباد. فضل سنغور أن يترك شعبه يختار النهج السياسي الذي يلائمه، وترك له رسالة الشعر الكبرى، المحبة. ومع رحيل سنغور نتذكر زمنا ثقافيا كان له الوعد بعالم إنساني. دفاع سنغور، الذي حافظ عليه، هو ما أعطاه قوة الرمز. واسم سنغور سيظل مقرونا بأسماء كبار شعراء القرن العشرين. وفي قصيدته يرتفع صفاء النشيد ليحتضن السماء والأرض، في حركة أبدية هي حلم أن نعيش شعريا، أحرارا في هذا العالم.@
الحياة- 22 ديسمبر 2001
نادرون هم الشعراء الذين استطاعوا، عبر شعرهم، أن يؤثروا في اتجاه فلسفي أو فكري فيغيروا شيئاً عن مساره، ومن هؤلاء الشعراء الألماني هولدرلن والسنغالي ليوبولد سيدار سنغور الراحل يوم الخميس الماضي.
فقد دفع شعر الأول الفيلسوف الألماني هايدجر إلى إعادة النظر في موقفه من اللغة، بعدما تعرف على شعر هولدرلن الذي قضى حوالي ثلاثين عاما في مستشفى للأمراض العصبية، فألف كتابه الشهير "الشعر والفلسفة" المترجم إلى العربية. أما شعر سنغور، فقد دفع جان بول سارتر إلى إعادة مفهوم الالتزام إلى جمهورية الشعر، بعدما طرده منها، فكتب مقاله الشهير "أورفيوس الأسود" معرفا بشعر سنغور وزميله في الشعر والنضال والحياة ايميه سيزر ومثبتا من خلال قصائدهما، أن الالتزام، بمعناه الأوسع، لا يغير فنية الشعر فقط و إنما يمكن إن يعمقها ويدفعها إلى أفاق إنسانية ارحب.
لقد مثل سنغور وسيزر لسارتر وغيره من المثقفين الفرنسيين في الخمسينات ظاهرة مختلفة تماماً في المشهد الشعري الفرنسي من جانبين: الأول انهما جمعا بين اليومي والكوني، والوطني و الأممي في إيقاع في أفريقي فوار نابض فلم يهبطا إلى نثرية الحياة اليومية كثيرا ولم يرتفعا إلى سماء التجريد كثيراً، وهما بعدان كانا يراوح بينهما الشعر الفرنسي عموما.
أما الجانب الثاني فهو أن شعرهما أعاد طرح قضية في الالتزام بمعناها الحقيقي، الأرحب من كل التضييقات التي ألصقتها بها ما سمي بالواقعية الاشتراكية والمقاييس التي حاولت أسطرتها على جسد غير موجود. لم لكن سنغور وسيزر بحاجة إلى مدرسة فكرية أو شعرية، فعفوية أفريقيا، كما قال سنغور مرة، تنطوي على الفلسفة والشعر المتوارثين من حقب طويلة، وليست هذه الفلسفة سوى الشراكة الإنسانية بين البشر أنفسهم، وتأخيهم مع الطبيعة وليس الشعر سوى ذلك الرقص الأفريقي الجماعي المصاحب لكل فعل اجتماعي أو فردي. وفى هذا الصدد يقول سنغور: "إن الصورة لا تأثير لها على الأفريقي إذا لم تكن إيقاعية. فالإيقاع هو الذي يكمل الصورة بتوحيدها مع الإثارة والحس، ومع الروح والحسد ". هذه الخاصية ميزت شعر سنغور، إذا استثنينا المرحلة الأخيرة بعدما اصبح رئيسا. وكما يقول الناقد وليم اوكسلى، فإن سنغور لم يكن يبحث عن الإثارة، بقدر بحثه عن الرموز المكتنزة بالإرث الأفريقي، والمشحونة بالصورة والإيقاع. وهذا ما يفتقد إليه، حسب رأيه، الشعر ألا نجلو- أميركي. إن الشعر، عند سنغور، يجب آن يسمع كما الموسيقى، فهو ميت على الورقة ما لم تبعثه الأصوات إلى الحياة، تماما مثل الموسيقى. وهى خاصية أفريقية لامتياز. فما أن "تسمى شيئا في أفريقيا، حتى ينبعث المعنى المختبئ تحت الإثارة،. ومن هنا فإن شعر سنغور أو سيزر ضروري لنا، بنفس القدر الذي كان فيه ضروريا للفرنسيين في الخمسينات والستينات، وللإنجليز الذين اكتشفوه متأخرين، لأن هذا الشعر، كما يقول اوكسلي، يكشف لنا كيف يشارك "الوعي الأفريقي" بفعالية في أشياء الحياة، وفى الطبيعة، بحيث يستطيع إن يربطنا، أو يعيد ربطنا، بحياة الجماعة، من خلال الشعر، وبمساحات مفقودة من التجربة. ولغير ذلك، كما يضيف، سيبقى فهمنا للحياة قاصرا، وكذلك شعرنا.@
جريدة (الشرق الأوسط) الأحد - 23 ديسمبر 2001
توفي سنجور عن 95 عاما في مدينة "فيرسون" في فرنسا حيث يقيم منذ عام 1980، ونعاه الرئيس الفرنسي جاك شيراك قائلا: "خسر الشعر واحدا من أعلامه، وخسرت السنغال رجل دولة وأفريقيا عظيما وصديقا لفرنسا".
تخلى"سنجور" عن الحكم بمحض إرادته مفضلا الشعر على حكم الدولة في عام 1980 هو الذي تولى رئاسة بلاده في عام 1960 بعد الاستقلال مباشرة وكان هو الرئيس الأول لها بعد حكم استمر عشرين عاما. ثقافة "سنجور" ذات مرجعيات فرنسية، وهو كما تقول الأنباء يحمل الجنسية الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية، ويوصف بأنه شديد المناصرة للثقافات الفرانكفونية، وفي عام 1935 حصل على إجازة من جامعة باريس ومن زملائه آنذاك الرئيس الفرنسي الأسبق "جورج بومبيدو" وحصل في الثمانينات من القرن الماضي على عدد كبير من الجوائز الاعتبارية التي كرسته كرجل شعر ودولة في آن، وتقول التقارير انه أول كاتب اسود تستقبله الأكاديمية الفرنسية في عام 1984 ، وفي عام 1978 اختير "أمير الشعراء" وارتبط اسمه بجوائز تحمل أسماء من مثل: "ابولينير، و!ألفرد دو فيني". حصل "سنجور" على 30 شهادة دكتوراه فخرية من مختلف اقطار العالم من بينها دولتان عربيتان هما: مصر ولبنان. ونقلت الاسوشيتدبرس أن الرئيس السنغالي عبد الله واد أعلن في وفاة سنجور بينما كان رؤساء الدول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يعقدون قمتهم 25، وقد علق المجتمعون أعمالهم ولزموا الصمت دقيقة حداد ، وقال "واد": إن تما وطنيا سيجرى للرئيس الأسبق بعد التشاور مع عائلته. وشدد الرئيس المالي ألفا عمر كوناري، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على أن "القضية التي تجمعنا هنا. ت. (تكامل أفريقيا ووحدتها) كانت قضيته". أضاف في كلمة تأبينية مؤثرة "أن ليوبولد سيدار سنجور هو حقا من السنغال، لكنه من أفريقيا، وهو مواطن عالمي". و أكد أن "مثاله سيكون قدوة لعملنا"، معربا عن حزنه لخسارة"مناضل كبير من اجل أفريقيا ومن اجل الحرية".
صرح سنجور مرارا انه يفضل أن يتذكره التاريخ شاعرا اكثر منه رجل دولة، ذلك انه اصدر ديوانه الأول لا أغاني الظلال " عام 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي شارك فيها متطوعا في الجيش الفرنسي، وقبل أن يضطلع بأي دور سياسي. وتعهد لدى توليه الرئاسة أن يحكم بصدق وعدل، لكنه اقر بأن "أي بلد لا يمكن أن يحكم من دون جدران السجون ". وعلى الرغم من انه كان من وجوه القومية الأفريقية، فإنه كان يعارض هجوم نظرائه من الزعماء الاستقلاليين لأفريقيا على الثقافة الأوروبية التي أدخلتها القوى الاستعمارية إلى القارة، لكن بعض الزعماء الأفارقة العسكريين اعتبروه دمية تدافع عن المصالح الفرنسية السوداء، وقد كان ولد في قرية "جوال فاديوت " على أحد السواحل السنغالية، ويذكر أن والده كان متعدد الزيجات بحسب بعض العادات الأفريقية، وهو كاثوليكي الانتماء الديني، وعلى الرغم من دراسته المبكرة والمتفوقة في فرنسا فإن جذوره الأفريقية بقيت على ثقافتها الأولى، وفي عام 1959 أسس حركة "الزنوجة" التي تؤكد على ثراء الثقافة الأفريقية ومعروف عنه مقولته التي يرددها دائما:"الزنجي بكلامه العفوي يعود إلى أصله وجذوره المميزة،. تزوج !سنجور، في بداية حياته من امرأة أفريقية هي "ابنة حاكم غينيا"، ثم تزوج للمرة الثانية من امرأة فرنسية هي حفيدة الماركيز النورماندى في عام 195، ولقد كانت حياته العائلية مملوءة بالمآسي فقد انتحر أحد أبنائه وتوفي الآخر في حادث سير. سنجور و"نوبل " في عام 1991 حل الشاعر "سنجور" ضيفاً على مصر في مناسبة إقامة الدورة الخامسة للألعاب الأفريقية في القاهرة، وفي حوار صحافي معه قال:
"لم احصل في حياتي على جائزة نوبل في الأدب ولا اعرف لماذا يربطون بين اسمي وبين هذه الجائزة، وتقول الصحافية التي أجرت المقابلة مع سنجور (حسن شاه):
"كانت ملاحظتي الأولى على الشاعر الكبير والرئيس السنغالي الأسبق هي تواضعه الشديد، فقد أصر على الوقوف لاستقبالي على باب جناحه في الفندق، وأصر على أن يقدم لي مقعدا أمامي".
وتضيف الصحافية قائلة:
(عندما بادرته قائلة: سيدي الرئيس أرجو ألا أكون قد أزعجتك بموعدي في الصباح المبكر".
جاء رده في صورة ابتسامة ودودة قائلا:
"لقد تعودت أن ابدأ نهاري مبكرا، فالإنسان تقل ساعات نومه كلما تقدم به العمر"
وكان سنجور يومها في الخامسة والثمانين من عمره.
ويرى سنجور أن أهم أعماله الشعرية هو ديوانه "أغاني الظلال" ويقول: (أن هذا الديوان مشهور جدا على مستوى العالم العربي). أما اقرب دواوينه إلى قلبه فهو ديوان (موسم الأمطار) ويقول سنجور: "الثيمة" الأساسية عندي هي الحب خاصة في ديوان، موسم الأمطار"، وهذا الديوان عبارة عن ترجمة شعرية لمجموعة من الرسائل كنت قد كتبتها لزوجتي وهي بعيدة عني، ويكشف سنجور عن حبه لامرأته الثانية الفرنسية قائلا: هي امرأة شقراء جميلة اجمل ما فيها عيناها اللتان يختلط فيهما اللونان الذهبي بالأخضر، وقد كتبت أشعارا كثيرة في جمال عينيها الذهبيتين ".
تأثر "سنجور" الشاعر بكل من الفرنسي "بول كوديل " والشاعر سان جون بيرس، لأنهما بحسب ما يقو "اكثر اقتراباً لمزاجه الشعري" أعرف عنه- اهتمامه بالثقافة العربية.. يقول: لا السياسة حرمتني من التخصص في اللغة العربية والأدب العربي، ولذلك أصدرت قرارا بإدخال اللغة العربية في منهج المدارس الثانوية في السنغال، وبذلت جهدا كبيرا في دراسة الشعر العربي الجاهلي القديم واستطعت الغوص في أعماقه وأعجبت بقوته وانسيابه وبراعة الصور التي رسمها الشعراء العرب الأوائل".
وعن سبب تخليه عن السياسة لمصلحة الشعر يقول سنجور: "العمل السياسي هو مجرد واجب وليس له أي اثر سلبي على حياتي كشاعر، لكنني فضلت الشعر على السياسة لأن الشعر يتخطى حدود الأوطان ويخدم الإنسانية والإنسان أينما وجد".
وتقول سيرته انه في بداية حياته قد اعد نفسه ليكون راهباً لكن أستاذه نصحه بالعدول عن فكرة الرهبنة لأنها لا تتوافق وطبعه المعارض،. وبعد تسلمه السلطة في السنغال قام "سنجور" بتأميم أملاك والده، وعرف عنه عزوفه عن التدخين والشرب، أما بدايات كتاباته للشعر فقد كانت وهو في الثامنة عشرة من عمره، وتقول سيرته انه عاد لمقاعد الدراسة وهو في الرابعة والسبعين من عمره، أما دراسته الأولى فقد كانت في حقل الفلسفة. يذكر عن "سنجور" انه قرأ "ماركس" و"انجلز" قراءة أفريقية وأخذ من ماركس كل ما هو شامل وترك منه كل ما هو هامشي وثانوي، ويفهم سنجور الاشتراكية على أنها، نوع من الحساسية الخاصة التي تملكها الشعوب العربية والأفريقية بالفطرة، ومن مقولاته المعروفة: "موسى تزوج "فوشيت" المرأة الزنجية وأمير تيزار تزوج الملكة والو،. ويكرر دائما: "لطالما اعتبر إلى البيض في أفريقيا السوداء كرسل أما في الماضي، فالآية معكوسة، عندما نظرت فتيات القدس إلى ملكة سبأ بتعجب واندهاش- "لأنك سوداء أولا وجميلة ثانيا".
صرح "سنجور" مرة (بأن الدول في الأفريقية الكبيرة هي دول إمبريالية، وان بعض رؤساء أفريقيا الشمالية يحلم في الاستيلاء على أفريقيا السوداء).
أما عن عمله في أثناء حكمه للسنغال فقد قال: "يعد انتخابي في عام 1960 أنشأت منظمات للمراقبة تساعدني على مراقبة الإدارات العامة والاتحادات الاقتصادية المشتركة ونحن نكتشف سرقات كبيرة، وهكذا يتبين أن الفساد موجود أينما كان". وفي أوائل الثمانينات طالب "سنجور" بالعودة إلى قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 1947 وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية- بحسب ما قال- وقال: "إن أي حل لا يقر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم لن يكتب له النجاح".
جريدة (الخليج) الشارقة - الامارات - 22ديسمبر 2001
الضباب يخيفني،
وهذه المنارات - عيون مولولة
لمرآى وحوش منزلقة على الصمت
هذه الأشباح التي تجاحف الجدار
وتمضي، أهي ذكرياتي
التي تنتظم في صف طويل صوب محجتا؟
ضباب المدينة الوسخ
سخامه البارد
وسخ رئتي اللتين أفسدهما الخريف
ورهط أحشائي الجائعة يعوي
فيما تجيب على أصواتها
الشكوى الضعيفة لأحلامي المحتضرة
يجتاحني الضباب
كما العزلة اليوم
أنا مزمع على الفرار
أنا كتاب مفتوح
تتقاطر في مخي الرمادي
كلمات فارغة
تتقاطر صفحات ، شوارع مقفرة
من دون ملاه.
يا روحي العزيزة، تمددي على الديوان الطويل
والق المرساة.
أنزلي وئيداً صوب القاع.
نعم الق المرساة.
هاهو الليل
صراخ وصيحات غضب،
الليل
جلاد المستقلين اليقظين
و الشهداء المحترقين فوق أسرة أحلامهم
ملقى في نار الهموم
أشم رائحة جلدي يحترق مثل شق الغزالة
و أستمع لرئتيّ تتكسران في مواجهة الهواء الجاف للريح الشرقية
ساكون سعيدا لو أن ساحرة الحلول،
عند وضوح الفجر
تمكنني من الشرب من مطرتها
وتجفف عرق الكوابيس عن جبهتي
وتتيمني في سفح المنحدرات
مستسلماً لنسائم البحر
ولمداعبات السكينة الصباحية.
تحت التنورة الملساء لشمس الصيف
أتلفت الشمس
المخمل الأخضر
لأيام الطفولة
البرد و الزوابع
استشاطت غضب عصاباتها المتوحشة
في السهل حيث يتأوه الصمت
منهكاً، يذيع زيز الحصاد المترع بالدم
أخبار هزائمي.
لينم موتى البارحة
في عينيك، عيني النداوة و الفجر
المعطرتين برائحة الخريف
أخضر مثالي المتجدد
تحت بيارق رموشك
أريد أن أنام
تداعبني الناي الصباحية
لمرجاتك الطرية
في انتظار يقظة دامية.
أنا وحيد في السهل
وفي الليل
بصحبة الأشجار المتقلصة من البرد
و التي تشد كوعها إلى جسمها
ملتفة بعضها على بعض
أنا وحيد في السهل
وفي الليل
بصحبة حركات الأشجار
حركات يأسها المؤثر
و التي فارقتها أوراقها إلى جزر مختارة
أنا وحيد في الليل
وفي الليل
أنا عزلة الأعمدة البرقية
على طول الطريق
الجرداء@
من مؤلفاته وشعره
أناشيد الظلال (1945)،
قربانات سوداء (1948)،
ليليات (1961)،
قصائد (1964)،
أرض الميعاد (966 1)،
رسائل الشتاء 1973
مراث كبرى - 1979)
(لتكوني مباركة يا أمي
أسمع صوتك حين أستسلم للصمت المخادع لهذا الليل الأوروبي
أسيراً في ألحفتي البيضاء والباردة
لكل القصص التي تعانقي بلا انفكاك
حين تذوب عليّ، الحدأة المفاجئة، والرعب اللاذع للأوراق الصفراء
أو للمحاربين السود في زوبعة إعصار الدبابات
حيث يقع قائدهم مع صرخة كبيرة في اندفاع كامل الجسد.
أمي... أوه... أسمع صوتك المغضب المهان
وها هي عيونك المغضبة المهانة والحمراء تشعل الليل والدَّغَل الأسود
كما في أمس الأسلاف
لا أستطيع ان أبقى أصم تجاه براءة القواقع
والسواقي والتحليق فوق الغابات
وذقنك ترتجف تحت شفاهك الغليظة المنتفخة
لتكوني مباركة يا أمي
اعرفي ابنك من صميمية نظرته
وهي صميمية قلبه ولسانه
اعرفي رفاقه
اعرفي المحاربين
وسلّمي...
في المساء الأحمر لشيخوختك
على الفجر الشفاف ليوم جديد).
في هذه القصيدة المختارة من شعر سنغور، والتي قمنا بنقلها للعربية، مع حرصنا على إيقاع المأساة والزنوجة فيها، تظهر جلية مقولة نيتشه حول الأصول الموسيقية للمأساة، سواء كان ذلك في الشعر الأسباني أو في شعر سنغور الأفريقي ولو بلسان فرنسي. هنا ينبثق إيقاع الزنوجة في شعره، وهو جالس في الأردية البيضاء والباردة لأوروبا، ينبثق بكل حرارته وتوقه في نداءاته العذبة، لأمه... الزنجية الغليظة الشفاه، الحزينة، الساحرة الغامضة، وللمساء الأحمر، لشيخوختها (على الفجر الشفاف ليوم جديد)، والأم هي أمّ وقارة.وشعر سنغور الراحل عن هذه الأرض وعن بلاده السنغال مع نهاية العام المنصرم 2001، هو شعر زنوجة إنسانية بامتياز. فهذا الشعر معقود على قلب القارة السوداء بنبضه وحرارته وأساطيره ورموزه، موسيقاه وإيقاعاته... لكنه ليس شعراً عرقياً أو محلياً، بل هو في توجهاته الثقافية والإبداعية ومن حيث اللغة الفرنسية التي اختارها الشاعر للتعبير عن مكنوناته، مشتمل على نبض إنساني شامل: أفريقي أوروبي من جهة، وأفريقي آسيوي عربي من جهة ثانية... بل هو منطو على أخوية حقيقية للإنسان الزنجي مع البشر كافة، في أعراقهم ولغاتهم وأديانهم. تكتظ إثنيات كثيرة في هذا الشعر، ويحتشد فيه الجمال الأسود، بأبهى صوره، في المرأة والليل والغابة؛ في القناع والشكل. يقول في قصيدة (امرأة سوداء) Femme Noire: (يا امرأة عارية يا امرأة سوداء/ ...يا امرأة عارية يا امرأة مظلمة/ اغني عذوبتك التي تعبُر/ شكلك الذي أُثبته في الأبدية/ قبل ان يحيلك القدرُ الغيور منك إلى رماد يغذي به جذور الحياة). وجذور الحياة التي أنشد لها سنغور، أشعاره، هي جذور أفريقيا العتيقة الحارة المأهولة بالحكايات والطواطم والأقنعة، امتلاءها بالملوك والإمبراطوريات البائدة. وهي أفريقيا المتشحة بسوادها وفقرها وثرواتها التي كانت ولا تزال قبلة عين المستعمرين والمغامرين وتجار الشعوب وثرواتها، اتشاحها بالغناء والإيقاعات والرقص والفرح والحزن... فكل شيء هناك حار... حار حد الغليان: اللذة كما الموت. المرأة كما الرقص. الحزن كما المتعة... وكل شيء يصنعه القدر والقوة معاً. فأفريقيا التي هي اصل الرقص والأقنعة والسحر وثروات الطبيعة البكر، هي أيضا جاذبة المغامرين والمستعمرين الجدد... لذلك فإنه من الطواطم وأغاني التام تام حتى تحرير العبيد، تظهر أفريقيا قائمة في جوهر هذه الحركة الإنسانية والفنية، ويظهر شعر سنغور طالعا منها... يقول في قصيدة قناع زنجي: Masque Niger: (هو ينام/ يرتاح على براءته في الرمل/ كومبا تا تام ينام/ سعفة نخل خضراء تُغَشّي حمى شَعره/ وتغطي الجبين المنحني...).
وهو يناجي القناع بقوله: (يا وجها كما خلقه الله قبل ذاكرة الأعمار نفسها/ وجه فجر العالم.../ لا تنفتحْ كعنق عذبة لكي تحُر لحمي/ أعبدك يا عذوبة... بعيني الأحادية الوتر...).
ويكتب صلاة للأقنعة Prier aux Masques التي يعتبرها تخص وجهه بالذات. يقول:
(يا أقنعة يا أقنعة
يا قناعاً اسود قناعاً احمر
أنت يا أقنعة بيضاء سوداء
يا أقنعة في أربع نقاط الأرض حيث تنفخ ريح العقل
أحيّيك في هذا الصمت).
ويغني للطوطم، للحيوان حارسه، ويصلّي صلوات وثنية طالعة من قلب السواد الأفريقي حيث يختلط دم السحر بالوثنية بالخوف والرجاء... وحيث الآباء الأسلاف يحكمون من وراء الأبدية، من تحت التراب، ومن خلف الطواطم والأقنعة.
يقول في قصيدة (عودة الابن الضال) -Le Retour de L'enfant Prodigue-:
(يا فيل مبيسل Mbissel
بآذانك الغائبة في العيون وهي تصغي مع أسلافي لصلاتي الوثنية
...لتكونوا مباركين يا آبائي...
لتكونوا مباركين...).
فهذا الدم الأفريقي الحار، دم الجذور الضخمة والعميقة والمتشعبة في التراب ودم الآباء والأجداد الذين يتحولون بعد الموت إلى آلهة تشارك من وراء الأبدية في تدبير شؤون القبيلة، ودم الأناشيد الاحتفالية والإيقاعات الزنجية على الطبول، والرقصات التي تأخذ أصلها من طبيعة الغابة وأصوات الحيوانات، وحركات الأجساد الحرة العارية.. ودم الطواطم والأقنعة والصلوات.. ودم صراخ المعذبين والمضطهدين في الأرض.. دم الحرية المهدور.. من هذا الدم بالذات صنع ليوبولد سيدار سنغور أشعاره. إنها إذن أشعار الزنوجة بكافة سحرها وخوفها وعذابها وإيقاعاتها. والزنوجة في أشعار سنغور إيقاع. الإيقاع في هذا الشعر أبعد من توازنات نغمية وموسيقية وشكلية. الإيقاع روح هذه الأشعار، والإيقاع الزنجي في شعر سنغور بمفهومه السحري والمكاني والموسيقي، هو أشبه ما يكون بما سماه غارسيا لوركا في الغناء الأسباني والشعر الأسباني بالروح المبدع (الدوينده).. حيث يلتحم الحزن الغامض والبعيد، بالعنف الدموي، والشعر والرقص باللذة العنيفة والموت، المتجلي في دم الثور أو دم الماتادور. كل ذلك يتجلى في أغاني الغجر وحلبة الثيران وأشعار المغنين والشعراء. إن الإيقاع الزنجي لأشعار سنغور هو أشبه ما يكون بالروح المبدع في الرقص والمصارعة والشعر في أسبانيا. الإيقاع إيقاع المناخ والمكان، الحرارة والسحر واللون الأسود، الأسلاف والأقنعة والجوع والخوف، الرقص والموت... وهو انبثاق موسيقى من داخل المأساة ومن أنات الصوت والجسد معا، كما تتجلى في الرقص والموسيقى والشعر.. في الحركات كما في الغناء وفي الأقنعة كما في أصوات السحرة. الإيقاع في شعر سنغور ينطوي على أخاديد أفريقية، وانبثاقات ذات تهاويل سوداء وخرافات وشغف لا واع بالموسيقى والحركة. إنه حيوية دافقة من أصول الحياة البدائية وجذور الغابة السوداء واعتمالات الجسد الأسود الحي. وهو ما يصب مباشرة في الحواس.. الحواس المتلقية اليقظة التي تتشرب الأصوات والآهات والمشاهد حتى لتكاد تندرج فيها. ويعبر عن الإيقاع بفنون الجسد والحواس، كما يعبر عنها بالشعر وأدواته: النقوش والرسوم والأقنعة والأغاني والأناشيد. إنه، كما يقول نمر الصباح في مقدمة تعريبه لقصائد سنغور (غنات في الشعر والموسيقى وحركات في الرقص، تأتمر جوقة كل هذه بأمره سيرا إلى نور الفكر، ويشع الفكر به بقدر ما ينسجم بطفرة الشهوات). وقرع الطبول المدوي، ولبس الأقنعة والألبسة المزركشة والبخور وأدوات السحر. يقول سنغور في قصيدة " قناع زنجي":
(هو ينام
يرتاح على براءته في الرمل
كومبا تام تام
سعفة نخل خضراء تغشي حمى شعره
وتغطي الجبين المنحني).
ومن هذه الأصول الإيقاعية للزنجية، طلعت رقصات أفريقيا الأولية، ومنها طلعت أغاني ورقصات الجاز Jazz في أميركا التي اكتسحت الشباب والمدن من شيكاغو حتى حي هارلم في نيويورك، كما اكتسحت الحي اللاتيني في باريس حيث اتخذ سنغور مكانا ينادي فيه بقيم الزنوجة، بالاشتراك مع إيمي سيزار وليون جوترون داماس وسائر المنفيين.
وسوف نصغي لسنغور وهو يردد في إحدى قصائده، كمن يعترف أو يصلي:
(زنجي
زنجي
منذ الأزل
والى الأبد..)
وإيقاع الزنوجة لا يقتصر على الرقص والغناء، والشعر، بل امتد إلى التشكيل والرسم، فجاءت الفنون الحديثة والمعاصرة في الكثير من مدارسها الإبداعية بمثابة تأويل لبدائية الفنون الأفريقية. فوراء المدرسة التكعيبية في الرسم Cubique التي أسسها براك ومن ثم بابلو بيكاسو تكمن الأقنعة الأفريقية. فالمدرسة التكعيبية ليست سوى صورة مطورة على أصل القناع الأفريقي وشكله. وفي كل حال فإن سنغور يهدي إحدى قصائده، المسماة قناع زنجي Masque negre إلى بابلو بيكاسو.
جريدة (السفير) يناير 2002