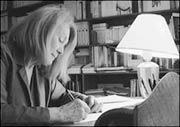 بدون أدنى شك، تبدو آني إرنو اليوم، واحدة من أكثر الروائيات الفرنسيات حضورا وأكثرهن شهرة على الساحة الأدبية الفرنسية المعاصرة، فكل كتاب من كتبها، لا بدّ وأن يسيل الكثير من الحبر والمتابعات الصحافية والنقد. ربما يعود ذلك إلى موضوعاتها التي تتقاطع مع سيرتها الذاتية. هذه السيرة التي بدأت عام 1940 في مدينة «ليلبون» (السين ماريتيم)، حيث نشأت في كنف عائلة متواضعة، في «إيفتو» (منطقة النورماندي). جاء موت شقيقتها البكر بمرض «الدفتيريا» (الذباح أو الخانوق) قبل مولدها ليسم حياتها اللاحقة. وبعد أن تابعت دراستها في الآداب المعاصرة، درّست اللغة الفرنسية، وتزوجت عام 1964 من رجل ينتمي إلى البورجوازية الصغيرة. صدرت روايتها الأولى «الخزائن الفارغة» عام 1974 واستمرت في التدريس حتى عام .1977 وحين انفصلت عن زوجها عام 1980 كانت قد أنجبت طفلين. عام 1984 نشرت رواية «الساحة»، كتاب سردي صغير استدعت فيه صعودها الاجتماعي الذي جعلها تبتعد عن أهلها. جاء كتاب «الساحة» ليشكل العمل المفتاح، لما عرف في ما بعد باسم تيّار «التخييل الذاتي»، وقد ترجم إلى العديد من لغات العالم، وليحز على جائزة «رونودو». بدءا من ذلك الكتاب، بدأت كتابة إرنو «المينيمالية» تتركز عبر سبر أغوار الحميمي ، أكان ذلك عبر شكل الرواية «الأوتوبيوغرافية» (السيرة الذاتية) أو عبر شكل «اليوميات»، إذ تخلت عن كتابة القصة المتخيلة التقليدية، لتركز على تلك «الرواية» المستمدة «أحداثها» من سيرتها، حيث تتقاطع فيها التجربة التاريخية مع التجربة الفردية. من هنا أصبحنا نجد أن كلّ رواية من روايات الكاتبة الفرنسية آني إرنو، تدور حول «تيمة» معينة. ففي كتاب «امرأة»، (ترجمته إلى العربية الشاعرة المصرية هدى حسين، مثلما ترجمت لإرنو العديد من الكتب الأخرى)، تتحدث الكاتبة عن أمها، وعن الانتظار العاشق في كتاب «شغف بسيط» وعن الإجهاض في كتاب «الحدث»، الخ... عبر لغة خالية من تزيين أسلوبي.
بدون أدنى شك، تبدو آني إرنو اليوم، واحدة من أكثر الروائيات الفرنسيات حضورا وأكثرهن شهرة على الساحة الأدبية الفرنسية المعاصرة، فكل كتاب من كتبها، لا بدّ وأن يسيل الكثير من الحبر والمتابعات الصحافية والنقد. ربما يعود ذلك إلى موضوعاتها التي تتقاطع مع سيرتها الذاتية. هذه السيرة التي بدأت عام 1940 في مدينة «ليلبون» (السين ماريتيم)، حيث نشأت في كنف عائلة متواضعة، في «إيفتو» (منطقة النورماندي). جاء موت شقيقتها البكر بمرض «الدفتيريا» (الذباح أو الخانوق) قبل مولدها ليسم حياتها اللاحقة. وبعد أن تابعت دراستها في الآداب المعاصرة، درّست اللغة الفرنسية، وتزوجت عام 1964 من رجل ينتمي إلى البورجوازية الصغيرة. صدرت روايتها الأولى «الخزائن الفارغة» عام 1974 واستمرت في التدريس حتى عام .1977 وحين انفصلت عن زوجها عام 1980 كانت قد أنجبت طفلين. عام 1984 نشرت رواية «الساحة»، كتاب سردي صغير استدعت فيه صعودها الاجتماعي الذي جعلها تبتعد عن أهلها. جاء كتاب «الساحة» ليشكل العمل المفتاح، لما عرف في ما بعد باسم تيّار «التخييل الذاتي»، وقد ترجم إلى العديد من لغات العالم، وليحز على جائزة «رونودو». بدءا من ذلك الكتاب، بدأت كتابة إرنو «المينيمالية» تتركز عبر سبر أغوار الحميمي ، أكان ذلك عبر شكل الرواية «الأوتوبيوغرافية» (السيرة الذاتية) أو عبر شكل «اليوميات»، إذ تخلت عن كتابة القصة المتخيلة التقليدية، لتركز على تلك «الرواية» المستمدة «أحداثها» من سيرتها، حيث تتقاطع فيها التجربة التاريخية مع التجربة الفردية. من هنا أصبحنا نجد أن كلّ رواية من روايات الكاتبة الفرنسية آني إرنو، تدور حول «تيمة» معينة. ففي كتاب «امرأة»، (ترجمته إلى العربية الشاعرة المصرية هدى حسين، مثلما ترجمت لإرنو العديد من الكتب الأخرى)، تتحدث الكاتبة عن أمها، وعن الانتظار العاشق في كتاب «شغف بسيط» وعن الإجهاض في كتاب «الحدث»، الخ... عبر لغة خالية من تزيين أسلوبي.
في روايتها هذه «الاحتلال» ([) ، نجد موضوعة «الغيرة»، التي تنسج حولها قصة جميلة. ذات يوم، تعلم الراوية بأن عشيقها السابق الذي كانت قد غادرته هي، رافضة أن تستمر في العيش معه، بعد أن طردته من حياتها، لأنها ترفض بشكل مطلق الحياة التقليدية بين زوجين وبخاصة أن زواجها الذي دام لمدة 18 سنة كان أشبه بسجن، وهي تتمتع اليوم بحريتها القصوى قد اتخذ لنفسه صديقة جديدة. من هذا الخبر، تتولد عندها، غيرة قاتلة، تجتاح كل شيء، لدرجة أن الراوية لم تعد تحتمل هذا الألم الفظيع، الذي يلفها ولا يدعها تفكر بأي شيء آخر، لغاية إعلانها بأنها أصبحت «محتلة» من قبل منافستها وغريمتها التي تؤرقها طيلة لحظات نهارها (وربما ليلها أيضا). ومن هذا الأرق، تكتب إرنو «موتيفات» الهوس والفقدان وعذاب العشق.
تراجيديا قصوى
على جري عادتها، تلاحق الكاتبة كل تصرفات وعواطف وأحاسيس بطلتها، بكل الدقة التي عرفت عنها، مثلما تلاحق عادياتها لغاية أن تصل بذلك كله إلى الحقيقة القصوى التي تطمح إليها. فإذا كانت الغيرة تُعاش في هذه الرواية مثل تراجيديا قصوى، إلا أنها تستدعيها أيضا كما لو أنها تلك اللحظة التي يفقد فيها المرء عقله ومنطقه بشكل مضحك وساخر. هل لذلك تدفعنا هذه الرواية، التي تبدو كمأساة، إلى الابتسام في بعض لحظاتها؟ ربما يعود ذلك إلى أن هذه «الانحرافات» العائدة «لعقل مريض»، مرسومة بفعل المسافة التي تتخذها الراوية عن موضوعها، كما بفضل الرؤية الواضحة التي تتمتع بها والتي تدفعها إلى الابتعاد عن كل تصعيد مفرط لذروة الانفعال. مثلما نجد في تلك المشاهد التي تقضيها وهي تجري اتصالات هاتفية «مجهولة» بكل ساكني العمارة التي تعتقد أن غريمتها تسكنها على أمل أن تسمع صوتها. أو أيضا تلك الجمل التي تبدو «سخيفة» لكنها تدل فعلا عن «هذا الاحتلال» الذي يتغلغل إلى أعماق أعماقها: «وكأنني مت حقا حين شعرت بأنه يستطيع أن يشاهد عند المرأة الأخرى قناة «باريس الأولى» التي لا ألتقطها في منزلي». لكن عبر ذلك كله، لا بد للقارئ من أن يشعر بأعمال أخرى، حول الغيرة، وهي تجتاز عقله وروحه، على سبيل المثال لا الحصر، رواية «السأم» لألبرتو مورافيا، أو «السجينة» لمارسيل بروست. لكننا هنا، بالتأكيد، أمام «نسخة» حميمية، أشبه باليوميات الخاصة أكثر من كونها رواية تنحو إلى رسم ذاك «الفريسك الهائل».
لا تشذ رواية «الاحتلال» عن المشروع الروائي الذي تعمل عليه إرنو منذ بداياتها: أن تقدم لنا في كل مرة جزءا من حياة، حدثا «عابرا» أو بالأحرى تفصيلا عاديا من تفاصيل الحياة التي نمر بها والتي تشكل جزءا منها (عملية إجهاض، علاقة شغف كبير، موت الأب...) إلا أنها تفاصيل واسمة بكل تأكيد ، ربما لأنها في النهاية تشكل مرجعا ما في سلم الوجود. لحظات هي بدون شك التي تؤسس جوهر الحياة الكبير. «ما من حقيقة أقل من أخرى»، هذا ما تقوله آني إرنو في روايتها «الحدث». حياة متقطعة، تقدمها إلينا الروائية الفرنسية من كتاب إلى آخر، لذلك تبدو رواياتها، كأنها لعبة «بازل»، حيث تشكل كل واحدة منها قطعة منفردة، لكن إن جمعناها معنا، لظهرت أمامنا الصورة (أو اللوحة) بشكل متكامل.
ثمة خاصية أخرى تتمتع بها إرنو وهو أسلوبها. بالتأكيد تملك الكاتبة أسلوبا خاصا بها. ربما يعتبره البعض بأنه أشبه بأسلوب «اليوميات الحميمة»، أي أسلوب بدون تزاويق أو ادعاءات، من هنا هذه المهارة في أن تجعلنا نعتقد وكأن ما تكتبه من كتاب إلى آخر ليس سوى يومياتها الحقيقية ومن دون أي تبديل أو تعديل. ومن كتاب إلى آخر، تنجح إرنو في بناء «عملها» الأدبي، الذي يذهب مباشرة إلى الأساسي، إلى الجواني والداخلي، إلى الحميمي، من دون أي تعقيدات أو التفافات. يذهب عبر هذه الكثافة المكثفة التي تفتح، في الوقت عينه، حقولا متعددة للقراءة الخاصة أمام القارئ.
ربما يمكننا أيضا أن نضيف ميزة أخرى، عند آني إرنو، أصبحت تظهر في كتبها الأخيرة، وهي تقدمها في حقل العلاقة ما بين الكائن الفرد والكتابة. لا نغالي لو قلنا إن الذين سبقوها إلى الغوص في هذا الحقل، لم يذهبوا عميقا في الأمر، مع هذه الرغبة في عدم ترك أي شيء مخفي في الظل. كذلك نجد أن الذين سبقوها، لم يخاطروا كثيرا في عرض ذواتهم الداخلية أمام الجميع، على هذه الدرجة من التعرية، وبالمعنى المزدوج للكلمة. كلما تراجعنا قليلا إلى الوراء، كلما لاحظنا هذا التحول الذي عبر أدب آني إرنو عميقا وبخاصة مع كتابها «مجرد شغف» عام .1992 فإذا كان هذا الكتاب يتحدث عن علاقة غرامية من دون أن تخفي أي مظهر من مظاهرها وربما لذلك بدا يومها وكأنه على قدر كبير من الفضائحية إلا أن ذلك لم يسقطه في الفجاجة والقسوة مثلما يتبدى عند القراءة الأولى، والسبب في هذه العلاقة التي ألقي الضوء عليها: العلاقة بين الكتابة وبين ما يمكن لنا أن نسميه «التوحشية الأصلية».
كتابة شامانية
إزاء ذلك كله، نجد أن آني إرنو تقترح علينا رؤية ما، ما أتاح لها أن توسع حمولة ما تكتبه، تقول: «يبدو لي وبعد أن اجتزت زمن العمل المكثف، زمن الزواج والإنجاب، وبعد أن دفعت غرامتي بأكملها للمجتمع، ها أنا أنذر نفسي للأساسي، الذي لم اعد أراه منذ المراهقة». بالتأكيد ثمة تأمل ذو رنين أنتروبولوجي، ولد من هذا الصراع الكبير ما بين الحميمي والاجتماعي. وهو صراع يشرعن بالتأكيد مرورها إلى هذه الكتابة البيضاء، التي يجد البعض أنها لا تنتمي مطلقا إلى الأدب، أي كتابة غير أدبية. بيد أن اللغة ذات المظهر «العادي»، و«الكليشيهات» المهترئة التي تستهزئ بها، تبدو لنا في نهاية المطاف بمثابة هذا اللجوء المشترك. أمام ذلك، لا بد بدورنا أن نعترف مع ما تقوله الكاتبة بأن «حتى الاستعارات الأكثر استعمالا واهتراء كانت قد عيشت، ذات يوم، من قبل أحد ما». هذه الدعوة في الاعتراف بشهادة التجارب المؤسسة الكبرى، تمر في كل مكان، وإن كانت محتقرة في أغلب الأحيان. ربما لأنها تجد نفسها في علاقة آنية مع هذه «التوحشية الجديدة» الخاصة بنا.
من هنا تأتي الكتابة، كما تتصورها آني إرنو، لتحاول أن تتآلف مع بعض الممارسات «الشمانية» (عبادة الطبيعة والقوى الخفية في آسيا الوسطى) كأن تشك تمثالا بالدبابيس (كما تفعل الراوية في الكتاب) كي تصيب هذا الشخص «المجهول المعلوم» وهنا هو غريمتها. حركة رمزية، لكنها تحرر، وقد تساعد في الخروج من حالة «الاحتلال»هذه.
إذا كانت كتب آني إرنو السابقة قد أضاءت وللكاتبة بالدرجة الأولى ما كان غامضا في كتبها الأولى، «الخزائن الفارغة» و«الساحة»، فإن كتاب «الاحتلال»، وعلى الرغم من قصره وصغره، يمكن له أن يشكل مفتاح هذه القبة التي تقف تحتها الكاتبة التي تتحدث عن امرأة وعن عصرها.
السفير
1 سبتمبر 2007