السبت, 05 سبتمبر 2009
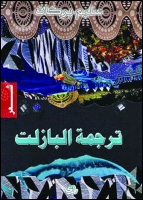
تشبه قراءة الشاعر السوري سليم بركات التزلجّ فوق جليدٍ صقيلٍ، إذِ يجدُ القارئ نفسَه متحفّزاً دائماً للسقوط، ويرى التهلكةَ بأمّ عينه منحوتةً بإزميلِ الدهشة. وبلاغة بركات فريدةٌ حقاً في المشهد الشعري العربي، وبخاصّة أنّها تؤسّس لقطيعةٍ جمالية مع نصّ الأسلاف، قدامى وحداثيين، على السواء. فهذا الشّاعر، المولع بالنحتِ اللغوي، يتعمّدُ نسفَ الطرائق التقليدية في الكتابة، داعياً المتلقي إلى التخلّي عن يقينه الجاهز، والتأمّل في شبكة علاقات رمزية جديدة، قوامها كنايات تتدافعُ وتتطاحنُ، وتصدمُ، بلا ريبٍ، الذائقةَ التقليدية، وتخلخلُ أسسَها الفنية. إذ ينبغي على القارئ أن يكون مستعدّاً للغوصِ عميقاً في بحر استعاراته المتلاطمة، التي تؤسّسُ لحساسيةٍ جديدة، وتذهبُ في النفي الدلالي إلى حدّه الأقصى، ما يصيبُ المعنى، كما نألفهُ، في مقتلٍ.
وبركات في ديوانه الجديد «ترجمة البازلت»، الصادر في طبعتين، عن دار النهضة العربية، (بيروت)، ودار المدى، (دمشق)، يصل بالنفي إلى درجة قصوى، إذ يركّز على موضوع الغياب كثيمة فلسفية بطلُهُا ضميرُ الغائب، «هم»، الحيادي، القاسي، الذي يعتمده كاستراتيجية سردية رئيسة في تشخيص وجودٍ ناقص، لا يفتأ يتحوّل بالتدريج إلى عدمٍ فضفاض: «هم، أنفسهم، عدمٌ فضفاضٌ لا يُرتدى، ووجودٌ ضيقٌ لا يُرتدى». ومنذ الجملة الأولى، تطالعنا استعاراته الشاسعة، المتدافعة كالسيل، التي تمتدّ لاهثةً فوق بياض الصفحة، مثل كثبان ثلجية متحرّكة، وكلّما أمعنّا النظر فيها، ابتعدت ونأت، وأضحت لا مرئيةً، ربما من شدّة صقلِها ولمعانِها. لكن، وسط هذا الانشغال بفتنةِ البيان، تظلّ عينُ الشاعر مثبّتةً على مصير جمعي يتأرجح بين المأساة والملهاة: «يقتطفون، كفطر الغراب، الينابيعَ المتصبّبةَ ياقوتاً من مسامّ أرقِها، ويمازحونَ الوقتَ المختَتِنَ بمِقصِ الأناشيد». هنا يضيع خيط الحبكة، ويتشرّد المعنى في مسيلات دلالية فرعية، ويتداعى المركز، وتنفلت الصورُ من عقالها، لتصبح القراءةُ ذاتها سيراً في التيه، ومطاردةً للسراب: «ها هم كلما اقتربوا من أزلٍ أبكوه. كلما اعتدلوا أنّقوا المذهلَ العاصفَ. يأكلون الوسائدَ في طريقِهِم إلى النوم». عبثاً يبحثُ القارئُ عن طريدةٍ دلالية يوقِعُ بها، أو عن ضفّة يرسو إليها. كأنما يتحوّل هو نفسه إلى طريدة، وتصبح القصيدةُ مرآةً لا تعكس سوى ذاتها، مثل لوحة باروكية، متشابكة الخطوط والألوان والظلال، مصنوعة من شهيق الفراغ فحسب.

مع ذلك، وفي ديوانه هذا، المؤلّف من قصيدة طويلة واحدة، يدوّن بركات ومضات من ماض شخصي، يضفي عليها، على رغم تنوعها وتشظّيها، وحدة فنية محكمة، فكلّ الفروع والمنحنيات والحواشي، تقود إلى مصب دلالي نهائي، ترسمه، من دون لبسٍ، كناياتُ الشاعر، المنحوتة بقدر هائل من القَصدية والانتباه. فالديوان، جوهرياً، تدوين مجازي بارع لسيرة ذاتية ناقصة، منهوبة، ونازفة. كأن الشاعر يريد أن يضمّد جراحَه بالكنايات، ويُلبِسَ صراخَه قناع الرّموز، إذ ثمة دعوة للإصغاء إلى نشيج جمعي خافت، يشترك فيه البشر والحجر والنبات والطير والماء والهواء، في رثاء دامع لعناصر الطبيعة وكائناتها، وبخاصة أولئك البشر الغائبين عن وجودهم، المبعثرين كالغبار في العَدَمِ المطلق، المنذورين لسبكِ الجراحِ: «سبّاكو جراحٍ، بقوالب سبكِ الجصّ، هُمْ. أهينوا، فأهانوا الجراحَ، أولاء، نسّاكو الزّنبقِ المبتذل، السّمكريون في أنفاق المطاحن، حلاّقو الرؤوس، متدحرجة على صحائِفِ الوعد.
صوتُ الشاعر هو صوتُ هؤلاء جميعاً، وقناعُهُ قناعُهم، المصكوك من هجرات وخيبات وحروب، ولهذا يأتي الديوان برمّته، وكما يشير العنوان، ترجمةً لألم الصامتين، المطوّقين بجماد البازلت: «مكلفٌ أن أحدّثَ عنهم ما أحدّثُ عني، جالساً هنا، قرب البراميل المطوّقة بأجناسِ البازلت». وفي منعرجات مفصلية كثيرة في القصيدة، يتقاطع ضمير الغائب مع ضمير المتكلم، ويندغم صوت الجماعة بصوت الأنا، ويذوب الفردي في الكلّي، وتنحرف الذات بعيداً من ذاتيتها، عاكسةً ألماً كونياً مترامياً: «هم الأممُ الشائعةُ، كشتائم شائعة، ارتضتْ أن تذيقَني تعبَ الممكنِ». وبركات يعي شساعة المأساة التي يصوّرُها، ويدركُ، في الآنِ عينِهِ، عبثيتَها، ولا جدواها. وعلى رغم طغيان ضمير الغياب، كما نوّهنا، نجد الشاعر لا يلتزم صوتاً سردياً واحداً، إذ يدمج أصوات المتكلّم والمخاطب والغائب في بوتقة واحدة، وبخاصة في الجزء الأخير من قصيدته، كمن يريد أن يتجاوز فداحة التاريخ المدون باتجاه رؤيا شعرية موشورية للخراب: «إنه الهديرُ لا يستثني قلوبَكم لا يستثني قلوبهَم، لا يستثني قلبي». ويصل التماهي بين العام والخاص ذروته حين يسمح بركات لأصداء من سيرته الذاتية بالتغلغلِ في نسيجِ سردِهِ الشّعري: «سأرجعُ من هنا؛ من ظلّ نسيه أبي على ماءِ الخابور، يترقرقُ ملتصقاً بظلال آبائه...» هذه الرغبة بالعودة ليست سوى وقفة طللية مستعادة، تمجّد الخسارةَ، ولا تمنحُ، في المقابل، فرصةً للانتماء، بل تزيد من شعور المتكلّم بالقطيعة مع العالم: «لا تهبوني شيئاً. لا تهبوني إلاّ الكِسرَ يصلحُهُ الكسرُ». والكِسرُ كامنٌ في الكلمات ذاتها، ولهذا، ربّما، يسعى بركات إلى صقلها وشحذها لاصطياد المدهش، والإغارة على القاموس، ونبش المنسي والمهمل فيه، وإعادة تسمية الأشياء كلها، والعناصر كلها. بمعنى آخر، يتحول القاموس برمته إلى مادة طيعة تُسخّر لبناء قصيدة لا تشبه أي قصيدة أخرى.
واللافت في بلاغة بركات ميلها الى القسوة، واختيارها مفردات خشنة، ناتئة، حتى أننا نحتاج أحياناً إلى قاموس للتعرف إلى دلالاتها. مع ذلك، تخفي هذه القسوة حناناً غائراً، وشفافية موغلة في العذوبة، وبخاصة أن الشاعر لا يملك سوى التسمية الحائرة للتدليل على وجود حائر: «فلأقسِّمْ عليهم الحبرَ المتردّدَ المهرِّبَ، اللاّعبَ بأناملِ الدّمِ على وترِ الكلمات.
سليم بركات خبيرٌ بالعزف على وتر الكلمات، واختراع المفردات التي تسمّي ولا تسمّي، وابتكار شعرية صادمة قلّ نظيرها في الشعر العربي، فكلما أوغل الشاعر في التجريد، التفت إلى ضرورات الحسّي، ما يجعله يوظّف فلسفياً التناغم (أو التناقض) بين الفكرة وأصلها، الوردة وعطرها، نسجاً على منوال الشعراء الميتافيزقيين الإنكليز (جون دن، كراشو، هربرت، مارفيل) الذين صهروا الحسّ بالفكر، وردموا الهوّة بين الهنا والهناك. وبركات يفعل هذا من دون أن يخسر تمرّده الشعري، في الأسلوب والرؤيا، فالمأساة التي يصفها، أو يتنفّسها، هي بعيدة وقريبة، حاضرة وغائبة، ذاتية وعامّة، في آن. بمعنى آخر، تقيم رؤياه الشعرية في منتصف الدلالات، أو تلعثم الكلمات، موزّعةً بين الكينونة والعدم، في «كونٍ يتسكّعُ في أنصاف الكلمات». وما خروج بركات عن نسق أسلافه، قدامى وحداثيين، سوى خيار تفرضه الموهبة القوية، الساعية إلى تحقيق الاختلاف، في أقوى معانيه، والغوص الفَكِهِ، السّاخرِ، في تاريخ اللّغة ذاتها، وانتقاء المفردات الصادمة، الجديد.
من هنا، لا شيء يصفحُ لبلاغةِ بركات المتدفّقة، القاسية، الصادمة، سوى الجنون عينه: جنون المعنى المنلفت من كلّ يقين، وجنون الأسلوب المتحرّر من كلّ نسق. وبالجنونِ يدوّنُ الشاعر سيرةً ذاتيةً وعامةً، مؤسّسةً على نفي متواصل، وهجراتٍ متواصلة، وموتٍ متواصل. وفي ديوانه يندغمُ العامّ بالخاص، ويشتبكُ الحسّي بالرّوحي، وتنجحُ لغته بابتكار قاموسها الخاصّ، بعد أن انقضّت على القاموس ونهَبَت أجملَ ما فيه، وتركتُهُ أثراً بعد عين، محققةً، من دون مبالغة، بلاغةَ الادهاش التي تغوينا دائماً بالسّقوطِ في مهاوي بيانهِا الخلاّق.