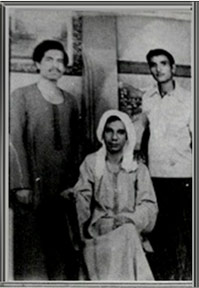 محمد الحمامصي من القاهرة: "أعشق اسكندرية" عنوان الكتاب الذي وثق للاحتفالية التي أقامها مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية مساء الأحد 10 يناير 2010، تحت عنوان "الاحتفال بالعيد السبعيني لميلاد أمل دنقل".
محمد الحمامصي من القاهرة: "أعشق اسكندرية" عنوان الكتاب الذي وثق للاحتفالية التي أقامها مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية مساء الأحد 10 يناير 2010، تحت عنوان "الاحتفال بالعيد السبعيني لميلاد أمل دنقل".
الكتاب الصادر هذا الأسبوع يشكل رؤية عميقة في تجربة أمل دنقل الشعرية والإنسانية والوطنية، وذلك من خلال شهادات لأجيال مختلفة من الشعراء والنقاد والمبدعين مثل د.جابر عصفور وأحمد عبد المعطي حجازي وعبد العزيز موافي ود.أحمد درويش وفؤاد طمان ومحمد زكريا عناني، والمايسترو شريف محي الدين وغيرهم، فضلا عن شهادات زوجته الناقدة عبلة الرويني، وأخيه الشاعر أنس دنقل، والمخرجة عطيات الأبنودي، وعدد من مقالات الشاعر وحوار صحفي أجري معه لمجلة الأسبوع العربي اللندنية، وملحق ضم عددا من الصور النادرة التي تنشر لأول مرة للشاعر.
صدر الكتاب الذي حرره الشاعر عمر حاذق عن مركز الفنون بالمكتبة مصحوبا بأسطوانتين مضغوطتين (سي دي)، الأولى تحتوي على الفيلم التسجيلي "حديث الغرفة رقم 8" للمخرجة القديرة عطيات الأبنودي، والثانية تحتوي على قصائد أمل المغناة التي لحنها المايسترو شريف محي الدين مدير مركز الفنون، وكانت جسرًا عبر به شعر أمل إلى المتلقي الأوروبي "العادي" الذي حضر الحفلات الغنائية التي غُنّيتْ فيها قصائد أمل وتُرْجمت في ألمانيا وفرنسا وغيرهما.
لم يعرف الاحتفال بعيد ميلاده
رأت الناقدة عبلة الرويني في كلمتها أنه من الجميل أن تحتفل مكتبة الإسكندرية بميلاد الشاعر أمل دنقل، فميلاد الشاعر أمر يستحق الاحتفال، وميلاد شاعر كأمل دنقل هو احتفالية ممتدة من جيل لجيل، وقالت: لم يعرف أمل دنقل الاحتفال بعيد ميلاده يومًا، هذا الطقس الاجتماعي الذي لم يعرفه ربما أبناء الصعيد، مرة وحيدة ربما هي الأولى والأخيرة؛ أصر فيها الدكتور جابر عصفور على الاحتفال بميلاد أمل.. أخذه من غرفته (رقم 8) بمعهد السرطان (وكان المرض قد اشتد عليه، وكان يعاني من صعوبة في السير) لكن الدكتور جابر أصر على أن يصحبه في السيارة ويتجول به في شوارع القاهرة؛ فكانت رؤية شوارع القاهرة من نافذة السيارة هي أول وآخر احتفال عرفه أمل في عيد ميلاده.
لكن أمل عرف دائمًا كيف يحتفل بميلاده الحقيقي؛ أقصد عرف دائمًا فرحة ميلاد القصيدة: "أيها الشعر يا أيها الفرح المختلس"؛ فكيف احتفل أمل دنقل بقصيدته؟ وكيف صانها؟ أظن أنه كان واحدًا من المعتدّين جدًّا بموهبتهم، فكان يثق في مكانته الشعرية ويعرفها جيدًا رغم أنه لم يكن يحب قراءة أشعاره في السهرات والأمسيات بين الأصدقاء، بل كان يقرأ قصائد حجازي وصلاح عبد الصبور مستعرضًا ذاكرته الحديدية؛ وأذكر مرة أنه أسمعنا قصيدة طويلة جدًّا ونادرة للدكتور عز الدين إسماعيل؛ كيف حفظها؟ وبكل هذه الدقة؟!.
الإخلاص للشعر كان أيضًا جزءًا من احتفائه بالقصيدة وصيانته لها؛ فأمل لم يشغل نفسه على الإطلاق بأي شيء آخر أو أي عمل آخر، حتى كتابة النثر لم يحبها ولم يمارسها.. مقالات معدودة تُعَد على الأصابع هي كل ما تركه أمل من نثر: أربع مقالات عن أسباب نزول القرآن، ومقال يحتوي على قراءة في ديوان "كائنات مملكة الليل" لأحمد عبد المعطي حجازي، ومقال آخر عن صلاح عبد الصبور؛ سوى ذلك كان حريصًا دائمًا على تجنب كتابة النثر. فكانت القصيدة هي الشيء الوحيد الذي كتبه وأخلص له.
هذا الإخلاص -في ظني- أخذ أشكالاً مختلفة تؤكد إيمانه بأن الشعر ليس مجرد موهبة بل العمل على هذه الموهبة وصيانتها بالرجوع الدائم للمعاجم. لم يكن لأمل بيت ثابت، بل كان دائم التنقل من بيت لبيت، ومن غرفة صديق لغرفة صديق آخر؛ وبالتالي لم تكن له مكتبة خاصة قائمة يمكننا أن نحصي محتوياتها من الكتب. لكن أربعة كتب هي التي كانت تنتقل معه من بيت لبيت، وكانت هي الكتب المتبقية بعد وفاته. هذه الكتب هي: القرآن الكريم والعهد القديم والعهد الجديد وكتاب ابن إياس. هناك كتب أخرى بالطبع كالأغاني والكثير من كتب التاريخ والتراث لكنها فُقِدَت من كثرة التنقل.
شعر أمل ملحنا
وتحدث المايسترو شريف محي الدين عن صداقته لأمل دنقل وحكى تجربته في تلحين شعره، قال حين قررت خوض هذه التجربة عام 1989 اندهش كثير من أصدقائي الفنانين، وتساءلوا: هل يمكن أن يخضع هذا الجبروت الشعري بعرامة لغته وعنفوان صوره وحواره العميق مع التاريخ؛ هل يمكن أن يخضع للتلحين ويترقرق غناءً عذبًا؟!
وكانت المفاجأة أنني وجدت الشعر محتويًا على لحنه ومتدفقًا بموسيقاه؛ خلافًا لما توقعه الجميع، وانطلقت في رحلة التلحين حتى اكتملت النصوص الملحنة أحد عشر نصًّا استمتعت غاية الاستمتاع باكتشاف طاقاتها الموسيقية الثرية الصافية، وذلك بقدر سعادتي بالحفاوة الجماهيرية الكبيرة التي كانت تنالها تلك الأعمال في مصر وفي أوروبا أيضًا حيث كانت تُعرض مع ترجمة القصائد إلى اللغات الأوروبية، وكان تفاعل الجمهور الأوروبي معها مدهشًا؛ وصارت ذكرياتي الحميمة معها أجمل وأكبر؛ وتحضرني من هذه الذكريات ذكرى مؤثرة أحب أن أشارككم دفأها: كان ذلك بألمانيا في أوبرا ساربروكن وتم غناء بعض قصائد أمل التي لحّنتُها مع عرض ترجمتها الألمانية، وكانت منها قصيدة "ضد من" التي كتبها أمل عن معاناته مع المرض اللعين حين اشتدت وطأته عليه، وإذا بالجمهور الألماني يحتفي بالعمل احتفاءً مؤثرًا حتى جاءتني بعد الحفل مجموعة من الممرضات الألمانيات، واعترفن لي بأنهن اكتشفن بعد هذا الحفل معاني جديدة لمعاناة الناس من المرض.
منذ كنت في الرابعة عشرة من العمر حتى رحيل أمل، سعدت بصداقته بعد أن قدمني إليه النحات الراحل عوني هيكل صديقه المقرب، وأصبحت ألتقي به على مقاهي وسط البلد، وتأثرت به، واستمعت إليه وهو يلقي شعره، ونشأت صداقة جميلة بين صبي يحلم بأن يصبح فنانًا وشاعر كبير ذي كبرياء خاص. وبعد رحيله ظلت الصداقة الرائعة مع إبداعه الخالد.
الوعي بالانهيار القومي
 الناقد د.جابر عصفور: مبدأ حركة القصائد ما بين الحاضر والماضي في شعر أمل دنقل هو الوعي بالانهيار القومي الذي استجاب إليه شعره حتى من قبل وقوع كارثة العام السابع والستين. وهو الوعي الذي أدى إلى رؤية اللحظة التاريخية لهذا الانهيار بوصفها لحظة السقوط، المساء الأخير على الأرض، وقت الرماد الذي ينسرب إليه الأفول من كل حدب وصوب، متخذًا العديد من التجليات الفردية والجماعية التي لا تخلو من حضور الموت الذي يبسط ألويته السوداء على قصائد أمل منذ البداية. ويصل هذا الوعي المأساوي بين المفرد والجمع، الخاص والعام، الحاضر والماضي. والنتيجة هي ما ينتهي إليه المتمعن في شعر أمل من أن قصائده تتحول إلى مراثٍ متكررة الرجع في مستوى أساسي من دلالاتها، مراثٍ لعالم يحتضر أو عالم ينتشر فيه الموت. صحيح أن هذه القصائد لا تكف عن رفض الموت في تعليقها على ما يحدث، ولا تتوقف عن التمرد على الموت الذي ينتشر كالهواء في كل شيء. ولكن رفض الموت والتمرد على حضوره الطاغي إثبات لهذا الحضور، وتأكيد لعلاماته الكثيرة التي تجذب العين في عالم مستكين لم يعد في ظاهره ما ينبض بالروح.
الناقد د.جابر عصفور: مبدأ حركة القصائد ما بين الحاضر والماضي في شعر أمل دنقل هو الوعي بالانهيار القومي الذي استجاب إليه شعره حتى من قبل وقوع كارثة العام السابع والستين. وهو الوعي الذي أدى إلى رؤية اللحظة التاريخية لهذا الانهيار بوصفها لحظة السقوط، المساء الأخير على الأرض، وقت الرماد الذي ينسرب إليه الأفول من كل حدب وصوب، متخذًا العديد من التجليات الفردية والجماعية التي لا تخلو من حضور الموت الذي يبسط ألويته السوداء على قصائد أمل منذ البداية. ويصل هذا الوعي المأساوي بين المفرد والجمع، الخاص والعام، الحاضر والماضي. والنتيجة هي ما ينتهي إليه المتمعن في شعر أمل من أن قصائده تتحول إلى مراثٍ متكررة الرجع في مستوى أساسي من دلالاتها، مراثٍ لعالم يحتضر أو عالم ينتشر فيه الموت. صحيح أن هذه القصائد لا تكف عن رفض الموت في تعليقها على ما يحدث، ولا تتوقف عن التمرد على الموت الذي ينتشر كالهواء في كل شيء. ولكن رفض الموت والتمرد على حضوره الطاغي إثبات لهذا الحضور، وتأكيد لعلاماته الكثيرة التي تجذب العين في عالم مستكين لم يعد في ظاهره ما ينبض بالروح.
لم أكن أستاذا له
الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي : قال أمل دنقل في بعض اعترافاته إنه تتلمذ عليّ. وقد ردد هذا القول عدد من النقاد. لكنني أقول إنني لم أكن أستاذًا لأمل أو لغيره من شعراء جيله الذين كانوا يقرأونني كما كنت أقرؤهم، وكانوا يتعلمون من تجربتي لأن تجربتي -وتجربة أي شاعر- ليست تجربة فردية، وإنما هي بلورة -صنعها كل شاعر بطريقته- لكل ما قرأ ولكل ما تعلم من تراث الفن الذي يشتغل به. ومما لاشك فيه أني تعلمت الكثير من محمود حسن إسماعيل ومن علي محمود طه ومن إلياس أبو شبكة ومن إبراهيم ناجي ومن شوقي ومن حافظ، ومن البكائيات الشعبية التي كانت تغنيها أمي في ظهائر الصيف وأنا طفل، حينما كانت تبكي إخوتها الراحلين، وتعلمت من القرآن، وتعلمت في الشعر من طه حسين وتوفيق الحكيم؛ تعلمت من لغتهما. وأنا أجد بالفعل في شعر أمل صيغًا تذكرني بالصيغ التي استخدمتها: صيغًا نحوية وصيغًا إيقاعية، وهذا طبيعي، لأننا أبناء لغة واحدة، وأجد أنه اهتم بموضوعات أنا أيضًا اهتممت بها، لكنه أبدع فيها إبداعًا خاصًّا لا يمكن أن يكون ثمرة التقليد أو التلمذة البسيطة؛ مثلاً عندما أقرأ قصائد أمل دنقل عن القاهرة أحسده وأتمنى لو أنني كتبت هذه القصائد، وعندما أقرأ قصائده عن الإسكندرية -خاصة عن البحر- أحسده كذلك وأتمنى لو أنني كتبتُ هذه القصائد، لأني أحب البحر وأحب الشعر المكتوب عنه، كما أحب الشعر المكتوب في أي موضوع، لأن الشعر يضيف للواقع خبرة الإنسان. وأحب الإسكندرية وكتبتُ عنها لكن كتابة أمل عن الإسكندرية تعجبني أكثر، وأنا لست متواضعًا وأعرف قدري، والحب يدفعنا للمبالغة في تقدير ما أخذناه ممن نحبهم وإن كان قليلاً محدودًا. وحين أقارن بين ما أدين به لغيري وما يدين به أمل دنقل لي أستطيع أن أقول إنني لست أستاذًا لأمل دنقل.
كان أمل دنقل إنسانًا طيبًا نقيًّا على غير الشائع عنه، وكان يحب أن يعطي الذين يحبهم وينسب لهم المزايا. وقد عرفت أمل دنقل سنة 1960 فيما أذكر أو 1961، وكنا نلتقي في قهوة عبد الله وهي قهوة قديمة كانت في ميدان الجيزة بالقاهرة، وكان من رواد ندوتها التي كانت تنعقد كل مساء الناقد الأستاذ أنور المعداوي، وكان يلتقي معه الدكتور عبد القادر القط وأحيانًا الأستاذ زكريا الحَجّاوي وكاتب صحفي اسمه طلبة رزق لا أدري أين هو الآن، والدكتور محمد كامل حسين أستاذ الأدب المصري، وكان يأتي بين الحين والآخر محمود حسن إسماعيل، لكنه كان يجلس بعيدًا عن الآخرين لأنه كان شديد الكبرياء، وكان الآخرون أيضًا أشد منه كبرياء؛ ولهذا لم يكونوا يقتربون منه أو يطلبون منه الاقتراب. وفي أمسية من الأمسيات، ظهر شابان وتقدما للتحية، وقد عرفت فيما بعد أنهما أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي. هل كان أمل آنذاك قد انتقل للعمل بالإسكندرية أم كان لايزال يبحث عن العمل؟ لكنني متأكد أنه لم يكن قد نظم بعد قصيدته التي قدمته للناس "كلمات سبارتكوس الأخيرة" التي أظن أنه نظمها عام 1962، ولهذا أستطيع أن أقول الآن إن هذا اللقاء الأول بأمل دنقل كان سابقًا على نظم القصيدة أي كان سابقًا على عام 1962.
مرحلة انتقال حاسمة
 وقال الناقد د.أحمد درويش: كانت المرحلة التي شارك فيها أمل دنقل في إبداع الشعر العربي المعاصر، مرحلة انتقال حاسمة، أسهم فيها هو بجهد ملحوظ، ونفس متميز، كانت مرحلة انتقال في موسيقى الشعر وإيقاعه، تجمعت فيها إرهاصات عقود وقرون سابقة، ناوشت الشكل المستقر في بحور الخليل المحكمة، وفجرت شكلاً من أشكال التطور أو التحرر من قيودها الصارمة في تساوي عدد تفعيلات البيت ووحدة نظام القافية في القصيدة، وانطلقت قصيدة التفعيلة متحررة من هذين القيدين، في فترة الصبا المبكر لأمل دنقل، وكثر عدد المهرولين إلى الميدان، بعد تجارب روادها الأوائل، ومن بينهم في مصر عبد الصبور وحجازي وفي العراق السياب ونازك الملائكة بعد المحاولات الأولى المبكرة لباكثير ولويس عوض، وجرَّت الهرولة إلى تخلف بعض ملامح التسطيح والتشابه فضلاً عن الخفوق الموسيقي لآذان تعودت على تلقي الشعر، على نحو موسيقي شديد الدقة والإحكام طوال أكثر من خمسة عشر قرنًا، وقد جاءت هذه الملامح من الفهم "المتسرع" لمفهوم الحرية في النظام الجديد، فكان أن ركز الكثيرون من شعراء موجة التفعيلة الثانية على الخلاص في القيد "الإجباري" المتروك، ولم يلتفتوا إلى القيد الاختياري المجلوب فجاء شعرهم صحيحًا وفقًا لقواعد شعر التفعيلة، لكنه جاء في الوقت ذاته خاليًا من المذاق الخاص لكل شاعر على حدة وتحقق ما كان يسميه رولاند بارت، انعدام درجة ما فوق الصفر، في الأسلوب، وساعد على ذلك وجود الإكلشيهات التعبيرية التي جنح شعراء الموجة الثانية من تقليد الرواد إليها فأدى ذلك كله إلى ما أشرنا إليه من تشابه وتسطيح.
وقال الناقد د.أحمد درويش: كانت المرحلة التي شارك فيها أمل دنقل في إبداع الشعر العربي المعاصر، مرحلة انتقال حاسمة، أسهم فيها هو بجهد ملحوظ، ونفس متميز، كانت مرحلة انتقال في موسيقى الشعر وإيقاعه، تجمعت فيها إرهاصات عقود وقرون سابقة، ناوشت الشكل المستقر في بحور الخليل المحكمة، وفجرت شكلاً من أشكال التطور أو التحرر من قيودها الصارمة في تساوي عدد تفعيلات البيت ووحدة نظام القافية في القصيدة، وانطلقت قصيدة التفعيلة متحررة من هذين القيدين، في فترة الصبا المبكر لأمل دنقل، وكثر عدد المهرولين إلى الميدان، بعد تجارب روادها الأوائل، ومن بينهم في مصر عبد الصبور وحجازي وفي العراق السياب ونازك الملائكة بعد المحاولات الأولى المبكرة لباكثير ولويس عوض، وجرَّت الهرولة إلى تخلف بعض ملامح التسطيح والتشابه فضلاً عن الخفوق الموسيقي لآذان تعودت على تلقي الشعر، على نحو موسيقي شديد الدقة والإحكام طوال أكثر من خمسة عشر قرنًا، وقد جاءت هذه الملامح من الفهم "المتسرع" لمفهوم الحرية في النظام الجديد، فكان أن ركز الكثيرون من شعراء موجة التفعيلة الثانية على الخلاص في القيد "الإجباري" المتروك، ولم يلتفتوا إلى القيد الاختياري المجلوب فجاء شعرهم صحيحًا وفقًا لقواعد شعر التفعيلة، لكنه جاء في الوقت ذاته خاليًا من المذاق الخاص لكل شاعر على حدة وتحقق ما كان يسميه رولاند بارت، انعدام درجة ما فوق الصفر، في الأسلوب، وساعد على ذلك وجود الإكلشيهات التعبيرية التي جنح شعراء الموجة الثانية من تقليد الرواد إليها فأدى ذلك كله إلى ما أشرنا إليه من تشابه وتسطيح.
أحد الصعاليك العظام
الناقد د.محمد زكريا عناني ختم مقاله بسؤال ماذا يبقى من أمل دنقل؟ وأجاب قائلا : في الظن أن اسم هذا (الجنوبي) حار المشاعر سيبقى –وإلى ما شاء الله للكون أن يبقى– باعتباره واحدًا من "الصعاليك العظام"، الذين أقبلوا يعبون من كأس الحياة في رعونة واندفاع، يعتصرونها بصفوها وعكارتها معًا، لأن حدسًا داخليًّا، فيما يبدو، كان ينبئهم بأن الكأس الأخرى مرة المذاق آتية عما قريب، وقد ضربت بالفعل ضربتها مبكرًا، ودفعته في غلظة إلى سريره الحديدي بالغرفة رقم 8، هزمته في يسر، لكنها لم تستطع أن تدفن اسمه كما وارت جسده.
وأجزم: ولن تستطيع أبدًا، ومهما فعلت. على كلٍّ، فماذا يساوي الجسد؟ إن الذي يبقى حقًّا هذه الخفة من الدواوين الصغيرة، التي يتوهج فيها الشعر كالجمر المتّقد، قصائد عن الوطن الذي يتذبذب تحت الأقدام كالطمي الرخو، عن الأحلام التي تطير كالدخان، وعن الحب الذي يعانق الوهم والمستحيل، مواكب الكلمات والصور والأخيلة التي تتجسم بالضبط كما ينبغي، فتتجاوز التصنيف والتمذهب والانتماء؛ فشعر أمل دنقل "حالة خاصة" يمكن أن تنتمي لهذه كله، ولكنها تبقى مختلفة لها نكهتها وأريجها ومذاقها ووهجها الذي يميزه عن غيره، والذي يضمن له أن ديوانه سيبقى أبدًا على أرفف "الشعر" يجالد الزمن طالما أن هناك شعرًا، ذلك أن أمل دنقل وبالتعبير المصري الشعبي: شاعر بحق وحقيق!.
حديث الغرفة رقم 8
وتحدثت المخرجة التسجيلية عطيات الأبنودي عن تجربتها تجربة فيلم "حديث الغرفة رقم 8" قالت : الحقيقة أنني أريد الخروج عما هو شخصي جدًّا في تجربتي مع فيلمي عن أمل إلى ما هو عام؛ وهو افتقادنا الشديد لأفلام وثائقية عن فنانينا وكتابنا وشعرائنا، ليس بمعنى وجود برامج تلفزيونية عنهم، وإنما بمعنى أن يقول الفنان بنفسه ما يريد. وإذا كان كل من في القاعة اليوم يتحدث عن أمل، فإن هذا الفيلم هو الوثيقة الوحيدة التي يتحدث فيها أمل عن أمل. وحين بدأت عمل الفيلم واجهتني مشكلة إنتاجية: من الذي ينتج الفيلم؟ لا أحد يريد ذلك. كنت أقوم بعمل فيلم تسجيلي طويل وفاضت لديّ خمس علب أفلام، ودخل أمل المستشفى، وقبله بقليل رحل يحيى الطاهر عبد الله ونحن جميعًا -حتى أسماء ابنته- لا نملك ليحيى إلا خمس صور، لم يكن له أي حديث تلفزيوني أو إذاعي، لم نجد أثرًا موثّقًا له، إنما مجرد صور التقطها هواة له مع أسماء طفلته في حديقة الحيوان، كانت هناك صورة وحيدة اتخذ فيها وضعًا خاصًّا للتصوير وهو يمسك سيجارته أمام الكاميرا. من هنا كان هول رحيل يحيى دون أي أثر تصويري له -كصورة- رغم أننا في عصر الصورة.
وأحب أن أقول شيئًا هنا: أمل لم يكن صديقي، ربما كان المتحدثون في هذه الاحتفالية جميعًا شاهدوا أمل والتقوا به، لكني بصفتي مخرجة أفلام تسجيلية تعرف قيمة الناس تاريخيًّا، قررت المسارعة لتصوير أمل وتوثيق شيء عنه. وعبلة تشهد بذلك، فأمل لم يدخل بيتنا أبدًا؛ لذلك لم أسجل الفيلم لأسباب شخصية بل لأنني متخصصة في التوثيق. ثم يتضح في النهاية أن الفيلم هو الوثيقة الوحيدة التي يمكننا أن نشاهد فيها أمل دنقل وهو يتحدث؛ فقد كان لديّ حس تاريخي بأن أتدارك هذا الرجل الذي دخل المستشفى لأن يحيى الطاهر لم يمكنني تداركه قبل رحيله.
ومع الأسف لم يموِّل أحد هذا الفيلم، فالأستاذ محسن نصر تبرع بتصوير المقابلة التي تمت مع أمل، وقمنا بتأجير الكاميرا ووسائل الإضاءة، وأخذ العمال أجورهم... لقد كانت فداحة الحدث تلزمنا بإتمام هذا العمل. وقد أجريت حديثي معه سنة 1982، ولم أتمكن من إتمام الفيلم إلا سنة 1990؛ فلم تتبرع أي جهة رسمية ولا أي أفراد لإتمام الفيلم، لأنني كنت أرى أن المقابلة بمفردها لا تكفي لعمل فيلم تسجيلي مكتمل يطالعه الناس، فلا يمكن أن يكون الفيلم مجرد إنسان يتحدث فينبغي عليّ أن أحل المقابلة فنيًّا. وفي سنة 1990 كنت أصور فيلمًا آخر في الصعيد، فقررت زيارة عائلته في "قِفْط"، والتقيت بالسيدة والدته واصطحبتني لتصوير المقبرة، ثم حصلت من عبلة على بعض الصور الفوتوغرافية؛ وهنا وجدتُ لدي حلاًّ فنيًّا للفيلم: أن يحتوي الفيلم على معلومات حقيقية على لسان أمل دنقل. فمنذ البداية كانت رؤيتي أنني لو طلبت من شاعر قراءة قصيدة له في فيلم تسجيلي عنه، فإنني بذلك سأختزله في هذه القصيدة. لذلك لم أطلب من أمل قراءة قصيدة له في الفيلم، وكنت أرى أيضًا أنني لو أردت عمل فيلم تسجيلي عن قراءة أمل لشعره، فينبغي أن يقرأ كل دواوينه، ويصبح اسم الفيلم: "الشاعر يقرأ شعره".
ممثل حزب المعارضة
واختتم الشاعر والناقد عبد العزيز موافي مقالته قائلا : يبقى لأمل دنقل أنه -في حقبتي الستينيات والسبعينيات- كان يمثل حزب المعارضة الأوحد بامتداد العالم العربي، وكان أنصار هذا الحزب هم أعضاء حركتي العمال والطلبة، وكل أطياف اليسار آنذاك؛ فكان أشبه بالضوء الساطع الذي يكشف الانتصارات الزائفة، وسيطرة العسكرتاريا الانقلابية على مقدرات عدد كبير من البلدان العربية إضافة إلى البؤر الرجعية المتخلفة -في بعض البلدان العربية- عن العصور الوسطى. وإذا لم يقدم أمل إنجازًا آخر غير تشكيل هذا الحزب، لكفاه ذلك لكي نعده أحد الشعراء العظام، الذين أثروا في واقعهم بالكلمة، دون أن يتقوقعوا داخل أوهامهم الذاتية.
شهادة أمل على الثقافة المصرية
أجرى الكاتب الصحفي وليد شميط حوار صحفية مع أمل دنقل في العدد 772 سنة 1974 من مجلة الأسبوع العربي التي كانت تصدر في لندن، وسأله في ختام حواره "كيف تنظر إلى الوضع الثقافي في مصر اليوم؟ وكيف تتحرك أنت في إطار هذا الوضع؟" وقال أمل: الوضع الثقافي في مصر اليوم يمر في مرحلة من الترهل. إن الكُتّاب الذين بدءوا ثوريين منذ شبابهم تحولوا بفضل ظروف عديدة إلى مرتزقة، وهذه هي محنة الثقافة الحقيقية في مصر. إن الخوف قاد الكثيرين منهم إلى التسليم وإلى نوع من الانفصام العقلي، فهم يدلون في مجالسهم الخاصة بآراء ثم يكتبون نقيضها ويتبنون مواقف غير التي يتداولونها. إني أعتبر أن الجيل السابق لا يختلف كثيرًا في نوعيته مهما اختلفت اتجاهاته السياسية ومهما سمي هذا الكاتب يساريًّا أو ذاك يمينيًّا.. إنهم في النهاية يصبون في مجرى واحد، وأعتقد بأن هذه اللعبة تمارس أيضًا مع أفراد جيلي، لكن سقوطهم صعب لأسباب عديدة منها أنهم شباب، ومنها أنه من الصعب أن يتنازل الإنسان عن أفكاره لقاء أثمان بخسة، فقد ذهب الكبار بنصيب الأسد من الفريسة ولم يبق إلا الفتات. ونتيجة لإبعاد هذا الجيل عن مراكز الصدارة فإنه يبقى متمسكًا بشرف كلمته حتى إشعار آخر. وكل المحاولات التي بذلت لاحتواء هذا الجيل لم تنجح تمامًا كما نجحت مع الجيل الذي سبقنا. ومن هنا فقد عادت إلى الظهور وجوه كثيرة بعد إسقاط ما يسمونهم باليساريين من المراكز الثقافية والصحافية، ممن بليت أفكارهم وأقلامهم. إن تبني هذه الوجوه يحقق هدفين: هدفًا براقًا بالنسبة إلى الجماهير لأن هذه الأسماء لاتزال تحتفظ ببعض شهرتها لدى القراء البسطاء، وهدفًا آخر في تمكين هؤلاء في ممارسة أحقادهم التي تولدت عن عزلتهم وتخلفهم وإحساسهم بالكهولة والنضوب والعقم. أنا لا أكره هؤلاء الكتاب وهذه الأسماء التي عادت إلى اللمعان من جديد لأن الزمن في صالح أفكاري وفني وآرائي وجيلي. ونحن في صعود وازدهار مهما وُضِعنا في أقفاص زجاجية، وهم في ذبول وانحدار مهما دخلوا غرف الإنعاش ولجأوا إلى الحقن المنشطة والمقوية. هذا ليس شماتة من الكهولة، أنا أقصد كهولة الفكر وكهولة الروح وهؤلاء الكُتاب لا يملكون إنتاجًا حقيقيًّا. إن أسماءهم تبرز في صفحات الصحف وعلى شاشات التليفزيون مسبوقة بلقب الشاعر أو الكاتب أو الناقد. لكنهم في النهاية لا نقرأ لهم لا شعرًا ولا كتابةً ولا نقدًا.
ومن هنا حالة التدهور الثقافي في مصر. إن المخرج الوحيد أمام المؤسسات الثقافية المسئولة في مصر هو أن تتبنى جيلي وقضاياه وأفكاره، لأن في هذا تجديدًا لشبابها قبل أن يكون تجديدًا لشباب مصر.
ايلاف
2010 الثلائاء 31 أغسطس