
كيف يلتقي شاعر بشاعر آخر، في لقاء غير تقليدي، لقاء يجب أن يتسم بحالة وجد صوفية. تزاوج نفسي بين ثقافتين، لغتين، جسدين.
هنا شهادات للشعراء العشرة الذين شاركوا في هذه التجربة. وكيف جاءت رؤيتهم، مخاض شعري بشكل وعناصر جديدة.
محمد النبهان:
ورشة الشعر.. سؤال الذات
 الأيام الأربعة لورشة تهريب أبيات الشعر شحنتني بأسئلة الشعر ذاتها؛ الشعر بما هو سفر لا ينتهي في المجهول، حين عقدنا الصفقة، توم شولتس وأنا، على إعادة ترجمة النصوص عدت بشكل أو بآخر إلى المستوى الأول للنص، إلى الشرارة الأولى، إلى تلك اللحظة الشعرية التي سبقت تدوين النص. هذه الفكرة أغرتني وأخافتني، ربما لأنها تحيل إلى النص الغائب في ثنايا النص المدون، لكن تنبهنا لهذه المسألة أضاف أبعاداً جديدة للنصوص التي وضعناها على طاولة الورشة، والتي كان لابد لها أن تفقد في الترجمة الحرفية.
الأيام الأربعة لورشة تهريب أبيات الشعر شحنتني بأسئلة الشعر ذاتها؛ الشعر بما هو سفر لا ينتهي في المجهول، حين عقدنا الصفقة، توم شولتس وأنا، على إعادة ترجمة النصوص عدت بشكل أو بآخر إلى المستوى الأول للنص، إلى الشرارة الأولى، إلى تلك اللحظة الشعرية التي سبقت تدوين النص. هذه الفكرة أغرتني وأخافتني، ربما لأنها تحيل إلى النص الغائب في ثنايا النص المدون، لكن تنبهنا لهذه المسألة أضاف أبعاداً جديدة للنصوص التي وضعناها على طاولة الورشة، والتي كان لابد لها أن تفقد في الترجمة الحرفية.
الأمر الأكثر إغراء في المشروع هو أن تبحث عن ذاتك في الآخر، كيف سيعبر عنك هذا الآخر في قصيدتك؟ كيف سيسرقك من لغتك ويبقي عليها، إلى لغته ويبقي عليك. أليس هذا هو، في الوقت نفسه، سؤال البحث اللا ينتهي عن الذات؟!
توم شولتس
كتابة الشعر عبر المحيط
 قصائد محمد النبهان لم تكن غريبة علي بعد القراءة الأولى. مواضيعها تتطابق مع كثير من مواضيع قصائدي. المسافة الناشئة عن الآفاق الثقافية المتباينة مكنتني من تحويل ''الغريب'' إلى قريب أثناء عملية النقل. هكذا غدت قصائده مألوفة لي.
قصائد محمد النبهان لم تكن غريبة علي بعد القراءة الأولى. مواضيعها تتطابق مع كثير من مواضيع قصائدي. المسافة الناشئة عن الآفاق الثقافية المتباينة مكنتني من تحويل ''الغريب'' إلى قريب أثناء عملية النقل. هكذا غدت قصائده مألوفة لي.
الاغتراب بين اللغات ضئيل إذا ما قسناه بسرعة الضوء. من يريد الترحال عبر المحيط بحاجة لجلد سباحة وزعانف جيدة. في أحد بوتيكات الشعر أنتظر رمش عيون جارية جميلة تشتري مني هذه الجمل. وغيرها. أو لأقول ذلك بكلمات شاعري محمد النبهان: تأخذني من جوعي لمطاعم سرية..
محمد الحارثي
أن نترجم شعراً من لغة لا تعرفها
 لم أتخيل نفسي مترجماً، فضلاً عن ترجمة الشعر من لغة كالألمانية، لا أفقهها. لكنها حقيقة، أقرب للمعجزة، تحققت خلال ''ورشة الأدب في برلين''.
لم أتخيل نفسي مترجماً، فضلاً عن ترجمة الشعر من لغة كالألمانية، لا أفقهها. لكنها حقيقة، أقرب للمعجزة، تحققت خلال ''ورشة الأدب في برلين''.
كان رفيقي في مشروع الترجمة المشتركة الشاعر الألماني رون فينكلر، وكان من حظنا أن يكون غيرت هيملر، وسيطنا في ترجمة قصائدنا بين اللغتين: العربية والألمانية.
كانت جلسات الترجمة مدخلاً باذخاً لتعارف شخصي عبر تشعب الحديث في كلا الثقافتين، وكانت الحكايات الطريفة والفريدة من رموز الشعر في اللغتين تتداعى واحدة بعد أخرى؛ ليس ابتداء بالمتنبي، ولا انتهاء بغوته، على سبيل المثال.
كانت تجربة ممتعة وبالغة الثراء أتاحتها ''ورشة الأدب في برلين''. فقد نجحنا رون فينكلر وأنا في ترجمة قصائدنا بروح شعرية نابضة في قلب اللغة الأخرى. نجحنا بالفعل؛ رغم عدم معرفتي للغة الألمانية، وعدم معرفته للغة العربية.
رون فينكلر
معاينة الأفق
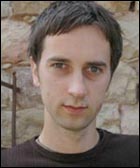 حقل الكلمات هو عنصر المترجم. حقل له أفقه الذي ككل أفق جيد ليس أفقاً. وبالتالي أفق. أليس كذلك؟ عنصر المترجم يتأرجح - بين الأفق واللاأفق وكل الآفاق التي ليست أفقاً.
حقل الكلمات هو عنصر المترجم. حقل له أفقه الذي ككل أفق جيد ليس أفقاً. وبالتالي أفق. أليس كذلك؟ عنصر المترجم يتأرجح - بين الأفق واللاأفق وكل الآفاق التي ليست أفقاً.
نراه أحياناً يقف هناك يعاين العنصر الأفق. لديه بعض الأدوات جاهزة، لا يعرف أسماءها، لذا يسميها كما يحلو له وكما يبدو له مناسباً. محراث النبض ونسبية الافتراض، إضافة إلى حز المكيال، وبعض شرائط المعنى وشيء من تشحيم الهجين. وغيرها.
أحياناً يكون ديسمبر/ كانون الأول وتكون برلين، عندما يكون على المترجم أن يجني ثمار حقل كلمات جديد. يقف عندها في صلب أفق. يقف على حافة أوراق ومبان من طوب مشوي، يقف بين شاعر ومترجم، يقف بدقة في النقطة الوسطى بين ماض ومستقبل. يلف سيجارة، يلف كلمة بكلمة أخرى، يسأل نفسه: كم مصطلح تعرف لغته لـ''طرف الصحراء''.
حضره المترادفات المعهودة: كفاف، الرمل، وانحسار الفقر، وعبق نهاية الكون. يعطي السيجارة الملفوفة للشاعر الذي أصبح شاعر (ه)، الذي لا يكتب قافية على [وزن] حقل الكلمات ولا على [وزن] المترجم. يبتسم الشاعر، يدخن صحراء التبغ حتى أطرافها. هناك تفاهم، نوعاً ما. في حقل الكلمات ينبت شيء. شيء ما ربما محدد. فوق وعكس كل غموض.
 علي الشرقاوي
علي الشرقاوي
ذهاب القصيدة للعمق
تجربة ورشة الترجمة بين اللغتين الألمانية والعربية التي عشناها في برلين كانت من التجارب المهمة في حياتي، فمن خلالها استطعت أن أتعرف على شيء من طريقة تفكير الشاعر الألماني، واستطعت أن أرى ذهاب القصيدة إلى العمق مباشرة، دون الحاجة إلى الشرح التي يعاني منها أكثر الشعر العربي. من هنا أرى من الضروري أن تتواصل هذه التجربة إلى أن تنضج ثمارها، بين اللغات المختلفة في عموم الساحة الثقافية، السلام العالمي الذي ينشده كل الناس على من خلالها قد نشم رائحة التسامح الإنساني والمحبة بين الأخوة البشرية.
جيرهارد فالكنر
لقاء كائنات استشعارية
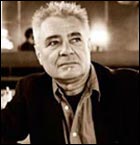 جاءت فعالية ''تهريب الشعر'' التي نظمتها ''ورشة الأدب برلين'' في أكتوبر/ تشرين الثاني 2009 لتكون لقائي المميز الثاني بكتاب من العالم العربي. ومن اللافت أن يكون الشعراء بشكل أساسي في صلب هذين اللقاءين عظيمي الأهمية من الناحية الثقافية وبالطبع السياسية أيضاً.
جاءت فعالية ''تهريب الشعر'' التي نظمتها ''ورشة الأدب برلين'' في أكتوبر/ تشرين الثاني 2009 لتكون لقائي المميز الثاني بكتاب من العالم العربي. ومن اللافت أن يكون الشعراء بشكل أساسي في صلب هذين اللقاءين عظيمي الأهمية من الناحية الثقافية وبالطبع السياسية أيضاً.
لم يكن لقاء مختصين يتحركون ضمن حدود الحوار القائم الضيقة، رغم تكرار احتدام الشعارات الجديدة، بل لقاء كائنات استشعارية ذات خلفيات شعرية يمكن فك مغاليقها في أرحاب العالم.
نتجت خلال ذلك جسور تواصل بين مواقف راديكالية متباعدة مثل ''اللبناني الثقافي'' الذي يصبح أحياناً أكثر جلاء عند ترجمة الشعر، أو ''التباين الأخلاقي'' الذي يشتعل غالباً على عتبات تململ وضيق ذرع العالم العربي بالمصطلح، عندما يحيل الغرب قسرياً كل ما هو ''عربي'' إلى مرجل حاضن للاهارب. العمل المشترك مع الشاعر علي الشرقاوي من مملكة البحرين تميز بتلازم الفكاهة والفطنة والجد في ذات الوقت.
نجوم الغانم
تهريب دم القصيدة
 في برلين كانت القصائد تحتفي بأيام الشتاء؛ حيث كل شيء ينتظر الميلاد بقلب مرتجف، ولكنه ناصع كالثلج.. لعلنا توقعنا أن يرتفع الوهج سريعاً، قبل أن يتاح لنا أن نمنح احتراق الجمر وقتاً كافياً، ليلقي عن وجهه غشاوته الخارجية، الممتزجة بالدخان والرماد.. لعلنا كلنا بحاجة إلى أن نتعلم أولاً؛ التمهل في الاقتراب من تنور التجربة، ربما كان الأمر يتطلب المزيد من تقليب الحطب، الذي كان يشتعل وفق قانونه.. البرد والنار كلاهما يلسعان، وكذلك الحيرة..
في برلين كانت القصائد تحتفي بأيام الشتاء؛ حيث كل شيء ينتظر الميلاد بقلب مرتجف، ولكنه ناصع كالثلج.. لعلنا توقعنا أن يرتفع الوهج سريعاً، قبل أن يتاح لنا أن نمنح احتراق الجمر وقتاً كافياً، ليلقي عن وجهه غشاوته الخارجية، الممتزجة بالدخان والرماد.. لعلنا كلنا بحاجة إلى أن نتعلم أولاً؛ التمهل في الاقتراب من تنور التجربة، ربما كان الأمر يتطلب المزيد من تقليب الحطب، الذي كان يشتعل وفق قانونه.. البرد والنار كلاهما يلسعان، وكذلك الحيرة..
كان علينا في برلين، ونحن نخضع لتجربة الترجمة؛ أن نهرب أرواحنا على موائد الشعر قبل الأبيات أحياناً.. أما الأفكار التي كانت تجيء وتذهب، بحثاً عن سبل لقول المعنى وغواية الآخر؛ فقد بدت وكأنها تتحصن خلف أسوار لغتها الأم.. لا أعرف إن كان المنفذ الذي تخيلت أنني أحفره في جدارها، قد اتسع بما يكفي ليسمح برؤية داخله، لا أدري إن كان قلب اللغة ظل متشبثاً بمفاتيحه، وخائفاً ان يمنحها تماماً لمن ينتظر على الطرف المقابل، بشغف الاطلاع على كل التفاصيل.. هل تمكنا من فتح صناديق اللغة، ليظهر بلورها الحقيقي، أم تركنا شيئاً من سحرها بين طيات الكلام؟ هل ظل ثمة شيء لم يتم البوح عنه؟.. هل ظل شيء لم يكن له أن يقال، أو ان ينحسر عنه غطاؤه؟!
الأمر المؤكد أننا وقفنا سوياً تحت نافذة المحاولة، تبادلنا التراشق بالمحبة، وذقنا كرز المعنى..
خرجنا جميعاً إلى شلال الضوء؛ حيث تنتظرنا جغرافيا جديدة، ومدن لا شك أنها ستكون قريبة من القلب، بنفس درجة قرب برلين، وسيكون لنا فيها ركن، نشعل تحت سقفه شمعة جديدة؛ لاستكشاف ما تخبئه خنادق اللغة، والتقاط ذهبها، في جولة أظننا أصبحنا أكثر تسلحاً لخوضها.
نورا بوسونغ
كيفية فهم القصائد
 أيام الترجمة الأربعة التي قضيناها ضمن مجموعة الشعر العربية الألمانية أتذكرها كوقت مكثف أتاح لي فرصة الاطلاع على الشعر العربي المعاصر البعيد في الواقع عن الشعر الألماني التقليدي وعن المشهد الشعري الألماني الحالي على حد سواء. إن نقل نصوص نجوم المسبوكة بلغة وتقاليد شعرية وعوالم صور على هذا القدر من الاختلاف تطلبت مني درجة استشعار عالية وكثيراً من المحادثات التي نحت سوء الفهم جانباً وساعدت على فهم القصائد وتموضعها الظرفي ومكنوناتها الوجدانية. علاوة على ذلك لمست إثراء خلال البحث في نصوصي الخاصة والتفكر بها بشكل معمق، وإثراء في تفكيك القصائد أولاً على صعيد تركيبها اللغوي ومجازاتها وإحالاتها، ومن ثم إعادة تركيبها جزءاً تلو الآخر. بهذا قاربت مجدداً قصائدي التي مضى على كتابتها عدة سنوات من منظور يكاد يكون آخر
أيام الترجمة الأربعة التي قضيناها ضمن مجموعة الشعر العربية الألمانية أتذكرها كوقت مكثف أتاح لي فرصة الاطلاع على الشعر العربي المعاصر البعيد في الواقع عن الشعر الألماني التقليدي وعن المشهد الشعري الألماني الحالي على حد سواء. إن نقل نصوص نجوم المسبوكة بلغة وتقاليد شعرية وعوالم صور على هذا القدر من الاختلاف تطلبت مني درجة استشعار عالية وكثيراً من المحادثات التي نحت سوء الفهم جانباً وساعدت على فهم القصائد وتموضعها الظرفي ومكنوناتها الوجدانية. علاوة على ذلك لمست إثراء خلال البحث في نصوصي الخاصة والتفكر بها بشكل معمق، وإثراء في تفكيك القصائد أولاً على صعيد تركيبها اللغوي ومجازاتها وإحالاتها، ومن ثم إعادة تركيبها جزءاً تلو الآخر. بهذا قاربت مجدداً قصائدي التي مضى على كتابتها عدة سنوات من منظور يكاد يكون آخر
محمد الدميني
فضائل التهريب
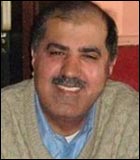 هل هناك أية مقاصد لهذه الرحلة المزدوجة للقصيدة (عربية وألمانية، وبالعكس) في ذاكرتينا، وفي لغتينا، وفي تغذية مخيلتينا؟ تبدو هذه الورشة التي سخرت لتهريب الشعر، وكأنها الإجابة على نحو ما! الغرابة هنا أن برنامجاً شعرياً كهذا يجمع شاعرين ينتميان إلى لغتين عسيرتين، دون أن يتقنا لغتي بعضهما، لكي يتحدثا - عبر وسيط لغوي - عن أشد التفاصيل التي تختبئ وراء نصوصهم. ورغم هذا فإنهما يبلغان برزخاً جمالياً تتواصل فيه، وعبره، كائناتهما الشعرية، ويعيدان كتابة قصائدهما في ضوء خبرات جمالية ودلالية تتكشف عبر جولات مسهبة وتشريحية في مجاهل تلك النصوص.
هل هناك أية مقاصد لهذه الرحلة المزدوجة للقصيدة (عربية وألمانية، وبالعكس) في ذاكرتينا، وفي لغتينا، وفي تغذية مخيلتينا؟ تبدو هذه الورشة التي سخرت لتهريب الشعر، وكأنها الإجابة على نحو ما! الغرابة هنا أن برنامجاً شعرياً كهذا يجمع شاعرين ينتميان إلى لغتين عسيرتين، دون أن يتقنا لغتي بعضهما، لكي يتحدثا - عبر وسيط لغوي - عن أشد التفاصيل التي تختبئ وراء نصوصهم. ورغم هذا فإنهما يبلغان برزخاً جمالياً تتواصل فيه، وعبره، كائناتهما الشعرية، ويعيدان كتابة قصائدهما في ضوء خبرات جمالية ودلالية تتكشف عبر جولات مسهبة وتشريحية في مجاهل تلك النصوص.
وفيما يعيد الشاعر قراءة رفيقه فإنه يقرأ نصوصه أيضاً عبر عين أخرى، لا تتوطأ معه بالضرورة على فسحات ومآلات ومرجعيات قصيدته، ولكنها تكشف له أحياناً عن بواطن في نصه لم يتقصدها، وعن حيوانات ظن أنها قد غدر بها سلفاً، وفي الآن نفسه تكشف عن ضفاف متحجرة في قصيدته وعن معان فاقعة لا تثير خيالاً.
عبر اقترابي من قصيدة شريكتي، الشاعرة سيلفيا غايست، كنت مهجوساً بأن أقرأ نصاً يعاندني، يخض يقينياتي، ويطيح بما حاولت أن أعمره في قصيدتي. أن أرى سياقاً مختلفاً لدور اللغة في النص، وأن أخالط كيفية مختلفة لاصطياد الشاعر لكائناته.
لعلها، إذن من المرات المقبلة التي أكتشف فيها بلوغ الشعر حافة العلم ومفرداته الجرداء، واجتهاداً لاستبطان رموز كيميائية في قلب القصيدة. اكتشف لدى غايست انزياحاً عن المفردات ذات الكثافة التراثية، والتمترس الدلالي، ونزوعاً نحو ما هو عنصري.. حي.. وفوضوي.. وفي مرمى النظر العادي.. لكن كل هذا لا يخفف من المهمة العسيرة الكامنة في نقل نصوص شديدة الخصوصية إلى لغة أخرى.
بالنسبة لي فإن هذه الورشة تقدم اقتراحاً ممكناً، ليس مثالياً بالضرورة، للتبادل الأدبي والجمالي، والثقافي بصور أشمل، بين أدبين يحملان الرسالة الأممية ذاتها، لكنهما يختلفان في مكونات صنعتهما وفضائيهما المكاني والاجتماعي. على نحو ما، تبدو لي وكأنها رد حميم على فيروس صراع الحضارات اليائس. إنها تقدم برهاناً إنسانياً بسيطاً على أن النصوص الأدبية وتبادلها قادرة على بناء جسور غير مرئية، لكنها صلدة بما يكفي، لتعميد الخلاص الإنساني عبر سرب من الكلمات والخيالات التي لا يمكن اعتقالها..!
سيلفيا غايست
من ضفة لغة إلى أخرى
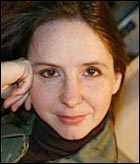 الترجمة هي فعل نقل من ضفة لغة إلى أخرى، لكنها اتخذت معنى إضافياً هذه المرة مع زميلي السعودي محمد الدوميني، أيضاً معنى أكثر من المعرفة بشيء من الثقافة وعالم الحياة الكامن خلف اللغة الأخرى أو الكامن بالأحرى فيها. ولمتابعة فكرة النقل من ضفة إلى أخرى، ولا أقصد هنا القصيدة المفردة فحسب، بل هذا الصوت الآخر الذي بات عبارة تحمل شحنة تفوق الشكل والنص والمعنى فبعد سنوات من سماعي للغة العربية عامة عبر التقارير المتلفزة وشذرات الأخبار القصيرة، التي كان وقعها بالكاد شيء بغير الغرابة وخوفي الغامض من ما يستعرض من تصورات عن العالم العربي في سياقات كهذه. بعد هذه الانطباعات التي تولد مسافة قاربني شيء ما. قصائد محمد الدوميني تحكي عن الغربة في ظروف حياة متكبدة لم يتم اختيارها، كما تحكي عن الحزن والخسارات التي تنشأ عملياً في ظل شروط محددة، لكن جوهر مألوف لي ولكل إنسان.
الترجمة هي فعل نقل من ضفة لغة إلى أخرى، لكنها اتخذت معنى إضافياً هذه المرة مع زميلي السعودي محمد الدوميني، أيضاً معنى أكثر من المعرفة بشيء من الثقافة وعالم الحياة الكامن خلف اللغة الأخرى أو الكامن بالأحرى فيها. ولمتابعة فكرة النقل من ضفة إلى أخرى، ولا أقصد هنا القصيدة المفردة فحسب، بل هذا الصوت الآخر الذي بات عبارة تحمل شحنة تفوق الشكل والنص والمعنى فبعد سنوات من سماعي للغة العربية عامة عبر التقارير المتلفزة وشذرات الأخبار القصيرة، التي كان وقعها بالكاد شيء بغير الغرابة وخوفي الغامض من ما يستعرض من تصورات عن العالم العربي في سياقات كهذه. بعد هذه الانطباعات التي تولد مسافة قاربني شيء ما. قصائد محمد الدوميني تحكي عن الغربة في ظروف حياة متكبدة لم يتم اختيارها، كما تحكي عن الحزن والخسارات التي تنشأ عملياً في ظل شروط محددة، لكن جوهر مألوف لي ولكل إنسان.
ليس مدعاة للحديث من منظور عقلاني، لكن من منظور وجداني انقلب الحلم. كنت قد أتيت إلى برلين بسعادة مسبقة وتوتر وتوجس. أتساءل كيف سيكون شكل العمل مع عربي، مع رجل آت من عالم ما كان له أن يسمح لنا بالمكوث في غرفة بمفردنا؟ لا أدري متى أدركت ذلك بوضوح. ربما رشحت تلك اللحظة أثناء الأسبوع كنور النهار الذي يتحدث عنه محمد في إحدى قصائده، لحظة إحساس (استخدم الكلمة هنا كنقيض للمبهم الغامض) بأنني لم أطوب التوق للحرية وتحقيق الذات لنفسي، لا بوصفي أوروبية ولا بوصفي امرأة، باقتضاب، إحساس بأن هناك شيئاً نتقاسمه بغض النظر عن الشكل الذي نمنحه لأحلامنا (أو خيالنا).
الوقت
22-4-2010