| ينشر هذا الملف بالاتفاق مع موقع (ديوان)
(بيت النص الشعري الجديد)
عن شعرية (القيمة) في النص | |  |
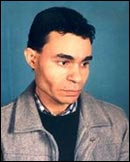 أريد هنا أن أكرس لـ (القيمة) كمصدر هام من مصادر الشعرية في النص. بل إنني أدعو لأن تكون هي العنصر المركزي في العملية الإبداعية، ومن حولها تدور العناصر الأخرى للشعرية فتمدها بالحياة أو تسلبها منها.
أريد هنا أن أكرس لـ (القيمة) كمصدر هام من مصادر الشعرية في النص. بل إنني أدعو لأن تكون هي العنصر المركزي في العملية الإبداعية، ومن حولها تدور العناصر الأخرى للشعرية فتمدها بالحياة أو تسلبها منها.
والقيمة، أية قيمة، هي ابنة المكان والزمان المسكونين بالبشر، تلمع حينا ثم تخبو، تسود حينا ثم تتنحى، في مراوحة مع ما يطرأ على بشر ذلكما الزمان والمكان.
يمكن إذن أن نتحدث عن أركيولوجيا قيمة ما، عن تحولاتها، عما يحفظها وعما يئدها، يمكن أيضا أن نتحدث عن قيمة أصيلة وقيمة وافدة، عن قيمة حق وقيمة باطل، عن قيمة خير وقيمة شر.
والقيمة قد تأتي مع الجيوش، أو تأتي مع السلعة، وها هي تأتينا الآن عبر الفضائيات وتحت شعار العولمة. ولكل أمة مجموعة من القيم، وهناك قيم هن أمهات. عن هذه القيم نحتشد لنزود ونكتب لنكرس وندعو للوقوف عليها.
والقيمة، وإن كانت وضيعة أو مبتذلة فقد يحييها النص بعناصره الشعرية الأخرى، كما أنها قد تكون رفيعة ونادرة ومع هذا يقتلها النص بغياب تلك العناصر.
إن نصوصا تدعو للعهر والابتذال، ونصوصا تمارس الكذب والتضليل،
ونصوصا تكرس للأثرة والخيانة، ونصوصا توقظ الشر وتنكت القلوب بالسواد، لهى ـ وأمثالها ـ نصوص عدائية تجاه الإنسان وتجاه الحياة.
وإن حصار قيم أساسية لأمة، والتشويش عليها وتغييبها لهو المقدمة الخطرة لفقدان هذه الأمة لهويتها، فماذا يكون الأمر إن كانت تلك القيم هي ما شكل فجر ضمير البشرية (مثل تعاليم امنموبي) وحتى أن تممت مكارم الأخلاق (رسالة النبي محمد) عليه الصلاة والسلام.
أين ذهب إرثنا إذن، وكيف غادر حياتنا ونصنا، على السواء، وما ذلك الذي يسعى كي يحل محله؟
* * *
إحذر أن تسلب فقيرا بائسا
وأن تكون شجاعا أمام رجل مهيض الجناح.
* * *
لا تزحزحن الحد الفاصل بين الحقول
ولا تتعدين على حدود أرملة.
* * *
لا تضرن رجلا بجرة قلم على بردية
لأن ذلك ما يمقته الله
ولا تؤدين شهادة كذبا.
* * *
إذا وجدت فقيرا عليه دين كبير لك
فقسمه ثلاثة أقسام
سامحه في اثنين، وابق واحدا
ستجد ذلك سبيلا للحياة
وتنام بالليل نوما عميقا
وفي الغد
تجد أخبارا سارة.
* * *
لا تتلاعبن بكفتي الميزان
ولا تطففن الموازين.
* * *
لا تسخرن من أعمى
ولا تهزأن من قزم
ولا تفسدن قصد رجل أعرج.
* * *
لا تمنعن أناسا من عبور النهر
عندما يكون في قاربك مكان.
* * *
من يفعل الفاحشة
فإن المرفأ يفلت منه.
* * *
إحذر رب العالمين
ولا تتعدين على حرث آخر.
هكذا كان يعلم الوالد (أمنموبي) ولده (حور ماخر) منذ ما يزيد على ثلاث آلاف سنة، فما الذي هو مطروح علينا الآن؟ وما الذي يحمله لنا النص الآن؟
وهل لم يعد في نصنا شعر، إذ لم تعد في حياتنا قيمة؟
علي منصور
النصوص المختارة ( بتصرف ) من كتاب: الأدب المصري القديم، الجزء الأول سليم حسن، كتاب اليوم، 15 ديسمبر 1990
* * * * * *
سيرة جديدة للتمرد
1
 أعتقد ان الذات التي تنتج الشعر الآن، أصبحت ذاتأ مهددة، لا تشعر بثقة في المستقبل. تحولت إلى ذات اجتماعية مهمومة أكثر منها ذات شعرية متجاوزة. هناك تحول في السياق الذي تتحرك داخله الذات الشاعرة، فلم تعد من أولوياته هذا النوع من التفسير والتأويل للحياة. حدث انفصال بين الشعر والسياق الاجتماعي الذي يحوطه، وفقدت الثقافة شعريتها وقدرتها على التخيل. ربما يكون الخطأ مزدوجأ، أن تشعب وتعقيد السياق الاجتماعي أصبح فوق احتمال أدوات الشعر وقدرتها على الاستيعاب. وكذلك فإن الأدوات الشعرية لم تتطور لتعبر عن لحظة راهنة عشوائية.
أعتقد ان الذات التي تنتج الشعر الآن، أصبحت ذاتأ مهددة، لا تشعر بثقة في المستقبل. تحولت إلى ذات اجتماعية مهمومة أكثر منها ذات شعرية متجاوزة. هناك تحول في السياق الذي تتحرك داخله الذات الشاعرة، فلم تعد من أولوياته هذا النوع من التفسير والتأويل للحياة. حدث انفصال بين الشعر والسياق الاجتماعي الذي يحوطه، وفقدت الثقافة شعريتها وقدرتها على التخيل. ربما يكون الخطأ مزدوجأ، أن تشعب وتعقيد السياق الاجتماعي أصبح فوق احتمال أدوات الشعر وقدرتها على الاستيعاب. وكذلك فإن الأدوات الشعرية لم تتطور لتعبر عن لحظة راهنة عشوائية.
وكما أن ثقافتنا لم يعد لها ثوابت أو محاور ارتكاز؛ أصبح من الصعب تثبيت أشكال شعرية بعينها وضمان استمرارها. لأن الشكل الشعري، والنثري بوجه خاص، هو الأكثر حساسية وتأثراً لغياب الثوابت التي كان يبنى عليها شعريته.
2
نشأت قصيدة النثر العربية في ظل مرجع تنويري أو جذري. ليس المعنى فقط هو ما كان جذريا، بل اللغة أيضا. كانت اللغة هي إحدى طرق التغيير، فالمجتمع بشكل ما كان يسكن اللغة، وأي جديد في تراكيبها وعلاقاتها، قادر على أن يصل إلى ذائقة وحساسية المجتمع. بتلاشي هذا المرجع النقدي، تحت ضغط الحياة الحديثة واليأس من التغيير؛ فقدت قصيدة النثر أهم مراجعها، أو المجال الذي تتحرك فيه اللغة الشعرية، المجال الذي كان يمنحها الشكل.
أعتقد أن النماذج المبهرة لقصيدة النثر، والتي ظهرت في الستينيات والسبعينيات، برغم عدائها للتفسير الكلى والشامل للفرد، إلا أنها استفادت من هذه العدائية. فقد ساهمت هذه النماذج، بحسها النقدي، في خلق نموذج جديد ضد النموذج السائد. لا أعرف الآن ما هو النموذج الذي يجب الوقوف ضده، وكيف نكون الوعي النقدي؟
3
الثقة التي منحها المجتمع للغة، وبالتأكيد للأدب وأشكاله المختلفة؛ عاد مرة أخرى ليسحبها، بعد التيقن بأن اللغة وتجلياتها غير قادرة على التغيير، ولا يمكن أن تكون بديلا عن الحياة. لا أعرف لماذا كانت المقارنة تقوم، في الأساس، بين اللغة والحياة؟ ربما هو مأزقنا المعرفي، أن ننشى ثنائيات، كل طرف فيها مهم وعلينا أن نختار بينهما. الأدب بكل أشكاله يقف في موضع الاتهام والمساءلة والحساب، وخاصة الأنواع الأدبية التي كانت تحمى نموذج المتمرد. كل هذا تم في صمت وبدون ضجة، أعنى أن سحب الثقة تم تدريجيا وبدون تعمد.
4
رغم فداحة الأزمة التي تعيشها مجتماعاتنا، إلا أنها غير ممثلة بحق في الأنواع الأدبية، وتحولت الأزمة داخل النصوص إلى إطار سميك من الإحباط واليأس. فمن أين تستعيد أي لغة نشاطها وفلسفتها وهى غائبة عن التعبير عن الأزمة وتفنيدها.
كذلك، الحوار، بمعناه الواسع، أصبح غائبا، وما يوفره من تعدد هام لأي شكل أدبي. فالحوار هو المكان الخام الذي تستمد منه أي شعرية وجودها. وبرغم أن قصيدة النثر غير حوارية بمعناها الفردي أو غنائية بشكل ما، إلا أنها لا تتحقق ولا تستمد قوتها إلا وسط حوار دائر حولها. حتى لا تصبح غنائيتها أو وحدتها مضاعفة.
تعطل وغياب الحوار جعل أي نوع أدبي، وحديث كقصيدة النثر، يفقد جزءا من مهنيته وتقنيته. فلم تعد هناك أسئلة وقضايا مثارة حول الشكل الأدبي، وبالتالي لم تضف أي تفسيرات جديدة على هذا النوع. بالتأكيد أصبحت قصيدة النثر الآن هي الشكل المسيطر، ولكنها سيطرة هشة، نظرا لغياب التأصيل النقدي.
أقصد النقد بمعنى التدقيق والتصنيف وإشاعة جو حيوي وخلافي من القضايا. كل هذا هام لخلق نوع من الأحاسيس العلمية اللازمة لأي تأسيس أو استمرار. هذا النوع من النقد سيضع قصيدة النثر في حجمها الطبيعي، ويفسر هذه السيطرة التي دانت لها، وهل هذه السيطرة تعبر عن حداثة تعبيرية، وكيف نجا هذا النوع الأدبي من عشوائية حداثتنا، إذا جاز التعبير. وهل أصبحت قصيدة النثر شكلا مفرغا من فاعليته؟
5
ربما ما حفظ قصيدة النثر حتى الآن هي تقنية الحكى، وهى التقنية التي أتت من حقول أدبية أخرى. أصبحت الحكاية هي بوصلة القصيدة لضبط الشكل والنفس الشعري. أعتقد أن المستقبل، بمعنى ما، سيرتبط بهذا النوع من السرد الحكائى.
6
ستستمر قصيدة النثر بانفرادات شخصية، بموهبة شعراء وحدسهم، وعمق أسئلتهم الوجودية، ووعيهم كذلك بخصوصية الشكل الشعري الذي يعملون داخله. إذا كان نموذج التمرد الذي تمحورت حوله قصيدة النثر من قبل، سواء كان التمرد الحياتي أو اللغوي، فنشاطها الحالي ومشروعيتها، كنموذج نقدي بالأساس، هو إيجاد سيرة جديدة للتمرد، بمعناه الإنساني والوجودي وليس السياسي فقط؛ كمقاومة أخيرة ضد غياب الفرد وموته المتعمد والمجاني والصامت.
علاء خالد
* * * * * * *
نحـن المجانين
 أية شهادة يمكن للمرء أن يكتبها عن الشعر الآن؟ نحن، أبناء الذعر المزمن والانتظار المستمر في خطر. لا أريد أن أركب السياسية على الأدب بالدخول في تصنيفات مثل شعراء الثورة وما بعدها، أو شعراء النكسة، أو شعراء الانفتاح..الخ.. وعندما لقبنا أحد النقاد بأننا شعراء حرب الخليج الأولى سخرنا وثرنا فأسمونا شعراء التسعينات.. ساعتها كنا نكتب شهادات عن الشعر. لكنني بين متابعة لبنان والعراق وفلسطين والسودان وبين اندثار أخبار عن الصومال وموريتانيا وغيرها، لا أستطيع في هذه اللحظة أن أنفض عن الأدب كونه متأثر – ليس بالسياسة – لكن بالكارثة. نعم. نحن شعراء الكارثة المنتظرة، الأشد من سابقتها بالضرورة، نعيش في عالم لم يعد البقاء فيه للأصلح ولا للأقوى لكن البقاء للقاتل. ويبدو أنني لم أع هذه الحقيقة إلا مؤخرا. فالرواية الأولى التي حكيت لنا صغاراً لابد وأنها كانت تعني أننا جميعا أبناء قابيل. كلنا أبناء القاتل رضينا أم أبينا.. ومن هذا المنطلق فكلنا موصومون بالعار. نقف على حافة الجنون لا ندخل فيه ولا نبرح عتبته. وهذا أمر فظيع لأنه يضعك في ما هو أشد من محنة وأقوى من صراع: كيف تكتب بينما تعي أنك ابن القاتل.. من هنا أظن نشأت قصائد اعترافية كثيرة في هذا الجيل. قصائد تُفضَح فيها الخرائب الداخلية التي أصابتنا أكثر منها تعري بلدوزر الواقع القاسي الذي سحق كل الأحلام. كانوا يلوموننا لأننا لا نكتب أشياء مبهجة، أو رومانسية هفهافة.. لأننا بدلا من أن نكتب كما تمنوا منا "عن العصافير والورد والنيل" صرنا نكتب خرائبنا وخيباتنا.. لكن قل لي، أو ليقل أحد، أي أحد، أليس الأمان أن تستلقي في مركب تهدهدك موجات النيل وأنت سعيد لأن كل الناس بخير؟ حسناً، هذا الجيل لا يعيش هذا الوهم. ويعرف أنه لا أحد بخير. حدثونا عن قتل الأب.. قالوا نحن جيل قتل أباه.. ولم لا، ألسنا أبناء القاتل؟ ألم يفكر أحد ما الذي يحدث في داخل شخص شاعر يعرف أن أباه قاتل؟ وأية أهوال تعترك بداخله، عندما يقرر أن يقتله؟ أن ينفيه بأن يحذو حذوه؟ لأنه في النهاية لا يمكنه أن يبقى هكذا بلا موقف. يا الهي نحن مساقون حتما للجنون. وأنا ينبغي أن أتحدث عن الشعر؟ فلنتحدث عن الشعر الآن إذا..
أية شهادة يمكن للمرء أن يكتبها عن الشعر الآن؟ نحن، أبناء الذعر المزمن والانتظار المستمر في خطر. لا أريد أن أركب السياسية على الأدب بالدخول في تصنيفات مثل شعراء الثورة وما بعدها، أو شعراء النكسة، أو شعراء الانفتاح..الخ.. وعندما لقبنا أحد النقاد بأننا شعراء حرب الخليج الأولى سخرنا وثرنا فأسمونا شعراء التسعينات.. ساعتها كنا نكتب شهادات عن الشعر. لكنني بين متابعة لبنان والعراق وفلسطين والسودان وبين اندثار أخبار عن الصومال وموريتانيا وغيرها، لا أستطيع في هذه اللحظة أن أنفض عن الأدب كونه متأثر – ليس بالسياسة – لكن بالكارثة. نعم. نحن شعراء الكارثة المنتظرة، الأشد من سابقتها بالضرورة، نعيش في عالم لم يعد البقاء فيه للأصلح ولا للأقوى لكن البقاء للقاتل. ويبدو أنني لم أع هذه الحقيقة إلا مؤخرا. فالرواية الأولى التي حكيت لنا صغاراً لابد وأنها كانت تعني أننا جميعا أبناء قابيل. كلنا أبناء القاتل رضينا أم أبينا.. ومن هذا المنطلق فكلنا موصومون بالعار. نقف على حافة الجنون لا ندخل فيه ولا نبرح عتبته. وهذا أمر فظيع لأنه يضعك في ما هو أشد من محنة وأقوى من صراع: كيف تكتب بينما تعي أنك ابن القاتل.. من هنا أظن نشأت قصائد اعترافية كثيرة في هذا الجيل. قصائد تُفضَح فيها الخرائب الداخلية التي أصابتنا أكثر منها تعري بلدوزر الواقع القاسي الذي سحق كل الأحلام. كانوا يلوموننا لأننا لا نكتب أشياء مبهجة، أو رومانسية هفهافة.. لأننا بدلا من أن نكتب كما تمنوا منا "عن العصافير والورد والنيل" صرنا نكتب خرائبنا وخيباتنا.. لكن قل لي، أو ليقل أحد، أي أحد، أليس الأمان أن تستلقي في مركب تهدهدك موجات النيل وأنت سعيد لأن كل الناس بخير؟ حسناً، هذا الجيل لا يعيش هذا الوهم. ويعرف أنه لا أحد بخير. حدثونا عن قتل الأب.. قالوا نحن جيل قتل أباه.. ولم لا، ألسنا أبناء القاتل؟ ألم يفكر أحد ما الذي يحدث في داخل شخص شاعر يعرف أن أباه قاتل؟ وأية أهوال تعترك بداخله، عندما يقرر أن يقتله؟ أن ينفيه بأن يحذو حذوه؟ لأنه في النهاية لا يمكنه أن يبقى هكذا بلا موقف. يا الهي نحن مساقون حتما للجنون. وأنا ينبغي أن أتحدث عن الشعر؟ فلنتحدث عن الشعر الآن إذا..
لكن دعنا نتحدث أولا عن نشرات الأخبار ومقالات الصحف وكل ما تكرس له أجهزة الإعلام الموجهة أساساً للتحكم في الشئون المعنوية للشعوب. الشعوب صارت درعا واقيا لمالكي وسائل الإعلام. إنهم يعلمونك بما يريدون وبالطريقة التي يريدونها. مثلا عندما يقولون "استشهاد" فلان فإنهم يريدون أن يحركوا فيك غضباً ورغبة في الثأر، وعندما يقولون "مقتل" فلان فإنهم يريدون تحييدك. كذلك عندما يقولون "مصرع فدائي" غير ما يقولون "وفاة انتحاري".. أتفهمني؟ إنهم يستعبدون اللغة. يسخرونها لاستعمار روحك. ليستوطنوك وأنت تتحول إلى رد فعل للغتهم؟؟ فلتسقط هذه اللغة إذا. ولنبدأ لغة جديدة. لغة يريد شاعرها أن يحررك من أوهام الاستعارات والكنايات والصيغ البيانية التي صارت تملأ الأخبار.. صار الشعر أكثر شفافية بهذا الجيل الحالي، أكثر قربا من الحقائق عن تلك "الحقائق المزيفة" التي يبثونها لنا. نحن لا نفتقد للإحساس بأن نلقي في سلة المهملات أشكال المجاز. فالحقيقة هي أن حياتنا كلها مجاز كبير. نتقبل النقد بصدر رحب. نحن أبناء القاتل. لا نوهم أنفسنا بأشياء أخرى. فهل - في مجتمع يوصم الطفل اللقيط بخطأ والديه – نستحق أن نحيا وأن نتنفس؟ طبعاً لا. هكذا قوبل هذا الجيل بكل احتقار وإقصاء ونفي. واتهمنا نحن الشعراء الجدد – المجانين لأننا مازلنا نكتب – اتهمنا في أول مشوارنا الأدبي بالعمالة والإباحية والأهم "تدمير اللغة"..لأننا لا نكتب عن الورد والعصافير!! وإلى جانب تدمير "اللغة" كان هناك اتهام أدعى للسخرية. وهو "كسر التابو".. ولا أعرف من كان أول من أطلق علينا هذه التهمة أو ختم على قفانا بهذا المصطلح "تابو" لأن الكلمة أصلا ليست عربية "بمناسبة اللغة وتدميرها". ثم إن أي "تابو" يمثل سلطة رقابية ومصادراتية لا يصلح أن يتولى أمرها شاعر. يمكن أن يتولاها عامل المقصلة الذي هو أصلا مستعبد من الآمر على المقصلة.. لكن الشاعر لو رأى تابوها ينبغي أن يكسره. كالنبي الذي لو رأى صنما يجب أن يكسره. بل وقد ينبغي للشاعر ألا يرى التابوهات أصلا، لأن كلمة تابو ذاتها تحمل حكم قيمي، والشاعر ليس قاضياً ولا واضع دساتير.. الشاعر أكثر حرية من هذا. أي أكثر طفولة.. والطفل بالنسبة لي، الطفل الوحيد بالنسبة لي، هو ذلك الذي صرح لأمه بين الحشود المهللة للملك في ثوبه الجديد وقال: أمي أمي، الملك عاري.
لا تقلق، فنحن لم نصل إلى هذه الدرجة من الطفولة بعد. فقط رأينا الحقيقة. حقيقة أن الملك عاري وحقيقة أننا لا نستطيع أن نقول ذلك. وبين الحقيقتين عرضنا أوساخنا، عمداً. كالشحاذين وأطفال الشوارع. عمداً لم نتجمل. كيف نتطيب ونتعطر لعالم يقمع أصواتنا ويهددنا في كل لحظة بالموت صمتاً، أو الموت بإعلان الحقائق؟ عندما يأتي الشحاذ أو طفل الشارع إليك بأوساخه ليطلب منك طعاماً وأنت جالس في مقهى أو في مطعم أمريكاني شهير، يكفيه أن يرى نظرة الذعر في عينيك. الذعر من حقيقته الوسخة، التي أنت لا محالة واحد من أسبابها. نحن نفعل ذلك فيك أيضا عن طريق قصائدنا. وإذ تطرد الشحاذ وطفل الشارع أو توبخه تجده يبتسم، لأنه في اللحظة التي تفعل فيها ذلك يدرك، أنه على حق في كرهك. وأنه محق في أن يمارس عنفا ضدك. هنا فقط يرضى عن نفسه.. وأظننا راضين عن أنفسنا، نحن الشعراء الجدد، المجانين غير الخطرين، راضين، على الأقل للدرجة المصروفة لنا من الرضا في عالم كلنا فيه، قتلة ومقتولين، مطببين وجرحى، كلنا فيه أبناء القاتل بنوة شرعية أو غيرها.
هدى حسين
* * * * *
الـ"تماس" الذي أحيا دهشة صنعها يحيى الطاهر عبدالله
 هل رأى أحدكم الصورة من كل زواياها، هل دققتم فيها...واضح أنكم لم تفعلوا، إذن من أين أتاكم كل ذلك اليقين؟
هل رأى أحدكم الصورة من كل زواياها، هل دققتم فيها...واضح أنكم لم تفعلوا، إذن من أين أتاكم كل ذلك اليقين؟
....................
احتار "أصدقاء الشعر" في تصنيف نص لي عرضت عليهم نشره في مجلة الحائط في كلية الإعلام في جامعة القاهرة. كان ذلك في العام 1984 تقريباً. أنا اعتبرته شعراً، مع أنه كان مختلفاً عما درجت على كتابته مبكراً وقراءته على أصدقاء آخرين قبل أن أدسه في يد ابنة الجيران. هم ارتابوا في النص، خصوصاً عندما لم يجدوه متوافقاً مع أي من البحور والأوزان أو التفعيلات المتعارف عليها، لكنهم نشروه، على أية حال، ودعوني لقراءته خلال أمسية سيحييها فاروق جويدة وعدد من الشعراء من أساتذة كلية دار العلوم... وقد كان.
خلال سنوات الجامعة كان صلاح عبدالصبور وأمل دنقل يتصدران قائمة شعرائي المفضلين، وانضمت إليهما فدوى طوقان. كنت في المرحلة الثانوية أحفظ دواوين فاروق جويدة، إلى أن مللت رتابة إيقاعاته، وفي أجواء تلك المرحلة أيضاً أصابتني مجموعة "أنا وهي وزهور العالم" ليحيى الطاهر عبدالله بدهشة لا تزال تلازمني حتى اليوم، فضلاً عن عوالم السينما التي لا أشك في أنها لعبت دوراً محورياً في تشكيل مخيلتي.
تلت ذلك سنوات عجاف بالنسبة إلى علاقتي بالشعر، قراءة وكتابة، وكانت تلك العلاقة بدأت في طفولتي عبر حاسة السمع من خلال ما كانت تبثه الإذاعة من قصائد مغناة وبرامج تحتفي بالشعر في مقدمتها "لغتنا الجميلة" لفاروق شوشة.
(سيقدر لتلك العلاقة أن تنشط في العام 1999 على نحو مباغت جعلني أشعر بالتحقق من جديد، خصوصاً في ما يتعلق بالاقتراب من أزمتي الذاتية).
(من بين أصدقاء الشعر في الجامعة، واصل السير أحمد بخيت، والسيد حسن الذي أصبح من أميز مقدمي البرامج الثقافية في الإذاعة المصرية، مع تفاوت حظيهما من الشهرة كشاعرين. أما يسري فودة الذي كان يتميز بموهبة لافتة في النظم، فهو اليوم وجه بارز في قناة "الجزيرة" الفضائية، وأيمن الشيوي يستعد لنيل الدكتوراه في المسرح من ايطاليا، ومنى ياسين تتولى منصباً إعلامياً في منظمة الصحة العالمية، ونادية النشار مذيعة مميزة في إذاعة الشباب والرياضة، ومجدي شندي يعمل في صحيفة إماراتية، وأسامة طه جسد شخصية كمال عبد الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ عندما قدمها التلفزيون في مسسل). (زمنياً، أنتمي وهؤلاء إلى جيل الثمانينات الذي سيقدر لي التعرف في ما بعد على عدد من شعرائه عن قرب، بالإضافة إلى شعراء آخرين من مختلف الأجيال).
من دون سابق إنذار، كتبت في أواخر 1999 قصيدة عنوانها "تماس" قرأتها على بطلتها عبر الهاتف. احتفت بها وبي، فانهمر السيل، لكن سرعان ما انقلبت محبتها إلى شئ آخر. على أية حال، غمرتني محبة إبراهيم أصلان وعبدالحميد البرنس وسيد محمود وعبد العزيز موافي وشعبان يوسف وعزمي عبدالوهاب وحسين عبدالبصير وأحمد الشهاوي، وقرر حلمي سالم نشر ثلاثة نصوص في أحد أعداد "أدب ونقد" قبل أن يعرف أنني من كتبها. بعد أربعة أشهر تقريباً اكتمل ديواني الأول الذي أسميته "على سبيل التمويه"، ونشرت دوريات عدة بعض نصوصه، قبل أن يحمله الشاعر الصديق شعبان يوسف إلى الشاعرة سهير المصادفة ليسألها عن مدى إمكانية نشره في سلسلة "كتابات جديدة"، وكانت تولت حديثاً رئاسة تحريرها عقب استقالة الروائي إبراهيم عبدالمجيد. وافقت سهير المصادفة، واقترحت حذف بعض الجمل والمفردات لأسباب "دينية وأخلاقية"، وأفهمتني أنها ليست صاحبة الملاحظات بشأن هذا الاقتراح، ولم أهتم بمعرفة من يكون صاحبها. أخذت بالاقتراح، بعدما تيقنت من أن ذلك لن يؤدي إلى خلل جوهري. كان ذلك في ذروة أزمة رواية "وليمة لأعشاب البحر" التي تفاعلت معها بنص قصير عنوانه "ريش" ولم أضعه ضمن قصائد الديوان لارتباطه المباشر بتلك الأزمة العجيبة.
بعد ذلك بنحو عام تم النشر الذي تزامن مع انطلاق دورة جديدة لمعرض القاهرة للكتاب، وفي العام التالي فوجئت بإعادة نشر الديوان ضمن سلسلة "مكتبة الأسرة".
* * * * * *
في حوار نشرته صحيفة "القدس" التي تصدر من لندن قال شاعر، من دون أن يسميني، إنني اقتبست أسلوبه في رسم "البورتريه" في الجزء الأول من الديوان وعنوانه "وجوه"، مع أنني لم أكن قرأت ديوانه قبل صدور ديواني.
هذا مجرد مثال على مماحكات انتبهت إلى أن البعض يمارسها للفت الانتباه، فالذي أجرى الحوار، وهو أيضاً شاعر، طلب مني أن أرد، ولكنني رفضت. هذان الشاعران، وغيرهما ممن يمارسون العمل الصحافي أو يستفيدان منه، لا يتحرجان من الاستعلاء على الصحافة والصحافيين، حتى أنه إذا أراد أحدهم أن يتطاول على شاعر مهنته الصحافة وصفه بـ"الصحافي" واستكثر الإشارة إليه بوصف "الشاعر"، مع أن موضوع الخلاف يصب في قلب الشعر!
)أرجو ألا أكون خرجت في كل ما سبق عن الحديث حول تجربتي الذاتية مع الشعر). هنا أود أن أقتبس من مقال لصلاح بوسريف نشره أو أعاد نشره موقع ديوان في شهر ابريل 2006 :"إن الشعر اليوم أصبح يكتب بغير ما كان من وسائط ومعايير قديمة. أصبح ينتمي فعلاً إلي حداثة الكتابة، ولم تعد الحداثة مظهراً أو شعاراً، بل إنها، شعرياً، حملت معناها، وصارت ممارسة وتجسداً".
وبعد هذا الاقتباس أود أن اقتبس نصاً آخر لا أعلم على وجه التحديد من هو قائله الأول:"ليس صحيحاً أن شعر اليوم بعيد من القضايا الكبرى، لكن أساليب الطرح اختلفت". أنا بالفعل لا أود التورط في تنظير لا أملك أدواته، وبعيداً من التنظير، فإن من الواضح لكل ذي عينين أن النص الجديد لم يفرز بعد نقاده الذين أتمنى ألا يكونوا من داخل التجربة الإبداعية نفسها، كما حدث في السبعينات. كل ما تحتاجه التجربة هو شجاعة نقدية تتخلص من مقولة :"هناك قصيدة جديدة...ولكن"، وتتخلص كذلك من آفات الأبوية والشللية وصكوك دخول الجنة أو الحرمان من دخولها، وغيرها من آفات شابت تجارب سابقة.
نعم، يتصدر شعراء القصيدة، التي لا هي تفعيلية ولا هي موزونة ومقفاة، راهن التجربة الشعرية المصرية على مستوى إبداع ثلاثة أجيال على الأقل، وهو واقع مشابه للحاصل في العديد من البلدان العربية، إلا أن معظم سدنة النقد ومنح الجوائز لا يعكسون ذلك على الأرض. يحدث ذلك بالنسبة للشعر بالذات، ويحدث عكسه تماماً في ما يتعلق بالإنتاج الروائي والقصصي الجديد، ولا أعتقد أن وراء ذلك أسباباً موضوعية.
على أية حال، ليس وارداً أن أنظر إلى تجربتي الشخصية سوى من منظور ذاتي. هذا أمر بديهي، حتى ولو كان يتعلق بوجود تلك التجربة وسط تجارب أخرى. المهم هو أن تجربتي الشخصية لم تستند إلى موهبة لافتة، ولا إلى محصول وافر من القراءة، أو من التجارب الحياتية، كما هو حال شعراء من جيلي أتمنى كلما قرأتهم لو أني كتبت ما كتبوا. وما أنجزته، بغض النظر عما إذا كان يندرج تحت مسمى "قصيدة النثر"، أو غير ذلك من مسميات، هو شخصي تماماً، بمعنى أن اعتزازي به لا علاقة له سوى بكونه تعبيراً، يرضيني بدرجة ما، عما تختلج به نفسي، وأتمنى أن أظل قادراً على التواصل مع ذاتي، على هذا النحو، إلى أن أموت.
أما بالنسبة إلى مجمل راهن الشعر في مصر، فإنني أرى أنه بخير، بفضل الدماء الجديدة التي جرت في شرايينه ونجحت في تجاوز ما كان سائداً قبل التسعينات. وأود هنا التأكيد على أنني لست ممن يرون أن لا صلة بين القصيدة الجديدة وما سبقها، وأتفق تماماً مع من يلاحظ تأثر شعراء مهمين من أجيال ما قبل التسعينات بنتاج شعراء القصيدة الجديدة، وهذا أمر جيد بما أنه يسهم في الخروج بالشعر من سجن الرتابة شكلاً ومضموناً.
علي عطا
22/5/2006
* * * * * * * *
اللحظة الشعرية المصرية الراهنة
 عندما نتناول اللحظة الشعرية المصرية الراهنة يكون لزاما علينا أن نعود للوراء خمسة عشر عاما، مع بدايات عقد التسعينيات من القرن الماضي الذي شهد مخاضا حقيقيا لقصيدة مصرية جديدة يكتبها عدد كبير من الشعراء في القاهرة والإسكندرية، ويدور بشأنها الجدل والمشاحنات على المقاهي والمنتديات وفى الغرف الضيفة لمجلات وزارة الثقافة التي كان يشرف عليها آنذاك شعراء على المعاش ونقاد على المعاش يبدون واهني الصحة ولكن يشع من عيونهم هذا البريق المخيف الذي يشير إلى التشبث بأشباح السلطة.
عندما نتناول اللحظة الشعرية المصرية الراهنة يكون لزاما علينا أن نعود للوراء خمسة عشر عاما، مع بدايات عقد التسعينيات من القرن الماضي الذي شهد مخاضا حقيقيا لقصيدة مصرية جديدة يكتبها عدد كبير من الشعراء في القاهرة والإسكندرية، ويدور بشأنها الجدل والمشاحنات على المقاهي والمنتديات وفى الغرف الضيفة لمجلات وزارة الثقافة التي كان يشرف عليها آنذاك شعراء على المعاش ونقاد على المعاش يبدون واهني الصحة ولكن يشع من عيونهم هذا البريق المخيف الذي يشير إلى التشبث بأشباح السلطة.
سنوات فليلة وتنشأ منابر مستقلة يصدرها شعراء وكتاب على نفقتهم الخاصة ليعبروا عن قيم جمالية بديلة وليصلوا جسرا مباشرا بين تجربتهم الجديدة والمتمردة وبين تجربة جيل الماستر "الطباعة الذاتية الفقيرة " في السبعينيات. كانت هذه المنابر إذن وفى مقدمتها " الكتابة الأخرى" و"الأربعائيون" هي المعمل الذي شهد تفاعلات القصيدة المصرية الجديدة، أو بمعنى آخر شهد انفجارها. عشرات الشعراء، ارتفع العدد تدريجيا ليتجاوز المئات من الشعراء يكتبون قصيدة النثر المتمردة والطازجة والمجانية أحيانا والركيكة أحيانا أخرى، بعضهم يكتب بجماليات قصيدة سابقة وبعضهم يكتب حالما بقيم جمالية جديدة والبعض يكتب كنوع من التعويض الاجتماعي والسياسي وحتى الجنسي، لكنهم جميعا يشكلون جيشا جرارا جميلا ويعدون بغد إبداعي مغاير. وسرعان ما تعثرت " الأربعائيون " في الوقت الذي واصلت " الكتابة الأخرى لعشر سنوات متواصلة ترافق معها عديد من المجلات غير
الدورية التي لم يمتلك القائمون على إصدارها مهارة هشام قشطة الذي استطاع استقطاب عدد مضمون من الأدباء والمثقفين كممولين مستمرين لمجلته، وكان من بين المجلات التي صدرت وتعثرت مجلة " شعر " التي كانت الأولى الموقوفة على قصيدة النثر وتقاطعاتها وكنت ومعي عدد من الشعراء الشباب العرب نحررها في طبعتين ورقية وإلكترونية، لكن سرعان ما صدق حدس الشاعر قاسم حداد الذي أخبرني أن التجارب النوعية مثل " شعر " سرعان ما تتوقف لأسباب لا علافة لها بالإبداع ودعاني إلى العمل على نشرها إلكترونيا وها نحن بالفعل نعمل بنصيحته مكتفين بإصدار العدد الرابع منها إلكترونيا فقط.
بعد خمسة عشر عاما من انطلاق الموجة الكبرى للقصيدة المصرية الجديدة يمكننا أن نلاحظ الآتي:
ـ أن القصيدة النثرية المصرية الجديدة سرعان ما احتلت المتن الشعري المصري وأزاحت الأصوات التي كانت تشكل فيما مضى هذا المتن إلى الهوامش، أو في أحسن تقدير إلى تنويعات معدودة بثلاثة أو أربعة شعراء على هذا المتن.
ـ أن القصيدة النثرية المصرية الجديدة أصبحت تشكل رافدا غنيا من روافد الشعر العربي الحديث على مستوى الكم والكيف، بل ويمكننا القول دون مبالغة أو شوفينية أن القاهرة تحتضن الآن المشهد الشعري العربي الأغنى والأجد
ـ الموجة الشعرية المصرية الحديثة من الضخامة بحيث تضم ـ دون مبالغة ـ مئات الشعراء ، ومثل هذا العدد الضخم من الشعراء ليس كله جيدا متمايزا في تجربته وليس معظمه وليس إلا أقله القليل من قدم جهدا خلاقا ينضاف إلى مسار الفصيدة العربية الحديثة وهذا شيء طبيعي لكنه يولد التباسا مغلوطا لدى كثير من المتابعين المشغولين ـ على هدى المخبرين التقليديين ـ بتتبع التشابه والتكرار والمجانية والركاكة والخيال الفقير في هذا الرافد العريض المسمى بالقصيدة المصرية الجديدة وهو ما يجرنا إلى محنة النقد الأدبي في مصر
ـ بدل أن يرتفع النقد الأدبي في مصر إلى مستوى التجربة الشعرية الخلوالإبداع،ايزة والتي تحققت خلال الخمس عشرة سنة الماضية عبر متابعة وتقصى الأعمدة الرئيسية في هذه التجربة والانطلاق من أن الشعر فردى مثل البصمة مثل تجربة الموت ، ينطلقون من التعميم السهل أو المقارنات التقليدية الممجوجة بين الجيل الحالي والأجيال السابقة أو بين القصيدة الحالية والقصيدة السابقة وبعضهم ما زال أسيرا للعبارات المحفوظة البالية حول صعوبة انتساب قصيدة النثر إلى الشعر العربي لتخليها عن العروض ، هذا بالإضافة إلى الضعف الشديد للدرس الأكاديمي في كليات الآداب وفى أقسام اللغة العربية والذي ينتج مسوخا متمسكة بالرطانة غير المفهومة وهى تلوى أعناقها إلى الوراء وتلوك جملا غير مترابطة من النقد العربي القديم فيما يشبه المحفوظات المدرسية تنال عليها إجازات علمية باهتة وتؤكد مناخ الغباء والإسفاف الذي يبدأ وينتهي بغياب حرية الرأي والتعبير والإبداع . من هنا عز أن نرى نقادا مفكرين أصحاب وجهات نظر وفلسفة تجاه العالم والإبداع ،تتفق أو تختلف معها ، إن هم إلا ببغاوات فارغة من كل حس أو روح أو بصيرة ، وهم جزء صادق معبر عن واقع الحياة الفكرية المصرية والعربية .ومثل هؤلاء لابد وأن يؤجلوا عملية الفرز والغربلة للمشهد الشعري المتكثّر والعارم والمضطرب، بدل أن يكونوا حملة رايات الإرشاد، المساهمين في بلورة التجارب الخلافة بالجدل معها وإضاءتها.
ـ بالنسبة لتجربتي ، فإنني أراها مثل كتلة الثلج العائمة ، ماظهر منها حتى الآن الجزء الأصغر منها ، فقد صدر لي أربعة دواوين هي: استئناس الفراغ 1993 ، بين رجفة وأخرى 1996 ، باتجاه ليلنا الأصلي 1997 ، فتاة وصبى في المدافن 1999، ولى أربعة دواوين تحت الطبع منها ديوان منشور نشرا إلكترونيا على موقعي جهة الشعر وقصيدة النثر المصرية ، بعنوان: مريم المرحة.
وإذا جاز لي أن أتحدث عن تجربتي وسط الشعرية المصرية الجديدة، فإنني أفترض أن الإنسان وتجربته القصوى في الحياة هي ما يمثل منجم الشعرية عندي، ولذلك فإنني أشحذ حواسي بالمعنى الطبيعي البدائي حتى أكون جاهزا لاستقبال الإشارات الشعرية المتدافعة من حولي والتي تدوّم في رأسي طوال الوقت . الشعر يبدأ وينتهي بالإنسان ويشترط الجاهزية لاستقباله عبر أمور عدة منها ، بالنسبة لي، الاقتراب من كل ما هو طبيعي وبدائي ومنها الوعي بتاريخ النوع الأدبي، أي الشعر العربي وموضعي من مراحله وتطوراته، ومنها علاقتي بالأداة اللغوية وانحيازي إلى أداء معين ضمنها، ومنها نفى فكرة النمط الواحد للقصيدة ، انطلاقا من حرية القصيدة في العثور على تشكلها وقانونها.
كريم عبد السلام
* * * * * * *
شعرية الوعي الضدي
 ربما كانت البداية للشعر أو للفن بشكل عام هي وجود حالة من عدم الرضا عن العالم, تلك البداية التي تقترن دائما بدرجة عالية من الوعي بالذات, ذلك الوعي الذي غالبا ما يقود صاحبه إلى جحيم ابدي حين يجعله يمتلك حساسية مختلفة فيرى ما لا يراه الآخرون,عندما تدركه تلك الرغبة المخيفة في اكتشاف العالم من حوله, والهواجس التي تنخر في الرأس, ولا تهدأ عادة إلا بالموت.تلك الهواجس التي أرقت الكثير من الشعراء ومنهم طرفة بن العبد الذي قال بيته الجميل
ربما كانت البداية للشعر أو للفن بشكل عام هي وجود حالة من عدم الرضا عن العالم, تلك البداية التي تقترن دائما بدرجة عالية من الوعي بالذات, ذلك الوعي الذي غالبا ما يقود صاحبه إلى جحيم ابدي حين يجعله يمتلك حساسية مختلفة فيرى ما لا يراه الآخرون,عندما تدركه تلك الرغبة المخيفة في اكتشاف العالم من حوله, والهواجس التي تنخر في الرأس, ولا تهدأ عادة إلا بالموت.تلك الهواجس التي أرقت الكثير من الشعراء ومنهم طرفة بن العبد الذي قال بيته الجميل
أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة
وما تنقص الأيام والدهر ينفد
وفي وسط هذا الحصار الكئيب والصحراء الممتدة والعدم الذي لا أول له ولا آخر,لا يجد الإنسان أو المبدع مخرجا سوى ان يبحث عن منقذ,وجود بدائل يجعل الحياة ممكنة فلا يجد سوى الكتابة وحدها ليحتمي بها ويهرب اليها وليعبر من خلالها عن خلافه مع العالم وهو يعلم ان الكتابة لن تحسم شيئا من هذه الخلافات.
الأبدية. فيعيش من خلالها حيوات متعددة ويموت فيها أيضا ميتات متعددة.
تصحبه الحيرة والقلق والتعاسة, تلك التعاسة التي أدركت الحكيم بوذا في القرن الخامس قبل الميلاد، ذلك الأمير الذي نشا منعما في أسرة ملكية لكنه ما ان خرج من قصره الفخم وشاهد لأول مرة في حياته أشخاصا تجلت فيهم أثار الزمن من فقر ومرض وشيخوخة وموت حتى أطلق صرخته
(أرى في كل مكان اثر التغيير، لهذا اغتم قلبي، يهرم الناس ويمرضون، ويموتون، أليس هذا كافيا لهدم كل رغبة في الحياة).
اعتقد أيضا ان الشعر بالنسبة للشعر هو إحدى الطرق التي تساعده على رؤية العالم جيدا وعلى اكتشاف ذاته بكل ما تنطوي عليه من جمال أو قبح. كذلك اكتشاف علاقته بالآخر التي تبدو للوهلة الأولى أكثر تعقيدا وتركيبا مما نتخيل، كما يطرح الشاعر في قصيدته الأسئلة الوجودية التي تؤرقه,والشعر بهذا المعنى يعد طريقا للمعرفة ,وتحقيقا لمبدأ سقراط الشهير(اعرف تفسك)
ربما بهذا التصور نفسه كتبت ديواني الاول(كائن خرافي غايته الثرثرة) وكان أيضا احد الأسباب الرئيسة لاختياري قصيدة النثر ,تلك القصيدة المتمردة بطبيعتها على الأعراف والتقاليد السائدة والتي تعد تجسيدا حيا لتماهي الحدود والفواصل بين الأجناس الأدبية.واعتقد ان كثيرين من أبناء جيلي الذين يكتبونها وجدوا فيها مثلما وجدت –انها أكثر قدرة من الأشكال الشعرية الأخرى على التعبير عن اللحظة الزمنية التي يعيشونها ,تلك اللحظة التي تتسم بالغموض والقلق , والتي تتفكك فيها كل المفاهيم والنظريات التي سادت العالم طويلا.
وفي تصوري ان قصيدة النثر –تحديدا- تحتاج وعيا مختلفا عن الوعي الذي يكتب قصيدة التفعيلة أو القصيدة العمودية. فهي قصيدة تحتاج إلى وعي ضدي ,لعل ابرز سمات هذا الوعي هو انه ينقسم على نفسه باستمرار, مما يعني انه يظل وعيا متوترا,فيجعل صاحبه يضع نفسه وتصوراته وأفكاره وقصيدته أيضا موضع التساؤل الدائم,ليخرج من اسر المفاهيم الضيقة التي تكبل الوعي وتقف حائلا ورؤية المتناقضات التي تقوم عليها بنية الوجود كله. فشاعر قصيدة النثر مضطر حينما يكتب ل(( إعادة تقييم كل القيم)) .
واعتقد انه ليس من قبيل المصادفة ان كثير من قصائد النثر الآن وخاصة ((القصيدة التسعينية)) تقوم بنيتها على المفارقة الساخرة الباردة التي تعكس عدمية ما تكمن وراء فعل الكتابة ,وتضرب ذلك التصور القديم عن الشاعر بأنه ذلك النبي الذي يمتلك اليقين ويعرف الحقيقة المطلقة عن العالم.
وفي تصوري أيضا ان قصيدة النثر الحقيقة أصعب في كتابتها عند الذين يعرفون الفرق بين قصيدة النثر وغيرها من الأشكال الشعرية الأخرى ويستبعدون مفهوم البعض عن الشعر بأنه ((ذلك الكلام الموزون الذي يدل على معنى)) لان قصيدة النثر تحتاج لان تحقق أعلى درجة من الكثافة الشعرية داخل القصيدة,لتعوض قارئها غيبة الإيقاع الخارجي الذي اعتاده قراء الشعر في الماضي.
ورغم اعترافي أننا كجيل تجمعنا لحظة تاريخية واحدة وهموم مشتركة أحيانا إلا ان هذا لا يعني أننا متشابهون.
أو أننا تكتب قصيدة واحدة, بل على العكس ما يفرقنا في طريقة الكتابة أكثر مما يجمعنا.
لكن من المؤكد ان جيلنا لا يكترث بالنقد كثيرا الذي يبدو متخلفا عن الحركة الشعرية الجديدة. فلا تكاد نرى سوى بعض الكتابات الباهتة التي تكتب عن الشعراء الجدد بعقول قديمة أو كتابات أخرى سريعة تغلب عليها الانطباعية.
نجاة علي
* * * * * *
أرض جديدة
الجدل البيروقراطي لابد وأنه أصبح ضعيفاً من حيث أن هناك قصيدة نثر أم لا، بدليل أن كثيرين ممن يكتبون شعراً الآن لا يكتبون إلا نثراً، وكثيرين ممن كانوا يكتبون التفعيلة تحولوا عنها إلى قصيدة النثر
هذه تُحسب لقصيدة النثر، لكن الذي أود أن أشير إليه أن الجدل هذا شابه بعض اللبس، حيث يعتبر من يعتبر أن قصيدة التفعيلة تطور للشعر العمودي وقصيدة النثر تطور لشعر التفعيلة، وهذا ما أراه معيقا حيث أن قصيدة النثر كونها ذاتية فهي جنس لا يتبع إلاّ نفسه كما أنه لا يجب أن تكون لها مرجعية غير مرجعية كاتبها وإلا سيحدث لها نوع من التعليب المؤسساتي الذي جعل من شعر العمود والتفعيلة واجهة إحتفالية ليس إلاَّ، فليس من مهام قصيدة النثر أن تكون جماهيرية بالمعنى الذي يطارد قصيدة التفعيلة ويكاد يجعلها تتماهى مع البورنو كليب
فلتكن غير شرعية، لتكن بلا جذور أو لقيطة، ولا أجد مبررا لبحث الكثيرين لها عن أب
فلتكن بلا حراسة، فليست هي نظرية علمية في الفلزات ولا في اللسانيات بحيث لا تنطلق إلا من مقدس ( معرفي ) يضفي عليها ماهيتها
يقينها الحرية الداخلية لكاتبها وتضيق ضرعاً بأهل البيت،
والمربي والمدرسة
نعم لا أعرفها، لكن أتعثر فيها وأحبها لأنها غير متاحة إلا في المناطق التي لاتملك اليقين
ليست لها هندسة ولا يتدرب عليها أحد، كما أنها لاتتطور إلا بقدر تطور وعي كاتبها لأنها لاتستفيد من النصيحة.
ليس لها أرشيف يمكن الرجوع إليه بل هي بيت بلا جدران
ولا تجد من يصفق لها في الحفل، لذلك لايجب أن تفكر في الاستقرار.
لا تعترف بأن العقوق صفة غير أخلاقية بل تعتبره مثل أعراض الحب والتدخين.
* * *
ولأن الفن في الأساس فردي، فقصيدة النثر لايجب أن تُطرِق السمع للأعلام إلا بقدر تحرره من كارثية الأنماط
طبعا مشهد قصيدة النثر - في رأيي - صاخب وثري ومن يرى غير ذلك يكون إما متحاملاً أو يشتكي من شيء غير الشعر
لماذا صاخب وثري؟
لأنها قضية تعدد أصوات تحدث ليس على مرجعية واحدة ولا نمط واحد، مجموعة ذوات تتوتر في فضاء الشعر، وهذه الأصوات لايجمعها مفهوم واحد عن الشعر مثلما يحدث في الغالب عند الكثير من شعر التفعيلة.
وبالتأكيد، هناك مآزق وليس مأزق واحد أمام هذا الصخب، أذكر منها:
1- المفهوم
فمفهوم الشعري من اللا شعري عند كثير من الكتاب ناهيك عن القراء- إن وُجدوا - مازال مفهوماً نمطياً يستمد وعيه من مرجعية لاتخضع حتى لإعادة النظر
هنا نتفاجأ بما يشبه المقدس عن مفهوم الشعر وحتى عن الذات الشاعرة وهذا يدعوني لطرح نموذج المتنبي مثلا حيث أن الذات والموضوع عنده لا تناسب قصيدة النثر ومن هنا لايستطيع المرء أن يصاب بالصدمة لو وجد أن شاعراً يكتب قصيدة نثر لا يستطيع أن ينسجم مع المتنبي - مع التقدير طبعا لعبقريته وموهبته وعظمته - أو ليس على المرء أن ينتظر أنه لو كان المتنبي بيننا سينسجم مع من يكتبون النثر
هنا يبدو الأمر كما لو كان قطيعة بين شيئين، ربما، ولكن هذا يثير جدلا كبيرا وهو مايلزم للحياة أن تُعاش.
فما بالك بالقراء!
أعتقد أن القارئ مازال ملبوسا بمفهوم واحد للشعر والشاعر وليس لديه استعداد للتعامل مع قصيدة النثر إلا باعتبارها شيئا ممنوعا أو مهربا أو غير شرعي وهذا يجب أن لاتنزعج منه قصيدة النثر فهو حقيقي وغير جائر
2- الريادة
تبدو قصيدة النثر كونها فضاء جديدا للكتابة مثارا لشهية الريادة وهو مايفصلها عن ماهيتها إذ أن مفهوم الريادة في رأيي لايناسبها حيث أنها يجب أن لا تعيد إنتاج مارفضته
فالشعر هنا والذات الشاعرة لاتخضع إلا لمفهوم الجمال، وكما تراه، بصرف النظر إن كان مريحاً حتى للذوات الأخرى التي تتحرك في فضائها
فوثنيتها تضايق كل الآلهة، وكل بطريرك يحاول غزوها سيجد أنه ليس إلا شرطي مرور في شوارع ليس لها إتجاهات.
3- النقد
أعتقد أن النقد تابع للأعلام وهذا يضعفه
لأنه تحول إلى شكل من أشكال الإعلان الصحفي
والناقد مازال يحيل كل شيء إلى قواعد يمارسها على فنون الشعر جميعا وبذلك يبدو كموظف أوقاف يدرس علم الفيزياء
لذلك أعتقد بأن عددا غير قليل من شعراء النثر عليهم أن يهتموا بالنقد حيث أن ناقدها لابد أن يكون متورطا في النسق وليس طارئا عليه، على الأقل يضمنوا عدم إحالتها لأبي تمام.
الناقد يغامر في المعروف فقط ويدعي غير هذا في حين أنه مشغول بأهل البيت والوطن والملتيميديا التي خذلت الجميع.
أعتقد أن قصيدة النثر أرض جديدة ومغرية للمغامرة معها
لكن لن يحدث ذلك إلا من داخلها
4_ المتلقي
كتاب قصيدة النثر لاينزعجون من غياب المتلقي، وحتى عندما يوجد هذا المزعوم لايكون همه إلا مطابقتهم على الأنماط الشعرية الأخرى ، لذا ، لايمكن إنكار هامشيتها وتهميشها وهذا يجعلها طاقة غير مستعملة
يجب أن نسعد بذلك
* * *
المشهد الشعري لقصيدة النثر صاخب وثري، لكنه ضعيف لكونه لم ينتج جنرالات !
* * *
يجب أن ننتهي من رطانات كثيرة وكذلك ما يسمى بالرواد وكذلك الإعلاميون الذين تحولوا إلى شعراء والعكس.
فقد جاء إلى قصيدة النثر تفعيليون ينشدون نثرا، وشعراء عامية وجدوها سهلة
جاء تعبيريون وقصاصون تحت مانشيت اليومي فسقط الشعر
جاء كناسون فتمسكوا بالزبالة
جاء مدرسيون ولجموها باللغة
جاء إليها بورنوبنات
جاء محنكون، وتجار قايضوا عليها
كتبها كثيرون هندسيا، فاضطروا لشراء نماذج
لكن هناك هامشيون لهم طاقات شعرية تتفجر دائما بشكل حر وتستطيع إعلان الشعر.
* * *
الحرب حالة مخيفة، لكن أعتقد أن كل الحضارات احتاجت إليها، أما التماهي فيجلب العار، فالآخر لا يقبل اختلافك معه، إنه لا يقبل إلا التماهي.
الشعر في بلادنا غير حر.
أحمد السواركة
* * * * * * *
أعيش في رئة الكلام ...*
أنتظر عطسة كي أخرج
... عانت قصيدة النثر- ولا زالت تعاني من ممارسات نقاد مسرفين يريدون أن يدخلوها بيت القاصرات، لتصبح منزوعة الأهلية، وفي نفس الوقت يدعون إلى استكناه جماليات جديدة، معتبرين الخرق غير الواعي للتابو الجنسي خاصة والديني من قبيـل ابتداع شيء جديد، أو حتى السياسي وعانت القصيدة في المقابل من براثن تيار متأصل ربما في العقلية العـربية رافض لكل جديد يرى في القديم قدسية لمجرد وجود فاصل زمني، رجمت القصيدة إذن من منظور هذا الاتجاه، واتهم شعراؤها بالضعف، وقد عزز من ذلك أن عددا غير قليل ممن ينتسبون للقصيدة الجديـدة كانوا يتعثرون في أبسط القواعد اللغوية والصرفية والنحوية علاوة على ارتباك الصياغة، جرهم إلى ذلك اندفاعهم للجديد فعميت أبصارهم عن أبسط حقوق القصيدة وهي السلامة اللغوية.
من جهة أخرى كانت هناك مطالبة جادة للشعراء، لكي يقدموا خلقا حقيقيا لجمالياتهم المزعومة حتى يتفردوا بها كما تفرد الشعراء المبدعين للقصيدة التفعيلية (وهم بالمناسبة تحصيهم أصابع اليدين بالكاد ) كانت هذه المطالبة- لقصيدة تستعصي أصلا على التأطير كانت بمثابة إيلاج للجمل في سم الخياط، بدا حينئذ شعراء النثر وكأنهم يهيمون في كل واد يريدون ابتعاث كائن من الرماد. في هذه الظروف الغامضة منحت الفرصة علي طبق من ورق لعدد من شعراء القديم أن يعيدوا ابتعاث الإطار الفني القديم مع إكسابه روح النص الجديد، فبدوا كمن يضع دشا على سطح بيت من البوص، كمن يرتدي الصدار البلدي تحت البذلة ( بمعناها المشاع وليس بمعناها المعجمي ) والغريب أن بعضهم لاقى نجاحا، بالنسبة لي كان الأمر شاقا حيث كنت قد خالطت بعض شعراء النثر الذين سبقت تجربتهم تجربتي، وتأكدت من صدق موهبتهم لكن ظلت المعضلة تحوط القصيدة
معضلة عدم اقتناع القارئ العربي البسيط بها
ومعضلة استيراد نقد غربي كان يراد له أن يفرض فرضا
ومعضلة أقوال بعض الشعراء أنفسهم بكلام يبدو مقنعا لكنه غثاء: "علينا أن ندخل القصيدة، ونحن غير متسلحين، ونكتشف شكل النص حين الكتابة كلام رائع، ولكن كيف نتأكد من حدوث ذلك يقينا أم أنها أقوال مرسلة".
ومعضلة التشابه المقيت بين عدد غير قليل من الشعراء بحيث لو محي اسم القائل لم تنسب القصيدة لأحد، وكأننا بصدد إرث شعبي مجهول المصدر، ومعضلة أشد صعوبة وهي خفوت الجانب الموسيقي، واغتيال الطرائق المعتادة في التخييل عمدا بحجة أنها خروج عن الإطار الجمالي المتوهم للنص الجديدة،و افترض أنك متميز أصلا في طرائق معينة في التعبير؛ فهل تترك ما يميزك من أجل مجرد فكرة لم يستدل على نجاعتها ؟ أم أن الشعراء محدودي الموهبة يريدون أن يجروا الشعراء الموهوبين إلى نقطة خالية تماما من الثوابت،إن الشعر كما يحتاج للمغامرة ، وما يمثل ذلك من متعة هائلة تناسب حالة الإبداع ، فلا يمكن له أن يظل دائما في بحر هائج العواصف ، إنه يحتاج لمرفأ ولو مؤقت حتى ينطلق مشحونا بالمغامرة من جديد ،يكتب الشاعر نفسه (هذا ما يهم) في السكون والحركة ، في العزلة والضجيج ،ولا يمكن أن يموت المتلقي الواعي الحصيف أو يذهب إلى الجحيم ،ولا يمكن أن يكون الشاعر ديناصورا هائجا يدمر كل شيء ، ولا يعد بأي شيء ،هل يصبح الشاعر عاصفة لا تحمل بذور الإبداع عاصفة فقط؟ فلماذا إذن ننشر أشعارنا وقد فقدنا نقطة تواصل مهمة مع المتلـقي؟
عانيت إذن في وسط هذه التيارات المتجاذبة وكنت قد أصدرت ديواني الأول والوحيد حتى الآن "أكثر مرحا مما تظن"
وصدمت من التجاهل رغم احتفاء جريدة أخبار الأدب به، وما قاله لي الروائي جمال الغيطاني وقتها: ستكون شاعرا كبيرا "وما قام به الدكتور محمد عناني من ترجمة لبعض نصوصي.
آنذاك أو قبلها بقليل، لا أذكر ردت عليَّ مجلة الشعر في قسم البريد عابت ما عابت، وأشادت بما أشادت رغم أنني أصلا لم أرسل لهم شيئا للنشر، بعدها أرسِلَ لي أنشر إبداعي على صفحاتهم فأعرضت، (أذكر أنني داعبتهم مداعبة لا يناسب المقام الآن البوح بها)
اهتمت أدب ونقد بشعري آنذاك ونشرت بعضه بينما قصيدتي التي زعِمَ أنني أرسلتها إلى الشعر نشرها الشاعر/ حلمي سالم في إضاءة 77 عدد العودة دون علمي فشعرت بقدر من الرضا، أيضا نشر نفس القصيدة الناقد أمجد ريان في نشرة الخطاب الهامشي.
ومن الإحباطات ما قامت به الدكتورة سهير المصادفة، وكانت رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بإهمال لديواني الذي قدمته لها من أجل أن يحصل على دور في السلسلة مر أربع أو خمس سنوات والديوان لم ير النور بالطبع الأسباب قد تكون معروفة لكم...
... كانت الأمور في المحلة الكبرى والغربية عموما لا تسير على ما يرام (باستثناء هذا الجيل المبدع الذي ظل يكبر طموحه أمام عيني جيل سيكون عنه حديث تفصيلي، ويضم كوكبة من أدباء حقيقيين : د/محمد طلبة ، د/محمد داوود، الشاعر/ ياسين محمد عبده ، الشاعر/ صالح غازي ، القاص عمرو النوساني ، ...وغيرهم كثير) كانت الأمور لا تسير على ما يرام، وكنت أعاني معاناة كبيرة في عرض أي نص لي، كان شبه اتفاق على تحجيمي
اكتفيت وقتها بعرض النصوص الجديدة على الأصدقاء فرادى ، ثم كانت القشة التي قصمت ظهر البكاء حيث، وفي مرسم الفنان أحمد الجنايني، وفي حضور عدد من أدباء الإقليم تعرضت لهجوم مبرح وقاس حيث أخرجني الروائي جار النبي الحلو من دائرة الشعراء نهائيا واعتبرني قاصا...في حوار مسجل عندي سيخرج في حينه،
حين كتبت قصيدة النثر في منتصف التسعينيات تقريبا كانت المحلة لا تدري شيئا عن هذا الأمر وتعرضت لأقصى ما يتعرض له مبدع وكانت الأمور غير متزنة إذ أنه بعد ندوات عقدت لهذا الأمر شاعت الأفكار الجديدة التي بالطبع لم أكن منظرها وبدأ عدد من الشعراء يدخلون إلى التيار الجديد في أغرب ظاهرة رأيتها في حياتي وتخلوا عن إبداعهم القديم تماما (لا أسجل ذلك حتى ادعي ريادة مزعومة ولكن أقص شيئا حدث) والغريب أنهم ظلوا يحاربونني أيضا هؤلاء أنفسهم الذين انقلبوا إلى النثر! وكانوا يكتبون أنماطا اشد هدرا لقيم الشعر من أي أحد.
من الطعنات مثلا في مؤتمر أدباء الغربية يتم حذف ملف كامل عني من كتاب المؤتمر بعنوان "ما بعد الحداثة إيهاب خليفة نموذجا " للأستاذ /أحمد عزت سليم بلا سبب سوى التحجيم كان طبيعيا أن يصرخ القاص محمد عبد الحافظ في نفس المؤتمر قائلا إيهاب أحق الأدباء بتخصيص ندوة مستقلة ولكن ذهب صوته أدراج الرياح، من جانب آخر اكتملت المأساة حين فازت قصيدتي "بيوت ناتئة" وهي من الشعر التفعيلي بجائزة أدبية في مسابقة نظمتها مجلة النصر العسكرية بالاشتراك مع جريدة أخبار الأدب وفوجئت بكوكبة من كبار النقاد والأدباء في التكريم د/ جابر عصفور، د/سمير سرحان، الشاعر حسن طلب، الشاعر فاروق شوشة، د / صلاح فضل، د/ حامد عمار، د مدحت الجيار وغيرهم ولعل المكسب الوحيد في هذا اليوم هو أنهم شهدوا بما امتلك من موهبة وبتمكني من الكتابة التفعيلية.
في القاهرة كان المشهد أكثر إشراقا وأقل سوادا حيث ساندني عدد من المبدعين بالتأييد والنشر لكنني شعرت بالألم لما وجدت أن إبداعاتنا تلتقي في نقاط كثيرة و كان علي أن أضع بصمتي شديدة الخصوصية في شعري لذا خضت صراعا هائلا مع المفاهيم التي شابت قصيدة النثر وكانت مثل حذاء من الحديد يعرقل طيرانها إلى آفاق بعيدة بل ويشدها دائما إلى الوراء
إن قصيدة النثر أشبه ببركان كان خاملا، ثم تفجر في مدينة تكتظ بالسكان، قبلها كان مدعو الأدب يستحمون في البحيرات الدافئة التي تستخدم كأماكن علاجية؛ فهم يعتبرون الأدب مجرد عملية تطهير، وفي غفوتهم هذه ثار بركان النثر ملقيا حممه التي دفنت حياة كاملة تحتها، حياة كانت أسست استقرارها على شفا الاحتمالات، الإرهاصات الأولى للقصيدة أشبه بما خلفه البركان من معادن مختلطة وتربة خصبة، القصائد الأولى التقطت أشياءها من مخلفات البركان كما هي، لذا ظلت تجمع في ثناياها حس البكارة والثورة كانت اقل جمالا وأكثر اقتحاما؛ لذا تم الاستهانة بها بعدها شيئا فشيئا جمدت مخلفات البركان، وأصبح على المبدع الحقيقي أن يعيد ترتيب المشهد، وينقيه من الشوائب فالغث والثمين كانا معا أول الأمر، كان ثمة مسوغ آنذاك، لا يوجد مسوغ الآن لأي استهانة بالإبداع
إننا نشكر البركان الذي أخرج لنا أرضا خصبة جديدة، لنغرس نبتة النثر فيها لأن نبتة النثر لا تنبت إلا في بوح البراكين،
إننا نشكر البركان الذي أهدر حدائق كانت مزدهرة بالوهم، وأفنى ممالك الجلبة
والضجيج، إننا نشكر البركان الذي جعلنا مستعدين دوما لثورته،
معنا بيوتنا المحمولة التي سنحملها عند أي ثوران مفاجئ له، وليحذر شعراء القصيدة الجديدة فالبركان الذي أظهرهم قد يكون هو نفسه الذي سيغتال ممالكهم إذا أصابها العطب، ولم يأخذوا الإبداع بجدية، ولم يقدموا البدائل الجمالية التي تكشف عن مواهبهم الجادة، وأخيرا...
استمري أيتها البراكين في الثورة بين حين وآخر، لعل ذلك يكون في مصلحة الشعر، الشعر الذي هو أهم من الجميع، الشعر الذي يدعون أن عصره ولى، الشعر تلك الكلمة الخالدة التي من أجلها خلقت اللغة...
* مجرد فضفضة ولا نقصد الإساءة إلى أحد
إيهاب خليفة
* * * * *
* * * * *
 أحيانا ما يشعر الإنسان المتكلم أن لغته، اللغة المتبادلة، أصبحت ذات وظيفة أحادية، وهى بالقطع لحظات حسيرة وكئيبة تستحق أن ننعتها بأبشع النعوت لكن هذه الحقيقة المولودة من رحم الألم أو من رحم هذه الأحادية على وجه التحديد، ربما كانت اقرب الصفات التي يمكننا أن نُخرج بها هذه الأحادية من تجريديتها لنقول : ثمة لغة أحادية وظيفتها القهر . ومع اعتقادي بصحة هذه الهلوسات أؤكد أن هذه الحرفة سبقنا أليها رواد أوائل وكتب صفراء وعقول كلّت من كثرة التعسف فهؤلاء الذين شهدوا على خوفهم فهموا الأمر على أن اللغة سلطان لا يأتيه الباطل، وكيف يأتيه إذن ؟ وهو ربيب المقدس الذي لايني أن يفوته شيء.
أحيانا ما يشعر الإنسان المتكلم أن لغته، اللغة المتبادلة، أصبحت ذات وظيفة أحادية، وهى بالقطع لحظات حسيرة وكئيبة تستحق أن ننعتها بأبشع النعوت لكن هذه الحقيقة المولودة من رحم الألم أو من رحم هذه الأحادية على وجه التحديد، ربما كانت اقرب الصفات التي يمكننا أن نُخرج بها هذه الأحادية من تجريديتها لنقول : ثمة لغة أحادية وظيفتها القهر . ومع اعتقادي بصحة هذه الهلوسات أؤكد أن هذه الحرفة سبقنا أليها رواد أوائل وكتب صفراء وعقول كلّت من كثرة التعسف فهؤلاء الذين شهدوا على خوفهم فهموا الأمر على أن اللغة سلطان لا يأتيه الباطل، وكيف يأتيه إذن ؟ وهو ربيب المقدس الذي لايني أن يفوته شيء.
اللغة بهذا المعنى تحولت إلى شيء أصغر من حاجات الناس فهي في المنطق المعكوس مسخرة لأفقهم المحدود واحتياجاتهم وصناعتهم وحرفتهم كما يرى الدكتور مصطفى ناصف، "وربما من هذا الباب أصبح قهر أصحاب الحرفة مألوفا فـ الحكام يقهرون الناس والمناطقة يخيفونهم والشعراء يفعلون ما هو أسوا".
فالذين استقر بهم الحال واطمأنوا يدافعون عن هذه الطمأنينة ولو بقوة السلاح، إن لم يسعفهم اللسان، ويرون النص المختلف أو النص الذي ينشد الاختلاف مارقا يستحق الكثير من النعوت التي ربما صرفته من إطار النوع الذي ينتسب إليه.
وربما لا يجد الإنسان أهمية كبرى ـ في مثل هذه الظروف ـ للتلاسن المتبادل حول الشعرية الجديدة، ليس لأنها لا تستحق عناء هذا التلاسن، ولكن لأنني اعتقدت ـ لبعض الوقت ـ أن شعرية ما بعد الريادة أنجزت بعض ما يدفع عنها هذه الشرور التي يلقيها عابرو السبيل حتى ولو لم يفهموا شيئا من الآمر برمته. وكنت ومازلت أعتقد أن النص نفسه قادر على القيام بهذه المهمة بأفضل مما يمكن أن يقوم به صاحبه، الذي قد يقع أيضا أسيرا لصلافة ما، مدفوعا برغبات جامحة وربما مكذوبة ودعية ـ حول التجديد والتجاوز والنفي وما إلى ذلك من مهاترات. واعتقد أن محاولة القبض على إطار عام يقدم الشعرية الجديدة لناقدها على طبق من ذهب، أمر في غاية الصعوبة، لأن ثمة مواصفات رديئة وغبية صاحبت انطلاق هذه الشعرية، لاسيما قصيدة النثر التي حازت اللغط واللبس الأكبر في هذا المضمار. وربما كان الدافع الوحيد وراء إشاعة النمط والتأكيد على ملامحه المجتزأة يهدف فقط إلى التكريس للشرعية بأسرع وقت ممكن. وأظن أن هؤلاء الذين حازوا شرعية مبكرة كانوا أكثر طواعية وانضواء تحت راية النمط وكانوا ـ بالتالي ـ هم الأسرع خروجا من جنة هذه المشروعية الزائفة وفى جميع الحالات يجب على الشاعر أن يدافع عن إرثه الخاص وعن ملامحه الخاصة أمام الحرية البالغة والخطيرة التي أتاحتها قصيدة النثر لعابرين غير محصورين، أو هكذا يجب أن نتعلم الدرس الذي دفعت إليه هذه المشاعية الكلية.
ومن هنا يبدو فعل التمرد على معطيات الداخل والخارج أمرا يعادل في أهميته التثبت بالمستقبل ومقولاته الغامضة الغاضبة. فالفعل الإبداعي الجامح لمجنون عاش يعتقد أن موضوعه هو صياغة علاقة ذات أفق مفتوح للتمرد على الله كان بمثابة إشارة أولى من " لوتريامون " تلتها إشارات متعددة لكل المشغولين بصناعة وتوليف الإرادات المضادة كفعل بديل للتشيؤ.
ربما كان هذا هو قلق الريح الذي ظل عالقا بمؤخرة المتنبي وربما أيضا هو العمى الذي جعل المعرى دائما وأبدا مستطيع بغيره وربما كذلك هو الموت المرصع بأسمى الآيات عندما أكل امرؤ القيس ذات ليلة عابرة. إن الشعر ليس في حاجة إلى العصي المخيفة التي يحملها في وجهه المناطقة والأسلاف والماضي وأعراقه التليدة المكدسة. فهذا الانسجام الذي يبحث عنه الآباء لن يكون موجودا، فالطريق محفوفة بالمخاطر وهى تمتلك من الفخاخ أكثر مما تملك من وسائل الأمان . ومع ذلك ليس ثمة أسباب حقيقية للتحوط .. فقد قال رامبو ستكتشفون يوما حواسكم عبر هذا .. وكان يشير إلى فصل جحيمه، لم يكن يكتشف الحواس لأول مرة، فليس هو مكتشفها الأول، والدلالة الإبداعية أعمق وأبعد أثراً من التعريف البيولوجي للحواس، لكن اكتشاف الاستيهام الإنساني عبر الحواس كان هو النار التي أشعلها رامبو ولم تنطفئ في عيون الشعراء. فالاحتفاء برمزية اللاهوتية في الماضي البعيد جعلت من عصر يقف رامبو على رأسه أمثولة تضرب عرض الحائط بكل صكوك الغفران التي خلفت ملايين الهكتارات الفارغة تحت أقدام الكنيسة أقصد تحت أقدام الميتافيزيقيا.
أن حروب الشعر مستمرة ويجب أن تظل كذلك وإلا فقد الإبداع مبررات وجوده، ومن هنا فإن الدعوة المنطلقة للبكاء على الشعر وعلى مستقبله تدعو للشفقة، ولن يكون البديل هو التمسك بالقار والكائن لأن كل نص نقيض لا يعنى أبدا قطع كل الأواصر مع ما نملك والعين الكليلة فقط هي التي ترى دائما نصف الحقيقة. ولا يمكننا هنا إلا أن نحتفي مجدداً بأسرار الجرجاني الذي لم يكن بعيدا عن أصحاب الحواس المشتعلة في أي لحظة ولم يكن تسليمه بأولوية الوظيفة اللغوية المركبة على بقية الوظائف الأدائية سوى نوع من التأكيد على علاقة اللغة بالحياة بأكثر من علاقتها بالحاجات العابرة لجماعات تحاول حصارها في إطار المفهوم القاهر والأحادي. الموضوع أذن ليس منفصلاً عن الحرية بحال، وربما اكتشفنا عبر الأشياء الأبعد أثراً العلاقة الوثيقة بين هذين الجحيميين. فجحيم الحرية هو الذي أخذ غاليليو من يديه إلى المقصلة وهو يردد "ولكنها تدور" وجحيم الإبداع هو الذي أوحى لخيالات الشاعر الآثم أن يلقن المحاربين دروساً في كيفية توجيه السهام إلى صدر الحقيقة.
إن شفاعتنا بأدونيس ومحمد الماغوط وأنسى الحاج وبدر الديب وحسين عفيف ومحباتنا المنفرضة لعفيفى مطر وحجازى وعبد الصبور ودرويش وسعدي وغيرهم تذهب أدراج الرياح ولا تبدو مأمونة العواقب بل ربما لم تشفع لنا تجارب الحقب الأكثر قربا التي تعاين الحال كتفاً بكتف وتشارك في حمل الجناز . إن أسرى مقولات سوزان برنار، المسيئون أكثر مما ينبغي، أوقفوا حواسنا على مواصفات جد بائسة ألقتها شعرية الأسلاف في المرحاض. إن هؤلاء كانوا أكثر خطراً على القصيدة من كل أعدائها، فنحن نتكلم عن ملامح أكثر تنوعا وثراء لا نقصد بها بتر خصائص النوع ولكن نقصد إلى منحه فضاء أكثر إمعاناً في العمق والبعد، وربما كان هذا الابتسار سبباً في التماس بعض العذر لأميين كثيرين يعملون بالنقد في معظم الأحيان، لاسيما إذا تعلق الأمر بالدرس العام الأقرب إلى أحاديث السمر الليلي مع الزوجات في الشؤون الأكثر روتينية.
إن أفق التجريب الذي سمح للجاحظ مثلاً أن يخصص فصولاً مطولة في الحيوان والبيان وغيرهما لاكتشاف طاقات ثرية في الدلالة المركبة هو الأفق نفسه الذي فجر طاقات الكوميديا الإلهية، وسيرة ابن هشام، والفتوحات، والسحاب الأحمر، ومجنون إلزا، وأزهار الشر، ومنارات، ومفرد بصيغة الجمع، ولن، وغيرها من الأحاجي المنبوذة في لحظة ما. وربما كان الأثر الأبعد بين ظهرانينا لم يسفر عن وجه كامل الاستدارة، وقاطع الملامح والدلالة، لكنه قطعاً سيكشف عن كل ذلك، وعن حديقة الحواس الرامبوية التي يدخرها الشاعر والشعر دائما تحت جناح المعرفة النسبية التي لا تملك يقينا بشيئ، ولا تمنح نفسها الحق في الجلوس تحت أعين الكاميرات مفردة. أن ما يأمله الشعر الجديد في ظني هو الإشارة الجزئية فسحب، إلا أن ثمة أشياء هناك في البعيد يمكنها أن تساهم في صوغ علاقتنا بالعالم بنفس الدرجة التي تقوم بها الأشياء القريبة أو التي تبدو كذلك. إن قدرة الشعر الجديد على صوغ أشواقنا المأمولة أبعد أثراً عن الكمال، بل ربما هي قدرة احتفت بالنقصان وآزرته وتؤازره. وأمنيتي الأبسط أن يتحلى الضمير العام – إذا صحت هذه التسمية – بشيئ من الموضوعية الالسبعيني.نته، قبل كل شيء من، معاينة الجثة موضوع الدرس قبل الشروع في تشريحها.
قصيدة النثر من الإنفلات إلى الشعرية الرسولية والعكس
لا تقصد هذه المقدمة إلى المساهمة في تقعيد الظاهرة الشعرية عليه.ة فيما بعد الشعر السبعيني . هذه الظاهرة التي لازالت تحمل من التناقض والشكوك أكثر مما عليه . من الطمأنينة والسكون، وهو أمر ـ رغم التباساته ـ يعبر عن روح النص الشعري في العقود الثلاثة الأخيرة، بعيدا عن القيمة التي يطرحها أو الآمال المعقودة عليه . وإن كانت هذه المقدمة تقصد إلى شيء، فهي تقصد إلى أن تكون دليلا غير متسلط يأخذ قارئ الكتاب برفق إلى مرجعيات هذه النصوص ليس بالمعنى السيميائي طبعا ولن يحدث هذا الأمر ولن يؤتى ثماره سوى بإلقاء الضوء السريع على تجربة الحداثة في تجليها المصري بداية من النص الريادي مرورا بالنص السبعيني .
وفى رأيي ليس ثمة إمكانية للتعامل مع الشعرية الجديدة دون إدراك لأهمية التحديثية في النص الريادي، وبالتحديد، في لحظته التاريخية أما محاولات الفصل بين راهن الشعرية وما فيها ففي ظني ينطوي على الكثير من أفعال المراهقة الشعرية والفكرية معا .
وفى إطار معرفتنا ـ التي تؤكد أنها محدودة ومحاطة بكيراودونه،حن ـ لا تستطيع أن نسلم بمثل هذه المفاهيم القطائعية المطلقة، وأظن أن الشعر، كوظيفة، يضاف إلى معارفنا المحدودة هذه، لذلك لا بد أولا من البحث بدرجة من التعري عن معلم ثقة ـ كما يقول مكليش ـ " رجل رأى واستبان ثم عاد ... ولن يكون هذا الرائد إلا شاعرا . أما النقاد منهم كمن يضع الخرائط لجبال العالم الذي يراودونه، غير أنهم لم يتسلقوا تلك الجبال أبدا" .
وفى الحقيقة سيكون دليلنا هنا، ليس شاعرا واحدا، ولكن شعراء، ليس نصاً واحدا ولكن نصوص، ودعوة التجاور في مجملها لا تقصد إلى إعادة الاعتبار إلى ماضي هذا الشعر وليست دعوة مكرسة لتقديس نص أو مقول، ولكن النظر هنا يقصد ويصب في مصلحة الحوار الذي من الممكن أن يكشف عن العلائق والوشائج التي تناسلت عبرها الشعرية سواء كان ذلك على مستوى الإشكال أو المضامين وهى ليست بالطبع دعوة اتفاقية تهدف لخلق وسطية بغيضة كجسر لمصالحة غير قائمة وغير مفترضة ولن تقوم أبدا، فجوهر العلاقة سجال دائم ومستمر، وحتميته الوحيدة هي الاختلاف وليس الخلاف، التجاور وليس التنافر، الامتداد بين تجليات الماضي والحاضر، وليس اجتثاث الجذور دون وعى بالمستقبل ومأزقه التاريخي، الذي نعيش مخاضه الصعب في لحظتنا الراهنة .
****
ليس من الملائم على الإطلاق الحديث عن مشروع الريادة في الشعر العربي، أو ما نسميه بقصيدة التفعيلة، تحت إلحاح هواجسنا بضرورة جره إلى متحف التاريخ وساعة نفعل ذلك فنحن لن نستطيع أن نجعله مجرد ذكريات نراها في أحلامنا السعيدة، أو نصحبها في العطلات الرسمية والمتنزهات .
إن المشروع الذي يصل إلى هذا الشيوع وهذه الثقة المفرطة، لا بد أن يتحول إلى كلاسيات راسخة، تأخذ مكانها في الروح والضمير العام بعد أن دخل الشعر العربي لأول مرة في تاريخه ـ إلى مضامين جديدة، كانت تجليا مخلصا وواعيا لسنوات، بل قرون من الحرب ضد اليقين والثبات .. ولذلك فإن استعادة الفرد لصوته الخاص كان مطمعا غاليا عضت عليه القصيدة بالنواجذ، مؤيدة في ذلك بمناخات الصوت الجمعي الذي كرسته ودفعته للأمام الدولة القومية .
فلأول مرة يصبح العقل العربي مؤهلا لأن يكون عقلا تركيبيا، ولم تعد القصيدة مجاميع من البدهيات والتراتبيات الأليفة حول الطلل والعشائرية . إن العقل الجمعي الذي صاغ توجهاتها كان حريصا على أن يكون عقلا كليا شاملا بالبحث عن يقين آخر. مولعا بتقاويم معرفية تستند إلى بطولات جديدة ومتعددة تضرب في عمق التاريخ وترتدي الأقنعة، وتلتبس كثيرا على الرائي .، لذلك فقد عرف الشعر العالميتافيزيقا.نحراف الدلالة وتجلياتها، بما في ذلك التماهي في الأسطوري والتاريخي والحضاري الإنساني العام والشامل .
وهكذا كان انطلاق الشعرية الجديدة بمثابة طريق مؤكدة نحو خلود من نوع آخر . خلود لا يخالطه الخوف من الميتافيزيقا . بل كان فعل الجرأة الذي انتهجته القصيدة دالا على القطيعة مع الماضي، والمؤسسي، والغيبي. وكانت الاندفاعة كلها تعكس الرغبة المحمومة في بناء إنسان وعقل جديدين، ينتميان بشدة إلى الحاضر والى المستقبل . وان خالط المشروع في جملته نكوص من نوع أخر فهو نكوص الحراك الأممي والجماعي، الذي كللته الخيبات الإنسانية ودهمته سلطة القوة الغاشمة وأطاحت بآلامه أفراس غبية، تجرى ضد الإنسان أينما كان .
ربما لهذه الأسباب أصابتنا الحسرة على المشهد .. وربما لأن الشعراء أنفسهم خامرهم يقين آخر بالنكوص، هو في الوقت ذاته نكوص الشعر ونكوص الإنسان الذي يتساقط جلده في المراكب التي تعبر يوميا إلى الشمال لتهريب الجائعين من أهل الجنوب . وربما كانت اللافتة كلها تعبيرا مجازيا عن الاضمحلال الأكيد لكل المعاني التي وسمت به الحضارة نفسها منذ فجر التاريخ.
إن كل ما يجرى يدعو للحزن والأسى . فعندما كان الشعر مؤازرا للجرح، اذره الجرح أيضا، وعندما حلم بتحرير الإنسان ناصره الإنسان، وعندما هم بإقرار العدالة، تأودت العدالة وعندما حلم بركل بثور التخلف واجتثاثها من الجذور ضحك السابلة بعد غيبوبة طويلة.
الكارثة التي أفاق على وقعها المتعبون، هي أن الشعر صاحب وظيفة أخرى، ليس لأنه أقل أو أدنى من القدرة على تغيير العالم، بل لأنه الصوغ الصامت والمستبطن لتاريخ الكون والإنسان في كافة صوره ودلالاته. اكتشف الشعر وظيفته المثلى في دوره الجمالي ليس أكثر . فالشعر يقيوالقتلة، في الغرف الصغيرة لكنه لا يستطيع جلد السفلة والقتلة، الشعر يتحرر من أسر الأعراف وغبائها وتسلطها، لكنه لا يستطيع أن يكتب صك الحرية حتى لصاحبه . الشعر يمكنه أن يركل الماضي لكنه لا يستطيع إقامة الحد على سدنته. إن فعل اليوتوبيا يحتاج إلى تماهي الإرادات المتباينة لا تنابذها . اليوتوبيا فعل إلهي آخر، وعندما يلجه الشعر،.... يكون قد ولج إلى ما لا يملك، ويكون قد أخذه الشيطان بلا رجعة . وأنا بدوري أندب هذا الشعر الفردوسي العظيم لكنه ليس وحده المكلوم والوجيعة ليست وجيعة الشعر في واقع الأمر، إنها وجيعة الإنسان، ابن الحياة ووارثها .. ومالك سُنة الأعمار فيها .. الرائي والكاشف ومختبر القناعات التفصيل.
******
لا شك أن الشعرية العربية تعرضت لطفرة هائلة في بنيتها، أيان مشروع الحداثة الشعري الذي توزع رواده بين بقاع عربية عديدة، أثرت وتأثرت تلك المشاريع بقربها وبعدها عن مركز التحديث الأوربي، ولكنها ظلت جميعها مشاريع تبنى موقعها بوحي من ثقافاتها القطرية حينا والقومية أحيانا أخرى، في الوقت الذي تضخم فيه دور الذوات الصانعة بدرجة مفارقة، حتى بدا النص موروثا شفاهيا، يحتفي بخطاب مجرد وكان وجود المتلقي ليس حقيقيا لكنه وجودا مفترضا، غير أن ما أضافتاه، العرفانية والذاتية معا أكد على مظاهر عديدة من أهمها اللغة التاريخية بكل تجلياتها النحوية والصرفية ومنبريتها العارمة، وأصبحت النصوص تقتفى لنفسها دينامية على درجة من الوعي القائم على أذيال هذه الشفاهية.
وقد انهمرت القصيدة في فوضاها باحثة في الحسي والرؤيوي والإشاري والمجرد، ضاربة ماضيها برفق بالغ وبوعي بالغ أيضا، لذلك فإنها عادت لاستخدام هذه المورثات بقوة في أقنعتها المتعددة، بالرفض حينا وبالقبول حينا آخر وقد طرح كل من أدونيس وصلاح عبد الصبور وعفيفى مطر ومحمود درويش من بين ما طرح، أهم نماذج النص الجديد وأقصى انفعالاته ومعطيات لحظته الشعرية . فأدو نيس أكد منذ "قصائد أولى" في العام 1947 أنه ابنا لقناع إله الخصب الكنعاني الذي خضبت دماؤه شقائق النعمان، غير أن ذلك لم يحل بينه وبين إدراكه لمعطيات التحديث ... على مستوى تأكيد الذات والزمن والرؤية كما يفترض مفهوم الحداثة وخصائصها، فقد لعب العالم الداخلي دوراً مهما في إبطال الدور الاجتماعي للعمل الأدبي (واعتبر الوعي الذاتي، لا الواقع الخارجي محوراً أساسياً للإبداع)، وهو الحس الناتج عن الشعور العام بالاغتراب الذي لازم النص، ولم يكن أدونيس منشغلا من قريب أو بعيد بما طرحته الماركسيه حول اعتبارها الحداثة تعبيراً عن انهيار ثقافة البرجوازية، وظل البحث الدائم عن الأقنعة بداية من "مهيار الدمشقي"فتحا جديداً" في ترميزات أدونيس الشعرية أمام كنوزه التراثية بعد تراجعه عن كثير من المقولات التي أطلقها إبان المشروع الثقافي الذي طرحته مجلة "شعر" في بداية الخمسينات، وهو التطور الذي جاء موازياً – على المستوى الموضوعي – لتوتر البنية الإيقاعية ودفع الجملة الشعرية إلى تكثيفات مضاعفة، لذلك فإن الحديث عن الغموض لدى أدونيس وأقرانه باعتباره بغية في ذاتها، كما يرى صلاح فضل، يعد تجاهلا لهذه السرية التي جلبها الشكل والموضوع إلى النص وهما عنصرا الكثافة في الفن ولن يمكننا "أن ننفى عن حياة الإنسان غموضها وسريتها وهو الطابع المؤكد بأكثر من تأكد الفهم والوضوح" . وغموض الشكل الفني وصعوبته ينجم – كما يرى السرياليون – عن غموض محتواه أو عدم إمكان فهمه، وترى الدكتورة خالدة سعيد "أن محتوى "أناشيد مالدورور" أكثر الموضوعات استغلاقا على الفهم، لأنه موضوع تمرد الإنسان على الله، لذلك فإن الفنان بهذا المعنى أصبح يشارك في صياغة أسطورة المعرفة من خلال اللاوعي الفرو يدي المستمد من مادة النشاط اللاواعي للإنسان، لأن الفنان لا يخلق مشكلة عصره وإنما يخلق الصيغ الموازية التي يمكن أن تساهم في فهم سلم المشكلات الإنسانية جميعا".
لذلك فإن العودة في هذه اللحظة للتأكيد على أهمية التعبيرية وتوجيه السباب للاتجاهات الأخرى بحجة التجريد هو قصر نظر في العقل النقدي لا يمكن تفسيره إلا على أنه استجابة للخطاب السياسي الفج والمباشر الذي لا يلعب العنصر الجمالي فيه دوراً حيوياً، وهو تصور مدرسي لنقاد لم يتجاوزوا بمعارفهم حلقات التعليم الأولى. وأمام عرفانية أدونيس تأتى حسية عفيفي مطر، وبساطة ورومانتيكية عبد الصبور الذي نفض يده من الأبنية الأيديولوجية، مؤسسا منهجه الشعري على الخاص الذي ينفى الخطاب المركزي والزخارف والأبنية اللغوية الفخمة، باحثا عن كائناته الحميمة والحزينة، متمتما بأن ماركس وإنجلز (لم يقوما بصياغة منهجية للمبادئ الجمالية، حيث اعتبر النشاط الفني عنصرا من عناصر البناء الاجتماعي الفوقية، أو طبقة من طبقاته الظاهرية المتعالية) لذلك فإن عبد الصبور يرد الفن إلى المعرفة النوعية بموضوعها ولغتها، لا إلى المعرفة الكلية التي تتزايد قيمتها حسب ماركس عبر الأنظمة الطبقية باعتبارها أثرا فنيا لمعرفة كلية، ويؤكد عبد الصبور رؤيته قائلا (الفن لا يخدم المجتمع، ولكنه يخدم الإنسان) وهو تصور محايث لحداثة نفى الدور الاجتماعي وإبداله، حيث أن كل شيء في الحياة يكتسب أهميته من خلال علاقته المباشرة بالكائن، لذلك فليس غريبا أن تكون المرجعية الدينية بتراثها الفني إحدى مرجعياته الأساسية كشفرة للترميز.
أما عفيفي مطر الذي أدرك مأزق النص لدى أدونيس في أقصى مراحل عرفانيته ولدى عبد الصبور في أقصى مراحل بساطته فقد ذهب إلى تأسيس نص يجسد تمايزاته عبر قناعاته بخصيصة المكان التي تتجلى بوضوح منذ ديوانيه "الجوع والقمر" و "يتحدث الطمي" حيث يتجلى الموروث الشعبي والخرافة القروية والعودة إلى السلالة عبر نطفة الخلق الأولى. إن وحشية واندياح الصورة الشعرية لدى عفيفي مطر ملمح أساسي حيث تتناثر أسطورة المكان هنا وهناك معتمدة بشكل أساسي على صورة العناصر الأولى للمادة.
ولن تتلاشى بسهولة التأثيرات الضخمة التي خلقتها تجارب محمود درويش وسعدي يوسف وأحمد عبد المعطى حجازي وقبلهم بدر شاكر السباب، حتى وإن بدت مساحة المغامرة الشعرية ذات إطار أكثر تحديداً داخل هذه التجارب، وهو تحديد يجد مرجعيته في الكثير من الشفافية والرومانتيكية التي كللت هذه الشعرية وجعلت الكثير منها يجرى على الألسن في نماذج كانت الأكثر استنساخا.
وربما لهذه الأسباب كانت هذه التجارب باحثة أبدا عن الجوهر الشعري بعيداً عن ظلال المعرفي والتركيبي، ومستوى هذه المغامرة عادة ما يرتبط بالموضوع الشعري وليس بشكله ومن ثم تتأطر مساحات التجريب.
*******
ونستطيع القول أن التحولات التي طرأت على المجتمعات العربية إبان الخمسينات، ودفعتها سياسيا إلى تبنى موقف قومي تحت رايات عديدة دفعت الإبداع دفعا إلى صورته الملتزمة، إلا أنها... لم تستطع أن تسلب المشاريع الإبداعية الحقيقية روافدها الجمالية وهو ما حفظ لهؤلاء الشعراء مصداقية وحيوية ممتدة عبر أقصى لحظات الانحسار القومي.
وكان طبيعيا أن يمتد أثر هؤلاء الرواد إلى التجربة اللاحقة لهم، والتي تمثلت في شعراء المد السبعيني في مصر والعالم العربي، حيث شهد الواقع السياسي والاجتماعي تغيرات هائلة، تفسخت على أثرها الطبقة الوسطى في مصر وتوارى الحلم القومي الذي كان يمثل مشروع الدولة الثقافي آنذاك، وإثر تفتت الطبقة المتوسطة لم يمر وقت طويل حتى صعدت إلى السطح قوى اجتماعية بديلة. وسرعان ما تجلت ملامح هذا الصعود. وكان انحياز الدولة لمشروعها الجديد له أثره البالغ في القضاء على القوى السياسية المختلفة في الوقت الذي غلت فيه يد المؤسسة الثقافية عن القيام بدورها، فظلت بعيدة عما يجرى، وفى هذا المناخ ولدت تجربة شعراء جيل السبعينات الوارث الأكبر لهزيمة 1967م.
وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه التجربة فالمؤكد أنها ولدت في خضم أزمة اجتماعية طاحنة، أثرت بدرجة كبيرة على النماذج الإبداعية لدى الكثيرين من شعرائها.
وقد واصل السبعينيون بدأب مسيرتهم الشعرية، حيث أدركوا منذ البداية أن يد المؤسسة إن لم تكن ضدهم فهي ليست معهم، فاعتمدوا بالفعل إمكاناتهم الخاصة في طبع دواوينهم وعقد ندواتهم ومجلاتهم الخاصة فلا تذكر حركة طباعة "الماستر" إلا وذكر السبعينيون، ثم انقسموا اثر صراعات طبيعية إلى جماعتي (إضاءة) و(أصوات) وكان الغريب أن العامل السياسي والأيدلوجي كان الموجه الحقيقي لهذه الصراعات حسبما كشفت بعد ذلك وثائقهم،وهو ما أجج المعارك والاتهامات بين الفرقاء وامتلأت الساحة الشعرية بالمشاحنات التي وصلت في بعض الأحيان إلى الاتهام بالخيانة، وتكون فيما بعد ما سمى "بشعرية الخنادق"... وقدمت هذه الشعرية نفسها على أنها النموذج المثال الذي ألقى بقصيدة الريادة في مزبلة التاريخ، وأطلقت صيحات من قبيل "قتل الأب" ومورست عداءات سرية قاتلة ضد هؤلاء الآباء، ولم يكن هذا الصوت الصاخب الذي كان يلجأ لإطلاق الشعارات بين الحين والآخر سوى رد فعل للإحساس العميق بالأزمة، فأمام أزمة الواقع الطاحنة انكفأت ذوات الشعراء على نفسها وأغرقت في التجريد والذاتية حتى أن الدكتورة سلمى الجيوسي وصفت هذه الشعرية "بأنها تجربة كلت من كثرة التعسفية في الصورة الشعرية، وأضافت أن هذا تعسف لا يمت للشعر بصلة، ويستطيع المرء أن يقول إن ثمة عدوانا غير مسئول حدث على تقنيات الشعر، في نقطة اللا احتمال بسبب هذا الإرهاق النفسي الجمالي" وكانت الدكتورة الجيوسي تشير إلى ضرورة اختفاء الصوت الجمهوري والخطابية، ليس لكي يخسر الشاعر عنفوانه ولكن لكي يعلو على الاستفزازية، وهى بالفعل قضية النص النثري الآنية.
غير أن حديث الجيوسي لا يمكنه أن يكون صحيحا على إطلاقه لعدة أسباب أولها أن هذا الحديث كان في فترة متقدمة من حقبة الثمانيات حيث كانت هذه الفترة هي ذروة التلبس بالأقنعة الصوفية وتداعياتها اللغوية المحضة، وثانيا لأن هذا النسخ الذي قبضت عليه الجيوسي لم يستمر قرينا لهذه التجارب في إجمالها، فقد خرجت مبكراً التجارب المهمة واللافتة من هذا النفق المعتم، ولم تذهب إلى هذه المشاعية سوى تجارب الشعراء الأقل شأنا والأقل تأثيرا في هذه التجربة.
*******
أما الحديث عن جيل الثمانينات فهو حديث شائك إلى حد معين لأننا أولاً لا نستطيع الجزم بالفرضية المطلقة التي تصور لنا أن كل عشر سنوات يمكن للواقع أن ينتج جيلاً شعريا مختلف الملامح قادراً على إنجاز إضافات نوعية للحركة الشعرية. وثانياً لأن هذا الرعيل الذي تلي السبعينيات – عمريا- ظلم ظلماً رهيبا بتحميله كل النتاج التعس للحقبة الانفتاحية التي شهدت عديد من الهزائم الاجتماعية والسياسية والثقافية . فعلى المستوى الثقافي – وكما أشرنا – شهدت بداية هذه الحقبة إغلاق جميع المجلات الثقافية والإبقاء على مجلتين عديمتي الجدوى هما "الجديد" التي كان يرأس تحريرها الدكتور رشاد رشدي وهى مجلة أساءت للإبداع أكبر إساءة ممكنة، ومجلة "الثقافة" التي كان يديرها الدكتور عبد العزيز الدسوقي، وهى مجلة كانت ذات اتجاهات محافظة على الدوام، وكان أبرز ما يميزها عدائها للتيارات الجديدة في الكتابة.
وعلى مستوى آخر فقد شهدت الحريات العامة مساحات هائلة من التضييق رغم إقرار المنابر السياسية عام 1977م وتحول هذه المنابر إلى أحزاب عام 1979م، فقد تم تجميد نشاط بعضها مثلما حدث مع حزب الوفد بسبب قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي قضى على كل صلاحيات الحياة الحزبية، ومن جانب آخر فقد كانت الجماعات الأصولية تلعب أدواراً أقرب إلى الأدوار الأمنية داخل أسوار الجامعة، وأذكر حجم المعاناة الذي كنا نلاقيها في عمل مجلة حائطية مثلاً، لا سيما بعد إقرار اللائحة الطلابية الجديدة في نهاية العام 1979م التي قضت قضاءاً نهائياً على مشاركة الجامعة في الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص. ورغم أنني لم ألتحق بالجامعة سوى في العام 1981 إلا أن آثار هذا التكميم ظلت ممتدة ولا زالت، لا سيما أن القبضة الأمنية ازدادت بعد اغتيال الرئيس السادات وباتت كل حركة جامعية مرصودة بمنظار دقيق لأجهزة الأمن ورجالاته داخل أسوار الجامعة . ولم تكن الانهيارات السياسية إلا تعبيرا وتجليا للانهيارات الاجتماعية التي تأكدت بتآكل الطبقة المتوسطة إلى تشكل عصبها متعلمون من كافة الأجيال وانتقلت دفة الحركة الاجتماعية لأيدي طبقات أخرى من أثرياء الانفتاح الذين أنتجوا أشكالاً ثقافية تلاؤم أذواقهم واحتياجاهم سواء كان ذلك في السينما أو الغناء أو كافة أشكال الإنتاج الثقافي الأخرى.
وسط هذا التحلل كانت المرجعية الأكثر دفعاً للاستبصار ترتبط ارتباطا وثيقا بالنموذج الشعري الريادي الأكثر كشفا لدى عبد الصبور وحجازى السياب وأدونيس ومطر ودرويش، لذلك سوف نلاحظ أصوات هؤلاء الشعراء حاضرة بشدة في أصوات الثمانينات الأولى، ليس فقط لأن هذه الأصوات كانت تبحث عن الأبوة الشعرية ولكن لأن ذلك كان يمثل العودة إلى جوهر الشعر، باعتباره نشاطاً فردياً محضاً يرتبط بوظيفة اجتماعية متعددة الأغراض، لذلك سنجد هذه الأصوات وقد انتبهت مبكراً إلى شعرية أكثر اعتمادا على رومانسية تعاملت مع الذات كموضوع ومحور للعالم وتعاملت مع اللغة – في معظم الحالات – باعتبارها بوتقة الأداء الشعري، وليست الغاية الأولى والأخيرة فيما سماه السبعينيون بتفجير اللغة الشعرية وانحراف الدلالة.
ونستطيع أن نرصد هذه الصورة لدى هشام قشطة في ديوانه الوحيد ذاكرة القروي، ولدى إيمان مرسال في ديوانها "اتصافات" وقصائدها المنشورة في النصف الثاني من الثمانينات في مجلة إبداع، ولدى مهدي مصطفى في ديوانية الوحيدين "رحيل م.م." الصادر عن سلسلة إشراقات بالهيئة العامة للكتاب و"تندارى" الصادر عن دارسينا للنشر، أيضا يمكننا أن نتوفر على هذا التصور لدى ياسر الزيات الذي لم يطبع أية دواوين حتى الآن، ولدى عصام أبو زيد في قصائده الأولى.
)،لك في كل دواوين الشاعر سماح عبدالله الأنور وعماد غزالي وأحمد بخيت وإبراهيم دواوود وعلى منصور وعزمي عبد الوهاب وحسن خضر وفتحي عبدالله بخيت وغيرهم، وأيضا لدى كاتب هذه السطور في ديوانه "خيول على قطيفة البيت" الذي نشرت معظم قصائده في مجلة إبداع في النصف الثاني من حقبة الثمانينات.
وكانت المشكلات الحقيقة التي جابهت هذا الجيل تنبع بالأساس من فكرة التحلل التي كانت فائضة، في التأسيس لمفهوم أكثر فردية في مواجهة التلاشي الحقيقي للتنظيمات السياسية والعمل السياسي السري، لذلك فقد خلت أدبيات الجيل من مفهوم الجيتو أو الاسترسال في إصدار البيانات الشعرية كما حدث مع سابقيهم فضلا عن توقف معظم الشعراء الذي شكلوا واجهة الجيل عن الكتابة أو بالأحرى الذين تم تعريف الجيل بهم، بالإضافة إلى التراجع والخواء الجمالي والتكرار الذي صاحب بعض التجارب التي استمرت في سياق أشبه بفكرة الوجود بالقصور الذاتي، أو مجرد الوجود – فقط – لأن الحياة لازالت مستمرة.
وليس من سبب، بالتأكيد، يدفعنا للبكاء على ما لا يستحق البكاء، فالاستمرار أو عدمه ظرف موضوعي محض يعود لكل شاعر على حده أيا كانت الأسباب الدافعة له، وعدم تطور التجربة عند البعض الآخر يخضع للظرف ذاته.
غير أن الالتباس الحقيقي يأتي من الخلط الشائه والمتعمد لما حدث مع بداية حقبة التسعينات التي شهدت انتقالة نوعية حقيقية شكلها بالأساس شعراء من مختلف الأجيال، وأخذت تسمية الجيل التسعيني تصبح اعتماداً شابته بعض المغالطات التاريخية القريبة.
وقد لعبت مجلة "الكتابة الأخرى" التي أصدرها الشاعر هشام قشطة في العالم 1991م والتي لازالت تصدر، الدور الأهم والرائد في تقديم معظم الأسماء الشعرية التي شكلت ملمح الشعر المصري فيما بعد وحتى اللحظة الراهنة, ثم تليها مجلة "الجراد" التي أصدرها الشاعر أحمد طه مع عدد من الشعراء الجدد ثم توقفت عن الصدور لكنها أيضا وساهمت في الحركة الشعرية الجديدة بجرأة مضافة ساهمت في ترسيخ الحضور الجديد، كما لعبت مجلة "الأربعائيون" دوراً آخر في مدينة الإسكندرية.
*******
يقول شارل موريس (إنه لما لم يكن هناك شيء، فهذا يعنى أننا في اللحظة المواتية لتفتح شيء) وقد كان موريس يرمى إلى أن هناك أزمة في النص الشعري، ويعنى أننا في انتظار اللحظة المواتية لتفتق أشكال جديدة قادرة على هدم مسلمات عديدة ... وفى الحقيقة لا أعلم إذا كانت هذه هي لحظتنا المناسبة أم ذلك محض رغبة في الهدم خلقها السأم العمومي الذي خلفه غياب المشروع الثقافي.
الواقع إن قصيدة النثر، الشكل القديم الجديد، التي هي محور هذه المحاولات التثويرية، أصبحت تجد لها ملاذا آمنا باحتضان معظم الأجيال الجديدة بل والقديمة لها، بعد تحول معظم شعراء التفعيلة إلى كتابة هذا النص والاحتفاء به وتقديمه في كل مناسبة كشكل من أشكال الخلاص .
ويطرح النص النثري الجديد نفسه كبديل لإشكاليات عديدة تجلت مع نص التفعيلة ففي اللحظة التي يتراجع فيها الشعر إلى منطقة اليومي والبسيط، يتراجع النص الريادي بتهمة انسحاق الذات أمام القضايا الكونية والإنسانية الكبيرة مثل أسئلة القيم الكبرى في الموت والحياة والخلق وما إلى ذلك، وفى الوقت الذي يؤكد فيه النص النثري على تهميش البلاغة وزخارفها، فإن النص الريادي يتراجع بتهمة الشفاهية الناتجة عن الخطاب اللغوي الأيدلوجي المؤسس على بلاغة يلعب فيها الموروث الدور الأساسي، وفى الوقت الذي تطرح فيه قصيدة النثر تدمير المكان وعلاماته بضرورة إنشاء النص الإنساني المتجاوز، يتراجع أيضا النص الريادي بتهمة "أفدح" وهى الشوفينيه والالتزام وتبادل الأنخاب مع الأوطان.
ولا شك أن قصيدة النثر جاءت في لحظة مفصلية تتغير فيها ثوابت كثيرة على المستوى المحلى والعالمي في ثورة ما بعد الحداثة المعلوماتية الهادرة من كل مكان وأيضا في لحظة يتم فيها التشكيك في دور النص الريادي، ولكن السؤال هل هذه المراجعات مع النص الريادي على المستوى المفهوم تعنى أنه يفقد فاعليته؟ )،صور أن الإجابة بالنفي أو بالإيجاب لن تكون ذات معنى، لكن المؤكد أن ثورات التحرر في العالم الثالث هي التي (دشنت استرجاع الفرد صوته في الشئون العامة والخاصة ومهدت لتوسيع حدود طبقات اجتماعية مسحوقة وهو الأمر الذي أعطى قيمة رفيعة لمعنى الالتزام في الفن والأدب..)، فهل يمكننا بطريق آخر الجزم بأن الواقع في ال، ةلم الثالث تجاوز مأزقه تجاوزا سليما يرتبط بحركات تحديث حقيقية، تمنح هذه الانقلابات الأخلاقية مبررات الإزاحة ؟! قد يكون ذلك صحيحا في جانب منه وهو الأمر المتمثل في حالة السأم العمومية التي أصابت المتلقي بفعل الشعر الفاسد الذي طرح مجموعة من الهلوسات والأمراض باعتبارها تجليات لتقدم النص، وهو تصور يدخل ضمن هذا التاريخ من الهلوسات المشار إليها، وقد حدثت في بداية القرن ردود أفعال عنيفة ضد الرمزية وضد كل ما هو ذهني، ودعى النقد الغربي إلى الاقتراب من الحياة أكثر، أو نحو "الحقيقة الملموسة" وقد شهدت فرنسا بالفعل تيارا يتبنى هذا الشعر الملموس منذ العام 1910م، إلا أن واقع الشعر الأوربي تغير تماما بعد الحرب العالمية الأولى، فقد ظهرت الدادائية والسوريالية لتحطما (قوى النظام والتنظيم الفني تماما)، ولكن يبدو أن الكائن في العالم الثالث وصل إلى نقطة اللاعودة ... لا إلى القيمة، ولا إلى المعنى ... وقد يتراجع هذا الشعور إذا ما ارتبط بمشاريع ثقافية وطنية واضحة المعالم حتى لو علمت في إطار من التدويل.
أود أن أتساءل قبل الخوض في تفاصيل أكثر حول راهن الشعر المصري فيما بعد السبعينيات، وعما آل إليه النص السابق على الشعرية الراهنة عبر مقولات بعض رموز الريادة المصرية والعربية وعبر الخطاب العام الذي يبدو أن مقولاته باتت تجرى مجرى الحكمة، وكأن ثمة مخلص لابد من خلقه كي يكون هو حامل النبوءة وحامل سراج المستقبل للإنسان في هذا الكون.
لكن الإنسان الذي آزر حلم تحريره، يرفض أن يتحول شعراؤه إلى أنبياء ومخلصين وشهداء على مذبح الصوامع الصغيرة التي تبتلوا فيها. أليس من حق هذا الإنسان أن يختار؟! أظن أن المقدمات التي أشاعتها الريادة تتناقض تمام التناقض مع الحق الذي شرعته لإنسانها، وها هي تتحول إلى سوار ذهبي في رقبة المستقبل. وعندما يظل الخطاب على هذا النحو خارجأخرى، دائماً، فقد وقع لا محالة، في الأيديولوجيا. لقد تخطى الوظيفة الجمالية إلى وظيفة أخرى، هي أليق ما تكون بالساسة وصناع الأفكار وصناع القنابل الفتاكة. ولا أظن أن إضافة هذا الزخم الشعري كله إلى خطاب الأيديولوجيا سيكون عملاً موضوعياً، لكن المؤكد أنها لم تكن الغاية التي ينشدها شعر "التحرير والنبوة". وإن كانت مقولات متناثرة هنا وهناك تؤكد الأفول الذي اعترى خطاب التحرير هذا، قبل أن يسلك طريقه إلى الشعر الخاص.
والنظر السريع إلى ما يردده بعض روادنا يؤكد هذا الدفاع الحالم عن علنية الشعر ونبوءته بالتغيير. "فأدو نيس" يؤكد دائماً .. على أن لغة الشعر تفلت من كل تحديد، الشعر،ي الوقت نفسه على أن الشعر الجديد يفتقد الخاصية الأولى للحداثة، وهى الرؤية النابعة في نظره، من موقف حتمي لتفكيك بنية العالم القديم بأصولها المعرفية والجمالية، وبالعلاقات التي أسست لهذه الأصول.
أما "محمود درويش" فيعتبر الدفاع عن الشعر، دفاعاً عن روح الأمة ووجودها الثقافي وأن التجديد والحداثة يراد لهما أن يتحولا إلى مرادفين للعدمية وللثورة المضادة أحياناً، حيث لا يصبح هنالك معنى للأشياء.
وكذلك يؤكد "سعدي يوسف" أن قصيدة النثر العربية ارتكنت إلى مرجعية ضعيفة هي مرجعية الشعر الفرنسي، وأنها في معظم الأحوال، اعتمدت التقليد المطلق للمجاز والاستعارة. وأن الفارق الوحيد بينها وبين قصيدة التفعيلة هو خلوها من الوزن، بينما كل تقنياتها تقليدية ومتخلفة.
ولا يختلف الخطاب المضمر لـ "محمد عفيفي مطر" عن سابقيه إن لم يكن أكثر عنفاً، وقد عبر عن ذلك بصور متعددة، وربما كان رفضه للأبنية اللغوية القائمة، هو من قبيل الدفاع المستميت عن بناءاته اللغوية الفخمة التي تؤسس مشروعه في مجمله. أما حديث حجازي عن رهنه تحقق الشعر بالوزن باعتباره شرطاً لازماً لا يقوم الشعر خارجه، فإنه يثير، من جديد، قضية شائكة وملتبسة حسم أمرها الأقدمون، ووجهوا بسببها انتقادات حادة إلى بحور الخليل بن أحمد، فقد ذمه "الجاحظ" في لحونه وإن اعترف بفضله على النحو والعروض. غير أن كثرة من الباحثين أجمعوا على أن "نظام الخليل لا يصلح لـ وصف إيقاع القصيدة القديمة نفسها، ناهيك عن القصيدة الجديدة". وهى قضية لن نخوض فيها، لأن الخلط القائم تاريخياً بين العروض والإيقاع لم يتمكن البحث العربي من استكناه مدلولاته ولا فروقه الدقيقة التي، وإن اقتربت من المعرفة، إلا أنها تستحيل على الوصف.
والخطاب الريادي في مجمله، فضلاً عن رسولتيه، يرفض خطاب المستقبل جملة وتفصيلاً، وإن اختلفت الأسباب، وهو موقف لا يختلف مع أصوليته ويبدو شديد الاتساق معها. ومناقشة هذه الأفكار عبر فكرتي الخطأ والصواب ليس وارداً. لكنني أريد الإشارة فقط إلى أن هذا الخطاب الذي كان يقود فكرة التغيير والحرب على اليقيني والثابت لأسباب ذكرنا بعضها، يقود الآن فكرة تثبيت المشهد على علته المستقرة لنفس الأسباب. وربما كان الخطاب في مجمله هو أحد تجليات الأزمة التي يعشيها النص الريادي، ليس في نماذجه المتبوعة والمستنسخة فحسب، لكن في الشواهد الشعرية لهؤلاء الكبار الذين تحدثوا إلينا قبل قليل، يشمل ذلك معظم إصداراتهم في السنوات الخمس التي تسبق هذا التاريخ على الأقل.
وأظن أن كتاب "الكتاب" لأدونيس في جزئيه العظيمين، هو أعلى تمثيلات هذه الأزمة . فهو بحق أعلى تمثيلات هذه الشعرية الرسولية، ولم يكتب أدونيس حرفاً واحداً فيه خارج هذه الروح. بل إنه يحاول، منذ عنوانه، وضع الدستور النهائي للشعر والمعرفة، وكأنه السقف الأخير الذي تنتهي عنده الأشياء. بل إنه يهدف إلى التساوق مع أعلى نصوص العربية قداسة، وكأنه شريعةمفرطة،أتى في الختام لراهب عظيم، قضى عمره في وضع السنن الجديدة للحياة وللكون معاً، ومن هنا يأتي تعاليه، وتأتي ذهنيته، ويأتي احتماءه بالمعرفة، ومن هنا أيضا يأتي تنكيله بالشعرية، التي أخفض أدونيس من شأنها، لحساب كل العناصر التي تقف خلفها .
علي جانب آخر لم يعد من الملائم أن نشير مفاهيم،ة النثر بعمومية مفرطة، باعتبارها "أداة لمعاينة العالم وتأمل شرط الوجود الإنساني ". فمثل هذه الإنشائية لا تصل قطعا لتحديد مفاهيم، لسنا في حاجة إلي تحديدها، علي الأقل في اللحظة الراهنة . ويكفي أن نعود إلي ما قاله الرومانسيون، والرمزيون والبرناسيون وجميع الاتجاهات التي تساوقت مع مذهب الفن للفن، حتى نكتشف مغالطات هذه الإنشائية وركاكتها، وسطوها علي منجزات الماضي، الذي تطمع قصيدة النثر إلي تجاوزه عبر مقولات تتواءم مع أطروحاتها .
وربما كانت مثل هذه التعميمات وراء المبالغات التي أكدت عليها القصيدة واندفعت نحوها في عشوائية وبروح قطيعية، لم تفرق بين العام والخاص . كان ذلك جزءا من المحاذير إلى طرحتها قصيدة النثر براهنيتها المطلقة والمخيفة .
ورغم التمايزات اللافتة التي طرحتها عديد من الأصوات الشعرية الجديدة، إلا أن لغطا كثيرا وتشوها في المفاهيم والمقولات دفع إلي درجة من العنف المتبادل بين مختلف التيارات المتصارعة وأحيانا بين أبناء التيار الواحد .
ففي الوقت الذي يجب أن تنفلت فيه قصيدة النثر من أسر كل المقولات المسبقة المفهوم، على وضع مواصفات بائسة ـ في معظم الحالات ـ لكيفية إنجاز النص الجديد فيما يشبه "المانفستو" الذي تقف كل المقولات خارجه موقفا معاديا يشوبه البطلان . فلا اليومية ولا التفاصيل الصغيرة ولا مغادرة المجاز كانت ناجزه في تحديد المفهوم، وظلت التجارب الشعرية أعلى بكثير من حيث تنوعها من مثل هذه المقولات .
ومن المدهش، مثلا التأكيد الدائم والمستمر على فكرة الاقتصاد في استخدامات اللغة، ومجازاتها، وتركيبتها، باعتبارها إدارة وظيفية. حتى أن شاعرا يود لو كانت الكتابة بلا كلمات .
وما أود قولـه هنا، هو أن التجربة الشعرية في جريانها الطبيعي أعلى بكثير من هذه المواصفات. والتنوع الذي تطرحه قصيدة النثر يؤكد هذا المعنى . فالنص يحتمل التماهي مع أنواع جديدة من المجازات والسرديات ويحتمل أيضا التماهى مع الفلكلوري والأسطوري، ويحتمل القضايا الكبرى، بنفس القدر الذي يقدس به التفاصيل الصغيرة واليومية المفرطة . وما يدفع به البعض من مقولات حول اللغة وغيرها هدفه قصر الشعرية على نموذج أوحد، ربما جاءت الكثرة الكاثرة من نماذجه رديئة وغير ناجزه، بسبب الطبيعة الأدائية لمثل هذا النوع من الكتابة فنجاح هذه الكتابة رهن بشروط محددة وقاطعة يفشل النص نهائيا بدونها، ويأتي على رأس هذه الملامح ملمح المفارقة الأرسطية الذي اعتمد عليه عدد كبير من الشعراء ولم يصادف نجاحا سوئ لدى قلة محدودة من الشعراء الذين كتبوه وفى بعض النماذج فقط .
*******
وإذا تأملنا الاتجاهات الشعرية التي يطرحها هذا الكتاب سنقع على نماذج تفصيلية لهذا التنوع البالغ، بل سنجد نماذج تتجاوز كل ما يشاع من مواصفات حول الشعرية الجديدة، وقد عمدت إلى إثراء هذا التنوع بأصوات لا يمكن إقصاؤها حتى لو كنت أقف معها على طرفي نفيض . فليس ثمة نية تتجه إلى إعمال الذائقة الخاصة حيال تجربة عامة وجامعة فليست هذه مهمة الكتاب، بل رجواره،د هذا التعدد والتنوع في الإسراع بعملية "الفرز والتجنيب" حسب التعبير القانوني، وهو ما يجب أن يتم عبر قنوات أكثر تعددا وأكثر شمولا لا يدعى الكتاب أنه يملكها وحده .
فالكتاب يقدم نماذج شعرية لسبعة وعشرين شاعرا هم عصب الشعرية التي استمرت بعد النص السبعيني وإلى جواره، بغض النظر عن القيمة التي يمثلها كل شاعر على حدة . وسوف تتأكد أمام قارئ الكتاب مساحات التنوع الهائلة في هذه النماذج، حيث تتباين المرجعيات والقناعات بشكل كاسح، وهو الأمر الذي يؤكد أن النص، في جريانه الطبيعي، جاء أعلى بكثير من كل المقولات التي سيجنه أو حاولت ذلك .
وأرغم أن ثمة عدوان مروع وقع على المرجعيات التي كانت ـ حتى وقت قريب ـ مخيفة ومربكة . فلم تعد تجربة مجلة "شعر" البيروتية تمثل هذا "الإرهاب" الذي كان يمارسه نقد قصيدة النثر المستند إلى "سوزان برنار" تحديدا , وأظننا الآن لا يمكننا أن تتحدث عن تجارب لنذير العظمة، خليل حاوي، أسعد رزوق، خالدة سعيد، عصام محفوظ، فؤاد رفقة، عادل ظاهر، حليم بركات، باعتبار هذه التجارب تمثل قيدا راهنا على فضاءات الشاعر، ولا يمكننا أن نستثنى من ذلك تجربة كل من أدونيس، أنسى الحاج، محمد الماغوط من هذا الشمول، فعلى أهمية هذه التجارب إلا أنها ستظل تجارب خلافية لا تقدم المقترح الأوحد للشعرية الجديدة، غير العابئة بالايدولوجيا على أي نحو، وهو الأمر الذي ينطبق بشكل أكبر على الرواد الموغلين في القدم سواء كان ذلك في الشام أو في مصر كما لا يمكننا استثناء تجربة مدرسة "كركوك" في العراق من هذا النظر.
وأعتقد أن مأزق هذه التجارب لم تقدم لنا إلا نقادا يدخلون إلى قصيدة النثر باحثين عن عدد من العناصر التي ميزت بها سوزان برنار القصيدة عن غيرها من الأشكال الشعرية مثل الوحدة العضوية والمجانية والإيجاز، والقصدية .. إلخ، فإذا لم يجد الناقد كل هذه المواصفات مجتمعة خرج على الشاعر وقد كتب شهادة وفاته بإضافته إلى كلاسيكيات زمنه هذا مع حسن التقدير، وقد بنى الناقد عبدالعزيز موافي مثالا كتابه " قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية ـ بكل أسف ـ على هذه العناصر التي تجاوزتها الشعرية الغربية قبل أن تتجاوزها الشعرية العربية، كذلك فعل كل من جودت فخر الدين وعز الدين المناصرة .
إن كل ما يمكن قوله هنا أن قصيدة النثر العربية وفى القلب منها القصيدة المصرية ـ أنجزت ملامحها الخاصة التي تناسلت من مصادر عدة منها ما هو عربي ومنها ما هو غربي، وفى كل الأحوال فإن ارتباكات الخطوات الأولى وتعثراتها أو شكت على نهايتها، وبات بإمكاننا أن نشير إلى الشعراء بأصابع التعريف المغلظة، ودعونا لا نستعدى المستقبل ولا نتعجل النهايات، فلا بد أن يصل الضوء والهواء إلى الحديقة كلها حتى يتسنى لنا بعدها أن نتعرف على زهورها حتى لو كانت عيوننا مغمضة .
*******
بقيت كلمة قصيرة تستهدف الشكر الجزيل الذي يجب أن أوجهه لكل الأصدقاء الذي شاركوا في هذا الكتاب، فلم يتوان أحد منهم عن الدفع بمشاركته بأسرع مما توقعت.
وقد رأيت أن يكون كل مشارك على علم تام بما أفعل وما أنتويه، حتى لا يعتقد البعض أنني أقدم نفسي كعراب لهذا الجيل، فليست هذه نيتي أبداً، لذلك رفضت القيام بعمل المختارات من واقع دواوين الشعراء، وتركت الفكرة أمام سمع وبصر الأصدقاء، وجميعهم وافقوا على ما طرحت. وعلى الفور قام معظم الأصدقاء بكتابة شهادتهم واختيار قصائدهم وقلة قليلة وافقت من حيث المبدأ وتركت لي شاكرة – حرية الاختيار.
وإذا كان لابد لي أن الوجه شكراً خاصاً فسوف يكون لكل من الشعراء عبد المنعم رمضان الذي دفعني بقوة إلى الاستمرار في هذا العمل مؤكداً : أنني يجب أن أغتنم كل فرصة تخدم جيلي وتقدسه بالشكل الأمثل.
كذلك لابد لي من أن أشكر الشاعر فتحي عبد الله الذي دعم الفكرة بكل قوته وكان من أوائل الشعراء الذين بادروا بتقديم قصائدهم وشهاداتهم، وكذلك الشكر نفسه للشاعر أسامه الدناصوري الذي تكبد عناء الاتصال بكل من الشاعرين أحمد يماني ومحمد متولي وقام بنفسه باختيار قصائدهم بناء على موافقاتهم.
وفى النهاية لا أستطيع الزعم بأن الكتاب يغطى كافة الأسماء الفاعلة بالمعنى الإحصائي، فليست هذه مهمته وربما غفل الكتاب أسماء لها مكانتها، لكنى قدمت ما أعتقد أنه يمثل هذه الخريطة المعقدة المتشابكة بكل تناقضاتها.
*****
-1-
 عندما دعاني الصديق الشاعر"عماد فؤاد" للمشاركة في هذه التحية للمشهد الشعري المصري، توجست قليلاً، لكوني لا أجيد الكتابة عن الشعر بمعزل عنه، ثم وعدته بالكتابة عنه، ذلك لمدى تأثري بحضوره البليغ كل نص ينحو بفرادة لا تطاق.
عندما دعاني الصديق الشاعر"عماد فؤاد" للمشاركة في هذه التحية للمشهد الشعري المصري، توجست قليلاً، لكوني لا أجيد الكتابة عن الشعر بمعزل عنه، ثم وعدته بالكتابة عنه، ذلك لمدى تأثري بحضوره البليغ كل نص ينحو بفرادة لا تطاق.
دوماً كنت أتوق لتجسد فضاء يستضيف التجربة الشعرية في مصر، ويدعها لتأتلق وحدها في حرية هذا الملكوت الأزرق.
عندما بدأ مشروع "الديوان" يتخلق ويتحول لإحدى الشرفات المغوية لي، لأمضي أمسيات عديدة، وأنا أتامل تلك النصوص المبهرة في قدرتها على تنضيد الحروف لتمس أتون الروح.
قد نتفق على مسار الغبن الجلي الذي تتعرض له أغلب الإجتهادات الشعرية العربية الفتية، المنفردة برهافة المكاشفة، حيث عم الخلل منصات الكتابة بكل تجلياتها، وتحول النظر عن النص الإبداعي نحو اشتغالات أخرى.. لا تمت بصلة لجمرة الخلق بل لأواصر إجتماعية، ذات مرجعية لبداوة قبلية، يزدان بها الموغل في عبء ذاك الإنتشار المبهج.
تلك المسارات - للأسف الذريع- تتراكم، وتتدافع نحو معايير زائفة، بدت تتعاضد، وتتحول إلى مزارات، وتكايا يحوم حولها المتشابهون في الوهم.
قد نتفق على كل ذلك، لكن مايحدث للتجارب المصرية الجديدة المزدهاة بفرادة القول ونفاذه، أقسى بكثير من ذلك، و.. غير قابل للصمت.
من الصعب حصر تلك المهاوي التي تعصف بالتجارب الشعرية التي تخوض وحدها تحديات حاسمة نحو الذات والنص، ولكنها مضطرة لأن تخوضها..
للأسف ضد اعتمالات غير ثقافية ومتردية أيضاً.
-2-
ألا يكفينا استبداد الأوصياء على الشعر، وتنويعات هذا الاستبداد المتشعبة في كل حال، من نواصي الإعلام وتفرعاته، هيجة المهرجانات، حمى الجوائز، التبجيل غير النقدي، أسواق عكاظ الالكترونية، وما خلقته من ظواهر تفشت فيها الخلافات، والمماحكات، هجمة الإستهلاك الثقافي بأواصره وجذوره المتشعبة في هيكلية مرتكزات الحضور الثقافي، تكريس المكرس، تبجيل التفخيمات اللفظية أمام من يدونون ما يشبه الشعر، كل هذا يتصاعد أمام حواجز حديدية تتعالى.. لتلغم كل هذا الهواء.
-3-
مع كل ذلك كله،
يأتلق النص
وحده.
-4-
حباني الله بتقديره العليم بي، لأمضي سنوات من عمري الدراسية في مصر، فاعتدت على عذوبة الوقت وجرأة الشعر هناك، تعرفت على تفاصيل صغيرة شحذت ذاكرتي بطقوس خاصة لم أرها إلا في مصر، رائحة ما.. تترجم التوق الذي يتهاطل فجأة في كل مكان.
لذا اعتدت كلما قرأت نصاً شعرياً آت من هناك، أن أتحرى عن تلك الرائحة ذاتها.. التي بدت تتخلل في مشاهد ترتسمها الكلمات ببطء، فيذوب مذاق مصر الفريد في هواء الورقة، ثمة علاقات تنحتها الحروف لها نكهة النيل لا الحبر.
زرقة حبر مغوية، تحققت لي في أكثر من تجربة شعرية استوقفتني طويلاً.. قبل أن أتدارك الغصة التي تخافقت نحو قلبي، لأسأل:
لماذا يتم تغييب تجارب شعرية بمثل هذه الحساسية النادرة؟
ضمن أي منظور حضاري لا يلتفتون لنبض يتصاعد على حافة غبن الذاكرة؟
لأهمس لي:
أمام النص الشعري المتفرد برؤى الجنة، لا مكان للنعي أو التعويل على حاضر يحتضر ببطء، لا بد من تكالب المحن التي لا تعي ما يتجمهر من حساسية مشرفة على الحب.
لا مجال لسبر أغوار المدهش الذي يواكب هكذا أجنحة كفيلة بسر الكون:
المحبة والنور.
-5-
رغماً عما أغدقتنا به أحابيل الثقافة الصحافية التي تحتل جل المشاهد الراهنة، من تداول مغرق بالأزمات وكيل المصاعب، إعلان الموت البطيء للشعر العربي، رغماً عن النقاد المتحصلين من ورق الهذر هذا، من يكيلون الهباء تلو الهباء، والمديح تلو المديح، والخسارات تلو الأخرى، رغماً عن وقت يلتهي بهزائم الكلام:
يأتلق النص الشعري كشمعة في أسر الذات المتوحدة بالكون وحده.
لست الشاهد الذي يحتل الطرف المغوي من حافة القبر، ليشهد على ديمومة نفضة الروح..
لست الرخام الجسور الواقف في مقبرة هذا الوقت العربي الواهن، لأشهد لإحتدام الموهبة..
وحده النص الشعري المصري يكتنز بسره الكفيل بكل ذلك.
ثمة حروف منصورة برؤاها المغايرة، تشبه مصر، بحرية تتسع لتشرف على هذا الهواء، حروف تدرك ما يعنيه ذلك.
كلماتي تطال المواهب الشعرية التي اتقنت هطول الشعر وحده.
لذا، لا يعنيني سرد الأسماء التي استهوت قلبي ومخيالي بحروفها الجازمة بحفر مراقي الروح..
لا تشكل الأسماء مقصداً.. عندما نفتش عن الشعر..
وحدها الصورة الشعرية النابضة بمعتركاتها الموحدة حول نبر سؤال الهوية:
تحدينا الأول والأخير
نحو انتشال ركام الماضي الراهن، المستند على شعارات القومية والاقليمية الضيقة، رهاب الأديان والمذاهب.. كل ذلك من أجل الابتهال نحو الهوية الأعمق، وسؤالها المنتهب هموم الإنسانية المتقدة برواجها الأعظم، رأفة بهذا الكوكب الذي يحترق ببطء هائل
نحو الشعر
حد الحضور العميق في مسارب التجديد الحداثي بمعناه الأزلي كصيرورة كونية
حد الحفر الأركيولوجي العميق نحو الذات كمعرفة وسؤال وجود لديمومة الروح
حد الخجل العميق الذي يتصف به
حد الهمس لأرواحنا بتعاليم الشعر
حد الحب الكاهن في النص
حد كل شيء يقترب من معنى الحياة.
*******
 مازلنا على قيد الحياة!
مازلنا على قيد الحياة!
شكرا لك يا إلهي الطيب!
فنحن مازلنا صامدين هنا
بقلوب أوجعتها الحشائش الطفيلية
فهكذا خلقنا
ريفيون فقراء نأتي ونمضى كآبائنا
دون أن يشعر بنا أحد..،
نهذى عن الغربة والسفر
والأرصفة التي لا ينتظرنا عليها أحد.
بداية.. من المؤكد أنه كانت هناك قضية، وكانت هناك أيضا طفولتنا التي تربت على انتظار الرخاء في عام 0002، كما بشرت به القيادة السياسية للبلاد، وانتظرنا، لكننا أدركنا حجم الخدعة لكبرى، فمازلنا نرسف في فقرنا، كما أننا فقدنا الحلم بعدالة الأرض والسماء، أصبح ظهرنا مكشوفا دون أحلام، وليس ثمة من جدار نرتكن إليه، لم يعد هناك مكان إذن لـ "نحن" فلتظهر الـ "أنا" رأسها على استحياء، وليكن السؤال: ماذا تريد؟ أنا؟ أحتاج كثيرا من الوقت والحزن لأكتب نصا صادقا يوازى خراب الروح، وصحراء الجسد، وخواء العالم، وتخلى الأصدقاء، والخيانات الصغيرة للنساء، باختصار.. يوازيني أنا في لحظاتي العبيطة الفرحة، وغيرها من لحظاتي الإنسانية المختلفة• ليس أمامي سوى الهذيان عن الجسد كأحد "التابوهات" التي انتهكتها في وضح النهار، وليلا عندما خلوت بنفسي، خجلت مما صنعت يداي، لأنني في واقع الأمر أمعنت في المحافظة على خطوات محسوبة تبعدني عن جسدي الحقيقي، وسأظل محتفظا بهذه المسافة مع أي نصر مزعوم أدعى تحقيقه داخل النص، وبكل زهو وثقة - يمتلكها كل المدعين - صنعت من ذاتي إلها صغيرا، ليكون حقدي مبررا حين أمسك بأي إله من تلابيبه بشكل غير لائق، وكأن هذا كان امتدادا لاستدعاء >فرويدى< خاص بقتل الأب المجازى والحقيقي، آملا في صنع بطولة زائفة أخرى. رأيت أن قوتي تكمن في هذه الخسارات التي أكسبها، وهذا اليقين المزعزع، فالهزائم في الشارع، والكوابيس تحت الوسادة، وآدميتي مهدرة في الأتوبيسات العامة، والغرف الضيقة التي لم تأتلف معي.. فادحة تجاربي المتواضعة، ومع ذلك مازلت أعيش، فهل يكون بعد ذلك من المناسب أن أوقع هذه التجارب في تفاعيل ومفردات متأنقة، وجمل غائمة، وصور خاوية من المعنى، كل هذا ليهتف الآخر الذي لا أعرفه (الله.. ياللجمال).. هل أكون كذلك متسقا مع واقعي؟ يحق لي الآن أن أضحك مع نفسي حين رددت مع أحد أنبياء الحداثة (أنا أكتب ما نسيه الله ولم يكتبه)، فعلى قدر ما تحمل هذه العبارة من غرور، فهي تحمل تعاليا على المتلقي الذي لابد سيصبح من واجبه أن يتلقى الخطاب الشعري/ اللاهوتي منصاعا لهمهماته دون جدل أو اشتباك معه، هناك إذن أصولية شعرية تستطيع تكفير الآخر/ الضد، وإهدار دمه الإبداعي أيضا• ستكون السخرية سلاحا مريرا لمواجهة العالم وقوانين الطبيعة، ولمواجهة إحباطاتي في الأساس، لن أتوارى كما فعل سابقو السابقين، وراء لغة مجازية، أخفوا بها تشوهاتهم وساديتهم حين تلذذوا بها في تعذيب الآخرين، وإيهامهم في الوقت ذاته بأنهم أنبياء يحملون صليبهم على ظهورهم، أو فرسان يقبضون على الكلمة كالقابضين على الجمر (لقد تقمصت هاتين الصورتين على مدار ديوانين - لم أدفع بهما للنشر - وفيما بعد اكتشفت أنهم يكتبون عن الحياة، لا يكتبون الحياة، يكتبون لتكريس سلطة لا لتقويضها، يكتبون قصائدهم على الشاطئ، راصدين حركة الموج خشية أن تبتل أقدامهم). كيف أسجل شهادتي، وأنا لا أستطيع الإمساك بتلك اللحظة المراوغة التي تشكل لحمة النص، كل ما أعرفه أنى تخليت عن طموحي الأول بمحاولة الوصول إلى مرحلة تكتبني فيها القصيدة إلى مرحلة أكثر رحابة أكبت فيها النص - دون تصور مُسبق - مسيطرا على أطرافه بمنطق الصياد، وبالتداعي الشعري أحيانا، حيث يتخذ السرد مكانه في قلب النص. أنا أطمع في اصطياد سمكة كبيرة، حتى لو وصلت بها إلى الشاطئ هيكلا عظميا كسمكة "هيمنجواى" في "العجوز والبحر"، في كل مرة أرمى فيها شباكي أنتظر هذه السمكة، فلينتظر العالم (آه العالم.. هذا الماخور الكبير أو الفخ الأكبر لن نطرحه خارج اللعبة.. فله الفضل الأول في إتقاننا الكذب على أنفسنا، وعلى الآخرين). تخليت عن أشياء كثيرة، إذن يمكن القول إنني أكتب نصا يتخلى عن أن يكون ذا موقف، هذا النص لا يدعى التحقق الكامل، أو الانتصار لقيمة أخلاقية، أو حتى جمالية، أكتب كما أرى بعد أن أقبض على ما حولي، وما في داخلي، أظن أن في هذا ما يكفى لكي لا يغضب مجددو الأمس لأن بساط التجريب الذي منحهم أرضا يقفون عليها، وسماء تتطاول فيها قاماتهم سيظل ثابتا تحت أقدامهم، فالنص الجديد - كما أوقن - لا يحتمل مهاترات الريادة، التفتيش في ذاكرة التاريخ القريب، للبحث عن صنم حمل على عاتقه لواء التجديد، لقد انتهت محاولات البحث عن حصانين يجران العربة. "جدة" مدينة تسكنها الظهيرة: تنتظر من شباكك لا شرفات هنا..، وتقئ المدن جميعاً تخرج للشارع.. لا تبتسمُ إلى أن تقرأ لافتةً: (ابتسم أنت في "جدة") جَسَدَ المكان شمس "يوليو"، والرمال الحارقة، والوحوش المغتربة، لم تجد مكانا لجسدك الضئيل وسط مجموعة من البشر ستعود إلى الوطن بهيئة براميل لها لحى ينقصها التهذيب، كان طبيعيا أن تظل حبيس الشقة أكثر الوقت، وفى النوم، يتكرر المشهد: يدان تمتدان لتفتحا رأسك، وتعبثا بمحتوياتها، فتعاودك كوابيس خيباتك الأولى، تصحو مرتعدا، تتصبب عرقا وحمى، تبحث عن ورقة وقلم، تكتب - متخلصا من التفعيلة للمرة الأولى - عن المدن الغارقة في وحل الأجناس، عن المرأة التي ارتدت النقاب وعباءتها السوداء فوق (الجينز)، و(التي شيرت)، قبل هبوط الطائرة بدقائق، تكتب عن رجال الجمارك الذين طوحوا "ذات" "صنع الله إبراهيم" بعيدا عن مرمى البصر، ثم سألوك بعد مطالعة "جواز السفر": هل أنت مصري أم عربي؟ كيف ستواجه هذه الصحراء وحدك - دائما كنت وحدك - دون كتاب، دون كتابة• لكنك كتبت، أنت الذي تعتقد أن العلاقة بالمكان تحدد شكل وفحوى الكتابة وكل مكان لا يمنحك أمانا ما ولو كان وهميا هو بمثابة تحذير بإمكانك التوقف عن الكتابة• استدعيت جسدك الحقيقي، وأماكنك الخاصة، وأشياءك المحببة، وكان لابد أن تكون مفرداتك حقيقية كحياتك، أنت مقيد، والكتابة وحدها تفتح لك سماء حريتك، فلتخلص النص من الكلس التراثي والتاريخي، والهواء الملوث بالنفط والبلهاء الذين لا يعنيهم موت "جمال حمدان"، بأسطوانة غاز. هكذا قلت لنفسك سيكون منطقيا - وواقع الحال كما ذكرت - أن تستخدم لغة تناسب المهمشين فتتساوى لديك العلاقة بين الدال والمدلول، إذ يصبح التقرير غير منبوذ حين يتحول إلى بناء كلى، منحيا الصور الجزئية جانبا. وكأن هذا النص سيفقد قوته إذا تحول إلى متن، لأنه سيحاول أن يتقن مسوح المتن من تعال لغوى، والتحول إلى سلطة تؤدى به إلى التشابه في النهاية. اكتب مستعينا بطفولتك، بأصدقائك، بأماكنك التي تحب وتكره، بأجساد النساء اللواتي عبثت بها في الغرف الرطبة المعتمة، ومن الممكن أن تستعين بالخبرة البصرية للكاريكاتير متفوقا عليه برسم الملامح الداخلية المبالغ فيها أيضا. أنت حُرٌّ فاكتب الجنون والفوضى بلغة حية هي الحياة ذاتها انج بنفسك قبل أن تتصدع وتنمو الأعشاب فوق أعضائك.
*******
 أنظر للمشهد الشعري فأراه ثريا جدا ومتنوعا ومتجانسا تماما مع اللحظة التي نعيشها، وهو بحاجة فقط للنظر إليه بشيء من التفتح والهدوء وتجاوز الأفكار المسبقة ولو مؤقتا، هو بحاجة إلى فعل نقدي جاد، وهو ما لن يحدث قريبا، بحاجة إلى سقوط جدران غليظة تبعد أي مخلوق عن الشعر، وهو ما قد يحدث وأحسبه لن يحدث، كما أن بعض الشعراء أيضا بحاجة للهدوء، فلم يعد هناك مبرر للانشغال بكسر شيء من أجل الفرح بكسر شي، أو الدفاع عن أسلوب معين، بعضنا وقد خرج من عبودية قرون طويلة، وصار سيدا أمام الورقة، لا يصدق الوضع، بعضنا يصدقه بهيستريا من يحمل صراخ آلاف الأجداد، وآلاف الجروح التي يجهل مواضعها، لقد سقط من القيود ما يكفي لنضج أكبر، سقط من الأوهام ما يكفي لكي ننتبه للشعر على نحو أفضل وأعمق، وخلت الساحة الذهنية من الأصنام بما يكفي لجدية أشد وصرامة داخلية أقسى من صرامة الوزن والقافية، صدور ديوان لم يعد يعني شيئا، حضور مهرجان لا يعني شيئا، الرغبة في الحصول على اعترافات بتجربة ما، لا يعني شيئا، المناخ خارج الورقة أسوأ من الرهان على شيء، سقوط المراهنة هدية أيضا ولابد من استغلالها، لم يعد في وسعنا الآن أن نصير ثمرا ولا شجرا، في وسعنا أن نكون جذورا تحت الأرض وهذا ما نفعله بضراوة، وبحرية داخلية أكبر، لسنا بحاجة إلا للطين، الطين فقط، الطين الحقيقي، حين نحاول رفع رؤوسنا والتطلع في الهواء سنموت، وخسارة الغصون يمكن أن تعوض، بتر الساق يمكن أن يعوض، العبرة بالجذور وهي تسري في صمت، ولا تعرف جهة محددة تقصدها، لا شأن لها بعرف الجهات، ببساطة تزحف في الأعماق، وكلما عثرت على حجر التفت حوله مثل شبكة وصار في قبضتها، نحن جذور فيما يحسبنا الناس أبعد ما نكون عن الجذور، نحن جذور وحسبنا أن نحافظ على أنفسنا.
أنظر للمشهد الشعري فأراه ثريا جدا ومتنوعا ومتجانسا تماما مع اللحظة التي نعيشها، وهو بحاجة فقط للنظر إليه بشيء من التفتح والهدوء وتجاوز الأفكار المسبقة ولو مؤقتا، هو بحاجة إلى فعل نقدي جاد، وهو ما لن يحدث قريبا، بحاجة إلى سقوط جدران غليظة تبعد أي مخلوق عن الشعر، وهو ما قد يحدث وأحسبه لن يحدث، كما أن بعض الشعراء أيضا بحاجة للهدوء، فلم يعد هناك مبرر للانشغال بكسر شيء من أجل الفرح بكسر شي، أو الدفاع عن أسلوب معين، بعضنا وقد خرج من عبودية قرون طويلة، وصار سيدا أمام الورقة، لا يصدق الوضع، بعضنا يصدقه بهيستريا من يحمل صراخ آلاف الأجداد، وآلاف الجروح التي يجهل مواضعها، لقد سقط من القيود ما يكفي لنضج أكبر، سقط من الأوهام ما يكفي لكي ننتبه للشعر على نحو أفضل وأعمق، وخلت الساحة الذهنية من الأصنام بما يكفي لجدية أشد وصرامة داخلية أقسى من صرامة الوزن والقافية، صدور ديوان لم يعد يعني شيئا، حضور مهرجان لا يعني شيئا، الرغبة في الحصول على اعترافات بتجربة ما، لا يعني شيئا، المناخ خارج الورقة أسوأ من الرهان على شيء، سقوط المراهنة هدية أيضا ولابد من استغلالها، لم يعد في وسعنا الآن أن نصير ثمرا ولا شجرا، في وسعنا أن نكون جذورا تحت الأرض وهذا ما نفعله بضراوة، وبحرية داخلية أكبر، لسنا بحاجة إلا للطين، الطين فقط، الطين الحقيقي، حين نحاول رفع رؤوسنا والتطلع في الهواء سنموت، وخسارة الغصون يمكن أن تعوض، بتر الساق يمكن أن يعوض، العبرة بالجذور وهي تسري في صمت، ولا تعرف جهة محددة تقصدها، لا شأن لها بعرف الجهات، ببساطة تزحف في الأعماق، وكلما عثرت على حجر التفت حوله مثل شبكة وصار في قبضتها، نحن جذور فيما يحسبنا الناس أبعد ما نكون عن الجذور، نحن جذور وحسبنا أن نحافظ على أنفسنا.
أريد غزالة من أي نوع
ما الذي بوسعي لأقدمه غير نصوصي، تجارب الأصدقاء وكثير منها ناضج وحيوي ومتميز تحتاج كما قلت لفعل نقدي كبير، ولست مستعدا للتنظير لها، لأنني أولا لست مؤهلا بما يكفي، كما أني أخاف على نفسي من التنظير، أنا في الحقيقة أكتب وفق مفهوم البركة، أجلس كل يوم لثلاث أو أربع ساعات في حجرتي - وطوال اليوم أكافح من أجل أن لا تسقط من على وجهي نظارة الشاعر، جثة أصير لو سقطت -، أقرأ وأتأمل وما يقتحمني أكتبه كما يريد هو، ثمة دور لقراءاتي وتأملي طبعا لكن الغزالة تجري هنا وهناك وأنا أجري وراءها حتى تسقط في حضني، أجري كما يجري ولد وراء بنت في حديقة عامة أو على شاطئ البحر وهما يضحكان، أحيانا أريد أية غزالة من أي نوع، يكفي أن أشعر بأنها غزالة، ولا يهمني إن كانت بحجم نملة أو فيل، لا يهمني إن كانت بلا جلد أو تحمل درقة، هل أخاف من التنظير لأن تجارب سابقة ملكت كرابيج من خلاله؟ بعضها دعم ريادة بكلمات نقلها وشغلت من النقاش أكثر مما شغلته نصوصه، بعضهم خنقه تنظيره، ولى زمن الرواد والنجوم، وصار كل شيء مكشوفا، هل أخاف لأنني لا أعرف أية غزالة ستجري أمامي غدا، لأنني أعول فقط على نصوصي، ولا أجد مبررا لحمايتها بالتنظير لآخرين كما حدث مع الكثيرين، ما جدواها إن ظلت خرساء أمام قراءة متفتحة تتطلع بجدية واحترام ودون أفكار مسبقة، ما جدواها إن لم تكن حية تسر الناظر، هل تحتاج سمكة غير اضطرابها في الشباك لتقول إنها حية، وهل تكون ميتة لمجرد أن المتطلع أعمى، نصالي تكفي بالكاد لأحادي بها نفسي، لأصوبها باتجاهي.
وردة في القيامة
أحيانا أكتب كمن قامت القيامة وفي يده فسيلة، يزرعها ولا يفكر في القيامة، يزرعها بأمل من ينتظر منها جذعا طويلا، وفروعا متشابكة، وثمارا حلوة، يزرعها وخياله مع أحفاد يجنون ثمرها، مع غرباء يأكلون منها دون أن يسألوا عن زارع الشجرة، وإن سألوا لا أحد يجيب، القيامة قائمة، وفي يدي ما أحسبه فسيلة، أغرسها لا مباليا بمصيرها، لا مباليا بقيامة قامت. أزرعها وأقطف منها في نفس اللحظة ما يكفيني، ما أظنه يجعلني أعيش على نحو أجمل.
بإصبعي أكتب في الهواء
في أوقات كثيرة، تخطر في رأسي كلمات، صورة تعجبني، أتابع الكتابة في رأسي، أعجن الجمل وأحبكها بهدوء، أتابعها حتى تكتمل، أو حتى آخر ما يمكن لجهدي بلوغه من اكتمالها، أعيش معها لحظات جميلة، ثم لا أكتبها، نعم لا أكتبها، أعيش معها وقتا وأتركها تتبخر، أحيانا أكون سعيدا جدا وهي تتبخر، خاصة حين أكون معجبا بها، كأنني أنتقم بتركها تتبخر، لا أجد مبررا لكي أتعب نفسي وأكتبها، مرة أقول: هل هناك من ترك مصالحه ومشاغله وأوقف كل شيء في حياته ليسأل عن قصيدة لي، حياته صارت متوقفة تماما حتى يقرأني، وها هو يبحث عن كلماتي بشتى الوسائل، أتخيل ذلك وأضحك، أضحك من قلبي، لا يحدث ذلك مع شعراء كبار جدا، فلماذا أكتب لمن لا ينتظر مني شيئا؟ مرة أقول شيئا آخر: لماذا أجهد نفسي من أجل لا شيء، لا شيء أتخيله قارئا جادا ومتفتحا وحساسا، أتخيله وهو يشتمني حين يتورط في قراءة سطرين لي ولا يجد ما يشجعه على المواصلة، يشتمني وهو يجد كلمة قلقة وليست في مكانها الصحيح، يشتمني وقد رآني أصطاد شيئا وأفسده، يريدني في منتهى الدقة، يريدني مدهشا، يريدني عميقا، يريدني مسيطرا تماما على أدواتي، ويريد يدي لترفعه كي يقفز من حياته المعتادة لحياته الحقيقية، وحين يشعر بأصابعي رخوة ولا تحتمل جسده يشتمني، هكذا أكتفي كثيرا بممارسة الكتابة دون قلم أو ورقة، وفي لحظات قليلة أندم على عدم الكتابة، أندم ندما خفيفا وعابرا وأتساءل عما يبرره، في لحظات أخرى أحاول استعادة ما كتبته بإصبعي في الهواء دون أن أخرجها من جيبي، أحاول استرجاع ما تبخر ولا أستطيع، لا أحزن لفشل المحاولة، بإصبعي وهي في جيبي أكتب كثيرا، لا أجد مبررا لمسك القلم والكتابة، النص الذي يغويني لا يهم أحدا سواي، لا أحد ينتظره، لا أحد سيفكر في حمله مثل رضيع، يحدث هذا معي كثيرا، وكلما مرت الأيام كلما زاد ميلي له.
سحقا لمن لا يتطلع إلا بذاكرته
عام 1983 كتبت قصيدة مقفاة، وبذلت بسبب الخوف والخجل مجهودا خرافيا في عرضها على مدرس اللغة العربية وعندما تمكنت من عرضها، ابتسم، وسألني عن الوزن، قلت وما الوزن؟ قال موسيقى تكون في أعماق الشعراء الموهوبين يكتبون وفق قواعدها، وأنه درس الوزن لكنه لا يستطيع الكتابة لأنه ليس موهوبا وحدثني عن صعوبة الشعر وعبقرية الشعراء، حدثني بما يكفي لأخرج بقناعة راسخة بأني لست موهوبا ولم أجرب ثانية كتابة حرف واحد، كنت أتجنب حتى النظر إلى قصيدة كمن ضبط متلبسا بعار الجرأة على الشعر، كمن ضبطوه يسرق وأشفقوا عليه من تسليمه للشرطة بعد أن أقسم على أن لا يعود، ألا سحقا لمن يفتي في الشعر بغير قلب، سحقا لمن يفتي في الشعر بلا علم، سحقا لمن يفتي في الشعر - مهما كان - بيقين وجزم من عرف الحياة منذ بدايتها حتى فنائها ومكث سنوات في كل روح وشغاف، سحقا لمن لا يتطلع إلا بذاكرته، وهذا للأسف ما يفعله معظم النقاد، لا فقط المدرس البسيط الذي نظر إلى الأوتاد والفواصل الصغرى والكبرى ولم يلتفت إلى روحي.
هذا شعر لا قصة
عام 1987 كتبت قصة قصيرة متأثرا بانتفاضة الحجارة، لم يكن في البال كتابة قصة أخرى، كنت غاضبا وحزينا وعاجزا وأريد أن أفعل أي شيء، لا لأوقف شيئا بل لكي لا أنفجر، ولم أجد حضنا غير الورقة فكتبت، كتبت لنفسي غير أن الصدفة تقريبا أوقعتها في يد شاعر اسمه سيد عبد العاطي يتمتع بقدر كبير من الشهرة في مدينتي، وصدمني بأن علق عليها قائلا إنها ليست قصة بل قصيدة، وإنني شاعر، وارتجفت (لماذا؟)، وسألته عن الوزن ذلك الأسطورة والإمكانية الخارقة التي لابد للشاعر أن يولد بها فابتسم، وقال لا وزن فيها، وطالبني بضرورة تعلم الوزن عن طريق حفظ نصوص قديمة والتغني بها بطريقة معينة وأعطاني كتابا صغيرا في العروض وخرجت من عنده كمن يطلب ثأرا، لم أنم حتى الصباح عندما خرجت بدراجتي إلى العمل وأنا أدندن بتفعيلة الكامل. وبعد أسبوع واحد كتبت قصيدة قال سيد عبد العاطي إن بها ثلاثة أخطاء عروضية، وإنها أقل جمالا من التي سمعها في المرة السابقة.
غليان المرجل
ثمة مرجل كان في الصدر وها أنا أستيقظ على غليانه، وأمضي كالمجنون (لماذا؟) لا أعبأ إلا بما يقربني خطوة من إدراك شيء عن الشعر، كنت حتى هذه الفترة لم أقرأ من الشعر ما يستحق الذكر، إلا ما كان مقررا في المدرسة، ما لم يدخل في رأسي شيء منه سوى تينة إليا أبي ماضي الحمقاء، وفي نفس الوقت تعرفت على شاعر آخر هو عطية حسن، الذي ساعدني بإعارتي بعض الكتب، كان وصولها إلى مدينتي معجزة لم تتحقق إلا على يديه، فرحت وفي وقت واحد أقرأ مفتونا كل ما أجده في يدي، في وقت واحد أقرأ المتنبي وأمل دنقل، فؤاد حداد والماغوط، درويش وأدونيس، أقرأ تجارب متباينة لا أقف بوضوح على تباينها أوتصادمها، أقرأ وأعجب بها جميعا، وفي نفس الوقت أتابع ما ينشر في الدوريات خاصة أعمال الشعراء الذين ظهروا كسلاطين جدد للمشهد الشعري في مصر تحت شعار جيل السبعينات، تابعتهم معجبا بتجاربهم ثم متسائلا حولها ومراجعا بهدوء وقلق من يبحث لنفسه عن سكة ويرغب في الإمساك بطرف خيطه هو مهما ذهب به ذلك الخيط، هكذا تقلبت طوال خمسة أعوام بين أشكال مختلفة، فتارة أهتم بالجمل المنحوتة نحتا والقوافي الحرة، وتارة أهتم بالمجاز، وتارة أهتم برسم الصور الشعرية وغيرها، وفي كل تلك المحاولات كنت محافظا على الوزن طبعا، ولا أنظر لما يخلو من الوزن باعتباره خارجا عن الشعر، وكان بعض الأصدقاء يستغربون ذلك، مادمت أجيد الوزن فلماذا أتعاطف مع الأعداء!
صفر ما
في لحظة ما - دعوني أختصر- رأيت أن الوقت المناسب قد حان لكي أبدأ، من صفر ما، صفر أحاول التخلي فيه عن كل ما اكتسبت، أقول أحاول - متلمسا شخصيتي أنا، وباحثا عن تصور للشعر يناسبني أكثر، فمهما كانت فتنة وسطوة بعض التصورات، إلا أن اقتفائها لمجرد التحقق في ظلها لا يعدو أن يكون قتلا للذات، ثمة ما يصلح لسواي ولا يصلح لي، ما يرفع تجربة ويهدم أخرى، ثمة ما يميزني أو ما يليق بي وعلي أن أبحث عنه بهدوء، أن أترصده بعينيّ لا بأعين أخرى، لي ذات وحسبي أن أرفع من فوقها الطوب والنفايات، ثمة أفكار كثيرة كانت تتسرب إلى أعماقي خلال تلك السنوات وكانت تتراكم لتتجمع في قرارات داخلية، ثمة قناعات تترسخ مثل الموت الحقيقي في تقليد وتكرار الآخر أو حتى الأنا التي أنجزت، الشعر أكبر من كل تصور عنه، الحياة هي المنبع والمصب، كل إنسان هو إضافة حقيقية ووحده يحولها إلى وحل أو جواهر،، وغيرها وغيرها، ومع المزيد من التأمل كانت تسقط طموحات، وتتكشف مسالك، وتتلاشى تصورات وأوهام، وتظهر مبررات للعلاقة بالشعر تبلى معها الرغبة في الحصول على لقب شاعر. وتتكشف حماقة السعي في طريقي بأقدام الآخرين وأمل الوصول إلى ما وصلوا إليه.
يلوحون لي وهم لا يشعرون
أنظر لنفسي، موظف يعمل في المحكمة حتى الثالثة عصرا، ويعود ليومين كل أسبوع ليعمل في الفترة المسائية لموعد مفتوح قد يصل إلى الفجر، إنسان بسيط للغاية وبلا أحلام كبيرة، يعاني مما يعانيه أي (مواطن) في ظل أوضاع تقود إلى الجنون، قلب يحاول أن يعثر على هواء، كائن يقاوم موته بالشعر ويدرك أنه مليء بالتشوهات، وغارق في الأكاذيب، أو ضرير وضع يده في يد الشعر وراح ينظر بقدر ما يستطيع مؤمنا بأن الشعر قرين الرغيف، وأنه متغلغل في اليوم، كل اليوم، وفي قلوب كل الناس وفي كل مكان، وكل الثقافات، ثمة آباء حقيقيون كانوا يلوحون لي وهم لا يشعرون، وكنت أهتدي بهم.
شاعر الربابة
ارتبط الشعر عندي بشاعر الربابة الذي كنت أسمعه منذ مطلع طفولتي في المناسبات المختلفة، وعبر أشرطة الكاسيت، أسمعه وأنا أمشي في الشارع، وأنا ألعب، وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها تلك الشهادة ـ يأتيني صوته ضعيفا وواهنا من البيت المواجه لبيتي، الرجل الذي يسمعه وبجواره مجموعة من الجيران لديه الدش، تركه بقنواته وخرج إلى الشارع معولا على شاعر الربابة، لم يعد هذا الأمر شائعا بكثافة لكنه يوحي بما كان عليه الوضع عندما كانت ترن في أذني كلمة الشعر للمرات الأولى، أسمعه وأسمع مقتطفات من السيرة يرددها حتى الآن بعض المحيطين بي، لقد سمعتها بلا قصد وسمعتها بقصد وتركيز، وأحببت شاعر السيرة، وكان فيها ذلك العناق بين السرد والشعر، كان فيها الهرب مما جرى لأبطال من أحداث لعناق مطالب أخرى، فثمة هجاء مباغت للزمان يحمل في طياته هجاء لكل ما يعكر النفس ويعصف بالكيان ويزرع الحلاقيم بالحسرات، ثمة صبوة للجمال وغزَلا يتنفس في ظل حياة قوامها الشقاء والقسوة، ترى لم يؤثر فيّ شاعر الربابة؟ ربما فقد جاءت علي فترة وأنا أبدأ علاقة قوية بالكتب، ونظرت له بازدراء، لا، تبدو الكلمة كبيرة، كنت أتفتح عبر القراءة على ما يحمل فتنة أكبر من تلك التي انتقلت إلي عبر أعين المحيطين وإعجابهم به، وكان ثمة ما هو أكبر في تقديري من شاعر الربابة، شاعر الجمهور العريض، المحترف طالب المال بشعره، الجاهز لما يريده الآخرون لا ما يريده هو، الطارق فوق سندان ثابت، لا الراحل عبر الكلمات إلى المتجدد بتجدد حياة الناس وأحداثها الحية.
تقول قولها وتنساه
رغم فتور علاقتي بالشعر الشعبي ظلت هناك هيبة قوية، وفتنة متينة لمشهدين، مشهد جدتي، أو خالتي أو أمي وهي تعدّد بمفردها، في زاوية، تعدد كلما غمرها حنين لا أعرفه، أو عصفت بها عواصف الحياة، كنت أمر بالجسد المقرفص والوجه الناظر في موضع سجوده لو سجد، وأشعر بالشؤم فأمضي مسرعا، أمضي لألعب الكرة مثلا، وأفكر كلما وقفت، في تلك الكلمات التي تصبح حضنا وملجأ وإكسيرا يعيد لأجساد النسوة حيوية لا يعيدها سواه، كانت أمي تضحك على أتفه الأسباب بعد دخولها نوبة من العديد نظن أثنائها بأنها على مشارف توديع العالم، فيما بعد اقتربت منها لأجمع مخزونها من ذلك الفن معتقدا بأنها تحفظ الكثير والكثير، وفوجئت أنها لا تحفظ ما يذكر، فقط عدة عبارات مشهورة، وعرفت أنها كانت تنطلق منها لتقول قولها، كانت تألّف ولا تبالي بما تألفه، تألفه لنفسها في لحظة معينة وتتركه يطير، فيما بعد تابعت المزيد من كلمات العديد، تابعت حدتها، وتكثيفها وصورها وجرأتها، واقتحامها للمحرم وهي تخاطب الموت، ولا مبالاتها بالوزن كما أنزل، وخروجها على عمود الشعر، تابعت عجز المتدينين عن فعل أي شيء أمام صيحات الجذع وبسالة من يكلم الموت وجها لوجه وندا لند، تابعتها بينما كان يتسرب في أعماقي وعيا بالشعر لم أعرفه من خلال الكتب، تراني لم أتأثر بذلك؟ تراني تأثرت به وخنته؟ إلى أي مدى يمكن أن يتجاوز المرء ما هو متغلغل في أعماقه ومازال يؤمن به؟
بلا جمهور
المشهد الآخر كان لرجل يروي الحقل بالشادوف ويحدو، سمعته أول مرة ولم أره، سمعت صوته ولم أفهم كلمة واحدة، لم أتبين كلمة واحدة، حتى أنني كنت أظن في البداية أنه لا يقول شيئا، يعوي فقط عواء آدميا جميلا ومليئا بحسرة ووجع حاد، فيما بعد تساءلت عما يفعل، عرفت أنها كلمات، بعضها محفوظ، وبعضها يتم ارتجاله، وأن الذي يصدر ذلك الصوت يعمل على الشادوف، وهو عمل شاق جدا، حيث يظل العامل طوال اليوم يرفع المياه مستعينا بتلك الآلة التي استخدمها جده منذ قرون بعيدة، وسط حرارة الشمس أو برودة الجو بلا ساتر سوى ملابسه المبللة وبلا معاون سوى صوته، وسيلته لمقاومة التعب والوحدة، وتحرير الروح من سطوة الوقوف في موضع واحد، بجُمل قصيرة جدا لكنها تتمدد في عوائه البطيء حتى لا نكاد نميز أحرفها، وكما كانت تفعل أمي يفعل هو، يرتجل أكثر مما يحفظ بكثير، لا يعنيه جمهور، ويسره صوته حتى لو كان أجشا، وحيدا يردد بعيدا عن النفاق والتملق وصياغة المشاعر بحيث تعجب الآخرين حتى لو أدى ذلك إلى قتلها، وحيدا يردد وقد صار جزءا من الطبيعة المفتوحة حوله، كأنه طائر حقيقي يقف على عرشه ويطلق صوته الحر في البراح الممتد وما يحمله من سماء وشمس وشجر، وحيدا يردد كي يقاوم البؤس والشقاء والفقر والقهر بصنوفه، وحيدا يغني للحياة.
الخيط في يدي
هكذا كانت تتبلور بعض التصورات التي شجعتني لأن أكتب في صفر ما نهاية عام 1992: (خذلني الوقت، وخسرت كل شيء، حائط أخير تبقى، أنت يا ربة الكتابة، فرممي جسدي، تغمدي بحنانك كل فضائحي، ولا تدقي آخر مسمار في نعشي) وبعدها شرعت في كتابة نصوص مجموعتي الشعرية الأولي (الخيط في يدي) والتي صدرت عام 1997 في سلسلة إبداعات عن هيئة قصور الثقافة بعد انتظار الدور لثلاثة أعوام تقريبا وكانت صادمة لمن اعتادوا على قصائدي الموزونة، الشاعر الذي صفق البعض لقوافيه المنحوتة بإحكام كان غائبا، المجازات الكثيفة والصور والتركيبات اختفت، الذات الأسطورية القائدة حل محلها موظف صغير يحكي عن عجائز يترددن على مبني المحكمة طلبا لحقوق صغيرة خطفت منهن، الرائي العليم يقر بفشله ويطلب بداية متواضعة وبسيطة، يخلع نعليه ويسعى للسير في الطين، لقد أرسل لي أحدهم خطابا قال فيه إنه كان يسمع عني، وكان يحلم باقتناء ديوان لي حتى عثر على ديوان الخيط في يدي، مطبوعا على ورق جرائد لا يليق بالدرر، وأذهله أن سعر الديوان نصف جنيه، فاشتراه وعاد إلى بيته فرحا، لكنه حزن عندما قرأ، حزن وندم على الخمسين قرشا التي ضيعها فيما لا يساوي، وفرحت بتلك الخسارة، كان من الممكن أن أضمن مثل هذا القارئ، لو كتبت ما أعرف أنه سوف يرضيه، وما أسهل ما يرضيه، ولم يكن موقف صاحب تلك الرسالة هو الوحيد، ثمة أصدقاء دعوني إلى التوبة، وكنت أعرف ذلك مسبقا، لقد قرأت على شاعر نص عجائز إسماعيل فقال، هذا ليس شعرا، إنه قصة، وقصة رديئة، لقد آلمني لكني واصلت كتابة المجموعة ولم أفكر ثانية في عرض ما أكتب على أحد ممن حولي، ولم أفكر في نشر شيء منها، لم تكن النوافذ لتسمح بنشرها آنذاك، كانت هناك نوافذ نادرة يفتحها بعض الشعراء بقروشهم لكنني كنت بعيدا عنهم بسبب إقامتي في أقصى الصعيد وبالفعل لم أنشر منها قبل صدورها سوى ثلاثة نصوص في مجلة القاهرة.
*******
(1)
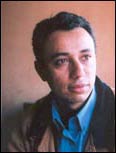 لكم تمنيت أن أصمت.. لا أكتب.. ولا أتكلم.. إلى أن تأتي لحظة تشبه سكرة الموت، فيقطر لساني وقتها بكلمات مكثفة، لا يهم أن تلقفها صفحات بيضاء أو يضمها كتاب، أو يرتلها الآتون بمحبة.. ولكن يكفي أن تسرى في روح الحياة، فتمنح الأشجار هزة خفيفة، والأنهار موجة حانية.. يكفي أن تذوب في الهواء، وأنا موقن بأنها ستصافح ابتسامة طفل، وستوقف انفجار عبوة ناسفة..و..تجعل الحياة أقل تعاسة.
لكم تمنيت أن أصمت.. لا أكتب.. ولا أتكلم.. إلى أن تأتي لحظة تشبه سكرة الموت، فيقطر لساني وقتها بكلمات مكثفة، لا يهم أن تلقفها صفحات بيضاء أو يضمها كتاب، أو يرتلها الآتون بمحبة.. ولكن يكفي أن تسرى في روح الحياة، فتمنح الأشجار هزة خفيفة، والأنهار موجة حانية.. يكفي أن تذوب في الهواء، وأنا موقن بأنها ستصافح ابتسامة طفل، وستوقف انفجار عبوة ناسفة..و..تجعل الحياة أقل تعاسة.
أي طموح رومانتيكي هذا ؟..وأية كلمات تملك هذا السحر والجبروت..؟! .. فطوال تاريخنا ونحن نهين الكلمات الكبيرة، نلوكها ونعجنها ونفرغ دماءها حتى تصير هياكل عظمية، ثم نغنيها وتعجبنا موسيقاها، فنركبها ونروض جموحها، ثم ندخل بها سباقاً طويلاً فتستوي معلقات، نفاخر بها ونعلقها على أستار الكعبة ليقرأها الطائفون..وها قد انتهت المعارك القديمة، وبقي صليل السيوف مختبئاً في اللغة.
تمر القرون تلو القرون ووقع حوافر الخيل محفور في الكلمات..أنصت إلى المتنبي فأقول: قد اكتمل الغناء، فلتسكتي أيتها الموسيقى المغوية.. كفي عن الضجيج.. ودعيني استمع إلى نبض الكون.. وأمرر أصابعي برفق على أسراره.
لكنني أندهش من نهر اللغة الذي سجناه في قوالب، وصببناه في أبحر، وكممنا فمه بالقواعد حتى خرس تماماً، وأتساءل: كيف لم يكسر سدوده وأعمدته الخرسانية؟!! .. كنت أتصور أن اللغة كالحضارة، حين تصل على ذروة تجليها تموت ثم تبعث من جديد.. لكن كيف يحدث هذا البعث ولدينا عدد وافر من قتلة الروح وعبدة النصوص ومحترفي إعادة إنتاج وتدوير الماضي..؟.. كيف.. ؟!!
(2)
ثمة جدل مقيت حول علاقة الشاعر بالواقع يثار كل فترة، وكأنني حين أحكي عن حبيبتي التي ألقاها على الكورنيش مذبوحاً بعدم قدرتي على تحقيق أي انتصار، وحين تدمع عيني لمجرد سماع هتاف "تعيش مصر حرة مستقلة" في مسلسل تليفزيوني تافه، وحين أرى الموت في عيون المارة، والكراهية في عيون من أحب..فإنني أكون منفصلاً عن الواقع ومحلقاً في خيالات متعالية..إذن ماذا يريدون..؟ يريدون شاعراً يقف شاهراً سيفه الوهمي في وجه الظلام القادم، وينبئ العميان بالخطر المحدق..
وهذا الشاعر الذي يرى ما لا يراه الآخرون هو "سوبرمان" الشعر السبعيني.. ذلك السوبرمان الذي وقعت تحت سطوته وزعيقه وتهويشه لسنوات طويلة، اتضح لي أنه سوبرمان "تايواني" – أونطه يعني - ..فقد اكتشفت أنني كائن ضعيف بإنسانيته المعذبة.. لا أملك قوى خرافية، ولا يمكنني أن أكون إلهاً يمر بيده على رؤوس المعذبين ليصيروا سعداء، ولا أستطيع تغيير هذا القبح الضاغط بثقله على الأرواح.. بل أنني أبكي..وأخاف..وأضبط نفسي وهي مختنقة بكراهية الوجوه البلاستيكية المزيفة.. وكل ما أطمح إليه بشعري أن أفضح حالة القبح المستشرية، وأرصد وجعي الخاص؛ انكساراتي وهزائمي، وأكشف اشتباك مشاعري مع قوانين الحياة المتناقضة، فأكتب ببساطة عن أشياء معقدة وليس العكس.. وأتمنى ألا يستنزف الواقع الشائه طاقتي الإنسانية في غير الشعر..فلست لا مبالياً ..بل أرى أنني متورط في الحياة أكثر مما ينبغي، حتى أنني مع كل هزيمة أفرد جناحي وأدور حول نفسي كما لو كنت أريد الطيران، أريد أن أفارق كل هذه الوجوه الحزينة.فلم أعد أحتمل الغباوات.. ولم أعد أحتمل التعامل اليومي مع كائنات لديها فائض من الكراهية ولا تعرف لمن تمنحه..
(3)
كان السبعينيون بالنسبة لي المثال الناصع للتمرد، أرواحهم الشعرية النزقة تمزق الأردية القديمة المتهالكة للقصيدة، وتبتكر لغة متفجرة تغري بالمحاكاة، لكني بعد أن هدأت الثورة، مشيت وسط الحطام بحثاً عن المشاعر الصادقة، وفتشت في كثير من نصوصهم عن الشعر، فجرَّحت كلماتي شظاياهم المتناثرة..
كان طبيعياً قبل أن يصدر ديواني الأول "كوميديا" عام1998، أن انحاز إلى هؤلاء الثوار المتهورين، وأن أنظر بريبة إلى جيل الستينات المحافظ/التقليدي. لقد التفت الخيوط العنكبوتية للقصيدة السبعينية على رقبتي فكدت أختنق، وشعرت بالهوة واسعة ومظلمة بين ما أكتبه من نصوص وبين تلك الجذوة البعيدة التي تسكنني.. فقررت الصمت.
لسنوات ست وأنا أبحث عني، الروح تفيض وما من آنية تتسع لفيضها، بدت كل القوالب ضيقة وعقيمة..إلى أن شعرت بلحظة أن قدميَّ تنفلتان من جاذبية الأرض، والنهر يكسر سدوده، فقيل : هذه قصيدة نثر.. ولا أدرى لماذا تنقبض روحي كلما سمعت هذا التصنيف "قصيدة النثر"، ربما لأنني أعتقد أن من يملك يقيناً إبداعيا مطلقاً، ومن يمنحنا تعريفاً دقيقاً لهذه المضخة الإنسانية الهائلة المسماة -مجازاً - بالشعر، فلينصب نفسه ناقداً لوذعياً يتقوت من ذبح الكلمات، وتنمط الشعراء ورصهم في طوابير، ربما لكي يسهل إسالة الخيط النوراني الساكن بكلماتهم..
(4)
فالشاعر خالق بالأساس، والشعر جسد ميت، ينبغي على قارئه أن ينفخ فيه من روحه لتتلاقى الروحان.. لكن هناك من يقرأون الشعر كمن يسددون طعناتهم إلى جسد القصائد، ثم يصرخون في وجه الشاعر قائلين: لقد لوثت أيادينا بالدماء..!!
والديوان هو الجسد المكتمل.. أظل لسنوات أكتب قصائدي – بسرعة- كمن يتخلص من عبء ثقيل، إلى أن تحضن كل قصيدة أختها وتلتئم.. وما إن أشعر أن روحا لضمت خيوط الأجزاء المبعثرة حتى أشرع في إصداره. وأفرح كطفل حين ينفخ قارئ في هذا الجسد وأحزن حين أراه يدمي.
وبعد أن اكتمل جسد ديواني الثاني "الذي مر من هنا" -2002- عكفت عليه كثيراً لأخلصه مما رأيتها أمراضاً نشبت أظفارها في لحم القصيدة الجديدة.. كنت في ديواني الأول أحفر عميقاً في روحي بحثاً عن لحظاتي الدموية.. فيما تطل الموسيقى برأسها كلما تعمقت يدي .. وفي ديواني الثاني لم أرد وأنا أرى كيف صارت تقنية المشهد الشعري-الذي تعتمده القصيدة الجديدة – مبتذلة وممزقة على أيدي بعض المدعين، لم أرد أن يزحف هذا المرض ليأكل قصيدتي، فقسوت على نفسي، ودمرت جزءا من هذه المشهدية لصالح التكثيف الشعري.. فعلت هذا وأنا أعرف أن هناك من سيشهرون سكاكين قراءاتهم العمياء في وجهي.. فلم أهتم..وقلت فليذهب أصحاب اليقين الإبداعي والنقدي إلى الجحيم، ولتخفت الموسيقى ويتعمق المعنى.
لي صديق عربي له يقينياته ذكر أنني سأمر على العالم مروراً شعرياً فحسب، أظنه يؤمن بخلود الكلمات، ولا يهمه كثيراً أن أمر من هنا عابراً بين أوراق الشجر كنسمة، حزنت قليلاً لأنني تخيلت الشعر كالأعمى وسط كل هؤلاء المبصرين.
(5)
تلك اللحظة السحرية التي تشبه نظرة وداع بين عاشقين على رصيف محطة متجهمة، إنها لحظة الكتابة؛ كأنها الثواني الأخيرة التي تسبق البكاء مباشرة.. لحظة صافية نقية.. تظل روحها متشبثة بجسد القصيدة مهما تقادمت، فالشعر في تصوري أشبه بالغناء الشعبي التلقائي المتدفق في عفوية، والمشحون بكم هائل من الأحاسيس المتفجرة.. فلا تعرف من أي نبع ينزف دمه الساخن..
وكثيرا ما أحاول العثور على تصوري هذا لدى كثيرين من الشعراء - ممن يملأون الدنيا ضجيجاً – فلا أجد سوى أفكار شعرية فقط، وشعرية هنا - مجازاً- لأنهم واعون تماماً لعميلة الإنتاج الشعري.. كأن يبدأون القصيدة بافتراض مدهش مفارق للواقع، وينسجون عليه مجموعة مفارقات أكثر إدهاشاً، حتى ليجد القارئ الغلبان فمه - بعد قراءة القصيدة – مفغوراً من الإندهاش..!! وعن نفسي لم تعد مثل هذه الأكروبات الشعرية تنطلي عليَّ.. فإذا لم يستطع الشاعر من الوهلة الأولى أن يمد يده ليعتصر قلبي، أو يفتح لي نوافذ من عالمه ليطل على روحي فأراه.. فأتألم لألمه أو أفرح لفرحه، فلا داعي لأن أتعب نفسي في محاولة ميئوس منها للتواصل مع مفارقاته الشعرية "المدهشة"..!!
إن أشد ما يحزنني اكتشافي للمسافة الواسعة بين اللحظة المرصودة شعرياً وبين اللحظة الفعلية..فقد أستطيع الإمساك بحالة عذبة من الشجن في قصيدة..لكن الذاكرة اللعينة لا تكف عن عقد المقارنات بين اللحظتين..تلك المقارنات المحبطة التي تكشف بوضوح أن الواقع أكثر إيلاماً، وأن ما أكتبه ليس أكثر من هوامش شعرية على متن لحظة دموية لم تتم كتابتها بعد..
*******
1
 ليس لدى قلمي شك في أن الكتابة في هذا الموضوع صعبة ومحرجة ومحفوفة بالمخاطر فهي تتطلب أولا أن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا في هذه اللحظة الشعرية ثم تقفز خارجها لتكتب عنها بتجرد وحيادية وبرؤية كلية عامة وشاملة وهذا ما لا يمكن ضمان حدوثه، فلا هناك تسليم بأني عضو فاعل ومؤثر في اللحظة الشعرية الراهنة - دعك من يقيني الداخلي بذلك - ولا هناك استسلام لإمكانية القفز خارج الظاهرة ذاتها لتكتب عن "ذات الظاهرة" كلها..!!
ليس لدى قلمي شك في أن الكتابة في هذا الموضوع صعبة ومحرجة ومحفوفة بالمخاطر فهي تتطلب أولا أن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا في هذه اللحظة الشعرية ثم تقفز خارجها لتكتب عنها بتجرد وحيادية وبرؤية كلية عامة وشاملة وهذا ما لا يمكن ضمان حدوثه، فلا هناك تسليم بأني عضو فاعل ومؤثر في اللحظة الشعرية الراهنة - دعك من يقيني الداخلي بذلك - ولا هناك استسلام لإمكانية القفز خارج الظاهرة ذاتها لتكتب عن "ذات الظاهرة" كلها..!!
2
وكذلك تتطلب الكتابة عن اللحظة الشعرية الراهنة الإحاطة القرائية بالمنجز الشعري الحديث كله - لا الحداثي أو التحديثي - فقط - وهذا أمر غير متحقق بالنسبة لي فإضافة إلى أن معظم المنجز الشعري الجديد غير منشور في طبعات ورقية بسبب عوامل الرقابة والاستبداد والجهل والإمساك بتلابيب أزمنة ولت، وأشكال بليت، وتقاليد فنية عفى عليها الزمان العفي، وكذلك فإن المنجز الشعري المطبوع ليس لدي القدرة على قراءته - وإن كنت أحب ذلك - لأسباب شخصية ليس لها دخل بالجمارك ولا بتوافر هذه الكتب في محافظات جنوب مصر ولا انعدام وجود هذه النوعية من الكتب في المكتبات العامة والمؤسسات الرسمية!!
3
يبدو والله أعلم أن المجتمع العربي على تنوع ثقافاته واتجاهاته لا يرغب في الاعتراف بأحقية القصيدة الجديدة في الوجود والحياة والعيش بأمن والتحرك بسلام على الأرض وبين المواطنين البؤساء / السعداء، وفى هذا ما يكفي للدلالة على انتكاسة هذا المجتمع الخائب وعودته جريا للوراء، وردته فكرا وثقافة وعلما وسلوكا، كما أن فيه دلالة على رغبة هذا المجتمع العادل في ستر عوراته، ورضاه بالفساد، وسعادته بالمفسدين، لذلك فهو يقف بالمرصاد للقصيدة الجديدة التي لا يتقن أدواتها ولا يعرف أساليبها، ولا يوقن بمراداتها ومقاصدها، لذا فهو يتوجس منها خوفا، ويقف أمامها هلعا ورعبا، إنه يخشى أن تعريه وتكشفه في أي سطر من سطورها أو في أي صورة من صورها، أو في أي جملة من جملها، خاصة وأن هذه السطور وتلك الصور، وهاتيك الجمل في مجملها "غير موزونة " وبالتالي فهي صادرة من عقول مهووسة غير قادرة على "وزن الكلام" قبل صدوره، إنها عقول غير مسئولة ورؤوس ليست أهلا لتحمل المسئولية، ومراعاة مقتضى حال المجتمع ومعاملته على ما هو عليه، وستره وعدم كشف عوراته كما أمرنا الدين الحنيف بالستر، واستقرت عوائد المجتمع وتقاليده على الستر العلني، والهمز واللمز والغمز الخفي!!!
4
لن يتخلى الوطن العربي الكبير عن الشعر كحامل لقضاياه وموصل لرسائله، ولسان معبر عن حاله، لأن هذا الوطن العربي الكبير مبنى أصلا على الكلام الصائت، ولهذا كانت المعجزة الخاصة به والمنزلة من عند الله العلي هي القرآن الكريم وهو كتاب مقروء وكلام مكتوب، إذن فالكلام أساس عظيم من أسس بناء هذا الوطن الخالد، صحيح نحن نمر بفترة لا تظهر فيها سطوة الشعر وتسمح للبعض بالتحدث عن "دولة الرواية " وعصرها ولكنها فترة انتقالية سرعان ما تنقلب ليعود للشعر مجده حالما تصل القصيدة الجديدة للمواطن الماشي على رجليه، والموظف البسيط، والعامل الكادح، والفلاح الفصيح، والأعرابي / البدوي الرحال أو المرتحل دوما، ساعتها ستقوم رابطة قوية ولغة مشتركة بين القصيدة الجديدة وتقنياتها الحداثية وأساليبها في القول وبين جينات الإنسان العربي المفطور على حب الشعر وتخليده، وستسطع الرواية وفنون القص والحكي بقدر اقتراب هذه الفنون من الشعر، ولذلك ترى النقاد يمدحون الروائيين والقاصين بأنهم يمتلكون "لغة شعرية"، هل رأيت ناقدا يمتدح شاعرا لأنه يمتلك لغة قصصية أو قدرة على السرد والحكي والثرثرة، للشعر مجده وبهاؤه حتى وإن لم يظهر ذلك في بعض الأزمنة ليكون دليلا عليها فيما بعد!!
5
الرقيب عندنا
يخاف من الشعر أكثر من خوفه من الرواية
يخاف من الشعر أكثر من خوفه من القصة
يخاف من الشعر أكثر من خوفه من السينما
يخاف من الشعر أكثر من خوفه من المسرح
يخاف من الشعر أكثر من خوفه من الصحافة
يخاف من الشعر أكثر من خوفه من مراكز الأبحاث الإستراتيجية
يخاف من الشعر أكثر من خوفه من المراكز الثقافية الأجنبية
يخاف من الشعر أكثر من خوفه من حوادث الطرق
يخاف من الشعر أكثر من خوفه من الحروب
يخاف من الشعر..
وهو محق
وأنا أقدم له - هل أقول نيابة عن الشعر-
تحية إجلال وإكبار
الرقيب وحده الذي يعطى الشعر في هذا الزمان قدره
وينزله منزلته
فالشعر مدمر
الشعر زلزال
الشعر بركان
الشعر: صاعقة
الشعر: طاقة في الروح
أقوى من الأسلحة النووية
أقوى من الأسلحة الكيماوية
الشعر جميل وجليل...
وبهي!!!
الشعر: روح
"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا "!!!
6
القصيدة الجديدة
سوف تجعلنا نحب التوراة أكثر
نحب الإنجيل أكثر
نحب القرآن أكثر
7
القصيدة الجديدة ستجعلنا نكتشف مسارات الشعر عند مولانا محي الدين ابن عربي وبهاءات القصيدة عند مولانا جلال الدين الرومي وإشراقات الرؤية عند القاضي عبد الجبار النفري ورائحة الليمون في "القناوية"!!!
8
القصيدة الجديدة
هي وحدها القادرة على اكتشاف
إيمان الكافرين بقدرة الفن على العطاء
وزندقة المؤمنين بالتقنيات القديمة
والأشكال العتيقة فيما يتوهم أنه شعر وما هو بشعر
ولكن أكثر النقاد لا يفقهون!!!
9
يا فارس خضر
يا عماد أبو صالح
يا على منصور
يا عماد فؤاد
يا فاطمة ناعوت وهدى حسين
يا جمانه حداد وفاطمة الشريف
يا بهاء علاء الدين رمضان
يا فتحي عبد السميع
يا مدرسا في الأزهر الشريف
يا إخوتنا الكبار:
ماجد يوسف/ وديع سعادة / حلمي سالم / عبد المنعم الفقير / محمد آدم / سيف الرحبي/ قاسم حداد / عبد المنعم رمضان / محمد النبهان / محمد سليمان / كريم هزاع / يسرى حسان / دخيل خليفة / مجدي الجابري / نادي حافظ / محمد أبو المجد / بريهان قمق /
يا أطفال الشعر الحليب الكبار: فؤاد حداد/ أمل دنقل / أدونيس / محمد الماغوط / طرفة بن العبد / أنسى الحاج / أبو فراس / العباس ابن الأحنف / محمد مهران السيد
أبشروا عما قريب سوف تكونون سلفييين جدا
جدا
ومن يدرى فربما تمطركم الأجيال القادمة باللعنات لثباتكم
وعدم قدرتكم على التحرر والتجدد والحركة للمستقبل
تحركوا - الآن -
أرجوكم
حاولوا أن تنقذوا أنفسكم من لعنات الأيام القادمة علينا كالإعصار الحالي ؟!!!
* * * *
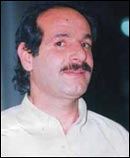 لم تثر حركة تجديدية في الأدب العربي، بعد حركة شعر التفعيلة، كل هذا الجدل الذي أثارته قصيدة النثر، منذ أن صارت مطية ركبها أغلب الشباب إلى أن انفجر النقاش في الآونة الأخيرة، مجددا، حول جيل التسعينيات، حيث تساءل البعض أين أبناء هذا الجيل الذي ملأ الدنيا ضجيجا حول تهميشه وإقصائه من المشهد الشعري الذي يرسم خطوطه كبار الشعراء والنقاد المحافظين.
لم تثر حركة تجديدية في الأدب العربي، بعد حركة شعر التفعيلة، كل هذا الجدل الذي أثارته قصيدة النثر، منذ أن صارت مطية ركبها أغلب الشباب إلى أن انفجر النقاش في الآونة الأخيرة، مجددا، حول جيل التسعينيات، حيث تساءل البعض أين أبناء هذا الجيل الذي ملأ الدنيا ضجيجا حول تهميشه وإقصائه من المشهد الشعري الذي يرسم خطوطه كبار الشعراء والنقاد المحافظين.
الأهرام العربي تفتح من جديد ملف قصيدة النثر بعد أن لاحظت أن الجدل حول الشعراء وليس علي الشعر نفسه، وتواصل في هذا العدد سلسلة الحوارات التي بدأتها مع شعراء القصيدة الجديدة حول: ما الذي أنجزته؟ وما دور الإيقاع فيها؟ وما علاقتها بتراثها الشعري علي مر العصور، ومستقبلها بعيدا عن ضجيج المعارك المفتعلة. التي تثار دائما وتتهم شعراء هذا الجيل بأنهم سبب في انصراف الجمهور عن الشعر وهي تهم تحتاج منا إلى أن نمنح هؤلاء الشعراء الفرصة في إعلان شهادتهم عما يكتبونه في اللحظة الراهنة.
فتحي عبدالله يرى أن دوافع الحوار حول القصيدة الجديدة غير شعرية: حسم الشاعر فتحي عبدالله خياراته مبكرا بالانحياز إلى قصيدة النثر، فكان ديوانه الأول "راعي المياه"، الذي تبعته دواوين أخرى أكدت حضوره الشعري من جانب، وأثبتت له من جانب آخر صحة ما راهن عليه. من هذه الدواوين التي حفرت لاسم فتحي عبدالله مجرى عميقا في الشعرية العربية: "سعادة متأخرة"، و"موسيقيون لأدوار صغيرة"، و"أثر البكاء" الذي صدر حديثا.. هنا حوار مع فتحي عبدالله يكشف جزءا من المشهد بوعيه الحاد الذي لا يجاريه فيه أحد من أبناء جيله، فإلى التفاصيل.
* رغم الاستقرار الذي تحقق لقصيدة النثر إلا أن المعارك حولها لم تتوقف.. ما دلالة تلك المعارك في رأيك؟
- هذه الصراعات الكثيرة لا تعكس أهمية قصيدة النثر كشكل في الأداء ولا تعكس أيضا انفصالها عن الواقع كما يردد المحافظون وإنما تعكس بالدرجة الأولي عدم تحقق شعراء هذا النمط في سياق الثقافة المصرية، مما يدفعهم جميعا إلى ممارسات عدوانية عنيفة تجاه الأشكال الأخرى وتمثيلاتها في السلطة أو خارج السلطة، وبهذا المعني فليس هناك استقرار لقصيدة النثر وإن هيمنت على الأداء الشعري بكامله، وهذه الصراعات لا تخلو من دوافع غير شعرية أهمها الرغبة في الوجود من خلال هذا الاستعراض الاحتفالي الذي يمارسه أنصاف الشعراء وأرباعهم كلما سنحت الفرصة، وأظن أن معظم هذه المعارك مفتعلة وزائفة وتحدث باستمرار للتغطية على إشكاليات حقيقية لدي الجماعة الثقافية مثل عدم وجود مجلة ثقافية واحدة تهتم بأشكال الأداء الحديث في مصر، سواء كانت أهلية مستقلة أو رسمية كما أن الجماعة الثقافية كقوة ضغط في المجتمع أصبحت تابعة إما لقوى خارجية ترى في المجال الثقافي أهمية خاصة للسيطرة وتوزيع الأفكار والتيارات التي تخدم أغراضها السياسية، وإما داخلية تدعو إلى تخفيف حدة الصراع الطبقي أو العنف بين الشرائح والطبقات الفاعلة ولكي يتم ذلك كان لابد من اختلاق صراعات صغيرة من هذا النوع للتضليل.
* لماذا تعاني تلك القصيدة، خاصة قصيدة التسعينيات من تجاهل النقد؟
- النقد عمل حضاري يرتبط بتطور المجتمع ومؤسساته الفاعلة وبهذا المعنى ليس لدينا نقاد في الثقافة العربية الحديثة، إلا عدد قليل مثل عبدالفتاح كليطو ـ مصطفي ناصف ـ كمال أبو ديب وقد تم تهميش هذا القليل وحذفه تحت دوافع أيديولوجية خالصة ليصبح المجال الثقافي ضحية النماذج الوسطية بين الغرب ومتطلباته في المجتمع العربي، فهم مجموعة من شراح نظريات الأدب والتيارات الحديثة وليس لهم أي اجتهاد حقيقي في مفهوم الثقافة أو الشعر أو الرؤية الحاكمة للإبداع العربي، فهم يؤدون دور الاستشراق القديم ولذلك فهم أكثر إلحاحا على تثبيت ما تقوله الأيديولوجيا الغربية على حضارتنا كمفهوم العنف والإرهاب دون أن يناقشوا الظاهرة كفعل اجتماعي له أسبابه ودوافعه وموجود في كل الحضارات، والمثير للدهشة فإن العنف في المجتمعات الغربية والأمريكية أكثر حضورا وبأشكال متطورة، ولهذا فالشعر العربي الحديث كله لم يقرأ قراءة واعية تضعه في السياق الاجتماعي الذي أنتجه. وبخصوص قصيدة النثر فالأمر أكثر فداحة، إذ روجت النخبة المتحكمة في المجال الثقافي لمجموعة بعينها في قصيدة النثر، توافق توجهات الدولة في تلك المرحلة وأطلقت عليهم جيل التسعينيات لينتهي بهم المطاف ليعملوا جميعا مرشدين سياحيين في الملاحق الثقافية الأجنبية لتحقيق صيغة المثقف الكوني الذي يريدونه دون أن يهتموا بالشعر وثيماته الخاصة وإنما بالدور المنوط بهم، فهم لم يتجاهلوا النقد وإنما دللهم وقدمهم نموذجا لهذه الشعرية في الداخل والخارج.
* ما قصيدة النثر، هل هي التي تخلو من الإيقاع أم التي تراوح بين أكثر من إيقاع، كيف ترى أنت المسألة؟
- النص الشعري الجديد، لا يمكن اختصاره في الإيقاع أو عدمه، فهو ابن رؤية جديدة، تتخلص من بقايا الرومانسية العربية، أو شعرية النهضة التي تهدر الذات الفردية لصالح الجماعة والتي تعلي من قيمة التاريخ في مقابل الفعل اليومي البسيط، والتي تروج للثنائيات المجردة والخالية من أثر الفعل الإنساني، كل ذلك لتخلق نصا جديدا به كل هذه المكونات الضرورية للإبداع ولكن في صيغة جديدة تقوم على الهجنة والاختلاط، تنفي أية عنصرية أو نقاء سواء كان عرقيا أو ثقافيا أو نوعيا يخص الشعر، فتداخلت الأجناس الأدبية والفنية وتداخلت الأشكال والثقافات بل الشعريات جميعها في هذا النص الجديد.
* هل توافق على اعتبار قصيدة النثر جنسا أدبيا مستقلا؟
- لا أوافق، لأن المحافظين والكلاسيكيين بهذا التقسيم أرادوا حلا لإشكالية هذا النمط الجديد الذي لا يتوافق مع رؤيتهم للشعر مع أن الشعر العربي في كل مراحله الحضارية الكثيرة يأخذ أسماء جديدة مثل الموشح ـ المقطوعات ولم يصنفوه في جنس آخر. وما هي إلا محاولات في صراع التيارات والأجيال للحذف أو التهميش دون الرجوع للنصوص ذاتها واكتشاف قانونها الشعري الذي يتلاءم مع اللحظة العالمية التي تعيشها الجماعة البشرية.
* أين تضع اعتذار حجازي الأخير عن تسرعه في الحكم على قصيدة النثر؟
- حجازي شاعر كبير وله رؤية خاصة فيما يتعلق بهذا النمط من الكتابة، وكانت متسقة مع تكوينه الثقافي ومع شعره وكنت أتمنى ألا يعتذر هذا الكبير وأن يظل الصراع قائما، فهو دليل حيوية وثراء ومعظم الرواد لهم نفس الموقف، وربما يكون الدافع لهذا التراجع هو طغيان النص الجديد وهيمنته وأن موقفه لم يعد مؤثرا، فقد أصبح حجازي والرواد جميعا خارج اللحظة الراهنة، وأن فاعليتهم الحقيقية قد انتهت منذ عشرين عاما وما هذه الأدوار إلا محاولة أخيرة للإحساس بالوجود، وربما يكون سلوكا اجتماعيا الغرض منه مراكمة بعض المكاسب الصغيرة كاستمرار رئاسته لمجلة إبداع وهذه التراجعات الكثيرة والمصالحات لا تكون ذات فائدة ثقافية في كل الأحوال، وأنا اعتبرها علامة واضحة على الشيخوخة.
* ما التأثير الذي تركه السبعينيون على قصيدة النثر؟
- من أهم النصوص الشعرية في حقبة السبعينيات والتي مهدت لقصيدة النثر قصيدة القاهرة للشاعر علي قنديل وتجربة "نثريات والصيف ذو الوطء" للشاعر حلمي سالم إلا أن السياق المهيمن والمسيطر على السبعينيين كان استمرارا لتجربة الرواد بدرجة أو بأخرى مع بعض الاقتراحات الشعرية التي تطور النمط، ولا تقطع معه أما سبعينيات العالم العربي فقد كانت انفجارا هائلا خاصة جماعة كركوك في العراق والتي تميز منها الشاعر صلاح فائق وسركون بولص أما الشام فكان موطن وميلاد قصيدة النثر بدءا من الماغوط وأنسي الحاج في الستينيات ووديع سعادة وعباس بيضون في السبعينيات وبسام حجار في الثمانينيات مع شعراء الأطراف في العالم العربي سيف الرحبي من عمان وأمجد ناصر بالأردن، وأنا لا أنظر إلى هذه القطرية الضيقة في تطور أنماط الأداء في الشعر، خاصة وأن المشتركات الثقافية كثيرة والاتصال سريع وأكثر تأثيرا.
* فتحي عبدالله يبدو مع فكرة القطيعة مع التراث الشعري القديم. ما حيثيات هذا الموقف؟
- أنا مع فكرة القطيعة مع التراث القريب الستينيات والسبعينيات بما يحمله من دلالات أيديولوجية مباشرة دون عناية بفكرة الكتابة وحدها وعلى أنهم قطعان لتبرير أو رفض مشروع الدولة، وهذا الحس الجماعي ضد طبيعة الإبداع، باعتباره عملا فرديا بامتياز خاصة الشعر ـ السرد والقطيعة هنا ليست جيلية أو سياسية وإنما إبداعية جمالية، تعيد للكتابة مركزيتها في السلوك الإنساني. أما التراث القديم، فهو أسطورتنا الجديدة، وطفولتنا الروحية والعقلية، ووجودنا الأول بكل ما به من اختلافات وتناقضات وأنا أحبه كله دون انتقاء أو اختيار، وإن كنت أكثر شغفا بالتراث النثري بدءا من القرآن الكريم والحديث النبوي وكتب الأخبار واجتهادات الفقهاء والملل والنحل، وأستعيده الآن من خلال الوسائط الجديدة الشرائط ـ الكمبيوتر في شكله الشفاهي، ومازال يلعب دورا كبيرا في إنتاج نصوص الشعرية ـ وإن جاء بشكل جديد ـ أما التراث الشعري القديم فأنا اعتبره من أهم الشعريات في العالم شرط أن يقرأ متخلصا من عبث الدارسين قليلي الموهبة والكارهين له، لا لشيء إلا لأنه قديم، وهم دعاة تحديث دون أن يعرفوا طبيعة الشعر التي تتجاوز الأحقاب والأشكال، وهذه إحدى تشوهات أصحاب النص الجديد، الذي لا يخرج عن كونه مجموعة من الخواطر، لا تحكمها إلا الثرثرة الزائفة والإدعاء بالتحديث.
* تبتعد بقصيدتك عن الموسيقى المباشرة بكل أنواعها، ألا تخشى الاتهام بالتغريب؟
- لا يخلو الشعر في عمومه من الموسيقي سواء كانت خارجية ترتبط بالألفاظ والتراكيب وهذا ما اكتشفه عبقري الثقافة العربية الخليل بن أحمد أو داخلية ترتبط بالمعني أو الدلالة وهذا ما أشار إليه فلاسفة الإسلام مثل الفارابي وابن سينا أو المتصوفة الكونيون مثل ابن عربي والإمام الغزالي وأنا أنتمي للنمط الثاني وإن وجد في ثقافات أخرى فإنه يعزز اختياري وليست لي علاقة بكل ما يحدث وما يقال عن موسيقي قصيدة النثر سواء في التيارات الغربية أو في التيارات العربية، خاصة أن اللغة العربية ذات إيقاع متعدد، حسب التركيب أو الرؤية التي وراء بناء النص، وربما تأتي الثقافة العربية الحديثة بعبقري آخر مثل الخليل، ليكشف عن موسيقى الدلالة أو نترك هكذا لاجتهادات الأنصاف الذين لا يعرفون اللغة ولا الموسيقى. أما التغريب عندي فإنه يأتي من الرؤية التي لا تعترف بهذه الثنائيات البالية شرق ـ غرب، الله ـ الإنسان، الخير ـ الشر، شعر ـ نثر، فالحضارة الإنسانية، تتطور باستمرار والكل يشارك فيها ـ دون النظر إلى هويته ـ ولا أعتقد أن هناك نقاء ثقافيا خالصا في كل الثقافات، فالتطور الثقافي يأتي من الهجنة والاختلاط، لا من العزلة والخصوصية، وإن كانت ضرورية في لحظات بعينها، ولا يجدد ذلك إلا الشعر أو المبدع، ولا تفرض عليه من الخارج.
الأهرام العربي-30 أكتوبر 2004
********
لماذا لا نترك الإنسان دون ان نفرض عليه وصايتنا....؟ .. نحن منذ قرون طويلة نحدد له ما هو الشعر ومن هو الشاعر.. دون ان نترك له الحق في ان يختبر ويختار ويشعر ويتأمل أشياءه بنفسه.
منذ طفولتي وأنا اشعر ان الشعر ليس له مفهوم او تعريف .. الشعر شعر.. أجده في كل شيء من ابسط الأشياء إلى اعقدها.. أجده في الطبيعة الصامتة.. وفى زحام الحياة الحديثة.. في النقاء الإنساني.. وفى الغباء البشرى..
كل شيء يصلح ان يكن شعرا .. لكن المهم ان يكون شعر.. كنت اندهش عند قراءتي للشعر المترجم من شرق آسيا او من أوربا او الأمريكتين.. أنني أقع أسير هوى هذه الأشعار رغم تباعد المسافات والأفكار والأحلام والرؤى, الا أنني تيقنت ان الشعر هو الوحيد الذي يستطيع تجاوز كل شيء.. واختراق أي شيء.. الشعر له أجنحة يطير بها دون إرادة من احد, ودون تعمد من احد.. الشعر يتجاوز الزمن ولا يأبه بالتاريخ.. الشعر لحظات خارج الزمن تتعدى وتستمر إلى الأزمان الأخرى. لم يخطئ من ربط بين الشعراء والأنبياء, لان الشعراء يستشرفون المستقبل ويتجاوزون الآتي إلى آفاق لا تنتهي. لذا لم أتوقف يوما أمام المعارك الدائرة بين شعراء القصيدة العمودية, وقصيدة التفعيلة, وقصيدة النثر. واعتقدت دوما انها معارك مفتعلة وليس لها أي مبرر الا التواجد والحضور.
لان ما يهمني ليس شكل القصيدة ولكنني ابحث دوما عن الشعر.. ابحث عن ذلك الجوهر الحي للحياة.. ابحث عن ذلك المراوغ الذي لا يكف عن إنتاج الدهشة.. ابحث عن ذلك الذي يجعلنا نعيد اكتشاف أنفسنا والعالم بشكل جديد ومختلف.
أقف أمام أشعار الشعراء الجاهليين وقفة إجلال متنسما عبير الصحراء ومدركا لطلاوة الكلمات, محاورا صامتا لقصائد امرؤ القيس وزهير بن أبى سلمى وعنترة بن شداد.....
واقف مشدوها أمام شاعر العربية الكبير المتنبي. اذ كيف استطاع ان يتجاوز يشعره الزمن . ولا أجد تفسيرا الا انه أنتج نصا موازيا للحياة, فكثير من أبيات شعره تصل إلى الحقائق المجردة من أيسر الطرق وابسطها وعندما نقراها نشعر أننا نعرفها ولكننا نحتاج المتنبي العظيم ليضعها أمام قلوبنا، ولو لوقت قليل.
كذلك أشعار أبو العلاء, وأبو تمام , وأبو نواس، والبحتري , وبشار بن برد .... وغيرهم من الشعراء القدامى. فمع أشعارهم نستحضر عوالم مختلفة وأيضا جميلة.
بدأت علاقتي بالشعر كالعادة بالحب وبداية التعلق بالأنثى. مثلى كآلاف غيري حاولوا ان يجعلوا من – لحظات خاصة – معاني كبرى. عادة ليس لها أي علاقة بالاثنين المتحابين, وغالبا ما تكون أشعار هذه الفترة نسخ رديئة من عوالم شعرية مقروءة او مسموعة لشعراء فرضتهم المناهج المدرسية في التعليم المصري. لكنني في فترة الدراسة الثانوية عرفت أمل دنقل. وما زلت اذكر أعماله الكاملة التي وقعت في يدي... اذكرها بغلافها الأحمر الذي تتوسطه صورة الشاعر الراحل.. الكتاب لم يكن كتابا عاديا.. بل صار لي إنجيلا للحياة والشعر لفترة ليست بالقصيرة.. فالشعر هنا مختلف عما كنت أقرؤه.. الشعر هنا يمس الروح من جانب خفي لا اعرفه. ظللت أتساءل وقتها من أين يأتي الشعر .. وما هو سر جماله الخفي.
ورغم تباعد السنوات الا أنني ما زلت بين الحين والآخر أقرا: الكلمان الأخيرة لسبارتكوس .. البكاء بين يدي زرقاء اليمامة.. الخيول.. الجنوبي.. أغنية الكعكة الحجرية.. وغيرها من أشعار الشاعر الراحل كي استحضر الحالة التي كنت فيها عند أول مرة قرأت فيها هذه الأشعار، ولا أصل أبدا إلى هذه الحالة. فالسنوات تمر ولا تعود أبدا. ولذة الاكتشاف لا تعادلها الا لذة اكتشاف آخر. وأمل دنقل كان اكتشافا لي في هذه الفترة من العمر , خاصة انه وقتها لم يكن شهيرا تلك الشهرة التي هو عليها الآن. فأحسست انه لي وحدي دونا عن البشر .
وفتح – أمل – لي الباب على عالم مختلف من الشعر تعددت لذاته واكتشافاته: احمد عبد المعطى حجازي.. صلاح عبد الصبور.. محمود درويش.. ادونيس.. عبدالمنعم رمضان.. محمد سليمان.. عبد الوهاب البياتي.. فؤاد حداد.. الابنودي.. سيد حجاب.. احمد فؤاد نجم.. فؤاد قاعود
ومع هؤلاء الشعراء الكبار لم انحز يوما لشاعر على حساب شاعر آخر, بل وجدت ان لكلا منهم عالم شعري فريد.. لا نستطيع ان نستغني بشاعر منهم عن شاعر آخر.. او ان نفضل عالم شعري هاملين العوالم الشعرية الأخرى.
المهم ان يكون الشاعر له مشروع إبداعي وشعري وقد تخلص من ارث السابقين عليه ويستطيع ان يحلق بمشروعه وحده دون مساعدة من احد ودون تعمد من احد .
وذلك لأنني أرى الحياة بهذه الصورة. ففي الحياة متسع للجميع.. المهم ان نكون مخلصين لما نحبه, وننفصل عن ذواتنا الضيقة إلى رحاب الحياة نفسها.. فالحياة دائما أخصب واكبر وأعمق منا مجتمعين.
والحياة لا تخضع لأحد, ولا ترتبط بقوانين ثابتة. هي دائما تتبدل وتتغير ونحن دائما زائلون .
أما الاكتشاف الأهم في حياتي فكان قصيدة النثر ...وللاكتشاف قصة . فقد التحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1989، وفى قسم اللغة العربية تتلمذت على د. جابر عصفور .. د. نصر حامد أبو زيد .. د. سيد البحراوي .. د.شمس الدين حجاجي وأستاذهم عبد المحسن طه بدر الذي توفى وأنا ما زلت في العام الاول من دراستي . وقد اثر هؤلاء الأساتذة في تفكيري تأثيرا بالغا لبس في مجال الأدب فحسب، لكن في طريقة ومنهج التفكير , فقد تعلمت منهم التفكير النقدي الذي يقدس العقل ويمنحه حقه في الاختيار والحياة , لكن لخجلي الذائد وقتها لم اقترب منهم اقترابا يسمح لي بالتواصل الحميم بين طالب وأساتذته واكتفيت بما درسته وقرأته عليهم . كذلك لأنني في هذا الوقت كنت مهموما بقضايا الوطن، فاقتربت من كل الفصائل السياسية كي أناقش واعرف و اختار الطريق .. اقتربت من الجماعات الدينية وحال بيني وبينهم – عقلي – الذي لا يكف عن طرح الأسئلة .. وعقولهم التي بها إجابة واحدة لا تتغير او تتبدل .
إلى ان حدثت مظاهرات عام 1990 التي قادها في البداية رابطة الطلاب الاشتراكيين , والتي جمعت فصائل اليسار المصري : الناصري والاشتراكي والماركسي. ولا زلت اذكر هذا اليوم الذي جاءني فيه زميلي في غرفة المدينة الجامعية قائلا لي : .. الجامعة مقلوبة .. فأجبته : أكيد جماعات دينية .. فرد: طلبة عاديين لابسيين قميص وبنطلون.. فارتديت ملابسي وهرولت إلى الجامعة . فوجدت ما لم أكن أتصور .الجامعة كلها ثائرة من أقصاها إلى أقصاها , وأصوات الطلاب الثائرين ترج في .. قبة الجامعة.. الساعة .. المكتبة المركزية.. مباني الكليات .. الآداب .. الحقوق .. التجارة .. العلوم .. الآثار .. دار العلوم .
تنسمت رائحة لم أتنسمها من قبل . ربما تنسمت رائحة الحرية .اعرف ان الحرية ليست لها رائحة, لكننا أحيانا نتنسم أشياء نحلم بها ولا نجدها , وتختفي بعد ان ينتهي الموقف الذي تنسمناه فيها .لذلك لم أتنسم بعد ذلك تلك الرائحة أبدا.
ورغم أنني لم أكن مع الطلبة الثائرين في موقفهم، ولم أكن بالطبع ضدهم فالقضية ملتبسة . ديكتاتور عربي غزا بلدا مجاورا فاجتمعت عليه قوى الامبريالية العالمية مستغلة تصرفه الطائش بالدخول إلى المنطقة وفرض شروطها وأهدافها ومخططاتها لتعيد رسم خريطة المنطقة من جديد .
فانا لست مع الديكتاتورية التي أفرزت لنا حاكما مثل صدام حسين , وأنا ضد الامبريالية العالمية التي تحاول السيطرة على مقدرات العالم الثالث والقضاء على أي حكومات وطنية يكون غرضها الأساسي الاستقلال والحرية للمواطنين البسطاء.
لكنني كنت في حاجة إلى حضور هذا المشهد الذي لا يتكرر كثيرا . جموع من الطلاب الصغار السن يثورون في وجه كل الحكومات العربية. ولن أنسى ما حييت لحظات الانتشاء الإنساني التي غمرتني وأنا أشارك الطلاب ثورتهم خاصة عند خروجنا من باب الجامعة إلى الشوارع ملتحمين بالجماهير , الذين شاركونا المظاهرات . فقد أحسست في أحايين عديدة ان المشاركين ليسوا بشرا عاديين . لقد خرجوا من ذواتهم وحلقت أرواحهم بعيدا عن الأرض . هم في لحظة تجمع بين الرفض والحب.. الرفض لدخول قوات أجنبية إلى المنطقة .. وحب ان يقولوا لا .. لأنهم في حياتهم العادية تعودوا ان يقولوا نعم لكل من يملك عليهم سلطة سواء في البيت او الدراسة او العمل .تزامن ذلك مع ظهور مجلات أدبية وفكرية ذات شكل جديد ومختلف : مجلة إبداع برئاسة الشاعر احمد عبد المعطى حجازي .. مجلة القاهرة برئاسة د. غالى شكري .. مجلة فصول برئاسة د. جابر عصفور , وكان لهذه المجلات الثلاث ابلغ الأثر في تكويني الفكري والثقافي والأدبي . فلا زلت أتذكر القصائد الثلاث الفائزة في مسابقة رامبو للإبداع الشعري, التي أجرتها مجلة إبداع , والقصائد كانت للشعراء احمد يماني و محمد متولي ,هالة لطفي . فور ان قرأت القصائد الثلاث حتى انتابتني قشعريرة الاكتشاف لعالم من الشعر كنت أتمناه وابحث عنه.. عالم لا يأبه بشيء الا الشعر.. الشعر الخالص الذي يستطيع ان يحلق بعيدا دون حائل او مانع.
أيضا ما زلت اذكر تصدى المجلات الثلاث لظاهرة التطرف الديني،واعتبارها القضية الأساس في تلك الفترة , وأيضا الدفاع عن الدكتور نصر حامد أبو زيد في قضيته الشهيرة مع د. عبد الصبور شاهين، والتي انتهت بفاجعة ترك الدكتور نصر ابوزيد لمصر وذهابه إلى هولندا.
لكن توقف ذلك الزخم فجأة بعودتي إلى بورسعيد مدينتي . فانفصلت روحي عن جسدي بقت روحي في القاهرة.. وعاش جسدي في بورسعيد . وتحول ذلك الزخم إلى مجرد ومضات للروح أتذكرها بين الحين والآخر.
إلى ان التقيت ببعض من مثقفي بورسعيد وشعرائها . اذكر منهم احمد عبد الحميد، محمد السلاموني، صلاح زكريا , إبراهيم أبو حجة، محمد النادي . وكانوا يمثلون (جيل الثمانينات) في الكتابة ببورسعيد .
ورغم أنني لا أفضل تقسيم الأجيال تبعا لسنوات إبداعهم، الا أنني لم أجد تصنيفا أخر أصنفهم به،خاصة ان جيل الثمانينات له ملامح مشتركة في مصر كلها . فقد بدأ بدايات متألقة جدا واختفى اختفاءا غريبا . ربما لظروف النشر التي كانت مقتصرة على عدد محدود من الدوريات الأدبية. ربما لوقوعهم بين جيلين لهم عوالم واضحة ومكتملة: جيل السبعينات برموزه المعروفة عبد النعم رمضان، حسن طلب , حلمي سالم، جمال القصاص، محمد سليمان .... وجيل التسعينات الذي يسود الساحة الإبداعية في لحظتنا الراهنة .
وارتبطت بهؤلاء الخمسة ارتباطا حميما، خاصة الشاعر احمد عبد الحميد المولع بالتجارب المختلفة والإبداعات التي تخط طريقها بعيدا عن المؤسسات الثقافية وتحاول ان تخلق عالما إبداعيا مغايرا لكل ما هو سائد ومستقر، وقرانا معا مجلات الكتابة الأخرى التي حررها هشام قشطة ومجلتي الجراد والفعل الشعري لأحمد طه وامجد ريان . وتيقنا ان طريقا آخر في كتابة الشعر بدأت معالمه، وان قصيدة النثر في طريقها لتتبوأ صدارة المشهد الشعر .
لكنني في هذا الوقت كنت اطمح إلى كتابة (نص) أدبي يتجاوز المفاهيم الكلاسيكية المعتادة _ قصة وشعر ورواية- نص تجد فيه كل هذه الأنواع الأدبية مع إفادته بالسينما. ذلك الفن المدهش الذي استطاع ان يتجاوز الفنون المقروءة خاصة بعد تطور التقنيات الحديثة. فاستطاع ان يصل إلى روح الشعر- والمسكوت عنه - في القصة والرواية إلى جانب استيعابه للفنون التشكيلية من رسم ونحت وتصوير.
لذلك لم أكن مندهشا عند طغيان الصورة في الواقع الحديث، وتحولها إلى لغة الفن والثقافة والحياة . وبدأت الكتابة وأرسلت قصاصات أوراقي إلى الناقد الكبير محمود أمين العالم وفاجأني برده على رسالتي بكلمات ما زلت اذكرها: لا شعارك عطر خاص ,وإيقاع خاص، وتمرد خاص .
ورغم حزني وقتها لأنني كنت اطمح إلى كتابة نص يتجاوز التصنيفات المعتادة الا أنني الآن تأكدت ان الشعر روح كل الأشياء وسر الجمال الوحيد في الحياة. وطبعت كتابي الاول كمجموعة من القصص القصائد. الذي تزامن للأسف مع مروري بحالة أحسست فيها بعدم جدوى الحياة وعبثها. وقبعت داخل ذاتي فترة ليست بالقليلة. لكنني استطعت الآن الخروج بعد ان زالت الأسباب. وكل ما أحاوله الآن ان اجعل الكتابة فعل يومي لأنها هي بالفعل.... الحياة.