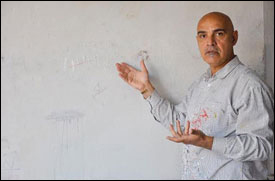
تنضوي أعمال الفنان التشكيلي علي رشيد المقيم في هولندا تحت لواء ما بعد الحداثة. وهذا يعني أنها تعارض الرؤية المركزية للوجود، وتتعامل مع الحياة من منطق ذاتي وخاص. لم يكن علي رشيد في مجمل أعماله مع تراث كلاسيكيات الحداثة التي صنعت للعالم نواة أو جوهرا، والتي استبدلت شعرية الطبيعة بالحكمة الحديدية للعقل الصناعي ولليد العاملة أحيانا. ولذلك يمكن قراءة الطريقة التي يوزع بها الألوان والخطوط والمعاني الغامضة المفتوحة على شتى التفاسير والدلالات بنفس المفردات المضادة لإطار الحداثة الإمبريالي والعقيم. وأقصد بذلك مفردات أو حتى مصطلحات فك العلاقة مع الاستعمار.
وفي مثل هذا الجو يرسم علي رشيد إطار عالمه الصغير والنوستالجي، المسكون بذاكرة من غير صور واضحة ولا محدودة، وهي ذاكرة النفس والروح، أو حتى ذاكرة الأماكن البعيدة التي يطويها النسيان شيئا فشيئا ويحولها إلى مجرد متبق.. ندوب من مرحلة يحق للعين أن تنساها.
ولقد أدى ذلك لخلق ركام من الفوضى والشرائع المتناقضة التي تستند إلى خيط درامي. ويبدو من أول نظرة أن هذه الدراما هي تعبير مزدوج عن صدام بين سرد محبط ومكبوت وساكن، ومنفى يحول الذكريات لأشخاص لم يعد لهم وجود، أو إلى رومنسيات بريئة ليس لها عقدة، وكأنها عاطفيات عامة. كما لو أن الوطن والمنفى مزدوجة تحمل أعباء الصدام التاريخي بين الماضي والحاضر. وتلازم ذلك في نفس الوقت مع إجراءين:
الأول التخلي عن المفردات الشعبية العامة التي تروج فعلا لقوانين صناعة إنسان الغيتو. وعن كل المفردات التي تبني نشاطها على أساس حدة الإبصار والرؤية.
الثاني الاهتمام بالتدرج في سماكة طبقات الدهان، وهو تدرج له معنى، لا يعبر عن السخاء بالنور، ولكن عن ثقل الحقائب والأمتعة التي نحملها معنا في رحلتنا في الوجود. وهي متفاوتة من لوحة لأخرى ومن زاوية في اللوحة الواحدة لزاوية غيرها.
إن علي رشيد (كما قال هابرماز) لم يهتم بحرية ذاتية تتحقق في المجتمع، ولكن بحرية تعود للحق العام ضمن سيرورة لثقافة تفكير. وهي نفسها ثقافة الأفراد التي تندمج بوجوه الروح المطلقة والروح الموضوعية. وهكذا استطاعت روحه الذاتية أن تتحرر من الصفات الطبيعية المسؤولة عن القراءة التقليدية لواقع المحاكاة.
عن هذه الإشكاليات، وعن الأدوات المستخدمة في التعبير، ودواعيها والفلسفة المكونة لها، كان هذا اللقاء.
لنبدأ أولا من المواد. فالأشكال والصور كما يبدو ليست من صلب رؤيتك الفنية. وأنت أصلا تنطلق من هذه النقطة. تحطيم أوهام الصورة.
لم يعد الشكل من عدمه، ولا كثافة الألوان من عدمها ما يشغل الفنان، ما يشغله هو صياغة حوار بصري، من خلال استنباط وسائل لتحرير العمل الفني من مباشرته، وتفعيل دينامكيته للبحث في الغير معلن، وتحريره فكريا وبصريا للوصول إلى ملامح وأشكال وصور هي تناص مع منظومتنا الفكرية والذهنية، وتناص مع المحيط بكل تفاعلاته الحياتية وانعكاساتها على واقعنا المعاش. كفنان لا أرغب في استنساخ الأشكال المتداولة لأفسر ماهو مفسر، بل أنا أخلق نوعا من المشاعة التي تقودني إلى إيجاد أكثر من معنى في المفردة، وأحرر الشكل من حيزه المتداول، ليصبح متخيلا يتسع كلما تفاعلنا معه ذهنيا، لنرى في الصورة ما هو أبعد من ملامحها المرسومة بحسب المفاهيم الجمالية التي تتيح لنا المتعة البصرية. الفن اليوم هو كم الأسئلة التي ستقودنا إلى تفكيك التركيبة البنائية للعمل، للتغلغل إلى ما وراء الأشكال والصور، لنعمق سعينا المعرفي في استيعابها حسب الاستعارات والرموز التي نستلهمها من الواقع وظواهره، ولذلك كثيرا ما نستعيض عن الشكل بمفهومه العام بشكل مفترض يلتمس علاقة الذات بالعالم. وهنا تصبح الصورة معنى وليس مظهرا. بالإضافة إلى ذلك فإن الشكل في العمل الفني لم يعد خطوطا خارجية تحدد ملامح واضحة تحدد بدورها العنصر المرسوم (على الأقل في مفهوم الفن اليوم )، بل هو شكل مفترض نستعيده من الأثر .
هل ترى أن المواد العضوية كالخشب والورق ذات دور أهم من المواد غير الأصيلة كالتراب والجبس وسواها. أم أن التعامل معها أسهل. وهل تقف وراء ذلك رؤية خاصة. هل تستند لفكرة عن علاقة الموت والحياة بالفن.''
أنا أرى أن أي مادة تمتلك خصائصها الشكلية وكيانها الوجودي وقدرتها على التعبير عن متغيرات الزمن وتقادم الأمكنة واضمحلالها، والإحالة إلى فعلها البصري. لذلك هي تحمل سمات الفعل في العمل الفني، وحسب الرؤية التي يشتغل عليها الفنان، حيث تتيح المادة تفعيل هذه الرؤية وتساهم في الإشارة إلى أثرها الغامض والمرمز، لا أرى أي فرق في أهمية المادة واستخداماتها بالنسبة لنوعها (عضوي، أو مصنع )، بل كثيرا ما تحثني المادة على البدء في العمل، لأنها تثير فيًّ الحراك للدخول إلى أسرارها البصرية. هنا يمكنني الإعلان عن رؤيتي الخاصة في تعاملي مع المادة ليس كعنصر ثانوي، أو وسيلة لتحقيق بعد فكري، بل إنها الصوت والإشارة، والمصدر الذي يشير إلى كيان فني علينا أن نلتفت إليه، لنجلي عنه سكونيته.'وهذا بالضبط ما فعله 'دوشامب' في التعامل مع ماهو مألوف وملقى ومبتذل من المواد، حيث وجد فيها وبعبقرية الفنان ذلك الوهج الفني المعبر، وهذا ما لم يلتفت له الإنسان العادي. الفن اليوم هو الأفكار العظيمة، وتصارع الأضداد في وجودنا الأزلي والزائل، بل هو طقسنا اليومي حتى في استنادنا إلى جدلية البقاء والعدم .
لا شك أنك فنان نخبوي مع أن مفرداتك شعبية. هلا بررت لنا هذا التعارض؟.
لا أجد نفسي فنانا نخبويا، لأنني كما أشرت أكثر من مرة أنا فنان ينتمي إلى اللحظة التي يعيشها ومشغول بتفاعلها مع المكان وكذلك على العلاقة بيني وبين الآخر، ومن ثم لحظة الإمساك بالزمن وتدوينه في عملي، ولذلك حينما أمارس فعل الفن، لا أفكر بأن علي الاشتغال بالصيغ والقوانين التي درستها لبناء العمل، بقدر انشغالي في تدوين زمني وعناصره ومفرداته، من خلال التعبير عما هو مبهم، لأستعيض عن العالم المادي بعالم ذاتي، تلمسا لوهج سيتكشف كلما تلمسنا العمل الفني وتعاملنا مع كيانه استقرائيا وباستدالال للجزء المنزوي من الكل، وهذا ينعكس على المادة التي أشتغل عليها أو بها، من حيث أنها مفردة يومية تقودني للبحث في عنصرها الجمالي، بقدر ماهي مفردة المكان والبيئة، والناس الذين أعيش معهم وأشاركهم زمنهم، هنا يتحتم علي تحريرها، واستخلاص البصري منها. لذلك ترى في أغلب أعمالي استخداما للمفردات والعناصر الأليفة التي يستخدمها الناس، لأنني أنحاز لبعدها الشاسع ولقيمتها المشاعة، والمخبوء من فعلها. هي نوع من ذات معممة في ذوات تتفاعل بذات الاغتراب، أو التوهج مع مايدور حولنا .
أين تقف من مفهوم الفن ثلاثي الأبعاد. وهل تفضل الانفصال عن لوحة لها عرض وطول لتكون أقرب من الواقع المجسم. ولو كنت من أنصار هذا التفسير. لماذا إذا التمرد على نسخ العالم. أن لا تنسخ الصور وأن تكتفي بنسخ الأبعاد والمجسمات. ألا ترى في هذا تناقضا فكريا آخر في جوهر فكرة الفن؟.
الفن بالأساس يستند على البعد الثالث، لايوجد عمل فني ببعدين، حتى اللوحة المرسومة على قماش يشكل لها العمق بعدها الثالث، وكل عمل فني يشغل حيزه، فاللوحة تشغل حيزها على الجدار، وكذلك ما يسمى بالعمل المجسم، كالنحت أو السيراميك تشغل حيزها في المكان، فلا يمكننا اعتبار اللوحة كعمل فني غير مجسم (كونها معلقة على الجدار) بينما هي كيان شكلي مجسم وله أبعاده التي نتلمسها، إذن الفعل هنا ليس نسخ صور، بل بناء أشكال تحتوي صورا وإشارات ورموزا، وهذا يدخل في جوهر الفن وحريته. لايوجد حدود ولا تقاطعات تقف في طريق هذا التداخل بين أنواع الفنون البصرية اليوم، بل حتى العلاقة بينها وبين الفنون السمعية، أو الشعر والأدب بعمومه، بل لا توجد حدود، أو تعارض بين الفن ودقائق حياتنا اليومية، الفن هو العلاقة وتجاذباتها بين الإنسان وعالمه، هو علاقة الفنان بزمنه وبالمكان'ومن يشغله، هو الحالة الوجودية بكل أحاسيسها، ونتائجها. فيما يخص عملي، اللوحة لدي محاولة للإمساك باللحظة التي لم يعد الإمساك بها ممكننا، أما شكلها وبناؤها فهو يخضع للحظة التي أعيشها أيضا. كانت آخر أعمالي هي تجربة أسميتها 'لوحات لا تحتاج إلى جدار' حيث رسمت لوحات مكتملة الخصائص أي مرسومة على القماش، ولكنني استعرت من النحت بناءه، أي جعلت اللوحات لها شكل نحتي، ويمكنها الاستقرار على الأرض ويمكن للمشاهد اللف حولها ومشاهدتها من كل الجوانب، أما الأسئلة المتعلقة بالكيفية والسبب لذلك فلا أجوبة واضحة لدي، عدا أن أي عمل فني هو فعل مخيلة، معتمدة على خزينها المعرفي، تقوده الصدفة إلى ابتكاره كمنجز .
ما هي درجة السطوع في لوحاتك. وهل لذلك معنى؟. مثلا هل تفضل الألوان الظلية الداكنة لتكون غامضا. أم الألوان الساطعة والمشرقة بغرض التوضيح، وبعبارة أخرى : هل لدرجة السطوع ارتباط بالخجل الوجودي من الحالة؟.
لم تعد المفاهيم والدلالات التعبيرية أو الرمزية للون ثابتة، فلكل فنان استلهاماته الخاصة، سواء مع المادة أو العناصر وحسب الكيفية التي ينجز فيها أعماله وتقنياته المستخدمة. ليس بالضرورة أن يكون الأبيض لون فرح والأسود لون حزن والأزرق لون السماء والبحر وهكذا، حتى تأثير اللون وانعكاسه على الحالة النفسية ومزاج الإنسان لم يعد مرهونا بما هو متعارف عليه، بل بالكيفية التي يتعامل بها كل شخص مع اللون ودلالاته، وهذا أيضا يتحدد بالاختلافات البيئية والفكرية والحياتية بين شخص وآخر. وكذلك في موضوع الغموض أو الوضوح، لذلك نجد أن التعبير الذي يبثه اللون في العمل مرهونا بالطريقة التي يستخدم فيها الفنان ذلك اللون، وبعلاقته بالعناصر الأخرى داخل العمل. أنا وفي أغلب أعمالي أشتغل على اللون الأبيض، ربما لأنني وجدت فيه السعة التي أنشدها بمفهومها الفكري والدلالي، ولأشير إلى السطوع الذي تعنيه، هذا السطوع الذي أقف عند حدوده كرؤية، لا لكي أبرهن على بهجة مفترضة، بقدر ما يمثل لي المشاعة التي تتخطى حدود العمل، لتختزل المكان في هذا القماش، ولتختصر الزمن باللحظة التي أنشدها داخل العمل لحظة الاشتغال، هي لحظة حدسية كاشفة توثق مفهوم الحداثة وما بعدها باعتبارها كشفا لجوهر الأشياء وجمالها .
هل تعتقد أن للفن وظيفة. هل الفن يسرد أم أنه يعكس فقط. يقدم انطباعات أم أنه يعيد بناء العالم؟
الفن كل ما ذكرت. هو الرائي الذي يلخص ويسرد، وهو المرآة التي ترينا عري العالم، ووجهه السافر، وهو انعكاس لكل ما يحدث ونتائجه. يؤثر ويتأثر. يقدم رؤية، ويثير العديد من الأسئلة. يقدم انطباعات، وينبه إلى الخلل الذي يحيط بتواجدنا. يعترض بشدة، ويصرخ بوجع كبير ضد الظلم والحرمان والجوع والاستغلال والدمار الذي يسود عالمنا المتخم بالحروب والخراب والصيرفة. مع هذا فالفن لايقدم حلولا ولا يعيد بناء، ولكنه يشير إلى كل هذا، هل سيتغير العالم بالفن يوما ؟...ربما
ما رأيك بالكوميكس. الروايات المصورة. هل تعتقد أنها تستند لموقف حكائي من الذات الفنية. ولماذا لا تفكر بإضافة لمساتك الخاصة لهذا الفن المسلي والذائع الصيت؟.
الروايات المصورة تستند الى عمل فني متقن، له قوانينه وتقنياته ومحترفوه ممن يصنعون من الحكاية المدونة باللغة تناصا شكليا. يؤسس فنا يعيد إنتاج الحكاية بصريا. الحكاية هنا تنهل من رحيق الفن لترفد منه بعدها التشكيلي. لا أعتقد أني أصلح لهذا النوع من الفن، ولا يمكنني أن أقدم فيه ما يغني مسيرته، فكما قلت لهذا الفن فنانوه، وهم أدرى بشعابه مني .
لو سلمنا جدلا أن الفن أصلا هو موقف مع الإنسان وليس من الإنسان فقط. لماذا تعتمد فنون الدعاية والإعلام على الصور البسيطة والفوتوغرافيا. ألا ترى أن الإنسان العام يحبذ الصور الواضحة والرسائل التي لا تحتاج للتفكير. ألا تود أن تقترب من الإنسان المعدل. الإنسان المتوسط بذكائه والذي يحب التواصل وليس حل الألغاز؟.
أنا أتعامل مع المتلقي كشريك في القراءة البصرية والفكرية وفي البحث والتنقيب وفي الإشارة الى إحالات العمل. إنه طرف مهم في المعادلة البصرية وفحواها. المشاهد هو المحرض الأساس للابتكار، حينما يحسب الفنان حساب المتلقي سيجعله أكثر أمانة وحذرا في إنتاج ما يجعل الآخر يبتكر أيضا طرقه المعرفية في النظر إلى الفن ونتاجه. لذلك تكون مسؤولية الفنان الاقتراب من المشاهد بالطريقة التي تحفظ له كيانه، وتحترم وعيه وليس الاقتراب منه بالطريقة التي تتعامل معه وكأنه قاصر، وغير مدرك لمفهوم الفن كنتاج حضاري، وجمالي مرتبط بالزمن ويتأثر به. إن النص البصري المعاصر بحاجة لمن يحرره ويحافظ على ديمومته، ولايمكن تحقيق ذلك دون خلق حوار معرفي مع المتلقي، وهذا سيؤول لنسق من الأسئلة التي ستكون مفتتحا لخلق معارف مبتكرة تحرك الساكن. المتلقي يشغل حيزا كبيرا في العملية الإبداعية اليوم، ودوره لا يقل عن دور الفنان، لأن حوارهما سينتج حراكا فكريا. هذا الحراك سيجعل من الفن قيمة حياتية، وحاجة تلامس وجودنا، وليس نتاجا جماليا فحسب. مسؤوليتي كفنان تحرير المتلقي مما أرى أنا في العمل الفني، كشخص مغاير له، لأنني حينما أخلق أشكالي المفترضة، وأرسم صوري التي هي معنى وليس مظهرا. هذا المعنى سيؤول إلى صور وأشكال مختلفة لدى كل مشاهد على حدة، وبحسب المرجعية الفكرية والثقافة البصرية له، سيعيد اكتشاف عوالمه الخاصة وتفعيل أبعادها الفكرية في العمل الفني، من خلال تحرير مكنونه التخيلي بما يتلاءم مع تاريخه هو كشخص مغاير ومختلف عن شخص الفنان. من المؤسف أن يكون المشاهد متلقيا سلبيا، ينقاد لشروحات الفنان وتفسيراته للعمل، دون إيجاد حراك فكري بين المتأثر (المتلقي) وجهة التأثير (العمل الفني)، لأننا سنخسر المشاهد كشخص أنا أؤمن بأن مسؤوليته تتساوى مع مسؤوليتي في فعل الاكتشاف والنكوص ومشاعة التأويل. وسيخسر الفن تحولاته الفكرية والبصرية في اكتشاف طرق وأبعاد ومفاهيم جديدة لفن قادم، سيقودنا إلى طرق ومفاهيم أخرى تتسع للتطور الذي يتسابق مع وجودنا كبشر. أما في الدعاية والإعلان، فالأمر مختلف تماما، لأن العملية هنا مرتبطة بالتسويق لنتاج معين، وسيكون الفن وسيلة للوصول إلى هدف تسويق المنتج، ولذلك يعتمد الفنان الذي يمارس فن الإعلان إلى البساطة ومخاطبة مشاعر وعواطف المستهلك، وحتى هذا الرأي لايمكن تعميمه، لأن هنالك حتى في فن الإعلان الآن روح معاصرة في استخدام العناصر الفنية .
كيف تنظر للنهاية المحزنة التي وصل لها طابع البريد مع أنه لوحة فنية أو صورة مطبوعة. لقد ترك المجال لأرقام تعبر عن قيمة الإرسال فقط. ألا ترى أننا بحاجة لإجراء ما لنضع الفن بين أيدي الناس مجددا وأن نحررهم من هذا التفكير المادي والرأسمالي.. التفكير بالمقابل النقدي لقيمة الإرسال. أنا أعتقد أن الرسالة شيء له قيمة عاطفية أيضا ويستحق طابع بريد له حساسية فنية خاصة.
أتفق معك في هذا، على الرغم من أن الأمر لا يقتصر على طابع البريد فقط، بل إن الحلم والرغبة، والحاجة تؤكد حاجتنا إلى الفن، لتفعيل الجانب المتسامي والمشرق والنقي في إنسانيتنا، لنستعين به على هذا الحصار المفروض علينا، بفعل القبح الذي يحاول أن يسرق آدميتنا، ويحولنا إلى مجرد أرقام تحركها البيانات الرسمية وسجلات الأمن وصلافة السياسة وقبحها. لذلك الدعوة إلى أن نعيد لطابع البريد سمة الفن، وقيمة الإبداع، هي دعوة، لتحريرنا من عبودية الاستهلاك والجفاف الذي يضرب في خلايا وجودنا. أنا أطمح بأن يكون الفن عنصرا أساسيا من عناصر وجودنا، نتحدث به، ونعيش معه، وننقاد لفعله الجمالي والمعرفي، ويقوم بوشم أرواحنا بنقائه. حينها ستنتصر آدميتنا .
كيف تنظر لألوان التعبير الفني الأخرى. الوشم. أغلفة الكتب. إعلانات الساحات العامة وأنفاق المترو. اللوحات التي يحملها المتظاهرون. أو حتى الإعلان عن وظيفة شاغرة. هل تعتقد أنها نشاط فني عفوي له رسالة مثل الفن الرسمي. أم أنها أحد أعراض الحياة العامة الشاغرة من الأهداف؟.
كل ألوان التعبير التي ذكرتها تحمل سمات الفن وتشير إلى سعته التي ذكرناها، خصوصا وأن التقنيات العالية المتاحة الآن (الملتيميديا) التي تستخدم الآن في تنفيذ العديد من الإعلانات أو الملصقات الدعائية وأغلفة الكتب، سهلت للمصمم أو الفنان تحقيق خصائص فنية عالية الجودة في نتاجه، ولاننسى أن هنالك أسماء كبيرة في كل هذه المجالات، وعلينا أن لانغفل فنا مهما وهو فن الرسم على الجدران، أو فن الخطوط، حيث سجل تاريخ هذا الفن أسماء مهمة، ومنهم الفنان الأمريكي الراحل 'ميشيل باسكي'، والفنان العالمي 'بانسكي' الذي ساهم في الرسم على الجدار العازل الذي بنته اسرائيل أعمالا تشير إلى الأمل والحرية كنوع من الاعتراض على هذا الجدار الذي فرض على الشعب الفلسطيني عزلة وحصارا، للنيل من كرامته وآدميته، وجعلته يعيش داخل زنزانة كبيرة فرضها على هذا الشعب كعقوبة جماعية. هذا يؤكد أن الفن لم يعد محصورا في شكل أو نوع أو تقنية معينة .
من هو الفنان الذي تشدك تجربته أكثر من سواه. لماذا. هل تحب أن تعيد إنتاجه بطريقتك. بصيغة أخرى، هل ترك بعض الفنانين خطوطا ومفردات فنية نحن لا ننتبه لها في لوحاتك؟.
هنالك العديد من الفنانين المبدعين في العالم، ممن يمتلكون تجارب كبيرة ومغايرة، تجارب تثير الدهشة، وتجعل الفن أكثر إبهارا، وهذه التجارب المعاصرة هي امتداد لتجارب سابقة، وهذا يعني أن الفن لايجنح إلى السكون، بل هو يتفاعل وينقاد لخيال وبحث وابتكار مبدعيه. أنظر باعتزاز لكثير من التجارب سواء لدى الرواد أو الشباب في العالم العربي، أما عالميا، فهنالك أسماء تركت بصمات كبيرة في تاريخ الفن، ويمكنني أن أشير إلى تجارب فنانين مثل 'ساي تومبلي' أو 'كيفر'، و'تابيس' أو بويز' من أكثر التجارب التي تفاعلت معها، وشدتني أعمالهم لعالمها الخصب والشاسع، ربما لأنني وجدت في تجاربهم البعد الذهني والبصري مما أسعى إليه في عملي الفني، وهو أن أجعل العمل مشاعة فكرية، يمكن لكل إنسان أن يتوحد، ويتفاعل معها، وأن يعيد تدوين المعنى الذي يتواءم مع كيانه كشخص مغاير، وأن يتجدد هذا المعنى ويتغاير مع الزمن، وأن يبقى العمل متفاعلا لا يستكين إلى نص يوجزه، ولا مساحة تحتويه. أما سؤالك عن رغبتي في إعادة إنتاجهم بطريقتي أو عن وجود بعض مفرداتهم في أعمالي، فهذا جائز ليس فقط مع هذه الاسماء، لأن أي فنان مهما ابتكر مفردة أو استخدم عنصرا، سيكون هناك من سبقه، لأن عمر الفن أكثر من سبعة آلاف سنة، وحتى المدارس لم تنبثق من الفراغ، لأن الإنسان الأول قد ترك لنا رسوماته التي تراوحت ما بين النسخ الواقعي للطبيعة، والرمزيات أحيانا، وحتى التجريد من خلال الرسوم الطوطمية، أو ذات البعد السحري والملغز التي كان يحاول من خلالها مهادنة الطبيعة والسيطرة عليها، من خلال الإشارات والرموز والخربشات، وهذا يدل على أن الفن ومنذ القدم كان عنصرا فاعلا في حياة الإنسان ومكملا لتواجده، وعبر العصور .
وأخيرا لا بد من الإشارة لفناني الشوارع الذين يرسمون البورتريهات الجامدة للتكسب. أين العلاقة بين الفن والمجتمع. هل أثر نمط الحياة على تصورات هؤلاء الفنانين المطرودين من المؤسسة. وهل تعتقد أن بعضهم سيدخل الأكاديمية في أحد الأيام؟.
أنا لدي وجهة نظر قد يختلف فيها معي الكثيرون، وهي أن هنالك فرقا بين الفنان والرسام، فالرسام هو كل من يزاول فعل الرسم من خلال الاعتماد على الحرفة، واليد التي ستكون في خدمة الحرفة، وهو لا يحتاج إلى الكثير من الجهد الذهني، لأن عمله سيتركز على نسخ واقع عياني، وسيكون العمل واضح الملامح، ومفسرا على النحو الذي لا يحتاج إلى البعد الفكري للتفاعل معه، على العكس من الفنان، فهو يزاول فعل الفن من خلال الاعتماد على المخيلة، واليد التي ستكون في خدمة المخيلة، وبإيعاز من تراكمات وتفاعلات ذهنية تشير لعوالم، وفضاءات، ودلالات غير معلنة أو واضحة المعالم في العمل. هذا لا يعني إقصاء رسامي البورتريهات من مدينة الفن الفاضلة، بل بالعكس فمرحلة الرسام كثيرا ما تكون مرحلة مهمة وفاعلة لنضوج الفنان داخل الرسام، حين يمتزج الذهني بالحرفي، ويتركا مجالا لعفوية تقود الفن إلى مرامي كثيرة.
تموز 2012
القدس العربي- 2012-08-08