 غيّب الموت فجر أمس في عمّان الكاتب والناقد والمؤرخ إحسان عباس عن 83 سنة، وكان راقداً في حال من الغيبوية حلّت به قبل أيام.
غيّب الموت فجر أمس في عمّان الكاتب والناقد والمؤرخ إحسان عباس عن 83 سنة، وكان راقداً في حال من الغيبوية حلّت به قبل أيام.
ولد إحسان عباس في قرية عين غزال (حيفا) سنة 1920. أنهى فيها المرحلة الابتدائية من دراسته وأنهى الإعدادية في صفد. حصل على منحة إلى الكلية العربية في القدس، وعمل في التدريس سنوات قبل التحاقه بجامعة القاهرة في 1948. حصلت النكبة فانقطعت أمامه سبل العودة إلى فلسطين، فعمل وواصل دراسته في القاهرة. وفي مطلع الخمسينات تعاقد مع جامعة سودانية لتدريس الأدب العربي، وهناك راحت تتوالى أعماله النقدية. وكانت دراسته عن ديوان البياتي "أباريق مهشمة" (1955) من أولى الدراسات التي تصدّت للشعر الحديث والحر. تنقل عباس بين حقول معرفية عدة، فأنتج ما يزيد على 25 مؤلفاً بين النقد الأدبي والسيرة والتأريخ، وحقق ما يقارب 52 كتاباً من كتب التراث، فضلاً عن أكثر من 12 ترجمة من عيون الأدب والنقد والتاريخ. ودرّس إحسان عباس الأدب والتاريخ والنقد الأدبي والحضارة في جامعات عدة منها الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة الأردنية. وحاز أوسمة وجوائز عدة منها جائزة سلطان العويس للدراسات النقدية.
من مؤلفاته النقدية وتصانيفه وتحقيقاته وترجماته
- الحسن البصري (1952)،
- أبو حيان التوحيدي (1956)،
- الشريف الرضي (1959)،
- تاريخ الأدب الأندلسي - عصر الطوائف والمرابطين (1962)،
- رسالة في التعزية لأبي العلاء المعري (1950)،
- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم مصر)،
- للعماد الأصفهاني (1952)
- بالاشتراك مع شوقي ضيف وأحمد أمين، رسائل ابن حزم الأندلسي (1955)،
- فضل المقال في شرح كتاب الأمثال، لأبي عبيد البكري (1958). بالاشتراك مع عبدالمجيد عابدين، جوامع السيرة، لإبن حزم الأندلسي (1958)، بالاشتراك مع ناصر الدين الأسد،
- التقريب لحد المنطق، لاين حزم الأندلسي (1959)، ديوان ابن حمديس الصقلي (1960)،
- ديوان الرُّصافي البلنسي (1960)،
- ديوان القتّال الكلابي (1961)،
- ديوان لبيد بن ربيعة العامري (1962)،
- شعر الخوارج (1963)،
- الكتيبة الكامنة، للسان الدين بن الخطيب (1963)،
- وفيات الأعيان، لابن خلكان (8 أجزاء) 1968-1972،
- طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي (1970)،
- فن الشعر (1953)،
- عبدالوهاب البياتي: دراسة في "أباريق مهشمة" (1955)،
- فن السيرة (1956)، الشعر العربي في المهجر (1957)،
- بالاشتراك مع محمد يوسف نجم، بدر شاكر السياب (1969).
وله في الترجمة:
- "فن الشعر" لأرسطو، النقد الأدبي ومدارسه الحديثة" (1958-1960)، لستانلي هايمن،
- "يقظة العرب" لجورج أنطونيوس (1962)،
- "دراسات في الأدب العربي" (1959)، لفون جرنباوم،
- "دارسات في حضارة الإسلام" (1962) لهاملتون جب.
الحياة 2003/07/31
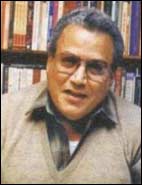 إحسان عباس واحد من النقاد النادرين الذين لا يوجدون في ثقافتنا العربية إلا على سبيل الاستثناء، وفي الفرط بعد الفرط كما يقول القدماء. وأول ما يميز إحسان عباس الناقد هو جمعه بين الخبرة التراثية بعلوم العرب القديمة والوعي المعاصر بتيارات الأدب والنقد في العالم الأوروبي - الأميركي، وهو الأمر الذي جعله يجمع ما بين أصالة المعرفة ومعاصرة المعالجة والاختيار، إضافة إلى درجة عالية من الرهافة في معالجة النصوص الإبداعية وتناولها. وتقترن الرهافة العالية بنوع من الحدس النفاذ الذي يبين عن العلاقات الخفية التي تنبني عليها الأعمال والظواهر، والذي يكشف عن الظلال المتدرجة من المعاني والإيحاءات التي تشعها النصوص في كل اتجاه. ولا ينفصل ذلك كله عن وعي نظري يتسم برحابة الأفق وشمول النظرة والمرونة الفكرية التي لا تسجن نفسها في أي إطار ضيق أو جامد. وإذا كان ناقداً عالمياً كبيراً مثل بول دي مان قد تحدث عن العمى والبصيرة في ممارسة النظريات النقدية أو الأدبية، فإن بصيرة إحسان عباس النقدية ظلت تنقذه دائماً من عمى النظريات المحدودة الرؤية، وتفتح وعيه على الجديد دائماً، لكن بما لا يتنكر للقديم، أو يتعارض مع تنوع المجالات التي عمل بها إحسان عباس - الظاهرة. رحمه الله فقد فقدت الثقافة العربية بفقده نجماً من ألمع نجومها، وفقدت، أنا، على المستوى الشخصي، أستاذاً رائداً، وزميلاً نادراً، وصديقاً رائعاً، فوداعاً أيها العزيز.
إحسان عباس واحد من النقاد النادرين الذين لا يوجدون في ثقافتنا العربية إلا على سبيل الاستثناء، وفي الفرط بعد الفرط كما يقول القدماء. وأول ما يميز إحسان عباس الناقد هو جمعه بين الخبرة التراثية بعلوم العرب القديمة والوعي المعاصر بتيارات الأدب والنقد في العالم الأوروبي - الأميركي، وهو الأمر الذي جعله يجمع ما بين أصالة المعرفة ومعاصرة المعالجة والاختيار، إضافة إلى درجة عالية من الرهافة في معالجة النصوص الإبداعية وتناولها. وتقترن الرهافة العالية بنوع من الحدس النفاذ الذي يبين عن العلاقات الخفية التي تنبني عليها الأعمال والظواهر، والذي يكشف عن الظلال المتدرجة من المعاني والإيحاءات التي تشعها النصوص في كل اتجاه. ولا ينفصل ذلك كله عن وعي نظري يتسم برحابة الأفق وشمول النظرة والمرونة الفكرية التي لا تسجن نفسها في أي إطار ضيق أو جامد. وإذا كان ناقداً عالمياً كبيراً مثل بول دي مان قد تحدث عن العمى والبصيرة في ممارسة النظريات النقدية أو الأدبية، فإن بصيرة إحسان عباس النقدية ظلت تنقذه دائماً من عمى النظريات المحدودة الرؤية، وتفتح وعيه على الجديد دائماً، لكن بما لا يتنكر للقديم، أو يتعارض مع تنوع المجالات التي عمل بها إحسان عباس - الظاهرة. رحمه الله فقد فقدت الثقافة العربية بفقده نجماً من ألمع نجومها، وفقدت، أنا، على المستوى الشخصي، أستاذاً رائداً، وزميلاً نادراً، وصديقاً رائعاً، فوداعاً أيها العزيز.
الحياة 2003/07/31
 قد يكون إحسان عباس من آخر "الأساتذة" في الرعيل المخضرم الذي نجح أيما نجاح في التوفيق بين التراث والحداثة، خائضاً، على خلاف الكثيرين، معركتهما معاً ومنحازاً إليهما في آن واحد كتيارين مختلفين. وكم كان هذا "العلاّمة" الذي درست عليه أجيال وأجيال من الأدباء والنقاد، قادراً فعلاً على أن يكون حديثاً ومعاصراً وذا بصيرة حاذقة، فيما جذروه تضرب في أديم التراث العربي والتاريخ، وفي عمق الفلسفة القديمة، الإغريقية والعربية والغربية. ولم يكن يضيره أن يدافع عن ثورة الشعر الحرّ ويضع كتباً عن عبدالوهاب البياتي وبدر شاكر السياب وشعراء آخرين أو أن يتناول الحركة السوريالية وسواها، هو الذي كان خير متضلّع في أدب التوحيدي وابن حزم وابن خلكان وفي شعر الشريف الرضيّ ولبيد بن ربيعة وكثيّر عزة والقاضي الفاضل وسواهم ممن لا يحصون.
قد يكون إحسان عباس من آخر "الأساتذة" في الرعيل المخضرم الذي نجح أيما نجاح في التوفيق بين التراث والحداثة، خائضاً، على خلاف الكثيرين، معركتهما معاً ومنحازاً إليهما في آن واحد كتيارين مختلفين. وكم كان هذا "العلاّمة" الذي درست عليه أجيال وأجيال من الأدباء والنقاد، قادراً فعلاً على أن يكون حديثاً ومعاصراً وذا بصيرة حاذقة، فيما جذروه تضرب في أديم التراث العربي والتاريخ، وفي عمق الفلسفة القديمة، الإغريقية والعربية والغربية. ولم يكن يضيره أن يدافع عن ثورة الشعر الحرّ ويضع كتباً عن عبدالوهاب البياتي وبدر شاكر السياب وشعراء آخرين أو أن يتناول الحركة السوريالية وسواها، هو الذي كان خير متضلّع في أدب التوحيدي وابن حزم وابن خلكان وفي شعر الشريف الرضيّ ولبيد بن ربيعة وكثيّر عزة والقاضي الفاضل وسواهم ممن لا يحصون.
أمضى إحسان عباس حياته منذ أن غادر فلسطين بُعيد نكبة 1948 منقّباً في الكتب التراثية القديمة ومحققاً المخطوطات الثمينة وباحثاً ومؤلفاً ومدوّناً بعض السير، وكانت آخرها سيرته الذاتية البديعة التي وضعها قبل سنوات تحت عنوان "غربة الراعي" وفيها كتب صفحات من تاريخه الشخصي، العائلي والعلمي والثقافي. ويصعب فعلاً تعداد ما حقق من كتب ودواوين وما أنقذ من مخطوطات كانت لتهجع في أدراج النسيان.
ولعل ما ميّز نصوصه النقدية والتأريخية تلك النفحة الأدبية التي نادراً ما يعرفها النقاد وهي ندّت عن نزعته الإبداعية، ناثراً وشاعراً. وكم كان مفاجئاً حقاً إقدام عباس قبل ثلاث سنوات وكان في الثمانين من عمره، على جمع ما كتب من قصائد في مطلع حياته الأدبية (1940 - 1948) في ديوان سمّاه "أزهار برية"، وبدا شعره ينتمي إلى الحقبة الرومنطيقية العربية. ظل طيف الشاعر والأديب ماثلاً في حياة إحسان عباس وفي إنتاجه النقدي على السواء. ولم تستطع روحه العلمية ودقّته المنهجية أن تسيطرا على ذائقته الأدبية، فإذا أعماله النقدية نصوص ممتعة تجمع بين حصافة النقد وجمال اللغة وطلاوة الأسلوب. أما ترجماته فلا تقلّ إبداعا عن أعماله النقدية وهو أكبّ على تعريب كتب بارزة مثل "فن الشعر" لأرسطو و"فلسفة الحضارة" لأرنست كاسيرر و"يقظة العرب" لجورج انطونيوس. لكن ذروة صنيعه في حقل الترجمة تجلّت في رواية "موبي ديك" للروائي الأميركي الكبير هيرمان ملفيل. وهذه الترجمة تعدّ من عيون الترجمات العربية التي شهدتها لغة الضاد. وكان عباس فيها أمينا على الصيغتين: الصيغة الأم والصيغة العربية. ونظراً إلى إلمامه العميق بأسرار الإنكليزية والعربية استطاع أن يصنع معجماً بالعربية للمصطلحات والمفردات البحرية التي استخدمها ملفل، معتمداً ذائقته اللغوية ودرايته وحدسه.
قد يكون وصف إحسان عباس بـ"سادن التراث" خير معبّر عن شخصه كباحث ومحقق ومؤرّخ شغوف بالنصوص التراثية، لكن صفة "علامة" قد تفيه بعضاً من حقه، هو الذي يتسم بخامة نادرة تذكّر بجهابذة الفكر والأدب في عصر النهضة. ويكفي إحسان عباس أن يكون ذلك "العلامة" النهضوي الذي صالح بين هويته التراثية وانتمائه الحداثي.
الحياة 2003/07/31
إحسان عباس واحد من جيل الأساتذة الكبار في الثقافة العربية في القرن العشرين. سيرته الشخصية تلخص سير الكثيرين من المثقفين العرب الذين تفتح وعيهم على الصدام بين العرب والغرب، ونشوء إسرائيل على أجساد الفلسطينيين وتاريخهم الشخصي والجماعي. فهو ولد في قرية عين غزال في فلسطين عام 1920، وقد كان في السنوات الأخيرة من تعليمه الجامعي عندما ضاعت فلسطين وتشرد هو وأهله في جهات الأرض الأربع، ما جعل النكبة تحفر عميقاً في نفسه ليقيم في ما بعد توازياً بين ضياع فلسطين وضياع الأندلس، ويشغف بالتعرف على تاريخ الأندلس الذي كان واحداً من الموضوعات الأثيرة إلى نفسه.
كان إحسان عباس أهم متخصص في تاريخ الأندلس وآدابها، انطلاقاً من ذلك التوازي القائم بين ضياع فردوسه الشخصي المفقود وفردوس العرب والمسلمين المفقود قبل خمسمئة عام. وقد أنجز على مدار عمره عدداً من الكتب التي تؤرخ للأندلس ومنجزها الحضاري الكبير، وعلى رأسها كتابه الضخم "تاريخ الأدب الأندلسي" في جزءين، وحقق أهم المصادر التراثية التي تصور اللحظات الذهبية التي عاشها العرب في تلك البلاد البعيدة عن قلب عالمهم الآسيوي. ومن هنا فإن مكتبة التراث العربي، في عصوره المختلفة الأندلسية وغير الأندلسية، تحمل بصماته لكثرة ما حقق من كتب وما أنجز من مؤلفات تعيد إحياء تلك الأزمنة التي ذكرته وذكرتنا بأن العرب كانوا في مقدمة الحضارات العتيقة التي خلدت في كتاب التاريخ.
لكن اهتمامه بالتراث، وعمله الأكاديمي الموصول على مدار عقود في أقسام اللغة العربية سواء في جامعة الخرطوم السودانية أو الجامعة الأميركية في بيروت أو الجامعة الأردنية، لم يصرفاه عن محاولة الوصول بالنقد العربي إلى زمانه الراهن، ملخصاً ومترجماً النظريات النقدية الغربية التي راجت في زمان تكونه ونضجه الثقافي. لم يتعصب إحسان عباس للتراث والمنجز البلاغي والنقدي في ميراث العرب فانطلق يؤصل للنقد في زمان العرب الحديث ويفتح أفق هذا النقد على اللحظة المعاصرة في العالم. لقد كتب مؤلفه حول "تاريخ النقد العربي حتى القرن الرابع الهجري"، الذي نعود إليه كلما أردنا التعرف على تطور الفكر النقدي عند العرب وعلى اللحظات المتوهجة في ذلك المنجز النقدي، لكنه ألف كتباً أخرى حول "فن الشعر" و"فن السيرة"، وهما كتابان ممتعان يستندان إلى النظرية الرومانسية ونسلها من النظريات الغربية حول مفهوم الشعر والكتابة بعامة. كما استمر يزاوج في كتاباته النقدية بين معرفته العميقة بالتراث وتبصره بالرؤى النقدية المعاصرة في الغرب، مستنداً في ذلك إلى متابعة نشطة لما يصدر في الغرب من كتب نقدية وما يجد من كشوفات نظرية، خصوصاً أن الناقد الكبير الراحل ترجم الكثير من الكتب النقدية عن الإنكليزية ومن بينها "الرؤية المسلحة" لستانلي هايمان (بالاشتراك مع د. محمد يوسف نجم) الذي وضع له عباس عنوان "النقد الأدبي ومدارسه الحديثة"، و"مقالة في الإنسان" لإيرنست كاسيرر عن فلسفة كانط، وكتاب ماثيسن عن إليوت، وكتاب كارلوس بيكر عن همنغواي "الكاتب فناناً".
هذا الاتصال العميق بما يصدر من كتب نقدية في العالم الأنجلو ساكسوني هو الذي جعل إحسان عباس متفرداً من بين الكثيرين من أبناء جيله من النقاد العرب، فهو لم يكتف بالترجمة والتعريف بالمدارس النقدية الحديثة بل صدر في عدد من كتبه حول الشعر العربي المعاصر من رؤى تلك المدارس الجديدة في زمنه. ولعل كتابيه الأساسيين عن حركة الشعر العربي المعاصر، وهما الكتابان المرجعيان عن البياتي والسياب، هما ثمرة الاتصال بالنقد الغربي في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
دفعته حماسته للقصيدة العربية الجديدة في نهاية الأربعينات، أي في فترة مبكرة صاحبت انبثاق رؤية جديدة للشعر والثقافة العربيين بعد نكبة فلسطين، لكي يخص عبد الوهاب البياتي، الشاعر الشاب في تلك الفترة، بكتاب عنوانه عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث" (1955)، منظراً لتحولات القصيدة العربية الجديدة وأتواقها، وكيفية نظرها إلى وظيفتها ورؤيتها للعالم والمجتمع والذات الفردية، من خلال قراءة منجز البياتي الشعري في تلك الفترة المبكرة من اندفاعة القصيدة العربية الجديدة. وبرهن عباس، في كتابه ذاك، عن جرأة نقدية واستبصار عميق لما يمكن أن تصير إليه القصيدة العربية في مقبل الأيام. أما كتابه الآخر عن "بدر شاكر السياب" (1969) فكان بمثابة حفريات في تاريخ السياب الشخصي وسيرته الشعرية، إذ تتبع بدقة الأكاديمي الحصيف مراحل حياة السياب وانشباك الحياة اليومية للشاعر بما يكتبه من شعر.
أنهى عباس علاقته بما أنجزته القصيدة الجديدة في كتابه "اتجاهات الشعر العربي المعاصر" الذي نشرته سلسلة عالم المعرفة الكويتية عام 1978 حيث قرأ آفاق تحول الشعر العربي في القرن العشرين من خلال النظر إلى مواقف الشعراء من الزمن والمدينة والتراث والحب والمجتمع. وبغض النظر عن العاصفة التي أثارها ذلك الكتاب في حينه، والانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه، فقد مثل تصورات عباس، الذي ظل طوال مسيرته النقدية واقعاً تحت تأثير إليوت الناقد والواقعين في ظلاله من جماعة النقد الجديد في بريطانيا وأميركا، حول مفهوم الشعر والثقافة بعامة. لكن اهتمام الناقد الراحل بمفهوم الالتزام، وهو المفهوم الذي كان أثيراً إلى نفوس نقاد الخمسينات والستينات في القرن الماضي، جعله ينظر إلى العمل الأدبي بصفته تعبيراً عن سياق اجتماعي محدد معطياً هذا العمل وظيفة سياسية ــ اجتماعية، وهو الأمر الذي يتعارض في جوهره مع مدرسة النقد الجديد الأنغلو ساكسونية التي تقرأ العمل الأدبي بصفته أيقونة نازعة هذا العمل من سياق إنتاجه ناظرة إليه كمعطى غير زمني، ونص عابر للتاريخ. ولا أظن أن عباس قد آمن بهذا التصور للآثار الإبداعية على مدار تجربته النقدية على رغم كثرة ما ترجم عن نقاد ينتمون في فهمهم للعمل الإبداعي إلى مدرسة النقد الجديد.
لكن إحسان عباس لم يكتف بالكتابة النقدية، أو تحقيق أمهات الكتب العربية أو ترجمة الكتب الكلاسيكية في النقد الأنجلو ساكسوني ، بل إنه صرف حوالى السنة ونصف السنة من عمره يترجم رواية الكاتب الأميركي الشهير هيرمان ملفيل "موبي ديك" ويعيد كتابتها بالعربية. وعلى رغم أنه تمرس في ترجمة الكتب النقدية والفلسفية ولم يترجم قبل "موبي ديك" رواية أو عملاً إبداعياً إلا أن قارئ الترجمة يجد أنها تضاهي الأصل في جماله وسلاسته وبنيته المركبة وتنوعه الأسلوبي وقدرته على عرض مستويات لغوية مختلفة تتناسب والشخصيات التي يحتشد بها العمل الروائي. ففي صفحات ترجمة إحسان عباس لموبي ديك، التي تزيد على التسعمئة صفحة، يجلو المترجم روح هذا العمل الروائي البديع الذي ينتقل من لغة الحياة اليومية في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى لغة الكتب المقدسة، ويعيد صوغ مقاطع من مسرحيات شكسبير، ويدمج التأملات بلغة الوصف التفصيلية. وحين تصدى عباس لنقل رواية ملفيل إلى العربية حاول أن يكون أميناً لمستوياتها اللغوية المختلفة، لكنه في الوقت نفسه حول الفصول المكتوبة بلغة إنكليزية رفيعة إلى عربية شديدة الفصاحة والرفعة تقترب في جمالها من لغة كبار الناثرين العرب من أمثال الجاحظ وطه حسين، في الوقت الذي ترجم العبارات الإنكليزية المكسرة إلى عربية مكسرة كذلك. ولهذا تستحق ترجمة عباس لرائعة هيرمان ملفيل أن تذكر بصفتها واحدة من إنجازاته الكبيرة التي لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام.
توزع إحسان عباس بين تحقيق التراث، الذي كان علماً من أعلامه الكبار في القرن العشرين، والترجمة وتاريخ الأدب والنقد، بل وكتابة التاريخ. ولعل هذا التمزق بين شجون معرفية عدة هو ما شغله عن تطوير عمله النقدي، خصوصاً في السنوات العشرين الأخيرة من حياته. لكنه، بما أنجزه في حقل تحقيق التراث والكتابة عنه وكذلك في الترجمة، يضيف إلى نقده بعداً مثرياً عميقاً يضيء لنا نحن أحفاده من النقاد العرب كيف عمل هذا الناقد الموسوعي الكبير في خضم هذه المعارف المتباعدة واصلاً بين العصور والحضارات، بين ثقافة الذات وثقافة الآخر.
الحياة 2003/07/31
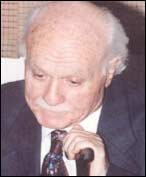 وقع عليّ نبأ وفاة إحسان عباس وقع الصاعقة، وأحسب أن الوقع كان كذلك على كثيرين من أصدقائه وتلامذته ومحبيه. وما جاءت كارثية الخبر من انه غير متوقع - فقد تناهبت الأمراض جسد الشيخ لسنوات، وبلغت الذروة قبل أسبوعين - بل لأن إحساناً ومنذ قرابة الثلاثين عاماً، صار بالنسبة إلينا جزءاً من عالمنا الثقافي والإنساني، ونصاب التماسك والبقية الباقية للانتظام في كوننا الثقافي العربي الذي يتضاءل ويضيق... وينهار.
وقع عليّ نبأ وفاة إحسان عباس وقع الصاعقة، وأحسب أن الوقع كان كذلك على كثيرين من أصدقائه وتلامذته ومحبيه. وما جاءت كارثية الخبر من انه غير متوقع - فقد تناهبت الأمراض جسد الشيخ لسنوات، وبلغت الذروة قبل أسبوعين - بل لأن إحساناً ومنذ قرابة الثلاثين عاماً، صار بالنسبة إلينا جزءاً من عالمنا الثقافي والإنساني، ونصاب التماسك والبقية الباقية للانتظام في كوننا الثقافي العربي الذي يتضاءل ويضيق... وينهار.
كنت ما أزال فتى يافعاً عندما قرأت دراسة عباس عن بدر شاكر السيّاب، رائد الحداثة الشعرية العربية. وقد تملكتني قراءته البالغة الروعة والشفافية لشعر السياب وشخصيته حيث بذلت جهوداً ووساطات كثيرة لكي أتمكن من مقابلته. وعندما حدث ذلك بالمصادفة في صيف العام 1971، كنت قد أعددت العدّة التي ظننتها مغرية له بقبولي في كونه، من طريق قراءة كل ما كتبه حتى ذلك الحين. لكن الأمر كان أسهل بكثير مما تصورته. تدخل على إحسان فيغمرك خلال دقائق إحساس بالدفء والاحتضان، وبدلاً من أن تقعد بحضرته، يجلس إليك هو متحدثاً في شتى المواضيع والشؤون لطمأنتك، ولبعث الألفة في أوصالك، والشعور بالود والتقدير. وعندما تنفك عقدة اللسان بعد اقل من نصف ساعة، تكون الخطط الطويلة العريضة كلها قد تغيرت: ما ذكرت له شيئاً مما أعددته، بل أخبرته إنني تخرجت في الأزهر بمصر، وتعرفت على العقاد وطه حسين ومحمود شاكر، وأنهم جميعاً ذكروه باعتباره طليعة الجيل اللاحق لجيلهم، أما أنا فقد قرأت له دراسته لمحمد السياب أولا ثم دراسته القديمة عن البياتي، ودراساته وتحقيقاته الأندلسية، وأخيراً تحقيقه لوفيات الأعيان لابن خلكان... و... أوقفني إحسان عند هذا الحد، وقال لي انه يعد لمشروعين كبيرين، أحدهما في التحقيق (الذخيرة لابن بسام)، والآخر في الدراسة: تأثير الأدب اليوناني في الأدب العربي من خلال الترجمات. ونقد الشعر في التراث النقدي العربي القديم. وعجبت لاستشارته لي، على حداثة السن، وقلة المعرفة، لكنها كانت سويعة فتحت الأفق على علاقة للتتلمذ والتلعثم والتأدب... والصداقة، ستبقى ما بقيت هذه الأشكال الفانية، ولعلها تخترق "غربة الروح" التي تشبث بها أبو حيان التوحيدي، صديق إحسان عباس، بعد أن عز عليه الملاذ.
ظل إحسان عباس يكتب وينتج حتى تعذر عليه ذلك قبل ستة اشهر. وقد شهدته منذ أواسط السبعينات يكتب آلاف الصفحات بخطه الجميل والدقيق. بعد "وفيات الأعيان" مطلع السبعينات، حقق عشرات روائع التراث من مثل التذكرة الحمدونية، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي (على مخطوطات جديدة). وبعد تاريخ النقد الأدبي كتب عشرات النصوص النقدية الكاشفة. واقبل في الثمانينات والتسعينات بعد مغادرة بيروت والاستقرار بعمان، على كتابة تاريخ بلاد الشام الذي أنجز منه ثمانية أجزاء حتى مشارف العصر العثماني. وإضافة إلى ذلك اشرف إحسان عباس على عشرات الطلاب الذين صاروا أساتذة الجيل الحالي في نظرية النقد، وتاريخ النقد الأدبي العربي. وظل حتى مرضه الأخير يستقبل عشرات الطلاب والأساتذة ممن يرجون الإفادة من معرفته وتجربته. عندما توثقت معرفتي به في النصف الثاني من السبعينات، كان المستشرقون الذين عرفتهم من خلال دراستي بألمانيا يسمونه على سبيل التحبب "قمر الزمان". وكان الأستاذ مانفريد اولمان (الذي لا يزال منذ أربعين عاماً يصدر أجزاء متوالية من المعجم التاريخي للغة العربية) يقول لي: "احسب أن هذا الرجل "ينظر بنور الله" كما يعبر الصوفية، لأنه لا يعجزه شيء في تراثكم الكتابي الهائل! نحن يا رضوان، نقضي عشرات السنين للتعمق في ناحية معينة في التراث العربي ولا نكاد نفلح، وإحسان عباس ينتج جديداً وأصيلاً في كل المجالات، حتى في الفقه (كنت قد أحضرت له معي نسخة من تحقيق إحسان عباس لكتاب الخراج لأبي يوسف). وقد عرفت (لا يزال الكلام لأولمان) من يوسف فان إحسان عباس في طليعة نقاد الأدب العربي الحديث: من أين للرجل هذه المعرفة الثرة، وهذا العلم الفذّ وذاك التضلع من الثقافة المعاصرة، وذلك الوقت المبارك؟!".
عباس الفلسطيني، من قرية عين غزال الوادعة، التي أزالها الصهاينة عن بكرة أبيها، وعائلته التي تشردت بين الأردن والعراق ولبنان والمهاجر... وشعره الأول، وعلاقاته الأولى قبل الهجرة والنفي، ودراسته في الكلية العربية. كل ذلك كان الحديث عنه من المحرمات في مجلسه مهما بلغت حميمية العلاقة به. عرفت شيئاً من ذلك من خلال السيرة الأولى التي أسهم فيها شقيقه بكر (توفي قبل ثلاث سنوات)، وتلميذته وداد القاضي، تقديماً للكتاب التذكاري الصادر مطلع الثمانينات. لكن الفاجعة المتسترة وراء ذلك الأنس الباش، ظهرت في سيرته الذاتية "غربة الراعي" قبل ست سنوات. كان إحسان عباس مغرماً بعبارة بدر شاكر السياب في قصيدة "المطر": "الأسى الشفيف"، بيد أن كآبته في الغربة بدت ضاجة صارخة من دون حجاب ولا مجاملات.
عندما عزيته بشقيقه بكر، وكان اعز الناس عليه منذ خرجا من فلسطين، قال لي: "كنت اذكر به فلسطين، فكأنها ضاعت ثانية! الشتات ممات يا رضوان، والغربة مفرد دامع، لكنها تعجز عن القبض على شِغاف السريرة!".
آه، يا أبا إياس! ليته كان صراعاً للعثور على المصطلح الملائم أو المفرد الصحيح. هي الغربة الحقيقية التي تتجاوز الراعي ولا تتوقف عند الرعية. عزاء لأم إياس ونرمين وإياس وأسامة، وسلاماً أيها الغريب!
الحياة 2003/07/31
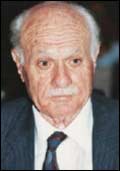 رحل إحسان عباس بعد صراع مع متاعب القلب والجسد دامت شهوراً. صراع مع الشيخوخة وأمراضها، استمر يراوح بين بيته وغرفة العناية المركّزة في أحد مستشفيات عمان، وحوله نفر من أصدقاء العمر والتلاميذ الكثر الذين تتلمذوا عليه وعلى كتبه.
رحل إحسان عباس بعد صراع مع متاعب القلب والجسد دامت شهوراً. صراع مع الشيخوخة وأمراضها، استمر يراوح بين بيته وغرفة العناية المركّزة في أحد مستشفيات عمان، وحوله نفر من أصدقاء العمر والتلاميذ الكثر الذين تتلمذوا عليه وعلى كتبه.
منذ أيام قليلة، كنا في زيارة أستاذنا الدكتور إحسان عباس، في منزله الذي عاد إليه بعد وعكة صحية اضطرته للبقاء في غرفة الإنعاش أسبوعين كاملين. وفي سريره الذي في بيته، وبحضور رفيقة عمره أم إياس، كان عباس يتشبث بنا لنتحدث معه في الأدب والشعر، فيما هو يحاول أن يتكلم بشفتيه، بعد ارتخاء الفكين وعدم مطاوعة اللسان، كان يخرج أصواتاً غير محددة، فنفهم ما نفهم، ونقدِّر البقية تقديراً.
كنت وأنا أشدّ على يده الناحلة، أشعر بقوة الحياة. كنت أقرأ له شعراً حيناً، وأحاول تذكيره بلقاءاتنا حيناً، وأخاف أن أقرأ له من ديوانه "أزهار بريّة" الذي وجدته على الطاولة وأنا أدخل غرفته خوفاً على قلبه الذي أخذت نبضاته تتسارع، فيما هو يشدّ على يدي التي تشدّ على يده.
الشاعر أولاً
كان عباس بدأ بكتابة الشعر في سن مبكرة (في الخامسة عشرة من عمره). لكنه، وربما بسبب ما يتميز به من خجل يصل إلى حد الانطواء، لم يكن قد عُرف شاعراً إلا في نطاق ضيق. فجاءت النكبة لتضعه أمام نفسه في مواجهة حاسمة، فأخذ يئد محاولات القصيدة التي كانت تفرض نفسها عليه. وعندما تلح ويشعر بضغط الشعر، كان يلقي بالقلم ويهرب إلى التجوال خارج البيت لساعات يشعر بعدها بالإرهاق وبعدم الرغبة في كتابة الشعر.
هكذا كان يفعل حتى العام 1952 الذي كان آخر عهده بكتابة الشعر. وهو يتذكر، بحسرة ومرارة، تلك المرحلة الحاسمة، فيقول كما لو كان يدفع تهمة لم يوجهها إليه أحد: "لم أتوجه إلى النقد والترجمة والتحقيق بسبب إخفاقي في الشعر، ولا أعتقد أنني أخفقت شعرياً. لقد كتبت قصائد كانت في حينها ذات قيمة كبيرة، ومتميزة. لكنني قتلت الموهبة. رأيت أنني لن أخدم قضيتي وقضايا أمتي بالشعر". أما الآن، وبعد أكثر من أربعين عاماً، فلم تعد القصيدة تمتلك تلك القدرة على الضغط. ويعتقد أنه لو كتب الآن شعراً لجاء أقرب إلى الأفكار الفلسفية "أقرب إلى شعر المعري". لذلك فهو لا يكتبه.
بحث إحسان عباس عن ذاته في الشعر، فلم يجدها كما يريدها. وربما كان البحث عن الذات، في حقل من الحقول، دافعاً من دوافع الخوض فيه. ولكن التنقل من حقل إلى آخر ليس مرتبطا بهذا الدافع تماماً، إلا في المظهر الخارجي. أما الدوافع الحقيقية، فجاءت في إجابة الدكتور عباس على سؤالنا. يقول عن تعدد الحقول والانتقال من النقد الأدبي إلى الترجمة إلى التحقيق ثم إلى الدراسات التاريخية، واصفاً التداخل في عمل الناقد المبدع: "في الظاهر يبدو هذا تعدداً، لكنه في حقيقته ينطوي على وحدة. فأنت حين تقبل على العمل في النقد، لا بد أن تعرف الأدب نفسه وتاريخ الأدب أيضاً، ولا بد من أن توسع ثقافتك بالإطلاع على ما يجد من نقد في ثقافات أخرى، وتتجاوز حد الإطلاع الذاتي فتنقل ما أعجبك في هذا المجال إلى بني قومك (وهنا مجال الترجمة). والعمل في النقد الأدبي يعني أنك تتعامل مع نص صحيح دقيق موثق، ومعنى هذا أنك في تحقيق التراث إنما تهدف إلى "نقد النص" وتقديم نص محرر بارئ من الخطأ، تنتفع به أنت في دراستك، وينتفع به غيرك. وأنت لا تستطيع أن تفهم الأدب منفصلاً ومعزولاً عن التاريخ والجغرافيا، ولا عن تطور الفكر الفلسفي، فهذه كلها حقول متصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقاً. ويبدو لي أنك إذا كنت تملك منهجاً مؤصلاً للدراسة، فأنت قادر - من خلال هذا المنهج - على مقاربة هذه الحقول، بتغيير غير كبير في زاوية الدراسة، إذ الأساس فيها جميعا هو القدرة على النقد: في التاريخ نقد الخبر، وفي الأدب نقد العلاقات المنطقية، وفي النقد تغليب الموضوعية، وفي نقد النص معرفة اللغة والتاريخ والتعاقب الزمني من خلال هذا التاريخ، وهكذا..الخ".
أما عن دوافع ذلك التعدد وضرورته، فهي تتضح كما يراها الدكتور عباس في قوله: "في الجواب المتقدم يتبين لك أن الدافع الوحيد هو اكتمال الروافد الثقافية التي ترفد التخصص الأصلي أولاً، وتصنع شخصية "المثقف" المسؤول ثانياً. وليست هناك ضرورات حياتية سوى ذلك. أعني أن التزود بهذا كله لم يكن لبناء شخصية الأستاذ الجامعي الذي تضطره بعض الظروف إلى التصدي لتعليم هذه المادة أو تلك، بمقدار ما كان لإيجاد بناء متكامل، فأنا أخبرك بصدق أنني لم أدرس في الجامعة موضوعاً خاصاً اسمه "النقد الأدبي" أو "تاريخ النقد" أو "التاريخ"، ولكني أحسست بضرورة المعرفة التي تمنحني الثقة النفسية الصحيحة".
هذه الثقة النفسية الصحيحة التي سعى إليها أستاذنا كما يسعى إلى تحصيلها أي إنسان، هي وجه من وجوه البحث عن الذات، أو ربما هي- في الآن نفسه - ناتج من نواتج هذا البحث. وما دمنا في صدد هذا البحث، فنحن نعتقد أنه لا يتوقف عند مرحلة البدايات كما قد يبدو، بل يمتد طوال حياة الفرد، بخاصة من هو في دائرة الطموحات الكبيرة. وإذا كانت تلك هي طبيعة التعدد ودوافعه، فلا بد أن ثمة ما يدعم الطموح إلى التعدد. لا بد من مصادر ثقافية متنوعة، وأساتذة مختلفين، وقبل ذلك، وبعده، تربية خاصة يأخذ الفرد بها نفسه ليطبعها بالطابع الذي يشاء.
إحسان عباس الذي أدمن الصعوبات، يميل إلى التفاؤل، الأمر الذي يبعث على التساؤل: كيف نعلل كون المتتبع لسيرته يجد أنه - على رغم الكوارث التي حلت وتحل بالعالم، والصعوبات الكبيرة التي واجهها الأستاذ عباس نفسه - يتمتع بنزعة تفاؤلية؟
يعلل الأمر على نحو بسيط، ومتفائل أيضاً، إذ يقول: "العالم كان حقل تجارب للكوارث في كل العصور، كوارث يصنعها الإنسان، وكوارث تصنعها الطبيعة، ولكن كوارث عصرنا تمتاز في درجة الحدة. وأنا قارئ مواظب للتاريخ، ولهذا أعرف أن عالمنا لم يكن يوماً غريباً عن الكوارث، وهذا يرفد لدي ميلي إلى التفاؤل. أعني أنني أدرك أن التفاؤل يعني تغلب الخير بين الحين والحين، وحدوث انفراجات في مسيرة الإنسانية. ولا أنكر أن في أعماق نفسي يكمن تشاؤم عميق بعد ضياع الوطن الأم. ولكن الإيمان بالنور موجود، ذلك أن مبعث التشاؤم الحقيقي قد يكون قصر حياة الإنسان، بحيث يريد أن تتحقق في حياته أشياء، فيحس باليأس من تحققها كلما تطاول الزمن واقترب الأجل. إلا أنني أجد أن الإحساس بالتشاؤم يجب أن يُكبح رحمةً بالأجيال. ولهذا فبعض التفاؤل طبع، وبعضه حمل على النفس من أجل "الاستمرارية" - استمرارية النضال والسعي الدائب والجد".
قارئ التاريخ والحضارات
سألته مرة عن ثقافته الممتدة من التراث اليوناني فالتراث العربي الإسلامي، وصولاً إلى الأدب العربي الحديث، وما إذا أمكن إجراء مقارنة بين العصور الثقافية المذكورة. وبحذره ودقته يجيب: "دعني أذكرك بأن الثقافة اليونانية والثقافة العربية الإسلامية بينهما من التشابه ما يجعلني افردهما بالحديث. فكلتاهما تأثرت بالفكر الفلسفي اليوناني والعلم اليوناني والحضارة اليونانية بعامة. ولذلك، يمكن أن نصف كلاً منهما بالكلاسيكية، مع انفراد الثقافة العربية الإسلامية بفكر ديني توحيدي.
ولا أدري لما خصصت العصر الإسلامي الأول والأموي بالمقارنة، فكلاهما يعتبر عصر تأسيس للنهضة الثقافية العربية التي بلغت أوجها في القرن الرابع الهجري. أما الثقافة العربية المعاصرة فشأنها مختلف. إذ إن العوامل المحركة فيها هي تيارات فكرية وفلسفية لم تعرفها الحضارتان السابقتان. ثم إن القوى الملونة لها هي حضارة مادية وافدة في كل مجال، وإذا اختلفت المؤثرات الفكرية والحضارية، اختلف حال الفن والأدب، وليس هنا مجال للمقارنة في العظمة وطول القامة وعمق النتاج، إذ كل يستجيب لحاجات ويخضع لمؤثرات مختلفة، إلا أن النتاج الفني والأدبي لدينا يغلب عليه التأثر بالعوامل الخارجية، وقد يحتاج زمناً أطول قبل أن يرسخ لنفسه استقلالاً وينتحل مميزات فارقة تكفل له وجوده المتميز".
وفي مقدمة كتبها للطبعة الجديدة من كتابه "اتجاهات الشعر العربي المعاصر"، يرد على بعض منتقدي الكتاب، فتلمس في ردوده هدوءاً وموضوعية، قد ينطويان على قسوة أحياناً، إلا أنها القسوة التي يتيحها الحوار بين الأفكار، على رغم أنه يرد على كتابات قاسية جداً.
الحياة 2003/07/31
 فجع الوسطان الثقافي والأكاديمي برحيل الناقد والباحث الكبير د. إحسان عباس أول أمس عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاما بعد معاناة مع المرض خلال الشهور الأخيرة.
فجع الوسطان الثقافي والأكاديمي برحيل الناقد والباحث الكبير د. إحسان عباس أول أمس عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاما بعد معاناة مع المرض خلال الشهور الأخيرة.
ويعد إحسان واحدا من أهم النقاد العرب خلال القرن العشرين حيث واكب بزوغ حركة الشعر الحر في نهاية أربعينات القرن الماضي وأصدر واحدا من أوائل الكتب النقدية عن حركة الشعر الحديث مركزا فيه على (عبدالوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث)، وكان د. عباس قد ولد في عين غزال في فلسطين عام 1920 وغادرها في الأربعينات ليكمل تعليمه الجامعي في مصر حيث أصبح في بداية الخمسينات من بين الوجوه النقدية البارزة في الوطن العربي. وقد أصدر في الستينات واحدا من كتبه النقدية الأساسية (بدر شاكر السياب) كما أصدر في نهاية السبعينات كتابه (اتجاهات الشعر العربي المعاصر).
حقق إحسان عددا كبيرا من كتب التراث، وأصدر كتابا، مرجعيا حول (الأدب الاندلسي) ما جعله واحدا من أهم المختصين في تاريخ الأندلس وأدبه في العالم. كما ترجم عددا من أهم الكتب النقدية التي صدرت في أميركا وبريطانيا خلال أربعينات القرن الماضي وخمسينياته محققا في عمله النقدي مزجا بين القراءة التراثية والنقد المعاصر في العالم.
ترجم إحسان عباس، إضافة إلى الكتب النقدية والفلسفية، رائعة الكاتب الأمريكي هيرمان ملفيل (موبي ديك).
وقد حصل الراحل على عدد من الجوائز تقديرا لعمله النقدي ومن بين هذه الجوائز: جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وجائزة سلطان العويس، وجائزة الملك فيصل العالمية.
وبرحيل عباس تخسر الثقافة العربية واحدا من ابرز أعلامها خلال القرن العشرين.
(الدستور) سألت تلاميذ الراحل الكبير وأصداقائه عن الفراغ الذي سيتركه بعده.
فيصل دراج
في غياب إحسان عباس نفتقد إنسانا رهيفا كرّس حياته للمعرفة وكرس منهجا ديموقراطيا في التعامل مع الثقافة والناس، كما نخسر أيضا إنسانا موسوعيا جمع بين معرفة التاريخ والنقد والترجمة وتحقيق المراجع التاريخية وكان لامعا في هذا كله، ولهذا فان إحسان عباس، لم يقدم فقط صورة الإنسان الرهيف كما يجب أن تكون بل قدم أيضا مثال الباحث النزيه الذي يرى في الثقافة منهجا في الحياة ويكرس حياته كلها في مسائلة أسئلة المعرفة المختلفة. ربما يكون في غيابه غياب لآخر الوجوه الفلسطينية الناصعة التي عرفت فلسطين وأحوالها بقدر ما عرفت المنفى وتوق الإنسان إلى فلسطين.
عز الدين المناصرة
تعرفت إلى إحسان عباس لأول مرة عام 1968 في القاهرة، ثم استمرت صداقتي معه طيلة عشرين سنة في بيروت، عندما كان أستاذا في الجامعة الأمريكية. كان في منتهى الحيوية والتوهج العلمي والشخصي، ثم توطدت صداقتنا بعمان حيث يقيم منذ منتصف الثمانينات.
إحسان عباس، واحد من أهم أعلام الثقافة العربية، له شخصية ثقافية متميزة لها خصوصيتها، سواء الباحث الأكاديمي فيه أو الناقد أو المحقق لعدد هام من كتب التراث الأدبي.
مؤخرا زرته مع زميل، فبدأ يروي قصة عذابه كفلسطيني منذ القاهرة والسودان، واسترسل أستاذ الأجيال في حديثه عن معاناته في رحلة الحياة الطويلة، وكشف لنا أسرارا لم يسبق له أن ذكرها ثم عاد إلى ذكرياته في فلسطين- الطفولة، كأننا كنا على موعد صحافي معه.
إحسان عباس، قيمة كبرى في تاريخ الأدب الحديث والقديم وعلامة مضيئة استفاد منها آلاف الطلبة والدارسين، وكان يعطي دائما. لقد خسرنا بطلا ثقافيا من أبطال فلسطين، الذين كافحوا بعصامية واضحة نحو الأعالي في زمن صعب بعيدا عن المؤسسة ورحل بعد أن ترك لنا كل هذا الثراء العلمي.
توالت خلال العامين الماضيين الخسارات المفجعة في أوساط المفكرين والكتاب والمبدعين الأردنيين حيث فقدنا عددا لا بأس به من أهم أعلامنا في الفكر والثقافة والإبداع، ولطبيعة الحال فان د. إحسان عباس هو واحد من القمم الثقافية والنقدية والأدبية على مستوى العالم العربي وابعد من ذلك أن هذه لا تعد خسارة للأدب الأردني وحسب.. إنما هي خسارة للعالم العربي والأدب الإنساني بشكل عام.
إبراهيم العبسي
ما يمكن أن يقال أن أديبا وناقدا وباحثا ومعلما كبيرا افتقدناه برحيل إحسان عباس، وبالنسبة لي فانا اعتبر إحسان عباس بالإضافة إلى أهميته كدارس ومحقق للتراث على نحو ينطوي على فهم عميق لهذا التراث فهو من أهم النقاد والذين اخذوا بيد الشعر الحديث في المنطقة العربية ولعله كان أكثر المتحمسين لخروج الشعر العربي من خندق التكرار والمألوف والعادي إلى اقتحام مناطق جديدة سواء عبر اللغة أو عبر الموضوع ولا أملك في هذا الصدد إلا أن أدعو إلى جمع تراثه الأدبي والنقدي كي لا يضيع ما تركه لنا في زحمة حياتنا القلقة.
إبراهيم نصر الله
حين تتحدث عن د. إحسان عباس فانك تتحدث عن الثقافة العربية بمجملها الممتدة منذ القدم حتى أفضل تجليات حداثة الأدب العربي.. لقد كان إحسان عباس مناصرا غير عادي لفكرة التجديد في الشعر العربي بل انه كان ناقد الحداثة العربية الأول في مجال الشعر، هذا على مستوى الإنجاز العام.. إما على مستوى الإنجاز الخاص فقد كان إنسانا وأبا وصديقا للجميع وان خسارته كانت خسارة إنسانية فادحه أن مجرد الحديث أو اللقاء مع إحسان عباس كان كفيلا بان يعلم المرء كيف يكون إنسانا كبيرا بحق، وعظيما ومبدعا، إلى هذا الحد ومتواضعا إلى هذا الحد.
أنا شخصيا افتقده كما لو أن جزءا إنسانيا مني يوضع تحت التراب.
صالح أبو إصبع
هل أبكيك أم أرثيك، وأنت كنت معلما ووالدا تمتلك حساسية تجعل الآخرين لا يمتلكون إلا أن يحبوك ويحترموك.
إحسان عباس كنت طيلة حياتك مثالا للعطاء ولا تنتظر حتى كلمة الشكر، علمك بحر ولا تضن به على احد.
كل من عرفك في مسيرتك العلمية يدرك ماذا أعطيت لهذه الأمة، أجيال من الباحثين المتميزين، تلاميذ يمتدون على ساحة الوطن العربي الكبير، وكم سيفاجئهم مصاب الأمة بفقدك، ولكن أنت اكبر من العزاء واكبر من البكاء، وحينما نستذكرك لن ننساك ليس بإرادتنا ولكن بإرادتك أنت المعطاءة من خلال تراث أغنيت به المكتبة العربية في مجالات عدة، لقد كنت رجالا في رجل، وعلماء في عالم واحد، هل أقول لك أيها الوالد الحاني والمعلم الكبير وداعا.. اسمح لي أن أقول لك في لحظات الفراق.. لقد أحببتك كثيرا...
خليل السواحري
آخر مرة التقيته فيها كنت بصحبة الصديق الدكتور غسان عبدالخالق، كنت قد أرسلت له مخطوطتي القصصية (تحولات سلمان التايه ومكابداته) لأخذ رأيه فيها، اقترح عليّ أن اجري تعديلا على نهاية إحدى القصص وحين أعدت قراءة القصة وجدته على حق فأخذت برأيه رغم أن بعض الأصدقاء ممن عرفوا بالأمر لم يستحسنوا ذلك.
قبل بضعة اشهر دُعيت إلى برنامج تلفزيوني عن أفضل مئة كتاب في القرن العشرين وكان موضوع الحلقة الشاعر بدر شاكر السيّاب واعترفت بالحلقة التلفزيونية إن أفضل كتاب أفدت منه كان كتاب الدكتور إحسان عباس عن بدر شاكر السياب: حياته وشعره.. رحم الله هذا العلامة الكبير وعوضنا عن الخسارة الفادحة بفقده.
نزيه أبو نضال
حين يصلك خبر وفاة كاتب كبير تشعر بالحزن والخسران، إما مع إحسان فتشعر بالفاجعة وعميق الحزن: فقد كان عظيما في كل شيء ولكن أعظم ما فيه انه إنسان.
قد تكون تلميذه أو صديقه أو زميله ولكنك في كل الأحيان تراه يغمرك بمشاعر أمومة حنونة لا تجدها لدى إنسان غيره.
الآن تتزاحم الذكريات منذ أيام بيروت وتونس إلى عمان والقاهرة ولكنك لا تستطيع أن تكتب شيئا: الحزن يملأ مساحات الروح والقلم، القلب يمتلئ بالحزن والعقل يرفض أن يسلم بحقيقة موت منتظر ولا بد يأتي.. هكذا كان بتباسط معي في آخر لقاء في بيته في عمان ونحن نتصافح صورته مع زملائه في آخر حفل تكريم أقامته الجامعة الاميركية في بيروت: كان زملاؤه الذين تركهم أحياء قبل أسابيع ولم يبق منهم احد، كان آخر ثمرة عظيمة في تلك الشجرة المباركة.
سقطت الثمرة: مات سارق النار العظيم الذي ظل يحترق طويلا ليضيء وليقدم للبشر ما يحتاجونه من معرفة. فالعزاء لنا.
-1-
في سنة 1940 بدأت عملي أستاذا في الكلية العربية في القدس. كان يومها إحسان عباس تلميذاً فيها، لكنني لم أدرسه. إذ أن تدريس التاريخ الكلاسيكي - اليوناني والروماني لم يكن قد عهد به إلي بعد.
لكنني تصادقت مع إحسان يومها. كان إحسان يصغرني بنحو 12 سنة. لكن قلبه كان اكبر من ذلك قليلاً، وكان قلبي أفتى من سني، فلم يكن ثمة مجال كبير للخلاف. إما عقله فكان لماعاً وكان يقرأ خارج المقرر المدرسي. فلم يكن ثمة صعوبة في الصداقة. فضلاً عن خلقه السجج.
لما تخرج إحسان في الكلية العربية تقدم الدكتور اسحق موسى الحسيني إلى مدير الكلية العربية احمد سامح الخالدي يطلب منه أن يهيئ السبيل لإحسان للحصول على بعثة لدراسة الأدب العربي، وتقدم الأستاذ عبدالرحمن بشناق أستاذ الأدب الإنكليزي بطلب مماثل إلى مدير الكلية العربية يطلب لإحسان بعثة لدراسة الأدب الإنكليزي.
كان بإمكان إحسان أن يختار. وكنت واثقاً من انه سيختار الأولى، فقد كان الأدب العربي وما يحويه من آراء وأفكار يملك لبه. وهكذا كان. وذهب إلى الجامعة المصرية وحصل على الإجازة (الليسانس)، وعاد ليدرس في فلسطين.
لما عاد إحسان إلى فلسطين كنت أنا قد ذهبت إلى لندن لإتمام دراستي العليا للدكتوراه. فلم نلتق يومها. ولم نلتق بعد 1948، إذ أن النكبة فرقت بين الأصدقاء والأقارب.
كان مجال العمل للفلسطينيين متسعاً يومها في الخليج. وقد ذهب بعض زملائه إلى الكويت. لكن إحسان عباس كان رجلاً نهِماً في طلب المعرفة، فاختار الذهاب إلى القاهرة، ليعلّم بمرتب أقل، وليتابع دراسته العليـا فحـصـل الدكتـوراه، وأنا جـئـت من لنـدن إلى بـيـروت. إلى الجـامعـة الأميركية.
كنت أتسقط أخبار إحسان من الأصدقاء، ولست أذكر أننا تراسلنا!
لكنني كنت عرفت انه وجد عملاً يرضيه في جامعة الخرطوم حيث قضى سنوات مثمرة من الناحيتين.
-2-
سنة 1949 زرت الخرطوم وسعدت بلقاء إحسان وأسرته. لست أستطيع أن اصف سعادتي بلقاء إحسان في البيت وفي الجامعة. صداقة أعادتها إلى قوتها أيام حضنني فيها إحسان الذي ظل يتقدم علماً وسعة أفق وسعة قلب.
بعد هذه الزيارة شغر منصب أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية في الجامعة الأميركية ببيروت. اقترحت على رئيس القسم، الدكتور جبرائيل جبور أن يسعى للحصول على إحسان. وكان الدكتور نبيه فارس ذا نفوس في إدارة الجامعة، فرجوته أن يسعى إلى ذلك. وتحققت آمالي وجاء إحسان إلى الجامعة الأميركية. وعدنا زميلين. لكن أهم من هذا هو أن صداقتي لإحسان توثقت وكم كنا نتشاور في مشاريع لها ارتباط بالتاريخ والأدب.
كان إحسان قد بدأ يكتب ويؤلف من قبل، ولكن سنوات الجامعة الأميركية شهدت من عمله الإنتاجي والتحقيقي الشيء الكثير. وكانت تلك الأيام أيام ازدهار حركة النشر في بيروت. وكانت كتب إحسان تستحق النشر والقراءة لأنها في كل مرة يكتب فيها إحسان كتاباً يكون قد ارتفع درجة (كبيرة) في سلم المعرفة.
-3-
سنة 1970 أو 1971 غادر إحسان عباس الجامعة الأميركية - مع حرقة من أصدقائه - من الزملاء والطلاب ومن خارج الجامعة. التحق بالجامعة الأردنية وظل يعمل إلى قبل بعض الوقت لما أقعده المرض.
كانت زياراتي إلى عمان، في السنوات التي تلت مغادرته الجامعة، متلاحقة، وكنت أتمتع بصحبة عدد من الأصدقاء هناك. وفي كل مرة زرت عمان نعمت بصحبة إحسان. مجال الشكوى واسع، ولكن مجال الإخوانيات والحديث عن العمل أوسع. وكان لنا في كل ذلك جولات.
أمس قبيل منتصف الليل بلغني خبر وفاة إحسان. وكنت أتوقع ذلك، إذ عرفت أن صحته ساءت قبل مدة، وأنه يكاد لا يفارق الفراش.
ذرفت دمعتين عليه: الواحدة عني والثانية عن أسرته، وبخاصة زوجته، السيدة الطيبة إلى حد قد يصعب إدراكه.
كنت، بسبب تقدمي بالسن، أصبحت أجد صعوبة في السفر، لذلك كانت زيارتي الأخيرة لإحسان قبل سنوات. لكنني قابلته لما زار بيروت وافتقدني.
إن ما نشر في الحياة اليوم (31/7/2003) عن إحسان العالم والأديب والكاتب يكفي لليوم، وأرجو أن يعهد إلى من يستطيع أن يدرس تراث إحسان ويفيه حقه. وقد يحتاج إلى وقت وجهد طويلين. ولذلك لن أزيد شيئاً في هذه الأمور.
لكنني أقول أن من أنبل صفات إحسان صداقته. وهذا ما أود أن أشير إليه هنا.
لست الخاسر الوحيد لصداقة إحسان، لكن لعله كان لها في نفسي نكهة خاصة.
بيروت 31 تموز (يوليو) 2003
الحياة 2003/08/2
 هو من القلة بين باحثينا العرب، في مجال الدراسة الأدبية والنقد، الذين يستأهلون صفة الكبير.
هو من القلة بين باحثينا العرب، في مجال الدراسة الأدبية والنقد، الذين يستأهلون صفة الكبير.
إحسان عباس.
كان كبيرا بما أعطى، وبأهمية ما أعطى في دقته وعمقه، في جدته وشموليته وريادته.
التقيته أول مرة في القيروان (تونس) بمناسبة مؤتمر. وكنت ما زلت في بداية الطريق تلفني مشاعر المهابة امام باحث هو ما هو عليه إحسان عباس من القيمة العلمية والمكانة العالمية. غير ان إصغاءه الهادئ الى الابحاث التي أُلقيت يومذاك، وقدرته النافذة على التمييز بين الجدي فيها والسريع، وحواره العميق، وسلوكه المرح، كانت مما قرّبه الى نفسي ودلّني على سبل في عملي قوامها: البحث والتنقيب واكتشاف الجديد والصدق مع الذات.
رائدا كان إحسان عباس في تعليمه لأجيال كثيرة، وفي نتاجه القيّم. ومنه ما خصّ به الشعر المعاصر.
رائدا كان، وسيبقى، في دفاعه عن الشعر الحديث، وفي تعليله لغموضه الفني الذي يراه من طبيعة الشعر والإبداع الذي لا يخضع (للمواصفات العقلية). فدور الشعر ليس الوعظ والإرشاد، يقول، بل اكتشاف (مجال الامكانات في كل وجهة).
على خلاف كثيرين من معاصريه، كان منفتحا في تنظيره للشعر الحديث لدى رواده ومبدعيه: السياب، الملائكة، عبد الصبور، البياتي، أدونيس، الحيدري، درويش، حاوي... يصنع الابداع على مستوى الممكن ويشرّع أمام الشاعر مخزون التجربة الانسانية في تنوعها، وفي اتساعها المكاني والزماني. هكذا ساند انفتاح الشعر العربي الحديث على التراث عندما أخذ يستعير منه أقنعة ورموزا، ويتوسل الاسطورة.
رائدا كان في دراسته للأسطورة والرمز والقناع، اي لعناصر ميَّزت الشعر العربي المعاصر بإثرائها صور فضاءاته، وبإطلاقها لدلالاته في أفق الاحتمالات.
لم يقف شأن آخرين ضد تأثر الشعر العربي بالتيارات الشعرية الغربية الحديثة، بالسريالية مثلا، بل انكب على قراءة النصوص يستكشف خصائص شعريتها، ويُرسي أسسا، بها يُمكن لحركة التأليف الشعري ان تهتدي، وبها يمكن لقراءة الشعر ان تستعين.
بدراسته القيمة لما سمّاه (الشعر المعاصر)، قدّم إحسان عباس اضاءة جديدة لشعرية هذا الشعر، وأرسى نهجا في التعامل معه، قراءة ودراسة.
رائدا كان عندما وضع الشعر المعاصر في علاقة بالزمن والمدينة والتراث والحب ليقرأه باعتباره (العمق النفسي والفكري): فالشعر، كما يقول، يتطور في ذاته كلما تطورت المداخل لفهم تلك النفسية.
لقد رفض ان يحول الشعر الى وثيقة تُلحقه بالتاريخ وتُفقده (وظيفته الفنية). رفض ان يكون اختيار النماذج والشعراء، موضوع الدراسة، خاضعا لمعايير القطرية او القومية.
وعندما أُخذ عليه عدم التزامه بالأكاديمية في دراسته للشعر، قال بأنه أكاديمي في المهنة وفي تعليم طلابه، وان أكاديميته في التعليم لا تعني أكاديميته في (الموقف النقدي) الذي هو، في نظره، موقف يحاور النص، ويسائله، ويستنبط خصائص جماليته بعيدا عن سلطة المنهج.
صلبا كان إحسان عباس في مواقفه عندما تكون، هذه المواقف، في خدمة الإبداع.
وليّنا كان عندما يكون على الناقد ان يصغي الى الشعر ويتحرى مواطن جماليته.
تعلمنا منه الكثير، وسيبقى معلّما كبيرا لأجيال قادمة.
في القاهرة التقيته آخر مرة. كنا معا في لجنة التحكيم العليا لجائزة الرواية العربية الأولى (1999).
كان رئيسنا الذي أصغى لآرائنا المختلفة، وابتسم لقرار طال النقاش للاتفاق عليه.. وعندما نهض توكأ على عصاه وخرج.
مساء أمس (الاربعاء) وأنا أتلقى نبأ وفاته، بادرتني صورتان له:
واحدة في القيروان تصدح ضحكته في قاعة الطعام ويُشجعني على المرح..
وأخرى في قاعة الفندق في القاهرة يبتسم هادئا لاختيارنا ولوداعنا له.
بين الصورتين بدا الزمن لحظة، وصاحب الصورة طيفا أهمس له:
وداعاً إحسان عباس؛ الباحث والناقد والانسان العظيم.. وداعاً أيها الاستاذ الكبير...
وداعاً أيها الزميل الجميل...
هل تفارقنا حقا اليوم؟ وماذا عن صورتك المستقرة أبدا في الذاكرة؟
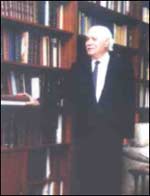 دهمت الهجعة الأبدية أخيرا إحسان عباس، فمات الشاعر الذي خنق شعره بيديه واكتفى من دهره بمجموعة يتيمة عنوانها: (أزهار برية). هو شاعر في بداياته الأولى، لكن تصاريف الأيام وندوب الغربة غورت في عروقه ينابيع الشعر، فانثنى إليه منقبا ومحققا ودارسا وناقدا من غير أن يلج في صومعته المرجانية، أو يعارك الجن في وديانه الوعرة، أو يتعقب أخيلته البهية في فضاءاته الفسيحة.
دهمت الهجعة الأبدية أخيرا إحسان عباس، فمات الشاعر الذي خنق شعره بيديه واكتفى من دهره بمجموعة يتيمة عنوانها: (أزهار برية). هو شاعر في بداياته الأولى، لكن تصاريف الأيام وندوب الغربة غورت في عروقه ينابيع الشعر، فانثنى إليه منقبا ومحققا ودارسا وناقدا من غير أن يلج في صومعته المرجانية، أو يعارك الجن في وديانه الوعرة، أو يتعقب أخيلته البهية في فضاءاته الفسيحة.
مات الراعي الجوال، لكن أزاهيره البرية ما زالت تنقف هنا وهناك في جامعات العالم العربي، وفي مراكزه العلمية، وفي مؤسساته الثقافية، وفي مكتباته المتناثرة التي من المحال ألا يجد الباحث أو الناقد أو الكاتب ولو كتابا واحدا من كتبه الموضوعة أو المترجمة أو المحققة.
* * *
إحسان عباس واحد من جيل الأساتذة الكبار الذين إن غاب واحد منهم فلا يمكن تعويض ذلك الغياب أبدا. جاور قسطنطين زريق وجبرائيل جبور ونبيه أمين فارس وأنيس فريحة ونقولا زيادة ومحمود شاكر وأحمد أمين وشوقي ضيف، وكان من بين أترابه في فلسطين ولبنان والسودان محمود الغول وجبرا إبراهيم جبرا وإميل حبيبي وجمال محمد أحمد ووليد الخالدي ومحمد يوسف نجم وغيرهم بالطبع.
كرس حياته القلقة للتأليف والتحقيق والترجمة. وعلى الرغم من الخطوات المتعاكسة التي تحكمت به، فقد تمكن من تأليف نحو خمسة وعشرين كتابا، وترجمة نحو اثني عشر كتابا آخر، وتحقيق زهاء الخمسين مخطوطة، حتى صار التحقيق لديه مثل لعب الورق أو حل الكلمات المتقاطعة. ومن فكاهات أيامه أن رسالة وصلت إليه في ذات يوم فيها دعوة الى حضور مؤتمر لمكافحة الجريمة... لأنه، ببساطة، (محقق).
* * *
ولد إحسان عباس في قرية عين غزال القريبة من مدينة حيفا في 2/12/1920. وسكان هذه القرية لجأوا، في معظمهم، الى العراق في سنة 1948، وكان في عداد هؤلاء اللاجئين والده رشيد ووالدته فاطمة وأخته نجمة وشقيقاه بكر وتوفيق. وفي قرية عين غزال نشأ هذا الفتى الذي صاحبته الكآبة طويلا، ولعله ورث الكآبة وبعض الصمت عن والدته. وفي أزقة هذه القرية، وبالتحديد في الرابعة من عمره، بدأت أول معرفة له بالعالم: خرج من منزله وحيدا وراح يتدحرج فوق الطريق الترابية، فلم ينتبه إلا وهو في مزبلة. وفي غمار تلك الطبيعة، عند أقدام الكرمل، أصابته متعة التحديق في الفضاء.
ومرة، حينما كان يحدق في تلك الزرقة رأى الله يتشكل بين الغيوم فوق بحر فلسطين. كانت الغيمة مثل جمل فاغر فمه فقال: (لعله الإله الذي يُكثر الناس من ذكره)، فخاف وارتعد. وربما كان لهذه الحادثة الغائرة في وجدانه أثر في تكوينه اللاحق. فمع أنه درس على الشيخ تقي الدين النبهاني الذي أسس، في ما بعد، (حزب التحرير الإسلامي)، وكان يصلي في جامع الاستقلال بحيفا الذي كان الشيخ عز الدين القسام خطيبه اللامع، إلا أنه أصبح، لاحقا، قريبا بأفكاره من الحزب الشيوعي في فلسطين. غير أن أفكاره (اليسارية) تلك لم تتطور الى خيار فكري وسياسي، بل كانت نابعة من حساسيته حيال الظلم الطبقي، ومن إحساسه بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.
* * *
لم يطق إحسان عباس حياة الأرياف الوادعة مع أنه ابن الريف الفلسطيني بامتياز.
فالأرياف، بحسب رأيه، (غليظة جافية والعادات فيها قيود). أما لهجة الريفيين فهي تثير النفس برتابتها، وهؤلاء يفتقرون، في غالبيتهم، الى روح الفكاهة بسبب فقرهم المتمادي. وهذا الفتى الذي ولد في (قرية) عين غزال ودرس في (مدينة) حيفا، ثم صار معلما في (مدينة) صفد، مال منذ يفاعته الى المدن التي تضج الحياة فيها بالصخب والتوتر والقلق والعلم معا، والمفتوحة دائما على احتمالات شتى.
ولعل أكثر ما جرح وجدانه حينما كان غريرا ذكرى ظلت تؤرقه وتحرق نياط قلبه، وطالما تحدث عنها، ولا سيما في سيرته (غربة الراعي)، قائلا إنه في ذات يوم نزل الليل عليه وعلى والده وهما في طريقهما الى (مدينة) طولكرم. فذهب الوالد الى (قرية) الجلمة يلتمس من بعض أهلها أن يتقبلوا ابنه لينام عندهم سواد ليلة واحدة، فما وجد مستجيبا. ومنذ ذلك الزمان وهو ساخط، على الأرجح، على سكان الأرياف القساة، وعاش سحابة عمره في المدائن العربية كالقاهرة والخرطوم وبيروت وعمان، الى أن أناخ رحله، وأراح ركابه، وغادر الى مكان بارد لا يُزار فيه ولا يزور.
* * *
إحسان عباس، يكفيه اعتدادا أنه أرسى النقد المنهجي وطرائق (النقد التحليلي) في الكتابة الأدبية، وأنه كتب، في جملة ما كتب، (فن الشعر) (1952)، و(فن السيرة) (1956)، و(تاريخ الأدب الأندلسي) (1962)، و(تاريخ النقد الأدبي عند العرب) (1971)، و(ملامح يونانية في الأدب العربي) (1978)، و(اتجاهات الشعر العربي المعاصر) (1978)، و(تاريخ بلاد الشام) (1995)، و(غربة الراعي) (1996). وحقق (وفيات الأعيان) لابن خلكان، و(نفح الطيب) للتلمساني، و(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) لابن بسام، و(معجم الأدباء) لياقوت الحموي، و(خريدة القصر وجريدة العصر) للعماد الأصفهاني، و(التذكرة الحمدونية) لابن حمدون، و(جوامع السيرة) لابن حزم الأندلسي، و(الروض المعطار في خبر الأقطار) للحميري، و(الخراج) ليعقوب بن حبيب الأنصاري. وحسبه رفعة أنه ترجم رواية (موبي ديك) لهيرمان ملفيل؛ هذه الترجمة التي اعتبرت طرازا فريدا في فن الترجمة، والتي سكبها في قالب لغوي عربي خالص من غير أن يتأثر باللغة الأصلية، فجاءت هذه الترجمة الخلابة والأمينة لتدحض الكلام السائر على الألسنة عن أن الترجمة كالمرأة، إما أن تكون جميلة وغير شريفة، أو أن تكون شريفة ولكن غير جميلة.
* * *
ها هو الموت (يفرفط) أحبابنا في كل يوم مثل تويجات الأزهار البرية بين أصابع شقي أرعن. إنهم يتناثرون كأوراق الخريف، أو ينطفئون كشهب الصيف. فيا أيها الموت، أخاطبك الآن بلا رهبة، لأن أيامنا الراعبة علمتنا ألا نخشى بعدها أي رعب. ها نحن أصبحنا مرصودين لوداع ضحاياك، الواحدة تلو الأخرى، وها نحن أمسينا رهائنك الليلة وكل ليلة. إننا ننتظرك، أيها العابث بمصائرنا، وربما لن يودعنا أحد أبدا مثلما نودع الآن إحسان عباس.
لقد عرف إحسان عباس أن لا خيار له في هذا العالم المملوء بالكآبة والعبث إلا أن يشرع في تحويل الكآبة الى نضارة، وأن يحول العبث الى إبداع. كان يعرف أن من غير ذلك لا سبيل له إلا العيش بجنون أو الموت كمدا أو الانتحار. ولأنه عرف كثيرا رفض أن يجن أو ينتحر، فسار الى مصيره وادعا كأنه يغرف من ينبوع حزن، ثم بالأمس مات.
فيا للحسرة.
الصدفة وحدها لم تضف اسم د.إحسان عباس إلي قائمة الشهداء في بيروت العقدين اللذين احترق فيهما الناي والياسمين، ففي احدي مساءاتها المضاءة برصاص غالبا ما كان يطيش، طرقنا باب شقة د. إحسان عباس في منطقة الصنائع، غالب هلسا وسلمان صبح وأنا، وفتحت زوجته الطيّبة الباب، لنري إحسان واقفا في الصالة وقد استبدّ به الذهول، وأمسك بما تبقي من غلاف معدني اصفر لرصاصة اخترقت الجدار وأحد الكتب في الرّف الأعلى، واستقرّت علي أرض الغرفة، وقال لنا بصوت مفعم بالحزن والدهشة: هل سمعتم برصاص عابر للمكتبات كالصواريخ العابرة للقارات؟.
لم يمت إحسان في ذلك المساء، وفي تلك المدينة، لكن غالب وسليمان رحلا قبل الأوان، احدهما افترس السرطان رئتيه والآخر افترست الغربة قلبه، ومكث إحسان في هذا العالم يحصي ما يلحق بوطنه الكبير من هزائم، واندحارات، فمسقط رأسه وروحه معا عين غزال الهاجعة تحت خاصرة حيفا، أوغلت في الغروب والنسيان إلا لمن حملها علي كتفيه، وبغداد التي كانت الملاذ الأول لعباس وأسرته، وقريته، سقطت أيضا في شيخوخة العرب وشيخوخة إحسان أيضا.
* * *
الكتابة عن إحسان عباس ناقدا ورائدا ومترجما وأكاديميا ومحققا سيتولاها من ينصرفون إلي الأرشيف عشية رحيل الكبار، وثمة ببلوغرافيا عباسية لو شئنا نقل بعضها في هذا المقام لما تبقي لنا ما نقوله عنه، إنسانا وصديقا وأبا حانيا لثلاثة أجيال، وراعيا في أقصى العزلة.
لم يكن إحسان شغوفا باستعراض مواقف سياسية ووطنية، بحيث بدا في لحظة الاشتباك كا لو انه خارج المدار، وخارج الجاذبية، لأنه كان منهمكا في عمله الأكاديمي وتحقيقاته التراثية، لهذا كان الإهداء الذي مهر به الشهيد غسان كنفاني احدي رواياته لاحسان عباس مشحونا بعتاب وطني وتذكير للرجل بأنه فلسطيني، فقد كتب له: الى د. إحسان عباس هذه الرواية رغم أنها لا تتعلق بالأندلس!
وكان لاحسان أندلسه أيضا، لكنها معاصرة، ولا يصوغها حنين رومانسي بحيث ينقطع الرجل عن السياسة، لكن فهمه للسياسة لم يكن شعاريا ولم يبدد العمر في مساجلات عقيمة كما فعل آخرون.
في جلسات دافئة وحميمة، وفي شقة بجبل عمان تقع في شارع يعج بالمستشفيات والعيادات، كان إحسان يروي لنا كلّما لذنا به مرارات الصّبا وعذوبة التخطي لشروط التجهيل والإفقار والنفي، كان يمشي علي قدميه وهو صبي عدة أميال كل يوم، لأن المدرسة لم تكن قرب داره ولم تكن المواصلات متيســــرة لأمثاله من أبناء طبقته، عانت النفـــــي المزدوج في فلسطين مثلما عانتــــه في شقيقــــاتها العربـــــيات، وذات يوم كنّا نتحلّــــــق حوله، وكان د. نقولا زيـــــادة يــــــزور عمّان، واذكر أنني قلت لأصدقائنا، لنحاول اللــــيلة أن نصــمت ولو قليلا، ونصغي الى إحسان ونقولا وهما يرويان تاريخا غير مدوّن في الكتب الداجنة، وسمعنا منهما ما يكفي للاعتقاد الراسخ، بأن جيل الرواد من الفلسطينيين والعرب عموما، كابد ما لا يصل الخيال الى حدوده، كي يقطعوا تلك المستنقعات من التخلف، وحاوروا شروطا لا يسهل علي أي جيل أن يحاورها بتلك البسالة وذلك الدأب.
وكانت تلك الليلة من الليالي النادرة التي رأينا د.إحسان فيها غاضبا بحيث احمرّت عيناه، وقال بطرافته وحكمته، تعالوا نشتق مصطلحا يعبّر عما نشعر به الآن إزاء هذا الواقع الفظ، وانتهينا الى مزج بين الإشفاق والاشمئزاز، فكان الاشفئزاز!
وعاش د. إحسان الأعوام الأخيرة في هذا الخريف القومي مشفئزا، يشعر بالإشفاق بقدر ما يشعر من الاشمئزاز، الإشفاق علي الذات والناس الذين لا حول لهـــــم ولا قوة، والاشمـئزاز من نظم سياسية أعادت العربي الى طور القرد في عقود قليلة، لأن التقريد له استراتيجية ومنظّرون ولا يمكن له أن يحدث بهذا الأحكام لولا أن هؤلاء نزعوا كل آدمية الإنسان، وجوّفوه حتى أصبح طبلا لا يصلح إلا للقرع أو الدحرجة.
* * *
من يتصورون أن إحسان عباس كان أكاديميا يؤثر المحافظة، والأتباع، هم الذين لم يروا طائرته منذ لحظة إقلاعها، فهو أول من انحاز للحداثة في النظرية والتطبيق، وكانت دراسته المبكرة عن البياتي تبشيرا بالشعر العربي الحديث الذي عاش أيامه الأولى محاصرا بإرهاب النقد الاتباعي.
لهذا لم يبالغ من قالوا أن إحسان عباس فتح للبياتي بابا واسعا في هذا الملكوت الشعري، ومنهم من عيّره بذلك، وحمله ما انتهي إليه عبدالوهاب في شيخوخته الشعرية.
سترثه أجيال على الأقل رضعت كتاب فن الشعر لاحسان عباس، وكان أول ناقد عربي يفكك لنا مقولات غامضة يتداولها نقاد ناشئون، منها مثلا مفهوم المعادل الموضوعي، الذي رسّخه ت. س . اليوت من خلال قراءته الخاصة والاستثنائية لهاملت، وإحسان عباس لم يتنازل عن كونه معلما حتى وهو في ذروة السّجال من أجل تحديث حساسية ومفاهيم.
لهذا فقد احترز من الشطط، ولم يذهب بعيدا في التعمية والتضليل، مما جعله في نظر الحداثويين الذي يطيشون علي شبر حداثة اتباعيا وكلاسيكيا، أو مدرسيا!
ولأننا تعلمنا منه الكثير، فقد كنّا نشعر بتقصير إزاء هذا الرجل العالم، الذي قضي عمره في الكتاب، وما اشق علي أمثاله من لحظة تتقد فيها البصيرة ويشحّ فيها البصر، فلم يؤرقه شيء في أعوامه الأخيرة مثل عجزه عن القراءة، وان كان قد وجد أصدقاء ومحبين وتلامذة عرضوا عليه أن يقرأوا له بعيونهم ساعات في النهار، لكن العين المدربة علي القراءة، وبصر الصيّاد الحاد الذي احتاز كل تلك الخبرة وذلك المران في التمييز السّريع بين القمح والزؤان، لم يكن يعوّضها شيء.
* * *
أطلق إحسان علي سيرته الذاتية التي كتبها تحت إلحاح أصدقائه عنوانا ذا مغزى عميق هو عزلة الراعي، فالرجل منذ صباه كان ذا نزعة للعزلة، لكنها العزلة المضيئة والعالية والفاعلة، وهو ابن ريف عربي، لم تكن الرّعوية قد فارقته في الربع الأول من القرن العشرين، ولم يكن إحسان عباس راعيا يتلهى بالعزف علي شبابة أو ناي في هضاب قرية شمالية، بل درّب أصابعه علي عزف آخر، وأصغي الى إيقاعات المدينة سواء كانت عربية عاشها في صباه كالقاهرة والخرطوم وبيروت أو أوروبية اتصل بها بعقله وخياله، والنصوص التي قرأها بشغف وترجمها بأمانة.
ولم تحل عزلة الراعي دون هبوطه الطوعي بل التطوعي عن التلال الى الوادي، فقبل سبعة أعوام، اقتنع إحسان بأن إعادة النظر بالإبداع الجديد تستحق منه وقفات مطوّلة، وقبل لأول مرة بكتابة مقال أسبوعي في الملحق الثقافي لجريدة الدستور، وهو الذي كان مصابا بحساسية شديدة إزاء الكتابة في الصحف اليومية، وبالفعل، أضاء إحسان للعديد من الشعراء الشباب والكتّاب الجدد الطريق، ودلّهم علي الينابيع، وكان شعاره المتكرر هو مقولة أحبها لستانلي هايمن عن دور الناقد كقنطرة بين النّص والمتلقي، بحيث يردم الهوة بينهما، واستطاع عبر هذا التجسير المعرفي أن يستأنف دورا رياديا وهو في السبعينات من عمره.
* * *
جيل إحسان قد لا يقبل التكرار في تاريخنا المعاصر، لأن ظروف نشأته، وما كابده من عذابات التأسيس قد لا يتكــرر في عصر أصبح كل شيء فيه ميسورا إلا الإرادة والدأب، والهاجس الرسولي الذي يمهر كل مجهود معرفي بالنزاه.
سنذكر أن إحسان كان يستشهد كثيرا بما كتبه ناقد ماركسي عن ت. س . اليوت، هو الناقد البريطاني ماثيسن، فالتناقض الإيديولوجي لم يحل دون نزاهة ماثيسين، الذي كتب عن اليوت بمعزل عن تصنيفه الإيديولوجي، وهو القائل صراحة: أنا ملكي في السياسة وكلاسيكي في الأدب، وكاثوليكي في العقيدة!
كان إحسان نزيها بشهادة زملائه وطلابه ومن عملوا معه علي امتداد عقود، ولم تفسد شهوات تحقيق الذات الزائفة برائته، فاحتفظ بقدر كبير من طفولته العين غزالية وهو في بيروت والقاهرة و لندن.
ولعل هذا الموت الذي هيأ إحسان له حقائبه وبياض شعره، هو رمزي الى حدّ ما، فسقوط بغداد بالنسبة لواحد مثله ليس خبرا عابرا في فضائية مغمـــــورة بالتراب، وما كان يراه ويسمعه عن وطنه من تنكيل كان يأكل من لحمه، وتوكأ إحسان علي قلمه قبل أن يتوكأ علي عصاه، وبكي كثيرا في عزلته البيضاء، وسهر مع الموتى من أبناء جيله الذين مضوا وأبقوه كالرمح وحده!
وكم كان بــــروميثيوس النقد العربي طليـــــقا عندما اســــتدل بفطــرته السليمـــــة
الأولى علي الطـــــريق، فعبّد البراري الفاصــــــلة بين المدرسة والقرية بقدمين حافيتـــــين، وتحدي الشـــــروط الباهــــــظة التي حاصــرت ارض ميـــــــلاده، فتعلّم وعلّم، وقرأ واستقـرأ، ووفر له تاريخ غاشم من أسباب الرّعونة ما عفّ عنه صبيا وشيخا.
إحسان عباس، ينتشله من القبر يوميا رفّ عزيز في مكتبة العرب، لهذا فأمثاله لا يشملهم الموت إلا في بعده العضوي العابر!
القدس العربي- 2003/08/02
بعد تكريم مؤسسة شومان في الأردن للعلامة الكبير الدكتور إحسان عباس، كرمته بيروت أيضا ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي الذي يقام مع آخر كل عام، حيث ألقيت كلمات وقصائد، وتحدث هو عن حنينه إلى بيروت كما منحه النادي الثقافي العربي وشاحه الأكبر، وألقى الشاعر حسين حيدر بالمناسبة قصيدة تنم عن الحب والتقدير للعلامة الكبير الذي تجاوز الخامسة والثمانين - أطال الله عمره - وهو في قمة صفاء ذهنه ووعيه الجميل.
التقينا إحسان عباس بيروت في عدة جلسات، استمرت أياما حتى نتعبه، وكان حصيلة هذه اللقاءات هذا الحوار الشامل في كل ما تعنيه الثقافة من معنى.
* ما أراه في حياتنا الأدبية عموما: هذه الفوضى.. فوضى النقد، فوضى الشعر، فوضى الرواية، فوضى الرسم, ونحن ندخل القرن الواحد والعشرين. هل ترى معي هذه الرؤية، وما رأيك في ذلك؟
الإحساس بالفوضى شعور طبيعي لدى كل من يحاول أن يطرح سؤالا يحتوي ضمنا على معيار تقييمي؛ والحاجة إلى التنظيم تتملكنا على نحو طبيعي أيضا حين نحس بأن هناك جهودا تهدر دون مردود إطلاقا، أو حين تسيطر علينا الحيرة القاسية إزاء التكاثر المتزايد في ظواهر لا نستطيع لها تعليلا ولا تسويغا. فإن كنت تعني بالفوضى حرية مطلقة لدى كل فرد في أن ينتج ما يظنه في نظر نفسه فنا، فلا ريب في أن هذه فوضى مشروعة، ولا يجوز بل لا يمكن لأحد أن يضبطها، الحقيقة الفنية أو الظاهرة الأدبية من طبيعتها أن تتمرد على كل تنظيم، عند المبدع، إلا التنظيم العام الذي أقرته التجربة الإنسانية على مر الزمن، ومن الصعب اللقاء الاجتماعي من حولها، فانك لو جمعت عشرة حول حقيقة فنية أو ظاهرة أدبية لتلقيت بعددهم آراء وأحكاما. كأن الفن في هذا أشد فردية من التصوف، هنالك كلما ظهر شيخ ظهرت طريقة جديدة، وفي الفن كلما ظهر "مريد" صغير ظن نفسه شيخا كبيرا من الواصلين.
إذن أين الفوضى؟ أعتقد أنها في أمرين أو تسيطر في ناحيتين:
حين يكون هناك خطأ فطري في تبين معالم الطريق، وعدم الوقوف عند القاعدة الذهبية "رحم الله امرءا عرف حده فوقف عنده"، وحين يكون الناقد قدرة زائفة أي فاسد الإحساس النقدي، يحب التلذذ بإقامة الأصنام، يرفع ويضع ويجعل من نفسه حكما، وضميره غارق في رشوة الشهرة أو غيرها من أنواع الرشوة، لا مفر من الإحساس بالفوضى في الإنتاج الفني والأدبي والنقدي ومما يزيد هذا الإحساس قوة لدينا - في العالم العربي- اختلاف المنابع الثقافية، وتفاوت المستويات الثقافية، وحدة الانقسامات الجزئية حول إيديولوجيات كثيرا ما تكون متقاربة، وحاجة المؤسسات الإعلامية إلى تغذية مستمرة مهما يكن نوع الغذاء، كما أن انتشار القلق العصري يتطلب الإرضاء عن طريق التغيير المستمر والتنويع، فإذا أضنت إلى ذلك الابتهاج الطفولي الذي يتملك من لم يتعود الانطلاق، حين يتاح له أن ينطلق، متخطيا كل الحواجز والأطواق، ساخرا بكل سلطة معتمدة تفرض النظام - ابتداء من سلطة الأب حتى قمة السلطات - وجدت أن الفوضى ستغدو هي القاعدة.
تسألني هل يمكن الحد هن هذه الفوضى؟ ربما أمكن التخفيف منها بحيث يصبح للجهد الإنساني في هذه الوجهة مردود أعمق وأصلح، وهنا لابد من تربية فنية أصيلة، ولابد مثلا من إحاطة وسائل الإعلام بقوى نقدية: في كل صحيفة ناقد أو نقاد لمختلف الفنون، وفي كل دار نشر هيئة من القراء والنقاد، ثم لابد بين الحين والحين - وهذا شيء لا يخضع لقانون - من ظهور عبقرية في هذا الميدان الفني أو في ذاك تصبح كالمجال المغناطيسي الذي ينظم من حوله برادة الحديد المتناثرة. ولابد لي ولك يا صديقي من أن ننجو من وطأة الخوف من شبح الفوضى، وأن يتبلد لدينا الإحساس بجبروتها الصاعق، كيف؟ بأن نعمل ونعمل، عن قناعة بأننا فيما نعمله لا نريد إلا خير الإنسان، وعن إيمان عميق بأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
* اهتمامك فاقت أي ناقد في تناول تراثنا من جهة، وإنتاجنا المعاصر من جهة ثانية، مثلا: تاريخ المغرب العربي، تاريخ الأندلس، تاريخ الأدب الأندلسي خصوصا فهل لك أن توجز لنا:
- رأيك في حياة العرب في الأندلس والأدب الأندلسي وجوانب التجديد في ذلك الأدب؟
- التفاعل بين الأدب الأندلسي وأدب لبنان في مطلع القرن، (جبران ونعيمة).
- تأثير التراث الأندلسي في الأدب الأسباني القديم والحديث؟
- في النظرة الشاملة يمكن أن تقول إن حياة العرب في الأندلس كانت حياة خصبة من النواحي الثقافية والفنية والجمالية، حياة فيها غبطة بنعم الطبيعة، أو كما يقول الشاعر- وأظنه أيضا أندلسيا-:
يا أهل أندلس لله دركم
ماء وظل وأنهار وأشجار
ما جنة الخلد إلا في دياركم
ولو تخيرت هذي كنت أختار
إذا نظرت إلى هذه الحياة وجدت تطويرا مستمرا في النواحي العمرانية، في الزراعة، في الكشف المستمر، الفتية المغرورون الذين حاولوا معرفة ما وراء المحيط الأطلسي خرجوا من الأندلس؟ الدهشة الفنية والإعجاب العميق بالتماثيل لا تجدهما على نحو واضح إلا في الأدب الأندلسي: محافظة الحياة على بساطتها رغم التطور الحضاري المستمر ظلت ظاهرة مميزة للأندلس: إنه ليس من السهل أن أتحدث عن تلك الحياة في صورها المختلفة بإيجاز، ولكني أقول: رغم كل الايجابيات في تلك الحياة كان الأندلسيون يحسون أن نصيبهم منها فلس، في بعض المراحل، بسبب ترقب الضياع والتخوف من حلوله، وهذا هو الذي خلق في النفسية الاندلسية الميلين المتصارعين: التدين الشديد والإيمان باللذة؟ الأندلس بستان متصل، هكذا قال أحد الأندلسيين، ولكن حين يحس المرء أن هذا البستان يضيع من يده يحاول أن يأخذ منه في الزمن القصير كل ما يستطيع.
والأدب الأندلسي يعكس تلك الحياة، إنه يفرق في نشوة الوجود الآني، إنه لحون جميلة في بستان جميل، ولكنه من ناحية أخرى نضج في عصر الفرقة السياسية فكان من وظيفته أن "يكرس" التجزئة وذلك لطبيعة العلاقة حينئذ بين الأدب والتعيش: كان يعاني شعورا بالنقص إزاء الأدب المشرقي، ولهذا أهدر جهدا كبيرا في التقليد؟ حتى الروح البدوية في الشعر المشرقي حاول تقمصها، على البون الشاسع بين الحياة التي يمارسها وبين البداوة؟ كان كأدب المشرق يحتاج إلى شمول في الرواية ولم يستطع أن يبلغ المستوى الفكري الذي بلفه المتنبي والمعري وإن تأثر بهما كثيرا، منحته النكبات المتلاحقة وترا حزينا ولكنها لم تستطع أن تمنحه الإحساس بمأساة كبيرة، موجهاته النقدية كانت في الأغلب أخلاقية المفزع، وحسبك أن تعلم أن ابن رشد متأثرا بأفلاطون قد أدان ذلك الشعر- الأندلسي منه والمشرقي- وربط بينه وبين تقويض المبنى الأخلاقي.
وعندما نتلمس مظاهر التجديد فيه فلابد أن أكرر ما يعرفه الناس جميعا وهو ابتكار الموشح؟ والذي أريد أن أقوله هنا هو أن الموشح لا يمثل عند الأندلسيين مراوحة في النغمات أو محض هرب من شكل القصيدة، إنما هو في نظري يمثل خصائص كثيرة في الطبيعة الأندلسية نفسها: يمثل التطور الموسيقي والروح الشعبية والقدرة على التقفز، وفي هذه الناحية الأخيرة أقارنه بالأعمدة الدقيقة في قصر الحمراء التي تحمل جسدا عمرانيا ضخما، حتى يخيل لمن يردها لأول وهلة أنها لا تلبث أن تنهار؟ ولهذا فانك إن قارنت بين الموشح الأندلسي والمشرقي وجدت هذا الثاني عملا سطحيا آليا فاقدا للحرارة الفنية التي تجدها في الموشح الأندلسي.
ومن مظاهر التجديد الأزجال الأندلسية، وهي تجديد محلي إقليمي، وإذا قارنتها بالأزجال العراقية والمصرية واليمنية، وجدت مظاهر مشتركة وخاصة من حيث روح السخرية الشعبية فيها جميعا. ولكن ليس هذان المظهران - أعني الموشح والزجل - هما كل مظاهر التجديد في الأدب الأندلسي. هنا لا بد من الوقوف عند الآثار الفردية البارزة، فأنت لا تجد في الحب والسيرة الذاتية أدبا يفوق "طوق الحمامة" لابن حزم، ولا تجد خيالا كثيرا مثل خيال ابن شهيد في "التوابع والزوابع"، وهكذا. وإذا سمحت لي قلت: "إن الأدب مظهر من مظاهر الفكر، والفكر لا يضاهى، فانك لن تجد في المؤرخين أناسا كثيرين بدرجة ابن حيان وابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب ولن تجد في علم الأديان المقارن مثل ابن حزم، وربما حكمت بتفوق ابن الرومية وابن البيطار في علم النبات على كل أهل هز ا العلم في المشرق، ولن تنسى في ميدان الفكر الفلسفي ابن طفيل وابن رشد وفي الفلك الزرقالة والبطروجي، وهل أمضي فأعدد عطاء الأندلس في اللغة والجغرافيا وهو أمر يكاد لا يحصر؟
أما التفاعل بين الأدب الأندلسي وأدب لبنان في مطلع القرن، فما أظنه كان قويا، نعم ربما كان شكل الموشح الأندلسي مثار اهتمام من يدعون للتجديد، ولعله أثر تأثيرا جزئيا في تجزئة القصيدة والتنويع في القوافي، ولكن المجددين اللبنانيين وخاصة في المهجر الشمالي كانوا يبحثون في الأكثر عن غذاء صوفي، فوجدوه في الفكر السينائي، وفي قصائد السهروردي وابن الفارض؟ ومن مميزات الأدب الأندلسي انه ابتعد عن التصوف إلا قليلا (كما هي الحال عند ابن عربي والششتري).
لقد أثر التراث الأندلسي في الأدب الأسباني، والأوروبي بشكل عام، وفي هذه الناحية كتبت دراسات مستفيضة حول أثر الأدب الأندلسي في شعر التروبادور، والحقيقة هي أن من أعسر الأمور في الدراسة الأدبية إثبات قضية التأثير والتأثر على نحو قاطع، ولكن المزيد من الشواهد المكتشفة يؤكد أن تأثير الثقافة العربية في الأدب الأسباني والأوروبي كان أمرا واقعا وكان في الوقت نفسه أمرا طبيعيا؟ منذ فترة أرسل إليّ أحد الدارسين مقطعا شعريا للشاعر جيوم التاسع، وهو من شعراء التروبادور، لأحل كلماته، ولشد ما كانت دهشتي عندما وجدت أن الكلمات التي في ذلك المقطع كانت عربية. وقبل سنوات كان الأستاذ شارل لاميه يطلعني على سطرين في قصيدة دانتي، وكيف رد الألفاظ إلى أصول عربية. إن هذا التأثر هو أبسط الأنواع ولكنه رغم ذلك ذو دلالة عميقة على أن الثقافة العربية - باللغة العربية نفسها- إلى جانب الترجمة كانت تترك طابعها في كل مكان: فكيف إذا عرفنا أنه كانت هناك دوائر للترجمة المنظمة من العربية وخاصة في أيام ألفونسو العالم؟ ومما ترجم. إلى جانب كتب العلم والفلسفة. كليلة ودمنة وقصة السندباد، وقبل القرن التاسع عشر ترجمت إلى الأسبانية قصص من ألف ليلة وليلة، ويبدو في الأدب الأسباني أثر المقامات وخاصة فيما يسمى حكايات الصعاليك، كما يبدو أثر قصة حي بن يقظان لابن الطفيل، كما استطاع المستشرق الأسباني ريبيرا أن يضع يده على الأثر القصصي العربي في أشعار الملاحم الأسبانية الأولى. ويجب أن نتذكر ونحن نتحدث عن اثر التراث الأندلسي في الأدب الأسباني أن هناك حلقة وصل هامة بينهما وهي الشعر الموريسكي والأدب الموريسكي الذي كتبه بلغة قشتالية شعراء مسلمون (بعد القرن الرابع عشر) مثل قصيدة سيدنا يوسف التي تعد مبكرة في تاريخها، وهي رباعية باللغة القشتالية تروي قصة يوسف كما وردت في القرآن، وكان الموريسكيون يسوغون أشعارهم في قوالب شعر الأغاني الأسبانية المعروفة بالرومانتس، وكانت لديهم قصص وأساطير تدور حول موضوعات دينية أو بطولية؟ وبهذا الأدب يمثل الموريسكيون حلقة بين الشعر الأسباني الحديث وشعر القرون الوسطى، حلقة يظل تأثيرها وتأثير الروح العربية ملموسا في الأدب الأسباني حتى لوركا، بل حتى ما بعده.
* اهتممت اهتماما بالغا بتحقيق التراث العربي ونشره وتدريسه وإعادة تقييمه بروح جديدة، هل توجز لنا هذا التقييم الجديد؟
- يقوم اهتمامي بتحقيق التراث على مبدأ راسخ في نفسي وهو "المعرفة قبل الحكم". ثمة شيئان ينمان عن انعدام الثقة الذاتية أو من تجاوز الحد الطبيعي في تلك الثقة وهما التعميمات الكاسحة وقبول الأشياء قبول مسلمات: وأنا أنفر من الاثنتين، وسأضرب لك مثلين عليهما. درست الأدب الأندلسي في عصر الدولة الأموية فكانت أحكامي محدودة بما وصلنا دون تعميم أو عاطفية، ثم اكتشفت كتابا عنوانه "التشبيهات من أشعار أهل الأندلس" فإذا به يحوي قدرا كبيرا من شعر تلك الفترة، وإذا الصورة الأولى التي كونتها تتسع جوانبها وتتضح منها جوانب لم تكن من قبل واضحة، وإذا بي- على ضوء كتاب جديد من كتب التراث أصبح أكثر ثقة في دراسة تلك الفترة، دون لجوء إلى تعميمات جارفة. ألست ترى أن بعث مثل هذا الكتاب شهادة جديدة أو وثيقة خطيرة في يد الدارسين؟. المثل الثاني: علمونا أن القصيدة الجاهلية ليست ذات وحدة، وأن حذف أبيات منها أو تغيير الترتيب فيها لا يؤثر كثيرا في سياقها لأنها مختلة البناء أصلا. كثيرون ما يزالون يأخذون هذه الفكرة أخذ تسليم. لقد درست نماذج من الشعر الجاهلي لطلابي، استطاعوا هم - عن طريق اللمح والإلماح البسيط - أن يكتشفوا أن ذلك الحكم على الشعر الجاهلي جائر، بل يدل على أن الذين أطلقوه لم يعرفوا من الشعر الجاهلي- إن كانوا عرفوا شيئا- إلا المعلقة.
التقييم الذي اعتمده يقوم على شيئين: معرفة الدور الصحيح للأمة العربية في التاريخ الحضاري والموادعة لروح العصر، مثلا: درست ما أسداه العرب في النقد الأدبي من خلال الرؤية العصرية، فوجدت أنهم قاموا بدور كبير جدا لا يقل عن دور أية أمة أخرى، ولولا هذه الرؤية للتراث ظل النظر إلى دورهم في الفكر النقدي إما اتهامات جائرة أو تفريطات مرتجلة، كل دراسة - في رأيي- لا بد أن تكون كشفا جديدا، وما دام الأمر كذلك، فلا كشف يتحقق على أصول علمية دون إحياء التراث، عند من يؤمنون بجدوى تلك الدراسات، أما رفض التراث - انقيادا لنزوة قلقة أو نزعة منحرفة - فانه لا يخطر ببالي، ولا أستطيع تصوره لأنه ينم عن تنكر للإنسان وجهوده على هذه الأرض.