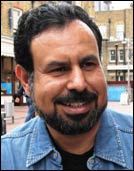 ليس من المصادفة أن تخلو بعض أحدث الروايات الكويتية من أي اشتباك بالمكمن الإجتماعي، فهي غير مهمومة - من الوجهة الفنية والموضوعية - بالتوثيق، بل معاندة للطابع التسجيلي، ولذلك تبدو منسوجة بلغة مجتمعية جديدة، تم التواطؤ على تشظيها من قبل جيل مغاير لمفارقة ما كرّسته مدارات الرواية الكويتية القديمة، نتيجة تبدل المرجعيات السوسيولوجية، وتخلخل الأنساق الثقافية، وإصرار منتجيها على إبداء شيء من فردانياتهم عوضاً عن تجسيد الملاحم الجمعية، فراراً مما يسميه ألن تورين " عبء الهوية " وهذا بعض ما تغري به سوسيولوجيا الرواية، من حيث تجانس الشكل الروائي بالبنية الإجتماعية، أي بين الرواية كنوع أدبي وضرورات النزعة الفردانية في المجتمع الحديث.
ليس من المصادفة أن تخلو بعض أحدث الروايات الكويتية من أي اشتباك بالمكمن الإجتماعي، فهي غير مهمومة - من الوجهة الفنية والموضوعية - بالتوثيق، بل معاندة للطابع التسجيلي، ولذلك تبدو منسوجة بلغة مجتمعية جديدة، تم التواطؤ على تشظيها من قبل جيل مغاير لمفارقة ما كرّسته مدارات الرواية الكويتية القديمة، نتيجة تبدل المرجعيات السوسيولوجية، وتخلخل الأنساق الثقافية، وإصرار منتجيها على إبداء شيء من فردانياتهم عوضاً عن تجسيد الملاحم الجمعية، فراراً مما يسميه ألن تورين " عبء الهوية " وهذا بعض ما تغري به سوسيولوجيا الرواية، من حيث تجانس الشكل الروائي بالبنية الإجتماعية، أي بين الرواية كنوع أدبي وضرورات النزعة الفردانية في المجتمع الحديث.
النفط كنسق وارث لنسق البحر، وبما هما محركان حيويان للنظام الثقافي والإجتماعي والسياسي، لم يعد لهما ذلك الحضور أو التأثير المباشر في الفعل الروائي الكويتي الأحدث، وهو أمر يتقاطع بشكل حتمي مع إنهيار المرويات الكبرى ذات الدلالات العمومية العريضة، المجسدة لأحلام الأمة والمجتمع والوطن، لصالح السرديات الفردانية الصغيرة المحتفية بالتاريخ الشخصي وإن ظلت داخل إطار التاريخ العام، والتي تعكس النزعة الإنشقاقية بالضرورة، على اعتبار أن الرواية فعل ابداعي تعددي وإختلافي يعمل ضد كل أشكال المركزية والشمولية والإمتثالية، فالكتابة لم تعد ضريبة يدفعها الكاتب تجاه المجتمع، حسب رولان بارت، نتيجة تحولها الدراماتيكي إلى فعل نصي يعبر به الكائن عن تحرره الثقافي.
يبدو هذا الأمر واضحاً لدرجة القطيعة في رواية هديل الحساوي " المرآة - مسيرة الشمس " حيث تتخلى عن التماس مع ملاحم " النواخذة " الذين كانوا محل تمجيد فوزية الشويش حيث روت عوالمهم وأهدتهم روايتها باعتبارهم " أسطورة الخليج " لصالح حكماء أسطوريين ذوي ملامح معرفية وحياتية كونية كسقراط وأرسطو وأثينا، إذ تفصح من خلال وعيها الروائي الجديد عن ذات تعيد تموضعها داخل مدار ( كتابي/حياتي ) مغاير، أوسع ربما من المعتاد، فيه من التحول الإجتماعي التاريخي ما يحرّض تلك الذات على مفارقة أو هدم أحادية المرجع، والرغبة الأكيدة في إحداث حالة كتابية مضادة من التنوع والتعدد المؤسس على الفرادة والإستجابة إلى نداءات الذات لا إملاءات الجماعة، كما أكدت ذلك على لسان منيرفا " إن الكتابة لا تكون مجزية إلا بعد البحث في الذات، البحث داخل الذات ". وبعد الإهتداء إلى ذاتها كتبت من خلال شبيهتها " وافقت الفتاة التي تشبهني على الكلام وقالت: اسمعي ما يقوله لك صوت النقش على يدك... الصادر من عمقك ".
ومن ذات المنطلق نأى سعد الجوير أيضاً عن المعطى من الفضاءات، باجتراح زيارة أسطورية إلى " باربار " ليروي ما حدث تحت الأرض وليس ما يُرى ويُلمس ويُعاش الآن فوقها، بما يعني الإرتداد القصدي والواعي في عمق التاريخ الذي لا يخلو من دلالات الإنقطاع عن الحاضر وتأكيد الإسقاطات في آن، أو استقراء جانب من الراهن من خلال الماضي، حيث يصاحب إله ( الأبسو ) سيد الأغوار السحيقة وحاكم المياه الأرضية. وبموجب تلك الصحبة المتخيلة روي حكاية " إنكي " الذي منح دلمون الحياة، فيما يبدو انصرافاً معلناً عن المتداول من المضامين، وانقلاباً فنياً مقصوداً على تقاليد السرد المكّرسة، حيث أسفر بكتابته عن ذات رافضة لإعادة إنتاج ما تلقنته، ومعاندة لفعل الاستنساخ الكتابي بفعل سردي غرائبي فيه من الرغبة على إعلان الاستقلال التعبيري، وتحدي السائد بأدوات ولغة تعكس الرغبة في الإنزياح وتؤكدها، أي الإصرار على الكتابة النوعية المختلفة كما جاء على لسان بطله " أزعم أنني لن أكتب سوى ما يستحق! ".
أما بثينة العيسى فإذ تحاول في " عروس المطر " الإطلالة على سحرية الماضي من خلال أبله " حصة " إلا أنها لا تسمتد مقومات تلك الشخصية من استيهاماتها، بل من حواضنها ووقائعها المادية، لإختبار ما أريد لها أن تستودعه في لا وعيها، على العكس مما فعلته ليلى العثمان في " وسميّة تخرج من البحر " التي عادلت شخصيتها بعفة وجمالية الزمن الآفل، كما يتمثل في البحر، الذي اعتبرته " مخبأ الأسماك والودع والأسرار والأغنيات الراحلة " ولذلك تعلن خيبتها بنبرة احتجاجية لا تخلو من النقد " أبله حصة غشاشة، تكذب، تكذب حول كل شيء، تستخدمني لتدعم دجلها بغبائي، إنها عادية، مجرد عادية، مجرد أخرى من الحشد العاديّ الذي أنا منه وأصبّ فيه وأذوبُ فيه و.. لم يكن هناك صندوق أسرارْ، لم تكن رائحة غرفتها جميلة، لم تكن هناك كائنات تعطس في قاع الكأس، لم يكن هناك أحلامٌ تتحرك بأجسادِ حيواناتٍ أليفة، لم يكن هناك بساط سحري ولا وسادة سحرية ولا عصا سحرية.. ولا حتى جورب سحري، لم يكن هناك سحر، لا شيء، إنها مجرد عادية، تكرّس فينا اليقين بكونها أخرى، بكونها مختلفة، بكونها ربيبة الكونية التي يبارك العالم خطوها ".
تلك كانت الحافة التي اكتشفت عندها وهم الأصالة التكوينية للماضي، وربما اقتربت من هاجس وجودي أكثر قلقاً يتمثل في كون الهوية حركة من حركات التموضع والتبدل المستمر، وأنها ليست مجرد معطى على درجة من الثبات والتحجر، بل يمكن حتى تداولها من منطلق " الإختلاق " بتعبير ادوارد سعيد، أي التعاطي معها كصيغة ثقافية قابلة للانتاج المستمر وليس كجوهرانية ثابتة أو كانتاج تاريخي يستحيل المساس به أو تهميشه، وعليه قررت أن تكتب من داخل لحظتها، وعمن يشبهها، لا عن " آخر " يموضعها في أخدوعات رومانسية، كما عكست ذلك الإنكشاف عبارتها التساؤلية " لو كتبتُ قصة أسامة، لو كنتُ أسامة؟ " وهو ما يعني رغبتها الواعية باستدعاء ذاتها عبر الكتابة للتعبير عن ذاتها بالنظر إلى ما تحمله التوأمة من دلالة تؤكد على أحوال الشبه حد التطابق، فذلك النمط من الكتابة الصادقة وحده الكفيل بإضفاء الطمأنية على روحها، ومصالحتها مع عالمها. الأمر الذي يفسر أيضاً إصرارها على تحميل أبطالها عبارات وثيقة الصلة بوعيها الكتابي الرافض للتدوين والتسجيل كاحتجاج أسماء مثلاً " بس أنا ودّي .. أعيش الكتابة .. كـ .. اكتشاف ، مو .. مو تقر.. تقرير ! ".
هكذا يبدو الأمر ظاهرياً، حين تأمل حس التفردن الطاغي في بعض الكتابات الروائية الحديثة، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى الوعي والتعبير عن دستور الحرية الفردية، ففي هذا الإنتحاء عن الجذور ضرب من الرهاب، أو الجهل ربما بالمكّون المكاني، ويعني فيما يعنيه الإنصراف القصدي عن تجسيد أي شكل من أشكال الهوية، إذ لا شيء يوحي بالمكانية كما زعزع قدسية تقاليد الإفراط في تعداد مآثرها ناصر الظفيري في " سماء مقلوبة ". وحيث لا تتوفر في المنجز إلا إشارات دلالية ضامرة تحيل إلى ذات المرجعيات المعهودة، فلا " ظل الشمس " ولا " رائحة البحر " التي أراد طالب الرفاعي تعفير أجساد أبطاله بها، حتى عناوين ومضامين الروايات ذاتها لا تحمل أي ملمح من ملامح وطقوس وعادات مجتمع ما قبل النفط كما سجلها وليد الرجيب في " بدرية " بما يعني الهروب من صيغة الرواية البلزاكية المتخمة بموضوعات وأوصاف بالغة الدقة لعالم مادي يتجاوز حضوره كمساكن وملابس وأثاث المهمة الديكوراتية ليكون صنو الانسان نفسه.
في الروايات الجديدة، الأرض لا تنادي أهلها، والأبطال لا يقتلهم الحنين إلى الماضي، ولا يغتال البحر أفراحهم بعودة أحبائهم، بل ولا يشعرون بأي أزمة روحية قبالة جناية " النفط " إذ لا يبدو أن الروائيين الكويتيين الجدد معنيين بتحميله مسؤولية خلق ظواهر الإغتراب الإجتماعي، وإحداث الهوة بين النظامين الحياتيين القديم والجديد، حتى النساء لا يدافعن عن حقوق إجتماعية مهدورة بقدر ما يواجهن مآزق شعورية ذاتية صغيرة، فهم أبناء العولمة، الممسوسين بشروط الكوننة الثقافية، الذين قرروا التمرد - بوعي أو لا وعي - على قدسية الحاضن الإجتماعي، والكتابة خارج قوسي النفط والبحر كما تنم عن ذلك جملة من العلامات الصريحة والمضمرة في مجمل المنجز الروائي.
مشهد " ابراهيم العود " المسجى في فراشه وسط الحوش الكبير، وهو يرتل وصاياه بصوت واهن يحمل بصيرة المعرفة وجلال الحكمة، كما رسمت تراجيديا نهايته فوزية الشويش " النوخذة القدير، صوت العبقرية التي لا تدرك سرها عظمة الماء وبساطة الجد الأول " لم يكن سوى الإعلان الأخير عن نهاية زمن البحر وبداية عصر النفط، وربما بداية الكتابة عن " المابعد " أي التأسيس لكتابة مهمومة بقضايا مرحلة يعادلها سعد الجوير بالراهن أو ما يسميه " زمن ما بعد العثور على كنز القاع " حال أباح له " إنكي " فعل الكتابة فامتثل له وكتب " أخرجت رزمة أوراقي التي تتعدى العشرين عداً، وأخرجت قلم رصاص، وممحاة، ووضعتها على طاولة حديدية أمامي ". وحيث تكلم أرسطو فكتبت هديل الحساوي " "جيد جداً، الكتابة فعل جيد جداً، بما أنني معك، سأستلقي و أحدثك فانسخي ما أقول ".
ثمة ذات روائية جديدة إذاً أدركت أن الرواية جنس أدبي تبدأ بالعنصر الذي يوافق خصوصيتها والذي يتمثل أولاً وقبل كل شيء بالذات الإنسانية الحرة التي تخلّف وراءها شيئاً فشياً زمن الكليات المغلقة لتدخل زمن الخصوصيات المفتوحة، كما يحلل فيصل دراج مقولة ليوتار عربياً في " نظرية الرواية والرواية العربية ". وهي ذات تعي بالتأكيد حقيقة التحول التاريخي، وتحاول التعبير عنه بشكل كتابي شديد الوضوح والإختلاف. كتابة من داخل اللحظة وليس عنها، حيث ترفض استنساخ القوالب والموضوعات الجاهزة، ولا تقر الرؤية الاعتباطية للموروث التي تشكل بموجبها المخيال الاجتماعي، معلنة عن رغبتها في حضور مستقل وباحث عن مرجعية سوسيولوجية وثيقة التماس براهنها، الأمر الذي يفسر انجذابها لمدارات أكثر اتساعاً لإختبار الواقع الموضوعي بجدليات مبرّأة من سلطة الذاكرة الدلالية، ومتخففة من سطوة الطابع الأيدلوجي، حيث تتحقق الثقافة بمعناها الحديث في مجتمع جديد يدرك حقه في الوجود، ويجهد لإنجاز لغة مجتمعية لا مراتب فيها.
ربما لهذا السبب بالتحديد تنبث صرخة - واعية أو لا واعية - من " باربار " إحتجاجاً على " أن يكون الشخص مذعناً لدورة الزمن " وإن كان هنالك مسلّمة عميقة داخل السرد بأن الزمن شرط لوجود الذات. أما محل الإحتجاج فيتجه ضد ما تم تكريسه من الصيغ الماضوية، حيث كان هو الملاذ الذي يستعيض به الروائيون الكويتيون عن راهنهم، كما يبدو ذلك واضحاً من اللذة التي تجدها ليلى العثمان، ووليد الرجيب، وفوزية الشويش في تعداد مآثر الماضي المادية والروحية، واستدعاء ما يسميه دولوز " الطبيعات الميتة " فكل المهملات الحياتية المهجورة، المحقونة داخل السرد، ليست مجرد علامات مرئية تحيل إلى عفة زمن آفل، ولكنها مكونات محسوسة يعتقد الروائيون بفاعليتها، واختزانها لطاقة روحية ومادية، وقدرة إيحائية للإخبار عن الكيفية التي عاش بها الأسلاف.
هكذا تعاطى الوعي الروائي آنذاك مع متعلقات الحياة لتشكيل عالم متماسك تحاك ضمنه صور الذات عن ماضيها، بتحليل ادوارد سعيد، وهو أمر تفاداه سعد الجوير بحيلة سردية تعتمد على خلط الأزمنة ومداخلتها بشكل استقرائي، وعاندته بثينة العيسى بما يشبه التأزم لتعيش وتكتب لحظتها هي لا لحظة الآخرين كما يتوضح ذلك في حيرتها " كيف أطردُ الزمن من وعيي؟ كيف أخرج إحساسي من الزمن ؟ " فيما قررت هديل الحساوي بعد أن " اكتشفت أن الشجاعة تكون في كسر الواقع المألوف " تهريب بطلتها من أكذوبة " القرية الآمنة " رافضة كل النصائح والوصايا التعقيمية لتعرف ما يخبئ العالم خلف جدار القرية وتكتشف إثر رحلتها المعراجية إنها تخالفهم كما تنم عن ذلك عبارتها الإشراقية " رأيت أني لا أشبه هؤلاء، عرفت أني لست منهم و أنهم ليسوا مني. أنني مختلفة و أملك سراً سيظهر".
تلك هي الذات الجديدة المحمولة على حس فرداني صريح كما عادلتها بثينة العيسى بزهرة التيوليب الحمراء كرمز للفرادة، أما " الأنا التاريخية " بكل تفاصيلها الفلكلورية كما كان يتم تقديمها كصورة تسجيلية معادلة للذكرى الخالصة بتحليل برجسون، فقد كانت دليلاً على خوف مستبطن من الحداثة، وقد أريد بها من خلال الوعي الروائي القديم الإبقاء على حيوية وإشعاع الماضي، والتأكيد عبر كثافة شريط الصور المحتشدة في الأعمال الروائية على كثاقة الحياة وحركيتها وعفتها، أي التعاطي مع الذاكرة بأقصى وساعاتها وأعماقها لتحفيز الذات واستنهاض شعورها داخل الزمن وإن افتقر ذلك الشكل الزمني إلى صيغة التعاقبات أو الآنات الحاضرة، بمعنى التأكيد على وجود " مروية كبرى " وثيقة الصلة بالتاريخي والإجتماعي.
وقد ظلت تلك المضخة مؤثرة وساطيةً حتى على السرودات الحديثة، فالذات الروائية الكويتية الأحدث لم تنسلخ تماماً مما تسلل إليها من تلك المروية ولا من أبعادها المادية والمعنوية التي صارت تكتسب أهميتها كلما تعرض الفرد لخطر يهدد مغزى وجوده، وهو الأمر الذي يفسر تفشي نبرات رثاء الوطن والأرض والبحر في الأعمال الروائية القديمة، مقابل امتلاء الأعمال الحديثة بالرحلات المعراجية الفردية تأكيداً للأنا كما قررته بطلة " المرآة - مسيرة الشمس " من خلال عبارتها الفارطة في الأنوية " استيقظت وآخر جملة تكرر نفسها في ذهني: بك تنقذين نفسك ". أو ربما رثاءً للذات كما يتبين ذلك في عبارات عروس المطر " إن مشكلتي ببساطة هي أنني أنا ( فرد ) ... وكأن كل شيء يتحرك في هذا العالم إلا أنا! ... الأمر مخزٍ للخبزةِ المتعفنة ، لي أنا ".
ثمة حيل سردية أخرى إذاً للعودة إلى زمن الحكاية، فالإحتفاء بالانتصابات المادية للموروث والمغالاة في تكثير الدوال الماضوية تصده بثينة العيسى في " عروس المطر " بإفراط في " تلهيج الحوار " الذي يعمل بمثابة صمام أمان روحي للذات التائهة، وهو ما يعني وعيها القصدي باستخدام اللغة كمركب بنيوي وليس مجرد قشرة قولية، إذ تعوّل عليه كثيراً في البنية الدلالية للنص، افتراقاً عن الروايات التي تستعرض الموروث بشكل وصفي أو متحفي، كما يشير ذلك الإتكاء على المكوّن البيئي للغة أيضاً إلى التصاق مقصود بالحاضن الإجتماعي للبقاء على تماس بأصالة المروية الكبرى، بدليل تأففها من أبله " حصة " التي ينفضح زيفها من خلال تقعرها اللغوي " ما أن انطلقت تتحدث بالفصحى، حتى شعرت بأننا لا ننتمي إلى المكان، أو الزمن أو .. لا ننتمي إلا لأحلامنا ".
أما ما تبدو عليه هديل الحساوي من اغتراب وانفصال عن الجمعي ومحاولة كتابة رواية أشبه بالملحلمة الفردية في " المرآة - مسيرة الشمس " فينكشف أمام كثرة طرقها على مفردة " جميعاً " وتساؤلها أو انهمامها الصريح بالمجموع " جميعاً، من هم ( الـ .. جميعاً !؟ ) ... ثم إنني فعلاً أريد أن أصل إليهم ( الـ جميعاً ). أو هذا ما ينم عنه لا شعور الرواية. على اعتبار أن السرد فعل فلسفي على درجة من التواشج بالإجتماعي، وهي أي الرواية - بتصور فيصل دراج " تتعامل مع إنسان محدد الإسم جاء من الناس وينتمي اليهم وبحث عن مصيره مفرداً أو مع بشر يقاسمونه المصير ولا يختلسون من فرديته شيئاً " وهو الأمر المؤكد عندها كخلاص فردي يمكن أن ينطبع أثره على الآخرين، أو هذا ما أرادته تلك الذات العارفة كما يتأكد في صراحة عبارتها الوسواسية إزاء المجتمع وقلق تشكلها كذات غير مجتمعية " ما هو الواجب، تركت قريتي لأقوم بواجبي تجاه الناس ".
سعد الجوير أيضاً لا يغادر راهنه تماماً كما قد يبدو من خلال تعاطيه مع خام المادة التاريخية، حيث يحدث تماسه مع ذات المكمن في " باربار " ولكن ليس من خلال التغني بمتعلقات البحر، إنما بقراءة حفرية في " البحر السفلي " الاسم القديم للخليج العربي، إذ لا يمل من التطواف بروح نوستالوجية معذّبة حول المكان ( دلمون ) التي تعني حسب تقصيه التاريخي كل الأرض الموازية للساحل الشرقي من شبه الجزيزة العربية، أي حيث وقف على الشاطئ إلى جانب " إنكي " الذي أطلق عبارة هو الآخر لا تخلو من الحنين " على هذه البقعة من الأرض وضع كلكامش خطوته الأولى " فهنا توارث أبناء الخليج العربي مبادئ الغوص من أول كائن بشري غاص إلى قاع البحر بحثاً عن عشبة الخلود " أنظر إلى الطريقة التي اتبعها بإيحاء منا في الغوص إلى نبتة الحياة في قاع البحر. كلكامش هذا استنشق كمية كبيرة من الهواء وغاص بواسطة ثقل وُضع في قدميه سحبه إلى الأسفل وعندما استقر في القاع فك الثقل وراح يبحث عن العشبة وبعد أن وجدها عاد نحو الأعلى خارجاً من الماء. هذه الطريقة هي ذات الطريقة التي كان أهل الخليج يستخدمونها قبل زمن قصير من زمنكم الآن، وقد علمناها كلكامش عن طريق أوتنابشتي" .
تلك هي حيّلهم السردية، أو ممراتهم السرية التي يتسللون من خلالها لحكاية الأسلاف، ولكن ليس من أجل تحنيط الماضي، وتحويل الرواية إلى متحف للموروث، إنما بنزعة نقدية ودودة لتفكيك المروية الكبرى التي أرادت الإبقاء على الإنسان الكويتي في الإخدوعات الرومانسية، وتمكيثه في ملامح التجانس وأحادية الهوية المستقرة، فثمة احتجاج يتخذ أشكالاً مبطّنة ومعلنة أحياناً على الهوية التي تم الاستيلاء عليها من قبل النخبة كمحل اجتماعي، حيث تبدو الرغبة واضحة عند بثينة العيسى للكتابة " من " داخل لحظتها لا " عن " لحظة الآخرين، وتتجرأ لفضح الهوام الذي تمثله أبله حصة كما يتبين في غضبة عباراتها التقويضية " من غير المريح أن يدخل شخصٌ غرفتها ليكتشف ( عاديّتها ). مزعج أن تتقلص المسافة الفاصلة بينها وبين الآخر، والغموض الذي تسبغه على كل ما يخصها لأجل أن تظل جديرة بالاحترام ".
ومن خلال تضمين التاريخ الشخصي داخل التاريخ العام، ترسم هديل الحساوي ذلك الخيار على شفتي بطلتها " أريد حربي وانتصاري الخاص بعيداً عن انتصاراتهم، قصتي الخاصة، أسطورتي أنا، تاريخي أنا " فهي أيضاً تكتب من الداخل، من الأقاصي، كما تفصح عن ذلك لوغوسية كلماتها الشعرية الخالقة " نكتب على أجسادنا بالمباضع، كتب مفتوحة متحركة سنكون و نقرأ، نكتب داخل النساء، فالكلمة تولد منهن " . ويبدو أنها بقدر ما تبدي إعتناءً بالحكي، إلا أنها أكثر إنهماماً بالبعد المعرفي، فهذه هي بعض انحيازاتها لتقويض السرديات شبه الرسمية، حيث الذات هي عصب السرد، وإذ تمتلك الجرأة والوعي بأهمية مناقدة المجتمع والذات كما يبدو ذلك في عبارتها الصادمة " سقراط أيها الحبيب، لم يصدقك أحد عندما قلت: احذروا، لا تصبغوا مراياكم باللون الأسود، فستندمون إذا انقطع الغيث. لم يصدقوا أن خداعهم و فسقهم سيطحن مرآة أنفسهم و يحول الزجاج المطحون لسم يسري في أوردتهم. قلت لي: ( اعرف نفسك ) جملة تعني مرآة ذاتك ".
لا يخلو الأمر من تقنّع وتمويه واستعارة وحيرة أيضاً يستشعرها الروائيون الجدد كضرورات سردية لاختبار أنواتهم المفترض تأملها من أبعاد ومساقط ومسافات مختلفة لإضفاء شيء من الدينامية في رؤية الواقع فسعد الجوير - مثلاً - لا يحضر كبطل ذي ملامح كويتية، بقدر ما ينسرد من خلال " آخر " اختراقي لطبوغرافيا المكان والشعور المتأتي من الإقامة فيه، وذلك باعتماده خدعة بيراندلو في مسرحية ست شخصيات تبحث عن مؤلف، فسعد يتم تمثيله من قبل شخص آخر، أو بمعنى أدق الإيهام بتمثيل ذلك الشخص، حيث السارد الذي يحاول إثبات حضوره وغيابة في النص شخصية شخص غائب يبالغ في الإيهام، وذلك ضرب من التواري الذي يشبه لعبة الحضور داخل الغياب عند ابن عربي، كما تتمثله بثينة العيسى أيضاً في كتابتها المموهة عن أبله حصة " سيصبح غيابي فيه بطولة ... أريد أن أشعر بي في غيابي ... لن أحضر في النص، أي شيء إلا أن يطفو وجهي المهرج أمام قارئ حذق ... لن أظهر، ستظهر هي فقط، ستظهرني من خلالها ... أريد هذا النوع النبيل من الغياب " أو هو التلاشي الذي يضفي على الذات حضوراً تأثيرياً كما عبّرت عن برازخه هديل الحساوي " ستعبرين ثلاث مراحل، لحظة التوحد مع الذات ... لحظة فناء الذات ... لحظة اللا ذات ".
إذاً، كتابتهم منبثة من داخل الأشياء، وبأدوات مشحوذة معرفياً، ومرئية من منظور " الآخر " وهذه دلالات حداثية تخترق الذاكرة الاحتياطية المشتركة للجماعات وتربك نظام التمويهات، كما تعيد تموضع الذات على خط الزمن، بما تحمله من بذرة التشكيك في فاعلية المرويات القديمة وقدرتها على قراءة التاريخ وتفسيره، حيث يعيد سعد الجوير التموضع قبالة الموروث التاريخي ليخلد تاريخ الغوص بإحالة تمثال رجل نحاسي صغير الحجم معمول بدقة وتقنية عالية إلى رجل أسطوري علّم أحفاده إخراج كنوز القاع، ولهذا السبب هم اليوم في بحبوحة معاشية، فيما يبدو إقراراً بالمديونية للأسلاف، ومحاولة لمغايرة النظرة في مسألة تلقي المروية " هل يا ترى ثمة علاقة بين ما تلوث وما رأيت؟ هذا احتمال لم أستبعده بعد، ومر بخاطري، لو أنني تشجعت مرة أخرى وحزمت أمري على رؤيته من جديد، سأحاول القراءة مرة أخرى " تماماً كما تتمثله بطلة هديل الحساوي بمراودات حفرية تحدث شروخاً في قدسية المروية " الاختلاف يأتي فقط في سير الحكاية، لكن حكاية الموت بالماء ثابتة. ما حدث ليس عليه أن يقرأ كما حدث؟ " على اعتبار أن تجديد التلقي بتعبير ياوس، إن هو إلا محاولة لتجديد شكل استقبال الحياة وتاريخ الآداب، أو إعادة تشكيل أفق إنتظار، مغاير ومتجدد بالضرورة.
هكذا ضاقت هديل الحساوي بهوامات المروية الكبرى، وصارت تبحث لبطلتها عن مدار أوسع، وأكثر إقناعاً " ما أن أحاول النوم حتى أرى نفسي وقد غمرت في لجة عميقة و صوت جهوري لا أعرف مصدره يكرر جملة واحدة يتكرر صداها في المكان: كبرت و المكان بدأ يصغر " ولهذا السبب بالتحديد تصاعد عندها الحنين لمغادرته " كل ذرة فيَّ تحلم و ترغب بالبدء من جديد بعيدا عن الوصاية ". أما بثينة العيسى فقد أفصحت بمنتهى الوعي عن خيبتها في الجوانب الرومانسية من المروية، وعدم طمأنيتها إزاء الماضي كما تمثل في انتباهة بطلتها على كابوس ما احتاطت له " رأيتُ، في تمامِ يقظتي، أن عليّ أن أبذر الأرض، وأن أرض وطني ليست خضراء كما يجب ". ولكنها لا تريد الوصول إلى الكارثة فالأسوأ، حسب تعبير بطلتها " أن تعيش خائباً، أن تعيش عاجزاً عن تبرير خيبتك ".
على إيقاع تلك الصدمة تشكلت ملامح بطلتها، فعروس المطر " أسماء " لا تستطعم " الباجلاء " ولا تسترخي في " الليوان " ولا يحتمل جسدها خشونة " المدّة " ولا تطيق التكفن في " البخنق " ولا تترنح على آهات " اليامال ". إنها ذات معولمة ترتاد مكدونالدز، وتلعب بباربي، وتختزن ذاكرتها شخصيات كارتونية، وتتلذذ بالبوظة، والبسكويت، ورقائق الشيبس المتكسرة، وتستمع لمحطات الاف ام، وربما لا تحب رائحة البحر مثل زوجة ابن مريوم الدلالة الهائم بوسميّة. أما مؤلفتها بثينة العيسى كساردة وروائية فمنقطعة عن حكمة الأسلاف ومتقاطعة في الآن نفسه مع أبوات من عوالم معرفية وجمالية وحياتية مغايرة فهي تقرأ " نيتشة " وتذيب أفورزماته ( مقولاته ) المتعالية في النص، بعد تخفيف وطأتها الفلسفية واسباغ شيئ من مزاجها الخاص عليها، تماماً كما تلهج هديل الحساوي بشذرات ابن عربي، ويتتلمذ سعد الجوير على مأثورات البير كامو العبثية.
إذاً، المروية أخذت صفة الواقع. وهذا الواقع الذي تصفه بثينة العيسى بالعالم السريع جداً صارت " تتداخل فيه الماهيات في فوضى مقدسة ومدنّسة ". وربما لهذا السبب قررت هديل الحساوي بعد اكتشاف بطلتها " مدى رمادية هذا العالم " الفرار ببطلتها التي ليست أكثر من صورة تصفيحية لذاتها إلى مكان/أفق آخر " قبلت الرحلة على أمل التغيير وترك المكان. ما عدت أتحمل التواجد فيه " فهذا الواقع آخذ في الانحطاط، وعندما يحدث ذلك التدهور حسب لوسيان غولدمان، يتحالف الواقع مع الأساطير، خصوصاً تلك المتولّدة من العقل، وعليه يقام ببطء تمثال القدرية القديم، فيما يبدو هروباً مدبّراً من الواقع إلى ما يشبهه أو ما يمكن أن يعبّر عنه سردياً، وذلك هو ما يفسر كيف دخلت بثينة العيسى غرفة " مليئة بالرّبات السومريات والبابليات واليونانيات، كانت في الغرفة إنانا وننخورساغ وعشتار وأرشكيغال وأثينا وبيرسفوني وأفروديت " كما يكشف أيضاً عن سر مصاحبة سعد الجوير لإنكي أنكيدو وكلكامش، ويبرر أيضاً الكيفية والجدوى التي ابتكرت بموجبها هديل الحساوي مكاناً أسطورياً جديدا " داليوب " لتجادل منيرفا وزيوس وأبولو وفينوس وهيراقليطس وأكاسيا وثيوفيليا، ... وهكذا.
باستدعائها القصدي والواعي لتلك الأسماء والخصائص والرموز، قد تبدو هذه النصوص مهجوسة بالتعالم، وإن كانت مسكونة بشيء من ذلك الهوس، إلا أن ذلك التماس المكثف يشير إلى أنها مستزرعة ومنتجة من قبل ذوات راغبة في التعلّم حد الإنقياد للآخر، باستجلابة من التاريخ أو من تعاليات المعرفة المجردة، وأحياناً إبداء الحاجة العاطفية والشعورية له، كما تعبر عن ذلك التأهب بطلة هديل الحساوي " أنا الآن مستعدة للإنصات للحق و الفضيلة حتى في أقوال الآخرين ". أو كما تعلن عن ذلك " عروس المطر " بصراحة لفظية " الآخر دائما هو الطريق ". وفي لحظة من لحظات الحيرة واليأس ترتد تلك الذوات المتكلمة لتبحث عن الآخر من داخلها بكثرة الطرق على المرآوية، كما تفلسف بثينة العيسى خيبتة بطلتها " ما أعرفه أنني سأكون المرآة، سأكون الآخر " أو كما تهتدي بطلة هديل الحساوي بنداءاتها الجوانية " المرآة التي ستعكس صورتك، ستعكس الآخر فيك ... أنا الآخر الذي يسكن داخلك، أدلك على الطريق، فاتبعيه ".
قد تختزن هذه المنتجات الروائية شيئاً من ملامح الصراع بين الأجيال الكتابية، وبعض المراودات - اللا واعية - لقتل الأب ربما. ولا تخلو بالتأكيد من حيل اللعبة اللغوية، أو الإيهام بالتجاوز، فيما هي في بعض جوانبها مجرد لعبة وعي شكلانية، وتستمد بعض انحيازاتها الفنية والمضمونية من دوائر الآخر بل أطيافه، ولكنها بالمقابل تتقاطع مع رؤية لوكاتش في بحث الذات الروائية عن قيم أصيلة في عالم منحط. وبالتأكيد تختزن إشارات جوهرية تدل على التحول ومن ورائها ذوات تعي وتشعر بالتحول، ولو فرغت رواية " باربار " من بناها الدلالية فلن تكون أكثر من حكاية يراد بها " الإمتاع والمؤانسة " كما أسس لها سعد الجوير، وإذا لم يتم التماس الحفري والواعي مع البنى العميقة لرواية بثينة العيسى " عروس المطر " فلن تكون سوى فضفة لا واعية لذات نزقة ومصدومة قبالة سرعة التحولات، وهكذا ستغدو رواية " المرآة - مسيرة الشمس " لهديل الحساوي مجرد تمارين فلسفية لذات صغيرة تحاول أن تتعالم لتعويض عجزها التكويني عن النمو، ولكن القراءة التأويلية لما هو مخبوء وراء ملفوظات هذه النصوص تكشف بالفعل عن دلالات كتابة جديدة، أو وعي روائي مختلف يجهد من أجل مرجعية سوسيولوجية مغايرة، منبثقة من راهنه، ورافضة لسطوة الحقل الثقافي التلقيني المسيطر بكل اشتراطاته الروحية والمادية، من خلال وظيفة وهوية سردية تتعامل مع التاريخ الإجتماعي كمادة خام، يمكن مقاربته بوعي لغوي قابل للتعدد والتأويل إلى أقصاه.
الرواية هي فن التلفت إلى الوراء، حسب ميلان كونديرا، بمعنى أنها طريقة وليس مجرد رغبة أو حنين. وعليه فإن العودة للخلف ليست ممكنة بعد الآن، حسب تعبير هديل الحساوي أو هذه هي النتيجة التي تتوصل إليها بطلتها، ولكن الكتابة الأحدث تعتمد الإرتداد الواعي بالذات للوراء، بحيث تمحو ما تريد وتموضع وعيها حيث تريد، وعلى اعتبار أن الكتابة في واحدة من أهم دلالاتها هي نشاط في حيز القراءة أصلاً، بتحليل رولان بارت، وعليه فإن " الفتاة التي ستولد من جديد " في رواية " المرآة - مسيرة الشمس " مسألة تنطبق على هديل الحساوي أكثر من بطلة الرواية. وعندما تكتب عبارة مثل " طقس تحولك قد تم، و هذا العالم الجديد أنت " فهي إنما تشير إلى إنغسالها من استيهامات الماضي، كما تؤكد ذلك بعبارتها " أقف أمام نفسي أراقب عاداتي القديمة، أراقب حركاتي، سكناتي، بحثي و شقائي و سعادتي ". وذلك نتيجة طبيعية لاقتناعها بأن الذات هي محراب الإنسان، كما أصرت على الإقامة فيه والفرار من هامش ومنفى الآخرين " المعابد كثيرة، و لكل معبد واحد. المعبد داخل ذاتنا، نعرف بالحدس والشعور انه موجود فينا ، ما الداعي لأدخل معبداً خارج جسدي".
إذاً، تعمل هذه المنتجات الروائية مجتمعة كمحاولة لإختراق المنطقة التبسيطية القائمة نقدياً بين الحياة والسرد، للوصول بالقصة كجوهرانية سردية إلى مرتبة الحياة، كما يحلل ادوارد سعيد في " الثقافة والامبريالية " الكتابات المضادة للهويات العزلوية، التي لا تجنح للهيام بالإنسان، لأنها معوّقة بحدود وقيود تمنعها من الانسراب إلى العالم، وعدم الرغبة أو القدرة ربما على الانخلاع من نقاط الثبات الثقافي والتاريخي، وهذا هو الإحساس الذي تحاول أن تلتقطه الذوات الجديدة المتصدية للفعل الروائي، فبثينة العيسى تستشعره وتتنهده بمنتهى الأسى " سوف أكتب كتاباً ميتاً، بلا مخاض ولا أحلام يقظة، سأكتبه دون أن يسكنني، دون أن أترك رائحتي على جلدهِ وبصماتي على رائحته، دون أن يتذكرني أو أتذكّره، إنها فكرة حمقاء ، حمقاء .. بقدر ما هي متناهية المثالية، أن تكتب عن إنسان لكي تسكنه، لكي تنسلخ منك، من جلدك القديم، هل فكرتُ للحظة بأنني إذا كتبت هذا الكتاب، سيتغير شكل ذقني؟ و بالتالي سأستطيع قول تلك الأشياء التي نسيناها والتي ترددها أبله حصة كالتعاويذ؟ ".
ولأنها أقل تطرفاً من الآخرين في الإنزياح عن المروية ظلت بثينة العيسى منفصمة قبالتها، ومنطرحة كوعي كتابي داخل نصها، حيث يظهر تفكيرها بصوت عال في المغادرة والإحتجاج، ومراودة الذات بالإنقلاب " لا أريدُ أن أكتفي بنسخ الورقة الخضراء، أريدُ أن أكتب، أريدُ لهذا الكتاب أن يكون لي، أعني: لي أيضاً، وبدون أن أمثل في النص، أريده بي لا عني، عنها ولكن من خلالي ... سأكتب كتاباً لأنني أريد تغيير حياتي، ولكنه سيكون كتاباً رديئاً و نتناً مثل جيفة، لأنه مكتوبٌ بدمٍ ميّت . ماذا أفعل ؟ ... ربما كانت الكتابة هي الفعل الوحيد الذي ما زال بالإمكان اعتباره غير ملوث بلهاث التسارع، خارج هذه النافذة وهذا الحائط الذي يحتاج إلى صبغ والباب... إن ما أفعله جريمة، أنا أحوّل الكتابة إلى فعلٍ غير أصيل، إلى مكعب مرق دجاج! ".
وبالتأكيد لا تملك هذه الذوات الروائية حلاً جاهزاً، ولا تعي بدقة ما تبحث عنه بقدر ما تعيش من خلال حضورها النصي علاقة استبدالية مع المجتمع محتّمة برؤية تعكس رؤيتها للعالم وتراتبيتها الإجتماعية، كما تفسر سوسيولوجيا المضامين تلك الصلة الغائمة، حيث يصبح اللا وعي هو الوعي بعينه، حين يسقط في اللا وعي الجمعي، ففي النهاية لم يسرد الروائيون شيئاً بقدر ما تدربوا على الكتابة، كما يتوضح ذلك عند بثينة العيسى مثلاًً، لأنها تدخل الرواية ببطلة مفعمة بالمثالية التجريدية مع وعي قاصر قبالة تعقّد العالم. ولأنها لا تريد أن تكتب موضوعاً، بقدر ما تطمح لتجسد شعور، تبدو روايتها مستزرعة بعلامات مضللة وكأنها مجرد تفكير في الكتابة " هذا ما نفعله منذ ساعتين: ندشن مسافة كاذبة بين النصّ الذي كتبته والراوي ". ويبدو أنها لم تنجح في الكتابة كما تطمح عن أبله حصة لأنها لا تؤمن بالجغرافيا والتاريخ، قدر إيمانها بالحب، فقد كفّ العالم عن كونه جغرافيا للاكتشاف، حسب تعبيرها، بينما يكفل الحب بما هو إنساني تحقيق الأسطورة الذاتية، وهنا مكمن خيبتها " إنها لم تخبرني بذلك من قبل لأنها لا تريدُ الحبّ مادّة في سيرتها، ربما لفرط خصوبة المحتوي، أو لفرط عاديّته ".
وهنا بالتحديد يكمن أهم مآزق الكتابة الروائية الكويتية الحديثة، فالهوية التي يحاول الروائيون القبض عليها في لحظة صيرورتها ليست قارة، بقدر ما هي آخذة في التشطي، حتى الواقع لا تبدو مقاربته سهلة، فهو حاضن مجرد أو مظهر وحسب، بتحليل ناتالي ساروت للحالات الملتبسة المستعصية على الاستيعاب المفهومي أو الجمالي، التي يوكل للسرد مهمة القبض عليها، أو هو المجهول والمحجوب الذي تتوجب رؤيته كمرجعية سوسيولوجية، وهنا يكمن السر في لجوء بعض الروائيين إلى واقع عادي يمكن من خلاله استخلاص واقع جديد، تتحطم بموجبه العادات الشعورية واللا شعورية التي تحول دون إدراك جوهر الواقع الجديد، والتعبير عنه.
هكذا جاءت تلك الروايات للتوفيق بين ما يسميه رينيه جيرار " الأكذوبة الرومانسية والحقيقية الروائية "حيث الذات لا تنكتب، والمروية الكبرى لم تعد مغرية، بل هامشية، وحيث " الذات " بتعبير بثينة العيسى، طافية تتأرجح بلذة، موجوعة بين عالمين " مثل قطرة زيت فوق قطرة ماء " أي التيه الوجودي قبالة تذبذب بوصلة المرجعية السويولوجية، وعدم استواء ملامح الذات الجديدة، من حيث علاقتها بمجرات تأثير التاريخ والواقع، وذلك ما يصفه لوسيان غولدمان بالتعالي العمودي، أي الوعي بتفاهة القيم وموتها العام والتطلع الرومانتيكي الى قيم مجهولة وخفية في آن واحد.
www.m-alabbas.com
m_alabbas@hotmail.com