-1-
( قال أبي : سيرحلُ الشتاءُ والصيفُ عن العالم، والأرض تُدفَعُ إلى قدمِ كاهنٍ، تسجدُ فينهرُها وتغيبُ. لبثنا وقتَها حيارى فلم نسألْ عن قدم الكاهنِ، ثم نمنا بين يديه، كلٌّ يرى قلبَهُ يبكي، وكلٌّ لا يموت.)
كمال سبتي
قصيدة
مكيدة المصائر
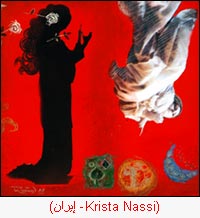 يعدّ النص المفتوح فضاءً رحباً مجدياً للتجريب الكتابي وبالذات الشعري. حيث وجد فيه الشعراء ضالّتهم المحببة في ملاقحة الأجناس الأدبية مع بعضها ليتمخّض عن هذا التلاقح نص يحتمل هول مراميهم للإطاحة بجبروت تقاليد الكتابة والقراءة السلفيّتين على الدوام. لما يمتلكه من خصوبة دائمة لأجراء تجاربهم الكتابية التي لاتركن إلى الثبات بل إلى التحول المتواصل من منطقة اشتغال إلى أخرى، بحثا عن الكامن والمستتر فيما وراء القادم، وإعادة قراءة الفائت بآليات جديدة متحركة لا ثبات لها ولا ركون ولا انصياع للمصدات والموانع والقوانين والبداهات.فما عادت كتابة الشعر تخضع لتوصيفات سوزان بيرنار أو غيرها. ولا يمكن لشاعر مبدع أن يضع أمامه رؤى وأفكار هذا الناقد أو ذاك. أو أن يتبع خطى شاعر ما.مهما علا شأنه أو ذاع صيته لدى الذائقة الخام. وأغلب الشعراء يعون هذه الحقائق، غير أن قلة منهم يخلصون لها. أي بمعنى أنهم ينتمون للشعر وحده لا لشيء آخر قطعاً فتراهم ينصرفون إلى (مشغلهم الشعري..التعبير من مقال للشاعر كمال سبتي) لتقليب جمرات البوح على مواقد التجريب، بغية اكتشاف لحظة منسية أو همسة مهملة أو فسحة وعرة، كيما يفتحوا إطلالة جديدة تسهم في استيعاب اندياحات منجزهم الإبداعي الذي من أجله يضحّون.فلا قيمة ولا اعتبار عندهم إلا لهاجس الشعر. ولا يثقون إلاّ بحواسهم فقط.ولن يمرّ يومهم دون أن يقتنصوا منه لحظة واحدة، لحظة ربّما تكون زمنا هائلا لمشروع كتابة. وبعضهم قد لا يحسنون العيش معنا.أو أنهم لا يطيقون ما يحدث من تزويق اجتماعي لشدّة وفائهم لصدق المشاعر المفضي إلى إنسانية الموقف. غير أنهم بارعون أبداً في الإخلاص لآلهة الشعر، والولوج إلى أفدح الأماكن غربة وأكثرها وعورة " من أجل فضح خصوبة النص أملاً بتحريض نهم القراءة المفضية للتأويل الكفء في تناسله إلى قراءات شتى.
يعدّ النص المفتوح فضاءً رحباً مجدياً للتجريب الكتابي وبالذات الشعري. حيث وجد فيه الشعراء ضالّتهم المحببة في ملاقحة الأجناس الأدبية مع بعضها ليتمخّض عن هذا التلاقح نص يحتمل هول مراميهم للإطاحة بجبروت تقاليد الكتابة والقراءة السلفيّتين على الدوام. لما يمتلكه من خصوبة دائمة لأجراء تجاربهم الكتابية التي لاتركن إلى الثبات بل إلى التحول المتواصل من منطقة اشتغال إلى أخرى، بحثا عن الكامن والمستتر فيما وراء القادم، وإعادة قراءة الفائت بآليات جديدة متحركة لا ثبات لها ولا ركون ولا انصياع للمصدات والموانع والقوانين والبداهات.فما عادت كتابة الشعر تخضع لتوصيفات سوزان بيرنار أو غيرها. ولا يمكن لشاعر مبدع أن يضع أمامه رؤى وأفكار هذا الناقد أو ذاك. أو أن يتبع خطى شاعر ما.مهما علا شأنه أو ذاع صيته لدى الذائقة الخام. وأغلب الشعراء يعون هذه الحقائق، غير أن قلة منهم يخلصون لها. أي بمعنى أنهم ينتمون للشعر وحده لا لشيء آخر قطعاً فتراهم ينصرفون إلى (مشغلهم الشعري..التعبير من مقال للشاعر كمال سبتي) لتقليب جمرات البوح على مواقد التجريب، بغية اكتشاف لحظة منسية أو همسة مهملة أو فسحة وعرة، كيما يفتحوا إطلالة جديدة تسهم في استيعاب اندياحات منجزهم الإبداعي الذي من أجله يضحّون.فلا قيمة ولا اعتبار عندهم إلا لهاجس الشعر. ولا يثقون إلاّ بحواسهم فقط.ولن يمرّ يومهم دون أن يقتنصوا منه لحظة واحدة، لحظة ربّما تكون زمنا هائلا لمشروع كتابة. وبعضهم قد لا يحسنون العيش معنا.أو أنهم لا يطيقون ما يحدث من تزويق اجتماعي لشدّة وفائهم لصدق المشاعر المفضي إلى إنسانية الموقف. غير أنهم بارعون أبداً في الإخلاص لآلهة الشعر، والولوج إلى أفدح الأماكن غربة وأكثرها وعورة " من أجل فضح خصوبة النص أملاً بتحريض نهم القراءة المفضية للتأويل الكفء في تناسله إلى قراءات شتى.
والشاعر كمال سبتي هو واحد من أهم الشعراء العرب، جال كثيراً في خارطة الشعر وخبر تضاريسها وعانى كثيراً من أهوالها، دون أن يفقد قدرته على التجريب المتواصل بحثا عن الشعر لا غير.وراح يجرب ويجرب في مشغله الشعري بحثاً عن جوهر الشعر.فأصدر (وردة البحر) بغداد 1980 و(ظلُّ شيءٍ ما) بغداد 1983 (وحكيم بلا مدن) بغداد1986 و(متحف لبقايا العائلة) بغداد 1989 و(آخر المدن المقدّسة) بيروت 1993 ثم كتابه الذي بين أيدينا (آخرون قبل هذا الوقت) دمشق 2002 والمتبوع بكتاب آخر لم يصدر بعد بعنوان (بريد عاجل للموتى).
وما (آخرون قبل هذا الوقت) إلا مدخل واضح يؤشر انزياحاً رؤيوياً في مشغله الكتابي الموزع على مراحل حياته المريرة التي أثخنها "الآخرون" الطارئون على حياته جراحاً وأسى، والمارّون عنوة على جسد تطلعاته لما هو حلمي وشفيف، والذين يغيّبون الوقت عن ذكراه، كانوا يتسمّعون غناءه، يحرسون سجينا ملقى على القش، والذين دفعوا به للهروب إلى المنافي أو أقاصي الذّبول.إذن هو بوح الشاعر - عن ومن ونحو - التاريخ. عما جرى له ولأمثاله من المبدعين. ومنه ينهل الرموز والمناخات السحرية ولكن نحو كتابة تاريخ آخر، يستبطنه نص مشفّر عبق بنفحات الموروث، لينبعث أسطورياً من جديد. وهو حلم يراود كل راء جاد لكتابة النص الأسطوري الذي ينطوي على أسرار خلوده. البحر مفتتح لغربة الشاعر، ومشهد مؤثر ومحفز لمخيلته كيما تنداح صوب الفائت بخفة وحيوية، لتفشي أسراره وتنهل منه في آن.
(الشتاء قرب البحر. أخرج طيّعاً لدموع الساحل فينبئني الصيادون نبأ البحر. لم يصل النعش بعد. أصغي إلى عجوز ترسم عكازاً على الرمل، وإلى حانة الساحل مهجورة من الساحل. لا غريب سواي إذن ولا قبر سوى قبرك.مأتم تسمّعَهُ البحارة ليسألوا العجوز عمّن لم يهلك بعد.) ولا غريب سوى الشاعر الذي سيهلك في جسده (النعش ).المكان هو البحر، الزمان قبل الآن.. حيث ذكرياته عن البلاد التي تطرد الحكمة بالسيف وتدمي الفضاءات بالسجون. على البحر تبدأ غربة الشاعر مع دموع الساحل المهجور والعجوز والحانة، لتهيمن على المشهد موضوعة انتظار المصير. لم يصل النعش بعد. ولم يبق غير سفن الذاكرة المحملة بعبق خيال الشرق الساحر والحكايا التي تستمد أجواءها من الأدب الشفاهي للذاكرة الشرقية. شاعر الحكمة والسجين وسلطة القمع مفردات تتكرر على مرّ التاريخ العربي والإسلامي. ما جرى له سبق ان جرى لغيره من الشعراء وبالذات أهل الزهد والتصوف وتحديداً الحلاّج.(أسمع في الحانة حكاية عن خاتم مسحور.تقول فتاة : هو خاتمي، مرة عند باب القصر رأيت جواري يحلمن ببساط الريح، وسمعت غناء" لشاعر جوال ينام ليله الصيفي على صخرة الينبوع.) رحلة هروب الشاعر إلى سواحل الضياع.(الضائع في سفر يهزم كل مرة.) خاتمه فكره الذي ما روّضته السلطة رغم شموليتها، ورؤاه الشعرية التي تضحك من شطارة الشعراء أمام باب القصر.وهو كنزه المعرفي الذي يدسّه في جيبه المثقوب الرابض على جسد نحيل غازل الحانات كثيراً. (عندي خاتمٌ لغزُ آلهة تسجنه الدولة في جسد يعرق في الصيف ويبرد في الشتاء، وقد يموت في الحانة كالسكران.) الأحدب ظل الشاعر يشاركه رحلته الصوفية ذات المشاهد التي أخرجتها مخيلته السينمائية وبرؤية غرائبية حيث المدينة القروسطية وسعيه إلى كتاب الحكمة.(نختلف إلى زقاق آلهة خرساء، واقفة على ارض زرقاء كالسماء..كتبتُ عن المدينة : كلما سعيت إلى قلبها خرجتُ منها مُشرّداً.)
التشرد كان ملاذه النقي وما عداه زيف ودجل. (ها نحن في الشوارع، يارعية الملك، نساء الملك، رجال الملك.) ويستمر في سرد ذكرياته عن البلاد التي يراها مثل بيت بلا سقف ولا باب.يعرض للسماء خجله..حائطه كتاب يقرأه رجال الأمة في العسر وينسونه في اليسر. بلاده أو بالأحرى سجنه، قبو سقفه حائط بلا كوة لخداع سماء بالشكوى. ويا لهول كارثة الجور في بلاد تعبد قيودها السلفية بشراسة لا تطاق. ويا لحنق الشاعر وسخريته من التراث الغيبي اللعين وعبودية العامة لأهرامات الوهم والخديعة : (الظلام غيب رضعناه من ثدي وتعلمناه في درس، فإذا خف ظنناه سيشتد، وإذا اشتد ظنناه قبة تتفتح عن رجل عليه دم وحبر الكتاب، وعليه السلام، الظلام إمام.) وقبل أن ينهي رحلة الفرار الخيالية، يلعب مع التلقي لعبة التخيل في ريازة عوالم ما ورائية. (أضرب الأرض بالخاتم، تنشقّ عن عربة قمح نهاراً، وحصانين في الليل..يتبعنا كلب ).وهنا إشارة إلى أنه ظل مطاردا من الجلاد رغم فراره منه.وينهي دورة النص بمقطع يعود إلى بدايته وبه يفشي لنا أسرار لعبته الكتابية الممتعة حد اللذة، حسب فوكو. (ما كنت أحداً أبعد من قبره، ما كان قبره بيت جسد مات.) -خاتمة قصيدة آخرون قبل هذا الوقت _.
قصيدة (مكيدة المصائر) تشير إلى أن الكون غابة. في الليل ينام القطيع ويبقى المشردون مدمني سهر الأرصفة. ليعدو النص إلى ما حفلت به حياته من تشرد. فيبدأ من غربته أيضا في ممارسة لعبة الاسترجاع مستعيناً بمهيمنات ذاكرته، لاكتشاف أسرار لغز الموت الذي ما زال يطارده وعائلته إلى الآن. فمنذ طفولته خذل نبوءة الأطباء بموته الحتمي بتعافيه المتواصل من ميتات متعاقبة. (ذلك ما كنته منذ تعثرت بنفسي في بيت الجراحين، أصغي إلى سرير مدمى تحرسه أقنعة الحديد، لأعرف أن ميتاً قد كنته سوف يهرّب إلى قبر.) لكنه يشير في النص إلى ما كان يعانيه خلال الكتابة.وهول صعوبات الخلق الشعري خلال زمن الكتابة. (خذلت نفسها هذه القصيدة، خذلتني معها. تتشبه بالصيادين فينفر الكلام، وتغازل أعمى الريف فتنهرها الطبيعة.)
ولشغفه وتماديه في قراءة آداب الشرق، ولمعرفته بكفاءة أداء الأدب الشفاهي، نجده يخلق مشاهد هي بذات المناخ الأسطوري الأخّاذ. (ما كان البيت يتهدم. يخرجون من الكتب الهاوية من رفوفها. ملء عيونهم سراب..وبخواتم عتيقة، سيشيرون إلى الباب الكبير، إلى وجوهه النحاسية. يومئون أن ادخل، ماشيا على سجادة فارسية وبيدي ناثرة الطيب. سأراه جالسا على كرسي خشبي، أقبّل يده حين يأخذ برأسي إلى صدره. سيناديني : حفيدي، وسأغرق في ذلك النهر برهة.. ويهديني خاتما من بلاد الهند، وقبلة على الجبين وآية من الكتاب.) ويستمر في الاستعانة بذكرى أمه التي يقدسها حباً، والتي شكل لديه موتها المبكر عقدة أثرت في أغلب نصوصه. فيعرض من خلالها موته المتوقع مع إخوته ابّان الحرب.تلك المتاهة الكوارثية التي مرّغت أنوف أجيال متعاقبة بسبب نزوة (دكتاتور) هائج. (ما كان البيت يتهدم.كان جنود أربعة يخرجون من المضيق إلى المضيق. وكان سحرة جوالون يترصدون ميتاتهم.) ويستعين بأبيه لينهل من طيبته حكمة البقاء. (قال أبي : نجمتان اثنتان تخرجان لكم في الشتات، أشهروا الكف عاليا.. تبكيا، واسألوهما عن كل مضيق.. تخرجا بكم من مكيدة المصائر، قلنا فلتشر إلى النوم كي يكون كلاماً لنا، قال : قد أشرت، واندفعنا خارج البيت في طرق شتى، كلّ يرى قلبه يبكي، وكلّ لا يموت.) ويستمر في عرض فنتازياه الساحرة بعدسة روحه الأثيرية.غير آبه بقدرة التلقي على التواصل مع هذيانات الصور الغرائبية.
فالذي جرى من أحداث لا يطاق ولا يحتمله جسده الناحل. فراح يفشي نواحه، أنغاما موجعة. وبروز من فداحة يباب وجوده، فراديس مروق صوب عوالم ما ورائية، ما كان لها ان تكون لولا مران مخيلته على عبور أكثر المسالك وعورة وضراوة. لينهي النص بعودة دورانية إلى البداية وكأنه أدركه الصباح : (نام القطيع أيتها الغابة. واكتملت رحلة القبر..وميناء ذلك البحر.. كان ذكرى عثرة غابت عن صديق الصدفة ويهودي البار.إذن.. فليسكت النوم عن الكلام.)والجملة الأخيرة رغم تركيبتها السريالية، فهي تحيلنا إلى سكوت شهرزاد عن الكلام المباح.
-2-
(تحملني الريح عالياً، تلقي بي قرب الجسر، أسأل الساحرةَ : ما كانت تلك البلاد ؟ تقول : بلادي وبلاد من وهبتهم كتابً المُلْك، وأنتَ فيه ميت، ومن تشبهه ميت، ومن غابَ ومن يظهرُ..)
كمال سبتي
قصيدة
حكاية في الحانة
ما أكثر حكايا الحانات. ويا وسع المخيلة في طقس الحانة. اذ تنفتح على أقصى وأغرب الأمكنة والأزمنة والحوادث والشخوص. لا رقيب لدى الشاعر في تعاقب المشاهد ولا يأمن إلا لمران المخيلة في اشتغالها الاسترجاعي للفائت من الأحداث. ولصدق الهواجس في التصدي لواردات الذاكرة بشتى مهيمناتها المشهدية ولقدرته اللغوية على تشكيل القناع الجمالي المتين للنص، ذلك التشكيل المتأتي من انتقاء دوال ذوات تشفير متوهج ذي طاقات أدائية عالية على تحفيز مجمل آليات منظومة القراءة.
و (حكاية في الحانة) لا تخرج عن سابقتيها في هيئة المثول أمام التلقي. فالآخرون هم الآخرون الذين يحركهم القصر باختلاف مواقعهم النفعية وبشتى مؤسساتهم القامعة للنصوص والرموز الإبداعية. (كان للملكة خدم تجسسوا عليّ يوم تسللت إلى حديقة القصر لأسمع جاريتها أشعاري.) ويومئ بوضوح إلى أدباء السلطة (السعداء) بمكرمات القصر. وضباط المخابرات وتحقيقاتهم الإجرامية. (كان سعداء قد شتموني بالجنون في حفل تقليد الأوسمة. وكان قضاة قد استحلفوني للشهادة في قتل الملك.) وعن كونه كان يغرد خارج سرب المداحين الذين كان يسخر منهم ومن متوسلي الأوسمة في (حفل العدو السعيد) يشير : (كنت لا أشبه أحداً غير النوم فقد كان قناعي. ضحكت في نومي من الشعراء يصرخون، ومن أبطال يتوسلون أوسمة.) لقد كانت أدبيات ومناهج ومؤسسات الدولة القمعية تلوح بالفناء لكل مبدع معرفي. (قالوا ما كنا مثلك أو مثل من تشبهه.كانت ساحرة أتتنا من وراء جبل قد وهبتنا كتاب الملك فحفضنا فيه أنك ميت، ومن تشبهه ميت، ومن غاب، ومن يظهر.) رغم هروب الشاعر إلى خارج البلاد ظل الموت يلاحقه، لأنهم يتبعونه أنّى يكون. (بعد كأسين ستنام المدينة. سأفتح عينيّ وأغلق فمي. فلا أخرج وحيداً، ولا أدخل في زقاق ضيق، وإن نادتني امرأة من بيتها فلا أستجيب، ولا ألتفت يميناً أو يساراً، وإن رأيت ميّتاً فلا أتعرف إليه، وإن سألوني عمّا رأيتُ لن أقول شيئاً حتى أصل البيت.) وخلال سرده الاسترجاعي الفنتازي يتشظّى الراوي (الشاعر) إلى عدة رواة. وهم رموز البث المعرفي لشخصية الشاعر خلال تحولات أزمنة العسف التي مرّ بها. فالشاعر المؤرخ هو الضحية وسجين القش والقاضي. ولشد ما توغل في أبهارنا مخيلته الغنّاء العبقة بسحر آداب الشرق. فالمخيلة الساردة تلبس المشهد زياً سحرياً مدهشاً لتبعده عن يباب واقعية الحدث. (أرى طيفاً يشبهني، أقدم إليه ربيعاً وناياً، يعيد إلي الربيع خاتماً مسروقاً من جثة طافية فوق النهر. كان الطيف جندياً من جنوب الحرب، أسمعني حكايته فبكيت، وذكّرني بالعتبة والمحراب فخرجت من الحانة لأشتم صباح الدولة والمؤرخ والخدم السعداء.) ليتحول بنا الشاعر من مشهد إلى آخر دون أن يفصح عن تناص غير محبب مع آليات اشتغال نصوص ألف ليلة وليلة وما تلاها من نصوص الأدب العربي الحافلة بالسحر والحكمة والبوح الرؤيوي الأخّاذ. (لأرى ساحرة قرب الجسر، موقدة إناء بخورها، قارئة طالع كل مصير بثلاث حصى فوق عباءة. أسألها أين كتاب الملك ؟ تنفخ في وجهي فتحملني ريح عالياً.. تلقي بي في بلاد ما كنت عرفتها قبلا.) فيما يلي من وصف خيالي للبلاد يستبطن إسقاطات لفداحة مأساة بلاده قبل الآن، والتي حاك خيوطها الآخرون أعداء الحكمة والضوء ومن بيدهم كتاب الملك : (رأيت المسنّ جاهماً، أخرس، لا يقول حكمة، والمرأة تضع جنينها فوق صخرة، حتى يأتي حيوان ضخم يبتلعه وقتاً، ثم يعيده إلى المرأة، ولم أر بيتاً يجاور بيتاً، رأيت الماء لا ينبع من ماء ولا يسيل إلى ماء، والشجر يثمر فلا يسقط ثمره إلى الأرض، رأيتهم لا يضحكون، ولم أسمع لهم كلاماً، وما غنّوا وما رقصوا، وما كانوا يبكون.) تتواصل المخيلة في التمتمة أمام جلال الحكمة، حتى نشيد الخاتمة الذي يعيدنا إلى مفتتح القصيدة - كتدوير كتابي - والذي يعلن فيه انصرافه التام للبحث عن أسرار حكمة الوجود في شغله الكتابي وملامسة أرقى وأنبل القيم الإنسانية دون الركون إلى ما هو يومي ورتيب ومبتذل. والاشتغال على مبدأ التجريب الإبداعي المستمر. وترفّعه على إغراءات المنفعة ومقارعته لثيمة الفناء التي تلاحق إنسانيته وحكمته على الدوام. (أعلى من الحياة قلبي، وأعلى من كل مقبرة.) وإذ يسترجع وجوده قبل المنفى، يعرض حطامه المنضّد في هيكل محترق يتوقّد وجداً وحكمة ورؤى تبدد دخان الحروب الموغلة بالنشوب. (أتذكره وحيدا، متربا بين جيشين، يقاتل ما لا يدريه)... ليعلن في النهاية صرخة احتجاج تنثال مدوية في دهاليز الآخرين : (قلبي هذا الذي تشعلون.. قلبي.)
أمّا في (البلاد) فالمخيلة تتحول إلى عدسة تنهب لقطات مختارة من أروقة الماضي، عدسة تتحرك بهاجس وتجربة الشعر وبمهارة وفطنة السينما. (القارب الذي لاح لي في النهر كان جثة.. أنكفيء إلى سعادة شباك.. يصهل حصان الذهب والفضة.. يرتجف الفنجان، يلطّخ بالقهوة خريطة مهرّبة..) تتوالى صور الذاكرة، وبحرية،لا رقيب سوى أمواج العواطف، لتنتهي بأبشع لقطة هي، صورة الذئب الطاغية أو الطاغية الذئب والخارج بالجنوبيين لحروب نزواته الدائمة. (يناديه الموتى : مت معنا، فيتنكر في هيأة غبار يشتمه الدم الغارق تشتمه عربات الموتى والعباءات.) ثم يشرك التلقي في لعبة التخيّل المعمولة بمهارة، بافتراضه إيقونات جمالية للمهيمنات الظرفية للفائت والتي عملت على صنع منفاه : نمر من خزف / طاووس نائم / ديك شمعي/ سلحفاة. تبدأ اللعبة السردية بأنسنة الأشياء - حوار العباءة - المفضي إلى حوار السلحفاة ثم صعود الشاعر إلى منفاه. (أصعد ورائي حطام العربات والغرقى، وأمامي قامة الأفعى.) وتنثال الذكريات متألّقة من حاضنة مخيلة ذات مران عال على تهذيب هذيانات الروح العبقة بنسائم أنبل المشاعر وأرقى الأحاسيس الإنسانية. (أصعد، تسمعني طيور النهر سلاما، يصادفني طيران، يحطان على كتفي، يدلاّن الماعز على العشب، ويغنّيان للرّعاة أغنية عن بنادق معطوبة.) إن منجز الشاعر الإبداعي وصراعه المرير مع الطارئين على حياته اجتماعياً وثقافياً، ينمّان عن مدى شغفه بمشروعه الرؤيوي للشعر، دون التعكّز على ما هو غير إبداعي. (ما ادّعيت أباً ولا شهرت سكّيناً في خيمة الليل لأقتل زائراً.. أرضى بشفيع لا يرى، أيمّم دمعي لغيبته، وأفسّر معناي بذكراه.) في حواره مع الشيخ الذي يأخذ بيده، في مشهد ذي مناخات صوفية، يصف هول معاناته بحثاً عن الخلاص من الكارثة : (أو لم تحلم ؟ أقول بلى. مثلت بين يديك شاهدا فأنّبتني، ومحارباً فغرقت قبلي، يقول : اصعدْ إذن.. لقد رأيتَ النور.) تمر أمامنا المشاهد وهي تشير إلى ماض حالك فيه الألم والدمع والدم لأن التراب خائن والماء خائن وما نطق النهر بما رأى لشراسة القمع. وقد أفاد الشاعر من لعبة السرد في الحكايات الخرافية، من اجل توريط التلقي في التواصل مع - أساطير نصوصه هو - دون ان يحدث نفوراً من آليات بثّها، فاتحاً أمامه إمكانيات شتى لابتكار مشاهد جديدة . في يدي طبيعة أنفخ فيها فتتراءى لي.. انفخ في الطبيعة ثانية فيخرج رأس بأربعة عيون.. أنفخ في يدي ثالثة فتتراءى لي قبائل. في لعبة اليد هذه، يمارس الشاعر (السارد) سلطته على التلقي لإيصال ما تنتجه مخيلته من استرجاعات مشهدية ، عن البلاد التي تشبه بئراً أو ربما كهفاً أو ربما مقبرة ، لأنّ السيد الموت فيها هو هاجسك المرير انّى رحت وانّى حللت. (ما كان للشفتين إن تحرسا تابوتا أو تخفيا سرا. ما كان لظلمة إن تنفتح إلاّ بظلمة. تلك هي حكمة صاحب الكهف.) وكعادته يعود بنا إلى مفتتح القصيدة والقارب (الجثة) وما تقول السلحفاة : (كل قبر باب إلى القبة كل شمس وكل ذهب.) ليثير معنا تساؤله الكبير عن لغز الموت الذي حيّر البشر. (يا ذكرياتي بماذا تتعطّرين حتى تتحمّلي رؤية قبر كل حين ؟)
بعد تجوال عجول بين ثنايا أربعة متون تنضّدت تحت ثريا (آخرون قبل هذا الوقت) الأسطورية حقاً بجدارة الاشتغال البنائي الرصين، على المستويين الدلالي والشفروي. نخلص إلى الوقوف عند أهم آليات البث الأسطوري للنص الشعري قيد الدراسة.
لكل نص لغته وشخوصه ووقائعه. والواقعة تبقى حبيسة حدودها التاريخية لو لم تتوفر لها عوامل (أو محرضات أو موجهات ) أسطرتها ومن ثم بثها عبر أثيرية الذاكرة الجمعية ( تلك الحاضنة العجيبة لأسفار العصور). وأهم هذه العوامل هي الطقوسية والتداولية والغرائبية والمبالغة والتضخيم والتقبّل الزمني لها، أي صمت الزمن - تاريخاً وشهوداً - حيالها، لتأخذ طريقها الأسطوري في الذاكرة. لقد أفاد الشاعر من الواقع العراقي المرير والذي كان أغرب من الخيال - بحكم لا معقوليته علينا - وأحدث مواشجة بينه وبين وقائع القرون الوسطى ذات المناخ الأسطوري. يتضح ذلك من خلال آليات السرد التي تتخلل المتون المفحوصة. والتي تتعالق مع آليات الموروث في الأدب العربي الكلاسيكي. وبهذا أخرج الواقعة من حدودها التاريخية إلى آفاق الأسطورة.
الزمان لديه - اختراقي - فالمشهد ينفتح على أبعاده الثلاثة، ويرغم التلقي على قبول هذا التشظي الزماني بمودة مقنعة. لما لهذا التداخل الزمني من جدوى في إسقاط مجريات واقعة ما على واقعة أخرى وفي زمن آخر. أي بمعنى إجراء مقاربات زمنية للوقائع والأحداث. المكان لا ملامح له. أنت في مدينة تحضن الموت والجوع وأقبية الظلام وسحر الحكمة وجنون السلطة. مدينة تشبه ولا تشبه بعض المدن. مدينة تتحرك معك إلى كل الأمكنة. مدينة ريازتها مأخوذة من بطون الأدب الصوفي، لتنفتح على أبعاد أكثر كونية. وهذا يتّفق مع ما ذهب إليه إدوارد سعيد في كتابه الآلهة التي تفشل دائما (المهمة بالنسبة للمثقف، كما أعتقد، هي بشكل صريح تعميم الأزمة، هي إضفاء مدى إنساني أعظم إلى ما عانى منه عرق أو أمة ما على وجه التخصيص، وربط تلك التجربة بآلام الآخرين). الشخوص مقنّعون كاحتراز كتابي جمالي (أيقوني وثيمي) يرسل إلى التلقي شفرات عاليات الكفاءة لتحريض منظومة القراءة ومن ثم التأويل الخصب. كل ماتقدّم لن يحدث لو لم يتوفر الشاعر على لغة ذات إيحاء مؤثر متأت من الانزياح التشفيري للمفردة عبر تجاورها الحداثي مع المفردات الأخر لإنتاج منظومة البث السيميائي الداعم للثيمي في سياق الخطاب العام. وهذه الشفرات : التأويلية والدلالية والرمزية والتخمينية والحضارية - حسب رولان بارت - لا تؤدّي وظائفها كما يجب من دون مخيلة ذات قدرة ومران على توليد نصوص ذاكرة محتملة ومتعددة - مشاريع ما قبل الكتابة - تلك المشاريع التي تسمح بانتخاب نص يستبطن بلاغة حاضنته الأم (المخيلة). بلاغة صيّرتها ابحارات مضنية في الموروث بمجمل مكوناته اللغوية والتاريخية والاجناسية والسياقية وغيرها. بلاغة قادرة على رسم مشاهد تقترح مشاريع تأويل لا تحد : (تمحو الريح أسماءنا. التراب خائن، والماء خائن. نودعها قبراً. نهرّبها بالعيون لا بالشفاه. يظنّها الثعلب شرودا، والمستكشف نظرا شزرا.. تحيا اذ ننام، نبصر بها ممراً أزرق إلى سفح، ينتظرنا حصان طائر وإخوة فرسان، يصعدون بنا إلى باحة العارف، نستلقي على عشبها، وننام.) أية حرية يمنحها لنا النص أعلاه إذا ما غامرنا في تفكيك بناه التشفيرية الخمس ؟ غير أن الوقت لا يسعف إلا للإشارة فقط. والإشارة أيضا إلى أن الشاعر نجح في إيصال رؤاه لهذا العالم عبر استعادة الماضي تاريخاً وشهوداً ووقائع وأمكنة ورموزاً ومناخاتٍ سحرية. وتمكن من إرغامنا على التطلّع إلى رؤاه التي أنتجتها مخيلة عامرة بفراديس بوح غرستها سنون الاجتهاد والمثابرة والتضحية بالرغبات والمنافع لصالح مشروعه الشعري الحافل بالتحولات المدروسة والمخلصة للنص.
إن (آخرون قبل هذا الوقت) نص رباعي المتون، منتج من مخيلة بليغة تجربة وأداءً لمنح التلقي فرصة اجتراح حكمة التطلع إلى سياقاته الأسطورية المعمولة بحنكة العارف ومهارة المجرب وكفاءة الرؤيوي وإخلاص المشتغل.
نص خلق أسطورته الشعرية هو - لا بفرض الأسطورة على الشعر - من خلال تعالق معرفي مع الموروث محاولا الخروج بالواقعة من محليّتها إلى الكونية. ومن قوميتها إلى الإنسانية. ومن غموضها إلى الإشراق.
إقرأ أيضاً: