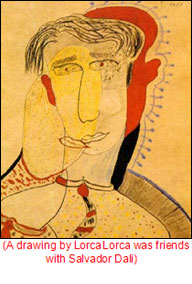 في إحدى قصائده يستشهد (سماء عيسى) بنص لأحد الشعراء الألمان جعل منه الفيلسوف الألماني (مارتن هيدغر) مناسبة لحديث هام عن الشعر وعلاقة الشعراء بالفلاسفة:.
في إحدى قصائده يستشهد (سماء عيسى) بنص لأحد الشعراء الألمان جعل منه الفيلسوف الألماني (مارتن هيدغر) مناسبة لحديث هام عن الشعر وعلاقة الشعراء بالفلاسفة:.
"ما الجمال إلا بداية الفزع وما يبقى يؤسسه الشعراء" و(هيدغر) الذي يجعل، مثل هولدرلين، الشعر "مسكنا للإنسان" و"بيتا للوجود" يقول إن بإمكاننا أن نتصور، عند الاقتضاء بأن الشعراء يقيمون أحيانا في الشعر، مع أن هذه (الإقامة) تتعارض مع أحوال الشعراء، لأنها مستعجلة ومهددة بأزمة الإيجار بعد أن أضحت محاصرة بالعمل ومضطربة من شدة التهافت على إحراز النجاح وكسب الامتيازات، ومأخوذة بسحر المتعة والتسليات المنظمة".
وإذا لم يكن الشعر بيتا وسكنا خاصا للشاعر (سماء عيسى) فإن ما تمنحه القراءة الأولى لأشعاره وكلماته القليلة المختزلة لا تجعله بعيدا عن هذا النوع من السكن. فهي توحي، على الأقل، بوجود طريقة للنظر إلى الأشياء والكائنات تختلف عما نجده عند كثيرين من الشعراء العمانيين والعرب. وربما كان هذا السكن الشعري الخيالي قد جعل قو ة النص المرجعية لا تتحد د على أساس المطابقة والمقايسة مع الواقع والتاريخ. فهو نص مفرغ من هذا التاريخ يبدو كما لو كان معلقا في الهواء لا علاقة مباشرة له مع الأشكال والتفاصيل اليومية، ولا يعير أهمية كبيرة للادعاءات الرومانسية في تطابق الهوية والتجانس مع عبقرية المؤلف. وهو ما يجعل مثل هذا النص معرضا للضياع وسوء الفهم في أحيان كثيرة. إذ ما دام النص يفلت، هكذا، من مؤلفه وسياقه التاريخي، فلا غرو أن يكون قابلا للإفلات من قارئه المحلي ليخاطب دائرة أوسع من القراء المجهولين، أو غير الموجودين في الحدود الجغرافية المتعارف عليها لتداولية النصوص الشعرية التقليدية.
ونغمة الأسى التي تملأ صفحة نص (سماء عيسى) بحزن لا وجه له تأتي من طبيعة موضوعاته الشعرية نفسها. فهي تدور حول "المنفى، سلالات الليل" وتتناثر كلماتها فيما يشبه "درب التبانة" بعد أن تغمس أصابعها بـ "دم العاشق" وتغتسل بـ"ماء لجسد الخرافة" و"هوفمنشتال" يرى أن الإنسان الذي يعرف الإحساس بالضيق والغم هو وحده الذي يمكنه أن يجد منفذا إلى الروح، ويمكنه أن يستوحي نوعا من الهدوء الذي لا يوجد في مكان آخر غير عالم العقل. فإذا ما سقط في هذا المأزق سيكون الرحيل إلى الفضاء على طريقة (بودلير) أول رد فعل له. وهذا ما يسميه (بنزفانغر) السير نحو الفراغ بحث-ا عن تجارب جديدة يمكن أن يجد لها المرء طريقا دون ضرورة الابتعاد عن الاتساع الأفقي للعالم.
وهي كلمات يمكن أن تنطبق إلى حد ما على تجربة (سماء عيسى) الشعرية بامتداداتها الميتافيزيقبة، وانطوائها على إحساس أصيل بمأساة الوجود البشري، وشعورها بحالة دائمة من الضيق والضجر وبشيء من الضياع والتيه.
"امرأة تتناسل أغصانها توابيت
طفل يقضم عظم أمه
إنيات تتلاشى قطرة دم
شجر يبتسم كنبي
امرأة تضيء عتمة مجهول
أجراس تدفن أسراب الطير
وطن يقذف أمعاءه
تدفنه الريح كمهل" (مهل من مجموعة ماء لجسد الخرافة 5)
وكل عبارة أو صورة في شعر (سماء عيسى) تبدو كما لو كانت تعاني من عزلة كلامية، ومن تفك ك جوهري يجعل العلاقة شبة مقطوعة بين الجملة الشعرية والتي تسبقها أو تليها. وبدلا من الإحساس بسعادة التملك والتشبث بالأشياء، لا يحيل نص (سماء عيسى) إلا إلى لحظه فقدان الذات أو عدم النظر إليها في واقعها الزماني والمكاني المحدد. وهو ما يورث اللغة الشعرية خصوصية تجعلها تقطع مع الأساليب اللسانية والبيانية السائدة.
ولنأخذ، مثالا على ذلك، هذه المقطوعة الصغيرة التي كتبها (سماء عيسى) بين مجموعة مقطوعات أخرى لها عنوان موحد هو (شهداء) في مجموعته (دم العاشق) الصادرة عام 1999م:
شهداء
"وردة الفجر
وهي تبتسم
لعابرين
لن يعودوا
ولن تعود معهم
أكفان المساء"
فهي، كما نرى، مؤلفة من جملة رئيسية واحدة تتضمن ثلاث جمل أخرى تابعة، وهي:
جملة الحال (وهي تبتسم) المؤلفة، هي الأخرى، من جملة أسميه خبرها الفعل (تبتسم)، وجملة (لن يعودوا) التي جاءت صفة لعابرين، ثم الجملة الأخيرة المعطوفة على ما قبلها (ولن تعود معهم أكفان المساء)
غير أن تركيب الجملة الرئيسية المذكورة غريب في علاقاته الإسنادية. فالمبتدأ أو المسند إليه (وردة الفجر) لا خبر أو مسند ظاهر له. والجملة التي تليه هي، كما قلنا، جملة حالية معترضة، وليست خبرا، في حين أن الجملة الأخيرة (لن تعود معهم أكفان المساء) معطوفة على جملة الصفة التالية (لن يعودوا).
وعلى الرغم من أن من السهل القول بأن (وردة الفجر) يمكن أن تكون خبرا لمبتدأ مقدر محذوف يتمثل في الضمير (هي)، فإن من شأن ذلك أن يقل ل من الطاقة الإيحائية للجملة الشعرية كلها.إذ إن جملة الحال الموالية( وهي تبتسم لعابرين لن يعودوا) تتضمن مثل هذا الخبر وتوحي به على نحو ما، بحيث لا يشعر القارئ بوجود نقص في التركيب الدلالي للجملة يوجب مثل هذا التقدير، على ما في ذلك من مباينة وانحراف عن القاعدة النحوية.
والواقع أن كلمتي (وردة الفجر) التي تقابل (أكفان المساء) وتكمل التضاد الدلالي معها، تمثلان (البؤرة) التي تؤلف بقية الأجزاء في الجملة إطارا لها. والمقطوعة تقدم، هكذا، مثالا على ما يقوله الدكتور (صلاح فضل) من أن نموذج (العطف النحوي) بين مجموعة العناصر الحسية المتباعدة في حقولها الدلالية يقوم، في قصيدة النثر، بتوليد مستوى تجريدي غائر هو القادر على تبرير الوصل في البنية العميقة للجملة الشعرية.
والمستوى التجريدي الغائر هنا يتجسد، كما هو واضح، في صورتي (وردة الفجر) و(أكفان المساء) اللتين تفتحان المقطوعة وتختتمانها على المستوى الكتابي (المكاني) والمستوى (الزماني) حيث المسافة بين الفجر والليل أو الولادة والموت لا تعدو أن تكون (عبورا) خاطفا بين لحظتين في عمر مكر س للشهادة وممنوح لها؛ وحيث الابتسامة المرتبطة بضوء الفجر الوليد ووردته المتفتحة والمكتنزة بالحياة والأمل، سرعان ما تنتهي إلى ظلام المساء وأكفانه المنطوية على الصمت والنهاية.
غير أن التعالق الدلالي بين بداية المقطوعة ونهايتها يتعدى هذا التقابل الضدي ويتجاوزه. فالشهادة تعني حياة واستمرارا، لا موتا ونهاية فقط. ولذلك فإن الوردة (وهي تبتسم) لا تعب ر فقط عن واقع الأمل المرتبط بالفجر الوليد، وإنما (هي تبتسم) أيضا لعابرين (لن يعودوا)، ولكنهم يملكون، بفعل الشهادة وبسبب منها، أن يدفعوا عن أنفسهم وعن الذين يستشهدون من أجلهم، الموت والظلام المرموز لهما بأكفان المساء. وهذا هو الذي يجعل وردة الفجر تبتسم لهؤلاء العابرين، وكأنها تعرف أن لهم علاقة بهذا الفجر وما يرمز له من حياة وضوء، مع معرفتها بأنهم ذاهبون أو عابرون إلى الجانب الآخر من جوانب الوجود، ولن يعودوا إلى هذه الحياة الدنيا.
ولنلاحظ أن التعبير عن الشهادة في اللغة العربية يرتبط، غالبا، بهذه العلاقة المترددة بين حركتي الضوء والظلمة، تبعا للتعاقب الطبيعي في حركة الزمن بين النهار والليل، كما في قول أبي العلاء المعري:
وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان
فهما في أواخر الليل فجران، وفي أولياته شفقان
والمهم أننا نلاحظ هنا الكيفية التي يتولد فيها من هذه المجموعة البسيطة من الكلمات أفق دلالي غائر نستطيع تتبع امتداداته مع امتداد الجملة ونموها وملاحظة تأثير علاقاتها النحوية المولدة، أو طريقة النظم فيها على بنيتها العميقة، وما يرافق ذلك من إيحاءات ميتافزيقية لآفاقها الدلالية.
والمقطوعة التي وردت في المجموعة نفسها عن الإمام (الحسين) شهيد كربلاء، تبدأ هكذا :
"ندى دمه الأبيض
وهو يبلل فجرا
قبور أحبتي
الموتى.."
متخذة نفس المنحى اللساني الذي يعتمد الانحراف في التركيب النحوي والدلالي حيث لا خبر ظاهر للمبتدأ سوى جملة الحال المفسرة والموضحة التي تليه، وحيث دم الشهادة (الأبيض) يرتبط بالفجر لينتهي المقطع قبل الأخير من المقطوعة بـ (ليل طويل جثم على صحراء قلوبنا).
والواقع أن هذا الانحراف في التركيب النحوي والدلالي ليس الوحيد الذي يواجهنا في لغة (سماء عيسى) الشعرية. فهناك انحرافات أخرى مقصودة، مثل تلك التي نجد فيها الصفة منفصلة عن موصوفها وغير متطابقة معه من حيث الإفراد والجمع،والتذكير والتأنيث كما هو الحال في هذه المقطوعة الصغيرة تحت عنوان (أم) من مجموعة (دم العاشق) أيضا:
"وحيدة
كالدمعة
وهي تنزف دما على صغيرتها الموتى".
فلفظة (الموتى) جاءت صفة لـ (صغيرتها) بدلا من (الميتة).. الأمر الذي يشكل انحرافا عن القاعدة النحوية، كما ذكرنا.. وهو ليس خطأ مطبعيا أو عدم انتباه من الشاعر، كما يبدو للوهلة الأولى.. إذ هو يتكرر في نصوص أخرى للشاعر بنفس هذه الطريقة الغربية، كما في هذا المقطع من نص تحت عنوان (عزان بن قيس البوسعيدي) من المجموعة نفسها:
"ماذا أقول للصخرة السوداء/ وهي تنزف ندما / على شجرة الحب الموتى"
وكما هو الحال في هذه المقطوعة الأخرى:-
"ظمأ الفجر
شجيرات موتى
وليس من يجيب
الصراخ في البراري".
فكلمة (الموتى) في جميع هذه النصوص لا تتطابق مع موصوفها. وهي تبدو، هكذا، منفصمة، ومعلقة في فراغ السطر، ولكنها ملحقة بكلماته على أساس المجاورة المكانية من دون أن تكون لها علاقة بنظام اللغة السائد فيه. فهي تكتفي بوجودها ذاته، بثقل دلالتها، مشيرة إلى نفسها عن طريق هذه المفارقة التي تحدث انفصاما في جسد الجملة الشعرية لتؤكد على الكلمة (البؤرة) فيها. فهي التي تمثل عنصرا مركزيا في الجملة الشعرية وتحكم وتحد د العلاقة مع العناصر الأخرى. واندراج هذه الكلمة في إطار (صفة) لموصوف بحسب النظام النحوي المتبع في الجملة العربية يحرمها، ربما، من الخصيصة الشعرية التي يجري فيها تأكيد الكلمة على نفسها مزيدا من التأكيد بواسطة كسر نسق الإنشاء السائد ليظهر بناؤها على أنه مجرد تراكم آلي أو جوار مكاني غير مكتمل في شروطه اللسانية التي تحيل فيها الكلمات إلى بعضها داخل الجملة الشعرية.. وقد بينت الدراسات الحديثة لنحو هذه الجملة الكيفية التي يرتبط الدال Singe فيها بالموضوع المعي ن برباط داخلي أدنى، ليكتسب أهمية أعلى. في حين ترتبط الوظيفة التقليدية للكلام، على العكس من ذلك، برباط أقوى وأكثر مباشرة بين الدال والمدلول. وكل ذلك يحدث نتيجة الانزياح أو الانزلاق في العلاقات المتبادلة لعناصر النظام في الجملة الشعرية، وما يترتب عليه من تغير في الوظيفة الدلالية، كما ذكرنا. والبلاغيون الجدد يرون بأن إسناد النعوت التي تتمتع بنسبة واضحة من الانحراف قياسا على الاستخدام النحوي المألوف في العبارة النثرية، يعد المدرج الأول للتخيل الشعري؛ إذ يتولى تحرير العبارة من حتمية علاقات المجاورة المكرورة مخترقا تقنية التشبيه إلى نوع من التكنية المجسدة، دون أن يبعد كثيرا عن الصيغ المستأنسة في التغبير الشعري.
وهذا النوع من الاستخدام الخاص للغة لا يبر ر بطبيعة الحال بعض الأخطاء التي يقع فيها (سماء عيسى) على المستوى النحوي. وهو أمر موجود مع الأسف في بعض النصوص ويبعث على الألم في النفس على قلته عند شاعر يملك مخيلة شديدة الخصب والحيوية ولغة متقشفة موحية.
غير أن ما هو أكثر أهمية عند هذا الشاعر أن هذه اللغة الشاعرية المكتنزة في أغلب نصوصه قد لا تتوفر بنفس القدر من الكفاءة والفعالية الشعرية في بعض النصوص، لا سيما الطويلة منها، فهذه النصوص تبدو متناقضة مع هدف قصيدة النثر المتمثل بالاقتصاد في اللغة والتكثيف في الصورة والقابلية للتنوع الداخلي في الموضوع والشكل. وبعض النصوص مثل (إلى أمهات الواصل) و(موت غض) من مجموعة (درب التبانة) يمكن أن تتحول بسهولة إلى ما يشبه الخاطرة القصصية بما تحمله من عناصر سرد وشخصيات محورية واستطرادات وجمل تفسيرية شارحة، وتفاصيل ومشاهد مثيرة لنوازع الحنين والصبوات العاطفية والصوفية.
وتلاحق الجمل النثرية في هذا النوع من النصوص وخلوها من الاختلافات الدلالية الحادة يحرمها من تفعيل الطاقات الشعرية التي تعو ض عن غياب الإيقاع ويحو لها إلى سلسلة مشاهد وصفية واستذكارات ومقاطع من سيرة ذاتية. وحين ينسى شاعر قصيدة النثر أن هذه القصيدة مبنية على قاعدة تناقض ومفارقات ضدية فإنما ينسى أهم مرتكزات الفن في هذا النوع من الكتابة. فإذا أضفنا إلى ذلك محدودية معجم (سماء عيسى) الشعري وتشابه كثير من موضوعاته، تبين لنا مقدار الجهد الذي يترتب على الشاعر أن يبذله للخروج من النمطية والتكرار في المفردات والصور. وكلمات مثل (الموتى والدمعة والينابيع والوحدة والدم والأم والطفولة والوردة والحنين والصحراء والروح والبحر والليل والظمأ والمرأة والشجرة) تؤلف في نصوص سماء عيسى الدوال الأساسية الخالقة لأشكال هذه النصوص وموضوعاتها ذات الرؤية الاشراقية والتصوفية.
وعلى الرغم من أن هذا المعجم الشعري الصغير يمنح بعض نصوص سماء عيسى سمات أسلوبية محدودة ومذاقا خاصا، فإن من شأنه أن يدمغ بعضها الآخر بالتشابه والتكرار. ومحاولة الشاعر الدائمة استخدام تاريخ بلاده والاستعانة بذاكرتها المكانية لا تفلح دائما في منع تعويم الرؤية الشعرية في هذه النصوص والحد من امتداداتها الميتافيزيقية. فإضفاء اللون المحلي على النص واصطناع الخصوصية في الرؤية الشعرية المرافقة قد لا يتوفران بدرجة كافية دون الارتكاز على تجربة خاصة من شأنها أن تمنح التعبير الشعري مزيدا من العمق والقابلية في الإقناع والفاعلية في التأثير. وأسماء الأشخاص والأمكنة المحلية الموضوعية داخل هذا النص أو ذاك ليست حلى ي زوق بها النص الشعري ليكون مختلفا وذا ذائقة وخصوصية معينة، ما دام من الممكن إجراء المناقلة التي ترتبط فيها هذه الأسماء بنصوص أخرى دون تغيير كبير يذكر. وبناء"قصيدة النثر" لدى سماء عيسى بهذا الشكل يخضع إلى نوع من التعارض الذي ينطلق فيه الشاعر من الفكرة أو الرؤية الشعرية للوصول إلى الصورة وما يرتبط بها من أسماء وتفاصيل بنية مكانية وزمانية، وليس العكس. ولذلك تبقى مثل هذه التفاصيل عاجزة عن اختراق النسيج الموحد للرؤية الشعرية مهما تعددت الموضوعات وتنوعت الأساليب. وهو ما يلقي أحيانا بظلال من الشك حول تطابق الهوية بين شكل النص وموضوعه، ويحرم الكلمات من أن تكون تعبيرا مؤكدا عن الذات المتكلمة، ويحمل ما نسميه بالوحدة العضوية في القصيدة على التراجع أحيانا، ويجعل من السهل على بعض النصوص أن تتبادل عناوينها دون اختلافات دلالية حاسمة. فما أن يفتتح الشاعر نصه حتى يدخل في التجريد وتغيب التفاصيل ونكون أحيانا في مواجهة إحساس يشبه ذلك الذي نجده في القصيدة المترجمة. وحين نقرأ مثل هذا النص لسماء عيسى:
"دون أن يبصر الأطفال
جلال روحك
مرة أخرى
أي ألم هذا
الذي قادك
إلينا ".
ونقرأ هذا النص لسان جون بيرس :
"أيها الغريب، يا من شراعه حاذى طويلا شواطئنا.. هل ستقول لنا ما بليت ك ومن يدفعك، في أكثر المساءات دفئا، لكي تهبط بيننا على الأرض الأليفة؟".
فإننا نجد تشابها في أجواء النصين وثيمتيهما اللتين تتحدثان كلاهما عن رجل غريب مبتلى ومتألم، يوجد بيننا فجأة كأنما ليذكرنا بمأساة وشيكة قد نكون موضوعها.
ونحن لا نستشهد هنا بهذين النصين العربي والمترجم للقول بوجود تناص أو تعالق ناتج عن تأثر مباشر بينهما، فهذا النوع من التأثر غير موجود بطبيعة الحال، خصوصا إذا عرفنا أن النصين مقتطعان من قصيدتين هما (حوية العلامة الحباسي) من مجموعة (سماء عيسى) (درب التبانة) و(أيها الغريب يا من شراعه..) من ديوان سان جون بيرس (منارات) الذي ترجمه أدونيس. وهو ما يعني أننا لا نستطيع وضع وصف صحيح لأي من هذين النصين وتقدير فاعليتهما الشعرية خارج إطار السياق الذي ينتظم فيه كل منهما. وهو سياق مختلف بالتأكيد.
فقصيدة (سماء عيسى) عن العلامة العماني (الحباسي) تمثل قراءة غائرة في حياة رجل دين شاعر في لحظة موته؛ ورغم كونه أعمى فهو يبدو في القصيدة مثل "قنديل وحيد مهجور بعتمة، لا يبصر من العالم إلا ظلامه" وفيها توق ف عند لحظات الانخطاف الروحي والاستبصارات الداخلية والذكريات والعذابات التي يواجهها إنسان يحلم عند موته برجل غريب يأتي من أطراف البحر ليقوده نحو أرض الموتى الخضراء أكثر من الحياة، تاركا وراءه كتبه وأوراقه التي هي له كما الرقوء على جرح الدهر، والقمر المفقود بليل الركبان، وكذلك نخلة وطفلة ستبكيان على تربته المبللة بماء من حنين الصبا وبألم خطته على الأرض سلالات الغياب البعيد، كما تقول القصيدة.
أما قصيدة (سان جون بيرس) فهي، كبقية شعر هذا الشاعر الفرنسي، أكثر سرية وغموضا وتندرج في إطار شعره ذي الطبيعة الملحمية الكونية التي تتغنى بالبحر والمرأة والنضارة والخضرة والخصب الموجود في بيئات وحضارات مختلفة. وبعض هذا الغموض راجع، كما يبين لنا نقاد هذا الشاعر ودارسوه، لاتجاهه الموسوعي في معجمه اللغوي واستعماله لمفردات نادرة وصعبة لأسماء أمكنة ونباتات وحيوانات ومعادن. وهو غموض نابع أيضا من طبيعة اتجاهه الشعري وإضفائه جوا من الغرابة والتفرد على قصائده، وما تشتمل عليه من معان ذهنية وفلسفية مجردة. وهو نفس ما نواجهه، بطريقة أو أخرى، في شعر (سماء عيسى) في القصيدة المذكورة وفي سواها، بحيث يبدو القناع الذي تستخدم فيه شخصية العلامة (الحباسي) في تلك القصيدة تعلة وسببا للانزلاق نحو تلك الأجواء الميتافيزيقية التي تحاكي في شكلها العام الأجواء المعتمة في القصيدة الفرنسية المترجمة.
وهو أمر لا يقتصر طبعا على شعر سماء عيسى وحده، وإنما يشمل شعراء عمانيين آخرين ممن يكتبون قصيدة النثر. ولكن شعر سماء عيسى ربما مث ل، أكثر من غيره، نموذجا لهذا التوافق أو المقابسة التي تبدو فيها القصيدة العربية صورة من نوع ما لقصيدة أخرى غير عربية، بصرف النظر عن محاولة تلك القصيدة الاعتماد على جذر تراثي وتمسكها بالمكان العماني وبعض شخصياته من أجل إضفاء قدر أكبر من الأصالة على مفردات الكتابة الشعرية. وهو ما يثبت، مرة أخرى، أن أصالة القصيدة، أية قصيدة، لا تعتمد دائما على نوع الاسم أو المفردة التراثية التي تعمد هذه القصيدة إلى وضعها بين قوسيها، بقدر ما تعتمد على عناصر داخلية كثيرة من شأنها أن تؤلف روحا جديدا أو عمودا آخر يمكن القول إنه يقوم مقام العمود الذي يرفع البيت بعد أن انكسر أو مال قليلا في القصيدة القديمة.
* "انظر، بول دي مان، العمى والبصيرة، ترجمة سعيد الغانمي ص86"
** انظر، صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة (ص 40)
مجلة (نزوى) عمان
11/27/2005
إقرأ أيضاً: