مدخل
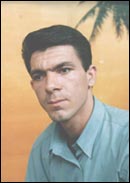 في حياة تساوي قطاع غزة (رفح، خانيونس، دير البلح، غزة، المخيمات + الانتفاضتين+ البحر + المستوطنات + الليل كله) أخذ الخطاب الشعري يتحرّرُ، بشكل ملحوظٍ، من حالة النص-الجبهة؛ وقد كان في مرحلة ما قبل "أوسلو" أسيراً لمعطيات الانتفاضة الأولى1987، التي أشبعتْ قصيدة الداخل بمفردات الحجر، السكين، الكلاشنكوف، المقلاع (النقيفة)، الإطارات المشتعلة، الملاحقة، الكمائن، ورشق الحجارة من خلف بيوت المخيم، وغير ذلك من معطيات. هذه "الورطة" التي حلّت بخطاب الداخل المنتفض أثّرت على تقدم الشعر كثيراً، وحالت دون تحقيق حضور شعري بمستوى الحضور الذي كان يتمتّع به الخارجُ. ففي حين كان الخارج يتلمس ملامح الفن والجِدّة، ويصبغها على القصيدة؛ كان الداخل متمثلاً بالأصوات الشعرية "الجهورية" متجهاً لرصد وتلمس معطيات الشارع المنتفض، واحتواءِ مشاهد الفعل النضالي في قوالب شعرية "تسجيلية". إلا أنه وبعد تأريخ قدوم "السلطة الفلسطينية" أصبح الخطاب الشعري أكثر تحوّلاً وتشكلاً وخروجاً عن السائد. فإلي جانب أنه غدا على صلةٍ قريبة من خطاب الخارج الذي استقرّ وبات يؤثر فيه؛ إلى جانب ذلك- ظهرت أصواتٌ شعريةٌ أكثر تداولاً وتناولاً لمعطيات الحياة والفن، وأكثر وعياً ومعرفةً بما يجب أن يكون عليه خطاب الشاعر - المواطن. الذي أصبح بإمكانه أن يدمغ حضوره بقصيدة الإنسان- الفن- الحياة، وأن يتكيف مع كل التداعيات والوقائع السياسية والاجتماعية الحادثة. لقد تمكنت الذوات الشاعرة الراهنة من صهر تفاصيل الشارع ،العيش ،الحب و الجمال في معطى - خطاب شعري يبتعد كثيراً عن غنائيات الجبهة، ويتخذ من النفْس التي تلمّ الخاص والعام في بوتقتها صوتاً شعرياً هادئاً يتألم بصمت، ويعشق ويقول ويتمرّد ويتعرّض لذاكرةِ الموت الذاتية والجمعية ويطلب الخلاص دون أن يعلن ذلك من فوق سطوح الصوت.
في حياة تساوي قطاع غزة (رفح، خانيونس، دير البلح، غزة، المخيمات + الانتفاضتين+ البحر + المستوطنات + الليل كله) أخذ الخطاب الشعري يتحرّرُ، بشكل ملحوظٍ، من حالة النص-الجبهة؛ وقد كان في مرحلة ما قبل "أوسلو" أسيراً لمعطيات الانتفاضة الأولى1987، التي أشبعتْ قصيدة الداخل بمفردات الحجر، السكين، الكلاشنكوف، المقلاع (النقيفة)، الإطارات المشتعلة، الملاحقة، الكمائن، ورشق الحجارة من خلف بيوت المخيم، وغير ذلك من معطيات. هذه "الورطة" التي حلّت بخطاب الداخل المنتفض أثّرت على تقدم الشعر كثيراً، وحالت دون تحقيق حضور شعري بمستوى الحضور الذي كان يتمتّع به الخارجُ. ففي حين كان الخارج يتلمس ملامح الفن والجِدّة، ويصبغها على القصيدة؛ كان الداخل متمثلاً بالأصوات الشعرية "الجهورية" متجهاً لرصد وتلمس معطيات الشارع المنتفض، واحتواءِ مشاهد الفعل النضالي في قوالب شعرية "تسجيلية". إلا أنه وبعد تأريخ قدوم "السلطة الفلسطينية" أصبح الخطاب الشعري أكثر تحوّلاً وتشكلاً وخروجاً عن السائد. فإلي جانب أنه غدا على صلةٍ قريبة من خطاب الخارج الذي استقرّ وبات يؤثر فيه؛ إلى جانب ذلك- ظهرت أصواتٌ شعريةٌ أكثر تداولاً وتناولاً لمعطيات الحياة والفن، وأكثر وعياً ومعرفةً بما يجب أن يكون عليه خطاب الشاعر - المواطن. الذي أصبح بإمكانه أن يدمغ حضوره بقصيدة الإنسان- الفن- الحياة، وأن يتكيف مع كل التداعيات والوقائع السياسية والاجتماعية الحادثة. لقد تمكنت الذوات الشاعرة الراهنة من صهر تفاصيل الشارع ،العيش ،الحب و الجمال في معطى - خطاب شعري يبتعد كثيراً عن غنائيات الجبهة، ويتخذ من النفْس التي تلمّ الخاص والعام في بوتقتها صوتاً شعرياً هادئاً يتألم بصمت، ويعشق ويقول ويتمرّد ويتعرّض لذاكرةِ الموت الذاتية والجمعية ويطلب الخلاص دون أن يعلن ذلك من فوق سطوح الصوت.
يتمثل جديد الخطاب الشعري الداخلي الغزّيّ بحركة شعرية شابة دؤوبة، تسعى إلى تشكيل ونحت حضورها في جسد الشعر الفلسطيني العام. وتعتبر هذه الحركة في حكم الامتداد التاريخي انبثاقاً من أصداء المشهد الشعري الثمانيني والتسعيني الذي قدّم خطابَهُ المتنوع، دون أن يرافقه ظلُّ النقد، في المشهد الغزيّ، على الأقلّ. وما يلاحظُ في ذلك غيابُ موقف الآخر المكّرس، والتزامه الصمت إزاء تشكُّلِ هذه الهوية الشعرية؛ وأحسبُ أن الدلالة التي تُمْكِنُ قراءتُها من هذا الغياب تتمثل في وجود درجة صامتة من الرضا عن هذا القادم الشعري الذي يحضر بقوة ويطرحُ شعريته الراهنة دونما وجل، و يأتي هذا الرضا أيضا، بالأساس، كإشادة عامة بعافية المشهد الغزي، والذي تتبلور فيه جماعة "تجريب" قادرة في الوقت الراهن أن تغيّر وتضيف للمشهد الشعري العام سمات وملامح مهمة. إنها حركة شعرية تتجاور فيها أصوات "قصيدة النثر" مع أصوات " قصيدة التفعيلة" ، وتقدم هذه الأصوات مجتمعةً شعراً مغايراً، كما تُبدي موقفاً رافضاً لخطاب المُؤسسة الثقافية، وهي في الوقت ذاته لا تقيم خصومة مع الآخر<الحرس القديم>، ولا تسعى لقتل "الأب الشعري"؛ فقط تطالبه بالإصغاء، لا ممارسة النفي والمصادرة وطرح الحكم المسبق. ونذكر في هذا السياق مقولة "جان كوكتو" التي هي بمثابة لسان حالٍ لهذه الأصوات الجديدة. يقول كوكتو: " إذا ما صادفت جملة أثارت حفيظتك، فإني وضعتها، لا لتكون حجراً تتعثر به، بل علامة خطرٍ كيما تلاحظ مسيري". إذن هي حركة شعرية تعلن أن لديها الجديد، وهي في طريقها لخلق "انتفاضة شعرية" ذات أثرٍ ربيعي في مشهد الشعر الفلسطيني العام. لقد غدت علاقة الشاعر بالوطن علاقة راقية مؤداها أن المبدع ليس بوقاً، وليسَ مُحَرضاً شكلياً ميدانياً، وليس أداةً تسجيليةً مُباشرةً، فهو له رؤيته الخاصة للحياة، وهو كائن إنساني لديه الطموح والرؤى والهموم. لا شك أنه يعاني معاناة كبيرة من جراء المعوقات والمشاكل التي يتسبب فيها الاحتلال بممارساته الفظة المستمرة، إلا أنه يظلّ، كونه مبدع، يملك مفاهيم الحبّ والحلم والرغبة في التغيير، ويتناول الحياة بتفاصيلها الخاصة والعامة، يُوسّع أو يُحَدّد علاقاته بالأشكال والأشياء والرموز المحيطة، وتحافظ ذاته الشعرية على المرونة الواضحة في صياغاتها المتنوعة مع الآخر العام.
إن لدى المبدع مَسعىً فطرياً للتحرر، وتجاوز السائد والمألوف؛ إنشاداً لكل ما هو جميل، إنه المبدع الذي يشكّل بمضامينه ومفاهيمه ومعرفته وعلاقاته بالآخر والأشياء خطاباً خلاقاً، وهو سارق النار تعينه على كشفِ ورسم علاقات الذات بـ المحيط_ العالم. ومن هذا المنطلق رأينا أن نشغِّلَ حرصنا في قراءة كوكبة من الشعراء؛ واضعين هذا العطاء كنبذة تعريفية قوامها الضوء الملقى على نصوص أهم الأصوات الشعرية التي برزت بعد عام 2000 في قطاع غزة، محاولينَ، ما أمكن، طرح الكيفية الشعرية التي تتحرك وفقها هذه الأصوات التي، هي من ناحيةٍ، تُمَثّلُ شريحةً واعيةً ولصيقةً في مكان الحدث السياسي والنضالي، ومُصْغِيَةً لخطاباتٍ متعددة الاتجاهات؛ ومن ناحيةٍ أوْلَى هِيَ أصْواتٌ مُبدِعَةٌ تُشكِّل حضورها المرافق لخطابات الإبداع والحداثة والتجديد بأشكالها المنتشرة والمتنوعة. ولقد سعينا، أثناء قراءتنا، للتنويع في مستويات وبواباتِ الدخولِ المتعددة كي يمكننا ذلك من تقديم القراءاتِ تقديماً تكاملياً؛ جدواه التعريفُ بالأصوات الشعرية الراهنة، كذلك كان هناكَ تركيز واضح على قراءة الأبعاد الزمانية والمكانية والحركية التي حول النصوص وفيها. ويَتَبَدّى ذلك واضحاً من خلال تناولنا القادم، وفي المقدمة أعلاه كنا قد قدمنا قراءة عاجلة في الزمان الخارجي لحركة الشعر الراهنة، نوجزها في بندين:- زمان الحصار (الانتفاضة الأولى+ مرحلة السلطة + الانتفاضة الثانية). - زمان الخطاب، تطور مضمون وملامح الخطاب الشعري الغزي. أما بالنسبة للزمان الداخلي، فقد تناولنا في القراءاتِ أبعادَ وحركية الزمان ( ماضي، حاضر، مستقبل) في داخل القصائد، كما سعينا، خلال القراءاتِ، لإظهار دائرية لحظة الذوات الشاعرة ومحتوياتها الزمانية والمكانية داخل خطاب الشعر الغزي الراهن.
إذن، يمكننا النظر إلى مستقبل المشهد الشعري الفلسطيني العام من خلال عطاءات حركة الشعر الشبابية الفلسطينية المعاصرة، نظرتنا هذه التي تُعبِّر عن ذروة الانتماء والاقتناع بحركة الشعر- لا بحركة الحزب؛ لا تحمل في الوقت ذاته مفهوم "إحلال أنا" حركة الشعر الجديدة في مقابل "محو أو إلغاء "الآخر الشعري القديم والمكرس". إن هذه النظرة المنتمية هي بمثابة إشادة واحتفاء بجديد الخطاب الشعري الذي تحمله هذه الـ الأنا الشعرية الأكثر تصالحاً مع نظم الاتصال ومصادر المعرفة الوفيرة، والمفاهيم الاصطلاحية الطازجة من عولمة، وحداثة وما بعد الحداثة.. لقد أصبحت هذه الـ" أنا" قادرة ومهيأة لقراءة كلّ سمات الجدّة الشعرية، والمرور على كلِّ آثار الحقب والأجيال السابقة مروراً فاحصاً وخلاقاً؛ فبحراكها الدائب تمنح حضورها الشعري هويةً متجددةً ومجددة في النتاج والخطاب واللغة والوعي والمعرفة. وبمعنىً أكثر مسؤوليةً وإلحاحاً، يمكن القول: إنّ كلّ "تجريب" في مجال الشعر تحديداً يحتاج، بالضرورة، إلى مرافقة نقدية تسير في خطّ موازٍ ومراقب، وغير تقليدي، كي يتسنى التأسيس لحركةٍ شعريةٍ تثمرُ الجودةَ للحاضر ، وللمستقبل ، وللماضي الذي سنتأسسُ فيه مثلما هو الآن مُتأسِسٌ فينا.
(الضوء الأول)
قراءة في نصوص للشاعر معين شلولة
الحلقة الأولى
شبهةُ التحليق، وحقيقةُ الانفصال
الوهلةُ الأولى عند قراءة قصائد الشاعر، معين شلولة، تغالطُ بترك انطباع يبثّ في المتلقي شبهة التحليق في الماوراء، فيما حقيقة انفصال الشاعر عن الأرض، وتحليقه فوق المكان، كنسرٍ يرى في نزوله مغامرة صعبة؛ تشير إلى حالة النكوص والهروب من الواقع. هذا التحليق لم يكن ليتخطّى غلافَ الجوّ، حيثُ النَسْرُ في تجلياتِ النشيد، فوق المكان، ضدّ المكان. هي إذن حالةُ علوٍّ لأنا هاربة، تمتاز بخصبٍ شعري، وبصوتٍ مُغايرٍ، ويتراءى ذلك بوضوح في انفلات اللغة وتدفقها الهائل عبر مراتب صوتٍ بالغةِ الجَرَس. وثمة أبعادٌ دلالية تكمنُ وراء خارطة "أبنية القصائد"؛ تعينُ على كَشفِ العلاقة بين انفلات اللغة وتدفقها الهائل، وبين "وحداتِ الوزن"، فنلاحظ وجودَ علاقاتٍ ضديّةٍ حادة بين الحركة والالتزام في القصائد.
إذ يَحِلُّ الالتزامُ في مَظْهَرينِ اثنين: مَظهرِ "البنيانِ التفاعيلي"، ومظهر السواكن في أبنية اللغة. أما الحركة في القصائد فتَحِلُّ، أيضا، في مَظْهَرينِ اثنينِ: مَظهرِ حياةِ اللغة بمعانيها ودلالاتها وتحليقاتها سيولة مفرداتها، ومَظهرِ الحَدْرِ والهرولةِ والدوران- الكائنِ بفعل "البنيان التفاعيلي" المُتَّبعِ في القصائد.
وللشاعر صورتان تتضحان في القصائد تبعاً لثنائية الحركة والالتزام: صورة النسر المحلّق، وفي العلوّ له النشيد، وصورة الفرسِ الموثوقِ جسداً، وفي المكان يُثْخِنُ في الصهيل. تحتوي الصورة الثانية ضديّن في كيانِها: الفرسَ الموثوقَ جسداً ، والمنفلتَ صوتاً/صهيلاً. واستنتاجاً لذلك يكون صهيلُ الفرس الموثوقِ في المكان، معادلاً صوتياً/حركياً لنشيدِ النسْرِ المُحَلّق في العلوّ.
إن أجزاء قصائد الشاعر التي بين يدي الذات القارئة تعين، إلى حدٍّ ما، على إحراز قراءةٍ بانورامية من شأنها تحديد منطقة عمل الشاعر بحساسيةٍ قارئ يسعى بين علاقاتٍ مشتبكة وملتبسة ومتشعبة ومتداخلة ومشجرة ومتشاجرة شكلاً ومحتوىً. إذنْ؛ هي مِنطقةُ عملٍ وعرةٍ، وجَمَالياتُها لا تزال تتخفى، غير أننا سنحاول جهد حرصنا في مُناشدةِ ضوءٍ؛ ولو ضئيلٍ، ليمنحنا حظوةَ كشفٍ متواضعة.
بادئ النظر يَضَعُنا أمامَ كثافةِ غنائيةِ التمنّي في خطاب الشاعر الغزي معين شلولة، تُخَبِّيءُ هذه الكثافة، التي لها حضور مُتفرّق، في باقي نصوص، أزمةَ المكانَ المُعَيَّنَ في هذا الأمام الوراء، حيث المخيم يشرفُ علينا. نلاحظ أنَّ الخطابَ الشعري، في هذه النصوص، قد أدغمَ شموليةِ الحديث عن أزمة الوجود الإنساني بشكل عام في جزئيةِ خطابٍ يتراوح بين أرض وجوّ في جزء المكان الوطني المشغولِ بالمحاصرةْ. في المقطع التالي يقول:
ليت أن النهر يمتصُّ وجودي
ليتَ ميزانكَ يا صمتُ خفافيش أملْ
ليت أحراشكَ وحيٌّ
يسحبُ الوقتَ كأفراس رحيلي
من تهاويم تَغَذِّي مَسّها روح جبلْ
نلاحظ، بدءًا بما سبق، وجودَ "أنا منفصلة" تحملُ عبءَ المكان الثقيل، وتلقي به، وتزيحه عنها، على مَحملِ ميزان الصمت؛ والتي تتمناهُ هذه "الأنا المنفصلة" لو يكونَ خفافيش أملٍ خفيفةٍ طيارة. ما يُلفِتُ النظرَ، هنا، هو إحلال الشاعر مفردة "أمل" محلّ مفردة " ظلام"، حيث المركبة المألوفة [خفافيش الظلام]، غير أنها جاءت هنا مُركّبةً من طرفين متنافرين، هذا التنافر الدلالي يضعنا أمام قراءة "أنا منفصلة متشائلة"، هذه صورة من تهاويم أنا مأزومةٍ من جزء المكان المشغول بالمحاصرة؛ فإنها في أزمتها تُربّي نشيدها في أحراش مغلقة تتمنى أن يَحِلَّ بها وحيُّ يخلصها من هذا المكان، وإليك نشيدُهُ:
ليت أحراشك وحيُّ
يسحب الوقت كأفراس رحيلي
من تهاويم تَغَذِّيْ مَسّها روحُ جبلْ
وتتشابك العلاقات والدلالات بين المقطع الأول والمقطع الثاني التالي:
يغيب الزمنْ
يرسل الحزنُ شبهاتِه في جبين الجمادْ
يموت الرعاة الصغار-كأمي- يبور العسسْ
وأوقْع قتلاي هذا أنا
وذاك الخرسْ
ففي غيبوبة هذا الزمن يرسل الحزن شبهاته في جبين الجماد/ الجبل/المكان، ويموت الرعاة الصغار في الأحراشِ - كأمي-، ولعل تسمية وتشخيص وتعريض الأمّ، هنا، مُرادفٌ للأمنية، وبوار العسس متعالق بشكلٍ حيٍّ في موتِ الرعاة الصغار، دونما تدخل العسس. وكأنّ الشاعرَ يريدُ أن يُصوِّرَ، لنا، حجمَ الضيق الذي يتحقّق من فرطِه الموتُ. وثمة مقصد في التحديد الحاصل في قولِه" الرعاة الصغار"، إذ سيكون لنا ذهابٌ لذكر علاقة موت الرعاة الصغار بالرعاة الكبار الذين لا ذكر لهم في المقطع. وحضورُ ذكرِ الرعاة الصغار يدلّل على اكتراث الأنا بالنشيد إلى المعلولِ، في مقابل تجاهل ذكر الآخر.
هذا مشهدٌ بدائيٌّ تتجلَّى فيه عناصر الطبيعة كجبين الجماد/ الجبل، وموت الرعاة والعسس، وقد جاء في المقطع السابق ذكر الأحراش والأفراس وروح الجبل. وهل القصد بالرعاة الصغار " بسطاء الناس" في هذا المشهد الذي يبعث على الهول والفوضى جراء استبداد الرعاة الكبار في ظلّ غيبوبةِ هذا الزمن؟!! ثمّ يعلن الشاعر ،عن يأسٍ، هذا الجللَ الفجائعي:
وأوْقع قتلاي هذا أنا
وذاك الخرس.
فقتلاه المُوقَعة المُتَوَقَّعة هي التهاويم والأماني التي يربيها بالنشيد، ثمّ يصيغ فجوة العلاقة بين " هذا أنا - وبين " ذاك الخرس"؛ أي بين الـ "أنا" وبين الـ "آخر" بدلالاته المتعددة والعامة. وتنشاف ذُرَى التَّمنِّي بجَلاءٍ في قصيدة للشاعر بعنوان "ساعةٌ من أمل" إذ يقول في مقطعها الأول:
عندما تكبر الأرض؛
سوف أبني جبالَ الهواء النقيّ
وأدنو كحقلٍ من الساقية
وأرسم بالصوت ضحكي
وشيء الهدوء
وأمي وريش الزمانْ
وإن أرجأتني اليدُ الباليةْ
أُوْلَى الدلالاتِ في المقطع تتجلّى في العلاقة الأولى بين عنوان القصيدة "ساعة من أمل" وبين الاستهلال الظرفي المتمثل في " عندما "؛ إذ الظرف للزمانِ، والظرف محمولٌ على أمانيٍّ تَحَقُّقُها محمولٌ على أفعال مُضارعةٍ مشروطة بالمستقبل " سوف ". ومِنْ مُلاحظة الأمنية الأولى " سوف أبني جبال الهواء النقيّ" المتعلقة بـ" عندما تكبر الأرض" نكشف عن وجود "أنا الشاعر النسرية" التي تتمنى أوّلَ ما تتمنى ما يَخُصّها- وهو أن تبني جبال الهواء النقيّ. ونستنتج من خطاب التمني هذا وجودَ نزعةٍ ذات شبهة أنانية، سوى أن الشبهة تزول أمام مشروعية تحقيق الـ"أنا" لوجودها أولاً، كذلكَ تزول الشبهة لأنّ الـ"أنا" هنا تتسلى بغناء الاستحالة خلال هذه الأمنية " سأبني جبال الهواء". واستمراراً في التمني: يدنو الشاعر بأناه النسرية كحقل من الساقية، حيث تتآلف في الشاعر أنا النسر مع "أناه الفرسية"، في إشارة إلى التصالح مع الأرضِ التي كان قد تركها وحلّق في البعيد فوقها، وحينها يرسم بالصوت( بالنشيد والصهيل) ضحكه، وهدوءه، وأمه، وريش الزمان. هي إذن مطامحُ وأمانيّ يرى تَحَقُّقَها؛ وإن طالت في إرجائه يد الماضي الفاعلة" اليدُ البالية".
هذا مشهد شخصية أسطورية تحتويها أبعاد الزمان الثلاثة(الماضي، الحاضر، المستقبل). وتتجه خلال الطموح المحمول على أفعال المضارعِ المعلقة على شرط المستقبل. كذلك الحال، تَعَلّقُ تحقيقِ الطموح على شرط المستقبل يتضح في قوله ووصفه في المقطع التالي:
سفوح الثواني البليدة
تسير بعينيّ نحوَ الخَرَسْ
ولكنني سوف أفجع وقتي؛
وأخرج من لحظتي شَهوةً وفرَسْ.
والمقطع التالي: يقدم تعريفاً لأنا: فهي أنا خطابُها الحرص العام، لكنَّ هذا الخطاب يثنيه استدراكٌ محتومٌ بالجزم والحجز؛ فتؤول الأنا إلى مواكبة الحزن، يقول:
أنا:
ما أريدُ لمن هم سوايْ
ولكنني لم أزلْ/
أواكبُ حزني على موتِ صغرى خطايْ
وفي المقطع التالي، نلاحظُ حلول الذات الشاعرة في اللحظة ذاتها دون ارتدادٍ لماضٍ، ودون تعالق بأفعال المضارعِ الملقاة شروط تَحَقُّقها على غيب المستقبل، حيث يقول:
حين أرعي الشموع الصغيرة في أي وادٍ
أحنّ..
أوطِّدُ دمعةَ حزني على الشيب في حاجبي
ورأس الجمادْ
وثمة في اللحظة مرونة في تسمية المكان ضَوءها ينعكس "في أيِّ وادٍ "، ففي هذه اللحظة يقوم الشاعر بارتداء "أناه النسرية"؛ ويرعى من علوٍّ الشموعَ الصغيرة "في أي وادٍ"، ويحنّ ويوطّد دمعة الحزن على الشيب فوق حاجبه، وتتحقق الصدمة هنا من أثر المخالفة المتمثلة في توطيد دمعة الحزن على الشيب في الحاجب، وذلك بالانتباه إلى موقع العين من الحاجب، وتكترث هذه المخالفة بإضاءة دلالة صعود وتفاقم الحزن، كما تتجلى إشارة الصعود في " رأس الجماد"/ أو الجبل الذي هو موطن ومجال تحليق النسر الذي يهذي قائلا: "تموت السماء لتخرج مني" ثم يخبر بأنه مازال من سرها المتواري على مقربة، بمعنى أنه لم يحلق في الماوراء، إنما دون بلوغه يبقى. هي إذن أضغاث وتهاويم أنا هاربة تدَّعِي التجلّي في العلوّ.
لأن الحقيقة هدأة شكٍّ؛
سأرقد في النهر والتجربةْ
تموت السماء لتخرج مني؛
ومازلتُ من سرها على مقربة.
من قصيدة" لوحات متربصة"، في المقطع الأول يقول:
عقصت هامتي شفاه الظلام
هل أضاعت سروجها؟ كلُّ موتٍ
لغةٌ غير ناكصةْ/كلُّ بدءٍ
ساعةٌ من حريرنا المذبوحْ
في هذا المقطع بدايةً؛ تنحصر هامة الشاعر بين الفعل الماضي (عقصت)، وبين الفاعل( شفاه) والمفعول به ( هامتي) هذه القراءة في المستوى النحوي تشي بحدة الحصارِ، ثمّ يتبع ذلك حضور سؤالٍ: هل أضاعت سروجها؟ أي هل أضاعت هامتي سروجها، ونرى أن هذه الهامة هي بمثابة "أنا فَرَسِيّة"، كما نلاحظ كيف تمّ الإحلال والتبدّل في علاقات المستوى النحوي، حيث هامتي التي أخذت موقعها الإعرابي المنصوب (مفعولاً به) تحتلّ الآن موقعَ الفاعل المستتر المحاصر بين (أضاعت) وبين ( سروجها)، إذ المحاصرة بين الزمن الماضي وبين فقدان "سروج "أنا الفرسية"، فالسروج تظهر كدالٍّ على مدلولٍ "أنا الفرس" اكتفى الشاعرُ بذكر بعضِ خصائصها وهي (سروجها)، أي سروج الهامة التي هي بمثابة أنا فَرَسِيّة، أو ما يصطلح عليه بلاغياً بالمجاز المرسل؛ فالسروج ذات علاقة جزئية بحضور الفرس، وأيضاً ذات علاقة غيابية بغياب الفرس. والغياب هنا معنويُّ وحاضرٌ في أنا الشاعر الناكصة.
والعقصُ بمعني القيد، والهامة دلالة العلو، ما يعني الحضور المترافق بين الـ "أنا النسرية" وبين "الأنا الفرسية" في الشاعر، وبين قيدٍ وعلوٍّ يعلن الشاعر أنّ:
كلّ موتٍ لغةٌ غير ناكصة/ كل بدءٍ
ساعةٌ من حريرنا المذبوحْ.
وكأنه يرى في الموتِ خلاصاً مُحاولاً بذلك إخفاء حالة النكوص، فيما هي تتجلّي وتترافق مع معاني الإزاحة والفرار من جزء المكان؛ "كلّ بدءٍ"؛ والبدء هنا بمعنى الحياة في مقابل الموت المقروء من " ساعة حريرنا المذبوح". كما يرد ذكر الموت في المقطع التالي:
يحرس الموت ضوءه في الإشارة
كيدٍ تعتني بروح الفراغ
أو سكون يلمُّ وجه الرياح
صُفَّ لي شرفتي وراء الصدى.
في هذا المقطع نقف أمامَ معاني ووسائط تبعث على الانتباه للمزدوج المعنوي / المادي، معنوي في حراسةِ الموت، ومادي في إشارة ضوءه، وثمة أيضاً عملٌ للحواس؛ والدلالة عن ذلك في " ضوءه" حيث حاسة البصر. والإشارة لها بُعْدَا تشخيصٍ: معنوي ومادي، المعنوي يتعادل مع معنوية الموت، والمادي يتعادلُ مع شكلِ الإشارة الظاهر.وثمة تشخيصٌ في المقطع لجزأين من الجسد: [اليد، والوجه] يوظفانِ في سياقٍ معنوي حيّ يُقدِّمُ مَهارةً دلاليةً حول الازدواج ، وإليك الشاهد:
كيدٍ تعتني بروح الفراغ
أو سكون يلمّ وجه الرياح
ويختتم الشاعر المقطع بقوله: " صفّ لي شرفتي وراء الصدى"، إذ فعل الأمر هنا مُحَمَّلٌ بخطاب التمني، وأنا الشاعر الأرضية في مخاطبةٍ لأنا مجهولةٍ وراء الصدى، ترتجيها بتشوُّفٍ؛ لتصفّ ولترتّبَ شرفةً وراء الصدى، أي منزلةً ومكانةً عالية؛ يفتقدها الشاعر في جزء المكان، إنه انفصام مبدع! وتظهر صورة الذات العامة يائسةً تكابدُ الانهزام، تراقب بعين قلقة يقظة حركة الفاجعة المستمرة، حيث نراها بائنةً في قوله:
لم يعدْ للبكاءِ غيرُ الفرسْ
لا سيولَ الدم المقدّسِ تَمحُو
ظلمة الوحش عن رحيقَ الغزال
لا ولا حائط الزهور الجريحْ
إذ الحائط ساكنٌ معنىً، وقُدُسِيٌّ دلالةً، والزهور على الحائط همُ [الشهداء = صورُ الشهداء]، والجرح سمةٌ للحائط، والدلالات العامة تكتنز بالوشائج التي بين هذه المفردات( رحيق،زهور/ غزال، جريح)، أيضا نجد التضاد بين (لم يعدْ) وبين (للبكَاءِ غَيْرَ الفَرَسْ) من خلالِ مظهري السواكن والمتحركات في أبنية اللغة، إذ (لمْ يَعُدْ) مَظهر سكوني، و(للبكاءِ غيرُ الفرسْ) مظهر حركي؛ وينسحب المظهر الحركي على المفردات المتحركة في معانيها "كالبكاءِ" وأيضاً يتبدى المظهر الحركي في "غيرُ" المتحرّكة في مستوىً نحوي، أما بالنسبة لمفردة "الفرسْ" التي تموضعت في آخر السطر الشعري مُسكّنة، فإنّ حركية المعنى فيها تطغى على ظاهريّة هذا السكون على حرف المفردة الأخير.
الحلقة الثانية
الشاعر في حوض الأنا
أسّسناَ الموقفَ آنفاً بقولنا: إنّ الحركةَ، في قصائد الشاعر، تحِلُّ، في مَظْهَرينِ اثنينِ: مَظهرِ حياةِ اللغة بمعانيها ودلالاتها وتحليقاتها سيولة مفرداتها، ومَظهرِ الحَدْرِ والهرولةِ والدوران- الكائنِ بفعل "البنيان التفاعيلي" المُتَّبعِ في القصائد. إذ نقرأ في إنتاج ذلكَ أن شكل الكتابة يعبّر عن مضمونِها من تلقاء حركتها؛ إنها كتابةِ دَفْعٍ وجَرْفٍ ودَعْوةٍ وتوصيةٍ لإزالة والتخلّص من ملموسات حياةٍ لا إحراز فيها. إنّ الكتابة لديه، مُضيٌّ وإيغالٌ وتجديفٌ في علوّ اللغة، بما في عملها من تدافعٍ وتولّدٍ ذاتيّ للصور والتراكيب، وحركاتٍ تدفّقية منفعلة في حوض (الأنا) التي من أحد معالمها وجودُ [سُرّةَ صِفْر مُنصهرة] فيها. إنها، أيضاً، كتابة أنا تنمّ عن التدفّق سعياً لكسرِ [هذا المقفلِ الأبديّ]؛ طلباً في استرجاع الوجه الذي كانَ [واحة منبسطة]، فهنا يقول: [وجهي استقطاب جلد للسعار]، وهناك يجزمُ مرتين، ويقرّر في الثالثة في المقطع13 من قصيدة: "سيرة للصور":
لم أعدْ ألبسُ صَحْوِي
لم يعدْ وجْهي أليفاً لي
إن هذي بؤرةٌ في قدر الغامض مني.
وفي قصائد الشاعر عرضٌ لمسردِ صورٍ نحدّدُ منها موقفَه في إطار الجدلية بين الانتماء للواد المنخفض الضيق، وبين الاندفاع للارتفاع والتفرّد والانطلاق في ظلّ المشاداتِ بين الملموس والأنا. فليس غريباً، إذن، أن يتمخضُ في القصائد تحجيم وتضئيل وتقليل الشاعر لقيم أناه، والتأشير لها في مفرداتٍ =أو= علاماتِ، وصور وجمل شعرية فعلية كما نرصد ذلك في:
- أحتوي سرّة صفر منصهرة.
- أنحني للواد أو أدفع للصمت صغار الحركة.
- تمنح النقص تعاويذ .
وأيضاً، نرصد ذلك في جمل دعوةٍ أو مطالبة خاصّة مثل:
- أنت يا سعري قِلْ أو تأسّس في فَمِي كي أمّحي.
- أنتِ يا صغرى خطوطي.
ونتعرف، في طريق ذلك، على (أنا) تُخبرُ، تُعرّف، تَمسَخُ وجودَها:
هذا التقليل من قيم الأنا، وهذا الإمحاء والمسخ وإنهاء الصلاحية، إنما يشي بقسوة الملموس التي تجعلُ الأنا تقتصّ وتبخّسُ من حضورها، حيث لا معنى تمنحه الحياةُ .. ولا غودو. في المقطع(12) من قصيدةٍ " سيرة للصور" يقول:
قلّما أفهم من يقصدني،
ربما أبواق غودو أنهكت هذي الحواسّ.
غير أنه، وعلى الرغم من حالة الإنهاك في داخل [حوض الأنا] يستأنفُ التردّد في المقطع(3) من قصيدة "عرائش":
وأنا التردّد بين أغنية تموء كروح قطّ في لظى جسدي وأزمنة عجاف.
إنه تردّدٌ حائرٌ بين مطالبةٍ =أو= أغنية تموءُ كروح قطّ في لظى جسده =أو= مكانِه، وبين أزمنة عجافْ. وفي هذا ما يعبّرُ عن الانصراف الفردي لتقديم غناء التفرّد في المعاناة كما في المقطع(5) من "عرائش": وتفرّدي بالنارِ في حوض الأنا. وقد كانَ في المقطع(4) في القصيدة نفسها. يغني غناءً جمعياً:
لنا قلاع من دموع الصمت تحت البحر أو بين المرايا والجبين
ندثر الدنيا بأحرفنا الصغيرة حين يحملنا إلى أبنائها نبض ويرقدها التحول والأنين
نروح حين نعود من أنفاسنا الثكلى ونطلع كالحجارة منهكين
نشكو الدوائر والنبات المر في أسمائنا ونحط كالرمل الحزين على مصير العابرين
لنا حدود خلف أعمدة المكان وفوق أجنحة الزمان وكلنا وغد أمينْ.
وعن الجدلية بين الانتماء للواد المنخفض الضيق، وبين الاندفاع للارتفاع والتفرّد والانطلاق في ظلّ المشاداتِ بين الملموس العام والأنا، نمسك على مفاتيح كثيرة داخل بنية النصوص، لكننا سنبدأ بهذا الشاهد من المقطع (1) في قصيدة "سيرة للصور" يقول فيه:
أنحني للواد أو
أدفع للصمت صغار الحركة.
أما بشأنِ الاستمرارية في "أنحني للواد" فنجد تأشيرة لها من الشاعر في المقطع(7) من نفس القصيدة، إذ يشير: ذاك رأسي/ صاغر كالاشتعال المنتحر. لكنه في المقطع(8) من قصيدة " عرائش" يسألُ:
هل أنحني، والصمت في عينيك مصباحٌ
تصوبه حدود النار نحو رواية الغرق الأكيدْ.
وكان قد بدأ تجديفه في المقطع(1) من "عرائش" بـ: لغة تجدّف كالمصابيح المريضة في بحار الصقر/تحت عباءة الوجع الغريب. وهو ما يقود إلى رصد علامات مهمة داخل القصائد تكشّف عن طغيانِ واقعِ الانحناء للوادِ؛ هذه العلامات طاغية بحضور مِثلياتٍ عن ظرفية المكان اللافتة، ونعني بالمثلياتِ هذه التحتيات والخلفيات التي يكرّسها الشاعر في نصوصه:
- تحت عباءة الوجع الغريب
- تحت الجليد
- تحت البحر
- تحت الأرض
- خلف نجوم عارية
- خلف رقّ أو خضوع
- خلف أعمدة المكان
- خلف ما يبكي الأصيل.
ومع ظهورٍ نادرٍ للظرف "فوق"، وقد أتى في مقطع، منفرداً موحّداً لـ"أجنحة" الزمان. على اعتبار الأجنحة إشارة أمكنة. ولتوسعٍ أكبر في القراءة التطبيقية للجدلية بين الانتماء للواد المنخفض الضيق، وبين الاندفاع للارتفاع والتفرّد والانطلاق أو بين الطلوع والخضوع في ظلّ المشاداتِ بين الملموس العام والأنا نقرأ في المقطع (5) من قصيدة "عرائش":
يا نواة الافتراس تبوئي نفس الشموع
واسغرقي روحي وأجساد الصغار ومزقي لغة الطفولة والدموع
وتفرّدي بالنار في حوض الأنا
واستعبدينا ربما نعوجّ منكِ فلا نجوع
وربما سنعيش تحت الأرض عبّاداً لأوتاد النوارس والطلوع
وربما سنموت كالكلمات من خرس الشفاه وكالحقيقة؛
حين تسقط خلف رقّ أو خضوعْ.
وترد الأوتاد بمعنى الجبال كما في الآية الكريمة{وجعلنا الجبال أوتاداً}، وكان الشاعر قد أتى بصورة أخرى لها علاقة بالأرض في المقطع (7) من قصيدة "عرائش" وهي:
إرجع إلى قمح السماء وكن كمن ولدته أمّ واحتوته سنابكُ الغاباتِ.
حيث القمح والولادة، وسنابك الغابات. وقد جاءت المجاورة بين القمح والسماء، وبين السنابك والغابات، وكان ذكرٌ لولادة الأمّ. مثل هذه العلاقات إنما تشي بتحولات الانبعاث والحياة المحمولة على فعل الأمر الجوّاني "إرجع"، ذلك أن أوتاد النوارس والطلوع هي مرتفعاتُ أو جبالُ كائناتِ الغاباتِ الطائرة نسراً كانَ أو صقراً أو نورساً. وثمة تعاكس ينم عن جمالية ومعنى حاصل بين [أوتاد النوارس] و بين [سنابك الغابات]، فالأوتاد (كائنات جماد)، والنوارس (كائنات حية). والـ(سنابك) مجاز مرسل: وهي أجزاء عضوية للخيول الكائنات الحية. وهكذا نرصد عناصر الطبيعة وكائناتها والعلاقات والطموح الذي فيها. كما تحضر الصحراوات -التي لا تظهر- في النصّ حضوراً متعالقاً بالمفردة المقابِلة (الغابات). وبالمفردة الدالة ( سنابك) وهي المجاز المرسل للكائن الحيّ. وتنشأ المفارقة في المقطع من انصراف السنابك بعلاقتها التجاورية بالغابات إلى غاية الجموح والتحرّر التي تنشدها الأنا التي في حوضها الـ[تحت الأرض]، وهي في حالة انحناء للواد! وفي قول الشاعر:
وربما سنموتُ كالكلماتِ من خرس الشفاه وكالحقيقة؛
حين تسقط خلف رقّ أو خضوع.
ما له صلة بقوله:
لنا حدود خلف أعمدة المكان وفوق أجنحة الزمان. وكلنا وغدٌ أمينْ.
ذلك أنّ [خلفَ رقّ أو خضوع =أو= حدود خلف أعمدة المكانْ] = الوادِ الـ[تحت الأرض]. والأعمدة بمعنى الأوتاد بمعنى جبال المكان. أما بخصوص [فوق أجنحة الزمان]، فكما أسلفنا، هذه الـ"فوق" لا تظهر إلا نادراً متصلةً المكان والزمان معاً، مثلما نعاين الأرض والوقت كذلكَ في المقطع (5) من قصيدة "سيرة للصور":
إنما الأرض غراب ريشه تربة قحطٍ
إنما الوقت جناح أخرس
لولبٌ متصلٌ مع آخر الملح وأغوار الكسور.
ولعلّ صغار الحركة التي تكشّفت، آنفاً، عن تضيئل وتحجيم وتقليل الشاعر لقيم الأنا هي وصايا للتصبّر والنهوض؛ تحملها أفعالُ الأمر في المقطعين أدناه:(6) و(7) من قصيدة "عرائش"، في الوقت الذي هي مطالبةٌ تحثّ عليها (أنا جوانية) تنشط فوقياً، فيما الجسد بحواسه السفلية منهكٌ؛ هذه (الأنا الجوانية) التي تنشط فوقياً هي التي تكتبُ: أدفعُ للصمت صغار الحركة. بغية إحراز التجاوزِ والعلو والتحليق أو التجديف العلوي [في بحار الصقر] التي [تحت عباءة الوجع الغريب]، والصعود باللغة والتحليق فوق واد أو الحوض الأنا، والقراءة، من ثمّ، في أحوال هذا الحاضر السفليّ في المقطع (6) نقرأ:
لا يأبه الماضي لما تعطي شفاه الحاضر السفلي
من حركات صوت في مهبات الخرس؛
فامسح كلامك من بقايا الليل وامسكه على رعد بعيد أو فرسْ
وانشر نجومك في سماء المتعبين ولا تخف ممن يعيش فقط على حجم النفس
وأرسل سماء للسماء وطابعا لتحوّل المجهول واصرخ؛
طالما ارتعدت على أذنيك روحٌ لا يباركها جرس
واحلب سطورك من سحابات الشرود وخلف ما يبكي الأصيل
وما يعيق الظلّ عن فتكٍ بتاريخ الحرس
واقطع خطوط البحر واكتب ردة الأشياء عن أوكارها
وافهم وصايا من أتى بالطين خصبا أو غرس.
أيضاً في المقطع (7) نقرأ:
إرجعْ إلى قمح السماء
وكن كمن ولدته أمٌّ واحتوته سنابك الغاباتِ
واقرأ باسمك السفليّ أمواج الحياة.
نلاحظ في المقطعين السابقين وجود ( الحاضر السفليّ) و (الاسم السفليّ)! ما يؤشّر، على (الحاضر العلويّ) و(الاسم العلويّ) = أو = (الأنا الجوانية) التي تنشط فوقياً في حاضرٍ علويّ، فيما الجسدُ =أو= {المكانِ، الحاضر، الاسم} بحواسه الأرضية السفلية منتهك ومنهك. وإنا نتبصّر، في المقطعين السابقين، في حركاتٍ وأصواتِ لغةٍ فيها شيءٌ من دَفْعِ الله؛ لولاه لذوت الأنا وامحت في انكسار ما تعطي شفاه الحاضر السفليّ!
إجمالاً وتخصيصا؛ً تَظلّ لهذا الصوت ميزته وخاصيته المتمثلة في أنه يكتب قصيدة "التفعيلة"، ويتحرّك في منطقةٍ إبداعية راقية في مستويات: الخصوبة الشعرية ، الامتلاك اللغوي والتحليق الرمزي والدلالي، وهكذا نقرأ القصائد من علوٍّ شعري ذي موضوعٍ وخطابٍ يدسّ العام بين في الخاص، الواقع في الخيال، ويعلو الخيال الجماليّ على الواقع المكانيّ الزمانيّ، وتتحلّق الذاتُ الشاعر في فلكِ خطاب التمني والاستحالة الذي يقدمه الشاعر الفلسطيني معين شلولة.
(الضوء الثاني)
قراءة في نصوص للشاعر ياسر أبو جلاله
مشهدية السقوط
تأويلُ المسافة، وخطاب الشاعر الحميم
الشاعر ياسر أبو جلالة، صوتٌ شعريّ يمتازُ بخصوصيةٍ، تنشغل نصوصُه بالهمّ والبحث الإنساني الوجودي؛ تتحرّك في حالة سقوط مستمرة، تُعرَضُ عرضاً مشهدياً خاصاً، نستقريءُ فيها حالات تيه وفقدان وحرمان متوارية بين العلاقات المشتبكة والمتداخلة بين الخاص والوطني. وهي تنشغل، أيضا، بالمتناقضات والمتقابلات والمتجاورات كالموت / اللاموت، الجسد / الروح، المكان / الزمان، الظلام / الشمس. ويقدم الشاعر القصيدة القصيرة المختزلة؛ فالقصيدة لديه مشهدٌ يلمُّ شتاتَ العام في الخاص دونما ضجّة أو جلبة. وتظهر الذات الشاعرة في أقوى معطياتها الشعرية مُحملةً بإشارات المعرفة والتجربة، إلى جانب ثراء التناول الموضوعي، والاكتناز الرمزي والتعدد وخصوبة الحقل الدلالي وجماليات بناء اللغة.
في قصيدة له بعنوان "فسيفساء" يقول:
تتأرجحُ المسافةُ بين الموتِ
واللاموت...
حين أسقط كظلام هزمه طلوع الشمس
حين تزدحم هواجس النبوءة/
قد أكون إلهاً أتعبته الانحناءاتُ
قد يتسع جسدي للموت أكثر
من مرة واحدة...
فمنذ الفعل الأول " تتأرجح" في القصيدة؛ نُحسّ بوجود حالةٍ من عدم الاستقرار في " المسافة " التي هي الفاعل الأول في القصيدة. والمسافة مرآةٌ نقرأ فيها بُعدَي: [الزمان والمكان]؛ فتارةً تَتَعينُ تعيناً شيئياً مرئياً ملموساً فنكون في المكان، وتارةً تتعين تعيناً معنوياً لا مرئيا حسياً فنكون في الزمان. وهي أي، المسافةُ، تتأرجح "بين الموت واللاموت"، حيث " بين"، أيضا، مرآةٌ لبعدي: [الزمان والمكان]. إذنْ فالمسافةُ - المرآة لها انعكاساتها - تأثيراتها على المنوجد فيها [الشاعر]؛ الذي يسقط " كظلام هزمه طلوع الشمس". هذا الظلام هزمَه فاعلٌ "طلوعُ"، كما يليق لسقوط بالمسافة - المرآة. ونلاحظ فواعل السقوط الكثيرة الظاهرة والمضمرة متمثلة في ( المسافة - الفاعل الظاهر، المرآة الفاعل العاكس، الزمان والمكان - وهما فاعلان متوحدان في المسافة - المرآة، أيضا الفاعل المستتر في المسافة - الفراغ بين " أسقط " و " كظلام". إذن، فالسقوط مشهد واقعيّ ذاتي وعامّ، ظاهرٌ وباطن، مرئي ولا مرئي، ملموس وحسيّ. وليس أعظم من هذه التمثيلية التي نشاهدها في " أسقط كظلام هزمه طلوع الشمس" إذ تحيلنا إلى تمثيلية الكسوف؛ فهذه التمثيلية ليس لها زمانٌ مثبت هي تمثيلية فجائية كحالات السقوط الفجائي. عند هذه الحالات تتزاحم، في الشاعر، هواجس نبوءة مادتها رغبةُ التغيير والخلاص من المسافة-اللحظة.
قراءة الموت واللاموت
يحصر الشاعر مشهد المسافة الـ " تتأرجح "، يحصرها "بين الموت و اللاموت"؛ ماذا يعني ذلك ..؟ سنحاول فيما يلي الخروج من منطقة الحصار المنوجدة بين الموت واللاموت بإجابةٍ. وما دمنا سنحاول فيما يلي الخروج فمعنى ذلك أنّ الذات القارئة ممثلة بنا تمكث، الآن، في منطقة الحصار، تماماً، كما هي الذات الشاعرة التي تقيمُ حضورَ هذه المنطقة وتَحِلُّ بها:
تتأرجح المسافة بين الموت
واللاموت...
قلنا فيما سبق إن لـ "بينَ" بعدان: بعد المكان، وبعد الزمان. معنى ذلك أن للموت بعدان: بعد المكان، بعد الزمان؛ ونستنتج من هذه العلاقة الظرفية:
- مكان الموت وزمان الموت.
- مكان اللاموت وزمان اللاموت
نلاحظ أيضا أنَّ الموت في القصيدة جاء مُعرّفاً، ونفس الشيء مع صيغة النفي المتمثلة في "اللا" المقترنة بـ"موت"، مع تأكيد النظر على أنَّ ("الـ" موت) المُعرّفَ يعادلُ النفي الممارسَ في اللحظة الراهنة التي هي المسافة المتأرجحة- اللامستقرة. أيضا مع تأكيد النظر على أنَّ النفي المُعرّفَ؛ المتمثل في ("اللا"ـ موت) يعادلُ الغايات المرجوة المنشودة، حيث المفردات الحية الغائبة (الهوية، الحرية، الحقيقة، الخلاص).
في المقطع الأخير من قصيدة " فسيفساء" يقول الشاعر:
قد أكون إلها أتعبته الانحناءات
قد يتّسع جسدي للموت أكثر
من مرة واحدة...
ولعل أداة " قد" الاحتمالية المكررة في المقطع مرتين تنأى عن دلالة الاحتمال الأقلّ، وتدنو من دلالة الاحتمال الأرجح، ونجد الإضاءة الدلالية الأوضح في هذا الشاهد:
قد يتسع جسدي للموت أكثر
من مرة واحدة..
إذن، فالاحتمال مُنجزٌ سلفاً، وأيضا مستقبلاً، وله تداعياتٌ في الحاضر. وكأنّ ثمة جدلية ناشئة بين الماضي والمستقبل يقع الحاضر ضحية تأثيراتها. في أوّل قصيدة بعنوان " زغب" يكتب: "لا أعرف كم ناياً مزقني في شحوب عينيك". هذه الجملة تحتوي على زمنين: زمن الشاعر في الحاضر (لا أعرف كم ناياً)، وزمن الماضي (مزقني) في حالةِ أو لون (شحوب عينيكِ)، إذ هي الأنثى- الوطن( المكان).
وفي قصيدة فسيفساء : "قد أكون إله"، أي قد أكون معنىً، بل هو إله ( معنى ) أتعبته الانحناءات في المسافة الضيقة المشغولة بعدم الاستقرار. وما تجب الإشارة إليه هنا هو أن بُعدَي المكان والزمان لم يَغِبَا أبداً، إنهما موجودان بكثرة وتزاحمٍ جليٍّ وخفيٍّ في القصيدة، ففي السطر الختامي، نجد المكان حاضراً مستمراً في "يتسع جسدي"، كما نجد الزمان في " أكثر من مرة واحدة"؛ هي إذن مشاهد سقوط متعاقبة، ومستمرة في ذات ومسافة - مرآة ( مكان وزمان ) الشاعر.
في قصيدة "سقوط"، يكتب:
ثلاثون جسداً تصلبكَ الأمكنةُ
ثلاثون مصلوباً بلا روحٍ/
ثلاثون روحاً بلا جسدٍ
تسقط في آخر المدينة، تنزف
دمعاً...
تمضي بلا اسم...
تحرّفكَ الأمكنةُ، أبجديةً
تجهلها
فتجهل غوغائية البحر،
في سقوطك
وتصير فراغاً يحتضر.
نلاحظ في هذه القصيدة استمرارية مشهد السقوط، كما نلاحظ حضور المكان وغياب الزمان، وبقاء قوى النفي كظواهر ترتبط بقوى معنوية دلالية جديدة في القصيدة؛ هي ( الروح - الجسد)- التي لا تجتمع في كيان يُعرّفُ "الأنا" بهويةٍ؛ كما كان الحال في "فسيفساء"، وقد اجتمعا الزمان والمكان، أي موتا ولاموتا الزمان والمكان في كيان " المسافة". ومن المفارقات أنَّ الاجتماع المنوجد في " المسافة" جاء طائعاً لمعنى كلمة عنوان القصيدة " فسيفساء "؛ التي تعنى انوجاد المشترك والمختلف معاً، وهذا ما لم يتحقق مثلا في قصيدة " سقوط " في كيان " الاسم". ولا أدري كيف تسعى ذاتيَ القارئة لمحاولة جمع الروح والجسد معاً لخلقِ التوحُّد في هوية؛ وهذا الشاعرُ يتحدّث عن نفسه بصيغة فاعل مستتر تقديره - أنتَ- القائل " تمضي بلا اسم..."!!. ولعلّ من المفارقاتِ أيضا، أن عدم اجتماع الروح والجسد يأتي طائعاً لعنوان القصيدة " سقوط " ما يعني حدوثَ التشظي، وفقدان خلق التوحّد في هوية الشاعر والقارئ ها هنا. أيضا ثمة ما يؤشّر لي لأقومَ بإسقاط المفارقتين السابقتين إسقاطاً سياسياً، وهاأنذا أقولُ: إنَّ الضدين منوجدان كطرفي صراع في كيان المسافة خاصة وعامّةً، في اللوحةِ الفسيفسائية المعقّدة مكاناً وزماناً، هكذا تُبرزُ مشاهدُ السقوط الكثيرة جراء التنافر الحاد بين طرفين؛ كلّ يسعى لتحقيق ذاته واسمه وهويته الوجودية.
وكما أشرنا، فإن الحضور في قصيدة "سقوط" كانَ منفرداً للمكان، فنشاهدُ الأمكنة في (القصيدة - المشهد) تقوم بدور الفاعل الجلاد، ولعلّ ما يقصده الشاعر من الصلب في القصيدة هو بقاء واستمرارية المكان في صيغِ الحصار، فنقرأ استفحال التزاحم في " ثلاثون جسدا تصلبك الأمكنة"، هذه الأمكنة هي الفاعل، والتزاحم إشارته " ثلاثون " والتمييز "جسداً". كما نجد المعنى في قصيدة بعنوان " تساؤل " حين يقيم الشاعر تشبيهه التالي:
كجسد منحوت من الوجع...
... من الموت
فالجسد المصلوب من الأمكنة، هو نفسه الجسد المنحوت من الوجع- وجع الحصار- مكان وزمان الموت.
وتتجلّى ديمومة السقوط في الجمل المضارعة المتنوعة بين الطول والقصر، ففي جملة " تسقط في آخر المدينة " نحسّ بطول القراءة وبطئها الذي يُعزى إلى حرف المدّ في كلمة " آخر" التي يكتمل المعنى بدلالتها؛ بالإضافة إلى قراءة طول الجملة بصرياً. أما الجمل القصيرة فهي متقطعة في القصيدة - المشهد كما يلي( تنزف دمعاً، تمضي بلا اسم...، تجهلها، تحرّفك الأمكنة، فتجهل غوغائية البحر، تصير فراغاً، يحتضر).
في قصيدة للشاعر بعنوان: " فنجان" نقرأ:
يبعد فنجان قهوتي
أحسُّ المسافة أكثر من رشفتين
رشفة أولى
ينكسر الفنجان
يسيل المسكوب الأسود
في صمت /
ويجف...
ويتراءى لنا في القصيدة مشهد شاعر يشرب فنجان القهوة، وإقتداء بذاته الشاعرة نتابع حركة إبعاد الفنجان عن الشفتينِ، إذ بين الفنجان وشفتي الشاعر "مسافة" يُحسُّها الشاعر، هذا الإحساس بالمسافة هو اعتراف بالفقدان، لا سيما وأنه بعد الرشفة الأولى وقع حدثٌ مفاجئ؛ وهو انكسار الفنجان، وسيلان المسكوب الأسود في صمت، ما ترتّب عنه فقدان النكهة- اللذة. وفي مشهدٍ كهذا نستطيع فك رمز- دال " الفنجان " بدلالتين:
الدلالة الأولى: أن الفنجان أنثى؛ وإن كان ،ظاهراً، مُذكراً. والمسافة ما بين الفنجان وشفتي الشاعر تشير إلى الفقدان والحرمان، وتتجلى إشارة الفقدان ذاتها في موضع آخر في قصيدة " زغب "، حيث يقول الشاعر:
لا أعرف لغةً للبحر...
في معسكرنا اللاهوائي
سرقت زغبَ يمامتي من
حرير شفتيك
فما يترتب عن السرقة يعني الفقدان والحرمان. والسرقة تعادل في المعنى انكسار الفنجانِ، وأظنُّ كذلك أننا لم نبتعد عن هذا الحقل الدلالي الذي يزداد خصوبة حين نقابل بين غياب كلمة " شفتيّ" من قصيدة " فنجان "، وحضور كلمة " شفتيكِ" في قصيدة " زغب "، كما تزداد خصوبة الدلالة ذاتها أيضا في قصيدة " تساؤل ":
أي الأمكنة تتسع لي،
حين يتملكني الحنين إليكِ/
كجواد يبحث عن أنثاه المروضة حتى الثمالة.
فالسؤال هو عن الأمكنة التي تليق بعاشق يتملكه الحنين للمعشوقة، وتشبيه زمن تملك الحنين له بجواد يبحث أنثاه المروضة حتى الثمالة؛ كل هذا يشير إلى شحطات ذات متورطة بضيق الأمكنة، فلا الأمكنة تتسع، ولا بوسع الجواد أن يبحثَ حتى الثمالة عن أنثاه المروضة. هو إذن الفقدان الذي يعني غياب الأنثى متعددة الرمز والدلالةْ.
الدلالة الثانية: الفنجان مكان له حافة، وحين نعرف أن هذا المكان هو (معسكر جباليا اللاجئين) كما جاء واضحا في قصيدة " زغب ": في معسكرنا اللا هوائي"، أي في معسكرنا المخنوق؛ فسندرك أن حجم انكساره يكون فجائعياً، هذه الفجائعية نهتدي لوجودها في ملمح إشاري مُهَرَبٍ في هذه الجملة الشعرية الفعلية :
يسيل المسكوب الأسود
في صمت/
ويجف...
فالفعل "يسيل" يرتبط تراثياً، أي وفق السائد في القول والتلقي، بفاعل سائل: كالدمِ مثلاً؛ غير أنّ الشاعر أتى بفاعل مغاير وهو "المسكوب" الأسود أي القهوة. إذ البطولة للفاعل الموصوف بـ"الأسود" هنا، فإزاحة الفاعل السائل <الدم> والإنابة عنه بفاعلٍ< أسود اللون> زادت من جمالية الصورة وتركَتْ الفضاء واسعاً لتعدد الدلالة.
في قصيدة " مشهد" تَحضر كذلك الصورة الفجائعية حضوراً غاية في الحزن الصامت. ففي هذا المقطع التالي نجد علاقة اقترانية بين لحظة الحبّ والذكريات، وبين دخول الرصاصة في القلب؛ وكأن ثمة حتمية بين دخول الحب، ودخول الرصاصة في القلب. وللمفارقة، يوجد تناصّ واقعي بين الأضداد، أو هو التأثر بثقافة الحالة الوطنية، فنحن نسمع، مثلاً: خطابات عشق متداولة بين العشاق من قبيل " أموت فيك" بمعنى "أحبكِ"، هذه المتداولات تمنح ذويها معاني السعادة والفرحة وتجدّد الحياة؛ أيضا نعلم يقين العلم أنّ دخول رصاصة في القلب يعني تحقّقَ الموتِ، وإشاعة الحزن ومظاهر الحداد في الحياة. فأيّ جلالة شعرية تنافرية، إذن، هذه التي يُقدّمها، لنا، شاعر يقطن " في معسكرنا اللاهوائي"..!!
حين تدخلني عائلة من
النساء...
تدخلني رصاصة
في القلب...
فيحتويني مشهد
لكن المشهد أصغر
من أن / تسقط في التيه
وجوه تشبهني
أغواها السفر.
واستدراكاً، في مُستهلّ قصيدةِ "مشهد" نقرأ: " قد تكتمل لحظة بالزمن"، أيُّ لحظةٍ هذه التي تحتمل أن تكتمل بالزمن؟ أعتقد أنْ لا لحظاتٍ سوى لحظة كتابة الشعر التي تحاول أن تُوْجِدُ لها لحظةً مكتملةً خارج دائرة الزمن العادي بأبعاده الثلاثة( الماضي، الحاضر، المستقبل) دون وقوعٍ في تأثيراتِ لحظة نقصان الدائرة، ومحاولة تقريب دوراتها من معنى التكامل بالزمن.
خطاب الشاعر الحميم:
ونتوقف أخيراً أمام خطاب الشاعر الحميم، في قصيدة له بعنوان " إنشاد الغريب"، وفيها:
يا غريبُ / ما ينقصُنا هو نحنُ. فأيُّ وطنٍ لك/ لي ؟
والمدينةُ تحملُ ارتجافها.. وجهَها الخائفَ مني / منك
تبعثرُ هذي المسافاتِ في عيني/ عينيك
من هنا حيث لا نعرفُ هنا أو هناك نعبئُ نحن الراحلين في البحرِ وأزرقه
ولا يسقطُ من أعيننا سوى أفقٍ
يُذكرُنا ببدايةِ الرحيلِ
وقسوةِ الاغتراب
نجدُ في جملة النداء الشعرية " يا غريبُ ما ينقصنا هو نحن" أنّ هوية النداء للقريب المغتربِ في المكانِ والزمان والمحيط عامة. هنا حرصٌ حميميٌّ محمولٌ على متن هذا النداء، وثمة، أيضاً، نقصانٌ يتمثلُ في ما تملؤه مفردة "غريب" من معنى في المتلقي، وتبرز قمّة الجمالية والمعنى في علاقة التضاد بين " هو " و بين " نحن"؛ فالأولى ضمير الغائب المفرد، والثانية ضمير الحاضر الجمعي. ويبرز خطاب الحميمية كملمحٍ جمالي فريدٍ، قلّما نعثر عليه في نصوص لشعراء لا يكترثون إلا بشغل ذواتهم وأنواتهم في الخطاب؛ مُعلنين من جهتهم أنهم طرفٌ والعالم الآخر طرف آخر، ولا وساطة. ونلاحظ ضوءَ الدلالة في قصيدة "مشهد"، حين يقول: "قد تحتويني صفوة الله بين ذراعيها"؛ ما يعني أنّ الشاعر يعيش اغترابٍ واضح، ويعاني من غياب الآخر " صفوة الله". هذي محاولة جميلة لإضفاء الحميمية في خطاب الشاعر الغزي، ولعلّ ذلك يعزى إلى مُشْتَرَكِ اللحظة الشعرية الإنسانية الراهنة بكامل تنوعاتها وتداعياتها الزمانية والمكانية والفجائعية؟!