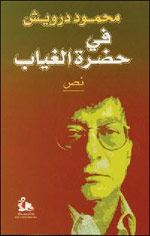 يرأب محمود درويش الصدعَ بين الشعر والنثر في نصه السّردي الجديد (في حضرة الغياب، منشورات رياض الريس، 2006)، عبر اللجوء إلى الاستعارة والتكثيف الرمزي، مطوراً كعادته أدوات التأويل البلاغية، التي تجعل الضباب حالكاً على الطاولة، وتجسرُ الهوة بين نمطين في الكتابة يميّزهما الاختلاف وليس التناقض. ولأنّ الاختلاف بين النثر والشعر اختلاف في الدرجة وليس النوع، يعمد درويش إلى تقريب المسافة المتوهّمة بينهما، فيجد الشعر الهارب من التفعيلة ضالّته في النثر الحرّ، الملوّن، والموقّع، متمرّداً على الوزن والقافية، ومحافظاً، في الآن عينه، على الإيقاع الداخلي الثري، من خلال الانتباه إلى النبر والتجويد والتنغيم، وتعزيز الهارموني التي تمسك بخيوط النص من كل أنحائه، وتجعل لغة النثر مرآة لغنائية الشعر، الخفيضة، الهادئة. وغنائية درويش تتأتى هذه المرة من اختياره السّرد الذاتي، الذي يحاور الأنا في تقلباتها وأحوالها، ويدوّن سيرة المتكلّم عبر شريط من الصور المتوالية التي تروي أحداث تاريخ دامٍ يمتزج فيه الشخصي بالعام، والواقعي بالرمزي. وليس مفاجئاً أن يقترب النص من المرثية الذاتية، من حيث نبرته التأمّلية وحرارته الوجدانية، لأنّ درويش يروي سيرة المكان الذي تعرض لخلخلة تاريخية، واستُبدِل اسمُه بالقوة، وبدّلت روايةُ القاتل روايةَ الضحية، في عملية قلبٍ تراجيدية للمصير الشخصي والجماعي. ودرويش يستنطق هذا الانزياح ويحاوره، ويغوص في طبوغرافيا المتاهة الوجودية، مدوناً شعوراً عميقاً بالفقدان، في استعادة لافتة لمأزق الشاعر مالك بن الريب، الذي يستشهد به في استهلاله، ليكون نفسه الراثي والمرثي، في معادلة تراجيدية مبكّرة.
يرأب محمود درويش الصدعَ بين الشعر والنثر في نصه السّردي الجديد (في حضرة الغياب، منشورات رياض الريس، 2006)، عبر اللجوء إلى الاستعارة والتكثيف الرمزي، مطوراً كعادته أدوات التأويل البلاغية، التي تجعل الضباب حالكاً على الطاولة، وتجسرُ الهوة بين نمطين في الكتابة يميّزهما الاختلاف وليس التناقض. ولأنّ الاختلاف بين النثر والشعر اختلاف في الدرجة وليس النوع، يعمد درويش إلى تقريب المسافة المتوهّمة بينهما، فيجد الشعر الهارب من التفعيلة ضالّته في النثر الحرّ، الملوّن، والموقّع، متمرّداً على الوزن والقافية، ومحافظاً، في الآن عينه، على الإيقاع الداخلي الثري، من خلال الانتباه إلى النبر والتجويد والتنغيم، وتعزيز الهارموني التي تمسك بخيوط النص من كل أنحائه، وتجعل لغة النثر مرآة لغنائية الشعر، الخفيضة، الهادئة. وغنائية درويش تتأتى هذه المرة من اختياره السّرد الذاتي، الذي يحاور الأنا في تقلباتها وأحوالها، ويدوّن سيرة المتكلّم عبر شريط من الصور المتوالية التي تروي أحداث تاريخ دامٍ يمتزج فيه الشخصي بالعام، والواقعي بالرمزي. وليس مفاجئاً أن يقترب النص من المرثية الذاتية، من حيث نبرته التأمّلية وحرارته الوجدانية، لأنّ درويش يروي سيرة المكان الذي تعرض لخلخلة تاريخية، واستُبدِل اسمُه بالقوة، وبدّلت روايةُ القاتل روايةَ الضحية، في عملية قلبٍ تراجيدية للمصير الشخصي والجماعي. ودرويش يستنطق هذا الانزياح ويحاوره، ويغوص في طبوغرافيا المتاهة الوجودية، مدوناً شعوراً عميقاً بالفقدان، في استعادة لافتة لمأزق الشاعر مالك بن الريب، الذي يستشهد به في استهلاله، ليكون نفسه الراثي والمرثي، في معادلة تراجيدية مبكّرة.
هنا يقدّم درويش نفسه كمدمن غياب، يفكّك الذكرى إلى لحظاتها الأولية، ويصفّي الحسرة حتى آخرها، في عودة أوليسية إلى ماض ما ينفك يولد في الحاضر: «ولد الماضي فجأةً كالفطر. صار لك ماض تراه بعيداً». ليست النظرة إلى الوراء هنا تمريناً في الحنين أو امتهاناً لنوستالجيا لا براء منها، بل هي محاولة للتطهر من إثم التناقض، والتخلّص من ازدواجية الاسم والمسمّى: «بمذبحة أو اثنتين انتقل اسم البلاد، بلادنا، إلى اسمٍ آخر.» ليس غريباً أن يرى درويش هذا الماضي البعيد فردوساً مفقوداً، تارةً، وجحيماً مستمراً، تارة أخرى. غير أن الحاضر، في كل الأحوال، ليس سوى هاوية، والدخول إليه غوصٌ مستمر في المجهول، وهذا ما يدفع الشاعر للسؤال والبحث عن معنى الهوية، في ضوء ولادة الماضي في الحاضر: «من بؤس الحاضر الجائع إلى تعريف الهوية... ولد الماضي». في النص، الذي يعتمد تقنيات السرد الروائي، ثمة استحضار متعمد لتفاصيل كثيرة عن تلك السنين الأولى التي شكلت وعي الشاعر، وبلورت مخيلته عن العالم من حوله. وفي هذا كله ينقل درويش محنة الوجود بين نقيضين، إحداهما يشدّه إلى الوراء، ويمثل ماضياً مسروقاً، وآخر يسحبه إلى المجهول، يتلخّص بأسطورة العيش في حاضر مزيف، لا واقعي. أما الغد فيظل منطقة رمادية، يصعب تلمس معالمها. كان الماضي واقعاً ملموساً، فأضحى الآن وهماً مزمناً في الحاضر. كانت البلاد حقيقةً، ماثلة للعيان، فأضحت الآن كذبةً. وفي محاولة الاقتراب من مفهوم الهوية الملتبس، يلج درويش دائرة التوتر القائمة بين الداخل والخارج، هو المنقسم، كما يقول، «إلى داخل يخرج وإلى خارج يدخل»، متأملاً بالمنفى كهوية بديلة، وناظراً للانزياح التاريخي بعين تراجيدية، هو العابر في كلام عابر، الماكث أبداً على الحافة، متأملاً ازدواجية الحضور والغياب: «عابراً، عابراً بين اختلاط الهنا بالهناك.» هنا يلعب الشرط التاريخي دوراً محورياً في قلب الأدوار، وخلط المصائر، وجعل الهوية إشكالية قائمة بحد ذاتها، بسبب ما تتعرض له من محو مستمرّ: «بساعة نحسٍ واحدة دخل التاريخُ كلص جسور من باب وخرج الحاضر من شباك.» والنص من أوله إلى آخره قائم على هذه الخلخلة التي أحدثها انزياح الاسم عن المسمى، وعلى القرصنة التاريخية التي تعرّض لها حاضر فلسطين في الماضي. من هنا جمالية التساؤل عن معنى الهوية، و، »نكوص إلى التكثيف الشعري والفلسفي في تسليط الضوء على جدلية الحضور والغياب التي يشيعها أصلاً بيت مالك بن الريب في الاستهلال الذي يفتتح النصّ: «يقولون لا تبعد وهم يدفنونني/ وأين مكان البعد إلا مكانياً؟». هنا يعي الشاعر، الراثي والمرثي، أن المكوث في الحاضر نأيٌ، بل هو شكل من أشكال الموت أيضاً.
والحاضر، بالنسبة لدرويش «الطارئ، اللاجئ،» قبرٌ يمتد بين مكانين. ثمة تلك المفارقة التي توسّع الهوة بين ما كان وما هو كائن، وفي الازدواجية التي تعاني منها الأنا، وعدم قدرتها على الانتماء حتى إلى «اللامكان»: «وإن قلتَ مجازاً إنكَ من لا مكان قيل لك: لا مكان للامكان هناك.» وعبر الحبكة المقترحة للنص يشعر القارئ بأن ثمة دائماً ما يهدّد الشاعر بالانزلاق الوشيك إلى الغياب، أو الموت، في كل لحظة، كأنما في استرجاع مستمر أو تمثل سيكولوجي لمفارقة ابن الريب، عبر هيمنة هاجس الموت أو الانتحار على ذهن المتكلم، منذ هروب الطفل درويش مع عائلته إلى لبنان، برفقة «سمسار حنين»، هرباً من ظلام المحتل. كأن الموت يكمن في كل مكان، والاستمرار في الحياة لم يكن سوى صدفة، لم تطلها الرغبة بالانتحار: «وعشتَ لأنّ ضوء القمر اخترق الماء وأضاء صخوراً مدببة أقنعتكَ بأن الموت سيكون مؤلماً لو قفزتَ من تلك الصخرة إلى البحر». سوف يلاحق هذا الهاجس درويش في محطات مفصلية كثيرة في حياته، منذ فراره مع والده، هرباً من «الضبع» الذي يحرس الحدود، إلى لحظة دخوله السجن، إلى الإقامة الموقتة في المطارات الكثيرة، والتنقل الأزلي بين العواصم «كبريد جوي»، وهذا كله يجعل الارتحال في المكان، وعن المكان، موضوعة مركزية في النص: «عشتُ في كل مكان كمسافر في قاعة انتظار».
وينتمي هذا النص إلى ما يمكن تسميته سردية الاعتراف (confessional poetry)، وهو نمط من الكتابة الغنائية السردية، التي تتعامل مع حقائق شخصية، وحالات ذهنية ووجدانية تعصف بالشاعر. ويلجأ المتكلم إلى وصف فوضى نفسية ذاتية، يعكسها وضع العالم، ليصبح الشخصي كونياً، والخاص عاماً. يستخدم درويش تقنية المونولوج الداخلي (interior monologue ) المتمثل في حوار الذات مع الذات، متجاوزاً القناع المسرحي، وتقنية استحضار مستمع متخيل، بديلاً من الأنا. هذا يجعل النص أقرب إلى هذيان تيار الوعي حيث يتحول العالم الداخلي للشخصية مسرحاً تجرى فوقه الأحداث: «وأهذي وأعرف أنني أهذي، ففي الهذيان وعي المريض برؤياه». ثمة اقتراب، كما أشرنا، إلى المرثية الذاتية، لأن درويش يتحدث عن جدلية البعد والقرب، الحياة والموت، من منظور شخصي تقريباً، مستجوباً حيرته، ومواجهاً قلقه، ومتأملاً في تلك المعضلة التي تجعل الركون إلى معنى ناجز للهوية مستحيلاً. ربما أراد درويش أن يتكلم بلسان الضحية، ويروي سيرة الصامتين الذين حُرموا من سرد قصتهم، هارباً من التدوين ذاته، ومن أسطورة المحتل الذي يلعب دور القدر الروائي الذي رسم له مصيره: «كأنني شخص هارب من إحدى الروايات المعروضة في كشك الصحف، هارب من المؤلف والقارئ والبائع». لكل كلمة هنا دلالة، بل ثمة حقل ألغام دلالي يمتد أمام القارئ، ليجعل جدلية الغياب والحضور في عنوان النص دراما ذاتية تعصف بالمتكلم الباحث عن رواية أخرى.
في هذا النص، المفتوح على تقنيات أدبية متنوعة، يقترب النثر من الشعر اقتراباً عضوياً، كما ألمحنا، بل إن المسافة بينهما تكاد تختفي، لأن الصورة الشعرية التي تميز أسلوب درويش حاضرة بقوة في نثره، ونراه يمارس شغفه بالمجاز من خلال تجريب شعري فائق في مستوى تشكيل الاستعارة، واستيفاء عناصرها البلاغية، كأن يقول: «فقد حلك الضباب على طاولتك الدائخة من فرط ما كدّست عليها من أدوات التأويل». أو كما في قوله «لو هطل المطر علينا في هذا الليل لذاب الظلام ورأينا خطانا والطريق». كما أنه يستحضر لمسته السينمائية أو التشكيلية في الوصف، راسماً مشهد الأفق في قرية فلسطينية نائية، لكي يدلل رمزياً على عبثية المكان المنسحب، الذي يتعرض هو الآخر لخلخلة جذرية: «بيوتٌ لو نظرت إليها من تحت كرم الزيتون لرأيت لوحة عشوائية رسمها فنانٌ أعمى على عجل، صخرة على صخرة، ونسي أن يرشّ عليها شيئاً من نعمة اللون، فقد كان خائفاً من أن يرى، فجأة، ما صنعت يداه».
تظل هذه اللوحة السريالية لبيوت مقذوفة في العراء الأعمى عالقة في المخيلة ونحن نغادر نص درويش، مستحضرين مكان البعد في بيت مالك بن الريب، الذي يرثي غيابه في حضوره، تماماً كما هو حال درويش في نصه، الذي يجعل الارتحال أو الانزياح ثيمة مركزية في سرده: «عشت عصي القلب، قصي الالتفاتات إلى ما يوجعُ، ويجعل الوجعَ جهة، وإلى ما يرجع من صدى أجراس تضع المكانَ على أهبة السفر». ولكي لا يظل الكائن دائماً على أهبة السفر، يدوّن درويش صدى تلك اللحظات، منوهاً بعلاقته الوجدانية بالمكان البعيد، النائي، المنسحب، مستنداً إلى وجع الشاعر، وحنينه إلى مكان لا يرتحل، لا يسافر، ولا يسقطُ البتة في الغياب.
الحياة - 22/09/2006