(حاملُ الفانوس في ليل الذئاب "يرتحل وحيداً في برلين")
نعت حركة شعراء العالم الشاعر العراقي سركون بولص أحد أعضائها البارزين الذي اختار صباح الإثنين نهايته في برلين.
وقالت الحركة في بيان وقعه الشاعر يوسف رزوقة الأمين العام لها، ممثل العالم العربي بعد كمال سيتي ورعد مطشر وآخرين، يغادرنا صباح اليوم، الاثنين 22 اكتوبر 2007 في برلين وبعد صراع مرّ مع المرض، سركون بولص، شاعرنا العراقي الكبير الذي تناوبته الأراضي البعيدة والغربة الكاسرة حتى استقر به التطواف في المانيا ليلفظ بها أنفاسه الأخيرة وهو في الثالثة والستين ربيعاً.
ولد سركون بولص عام 1944 بالقرب من بحيرة الحبانية، العراق، يقيم منذ عام 1969 في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة وقد أمضى السنوات الأخيرة متنقلاً بين أوروبا وأميركا، وخصواً في المانيا حيث حصل على عدة منح للتفرغ الأدبي، وحيث صدرت له ثلاثة كتب بالألمانية، غرفة مهجورة، قصص، 1996 شهود على الضفاف قصائد مختارة، 1997 وأساطير وتراب، سيرة وقد أصدر بولص: "الوصول إلى مدينة أين"، "الحياة قرب الاكروبول"، "الأول والتالي" 2002 "حامل الفانوس في ليل الذئاب"، "إذا كنت نائماً في مركب نوح"، و"العقرب في البستان".
كما اصدر ترجمته لكتاب ايتيل عدنان هناك في ضياء وظلمة النفس والآخر، وسيصدر له هذا العام "النبي" لجبران، "ورقائم لروح الكون"/ترجمات مختارة.
وحسب افادات صلاح عواد، فان سركون بولص كان ينتمي في الستينات وقبل ان يهاجر إلى جماعة كركوك الأدبية، حيث برزت وقتها اسماء عدة من العراقيين الناطقين بالسريانية، مثل الشاعر وراعي الادباء (الاب يوسف سعيد) والشاعر العبثي الراحل (جان دمو) وكذلك الشاعر العراقي الاصيل والمتميز (سركون بولص) هذا الشاعر المنحدر من مدينة كركوك حاول مع أقرانه حين وصلوا إلى بغداد في الستينات تغيير خريطة الشعر العراقي، جيل قصيدة التفعيلة ومن بغداد حمل سركون بولص مشروعه الشعري، حيث توقف في بيروت وتعرف على تجربة مجلة شعر اللبنانية وساهم في تحريرها وترجم العديد من النصوص الشعرية من اللغة الانكليزية، خصوصاً لشعراء القارة الأميركية. ثم منذ فترة تزيد على عشرين عاماً هاجر سركون بولص ليقيم في مدينة سان فرانسيسكو وخلال الاعوام التي قضاها هناك، بقي سركون مخلصاً للشعر ولترجمة الشعر، واثناء تلك الاقامة الطويلة التي قرر ان ينهيها بالذهاب إلى أوروبا، خصوصاً إلى لندن وباريس والمانيا حيث حصل علي عدة منح للتفرغ الأدبي، طور الولايات المتحدة لم يتخلص من لهجته البغدادية وبقي نفس القروي ذلك القادم من كركوك.
يقول في قصيدة له بعنوان " حديث مع رسام في نيويورك بعد سقوط الابراج.
نهايتك انت
من يختارها؟ قال صديقي الرسام.
انظر إلى هذه المدينة. يشترون الموت بخساً، في كل دقيقة، ويبيعونه في البورصة بأعلى الأسعار كان واقفاً على حافة المتاهة التي تنعكس نازلة على سلاسل مصعد واسع للحمولة سفلاً باثني عشر طابقاً إلى مرأب العمارة.
انها معنا، الكلبة
سمّها الابدية، أو سمها نداء الحتف
لكن شيء حد، إذا تجاوزته، انطلقت عاصفة الاخطاء.
انها حاشية على صفحة الحاضر.
خطوتها مهيّأة لتبقى
حفراً واضحاً في الحجر
أرى اصبع رودان في كل هذا
أراده واقفاً في بوابة الجحيم، يشير إلى هوة ستنطلق منها وحوش المستقبل، هناك حيث انهار برجان، وجُنت أميركا.
هكذا حدث الرسام صديقه الشاعر وهو يسأله: نهايتك أنت، من يختارها؟ في اشارة إلى البرجين اللذين انهارا في نيويورك وكأنهما يخفيان برجاً آخر هو الشاعر سركون بولص وقد "اختار نهايته" هناك، بمنأى عن النبع والأصدقاء.
"رحل الشاعر الكبير سركون بولص لنظل نذكره بين قصيدة وقصيدة فمثله لا يموت وان اختفى عنا".
علي بدر (*)
بولص بطل حياة لم يأخذ منها غير موته
طوال تاريخ العراق كانت الموجات الأدبية والتيارات الثقافية تأتي من المركز، وللمرة الأولى يأتي شباب صغار السن من محافظة نائية (كركوك) إلى بغداد ويخطفون الأضواء.
كانوا مهمشين اجتماعياً أي من طبقات فقيرة ووضيعة. مقصيون ثقافياً أي كلهم من طوائف وأقليات صغيرة ومضطهدة، معارضون سياسياً كانوا ينتمون للشيوعية أو كانوا قريبين منها، فجأة أصبحوا مركز الثقل المعارض والمناوئ للحداثة السائدة ذلك الوقت، أصبحوا على خصومتهم وضعفهم هم التجديد المتطرف، الصارخ بهدم الأسس الكائنة والثابتة، المطالب بالشك بالموروث المقدس، هم أبطال المطالبة بالتغير والنقد والهدم والتفجير والتغيير.
ووجد سركون بولص قمة المعارضة والتغيير في قصيدة النثر، فهي من جهة لا تمتد إلى التراث العربي الإسلامي بصلة، من جهة أخرى أراد أن يصنع من اللغة الأجنبية المترجمة البديل الاستعاري لتراث لا يرثه، ومن إيقاع التوراة هروباً من البلاغة الباقلانية والقرآنية التي تذكر بالشعر التقليدي.
سركون بولس بطل أمة (أمة الأثوريين) لم يرث مها غير تشردها، ووريث أمة (أمة العرب) لم يرث منها غير هزائمها، وبطل قصيدة (قصيدة النثر) صنعت من نفيها نفيه، وبطل حياة (لا حياة) لم يأخذ منها غير موته.
فخري صالح (*)
ذلك الصوت الخفيض المتأمل
يمكن النظر إلى الشاعر العراقي الراحل سركون بولص بصفته واحداً ممن رسخوا حضور قصيدة النثر العربية منذ الستينات، حيث إنه انضم في سنوات مبكرة من عمره إلى مجلة "شعر". وكان واضحاً مما نشره في تلك المجلة التي رعت قصيدة النثر العربية أن هذا الصوت الشاب القادم من العراق ينحو بكتابته الشعرية إلى نمط مختلف، أقصد أن شعره، رغم انه لم يكن صاخباً ومهتماً بالايقاع، إلا انه كان يحاول أن يجعل من قصيدته ملتقى للميراث الشعري العربي وقصيدة الحداثة الغربية.
وهو بمعرفته المتعمّقة لتيارات الشعر الأميركي في القرن العشرين استطاع أن يحقن القصيدة العربية بذلك الصوت الخفيض المتأمل الذي يجعل الشعر استبطاناً للتجربة الوجودية للانسان العاديّ البسيط وبالإمكان القول انه كان من بين أسماء قليلة أرست ما يسمى "التيار اليومي في القصيدة المعاصرة"، وانه جعل من هذا اليومي منطلقاً لتأمل وجودي فلسفي لأوضاع الكائن الانساني.
وما لفت انتباهي في شخص الراحل في لقاءاتنا القليلة خلال السنوات الماضية تواضعه الجم وبساطته وعدم احتفاله بذاته وعدم إثارته الصخب حول منجزه الشعري رغم أن هذا المنجز يقع في قلب تحديث القصيدة العربية ويطاول في قائمته أهم ما أنجز خلال السنوات الأربعين الأخيرة في الكتابة الشعرية العربية.
جهاد هديب (*)
طاول الموتُ الغريب في المكان الغريب
هل يمكن للموت أن يكون غير مباغت؟ كان سركون مريضاً بحسب أصدقائه والقريبين إليه، هؤلاء الذين أشاروا على أن حالته الصحية في وضع صعب. كانوا يدركون أن ما من أمل. مع ذلك يبقى موت شاعر مباغتاً. مع ذلك لم تسقط نجمة ولم ترتج الأرض بل طاول الموتُ الغريب في المكان الغريب بعيداً عن اللغة موطنه الأصلي وقاربه، في الوقت نفسه، الذي أبحر به وحيداً نحو جزيرة الشعر النائية والبعيدة.
مغامرته في هجرة العراق إلى بيروت مشياً ومن ثمّ إلى أصقاع الأرض كلها تشبه مغامرته في الشعر. لم يتوقف عن التجوال بين المدن، ربما بحثاً عن مدينة "أين" كما في عنوان كتابه الأول: الوصول إلى مدينة أين.
تعرّفتُ إلى شعره مطلع التسعينات. هكذا بلا مقدمة عن سيرته الذاتية أو موقعه في خريطة الشعر العربي. كان ديوانه الأول ذاك سؤالاً شعرياً مباغتاً وحاراً عن ماهية الشعر إذ يبتغي الهبوط إلى الأرض والمشي بإحساس عالٍ بالفردية بين البشر في الطريق إلى "مدينة أين" التي ربما تكون هي مرقد سركون بولص أخيراً لتحتضنه هي لكنه لن في شوارعها ثانية مثلما مشى بحثاً عنها بقدرة الذي جمع ما ينتسب إلى الصعلكة إلى ما يقترب من المثيلوجيا.
مات سركون بولص. لكن نجمة لم تسقط وغيمة لم تمرّ وأرضاً لم ترتج. يا لمصائر الشعراء الغرباء.
زياد العناني (*)
مات ليترك الرصيف بلا شاعر
لا أعرف لماذا ترك فيّ الشاعر سركون بولص جملة من التفاصيل الشاحبة.
قبل ثلاثة شهور كنا معاً في غابة فرنسية بامتياز. اشجار باسقة وطيور غير انه لعب برأسي وجرني معه إلى الاعتراض على هذا المكان الذي قال انه لا يختلف عن قرانا الحزينة.
وافقته واعترضنا لنطرح بديلاً آخر هو عبارة عن مبغى قديم صار متحفاً وفندقاً يحمل آثار نساء غابرات من ملابس وعطور وكتب قديمة مليئة بالصور والحكايا التي تمجد تاريخ الجهد ومباهجه.
غير ان إدارة المهرجان برّدت فكرة الانتقال إلى هذا المكان ـ الحلم الذي رأى فيه بولص بعض التشابه والونس في منطقة محمّرة لا يقر بها الشعراء، خصوصاً انه ربط بين القصيدة وملابس المومسات ربطاً يكاد ينطق حينما قال: "الملابس تتحدث والقصائد تتحدث"، فقرر ان يداهم المكان ويسكنه من دون إذن فما كان من مديرة المكان إلا ان طردته بعد منتصف الليل فنام على الرصيف وهو يقول منذ العراق وأنا على الرصيف.
بولص الذي خرج من العراق في سن مبكرة قال لنا في آخر جلسة: يا أصدقائي لم أعد معارضاً لا للنظام العراقي القديم أو الجديد، انا مع بائع الثلج فقلنا: من بائع الثلج؟ فقال انا مع عزت الدوري الذي استطاع أن يمرغ أنف أميركا في الوحل في وحلها من دون ان يكتب قصيدة أو يقرأ أو يكمل حتى تعليمه الثانوي.
في تلك الليلة تحديداً تشردق وكاد ان يقضي بمرضه الغريب الذي يعني في النهاية جفاف الجسم الذي أورثه مرض القلب. وبعد ان استقرت حالته قال بصوت مرتجف "العلم تاريخ الأخطاء" ولو كان تاريخ الصح كما يقال لما كانت حالتي على هذه الشاكلة، انا عاجز وهو كذلك وكل ما اتمناه ان احصل على وجبة مملحة لا يتدخل في طهوها الأطباء.
اخيراً مات سركون ليترك الرصيف بلا شاعر ينام عليه ويترك قصائده مفرقة في مدن العالم تتحدث عن نفسها بعد ان خجل من الحديث عنها أو الدفاع عن حق وجودها، فهو الزاهد وهو جذوة الشعر الذي رآه في المخيال تماماً وليس في تبارز الأشكال ومعاركها.
سيف الرحبي
(شاعر عُماني):
الرائد الصادم والجديد في خريطة الشعر العربي الحديث
صباح أول من أمس يتصل صموئيل شمعون من لندن حاملاً خبر الرحيل الفاجع لسركون بولص بعد أن هدّ جسده المرض الكاسر المفاجئ الذي سيكون خاتمة حياة الشاعر المضيئة شعراً وتشرداً وطفولة مفارقة، هو المنتمي الى العراق ولادة و"وطناً" أولاً وإلى أميركا الشعرية والثقافية وطناً ثانياً..
أتذكر كنا في منزل صموئيل ومارغريت في ذلك الصباح اللندني الذي كنت أنوي فيه العودة الى عمان، حين قال لي؛ أفظع لحظتين في حياتي والأكثر فتكاً على المستوى الشعوري هما حين أفكر بالعودة الى العراق أو أميركا...
يرحل عنا سركون هذه المرة من غير عودة، في برلين وحيداً وحزيناً بعد رحيله المستمر في تخوم الجغرافيا واللغة، تلك اللغة التي كانت من الفرادة والنضارة والعمق بمكان قصيّ وخاص في خارطة الشعرية العربية، مؤسّسة ورائدة صادمة وجديدة أيما جدّة وأصالة غائرة في الكشف والإشراق والاختلاف.. كانت حياته في الشعر والمعرفة ولهما بالكامل، إذ قلما اشتبكت حياة الشاعر بإبداعه مثلما هي لدى سركون بولص. طارحاً عُرض الحائط بكل ما هو خارج هذا المجال الحيوي للروح والخلق..
شاء، هو المتعلق باللحظة، بالحياة الحقّة حتى الثمالة، وشاء له القدر المأسوي الذي حمله على كتفيه كما تحمل الأم رضيعها، طوال هذه الحياة الخاطفة، أن يغادر هذا الحطام في هذه البرهة من التاريخ حيث موطن الصرخة الأولى والحنين، حيث البشرية تكاد أن تصل الى قاع مستنقع البربرية والإنحطاط أو أنها وصلت. وعلى الشاعر أن يلقي التحية الأخيرة ويغادر صالة الانتظار من غير أسف أو ندم.. سلاماً على روح الشاعر الكبير وهي تنام في منفاها الأخير، موطن الأبدية.
محمد علي شمس الدين
(شاعر)
سركون بولص شاعر حمل غصة الشعر وحمل فوق ظهره آلام البلاد ورحل من العراق الى الولايات المتحدة الاميركية. سركون بولص شاعر الأمكنة القلقة والأزمنة القلقة ودواوينه التي صدرت خلال إقامته في العراق تنطوي على غبار الأمكنة والأزمنة العراقية، وتنطوي على الايقاع الشرقي. كتب سركون أشكالاً متعددة في القصيدة ولو قرأنا ديوانه "الوصول الى مدينة اين" نجد ان في هذا الديوان بصمة من ايقاع المكان العراقي لجهة اللغة والوزن، لكنه لم يبق داخل هذا الاطار فقد انسرب الى السرد الحر كما الى الأمكنة المفتوحة ولكن الغامضة أيضاً. فأين هي "مدينة أين"؟
إنها على الأرجح مدينة اللغة الغامضة والمتوترة والحرة. هل نستطيع ان نقول ان سركون كتب التوتوبيا خاصة في ديوانه "الوصول الى مدينة اين" و"الاقامة في جانب الاكروبول"، فالاكروبول هو جبل الآلهة و"اين" هي مدينة الأعماق وفي كلتا المجموعتين لا يبتعد سركون عن الاقامة في متاهة قصيدته. هذه القصيدة التي لم تستطع الثقافة العربية ان تلتقط جميع اشعاعاتها واحتمالاتها.
شوقي بزيع (شاعر):
خارج النفاق الثقافي
أكثر ما يشق على النفس ان لا ننتبه الى الشعراء الا بعد رحيلهم، ذلك ان حضورهم بيننا أو وجودهم على قيد الحياة يبدو كما لو انه يقيم حجاباً بيننا وبينهم. كأننا نشعر ان امامنا متسعاً من الوقت لكي نقول رأينا فيهم. ثم فجأة ننتبه الى ما سنقوله قد فات أوانه بالنسبة اليهم على الأقل. واذا كان هذا الأمر يصح على أحد فانه أكثر ما يصح على سركون بولص. فرغم التواطؤ الذي يقوم بين غالبية شعراء الحداثة سواء انتموا الى قصيدة النثر أو التفعيلة بالأهمية الاستثنائية لهذا الشاعر، الا ان هذا التواطؤ لم يتكرس عبر مقالات ودراسات تناولت شعره بالنقد والتحليل. كما لو ان الجميع آثر ان يبقي هذا الرأي في اطار المشافهة والكلام العابر. وأعتقد ان وراء ذلك سببين اثنين: أولهما صعوبة شعر سركون، وتغريده خارج سرب القصيدة العربية، وتركيبه الخاص الذي يجعله في حاجة الى جهد استثنائي لفهم ما استغلق منه. وثانيهما وهو الأهم في تقديري، هو تواري سركون بولص عن الأنظار بالمعنيين الجغرافي والاعلامي. فهو عبر اقامته في اميركا وفي بعض دول الغرب، آثر ان ينسحب من الحياة الثقافية العربية غير مكترث بالاعلام ولا بتسويق نفسه مبتعداً ما أمكنه عن حالة النفاق التي تحكم العلاقة بين الشعراء والمثقفين. وهو من هذه الزاوية أعفى النقاد كما الشعراء من تبعة الانهمام بشعره وأراح ضمائرهم".
اعتقد بأن سركون بولص كما شعره، يجسدان حالة المنفى بكل أبعادها وتجلياتها. فانتماؤه الى اقلية قومية ومذهبية داخل وطنه جعله يعيش حالة التهميش التي شاركه فيها عراقيون آخرون من أمثال جان دمو ويوسف سعيد، الأمر الذي حول هؤلاء الى صعاليك جدد في الشعرية العربية المعاصرة. لكن الفرق بين سركون ورفيقيه هو انه حول التهميش الاجتماعي الى حركة انقلابية داخل القصيدة الحديثة، وأعطى للصعلكة مفهومها الايجابي من حيث التجديد والفرادة والخروج على المتن. في حين ان رفيقيه انخرطا في نوع من العدمية السلوكية التي حولت احتجاجهما على الواقع الى اطار سلوكي لا لغوي. واذا كان سركون قد آثر الابتعاد عن العالم العربي برمته مختاراً منفاه الطوعي فليس فقط لتبرمه من الديكتاتوريات العربية ومن وضع بلاده المزري، بل لتبرمه من نماذج مصغرة من هذه الدكتاتوريات تتمثل في العلاقات بين المثقفين المنخورة بالفساد والاهتراء وتبادل المصالح. لذلك فهو لم يدخل في سجال مع احد ولم يتعصب لأي نموذج ابداعي يعنيه.
وكانت شخصيته محكومة بالتواضع والانسحاب والطيبة المفرطة. أما من الناحية الفنية فأعتقد بأن قصيدة سركون هي من أقرب التجارب الى نموذج قصيدة النثر الذي نادت به سوزان برنار في بيانها الشهير. فهي تجمع بين المغامرة اللغوية وبين الجدية والدأب والاعتناء بالشكل. وهي تجمع بين المجانية وبين الصدق والالتصاق بالحياة. اننا حين نقرأ شعره نشعر بقدر كبير من الاتقان الأسلوبي الذي يذكرنا بتجربة ابي تمام (الذي يذكره سركون كثيراً في شعره).
ومع ذلك، فهو يبدو كمن يرى الى العالم من مكان خارجه كأنه عالم محلوم به او مصنوع من المتخيل نفسه. تبدو لديه، على تصعلكه أعراض الحكمة حيث نستطيع ان نقتطف من شعره عشرات الشذرات التأملية والتي يمكن ان يكررها بين حين وآخر كقوله (أقصى ما يمكن ان يحدث هو الواقع). أو قوله (الألم أعمق لكن التحليق أعلى).
شارل شهوان (شاعر وروائي):
سيبقى موتك غير محقق
كنا عند الشاطئ الصخري وكان النهار شاسعاً والأفق نيئاً وكأنما لحظة ولادة الكوكب ولربما لم يكن المشهد كذلك، بل كان اعتيادياً بسيطاً وربما افتراضياً، كنا وسركون الصديق نصطاد السمك وكان معنا البحر ورائحة غريبة وعنابر مسلخ مهجور ونصب شركة الكهرباء الضخمة، وسركون الحاضر كهدير لا يتوقف وسركون مبيد الصمت ومصنع الأحلام والأوهام ومثلها القصائد المكدسة والمحمّلة في الحقائب في حقائبه والجيوب وخصلات الشعر الكثيفة كخيمة متجولة، كقبيلة شاردة.
سركون الصديق يغيب هذه المرة ويريدنا أن نصدّق، غير أن خدعته هذه الأخيرة لن تنطلي، لا يا صديقي القديم كل هذا وهم ما زلنا عند الشاطئ وسيبقى موتك غير محقق كمثل قصائدك وقصائدنا، من ذا يأبه بهباء وسخف كهذا. أيها المتشرد الأبدي، الهائم كغيمة غاضبة قاتمة أرجوانية بلون القلب والشغف. سركون العزيز لا شيء نقوله غير الألم، ألم الانتظار، انتظار شاطئ آخر أكثر بهاء في كوكب لنا سقطنا منه سهواً، لا شيء هنا يستحق البقاء...
زاهي وهبي
(شاعر):
إنضم إلى الموتى الأكثر حياة
يوم التقيت سركون بولص كان قد صار ابيض الشعر ورأيته "قديساً يملأ الباب بقامته الوضيئة"، كما في قصيدة له بعنوان "حلم أبي". ولم يك فيه ما يشبه الشعراء الآخرين. جلسنا في المقهى الباريسي وراح يحدثني بكثير من المودة وبشيء من الأخوة. ولما عبرت له عن فرحي به مشيراً الى طريقته الأخوية في الكلام قال لي "انها اخوة الشعر". ليت هذا الشاعر بيننا دائماً، ليتني عرفته في بيروت لا في باريس. فبأمثاله لا يعود الشعر يجعل الأخوة أعداء".
روى لي سركون الكثير من مغامراته ومن الحكايات الآسرة عن الغربة والمنافي وكاليفورنيا وألمانيا حيث كان في السنوات الأخيرة، وأبديت له رغبتي في استضافته في برنامج "خليك بالبيت" واتفقنا على موعد مسبوق باللهفة والشوق العارم الى بيروت والمقاهي والشعر والشعراء وشوقي ابي شقرا الذي له "أجمل المودة". وقبيل الموعد بأيام فرض المرض عليه التأجيل، ودارت الأيام وغرقت بيروت في أحزانها على الشهداء الذين سقطوا تباعاً، وطال انتظار عودة سركون بولص الى المدينة التي أحبها كثيراً وأعطاها بعضاً من شغفه العارم بالشعر ومن سعة ثقافته ومداركه.
"هل دفع الشاعر ثمن الحق بأن يدخل من باب البيت أخيراً/ أن يملك مفتاحاً وسريراً.."
هذا السوال الذي طرحه سركون في "الأول والتالي" يبدو وكأن الجواب الوحيد عليه هو الموت. أو كأن قدر شعراء العراق ان يدفعوا حياتهم ثمن الحق بأن يكون لهم سرير هو القبر، اما شهداء في وطنهم واما غرباء في مدن الدنيا، هكذا حال السياب والحيدري والجواهري والملائكة والمئات من مبدعي البلاد المغسولة دوماً بدماء بينها.
"بعد ان نام الأحياء يسهر الموتى على ضوء القنديل في بستان الفاكهة المهجور، يلعبون الورق تحت الأشجار. وأنا أصغي الى النهر عندما يجري تحت نافذتي وأسمع كيف يختلس الزمان خطاه..."
وها هو قد انضم الى "الساهرين"، الى الموتى الأكثر حياة لأنهم الأكثر بقاء في النصوص الخصبة كما لدى سركون بولص كاتب المرثية الى "الاحياء"، وفيها: "ستذكر كيف كان المذيع/ينق بالأخبار كالضفدع في كهفه الشفاف/ ويطلق فقاعات الموت من فمه/متشدقاً عن مزايا التكنولوجيا في صنع الأسلحة الفتاكة/بينما ترى التاريخ في عينيه الفارغتين يدمى ونهر الدم يجري".
على غربته الطويلة، وعلى قسوة المنافي ووحشة المطارات الغريبة ظلت مياه بحيرة الحبانية حيث ولد قبل 63 عاماً تترقرق في وجدانه كما في شعره حيث المزيج الابداعي بين أقصى "الحداثة" وأشف "الغنائية"، وقلما نجد في قصيدة النثر العربية المعاصرة مثل النداوة المبلولة بالدمع والشراسة الجارحة بنعومة الرماد الا لدى ابائها الكبار، وسركون بولص واحد منهم بلا منازع يأتيها من نبعها المتفجر في الارث الشعري العربي لا من روافدها وحسب.
"ستذكر ولن تنسى/ولن تريد ان ترى ما تراه/ستذكر قوائم احصاءاته السهلة الجريان على زجاج الكومبيوترات/وسوف تلاحظ كيف يحاذر ان يقول، كم أماً وطفلاً من بلادك يموت في كل غارة (...) ستذكر الأخاديد على شاشة بذيئة في الغرب عندما تبصر مدن الطفولة، والجسور عندما تتدلى كأضلاع رب قتيل فوق دجلة والفرات ولن تنسى..."، وسركون عاش جل حياته في الغرب ولم ينس، ظل دجلة والفرات يجريان في عروقه وفي حبره وظل في قلب حداثته صدى الموال العراقي الشجي الحنون. عاش جل حياته في الغرب. ولم يساير "الغرب السياسي" او الايديولوجي ولم يتملقه ولم ينتظر منه تكريماً أو تشريفاً. وظلت عينه على تلك البلاد، بلادنا التي تقسو على أبنائها وتجور وتبقى عزيزة.
رحل هذا العراقي الشجاع. رحل وتحت ابطه دفتر على غلافه أرزة لبنان (اقرأ قصيدته "لقاء مع شاعر عربي في المهجر). رحل ودخان الدم المتصاعد من بغداد لا يحجب عن ناظريه حقيقة المشهد، رحل كاتباً على "شاهده": "ما تبنيه اليوم، قد ترقص في خرائبه غداً. اذا كنت تبحث عن شاهد تطلع الى المرآة".
*******
قصائد غير منشورة لسركون بولص
يصدر قريباً عن "دار الجمل" ديوان ضخم لسركون بولص بعنوان "عظمة أخرى لكلب القبيلة"، وكأنه ديوانه الأخير أو الديوان الذي يصدر بعد رحيله بأيام معدودة. في هذه القصائد من الخصب،
والتدفق، والتنوع، والصراخ، والألم، والحنين، والاحتجاج، والقسوة، والحنان... فيه من هذا الخصب ما يشبه أرض العراق، وأنهاره، وسماءه، وتاريخه، وآلامه، ومكابداته، وأوجاعه، وجروحه، وأهله، وأمواته، كأنه رحلة أخيرة الى العراق، صاغها سركون بولص بنبرات حية، مروسة، مؤثرة، قريبة، متوغلة، كاسرة، حارة، متوهجة. ذلك أن سركون بولص لا يعرف "الحياد" في شعره، ولا الركون خلف الصمت، والانزواء عن الحياة والواقع والتاريخ. إنه في "الأتون" يكتب بلغة صنو الأتون، واللهب، والحجارة.
هذه القصائد التي ستنشر بعد أيام عن "دار الجمل" كان أن اخترنا، وبما للصديق الشاعر خالد المعالي الناشر عندنا من ودّ وتقدير، وما لنا عنده من تجاوب وتعاون، كان لنا أن ننشر هذه القصائد لتكون شهادة أخرى عن كبر سركون وعلوه، وخصوصيته وريادته الأصيلة (لا كريادات طازجة مفبركة من بعض اخوان الصفاء). إنها تحية سركون لنا بعد رحيله وهي أجمل التحايا لأنها تنزرع في الوجدان والعقل... والشعر.
سقط الرجل
في وسط الساحة
سقط الرجل على رُكبتيه.
ـ هل كان متعباً الى حدّ
أن فقد القُدرة على الوقوف؟
ـ هل وصل الى ذلك السدّ
حيث تتكسّر موجة العُمر النافقة؟
ـ هل قضى عليه الحزن بمطرقة يا ترى؟
هل كان إعصار الألم؟
ـ ربما كانت فاجعة لا يطيق على تحمّلها أحد.
ـ ربما كان ملاك الرحمة
جاء ببَلطته الريشية عندما حان له أن يجيء.
ـ ربما كان الله أو الشيطان.
في وسط الساحة
سقط الرجل فجأة مثل حصان
حصدوا رُكبتيه بمنجل.
فجوة الأزمنة المتاحة
لا حد لهذا الهُجران، أزاوله
كأنه عادة مزمنة، أثقل من فيل هرم يتربّع في
مرجة محصودة بلا عشبة، وفي فجوة الأزمنة المتاحة لي
أطلّ بنصف وجهي لأشهد أيامي المدفوعة وراء القضبان
تتمرّغ في طين الإمكان مثل عصفور يتمرغل وسط بركة ضحلة.
وها هي ذاكرتي التي لم تُرد أن تصير كيساً تلقي فيه الآلهة
فضلاتها المتبقية من عشائها الأخير، تؤرّث نارها.
ها هي تخطيطات دماغي المهزوزة في آخر الليل
على صفحات دفتر أسود تركته خلسة تحت باب المحكمة
حيث ينتظر الشاهد القروي في قصة كافكا أن يفتحوا له الباب.
أجلجل هذه المفاتيح لا لأنني سجّان، بل لأنني
أنا من يفتح الأبواب، ولا يعرف كيف يغلقها، وينام.
أم آشور تنزل ليلاً الى البئر
وكيف حال أم آشور...
سألت أهلي حينما زرت مدينتي المهدّمة
الموشّحة بدخنة الحروب، بعد سنوات طويلة
من الغياب... أين أم آشور التي كانت مرضعتي
بصدرها الأرحب من هذه الدنيا
ووجهها، إلهي
الذي برت ملامحه المذابح والكوارث حتى اكتسى
بتلك الهالة، حتى تقدّست العينان؟
خبّرني، يا عمانوئيل، أيها الصديق
عن أم آشور: أين هي، كيف تقضي
أوقاتها؟ خبّرني يا عمانوئيل، أيها الصديق
عن عزيزتنا أم آشور...
تقصد عمّتي، أخت أبي الكبرى
أم آشور؟ هي ذات العينين الحزينتين
مُذ كانت طفلة، حتى قيل أنها سيدة الأحزان السبعة
تحكي لنا عن هروب أهليها عبر البراري
عن الأطفال تحت سنابك الخيول؟
هي التي كانت تطردنا بالحجارة كلّما
سرَقنا طماطمها الصغيرة
لكنها تحاذر أن تُصيبنا، ولا تُصيب
سوى سياج البستان؟
أم آشور، عمّتي، أخت أبي الكبرى
ومُرضعتك الفاضلة أيها الصديق
ذات الصدر الأرحب من هذه الدنيا
والوجه الذي برت ملامحه المذابح والكوارث
وموت الأحبة، وفراق الأبناء
حتى اكتسى بتلك الهالة
حتى تقدّست العينان... تعال الليلة
لأريك أم آشور، تعال معي أيها الصديق
لنزورها عندما تنزل ليلاً الى البئر.
تقول إن الأرواح تناديها شاكية
من أبعد الأماكن لتنزل الى البئر
وتواسي أمواتها، منذ ذلك اليوم الأسود
يوم جاؤوها بآشور.
حينما سجّوه بين يديها، صاحت من الأعماق:
إلهي
من ينزع هذه الشوكة السوداء من قلبي الآن؟
سمعناها، وأحنينا الرؤوس، وماذا
سيرفعها بعد الآن؟
تعال الليلة
لأُريك أم آشور، تعال معي
أيها الصديق
لنزورها
عندما تنزل ليلاً الى البئر.
جسدي الحيّ في لحظته
النوافذُ مغطاة بستائرها المخرّمة، وأنا
راقدٌ في سريري، بؤرة لشذرات آتية من باطن أرضي أنا،
جسدي الحي في لحظته، هذا التنور الذي لا يكف عن تدوير الأرغفة
للجياع المزدحمين على بابي.
وجهي معلى للسماء وما من زاوية للتنحي
شعري معفّر بأتربة الشمس، والهواء يدخل قمرات سفينة
أبعثُ بها إلى البحر، بين آونة وأخرى، مصنوعة من كلماتي.
كلماتي المليئة بالنذائر، والنذر، ومفاجآت أيامي.
هي الأثقل من تراب قبر أبي المجهول في مسقط رأسي.
لا، لست الطريح الذي قد تتخيل، على سرير انعزالاتي
أبعد من أن تصلني صيحاتك المجيدة.
النور يملس وجهي، والرؤية قد تحيل جدران غرفتي
إلى مسرح ورقي، يشعل فيه النار عود ثقاب.
يدي قد تسقط حملها من الكلمات على هذه العتبة المغطاة بالخطى
وتبعثرني ريحُ الربّ الغاضب المترنح في مسيرته عبر
الصحراء كحفنة.
من الحنطة.
(آه، يا أوجه التواريخ الجريحة!)
هذا أنا: صوت أجراسي الخفية في اللحم، أعلى من عاصفة وشيكة.
محمود البريكان واللصوص في البصرة
حبلُ السرّة أم حبل المراثي؟
لا مهرب: فالأرض ستربطنا إلى خصرها
ولن تترك لنا أن نفلت، مثل أم مفجوعة، حتى النهاية.
كل يوم من أيامنا، في هذه الأيام، جمعة حزينة!
ويأتيني، في الجمعة هذه، خبر بأن البريكان
مات مطعوناً بخنجر
في البصرة
حيث تكاثر اللصوص، وصار القتلة
يبحثون عن... يبحثون، عمّ صار يبحث القتلة؟
حتى هذا الشاعر الوديع لم ينج، هو الذي
كان يعرف منذ البداية لون القيامة، وهجرة الفراشة
نحو متاهة العالم السفلي، حيث الليل، والله، واحد.
أكانت هذه معرفتك، هل كان هذا سرّك؟
كنت أراك، أنت الملفّع بغشاء سرّك
بين حين وآخر، في مقهى "البرلمان"
حديثنا عن رخمانينوف، عن موتزارت.
واليوم الذي أتذكرك فيه
اليوم الذي فيه بالذات أراك:
كنت اشتريت "صور من معرض" لموجورسكي
من "أوروزدي باك"...
والله أعلم كم كلفتك تلك الأسطوانة
من راتبك الضئيل!
(سأسمعها، في ذكراك، اليوم، نفسي)
سأصغي... وها هو الخبر يأتيني.
حبل السرّة انقطع، وامتد حبل المراثي.
انه الليل. نم، أيها الشاعر. نم، أيها الصديق.
الناجي
قاموس الندى، معجم الأنداء الساقطة
عبر الأفق المجمّر على وجهي: أنا قيلولة ذاتي.
أنا ظهيرة أيامي. أنا لست سوى هذه الصفحة المحترقة بنظرتي.
الريح وحنجرتي: أنا من يُنادي بين سارية المستقبل، وراية
الماضي.
أنا العبد. أنا العاجز، بعكازين تحت إبطي أعرج نحو المنتهى
يتبعني الموت بأرجل عنزة سوداء.
تتبع رأسي حربة الساحر ذات الرأسين
وأعرف أنني، رغم هذا، سأنجو لأروي الخبر على الأحياء.
بورتريه للشخص العراقي في آخر الزمن
أراه هنا، أو هناك:
عينه الزائغة في نهر النكبات
منخراه المتجذّران في تربة المجازر
بطنه التي طحنت قمح الجنون في طواحين بابل
لعشرة آلاف عام...
أرى صورته التي فقدت إطارها
في انفجارات التاريخ المستعادة:
عدوّ يدمرّ أور. خراب نيبور. يدمر نينوى.
خراب بابل. يدمر بغداد.
خراب أوروك.
صورته التي تستعيد ملامحها كمرآة
لتدهشنا في كل مرة
بقدرتها الباذخة على التبذير.
وفي جبينه المغضّن، مثل شاشة
يمكنك أن ترى طوابير الغزاة
تمرّ كما في شريط بالأبيض والأسود.
إعطه أي سجن ومقبرة، إعطه أي منفى...
سترى المنجنيقات تدك الأسوار
لتعلو في وجهك من جديد.
وبأي وجه ستأتينا، هذه المرة، أيها العدو؟
بأي وجه،
أيها العدو،
ستأتينا هذه المرة؟
الكمّامة
اليوم أريد أن تصمت الريح
كأن كمامة أطبقت على فم العالم.
الأحياء والأموات تفاهموا
على الارتماء في حضن السكينة.
لأن الليل هكذا أراد
لأن ربّة الظلام، لأن ربّ الأرمدة
قرر أن آخر المطاف هذه المحطة
حيث تجلس أرملة وطفلتها على مصطبة الخشب
بانتظار آخر قطار ذاهب إلى الجحيم، في المطر.
المستقبل
الاربعاء 24 تشرين الأول 2007
-الحياة
سركون بولص، غامر بالقصيدة والحياة وصنع حداثته
عالياً وعموديّاً
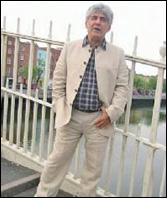 بوصفها هيَ هيَ،
بوصفها هيَ هيَ،
لا بوصفها وَزناً أو نثراً، ينظر سركون بولص إلى الكتابة الشعريّة
ويمارسها. الكتابة عنده وجودٌ آخر داخلَ الوجود. هكذا لا يُجابِه إلاّ نفسَه
فيما يجابه العالم. وإذ يتجنّب، ويحيد ويعتزل، فلغايةٍ واحدة، أن تكتمل المسافة التي تقتضيها هذه المجابهة، والتي تتيح له أن يُحسِن الرّؤية، لكي يعرفَ كيف
يخترقُ ويستشرف.
ولا يجادل -
ليكن الخيرُ، كما هو، خيراً لأصحابه. وليكن الشرّ، كما هو، شرّاً لأصحابه.
وَلْيتصارعِ المتصارعون.
أمّا هو فيُؤْثِر البقاءَ في الضوء -
في سرّة الشّيء،
عالياً، وعموديّاً.
القيَمُ أراجيح،
والضوء في ما وراء الجهات.
وما «الرسالة»؟
الماءُ، وديعاً، يَنفَذُ ويغوص.
الهواء يُلامس الوردَ والشوك باليد نفسِها.
والجَناحُ هو الأخُ الأقربُ إلى الأفق.
ولا فَصْلَ بين الواقع وما وراءه:
المخيّلة عند سركون بولص معجونةٌ بالمادّة كأنها جسدٌ آخر في جسده.
شعرُ سركون بولص يسألني.
لهذا أحبّه.
* كتب أدونيس هذا النص قبل يومين من وفاة سركون بولص، لينشر في كتاب يضم مختارات من شعر الراحل يصدر بالانكليزية عن دار بانيبال في لندن.
***
الشجرة الباسقة التي عبرت القارات
لا شيء أكثر صعوبة من أن تفقد صديقاً عرفته طوال نصف قرن من الزمان، والأكثر من ذلك أن ترثيه. فإذا ما فعلت ذلك فكأنك ترثي نفسك أنت بالذات. ترثي تاريخاً لا تعرف كيف مر وانتهى. لا أريد أن أفكر في سركون خارج الحياة، لأنه سيكون ضد كل ما كتبه وعاشه في حياته، هو الذي لم يعتقد قط بأي نهاية لتلك الرحلة التي كانت قد بدأت ذات يوم في الحبانية وأينعت في كركوك ثم صارت شجرة باسقة عابرة للقارات.
عرفت سركون شاعراً حقيقياً منذ اللحظة الأولى التي التقيته فيها في مقهى في منطقة القورية في كركوك في العام 1958 وكنا لا نزال تلاميذ في المدرسة، حيث أطلعني على قصائده الأولى التي كان قد كتبها، ثم صرنا غالباً ما نلتقي في مقاهي كركوك او في غرفته الواقعة في بيت أهله في منطقة «التبة» القريبة من المقهى الذي كثيراً ما كنا نلعب فيه «البليارد» أيضاً الى جانب لعبة الشعر. كنا نجلس ساعات وساعات في تلك الغرفة الواقعة في نهاية الفناء ونقرأ ونحلل كل قصائد العالم ونحن نحتسي الشاي الذي كانت تقدمه لنا والدته. وحينما انتقلت بعد عام من ذلك الى الجامعة في بغداد كان سركون كلما قدم الى بغداد ليقيم عند أقارب له في منطقة «الدورة» يقضي معظم وقته معي، متنقلين من مقهى الى مقهى ومن شارع الى آخر.
ربما كان سركون الشخص الوحيد الذي لم أكن لأجد موضوعاً آخر أتحدث فيه معه غير الشعر، وكأن العالم خلق من الشعر وحده. كل ما عدا ذلك كان يعتبر شأناً ثانوياً لا قيمة كبيرة له. في كل مرة نلتقي فيها كنا نقرأ قصائدنا على بعضنا ونتحدث عن أهم الأعمال التي كنا قد اكتشفناها لتونا، وبالذات للشعراء والكتاب الأميركيين والإنكليز الذين كنا نتابع أعمالهم وإنجازاتهم بكل حرارة الأدب التي كانت وحدها تشكل معنى حياتنا. بعد أربعين عاماً من ذلك وكنا مدعوين الى مهرجان شعري في صنعاء قال لي سركون: «هل رأيت؟ يومها حين كنا نجلس في مقهى أطلس في كركوك لم نفكر في أن الشعر يمكن أن يقودنا حتى الى صنعاء، ولكنه قد فعل ذلك. أليس في هذا ما يشبه السحر؟»
أجل، كان الشعر في نظره شيئاً يشبه السحر. كل جملة، بل كل كلمة هي خلق جديد للعالم، ولذلك ينبغي لك الحذر دائماً حين تبتكر وصفتك الشعرية الكيماوية التي يكون أي خطأ فيها قاتلاً.
لم يكن سركون يحب العمل الوظيفي، فكرس بالمقابل كل حياته للشعر. ففي رأيه أن الشعر والعمل لا يتفقان. فإذا ما أردت أن تكون شاعراً عليك أن تهب حياتك كلها للشعر، بل أكثر من حياة إذا ما كان في إمكانك فعل ذلك. ولكن لذلك ثمنه الباهظ أيضاً، وهو القبول بالعزلة التي تفرضها على نفسك.
في كل الفترة الطويلة التي أمضاها سركون في سان فرنسيسكو ظل يعاني الوحدة والعزلة التي أثرت كثيراً على روحه وحيوية جسده، ولذلك كان يستغل كل فرصة للهروب من سجنه الأميركي ليكون حاضراً بين أصدقائه الكثيرين الذين يحبونه. وبالطبع كانت مغامرة كبيرة منه، وهو الناجي لتوه من مشكلات فعلية بالقلب، أن يترك أميركا قبل بضعة شهور ليحضر مهرجاناً شعرياً في لوديف وآخر في روتردام ثم أن ينتقل الى برلين ليمكث فيها، غير آبه بنصائح الأطباء وآلامه الجسدية. لكنه، وهو يفعل ذلك، بكل خياليته الشعرية، كان يهرب من وحش أكثر فتكاً، وحش عزلته الذي كان يخيفه أكثر من أي وحش آخر. لم يعتقد سركون في أي يوم بأنه يمكن أن يموت. وقد كان محقاً في ذلك.
***
الشاعر الذي جُنّ من الإفلاس والمحبة
في مجلة منزوعة الغلاف وقعتُ على قصيدة لشاعر طالما سمعت باسمه من دون أن اقرأ له، مجلة وجدتها في بسطة كتب على رصيف في شارع من شوارع بغداد في السبعينات. القصيدة هي: «آلام بودلير وصلت» حيث الشاعر الذي جنّ من الإفلاس والمحبة، الجمرة في اليد والقدم الحافية تسعى.
بقيت الصورة راسخة والأملُ يحفرُ في موضعه، والألمُ أيضاً.
ترى صورة الشاعر وتجده، اليومَ هنا، البارحة هناك، سنوات مرّت وأحداث أقلها مُرعب، كرّت، والشاعرُ الذي أحرقَ عقبُ سيجارةٍ أصابعه وهو يلاحق الصورةَ في القصيدة لسنوات بلا كلل أو ملل. القصيدة التي تجد نفسها وقد ولدت في أسطر مرتعشة الكلمات، والشاعرُ يجلوها من جديد بعد كل إعادة كتابة من دون أن يصله الرضا ويترك القصيدة كي تأخذ طريقها.
تجدها في دفاتر متفرقة، على أوراق روزنامات لبلدان عديدة وسنوات متباعدة والشاعر ينظر إليها بعيني صقر، يعرف ما ينقصها، لكنه ينتظر اللحظة المناسبة التي يطول انتظارها لسنوات حتى يضع الشاعر اللمسة الأخيرة.
شاعر أساسي؟ أهم شاعر عربي معاصر بعد بدر شاكر السيّاب؟ تقرأ له بلغات عدة وهو يبرق في القصيدة، لغتهُ واضحة وأفكارهُ نُسجت بعناية لا تجد لها مثيلاً في الشائع من الشعر العربي السائد اليوم!
لم تعنه الشهرة، أحيانا مغمض العينين، ومستريحاً في سريره ينصت إلى سيرة الحياة في كل مكان قاده قدره إليه. ترى فيه المراقب الدؤوب لكل ما يدور حوله، حتى لكأنك تجد المكان أمامك وتشمّ الرائحة ولو كان الوقت خريفاً لعرفت فوراً أنه الخريف.
كان يكتفي بهذا القليل، فالعين تبصرُ آخر الطريق، وتقيس المسافة المتبقية تنتظر من ليست لديه المؤونة.
تقرأ القصيدة وتعرف المسافة الفاصلة، تقرأ ترجمته لتعرف كيف عرف أن يغوص على المعاني... وما عليك ان أردت معرفة الفارق سوى قراءة ترجمته لبضع قصائد من شيموس هيني وأي ترجمة عربية أخرى للقصائد ذاتها...
قبل اسبوعين كنت عنده في المستشفى، حالته تحسنت، جلسنا مع مؤيد الراوي، صوّرنا أنفسنا، بل طلبنا من جاره المريض أن يصورنا، واستعدنا روح النكتة كالعادة. ألقى نظرة أخيرة على ديوانه «عظمة أخرى لكلب القبيلة». وفي اليوم التالي زرته ليشرح لي على الورق اللمسات الأخيرة على الديوان، فيما بقي الغلاف معلقاً، ذلك أننا اتفقنا على رسمة انجزها ضياء العزاوي عن قصيدة له.
كان عليه أن يسافر يوم 27 من الشهر الجاري الى سان فرانسيسكو حيث يقيم. وأتيته كي أودعه ولكي نلقي نظرة على رسمة الغلاف التي أرسلها ضياء العزاوي وعلى مقترحات الغلاف الأخير... وحالما وصلت برلين، وجدت الألم، جنون الألم قد غيّر الميزان ولم يعد سركون يستطيع الجلوس ولا النهوض. وبين هذه وتلك، كنا، مؤيد الراوي وأنا، عاجزين هنا، سركون قال لنا إن الأمر يبدو خطيراً هذه المرّة، وألقى نظرة على مقترح الغلاف بصفحتيه... خرجت من عنده وهو يعتذر عن آلامه التي قال أو بالأحرى أمل، وأملنا، بأنها غداً ستختفي...
وأتيت غداً، لم يفتح البابَ لي أحدٌ، ولا ردّ علي الهاتف... وأنا بين أمل ويأس، أمل في أن يكون مؤيد قد أقنعه بالذهاب إلى المستشفى الذي لم يعد سركون يطيقه، ويأس لم أرد حتى أن أعرف خفاياه، وهكذا عدنا إلى الشاعر الذي افترسه الألم ولم تعد المحبة قادرة على فعل شيء.
***
عاش دوماً في زمن مقبل
لن يكون رحيله مفاجأة كرحيل من إذا رحل... راح، فهو المرتحل أبداً إن بين قارات الأرض وإن في أصقاع المغامرة، وإن في الكلمة والحياة. وليس من قبيل التأدّب أن قصائده الماضية هي أجمل القصائد يوم ننهض من كبوة الحاضر. عاش سركون بولص دائماً في غد الزمن المقبل. كلّ غروب رفّت له عيناه كان فجراً. هذا الأشوري الذي مشى صافياً كالبرق من العراق عبر الصحراء إلى سوريا فلبنان كي يلتقي قصائده المنشورة في «شعر» ولم يكن في جيبه فلس ولا قطرة تعب على جبينه، هذا الأشوري ظلّ يبتسم هازئًا بكل الصعاب، بلا بيت، بلا جواز سفر، بلا نعل غير الذي ألصقته رمال القيظ بقدميه.
طالما قال لي يوسف الخال ان قصائد سركون أدركته في بيروت مثلما تظهر طيور غريبة فجأة على النافذة، ترمقك بشزر، تحطك في قلقك وتختفي، كأنها بانت في منام. وحين وصل سركون في أوائل الستينات إلى عتبة يوسف كان يشبه ناطوراً عارك الذئاب فأكلها وما تركت فيه سوى خدوش طفيفة: أنا هنا! هربت من سجن بلادي ومن شجونها وما معي سوى هذا القلم!
كانت مراحل عبوره إلى الولايات المتحدة مسبوقة بتسكعه في بـيـروت يوم كانـت بيروت مملكة الشعراء. الكل قلقوا عليه وجهدوا لاستصدار جواز له من الأمم المتحدة. وبقيت جيوبه مملوءة بالقصائد وبقي هو مبتسماً في وجه التوقعات. ذلك الثبات لديه، تلك الصلابة، توّجهما دائماً بضحكته البيضاء. وحين صعد إلى الطائرة أخيراً لم يلوّح لأحد. كأنه كان مدركاً أن خميرة حضوره باقية في معجن ذاكرتنا. وكان على حق.
في مطلع الثمانينات، وفيما الحرب تأكل لبنان، قيَّض لي الإمساك برسن الحظ لمرة فأرسلت «أستنقبه» من سان فرنسيسكو إلى أثينا بعدما اكتنفت غيابه غمامة طويلة: تعال إلى القرب يا سيرغي، أثينا عوضاً عن بيروت.
ثلاثة أعوام بين 1982 و1985 تبدو لي اليوم مثل مدى ازرق لا يؤطره زيح، ولو أن سركون كان قانطاً تماماً من جدوى النشر في العالم العربي. يكتب لأنه لا يستطيع إلا أن يكتب. تحت السرير، تحت الوسادة، بين الصوفا والجدار، في جيوبه الذاهبة إلى الغسيل... كنت أصطاد القصائد له وأحاول زحزحة عناده حيال نشرها. أخيراً قبل على مضض كؤود، وهكذا أخذت ديوانه الأول «الوصول إلى مدينة أين» وطبعته في بيروت وحملته له كي يفرح.
حكايتي مع سركون أطول من طريقنا معاً بين سان فرنسيسكو ورينو طوال الليل بدعم سائل من الصديق البني جاك دانييلز... إلا ان ذكرى يوم معين في مقهى مهجور على شاطئ بيريوس بانتظار سفينة تقلنا إلى الجزر الإيجية والريح تعبث بالبحر وبأحلامنا، تلك الذكرى أخذتني اليوم إلى دفاتري المهجورة حيث قرأت من سطور سركون: «قبل أن نترك هذا الميناء، قبل أن نجرع هذه الجعة، قبل أن يفرغ صحن اللوز، علي أن أتذكر. في الصباح كانت نياتي واضحة: أن أجد حلاقاً. في لندن ترددت في أن أسلّم رأسي إلى حلاق إنكليزي. دخلت دكان حلاق في باريس كانت له أخت في تكساس حدثني عنها طويلاً، بفرنسية – انكليزية – إشارية، فهمتها جيداً متعاطفاً معه: البعد، الأخت البعيدة. ولكنه نسي أن يقص شعري».
كان ذلك صباح الحادي عشر من الشهر الأخير من سنة 1982 وكان معنا دفتر نكتب فيه مداورة كلّ ما من شأنه الاحتيال على الزمن.
***
لقاء أول به ... وأخير
كان لقائي الأولُ به هو الأخير فعلاً. لم أترك بابَ صديق من الأدباء إلا طرقته بحثاً عن وسيلة اتصال به، عن رقم تليفون، إيميل، عنوان بريدي. أي شيء! الكلُّ أجابني أن أرقامه سريّةٌ وأنه يحب عزلته التي اختارها لنفسه في سان فرانسيسكو منذ عقود.
بعد دعوتي الى المشاركة في مهرجان الشعر العالميّ في روتردام هذه السنة، راسلني فيليم آنكر، أحد مسؤولي لجنة المهرجان، قائلاً إنهم كانوا يودون دعوة سركون بولص، الشاعر العراقي الكبير، لكن أعيتهم سبل الوصول إليه! لذلك ما باليد حيلة وسأكون وحدي العربية! وأنا كذلك أعيتني الحيل. لكنني لم أيأس كما يئسوا هم. فمَن أجملُ منه يمثّل شعراء العرب في المهرجان الهولنديّ؟ وحصلت بعد جهدٍ على إيميله من صديق. وراسلوه. ومن طيب الظروف أن لبّى وشرّف المهرجان بحضوره الجد جميل.
مادام يحب العزلة، أقول لنفسي، فبالتأكيد هو شخصٌ باطنيٌّ غيرُ اجتماعيّ ولا يحبُّ الناس.ّ واللقاء به، فضلاً عن مرافقته أسبوعاً كاملاً، سوف يكون عملاً ثقيلاً وصعباً. واطمأننتُ لقراري بعدم الاقتراب منه، والكلام معه في أضيق الحدود. على أنني لم أعد أذكر هذا القرار إلا الآن فقط فيما أكتب عنه في مماته. إذ بمجرد لقائي به لم أجد إلا أحد أجمل خلق الله، روحاً وبساطةً ورقياً وتواضعاً مشوباً بنرجسية رفيعة تليق بالشعراء. لكنّ ثمة وعداً لم يتم. فحين عرف افتتاني بـ «نبيّ» جبران، وعدني أن تكون أول نسخة، من ترجمته العربية التي يتوفر عليها تلك الأيام، لي.
غير مسموح لك أن تدخن على مقربة منه، بسبب آلام حنجرته. لكنك لن تعرف هذه المعلومة منه، فهو أرقُّ وأرقى من أن يطلب هذا، بل من أصدقائه العراقيين الذين يتوافدون من أنحاء أوروبا ليلتقوا حبيبهم المهاجر إلى بلاد العم سام منذ العام 1969. كي يتجمهروا حوله في مظاهرة حبٍّ تلقائية لا توجدها إلا حالٌ حقيقية من الإكبار والمحبة والفخر بهذا الشاعر الذي أنجبه العراق ليعتلي قمّة الشعر العربي مع قلة ممن يجارونه قامةً وعلوّاً.
أمسيةُ الافتتاح كانت مبرمجة ليلقي فيها كل شاعر قصيدة حول «كلمة» يحبها وتتكرر في شعره ويعدّها ملهمتَه. وحده سركون بولص صعد المنصّة ليقول: وماذا عن الكلمة التي «لا» أحبها؟ ثم قرأ قصيدة عنوانها: «الرئيس». لاعناً فيها كلَّ قامعٍ مستبدٍّ وفاشيّ. إنه الشاعر الذي يؤمن أن لا شيء فوق الشعر إلا الحرّية، وأن لا رئيس على الإنسان سوى نفسه وكلمته.
***
كل يوم ... بيومه
لا. لن أبكي على رحيل سركون، لن ألومه «لوم الصديق» على عدم اعتنائه بصحته التي تدهورت في شكل خطير بين لقائنا الأول في مهرجان «أصوات المتوسط» عام 2005 ولقائنا الثاني في المهرجان ذاته في أقل من ثلاثة أشهر.
هكذا عرفته، بعدما عكفت على ترجمة شعره إلى الفرنسية. يعيش كل يوم بيومه، حتى الثمالة، وكأنه يومه الأخير. لا. لن أسرد صفاته اليوم أو أتحدث عن شخصيته التي أسرت كل الذين عرفوه بالطريقة ذاتها وتبيّن لي بسرعة أنها الشخصية العربية الوحيدة التي يجتمع جميع الشعراء والمثقفين العرب على مدحها.
سأقول فقط أنه بهذا الإجماع إنجازاً فريداً وصلباً على أرضيتنا الرملية المتحركة وتحوّل إلى مثالٍ مشترك لنا كإنسانٍ وشاعر.
***
الرائد بامتياز و ... المظلوم
عندما يتوقف قلب شاعر له قامة سركون بولص، الرائد بامتياز، في حركة الشعر العربي الحديث، والمظلوم بامتياز من أقرب الأقرباء، ممن سبقه منهم ومن لحقه، عندما نخسر هذا المغامر الفاتن، والرفيق الغالي، المنتَظَر ببهجة، هو وقصيدته، هل سيكون في وسعنا أن نعود إلى أنفسنا كما كنا؟
لقد فقدنا، اليوم، رفيقاً في رحلة قاتلة. اقتسمنا معه المنفى الأكثر عبثية لشرقيين بلا أمل.
وضيعناه في مكان ما من هذه التغريبة.
هل من جديد؟ إنها الأمثولة نفسها: نفقد ونندم، ثم نفقد ونفقد ونندم.
كنت كتبت لك رسالة طويلة يا سركون عن أشياء طريفة من صيف مضى. هل تذكر؟ وها أنا أفقد خفّتي، وأمحو كل شيء.
أيها الشاعر، الموت ينحني لك لتمر.
***
الكرسي
كرسيّ جدّي ما زالَ يهتزّ على
أسوار أوروك
تحتَهُ يعبُرُ النهر، يتقلّبُ فيهِ
الأحياءُ والموتى.
***
أبي في حراسة الأيّام
لم تكن العَظمة، ولا الغُراب
كانَ أبي، في حراسة الأيام
يشربُ فنجان شايه الأوّل قبل الفجر، يلفّ سيجارته الأولى
بظفْر إبهامه المتشظّي كرأس ِثُومة.
تحت نور الفجر المتدفّق من النافذة، كانَ حذاؤهُ الضخم
ينعسُ مثل سُلحفاة زنجيّة.
كان يُدخّن، يُحدّقُ في الجدار
ويعرفُ أنّ جدراناً أخرى بانتظاره عندما يتركُ البيت
ويُقابلُ وحوشَ النهار، وأنيابَها الحادّة.
لا العَظمة، تلك التي تسبحُ في حَساء أيّامه كأصبع القدَر
لا، ولا الحمامة التي عادت إليه ِبأخبار الطوَفان.
***
سقط الرجل
في وسَط الساحة
سقطَ الرجُلُ على رُكبتيه.
هل كان مُتعَباً إلى حدّ
أن فقدَ القُدرة على الوقوف؟
هل وصلَ إلى ذلك السدّ
حيث تتكسّرُ موجةُ العُمر النافقة؟
هل قضى عليه الحزنُ بمطرقة ٍ يا تُرى؟
هل كانَ إعصارُ الألم؟
رُبّما كانت فاجعة ًلا يطيقُ على تَحَمّلها أحد.
ربّما كان ملاكُ الرحمة
جاءَ ببَلطته الريشيّة عندما حانَ لهُ أن يجئ.
ربّما كان الله أو الشيطان.
في وسط الساحة
سقطَ الرجلُ فَجأةً مثلَ حصان
حصَدوا رُكبتيه ِبمنْجَل.
***
جسدي الحيّ في لحظته
النوافذ ُ مُغَطّاةٌ بستائرها المُخَرَّمة، وأنا
راقدٌ في سريري، بؤرةً لشَذراتٍ آتية من باطن أرضي أنا، جسَدي
الحيّ في لحظته، هذا التنّور الذي لا يكفُّ عن تَدوير الأرغفة
للجياع المزدحمينَ على بابي.
وجهي مُعَلّى للسماء وما من زاويةٍ للتنَحّي
شَعري مُعَفَّرٌ بأتربة الشمس، والهواءُ يدخلُ قُمرات سفينة
أبعثُ بها الى البحر، بين آونةٍ وأخرى، مصنوعة من كلماتي.
كلماتي المليئة بالنذائر، والنُذُر، ومفاجآت أيّامي.
هي الأثقَل من تُراب قبر أبي المجهول في مسقط رأسي.
لا، لستُ الطريحَ الذي قد تتخيّل، على سرير انعزالاتي
أبعدَ من أن تصلني صيحاتُكَ المجيدة.
النورُ يُملّسُ وجهي، والرؤيةُ قد تُحيلُ جدرانَ غرفتي
إلى مسرح ٍورَقيّ، يُشعلُ فيه النارَ عُودُ ثقاب.
يدي قد تُسقطُ حِمْلها من الكلمات على هذه العتبة المغطّاة بالخطى
وتُبَعثرني ريحُ الربّ الغاضب المترنّح في مسيرتهِ عبرَ الصحراء كحَفنةٍ من الحنطة.
(آه، يا أوجُهَ التواريخ الجريحة!)
هذا أنا: صوتُ أجراسي الخفيّة في اللحم، أعلى من عاصفةٍ وشيكة.
الحياة
24/10/2007
***
- البديل
«سركون بولص» حامل الفانوس في ليل االذئاب
غيب الموت ـ أمس الأول ـ الشاعر العراقي سركون بولص، بعد صراع طويل مع المرض، وبعد حياة كانت حافلة بتنوعات وسفر قام به بولص الذي لم يكن يهدأ، ترك العراق أواخر ستينيات القرن الماضي إلي بيروت ثم إلي سان فرانسيسكو حيث استقر فيها لمدة تزيد علي العشرين عاما، ثم انتقل بعدها إلي برلين ليموت هناك .
ولد سركون في عام 1924 في شمال العراق بكركوك المدينة الصناعية البعيدة عن العاصمة بغداد حيث كانت توجد بالمدينة شركة نفط كبيرة كان زاده هو ورفاقه فاضل العزاوي ومؤيد الراوي وجان دمو وصلاح فائق، الذين كانوا ملمين باللغة الإنجليزية قراءة الشعر الغربي والشرب من منابعه بلغته الأصلية مما ساعدهم علي تكوين " جماعة كركوك". ثم بعد ذلك سافر إلي بيروت مدينة الحلم بالنسبة له و نشر قصائده في مجلة شعر في مرحلتها الثانية بعدما تركها ادونيس ورفاقه.
ابتعد سركون بولص عن الساحة الثقافية والشعرية جاعلا من حياته شعرا ومن شعره حياة
ومن أعماله " الوصول إلي مدينة أين " و" الحياة فوق الاكربول" و"إذا كنت نائماً في مركب نوح" و "حامل الفانوس في ليل الذئاب " اضافة إلي مجموعة بعنوان، عظمة أخري لكلب القبيلة، تصدر خلال أيام عن دار الجمل . اللافت أن " البديل " حين حاولت استطلاع رأي الشعراء المصريين وحول إنتاج الشاعر الراحل هالتنا حالة "الجهل" بمنجزه الشعري بخلاف الصحافة اللبنانية التي أفردت مساحات واسعة للحديث عن الشاعر الراحل وأعماله.وربما يكون "الجهل" بإنتاج سركون في الساحة الشعرية المصرية ناتجا عن ندرة كتبه في المكتبات المصرية اذ ان غالبيتها نشر بين المغرب وبيروت والمانيا من خلال " دار الجمل " التي بدأت نشر أعماله الشعرية تباعا وفي طبعات فاخرة . هناك سبب آخر يعود إلي قلة أعمال «بولص» الذي لم يكن شاعرا غزير الإنتاج. ومن ثم فإن قلة من الشعراء هم من يعرفون تجربته عن قرب وإن قرأ البعض الآخر قصائد متفرقة لكنها لاتسمح بتكوين رأي محدد بحسب رأي بعض من استطلعنا آراءهم
وباستثناء عبد المنعم رمضان لم نجد شاعرا مصريا من الشعراء المكرسين علي صلة بانتاج سركون فيما كان أثره لافتا في شعراء الثمانينيات والتسعينيات.
لا يتوقفون عن تقليده
أذكر أن شبابا من اقراننا حفظوا الحياة قرب الأكروبول عن ظهر قلب، وأعادوا إنتاجه، وابتسروا منه ما استطاعوا، ومع ذلك فإن حضور سركون في أدبيات الشعرية العربية ونقدها لا يناسب ـ بالمطلق ـ أهمية اجتراحاته المبكرة، باعتباره همزة اتصال بين جيلي الستينيات والسبعينيات، وهذا الاقصاء ليس غريبا علي حياتنا العربية علي كل حال . غير أن اغترابا دام أكثر من أربعين سنة لشاعر في قامة سركون بولص دون أن ينتبه الكثير من الأقران والأنداد فضلا عن المؤسسات الرسمية إليه، لأمر يدعو للدهشة والتساؤل، أما الدهشة فبسبب هذا القدر الفائض من الجحود والنكران، أما التساؤل فهو للشعراء قبل أن يكون للسلطات: ما الذي فعلته المؤسسات الثقافية العربية التي تقيم المهرجانات وتطبع المؤلفات وتمنح الهبات لشاعر في قامة سركون؟!
عاش بلا ظهر، بلا قبيلة، بلا مريدين. باستثناء من تعرفوا علي الأحشاء الحقيقية لتجربته شديدة الخصوصية ـ وهم قلائل بالطبع- لم يتسنَ لصاحب "الوصول إلي مدينة أين" أن ينتشر ويُدرس نقدياً ويُحدد أثره الشعري سواء بين مجايليه أو بين الأجيال التي جاءت بعده. الشعر عصبيّات، وسركون بولص لم يكن يملك ما يُديم ذكره ويدافع عن موطئ قصيدته الراسخ والمتميز.
وهب سركون بولص حياته للشعر. لم يفعل شيئاً آخر تقريباً. ولكنه في الوقت نفسه، وكأي شاعر حقيقي، لم يسعَ إلي الأضواء. لم يخطط لصناعة شهرة أو صيت مبالغ به. لم يسأل عما كانت تفعله نصوصه بقرائها. كنا نعرف أنه مريض بالشعر، قبل أن يُصاب بذاك المرض الفتاك الذي يُسرع بصاحبه إلي الموت.
كان سركون بولص شاعرأ حقيقياً إلي حد أنه أهمل أن يتقصّي عما يتسرّب من شعره إلي نصوص الآخرين. لم يكترث بأن يكون هؤلاء مدينين له، ولم يطرق أبوابهم يوماً مطالباً بما له في ذمّتهم.
وهب سركون بولص كل شيء للشعر، بحيث يصعب علينا أن نفرق الآن بين أن يكون قد فارق الحياة أم فارق الشعر.
صياد العبارات
اطمئنْ أيها العزيز سركون لقد تناقل الأصدقاء في صحفهم ومواقعهم الإلكترونية خبر مرضك ووصولك إلي مدينة أين بأسرع مما كانوا يتناقلون أخبار نصوصك ، وغمروك بألقاب : الشاعر الكبير وصياد العبارة ورائد الحداثة الثانية والحبل عالجرار ، لكن لا تقلق فالزوبعة ستمضي ويرتد البدو إلي طباعهم في الذود عن طبخة الوزن والقافية علي وقع أقدام ناقة أو بعير معبّد ، وبالتالي ستظل خماسيتك ( خمسة دواوين ) بعيدة عن نقدهم أو حقدهم ، لأنهم يمارسون
، بصدد الحداثة ، الحقد وليس النقد . أمَا قلت لك : تمهل الآن ولاتصل إلي مدينة أين بهذه السرعة وبثياب كركوك تلك عينها ، أمَا قلت لك مرّ عليّ في طوكيو لألبسك قبعة علي شكل هايكو فيستقبلك هناك في تلك المدينة "باشو" وحشد من حملة الفوانيس ، أمَا قلت لك ، أمَا قلت لك أمَا... أرهقكَ البحثُ عن نفسكَ يا سركون وأرهقتَ نفسكَ بالبحث عنكَ ، أرهقتما بعضكما: الشِّعرُ وأنتَ .
البديل - مصر
***
أنا الذي
لا نأمةٌ.
هل مات من كانوا هنا؟
لا كلمةٌ
تَرِدُ اللسان -
الانتظارُ أم الهجوم؟
أم التملّصُ من ...
كهذا الصمت
حين أُهيل جمرَ تحفُّزي حتى
يبلّدني التحامُ غرائزي: أرعى كثورٍ في الحقول
أنا نبوخذُ نُصَّر -
تُلقي الفصولُ إليَّ
أعشاباً ملوَّثةً، وأُلقي النردَ
في بئر الفصول -
لأجتلي سرّاً
يعذّبني؟
يعذبني طوال الليل. حتى صيحة
الديك الذبيح.
لأجتلي سرّاً.
وأسمعَ ضجّةَ الأكوانِِ؟
(إنهُ مأتمُ
قالوا لنا: عُرْسٌ)
جيوشُ الهمّ تسحبني
بسلسلةٍ
ويستلمُ الزمانُ أعنّةَ الحوذيّ -
تسبقنا الظلالُ.
وراءنا:
كلُّ الذينَ، وكلُّ مّنْ
"طال الزمن"، قال الرجل.
شمسٌ على هذا
المشمّع فوق مائدتي:
نهارٌ لا يضاهيه نهار. كوجه الله
تبقى تحت عينيّ انعكاستها، وتخرقني
الى قاعي كرمْحٍ -
إنها شمسي.
وملأى غرفتي، بيتي، كقارب رَعْ
تسافرُ في المتاهة
بالهدايا.
شمسٌ على صحني
وصحني، في الحقيقة، فارغٌ:
حبّات زيتونٍ، بقايا قنّبيطٍ، عظمةٌ...
ما زاد عن مطلوبنا.
تلك البقايا..
نُتفةٌ في كل يومٍ، قشرةٌ
نلقي بها في لُجة التيار - يبقى الصحنُ.
والسّكين.تبقى شوكةُ
أبقى. وجوعي، تُخمتي.
*
الشمسُ أو ليمونةٌ
تطفو على وجه الغدير المكتسي
بطحالبٍ ألقي الى أكداسها حجراً
فتخفقُ، مرةً، وتُبقْبِقُ الأغوارُ
فقّاعاتُ أوهامٍ مبّددةٍ
رغابٌ لم تجسدها الوقائعُ
جَمجَماتٌ لا محلّ لها من الإعراب
أطماعٌ. دهاليزٌ. وعود بالعدالة؟
(بالسعادة!)
رغوةُ الكلمات في بالوعة المعنى
تواريخٌ
وثمّةُ من يُفبركها، ويشطبنا بممحاةٍ -
لنبقى.
قال الرجل: "فاتَ الأمل.
زادَ الألم"
شدّوا الضحيّة بين أربعةٍ
من الأفراسِ
جامحةٍ.
جنودٌ يسكرون. جنازةٌ عبرت وراء
التل. هل جاء البرابرةُ القدامى
من وراء البحر؟
هل جاؤوا؟
وحتى لو بنينا سورنا الصيني،ّ سوف يقال: جاؤوا.
انهم منّا، وفينا. جاء آخَرُنا
ليُضحكنا، ويُبكينا..
ويبني حولنا سوراً من الأرزاء. لكن، سوف نبقى.
هناك، في بلاد باتاغونيا، ريحٌ
يسمّونها "مكنسة الله"
ريحٌ
أريدُ لها الهبوبَ، على مدار
الشرق، في أسماله الزهراء
والغرب المدجّج بالرفاه: أريد أن أختارها
لتكون لي
أن أستضيف جنونها
إذ تكنس الأيام والأسماء
تكنس وجه عالمنا كمزبلةٍ
لتنكشف التجاعيدُ العميقة تحت
أكداسٍ من الأصباغ
والدم، والجرائمِ
والليالي.
أقْبلي، يا ريحُ.
مكنسةَ الإلهِ، تَقدّمي.
قال الرجل. قال الرجل
لا ترمِ في مستنقعٍ حجراً
ولا تطرق على بابٍ فلا أحدٌ
وراءه غيرُ هذا
الميّت الحيّ الموزع بينَ بينٍ في أناهُ، بلا أنا
يأتي الصدى:
هل مات.
من كانوا.
هنا.
*
جاء الواحدُ الذي يقولُ، والآخر الذي يصمتُ.
الذي يمضي، والآتي من هناك.
بينهما
كلمةٌ، أو نأمةٌ.
بينهما أنهارٌ من الدم جرتْ، فيالقٌ تسبقها الطبولُ.
ولم يستيقظ أحد.
بينهما صيحةٌُ الجنين على سنّ الرمح
في يد أول جنديٍّ أعماهُ السُّكْر
يخسفُ بابَ البيت.
بينهما مستفعلنٌ، أو ربّما متفاعلنٌ؟
لا
ليس بينهما سوايَ :
أنا الذي
***
وها هي سِيرَةُ أَرَقِ الشاعر العراقي سركون بولص
في مدينة لوديف بجنوب فرنسا
في اللّيلةِ الأُولَى، تَكَلّمَ عَلَى مَقْربَةٍ مِن اصْطَبْل
وَعَلَى رُؤُوسِ المَساميرِ في حَذواتِ الخُيُول
سُمِعَتْ طَرَقاتُ صَمْتِها.
في اللّيلة الثّانية، في غُرفةِ الخُوري، تَحْتَ مِسْمارٍ آخَر
صَلَبَ رِجْلَي يَسُوع إلى الحائط، لَمْ يَنْبسْ
بِبِنْتِ شَفَة.
في الثّالثة، في فُنْدقٍ كانَ مرّةً ماخُورًا،
حَكَّ كِلْسًا مِنْ شِفَاهِ الحِيطان
وَخَلّاهَا تَعْتَرِف.
مَنْ يَعْرِفُ، فَكّرَ، إلى أيّ ارتفاعٍ سَتَصِلُ كَوْمَةُ
الشّراشفِ الّتِي استُبْدِلَتْ على مَرّ السّنين على
ذاتِ السّرير.
لم يُغْمَضْ لَهُ جَفْنٌ في أَيّ من اللّيالي.
الوَقُودُ الّذي أشْعَلَ أَحْلامًا ظَلَّ يَجْرِي
في مُحَرِّكاتِ الطّائرات الّتِي قَصَفَتْ
قَبْرَ أَبِيه،
هُناكَ، عَلَى الأَرْضِ الّتي
أَقْلَعَتْ مِنْهَا حَيَاتُه.
عن (كيكا)
رحيل سركون بولص
 حين التقيته، ربما لآخر مرة، قبل سنوات في مدينة الرباط بالمغرب، كان الرجل مريضا. كان سركون بولص متوعكا بجسد منهك، وكان الأصدقاء المشاركون في مهرجان الرباط، أمجد ناصر وغسان زقطان وحسن نجمي وآخرون، يتكوكبون حوله بمشاعر منسوجة من المحبة والتقدير والخوف عليه.
حين التقيته، ربما لآخر مرة، قبل سنوات في مدينة الرباط بالمغرب، كان الرجل مريضا. كان سركون بولص متوعكا بجسد منهك، وكان الأصدقاء المشاركون في مهرجان الرباط، أمجد ناصر وغسان زقطان وحسن نجمي وآخرون، يتكوكبون حوله بمشاعر منسوجة من المحبة والتقدير والخوف عليه.
كان الشاعر العراقي سركون بولص، المولود قرب الحبانية عام 1944 والذي عاش زهرة شبابه في مدينة كركوك، والراحل عنا قبل أيام قليلة، شاعرا كبيرا بالفعل، لكنه لم يثر في يوم من الأيام ضجة حول نفسه، لم يسع لكي يكرم، لم يلتفت إلى عالم الإعلام، لم يحاول تلميع نفسه. وما همه طوال حياته هو أن يكتب قصيدته، ويعيد النظر فيها حتى تصير درة لامعة تصبو إلى الكمال إذا كان هناك ثمة كمال في هذا العالم!
وهو رغم كونه لم ينشر مجموعاته الشعرية إلا بعد أن تخطى الأربعين من العمر، إلا أن حضوره البارز، وفي سنوات مبكرة من شبابه على صفحات مجلة "شعر" اللبنانية، و"مواقف" التي كان أدونيس بدأ إصدارها في بداية سبعينات القرن الماضي، كان ملحوظا ومدهشا ولافتا للمتابع الحثيث لتطور الكتابة الشعرية العربية في ذلك الزمان.
كان نصه الشعري المنشور على صفحات شعر ومواقف، اللتين عنيتا بتكريس مفهوم الحداثة الشعرية بخاصة، والثقافية بعامة، مغايرا، ينبئ بأن هذا الشاب الآشوري الموهوب، الممتلك ناصية اللغة العربية، الغائص في الميراث الشعري لإمرئ القيس وأبي تمام، يبشر بكتابة شعرية مختلفة، ويأخذ قصيدة النثر العربية في تلك السنوات في درب أخرى قريبة من موجة شعر النثر الأمريكية بأعلامها الكبار كوالت ويتمان، مازجا ذلك كله بتجربة جيل البيت Beat الأمريكي بعد أن رحل سركون إلى سان فرانسيسكو وأقام فيها معظم سني عمره.
قصيدة سركون بولص مقتصدة أسلوبيا، ليس فيها ذلك الانثيال اللغوي الذي عهدناه في الكثير من قصائد النثر العربية، حيث يمثل بولص حلقة وصل بين جيلي الستينات والسبعينات في الشعر العربي.
وهي تسعى للتعبير عن اليومي الخالص، والأرضي المنفك عن أية أفكار ميتافيزيقية، لكنها تغور عميقا للبحث عن معنى للوجود ما أمكنها ذلك.
إنها قصيدة يومية ببرنامج وجودي مضمر يحاول تأويل حضور الكائن في هذا العالم. صحيح أن سركون بولص كان قريبا من تيار القصيدة الأمريكية لكنه في أعماق قصيدته كان يزوج تلك القصيدة لميراث القصيدة العربية، لما يجذبه في إمرئ القيس وطرفة بن العبد والصنعة الشعرية لأبي تمام. ومن هنا نزوله بما يقتبسه من الذاكرة الشعرية العربية إلى الشارع، إلى اليومي المعاصر، بحيث يصبح القديم المتعالي في هذا الشعر أرضيا، قريبا من الأصابع ومن تجربة العيش الراهنة المعقدة.
صحيح كذلك أن سركون لم ينجز الكثير من المجموعات الشعرية، فما هو بين أيدينا من كتاباته الشعرية لا يتعدى المجموعات الشعرية الست (وهي:
الوصول إلى مدينة أين، الحياة قرب الأكروبول، الأوّل والتالي، حامل الفانوس في ليل الذئاب، إذا كنتَ نائماً في مركب نوح، والعقرب في البُستان، إضافة إلى مجموعة شعرية سابعة ستصدر قريبا عن دار الجمل بألمانيا بعنوان "عظمة أخرى لكلب القبيلة") إلا أن تأثيره الفعلي سيظهر في الجيل الحالي من جماعة قصيدة النثر العربية، ولن يتسنى لنا ملاحظة هذا التأثير إلا إذا أعيد طبع أعماله الشعرية مع مقدمة ضافية يكتبها واحد من النقاد الذين عرفوا سركون عبر ترحله في أصقاع الأرض.
لقد كان شاعرا أصيلا يستحق الالتفات.
fsaleh@addustour.com.jo
عن (كيكا)
***
ملاك الشِعر الأبيض
 أرفض ان اكون رثّاءة، سجينة تلقائية لفظية، ولكني هنا استعيد لمرة ثانية، تفوق سركون بولص في العيش، وولعه بالمسافات، واستغراقه اخيرا في نهاية ذابلة وحزينة، ليس تحت اصوات العويل، بل بتمتمات تعبر عن اسف رجال مهذبين، علي الشعر والشاعر.
أرفض ان اكون رثّاءة، سجينة تلقائية لفظية، ولكني هنا استعيد لمرة ثانية، تفوق سركون بولص في العيش، وولعه بالمسافات، واستغراقه اخيرا في نهاية ذابلة وحزينة، ليس تحت اصوات العويل، بل بتمتمات تعبر عن اسف رجال مهذبين، علي الشعر والشاعر.
موت علي هذه الشاكلة، وحيداً علي سرير برليني حديدي، هو تهيؤ سركون، واستعداده الباكر، وتآلفه الحدسي مع المكان الغريب.
ان كلمة شاعر تعني لي الصفات المتوافقة والمتناغمة بين المبدع ونصه. يضاف اليها سماحة القوة، وغزارة التخييل، والجمال بصحبة العظمة والسيادة والتواضع والذكاء. وانا اكتب الآن، استغرق في التفكير في ربع الساعة الاخير الذي يكون مر علي سركون المحتضر. أود لو تسني له ان يمسح احدهم جسده بقصيدة. أود لو استحمت عظامه بكل تلك الكلمات التي كتبها، وقد شوشها السرطان، متخذا شكلا نهائيا ومتسلطا.
الشعر الآن مأوي، يزدحم بالاجانب اكثر منه بالشعراء. سركون كان يعرف. كان يعرف ويضحك، كان يعرف ويبتعد. كل تألقه وقوته، انه كان يعرف.
ان ثقافة الآلام والاحزان التي غرف منها الشعراء قليلو الشعر، احتاجت الي كبرياء سركون، لرفع الابيات عالياً في فضيلة الشجاعة، فضيلة الصمت والعض علي النواجذ، وفي الرأس كالصخرة، يفتت العويل ورثاء الذات، يفجرهما.
انغماس سركون بالحياة، رفع القبعة لاغوائها، قوي كبريائه وشعره، وخلّصه من جذام العلاقات النفعية، وعصابات التكسب، والميديا البراقة الخادعة، ورحل رحيله المنتظر مجللا بالغياب الجمالي والاخلاقي في الوقت ذاته!
هل كان عليّ ان اعرف سركون بولص معرفة شخصية لكي ابتسم برقة لكل الاشياء الفاتنة والبسيطة في الحياة؟ الاشياء الفاتنة والبسيطة، مادية او بشرية اتاح لها سركون بولص ان تتنفس في الشعر، كما لو الذهب يستخرجه من الارض، وينبش في القارات بحثا عنه.
قرأت ما وقع تحت يدي من كتبه. ما تسني لي سرقته من مكتبة بسام حجار وعباس بيضون. قرأت القليل مما كتبه وقد فاتني ما خبأه في الادراج وما ضيعه في اقاماته التي لم تكفّ.
مع ذلك سمعته في الكلمات يقول لي تعالي معي. ولحقت به في الكلمات. قادني برفق من مدينة الي مدينة. ساعدني الي الجمال برقة وصبر، وكنت في رفعته، وغربته، وترحاله، حتي خجلت من تعثري بحزني المسكين الصغير، فيما يخبّ هو كحصان مجروح، ضاربا تحت سماءات عديدة.
انتزعني من التعثر. ولعدم استطاعتي رؤية دموعه في الكلمات، تخيلت في ذهني قلبه القوي، العصبي، الرائق في غدير الحياة. كان سركون كيان حياته المتحرك، وهازم رياحها، ولو يمنحه التناسخ حياة اخري للسكني، لاختار حياته نفسها، باحثا ابدا عن شيء مجهول، وظلام تكون فيه اوراق الشجر سوداء، وحياة الكهوف والجبال ثقيلة، باردة.
لم يقرر كتابة الشعر. قاده كسله واحلام يقظته الي الشعر. قادته اسفاره، تنقله تحت شمس رصاصية، وفي سماء الظهيرات اللاهبة، حلق ملاك الشعر الابيض.
ان قميصه القطني الابيض، المخطط بالاسود في احدي صوره علي هيئة بحار، امدني بنوع من الحس الداخلي لمعرفة اين يختلط الشعر بالحياة. احدهما يتواري خلف الآخر، ويشعر بلمسة من التوق الي المغامرة. سركون المغامر في الحياة والشعر كان اكثر روحية ودهاء من كثير من الشعراء، انغمس في الحياة وعرف كيف يستفيد منها من دون ان يعرّض قصيدته الي الخيانة.
كان الترحال سلطة، بالنسبة لسركون بولص. كانت وحدانيته وشراسته وحزنه وانانيته تحدد بشكل واضح تخوم قصيدته الطبيعية. وهكذا كان يحلم بين مدينة ومدينة، بمدينة اخري، حتي اعتقدت اني اكتشفت الصدع في صدفته المتحجرة علي ذاته، ومنها تسللت رقتي اليه، الي نوع حياته، نوع قصيدته. وحيث اني قارئة جيدة، فقد عرفت سركون بولص من دون ان اعرفه فعلا ـ سوي المرة اليتيمة في جرش ـ وكان يخشاه صغار الشعراء، اذ يستعرضون جسارتهم الوهمية في الكتب، ويحرضون قصائدهم علي اعمال الشعر الخطرة، فيما تعوزهم في الحقيقة، سماؤهم الخاصة، التي كانت مفرودة ورحبة، لسركون بولص.
احسست في موته، انه منح حيواتنا القليلة، شفقته بأثر رجعي. من المحتمل ان احساسي البالغ بفقدان شاعر لا يعبر عنه بهذا الشكل، سوي ان شيئا قد تبلور عندي، واخشي انني اذهب الي القصيدة الآن، من تهور كبير، ومن تشكيلات فاتنة، لا تخشي شيئاً.
القدس العربي
25-10-2007
***
موت شاعر
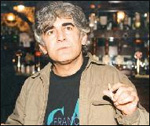 ليس من الغريب أن يكتب المرء عن موت شاعر، لكن من غير المألوف أن تكون شاهدا على صراعه مع الموت، حاضرا في هذا الصراع كما لو كنت جزءا منه، ترى أمامك حَدَمة هذا الصراع أو تراجع حدته، وتشعر بنفسك واقفا الى جانب الطرف الأضعف، الطرف الإنساني الذي غالبا ما يكون خاسرا في النتيجة. هذا ما حصل معي أئناء إقامة الراحل سركون بولص في ألمانيا، فكنت كلما التقيه على انفراد أشعر بحضور الآخر الذي يراقب بسخرية نقاشاتنا، ويتطلع الينا بتشفي حين نحاول إسترجاع ذاكرة بغداد. هذا الآخر أنتصر من جديد، وها هو ذا يرحل الى مملكته، تاركا لنا ظلال الحزن الأسود وكآبة الأيام المقبلة، مصطحبا معه طفلا أصر حتى النهاية على الإحتفاظ بعناد الطفولة لحماية روحه الشاعرية تجاه هجمات الواقع المعاش. لقد عايش سركون الذي كان في داخله أبعد ما يكون عن الحدث السياسي اليومي كوارث العراق بكل حضورها، وذلك منذ اللحظة التي وجد فيها نفسه مضطرا لمغادرة هذا البلد ولحد رحيله المفاجيء، وكان توقيعه على البيان المؤيد لإسقاط نظام صدام الذي أصدرناه قبل إسقاط "صنم بغداد" تعبيرا عن حنينه العميق لهذا البلد، قبل أن يكون تعبيرا عن قناعة سياسية. وفي كل لحظة من حياته كان حلمه يستقر في بلاد الرافدين، حيث يرقد أجداده وأجدادهم في وديان تصب في عروق هذا البلد. كان لبغداد حضور دائم في حواراتنا: بغداد المقهى، بغداد الشارع، بغداد السينما وبغداد البهجة المسروقة، مدينة كلما أمتلكنا وهم الإقتراب منها، أبتعدت عنا.
ليس من الغريب أن يكتب المرء عن موت شاعر، لكن من غير المألوف أن تكون شاهدا على صراعه مع الموت، حاضرا في هذا الصراع كما لو كنت جزءا منه، ترى أمامك حَدَمة هذا الصراع أو تراجع حدته، وتشعر بنفسك واقفا الى جانب الطرف الأضعف، الطرف الإنساني الذي غالبا ما يكون خاسرا في النتيجة. هذا ما حصل معي أئناء إقامة الراحل سركون بولص في ألمانيا، فكنت كلما التقيه على انفراد أشعر بحضور الآخر الذي يراقب بسخرية نقاشاتنا، ويتطلع الينا بتشفي حين نحاول إسترجاع ذاكرة بغداد. هذا الآخر أنتصر من جديد، وها هو ذا يرحل الى مملكته، تاركا لنا ظلال الحزن الأسود وكآبة الأيام المقبلة، مصطحبا معه طفلا أصر حتى النهاية على الإحتفاظ بعناد الطفولة لحماية روحه الشاعرية تجاه هجمات الواقع المعاش. لقد عايش سركون الذي كان في داخله أبعد ما يكون عن الحدث السياسي اليومي كوارث العراق بكل حضورها، وذلك منذ اللحظة التي وجد فيها نفسه مضطرا لمغادرة هذا البلد ولحد رحيله المفاجيء، وكان توقيعه على البيان المؤيد لإسقاط نظام صدام الذي أصدرناه قبل إسقاط "صنم بغداد" تعبيرا عن حنينه العميق لهذا البلد، قبل أن يكون تعبيرا عن قناعة سياسية. وفي كل لحظة من حياته كان حلمه يستقر في بلاد الرافدين، حيث يرقد أجداده وأجدادهم في وديان تصب في عروق هذا البلد. كان لبغداد حضور دائم في حواراتنا: بغداد المقهى، بغداد الشارع، بغداد السينما وبغداد البهجة المسروقة، مدينة كلما أمتلكنا وهم الإقتراب منها، أبتعدت عنا.
في بغداد كان سركون واحدا من مجموعة محدودة من الأدباء المهتمين بالموسيقى الكلاسيكية. وكان غالبا ما يغادر المقهى متجها الى المركز الثقافي السوفيتي الذي كان يحتوي على مكتبة موسيقية كبيرة، ليقضي ساعات عديدة في الإنصات الى سنفونيات رخمانينوف وريمسكي كورساكوف وغيرهم، وربما كان عشقه للموسيقى لا يقل عن عشقه للسينما، عشق أستمر حتى في أحرج لحظات الألم، وما زلت أذكر الأمسيات التي قضيناها في أستوديو مؤيد الراوي في برلين في مشاهدة أفلام قديمة، سبق لنا وأن شاهدناها في العراق، هل تذكر كم كانت تسحرنا ريتا هيوراث، ثلوج كليمنجارو، حيث تتربص الضباع بكاتب على وشك الرحيل، أو الساحرة آفا غاردنر في موغامبو، ومنافستها في حب كلارك غيبل غريس كيلي؟ وهل سنلاحق سبنسر تريسي في دفاعه عن صيده بمواجهة الكواسج في "الشيخ والبحر". لقد مررنا بكل دور السينما في بغداد، وترك سركون عليها بصماته قبل أن يغادر المدينة، وحولنا في برلين أستوديو مؤيد الراوي الى سينما منزلية، نستعيد فيها ذكريات مدينة أصبحت على وشك أن تفقد ذاكرتها الحضارية. وفي كل مرة كنت أرى في عينيه تألقا يخرجه من قيود الألم ورحلة الحزن الطويلة. في هذه اللحظات التي أصبحت نادرة كان سركون يعود الى ما كان عليه في العراق، شاعرا لا هم له سوى إنتهاك الحدود والتوجه نحو المطلق.
سركون يحتضن برلين، كما كان يحتضن بغداد أو كركوك أو الحبانية، وهو دائما شاعر المدينة، وربما كان يتجول في شوارع بابل، كما تجول في شوارع برلين. وربما كان إنشداده الى المقاهي القريبة من النهر في برلين وسواها هو إمتداد لما كان يفعل في العراق، على مقربة من الماء، في قلب المدينة.
ولا أدري لماذا مازلت لحد هذه اللحظة أتصور سركون بحارا يدور حول العالم من مكان الى مكان، دون أن يجد ما يستقر عليه، مثله في ذلك مثل "الهولندي الطائر" في أوبرا فاغنرالذي لم يلق ميناءا يحط فيه. إلا أنه كان على عكس الأخير، منغمرا في القصيدة التي كونت حياته وخططت لها حتى اللحظة الأخيرة. حين ألتقيت سركون بعد فراق يزيد عن عشرين عاما في "بيت الثقافات في برلين" كان يرتدي بذلة بحار. تعرفت عليه حينها، رغم كونه ملتحيا، ربما بسبب البذلة، فقفزت من مقعدي متجها نحوه للترحيب به. كان أول ما قاله لي: "كيف أستطعت أن تتعرف علي؟"
في المقهى البرليني "على الشاطيء" يوجد كرسي يتذكر سركون، وهناك نادلة مازالت تستفسر عنه، إذ كان قد صورها قبل سنوات عدة وقال لها: "صورتك هذه سترحل معي الى أمريكا."
في وقت سابق كنت إحاور سركون عن مالكولم لوري وروايته الكبيرة "تحت البركان". كنت أحلم، ولهذا الحلم ما يبرره، أن يقوم سركون بترجمة هذا العمل الملحمي، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هذا الحلم قبل رحيله.
في آخر لقاء معه حاولت أن أرتدي جبة الواعظ، حين طلب مني أن آتيه بزجاجتين من البيرة، فتطلع سركون نحوي بغضب: "لا أريد سوى أن أطفيء النار في جسدي. ثم من يمنحك الحق في أن تقدم لي النصح؟ هل أنت أكبر مني سنا؟"
في تلك اللحظة بدا لي كما لو أطلت علي من عينيه عشرات القرون من تاريخ العراق، رغم أن فارق السن بيننا لا يتجاوز ثلاث سنوات.
عن (إيلاف)
يتبع