| 
سركون بولص مع الشاعرين
أنسستنبرغر و سارتوريوس
|  ... بالزي العراقي (تصوير صموئيل شمعون) |
الكرسي
كرسيّ جدّي ما زالَ يهتزّ على
أسوار أوروك
تحتَهُ يعبُرُ النهر، يتقلّبُ فيهِ
الأحياءُ والموتى
الملاك الحجري
حتى ذلك اليوم الذي لن أعودَ فيه
إلى قصدير الأيام المحترقة، والفأس المرفوعة
في يد الريح، أجمعُ نفسي، بكلّ خِرَق الأيام ونكباتها، تحتَ
سقفِ هذا الملاك الحجري.
هذا الحاضرُ المجَنَّح كبيتٍ يشبهُ قلبَ أبي
عندما سحَبتهُ المنيّة من رسغه المقيَّد إلى جناح الملاك
في تُراب الملكوت.
حتى ذلك اليوم، عندما يصعدُ العالمُ في صوتي
بصهيل ألف حصان، وأرى بوّابة الأرض مفتوحةً أمامي
حتى ذلك اليوم الذي لن أعودَ فيه
مثلَ حصان مُتعَب إلى نفسي، هذا الملاكُ الحجريّ:
سمائي، وسقفي.
إلى سيزار فاييخو
"من بين أسناني أخرجُ داخناً،
صائحاً، دافشاً، نازعاً سراويلي..."
سيزار فاييخو، "عجلة الإنسان الجائع"
يا سيزار فاييخو، أنا من يصيح هذه المرّة.
إسمح لي أن أفتح فمي، وأحتجّ على الدم الصاعد في المحرار
دافعاً رايةَ الزئبق إلى الخلف. لتصطكَّ النوافذ، لتنجَرَّ ميتافيزياء الكون
إلى قاع الأحذية الفارغة لجنديّ ماتَ بحَربته المعوجّة.
"عجلةُ الإنسان الجائع" ما زالت تدور...
من يوقفُ العجلة؟
قرأتُك في أوحَش الليالي، لتنفكّ بينَ يديّ ضماداتُ العائلة.
قرأتُ عواصفكَ المُتململة حيثُ تتناوَمُ الوحوشُ في السراديب
حيثُ المريضُ يتعَكّزُ، على دَرب الآلام، بعَصا الأعمى الذي رأى...
وفي هذا المساء، يا فاييخو، تعلو الأبجديّاتُ وتسقط. المبنى ينهار، والقصيدة
تطفئ نجومها فوق رأس الميّت المكَلَّل بالشوك. ثمّة ما سيأتي
ليسحبَ أجسادَنا على مَجراهُ الحجريّ كاندفاعة نَهر.
ثمّة حجر سيجلسُ عليه شاعرُ الأبيض والأسود في هذا الخميس.
واليوم، أنا من يصيح.
يدا القابلة
ومن غير أن نولد، كيفَ نحيا مع الريح
دونَ كفالات: يدُ النوم مُدْلاةٌ على مَهد الوليد حتّى
تأتي الظلال.
الصدى يعرفنا، آتياً من وراء العالم.
تعرفنا خادمةُ اللّه
هذه التي تمدُّ جسراً بين دُنيانا والآخرة.
الريحُ، والظلُّ، والجسر
وبيوتٌ خشبيّة تترنّحُ قبل مجيء الإعصار.
مَسقط الرأس هذا...
وجهُ الحياة القَلِقُ، حيث ترتعدُ الولادة
ويسقطُ الجنينُ صارخاً بين يديّ أمّ يوسف، القابلة.
من الصُدفة
منَ الصُدفة، من اصطدامها بالوقيعة
أن تنتهي الحكمة مستقيمةً كشاقولٍ بباب الريح
والعَقلُ نَقّارُ أسمالٍ في صندوق زبالة الفيلسوف.
ومن الصُدفة، من انصدافها، أن أكون، أنا
السائرُ بلا هدَفٍ محَدَّد، دائراً هنا كثَور الطاحون
حولَ محوَرٍ أشبه بالسارية، مرفوعةً، بلا عَلمٍ، وسطَ حياتي.
في الليل وحده أستطيع أن أنادي
من أريدهُ أن يُنادمَني، إلى هذه المأدبة الصغيرة في عَراء أيّامي.
الطينُ، والجلدُ، هنا. طينٌ يغوصُ فيه زُعنفُ تيامات
جلدٌ يَتسلّخُ عن صلعةِ إنليل. أنا المنتظرُ في بيت الخراب
هنا حيث تجتمعُ الغربانُ والبيارقُ السوداء والعماماتُ واللّحى
في شجرة الأنبياء اليابسة.
هنا ينفتحُ البابُ على شَذرةٍ من عُماي.
أهذا يعني أنّ ناري ما زالت تَلهو بالخشَب؟
أنا كنّاسُ السماء، ومكنستي المضلَّعة، من ريش أوهامي
المختبَرة بالنار، وقشِّ جنوني المُتَذَرّي في كلّ هَبّة من هذه الريح
هل من الممكن أنني أنسيتُها سرَّ القُمامة؟
ينفتحُ الباب، وأرقدُ بكلّ حجمي في قلب الليل المريح مثلَ سرير.
الناجي
قاموسُ الندى، مُعجَمُ الأنداء الساقطة
عبرَ الأفق المجَمَّرِعلى وجهي: أنا قَيلولة ذاتي.
أنا ظهيرةُ أيّامي. أنا لستُ سوى هذه الصفحة المحترقة بنظرتي.
الريحُ وحُنجرتي: أنا من يُنادي بين سارية المستقبل، وراية
الماضي.
أنا العَبدُ. أنا العاجز، بعُكّازينِ تحتَ إبطيَّ أعرجُ نحو المنتهى
يتبعني الموتُ بأرجُلِ عنزةٍ سوداء.
تتبعُ رأسي حربةُ الساحر ذاتُ الرأسين
وأعرفُ أنني، رغمَ هذا، سأنجو لأروي الخبَر على الأحياء.
لحظة الجندي
تلك اللحظة التي أشِكُّ فيها حَربتي الصدئة
جانبيّاً، بلا هِمّة، في جَنب المسيح
هو الذي يحتقرُ إمبراطوريّتي، وروما، كلَّ روما، بنظرة
أنا الجنديّ التافه الذي قد يذكرهُ التاريخ بكلمة أو كلمتين
لأنهُ أهانَ النبيّ، ألبَسهُ تاجَ شوكه، سَقاهُ خَلاًّ...
أنا الدودةُ الحيّة في تُفّاحة العالم.
تو فو في المنفى
"دُخانُ الحرب أزرق
بيضاءُ عظامُ البشَر".
تو فو
قرية يَصلُ إليها تو فو
دَسكرةٌ فيها نارٌ تكادُ تنطفئ
يَصلُ إليها عارفاً أنّ الكلمة
مثل حصانه النافق، دون حَفنة من البَرسيم
قد لا تبقى مُزهرةً بعدَ كلّ هذه النَكبات!
كم ساحة معركة
مرّ بها تصفُرُ فيها الريح
عظامُ الفارس فيها اختلطتْ
بعظام حصَانه، والعشبُ سرعانَ ما أخفى البقيّة!
نارٌ تتدفّأ عليها يَدان
بينما الرأس يتدلّى والقلبُ حَطب
هو الذي بدأ بالتِّيه في العشرين
لم يجد مكاناً يستقرّ فيه حتى النهاية.
حيثما كان، كانت الحربُ وأوزارُها.
ابنتهُ ماتت في مجاعة...
ويُقالُ في الصين إنه كانَ يكتبُ كالآلهة!
قرية أخرى يصلُ إليها تو فو
يتصاعدُ منها دُخانُ المطابخ
وينتظرُ الجياعُ على أبواب مَخبَز.
وجوهُ الخبّازين المتصبّبة عرَقاً، مرايا
تشهدُ على ضَراوة النيران.
تو فو، أنت، أيها السيّد، يا سيّد المنفى.
محمود البريكان واللصوص في البصرة
حَبلُ السُرّة أم حبل المراثي؟
لا مَهرَب: فالأرض ستربطنا إلى خصرها
ولن تترك لنا أن نُفلتَ، مثلَ أُمّ مفجوعة، حتى النهاية.
كلّ يوم من أيامنا، في هذه الأيام، جمعةٌ حزينة!
ويأتيني، في الجُمعةِ هذه، خبَرٌ بأنّ البريكان
ماتَ مطعوناً بخنجر
في البصرة
حيث تكاثرَ اللصوص، وصارَ القتَلة
يبحثونَ عن... يبحثون، عَمَّ صارَ يبحثُ القتَلة؟
حتى هذا الشاعر الوديع لم يَنجُ، هو الذي
كان يعرفُ منذ البداية لونَ القيامة، وهجرةَ الفراشة
نحو متاهة العالم السفلي، حيثُ الليل، واللّه، واحد.
أكانت هذه معرفتك، هل كان هذا سرّك؟
كنتُ أراك، أنتَ الملفَّع بغشاء سرّك
بين حين وآخر، في مقهى "البرلمان"
حديثنا عن رخمانينوف، عن موتزارت.
واليومُ الذي أتذكّركَ فيه
اليومُ الذي فيهِ بالذاتِ أراك:
كنتَ اشتريت "صُوَر من معرض" لموجورسكي
من "أوروزدي باك "...
واللّه أعلَم كم كلّفتكَ تلك الأسطوانة
من راتبك الضئيل!
(سأُسمِعُها، في ذكراكَ، اليومَ، نفسي.)
سأصغي... وها هو الخبَرُ يأتيني.
حبلُ السُرّة انقطع، وامتدّ حبلُ المراثي.
إنه الليل. نَمْ، أيّها الشاعر. نَم، أيّها الصديق.
وصلت الرسالة
قُلتَ
أنك تكتب والقنابل تتساقط، تُزيلُ تاريخَ السقوف
تَمحقُ وجهَ البيوت.
قلت
أكتبُ إليك بينما اللّه
يسمحُ لهؤلاء أن يكتبوا مصيري. هذا ما يجعلني أشكُّ في أنه الله.
كتبتَ تقول:
كلماتي، هذه المخلوقات المهدَّدة بالنار.
لولاها، لما كنتُ أحيا.
بعد أن يذهبوا، سأستعيدها
بكلّ بَهائها كأنها سريري الأبيض في ليل البرابرة.
أسهرُ في قصيدتي حتى الفجر، كلَّ ليلة.
قلتَ: أحتاجُ إلى جبَلٍ، إلى محطّة. أحتاجُ إلى بشَرٍ آخرين.
وبعثتَ بالرسالة.
الكمّامة
اليوم أريد أن تصمتَ الريح
كأنّ كمّامة أطبقَت على فَم العالم.
الأحياءُ والأمواتُ تفاهموا
على الإرتماء في حضن السكينة.
لأنّ الليل هكذا أراد
لأنّ ربّة الظلام، لأنّ ربَّ الأرْمِدَة
قرّرَ أنّ آخرَ المطاف هذه المحطّة
حيثُ تجلسُ أرملة وطفلتها على مصطبة الخشب
بانتظار آخر قطار ذاهب إلى الجحيم، في المطَر.
(*) عنوان كتاب يوزع قريبا عن دار الجمل
**********
عوليس عراقي رحل خارج المتن الشعري العربي
 إن ميزة سركون بولص الأقوى هي تطويع الوجد الرومانسي، الذي ورثه شعراء الستينيات عن بدر شاكر السياب، متأثّرين جميعاً، وإن بدرجات متفاوتة، بحساسية هذا الرومانسي المتأخّر، المتأثّر بدوره بالقصيدة الإنكليزية الحديثة. لكن بولص آثر أن يتكتّم على الكآبة السيابية، فأبقاها مطمورة تحت رماد ثقافته الغربية، الأكثر رصانة وقوة. ترك بولص بلاغة السياب وذاتيته القاتمة، واحتفظ بذاك الحدس الفجائعي الهادئ، الذي يشكل جوهر رؤياه الشعرية للعالم. هذا الحدس جعله يروّض العاطفة السيابية، ويصقلها لتظلّ منحرفة عن نموذجها الأعلى، ولتسدّ فراغاً تركه غياب التفعيلة من قصيدة النثر الحديثة. لكن بولص لم يترك الإيقاع بتركه التفعيلة، وبدل أن يكتب قصيدة النثر «َُِّْم ُِمٍ» بمفهومها الحديث، اختار الشعر الحرّ «نْمم ًّمَّْم»، الخالي من الأوزان والقوافي، لكنه الغني بالإيقاع، والمموسق بمكائد البلاغة وحيلها الرّمزية. وقصيدة بولص موقّعة أيضاً بتلك العاطفة الصامتة، ذات النبرة الخافتة، والحياء التعبيري، فهي تختزن عذابات وجودية بكماء، ذاتية وكونية معاً. وهو، إذ يهجر الموقف الذاتي الغنائي، يختار الموضوعية التعبيرية، القائمة على التضادّ والمفارقة «ِفْفلٍُّ»، ويقيم عند تخومها، لكي يدوّن ألم الكينونة، الفجّ والعاري، مثله مثل العديد من أبناء جيله، كفاضل العزّاوي، المولع بسرد العدم، أو عباس بيضون المفتون بجماليات القطيعة، أو وديع سعادة الشغوف بفلسفة الهباء. لكنّ بولص يكتب من وحي تلك الفجوة «الإليوتية» التي يراها تتّسع وتمتدّ أمامه، والتي تفصل الذات عن العالم، واللغة عن الواقع، وتقذفُ باليقين إلى مهب الحيرة. وككل الحداثيين الكبار، يركّز بولص في شعره على معنى اللا نتماء، وقسوة الإقامة في التيه الوجودي، ما يعني بالضرورة حيرة اللغة إزاء دلالاتها، وتأرجحها الدائم بين الغياب والحضور: «هذه الكلمات، أبداً، تهبّ في مفترق الطرقات/ بين النوم واليقظة».
إن ميزة سركون بولص الأقوى هي تطويع الوجد الرومانسي، الذي ورثه شعراء الستينيات عن بدر شاكر السياب، متأثّرين جميعاً، وإن بدرجات متفاوتة، بحساسية هذا الرومانسي المتأخّر، المتأثّر بدوره بالقصيدة الإنكليزية الحديثة. لكن بولص آثر أن يتكتّم على الكآبة السيابية، فأبقاها مطمورة تحت رماد ثقافته الغربية، الأكثر رصانة وقوة. ترك بولص بلاغة السياب وذاتيته القاتمة، واحتفظ بذاك الحدس الفجائعي الهادئ، الذي يشكل جوهر رؤياه الشعرية للعالم. هذا الحدس جعله يروّض العاطفة السيابية، ويصقلها لتظلّ منحرفة عن نموذجها الأعلى، ولتسدّ فراغاً تركه غياب التفعيلة من قصيدة النثر الحديثة. لكن بولص لم يترك الإيقاع بتركه التفعيلة، وبدل أن يكتب قصيدة النثر «َُِّْم ُِمٍ» بمفهومها الحديث، اختار الشعر الحرّ «نْمم ًّمَّْم»، الخالي من الأوزان والقوافي، لكنه الغني بالإيقاع، والمموسق بمكائد البلاغة وحيلها الرّمزية. وقصيدة بولص موقّعة أيضاً بتلك العاطفة الصامتة، ذات النبرة الخافتة، والحياء التعبيري، فهي تختزن عذابات وجودية بكماء، ذاتية وكونية معاً. وهو، إذ يهجر الموقف الذاتي الغنائي، يختار الموضوعية التعبيرية، القائمة على التضادّ والمفارقة «ِفْفلٍُّ»، ويقيم عند تخومها، لكي يدوّن ألم الكينونة، الفجّ والعاري، مثله مثل العديد من أبناء جيله، كفاضل العزّاوي، المولع بسرد العدم، أو عباس بيضون المفتون بجماليات القطيعة، أو وديع سعادة الشغوف بفلسفة الهباء. لكنّ بولص يكتب من وحي تلك الفجوة «الإليوتية» التي يراها تتّسع وتمتدّ أمامه، والتي تفصل الذات عن العالم، واللغة عن الواقع، وتقذفُ باليقين إلى مهب الحيرة. وككل الحداثيين الكبار، يركّز بولص في شعره على معنى اللا نتماء، وقسوة الإقامة في التيه الوجودي، ما يعني بالضرورة حيرة اللغة إزاء دلالاتها، وتأرجحها الدائم بين الغياب والحضور: «هذه الكلمات، أبداً، تهبّ في مفترق الطرقات/ بين النوم واليقظة».
متأثراً بجيل البيت «قمفُّ» الشعري، وحساسية الثورة الثانية في الحداثة الأميركية، التي رسم معالمها آلن غينسبرغ في ديوانه (عواء)، وجاك كرواك في روايته (الغداء العاري)، في مطلع الستينيات من القرن الماضي، تعلّم بولص أن يصطاد لحظته الجمالية بشغف المتصوف، وحذر العدمي، غائصاً في عمق اللاوعي الكوني، مستخرجاً صوراً ملغزة وصادمة، فائقة الرّوعة، ومدوناً أحلام ذات تنبذ ذاتيتها، وتصير هروباً. فالأنا المتكلّمة في شعره هي أنا هاربة، فارّة من تقليد رومانسي أعلى، لا تبوح بقدر ما تتكتّمُ، ولا تُظهِرُ بقدر ما تُخفي، وربما لا تكشفُ بقدر ما تحجبُ. إنها تلك «الأنا» التي تقدّم نفسها دوماً كقناع، كما في مجمل شعر الحداثة. ففي قصيدة (سقط الرجل)، مثلاً، يكتب بولص عن تراجيديا وجودية فردية، كونية الأبعاد والدلالات، لرجل انحنى فجأةً على ركبتيه، في ساحة عامة، كأنما بسبب ألم مفاجئ، أو بسبب قوة عليا غامضة، إلهية أو شيطانية، أو ربما بسبب ضربة حزن مباغتة: «هل قضى عليه الحزنُ بمطرقةٍ يا تُرى؟» لكنّ بولص، في هذه القصيدة المكثفة، المنسجمة بنيوياً وتعبيرياً، يؤكّد ثيمة السقوط بإطلاق، ربما سقوط آدم من الجنة دينياً، أو سقوط الإنسان من إنسانيته داروينياً، أو سقوط الوعي الفردي فرويدياً، وربما سقوط اللاهوت الجمعي نيتشوياً، لكنّ الرّجل القناع، في النهاية يسقط، ونكاد نسمع صوت ارتطامه الخافت في هذه القفلة الرائعة للقصيدة: «سقط الرجلُ فجأةً مثل حصانٍ/ حصدوا ركبتيه بمنجل».
في استرجاع صورة سركون بولص المنسي في منفاه، استرجاعٌ لصورة الشاعر المفتون بالسفر دائماً، منذ مغادرته كركوك إلى بغداد، ومنها إلى بيروت ثمّ إلى سان فرانسيسكو، التي احتضنته لأكثر من ربع قرن. وفي هذا الاسترجاع تحضرني بغرابة تلك الكلمات الختامية لتنيسي ويليامز في مسرحيته (الحديقة الزجاجية) التي يسوقها على لسان بطله الشغوف بالسفر، توم، والتي تقول: «تنقّلتُ كثيراً. كانت المدنُ تتطايرُ حولي كأوراق ميتة، أوراق ساطعة الألوان، سُلِخَت عن أغصانهِا وتطايرت. كان يمكن لي أن أتوقّف، لكنّ شيئا ما كان يلاحقني. يهبطُ عليّ في غفلتي، ويباغتني. لعلّها مقطوعة موسيقية مألوفة. لعلّها مجرّد نثرةٍ من الزّجاج الشفّاف». لا أتصوّر أنني أتذكر هذه الكلمات عبثاً، ففيها الكثير مما يصف حياة وشعر سركون بولص، حتى ليخيل للمرء أن بولص وليس ويليامز، هو من كتبها. والقارئ لقصائد بولص يجد أنها مكتوبة حقاً عن مدن هاربة، أبطالها جوّابو أحلام، يتنقّلون كثيراً بين الموانئ والمحطّات، مطاردين بأشباح وأطياف شتّى. حياة مشدودة إلى وتد، تتحول بين يدي بولص إلى منحوتة زجاجية، تتناثر لحظاتها إلى أسرار شتّى: «ها هي حياتك مشدودة من شعرها/ إلى وتدِ الأيام، كأنهّا امرأة/ تريد أن تبوح لكَ/ بأوّل الأسرار/ وآخرها». ووراء هذا البوح، يكمن ألم وجودي عميق، مردّه الشعور بعبثية الأشياء، وسقوط الكائن فريسة للضياع واللا جدوى: «ثم كانت الأيام/ ودسّ أحدهم بين يدي/ هذا العود، وعلّمني كيف أغنيّ/ بهذا الصوت الجريح».
ولأن بولص يجيد الإصغاء إلى بوح الحياة، نراه يبحث عن معادل موضوعي لها في تلك القصيدة الحرّة، الشرسة والحزينة، التي تطارده ويطاردها. القصيدة التي تشبه الحياة ذاتها. القصيدة الشفافة، الحية، الغنية بإيقاعات العالم. لا ذهنية ولا فلسفية. قصيدة رشيقة، غنية بالإيقاع الداخلي للتراكيب، إيقاع النثر الذي تحوّل بين يدي هذا الشاعر، بوجه خاص، إلى ندّ حقيقي لإيقاع التفعيلة. وهي قصيدة متحركة، تنام على حلم وتستيقظ على حلم. أقصد أنها ليست قصيدة دوغمائية ساكنة. أي ليست رهينة مقولاتها النظرية أو النقدية. ففيها الكثير من رغبة التجريب والمغامرة، على صعيد البنية والموضوع. ولعلّها القصيدة الرحلة (يَُِّْمۖ ُِمٍ) بامتياز. القصيدة الزورق التي تهب عليها الريح، ويأخذنا المدّ إليها، وتأخذنا، نحن قرّاءها، إلى شواطئ مجهولة، بعيدة وآسرة. ولأن بولص مدمن سفر، يتحوّل المتكلم في قصيدته إلى عوليس آخر، لا يهمّه الوصول إلى ميناء أو محطّة، بل تغويه الرحلة ذاتها، فالسفر غاية لا وسيلة. في إحدى قصائده يسأل: «هل أغرتكَ السفنُ إلى هذا الحدّ/وسرتَ كما قلتَ/ على الماءِ؟» كأنما للتدليل على شفافية الرحلة وصفائها، وربّما على عبثيتها وخفّتها، أي خلوها من كلّ هدف أو غاية، تماماً مثل هذا السير الخرافي فوق موج المجاز. وما العنوان الأخير (إذا كنت نائماً في مركب نوح)، الذي خصّ به مختاراته الشعرية الصادرة عن دار الجمل، قبل سنوات، سوى تأكيد إضافي على شغف بولص بالرحيل والارتحال والسفر. هذا إذا لم نذكر كتابه الشعري الأول، (الوصول إلى مدينة أين)، المفتون بالموانئ والمدن والترحال، والذي يبدأ، بكلمةِ «وصلتُ»، وينتهي بكلمة «ذهبتُ»، وبين الوصول والذهاب رحلة مفتوحة على المجهول، تبدأ ولا تنتهي.
وإذا أردنا أن نبحث عن مرجعية جمالية للشاعر، فإننا لن نجدها في شعر أدونيس مثلاً، المفتون بالرؤيا الميتافيزيقية، أو في شعر سعدي يوسف، الشغوف بالسّرد الزماني، أو في قصيدة أنسي الحاج المائلة إلى عذوبة إنجيلية نادرة، أو في كآبة محمد الماغوط المتضورة وحيدةً في عراء المفارقة. ربما كان بولص، من دون أن يدري، يقيم خارج المتن الشعري العربي كلّه، ليس بفضل إقامته الطويلة في منفاه الاختياري، واحتكاكه المباشر بالثقافة الأميركية فحسب، بل ربما بسبب رؤيا فريدة للشعر، تمثل خلاصة فهم عميق لتقليدين شعريين قويين، غربي وعربي. وهي رؤيا المقيم المهاجر في منفاه وثقافته ولغته، المنتمي واللا منتمي في آن واحد. وهذا المكوث بين لحظتين حضاريتين ولغويتين مختلفتين جعلت الصوت الشعري أكثر تفرّداً واختلافاً، وربما أقوى حضوراً وتأثيراً. ونعلم أن بولص ليس بشاعر بلاغة إنشادية ملحمية، مثلما هو حال أغلب معاصريه. لكنه نحّات الومضة الشعرية الخاطفة، وصاحب الضربة المجازية الرفيعة، التي تجعل الشكل توأماً للمضمون.
هي، إذاً، قصيدة سركون بولص وحده. القصيدة المسكونة بألحان خفية، ونثرات زجاج شفّافة ومشعّة. نثرات مضيئة، تؤلف شعراً طبيعياً «كالدّم والكحول وورق الشجر»، على حدّ تعبير عباس بيضون، تتأمّل ذاتها في مرآة اللغة وتحلم بالديمومة: «أجمع نفسي/ عارضاً وجهي للبرق/ وأنا أهذي بانتظار أن تتركني الموجةُ/ على شاطئ مجهول/ مقيداً إلى حجر». من هذا الحجر تولد تلك النثرات الوجدانية والشعورية والفكرية واللغوية، ثم تنصهرُ وتنصقلُ تحت مطرقة المجاز الرفيع، لتنطلق وتطير مثل شهبٍ في ليل دامس.
السفير- 26 اكتوبر 2007
**********
مراسم الوداع الأخير للشاعر الراحل سركون بولص
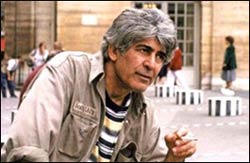 سوف تقام مراسم دفن فقيد الشعر والأدب الراحل الكبير سركون بولص وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت كاليفورنيا من يوم الأربعاء المصادف 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، في كنيسة القديس مار كيوركيس في سيرس بولاية كاليفورنيا/ امريكا، والواقعة على العنوان التالي :
سوف تقام مراسم دفن فقيد الشعر والأدب الراحل الكبير سركون بولص وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت كاليفورنيا من يوم الأربعاء المصادف 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، في كنيسة القديس مار كيوركيس في سيرس بولاية كاليفورنيا/ امريكا، والواقعة على العنوان التالي :
St. George Parish,
. Brickett Ct3900
Ceres, Calif. 95307
USA
ويمكن لأصدقائه ومحبيه الذين يودون المشاركة في مراسم الدفن وتقديم التعازي القدوم إلى عنوان الكنيسة المشار إليه أعلاه. كما ترسل كافة برقيات التعزية وباقات الورد إلى ذات العنوان.
عن آل الفقيد
كيوركيس شمعون يوسف
Gewargis Shimoun Yoseph,
549 Bantry Road,
Pinole, Ca. 9456
USA
هاتف المنزل: 5107249562+ 1-
الهاتف النقال: 4153852630+ 1-
لمزيد من المعلومات
ميخائيل ممو
mammoo20@yahoo.se
****
إلي أرض الأحياء تاق السّيدُ للسّفر
وداعا سركون.
لن نلتقي بعد الآن في (السالوتيشن بب). لن نمشي في شارع (الملك) حيث يكلِّم الكاريبيون أنفسهم وتلسع (بنسات) البرد جيوب الهنود المهرولين الي العمل وتنتفخ أوداج الكادحين الانكليز بالبيرة المرَّة وخلِّ (السايدر).
لن نلتقي بعد الآن في تلك الحانة الداكنة التي جلجلت بين جنباتها أفضل ضحكاتك وأكثرها عافية. لن نلتقي هناك. لن تري (أبراها) وهو يحمل الفانوس أمامك، كمريد مفتون، في ليل (آكتون)، ولن تراني أهوي بقبضة يدي علي الطاولة، فيجفل فتي بشعر طويل يجلس علي برندة اسمنتية في (المفرق) يحلم بكنز في جزيرة بعيدة.
لن نلتقي بعدُ، لأنك لن تأتي إلي لندن التي قذفتني إليها قلوعي الممزقة بعد ترحال طويل، مثل ترحالك، بحثا عن جزيرة الكنز. ربما يبقي جسدك، ذلك المركب المنهك، الذي دفعه المهربون، ذات يوم بعيد، وراء حدود (القائم)، في برلين. وربما يطلبه أهلك الآشوريون المنفيون من بلاد النهرين إلي أمريكا. ليس هذا مهما. ليس مهما بعدُ أين يذهب ذلك الجسد المركب ما دام قد رسي، أخيرا، حيث ترسو كل المراكب. لكنّ الأكيد أنَّ الروح (إن كانت شيئا آخر غير ذلك النمر المتحفز وراء القفص الصدري) ستذهب الي مكانها الأول. إلي تلك الشوارع المتربة والشمس الشرسة والوضوح السافر للأشياء. هناك في (الحبانية) أو في (كركوك) حيث انهمك بناؤ مراكب وقلوع غامضون بتجهيز مركب السيد الآشوري للسفر. أنا شبه متأكد من ذلك. ربما لأنك أكثر العراقيين الذين عرفتهم عراقيةً. وربما لأنك شاعر، والشاعر، لسبب ما، يعود دائما إلي (الهناك). ورغم أنَّ مركبك خلَّعه السفر في الاتجاهات غير أنك ظللت تسمع، أبدا، موسيقي ذلك الزقاق البغدادي (حيث غمزت لك نجمة وانسرحت فوق جبينك نسمة ليلية وعرفت، بأصفي يقين، أنك أبدا لن تموت) الا بعد ان تودع رسالتك في زجاجة ستصل، حتما، الي حيث ينبغي لها ان تصل. ففي شِعرك، في عينيك الضاحكتين، أيها السندباد البغدادي، ترفع المراكب قلوعها بحثا عن ريح رضية تعود بك إلي (هناك). من كتب أكثر منك عن المراكب، عن المرافيء، عن القلوع، عن أنواع الرياح، عن مسافرين عيونهم الي الوراء، عن التاركين ملاحظات عن الأحوال، عن مخططات لمدن يغادرها الغرباء ما ان يحلوا بها؟
لا أعرف شاعرا عربيا اكتظت مدونته بهذا التيه البحري ووحشة الطرق، بتلك الفنارات التي تتلامع فيها أضواء مضللة، بأولئك المسافرين الذين يتركون علامات يائسة في خانات مهجورة لقادمين قد تخدعهم كثرة الطرق.
الفانوس، الليل، النجوم، المراكب، المحطات، الفنارات، العواصف، الأرصفة الباردة، أسرّة الوحدة، تلك هي مجازاتك الأثيرة. تلك هي الاستعارات التي (عشت) بها وكتبت قصيدتك بحبرها الداكن. هناك طرق مختلفة تؤدي الي روما، أنت قلت هذا، لكن من يقرؤك، أيها الشاعر العراقي الذي طعَّم العربية بوجع آشوري مكتوم ، يعرف أن الطرق الي روما ليست كثيرة، وأنَّ (لا طريق سوي الطريق). بوصلة أعماقك تشير بإبرتها المترنحة الي ذلك. كأنني أسمع، وأنا أقرؤك، أنفاسا تأتي من ناحية (إيثاكا)، من صوب ذلك السيد اليوناني الذي يقف بزاوية منحرفة عن الكون قليلا. فعلي (عوليس) أن يواصل رحلة العودة، عليه، كقدر إغريقي لا مناص منه، أن يمضي في الطريق مواجها العواصف والأنواء في اتجاه (إيثاكا)، عليه أن يغضب بعض الآلهة، عليه أن يحلم ب (بنلوبي) نديةً منتظرة، ولكن عليه أن لا يتوقع أن تكون (إيثاكا) غير (إيثاكا). الرحلة عند السيد اليوناني، طريقه الطويلة إلي (إيثاكا) قد تكون هي الهدف ولا شيء سواه، ولكن ليس هذا شأنك، علي ما أظن، مع (مدينة أين). فالطرق الكثيرة إليها لم تخدعك، فأنت تتبع إبرة بوصلة الأعماق مهما اهتزت، مهما ترنَّحت، ف (كما للنهار أجنّةُ ظلامه، فالليالي لها شمسها) أيضا. الموسيقي التي سمعتها في زقاق بغدادي، ذات يوم، ظل صداها الفتي، صداها الذي لا يفتر له رنين، يتردد في أذنيك، وتلك التي رأيتها، وأنت تعبر تحت شرفة في ذلك الزقاق، ظللت تسترجع صورتها مع (كل وصول) و(كل مغادرة)، حتي رسي مركبك حيث ترسو جميع المراكب.
وداعا سركون.
يا صديقي وشبيهي في التيه، أنا مثلك بيدي جمرة تبرد، وفي أعماقي بوصلة مترنحة تشير إبرتها إلي فتي بشعر طويل يجلس علي برندة اسمنتية ويحلم بكنز في جزيرة بعيدة، فيما غبار الأيام يتراكم علي مشجب أم راحلة.
القدس العربي
26/10/2007
****
كأني انتظر لقاءه مرة أخري
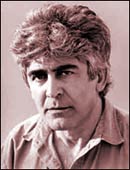 أول مرة اتعرف علي شاعر أمريكي خارج سياق ما قرأته عن الشعر الأمريكي مترجما هو الشاعر وليم ستيفن ميروين ولم يكن التعرف علي هذا الشاعر الذي كان يغرد وما زال خارج سماء الشعر الأمريكي قراءة وإنما باللقاء به مباشرة.
أول مرة اتعرف علي شاعر أمريكي خارج سياق ما قرأته عن الشعر الأمريكي مترجما هو الشاعر وليم ستيفن ميروين ولم يكن التعرف علي هذا الشاعر الذي كان يغرد وما زال خارج سماء الشعر الأمريكي قراءة وإنما باللقاء به مباشرة.
كنت ذات يوم أنا القادم توا إلي نيويورك أذرع شوارع المدينة التي لا اعرف فيها أحدا وقادتني قدماي إلي الجادة الخامسة حيث يمتد من الجهة الغربية منها السنترال بارك حديقة نيويورك الكبيرة وسط غابة من العمارات الشاهقة وإلي الجهة الشرقية من الجادة تسكن الطبقة الارستقراطية من سكان نيويورك التي تحدثت عنها الكاتبة اديث نورتن.
وأثناء تجوالي في الجادة التي فاجأتني بناياتها التي ذكرتني قليلا بباريس وجدت نفسي فجأة أمام متحف غوغنهايم ذي التصميم الذي يشبه ملوية سمراء. وربما تصميم المتحف قد أوقفني غير أني لاحظت أفواجا من البشر بملابسهم الأنيقة في طريقهم الي المتحف في وقت متأخر من الليل. ومن باب الفضول سحبت جسدي الخجول كي اتابع خطوات طابور من النساء والرجال وهم بملابسهم الأنيقة فقادني هذا الفضول البدوي إلي قاعة مكتظة بجمهور عريض لكي يستمع إلي الشاعر ميروين في صحبة شعراء آخرين منهم ديفيد ليفن وجان آشبري. لا اعرف لماذا آنذاك شدني كثيرا ميروين من بين خمسة شعراء ربما لنزعته الصوفية وربما لحريته المذهلة في الحديث عن عالمه الداخلي وربما للهالة التي كانت تصاحب وجهه الذي ذكرني بوجوه القديسيين والمتصوفة ولا غرابة من هذا الانطباع حين عرفت فيما بعد أن والده كان قسا في إحدي كنائس نيويورك.
وبعد انتهاء القراءة الشعرية كانت هناك حفلة استقبال علي شرف الشعراء في ذلك المتحف الفخم والمترف في اناقته فوجدت نفسي في زحمة الحفلة كالصعاليك المتمرسين وكانت غايتي اللقاء بالشاعر الذي احببته من بين الشعراء الخمسة.
وحملت كأسا من النبيذ الأحمر وتقدمت بخطوات تصحبها الجرأة والخجل إلي الشاعر ميروين وعرفته بنفسي فقال لي انت من بلد سركون بولص هززت رأسي بالإيجاب ثم سألني عن نزار قباني وعن محمود درويش وعن المشروع الذي كانت تقوم به الشاعرة سلمي خضراء الجيوسي في ترجمة الشعر العربي المعاصر إلي الإنكليزية.
بعد ذلك اللقاء رحت اقرأ اعمال الشاعر ميروين الذي لا زال يقيم في جزيرة هاوي هربا من مدينة نيويورك التي نشأ فيها مع والده القس. وذات مرة قمت بترجمة جزء أساسي من حوار معه أجرته المجلة الأدبية الفصلية باريس ريفيو وذكر ميروين في ذلك الحوار أنه قد حج مرتين المرة الأولي عندما زار الشاعر اليوت في لندن والحجة الثانية عندما زار الشاعر عزرا باوند في معتقله بعد انتهاء الحرب الثانية.
وذات يوم طلبت من القسم الشرقي في مكتبة نيويورك الاعداد الكاملة لمجلة شعر فوجدت قصائد كثيرة لميروين ترجمها سركون بولص إلي العربية. ومنذ تلك اللحظة تلمست الحيوط التي تربط سركون بميروين فوجدت أن سركون هو الأقرب الي ميروين وميروين هو الأقرب الي سركون.
ما يميز ميروين هو أنه جاء وسط صخب حركتين أدبيتين في أمريكا وبالتحديد في نيويورك وفي سان فرانسسكو الحركة الأولي والمتمثلة بجيل البيت كان يقودها جاك كورياك وآلن غينسبرغ والكاتب بوروغ.
وكانت الحركة الثانية متمثلة بمدرسة نيويورك التي يقودها الشاعر جان اشبري المتأثرة بالمدرسة الفرنسية وبالمزج بين الفن التشكيلي والشعر وفن الرواية. وفي المقابل توجد المدرسة التي تمثلها الأكاديمية الأمريكية للشعر التي ظلت تحافظ علي أصول الشعر الأنكلو - سكسوني. ومن بين هذه الاتجاهات الثلاثة يبرز شعراء مهمون من بينهم ميروين وديفيد ليفن وآخرون سعوا إلي الحفاظ علي الروح التي تميز بها شعر اليوت وعزرا باوند. وقد ساعد ميروين للحفاظ علي هذه الروح معرفته باللغات اللاتينية الفرنسية والاسبانية والبرتغالية إضافة إلي اللاتينية الأصل وذهب ميروين ابعد من ذلك تقليدا لاستاذه باوند في ترجمة شعر لا يتقن لغته الأصلية عندما ساهم بترجمة اشعار من السويد ومن العربية من بينها قصيدة لمحمود درويش.
وكما فعل ميروين مارست حجتي الأولي الي سان فرانسسكو للتعرف علي سركون بولص الشاعر الذي نشر مجموعته الأولي الذهاب الي مدينة أين وكان في ذهني تجربة جيل الستينات. وقبل ذلك كنت في لندن وكانت ما تسمي برابطة الفنانين والكتاب التي كان يديرها الشيوعيون العراقيون تبحث عمن يشكل فرعاً لها في امريكا وكان أعضاء الرابطة مترددين بدعوة سركون بولص لأنه شارك في مهرجان المربد أيام عهد صدام حسين.
قلت انه ذهب الي هناك كي يشهد وفاة والده ولم يقرأ شعرا في مهرجان المربد وبعد جدل مع أعضاء الرابطة تمت دعوة سركون الي لقاء في برلين. وفي ذلك اللقاء الذي اجريته معه في سان فرانسسكو في احدي باراتها الرخيصة اكتشفت أن سركون غير متحمس لجيل البيت الأمريكي وأضاء لي قائلا ان ما يكتبه هو الشعر الحر وليس قصيدة النثر .
وما زلت اتذكر تلك المقارنة بين شعر توماس هاردي الذي شبهه بتجربة شعراء التفعيلة قياسا الي الثورة التي احدثها شعر اليوت وعزرا باوند وقال لي: يا صلاح نحن نكتب شعرا حرا كما يكتبه اليوت ولكن بشكل وبإيقاع مختلف وأثار انتباهي الي كتاب عن جيل باوند.
وادركت بعد قراءة شعره أنه يشبه ميروين في بعض الوجوه وأنه الشاعر الأقرب إليه وأنه شاعر يختلف كليا عن زملائه من شعراء الستينات في العراق. فالقصيدة لديه تختمر بعد فترة طويلة كي تصفو وتتخلص من الشوائب لتكون ناصعة وحادة وهو يعي بشكل جيد كل العيوب التي مرت بها قصيدته، وهوحريص في الوقت ذاته علي الصورة كإقليم وفي الوقت ذاته يحاول التخلص منها بحثا عن حكمته الخاصة النابعة من تجربته ومن طريقة رؤيته لنفسه وللعالم. إنه كائن مسكون بالحكمة والخرافة بامتياز شديد.
وكأني ما زلت انتظر لقاء آخر مع سركون لبحث الصلة الحميمة بينه وبين ميروين وكان قد ذكر لي في الحوار الذي اجريته معه والذي نشر في مجلة ( نزوي) أن ثمة حركة شعرية جديدة في أمريكا تنساق وراء اللغة. واعتقدت انه كان يمزح لأنه كان خارج اللغة وكان يصر أن يضع نفسه أمام العالم بوضح وعري كامل رغم التقنيات الهائلة التي كان يمتلكها . وما زلت اتطلع الي حوار آخر معه لمعرفة عوالمه وكان يؤكد لي أن مفردة العالم التي ترد كثيرا في قصائده هي اختزال لعوالم متعددة.
القدس العربي
26/10/2007
****
يومٌ مع سركون بولص

عندما اتصل بي الصديق الشاعر عبد الإله الصالحي في طلب شهادة عن الراحل سركون بولص لإذاعة مونتي كارلو، لم أجد لديّ شيئا محدّدا لأقوله عن هذا الشاعر الشاهق كجبل... فاعتذرت للصالحي وأنا أفكر في ذلك المقطع من قصيدتي "أكره الحبّ". القصيدة التي تورّطت في كتابتها ذات ضجر في بودابست، بلد أتيلا يوجف، قبل عامين ونصف من الآن:
لا أحبّ الرثاء
لأنه محضُ مجاملاتٍ متأخرةٍ
وملاطفاتٍ
نلوكها بعد فوات الأوان،
وأكره المديح
لأنه كذبٌ فصيح.
سحبتني دوامة العمل... لكن طيف سركون بولص ظلّ يرافقني... وفي لحظة سهوٍ سرحتُ بأفكاري إلى مراكش أواخر الثمانينات، عندما استعرت من صديقي الشاعر سعد سرحان ديوان سركون "الحياة قرب الأكروبول" الصادر حينها عن دار توبقال بالدار البيضاء. لقد اكتشفتُ شعراً جديداً خالصاً لا يضاهى على مستوى الفرادة والانفلات. شعر يتقدم خفيفاً من كلّ موسيقى كانت تُشكل لديّ حينها هيكل الشعر. لقد كانت قصيدة سركون بولص ثرّة ثرية بصورها الواضحة الغامضة قوية بنبرتها النثرية الخفيضة والنابضة بإيقاعات سرية تلزمها أكثر من أذن لكي تتحسس موسيقاها الجوّانية. ولقد كان لعوالم سركون بولص كبير الأثر في نفسي... أثر لا يضاهيه سوى الرنين السحري لهذا الاسم الآشوري الغريب الذي اختار المنفى موطناً وملاذاً.. قبل أن يرتضيه مرقداً أبدياً بعد ذلك. لذا كان من البديهي أن يرتبط لديّ اسم سركون بالهجرة والمنفى حتى أنه صار للمهجر عنوانا وللمنفى رديفاً... وهكذا وجدتني أستعيده رمزاً غامضاً حدّ الوضوح في قصيدتي "وئيداً أحفر في جليد حيّ" التي كتبتها ذات حنين في أواخر 1999:
مثل أصحابي هناك
كان لي بابٌ ومفتاحٌ قديمٌ
وسماءْ
كان لي دفترُ أشعارٍ
سريرٌ ورفاقْ.
لكن أغوتني قصائد سركون بولص
أغواني أدب المهجر
منذ الرّابطة القلميّة
حتى آخر قصيدةٍ مجمَّدةٍ
لشاعرٍ عراقيٍّ
ينتظر الاعتراف به كلاجئ
في الدانمرك.
صديقي هشام فهمي
دعك من الحلم عبثاً
بالهجرة إلى سويسرا
واحفظ لقصائدك
شراستها الأليفة.
استعادة صريحة لشاعر أحببته... أما الاستعادة الأخرى فجاءت مضمرة في قصيدة كتبتها في يناير 2002 تحت عنوان "الشاشة عليكم":
لا حياة خارجكِ، فضُمّيني إلى ذبذباتكِ
أيّتها الإلكترونات الرّحيمة
أنا أسيرُكِ المُساقُ برِضاي
سآتيكِ كاملاً غير منقوص
سآتيك بما أخفي وما أُعلن
وبما لم يخطر على بالي بعد
سآتيك بأحلامي وأوهامي
بأسماء دخولي كلّها
وبكلمات السر
سأحمل روحي على فأرتي
وأُلقي بها في مهاوي الكوكيز.
قبل خمسة أعوام، قرأتُ هذا المقطع على سركون بولص في مطعم فلمندي بمدينة أنتويرب البلجيكية. كان ذلك على هامش أمسية شعرية أحياها هناك رفقة الشاعر عبد الكريم كاصد. الأمسية نظمتها "ثقافة 11" الهولندية التي كان يرأسها الصديق ياسين النصير ويساهم معه فيها من أنتويرب ثلاثة مستشرقين بلجيكيين شباب: فرانك أولبريختس وهيلج دانييل وكارلوس تويس...
سألتُه إن كان قد انتبه لشيء خاص أو لفت انتباهه شيء أليف مثلاً. أجاب بالنفي باسماً... لأخبره بأنني كنت معجباً بشطر من شعره قال فيه "مثل خطيفة تذهب برضاها"... لا أذكر أين قرأتُ ذلك ولا متى... لكنه له. وعندما كتبتُ " أنا أسيرُكِ المُساقُ برِضاي" كنت في الواقع أسطو بأسلوبٍ شعري سافر على مقطعه الجميل الذي علِق في مكان مزهر شمال القلب جنوب الذاكرة. ضحك سركون طويلا وقال: "والله لا أذكر إن كنت كتبتُ ذلك... وإن كنتُ فعلت فلا أذكر متى وأين؟؟؟ يعني أنا مثلي مثلك تماماً".
بعد ثلاثة أعوام من ذلك اللقاء، هاتفتُ أخي ياسين الذي كان بمهرجان لوديف الشعري جنوب فرنسا. قال لي: خالد النجار وطاهر رياض وفاضل العزاوي وسركون بولص معي وهم يسلمون عليك...
أما خالد النجار فنحن على صداقة بريدية وتلفونية ثم إلكترونية من زمان، ورغم ترددي على تونس في السنتين الأخيرتين وتردده هو على هذه القارة العجوز إلا أننا لم نلتق بعد... وأما طاهر رياض فقد أرداني صديقاً منذ لقائنا لأول مرة قبل أربع سنوات في بينالي الشعر العالمي بلييج... وأما فاضل العزاوي فأنا أعتز به صديقا كبيراً منذ لقائنا بمهرجان الشعر العربي الهولندي بلاهاي خريف 2002... لكن سركون؟؟؟ لقد استغربت فعلاً سؤاله عني... لأن اللقاء معه كان سريعاً مساءها... وأنا كنت محاصراً بموعد آخر قطار ليلة ذلك الخميس الأكتوبري البارد...
"هل قلتَ 24 أكتوبر؟؟؟" سألتُ فرانك أولبريختس على الهاتف.
"أجل كان ذلك ليلة الخميس 24 أكتوبر 2002.. بالضبط".
" تقصد مثل اليوم تماماً"..
اتصلتُ مباشرةً بعبد الإله الصالحي في باريس... لكن هاتف الصالحي لم يكن يجيب.
بروكسل، 24 أكتوبر 2007
ايلاف
الخميس 25 أكتوبر
****
كانت حياته صباحا أبديّا
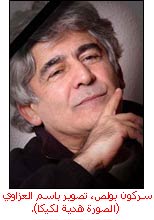 لعل هنري ميللر كان يقصد سركون بولص عندما قال أن حياته كانت صباحا أبديّا، إشراقا لا ينتهي، وأنّه بذرة من العالم القديم زرعتها الرّيح في عالمنا هكذا أتمثّل حياة سركون بولس هذا الشاعر البدائي التّائه، الأشوري الخارج لتوّه من ملحمة قلقامش بجمجمته الآسيويّة المدوّرة هو رامبو وقد قام بسفر معاكس من آسيا الصّغرى إلى سان فرانسيسكو مارّا في سيره بموانئ وأرخبيلات العالم القديم
لعل هنري ميللر كان يقصد سركون بولص عندما قال أن حياته كانت صباحا أبديّا، إشراقا لا ينتهي، وأنّه بذرة من العالم القديم زرعتها الرّيح في عالمنا هكذا أتمثّل حياة سركون بولس هذا الشاعر البدائي التّائه، الأشوري الخارج لتوّه من ملحمة قلقامش بجمجمته الآسيويّة المدوّرة هو رامبو وقد قام بسفر معاكس من آسيا الصّغرى إلى سان فرانسيسكو مارّا في سيره بموانئ وأرخبيلات العالم القديم
يريد أن يذهب إلى مدينة أين
ما تزال إلى الآن الصورة الجانبية لوجهه ماثلة في ذاكرتي في أوّل لقاء معه.
صورة لوجه محارب أشوري لولا أنّه غير ملتحي ويلبس دجينز فضفاض، ويرسل الكلام في الهواء مثل نبيّ بلا شعب.
ما أزال أتأمّله أوّل ذلك الليل ونحن نجلس مع صموئيل شمعون في ذاك المقهى الباريسي في الدّائرة الرابعة عشر، وهو يتحدّث عن كلّ شئ بالشكل الاحتفالي الساخر الذي عرف به، فقد نزل علينا سركون فجأة في باريس خريف ذلك العام كان قادما من سان فرانسسكو أو ذاهبا إليها. وكانت المرّة الأولى التي أراه فيها. قبلها عرفته نصّا في مجلة "شعر". أحببت قصائده التي تأخذ في تداعياتها شكل الحلم و مساره ، وظللت أتابع هذا النصّ الشعري المتفرّد الخارج عن السّرب، النصّ الذي دشّن قصيدة النّثر قبل أن تدفن تحت أنقاض التنظير.
النصّ الذي يقدّم المفردة والعالم في بدئهما، إنّه الأشوري الذي حدّثنا عنه برخس،
الأشوري الذي سمع صيحة العصفور أوّل صباحات العالم فوق نهر الفرات. وظلّت تلك الصيحة تتردّد إلى الآن في قصيدته أو قل ظل يتابعها هو وهي تسيل بشكل غامض في دمائه، وما شعره سوى تجليات لتلك الصّيحة...
لم يكن بولص كما هو شأن الكبار يحتفي بالشهرة ولكن كان اسمه يتردد في القارات الخمس، حدثني عنه ذات مساء وعلى غير انتظار الشاعر لوران غسبار المغرم بالشعوب العريقة من أرمن وبربر وأشوريين وصقالبة؛ وهو يرى في بولس تجسيدا حيّا لقوّة تلك السّلالة، وعندما وصلت إلى نيويورك في تلك السنوات البعيدة كان أوّل اسم ذكرته لي ميرين غصين هو سركون بولص الذي ترجمته إلى الانكليزية، ولكن عندما التقيت سركون - وأنا أدري الآن أنها آخر مرّة - وقضينا أسبوعا مع بعض في لوديف لم يكن يبدو عليه أنّه يدري بصورته لدى الآخرين كان منهمكا باستمرار في حياته و شعره
يعيش غبطة ذاك الصّباح صباح حياته الذي لا ينتهي.
najark@wanadoo.tn
****
في رحيل أسد أشور
23 أكتوبر
مات سركون بولص. مات ذاك الذي "باع حياته ليشتري عينين وفيتين".
مات شاعر شعر الليل. شعر الارتجاف. شعر المصير المعلّق تحت مقصلة سيف دائمة. شعر العزلة والهشاشة والعجز بمعناه النبيل. شعر ضرب الرأس بالجدار. شعر اللاضجيج والانتي ايديولوجيا. شعر الانتماء الى الانسان والتحرّر من أثقال الذات نفسها. شعر الوقوف على الحافة. شعر الحساسية العالية والنبرة الخافتة. شعر الشغف بالشعر.
مات سركون بولص. مات بعدما قال إن "الموت سيدٌ عطشان/ سيشرب كلَّ ما في آبارنا من نفط، وكلَّ ما في أنهارنا من ماء". أمس كتبتُ أخبره أني أحيّيه لا أرثيه. واليوم، أيضاً، اليوم خصوصاً، أحيّيه لا أرثيه.
محطات كثيرة في حياة هذا الأسد الأشوري: ابن الحبانية هو، لكنه ابن بيروت ايضاً. لولب من لوالب "جماعة كركوك" العراقية بقدر ما كان وتداً من أوتاد "شعر" اللبنانية. كتب قصيدته الأولى في الثانية عشرة من عمره عن "الصياد"، وهو صيادٌ بامتياز. انتقل في الطفولة من الحبانية الى كركوك، وفي شبابه من كركوك الى بغداد، وبدأ في نشر شعره وقصصه وترجماته في مجلات وجرائد عراقية وعربية. عام 1963، وبعد رحلة مضنية عبر الصحراء العراقية – السورية، وصل إلى دمشق، ومن هناك تسلل في غفلة من حراس الحدود إلى بيروت. بيروت مختبر التجديد والحداثة والطليعية والفوران والحرية. بيروت الحرية أولاً. هنا عمل في مجلة "شعر" محرراً ومترجماً، وعندما ضاقت به السبل قرر أن يهاجر إلى أميركا. استقر به المطاف في سان فرنسيسكو، المدينة التي أحبها، وكتب عنها قبل أن يراها. هناك تعرف الى أشهر الأدباء الأميركيين، واحتكّ عن كثب بجيل "البيت" من أمثال ألن غينسبرغ، جاك كيرواك، لورنس فيرلينغيتي وسواهم. أما الرحلة الأخيرة فمن سان فرنسيسكو الى برلين، حيث أتى للعلاج، فوافته المنية صباح أمس في أحد مستشفياتها.
مات سركون بولص. مات رغم أنف الشعر الذي لم يستطع أن يخلّصه. مات رغم أنف محبتنا له، نحن عارفيه عن كثب، ومحبّيه عن بعد. مات قبل أن تصدر مجموعته الجديدة "عظمة اخرى لكلب القبيلة". مات رفيق جان دمو وجليل القيسي وأنور الغساني ويوسف الحيدري وفاضل العزاوي ومؤيد الراوي. مات شاعر الشعر بصفته شعراً معيشاً قبل أن يكون قصيدة مكتوبة. مات شاعر الشعر بصفته انتحاراً يومياً على الورق.
كتب سركون يوماً: "البضاعة الوحيدة التي تشبه الذهب هي الطريق".
لا شك عندي في أن الطريق التي يمشيها الآن، ذهبُها من صنيع خطاه.
23 اكتوبر
جريدة النهار
****
أسد أشور الجريح
مرحبا سركون!
حسبي أنك قلق لأننا جميعاً نكتب عنك. ربما تقول في سرّك: "ما زلت حيّاً! كفّوا عن نعيي أيها الأوغاد!". لكنكَ لستَ ممّن يحبون الادعاء بأن كل شيء "تمام"، أليس كذلك؟ ثم نحن لسنا لنرثيك قطّ. إن هذه سوى تحية متواضعة إليك. إلى حياتك خصوصاً. التحيات أجمل بلا مناسبة، طبعاً. لذلك اغفر لنا إذا كان لهذه التحية مناسبة، هي حالتك الصحية المتردية.
أخاطبكَ من هنا، من "مدينة أين" أنا ايضاً، لأقول لكَ إني لا أصدّق أن شعر الشاعر لا يستطيع أن ينجّيه، وينجّينا، من المرض.
حتى هذه اللحظة من عمري، وشعري، لا أزال أعتقد بجوارحي كلها أن الشعر هو نوع من دواء يومي، أنه ترياق يسمّم الألم، وأنه يستطيع في الأقلّ أن ينسّي الوجع هواجسَ الوجع، وأن يجعله يصاب بالدوار، فيطيش قليلاً، ليذهب الى أماكن أخرى بغية تأدية أدوار أخرى.
لقد رأيتُ أشياء وحوادث كثيرة في حياتي هذه، وفي حيوات آخرين، انتَ منهم، كانت برهاناً مستمراً على هذا النوع من الشفاء، أو المراوغة.
اليوم، أيضاً، أريد أن أصدّق. وأكثر من أي يوم مضى، أن الألم يهمّ لكنه لن يستولي، وأنه مشغول بأمور أخرى، وسيذهب ليعوي تحت نوافذ مدن مصقّعة، غير النافذة التي تطلّ منها حياتكَ.
بوهيميتكَ تحميكَ يا سركون، وأنا مطمئنة عليكَ بسببٍ من ذلك.
أيضاً: مطمئنة لأن الشعر، شعركَ المنشور في الكتب، أو المدفون في الخزائن، وخصوصاً ذلك الذي يسيل من براثن حياتكَ الجوهرية، يعطيني البرهان بأنكَ أقوى.
أعرف بالوحش الذي فيكَ، بوحش حياتكَ، وشعركَ، وبوحش حياتكَ الشعرية، أنكَ ستظل تصارع الوحش.
قد ينتصر هذا الوحش في النهاية، لكن ليس الآن، يا سركون. هذا أكيد عندي، وانا أقوله للجميع، من أجل حياتكَ، من أجل حياتنا، ومن أجل الشعر.
صحيح! لم أتعرف اليكَ يوماً. فقد كنتُ في مدينة أخرى، غير مولودة، بعدُ، حين مررتَ أنتَ ببيروت هذه. هذا ليس مهماً الى حدّ كبير. المهمّ أني أعرفكَ تماماً، وأعرف مَن أنتَ، وكيف تموت وتحيا كل يوم تقريباً، منذ جاءت بكَ الدنيا الى هذه الدنيا لتمارس، في كل صقع وغربة، رقصة البهلوان الماجن، هذا الذي لا يعرف سوى أن يتلاعب بالجنون. حياتكَ كلها، يا غريبَ هذه الحياة، هي البرهان، وهذا الشعر الذي لا يكفّ عن قرع الجدار مرةً تلو مرةً، هو البرهان، ولا يصاب بوهن.
يا ابن الحبّانية المراوغ، أيها الغريب الضارب في غربة الأرض، تحت ثقل هذا الوحش العجوز الذي يراود حياتكَ، وينهش، تستطيع أن تفوز الآن أيضاً، لأنكَ الفائز منذ البداية، بوحش حياتكَ، وبوحش الشعر، وهما صنيعاكَ بامتياز!
سلامٌ اليكَ، يا سركون، يا أسد أشور الجريج المجنّح،
سلامٌ اليكَ، بدون سابق معرفة بيننا،
سلامٌ اليكَ، بكامل المعرفة، يا شاعراً كبيراً، وسلامٌ عليكَ أيها الأقوى من المرض خصوصاً! (عن النهار). هذا المقال نشر قبل يوم من وفاة سركون بولص.
جريدة النهار
22 اوكتوبر
قبل وفاة سركون بساعات
****
سركون بولص من نكهةِ المطر
نصّ مفتوح
إهداء: إلى روح الشَّاعر الرَّاحل سركون بولص
تعبرُ صحارى الرُّوحِ
بحثاً عن بخورِ الشِّعرِ
عن تلألؤاتِ شهوةِ الحرفِ
لترسمَ أمواجَ حزنٍ
حنينَ حبِّ
فوقَ مرافئِ العمرِ
تنمو في أزقَّةٍ مكسوَّةٍ بالطينِ
حيثُ سِفرُ الكلمات
منقوشة على رُقيماتِ حفيفِ الجمرِ
وجهٌ مكحّل ببخورِ التجلِّي
بحثاً عن أقنومِ الشِّعرِ
بحثاً عن طهارةِ الكلمة
عندَ ابتسامةِ الفجرِ
تعبرُ حُلُمَاً منبعثاً
من حنايا القلبِ
يتناثرُ حبَّاً على امتدادِ القارَّاتِ
لا تعبأ إلا بحدائقِ الشِّعرِ
كم مرّة حلمْتَ
بتصدُّعِ أركانِ الصَّولجانِ
بانهزامِ طغاةِ الكونِ
من سطوةِ القلمِ
كم مرّة ابتسمْتَ فرحاً
بتهاوي تيجانِِ الصَّنمِ
بانتصارِ القصيدة
على برابرةِ العصرِ
على جلاوزةِ هذا الزَّمان
كم مرة انتعشْتَ
من بلاسمِ الشِّعرِ
من حفيفِ الحرفِ
وهو يغفو فوقَ منارةِ العشقِ
كم مرة رسمْتَ القصائد
على وجنةِ الشَّمسِ
قبلَ أن تغفو عيناكَ فوقَ وسائدِ الغربةِ
يا صديقَ الشِّعرِ والشُّعراءِ
تشبهُ غيمة حبلى بزغاريدِ المحبَّة
وردةٌ هائمة في انبعاثِ الشَّذى
تكتبُ على أجنحةِ الفراشاتِ
شوقُ الأمِّ إلى هدهداتِ الطُّفولةِ
كم تبلَّلتْ مآقيكَ كلَّما جنٌّ بكَ الحنين
إلى أزقَّةِ الحبّانية
متسائلاً
هل يكفي ما تبقّى من العمرِ
كي أنسجَ قصيدةً
من لونِ الحصادِ
حصادُ الشِّعرِ
من أبهى أنواعِ الحصادِِ
تعبرُ صحارى الرُّوحِ
بحثاً عن دماءِ خمائلِ الشِّعرِ
عن صفوةِ الحرفِ
سركون بولص
من لونِ شموخِ السَّنابلِ
كم من التشرُّدِ
كم من الانشراخِ
في جبهةِ الرُّوحِ
حتّى تبرعمتْ أغصانُ القصائد!
لم تعبأ من ضجرِ الغربةِ
ولا من أنينِ العزلةِ
وحدُهُ الشِّعرُ يناغي ظلالَ الرُّوحِ
وحدُهُ الشِّعرُ ينامُ بينَ خفايا الحُلُمِ
وحدُهُ الشِّعرُ يسترخي
فوقَ قبابِ العمرِ
يا صديقَ الحرفِ
يا لون الضُّحى في صباحِ العيدِ
كم من الأعيادِ
وأنتَ تنتظرُ لقاءَ الأهلِ
لقاء الأمِّ
لقاء الأصدقاءِ
لقاء بغداد
تهمسُ لبواطِنِكَ الغارقةِ في الأوجاعِ
بغداد آهٍ يا بغداد
عفَّروا وجهكِ الغزاة
تناجي كَلكَامش
فيرفع رأسه حاملاً نبتةَ الشِّعرِ
أَهذا كل ما تبقَّى
من مفازاتِ الخلاصِ؟!
خلاصُنا من قراصنةِِ العصرِ
خلاصُنا من طغاةِ اللَّيلِ والنَّهارِ
رهانُكَ دائماً كانَ على الشِّعرِ
عبورٌ إلى أقصى أقاصي البحرِ
بحثاً عن مجاهيلِ أرخبيلاتِ الحرفِ
رحلةٌ متعرِّشة بأغصانِ التجلّي
وجهٌ مُحْتَفَى بالحنطةِ
بهلالات التُّرحالِ
هل وصلْتَ إلى "مدينةِ أين"
أيُّها المسافر في بخورِ المدائنِ؟!
يا صديقَ المدائنِ
لا بدَّ أن نحطَّ الرحالَ في "أينِكَ" يوماً
في مُدُنِكَ المطرَّزة برائحةِ العشبِ
في مجاهيلِ القصائدِ
تعبرُ مجرَّاتِ الرُّوحِ
بحثاً عن حنينِ العراقِ
بحثاً عن الأمَّهاتِ اللائي بكينَ
منذ أولى الولاداتِ
حتى آخرِ حشرجةٍ
من حشرجاتِ المماتِ!
كم مرة سألتُ عنكَ صموئيل شمعون
أَما كانت تطنّ أذنيك
طنينَ الشَّوقِ
أيُّها المعجون بشجونِ العناقِ؟!
كم مرّة حمّلتُ صموئيل شمعون عناقيدَ السَّلامِ
هل قرأتَ نصّي
"السَّلامُ أعمق من البحارِ"؟!
هل توغّلْتَ ولو قليلاً
في ضفافِ السَّلامِ ـ سلامي؟!
لم أنسَ عندما قال لي يوماً صموئيل شمعون
طلبتُ من سركون أن يقرأ قصيدتك
"الإنسان ـ الأرض جنون الصولجان"،
قرأ سركون أوجاعَ الحرفِ
بحثاً عن رعونةِ أصحابِ الصولجانِ
هادئٌ في غورِ العبورِ
طويلُ الصَّبرِ
حاملاً فوقَ جبينهِ مفتاحَ السَّخاءِ
يا لهُ من نفسٍ طويل!
ضحكَ صموئيل قائلاً
هذا يا سركون القسم الأول
من اهتياجِ الشعرِ عندَ صبري
ردّاً على جنونِ الصَّولجانِ
ضحك سركون
الله يستر يا صامو من القسم الثاني!
سركون آهٍ يا سركون
لو تعلم
كم كنتُ أتوقُ إلى لململتِكَ
بين كياني الصَّغيرِ
أضمُّ نقاءَ الشِّعرِ
كم كنتُ أتمنّى
أن يصطحبكَ يوماً صموئيل
إلى سماءِ ستوكهولم
محقِّقاً لي مفاجأةَ المفاجآتِ
فلم يفعلها صموئيل
معذورٌ يا صديقي
غائصٌ في حبِّكَ
في نشرِ الجمالِ في كيكا
غائصٌ في امتطاءِ البحرِ والسَّماءِ!
ألومٌ نفسي ملامةَ الملاماتِ
لماذا تلكَّأتَ يا صبري
ولم تبحث عن وسيلةٍ للعبورِ
إلى أبهى قلاعِ الشِّعرِ
إلى سركون وهو ينثرُ حنينه
فوقَ مجامرِ القلبِ؟!
ينثرُ حرفه للنوارسِ المهاجرة
ماشياً على ضفافِ غربةِ الرُّوحِ
زارعاً في وجنةِ الضُّحى بريقَ الشِّعرِ
آهٍ ..
رحلتَ دونَ أن أسمعَ صوتكَ المندّى
ببهجةِ القصائدِ
رحلتَ دون أن أعانقك عناقاً عميقاً
يا قلبي
أخائنٌ أنا في حقِّ القصيدةِ
أم أنني تائهٌ في صدِّ لظى الغدرِ
غدرُ هذا الزَّمان
غدرٌ مبهرج بالفقاقيعِ
بكلِّ أنواعِ الهزائمِ
وحدُهُ الشِّعرُ يطهِّرنُا
من طيشِ الطُّغاةِ
من تفاقمِ رعونةِ الصَّولجانِ!
سركون بولص
صديقُ القلوبِ المكلومة
صديقُ الثَّكالى
صديقُ الغربةِ
(.....)
(........)
سركون بولص
قصيدةٌ مندلقةٌ
من ليالٍ مرصرصةٍ بالبكاءِ
ريشةُ فنان مذهّبة بكنوزِ البحرِ
كتبَ فوقَ وجنةِ المدائنِ
ما تبقّى من فرارِ الحلمِ
ما تناهى إلى مسامعه
من طنينِ حنينِ الأمِّ
في طبلةِ الأذنِ!
عاشَ مسكوناً بهواجسِ الشِّعرِ
شاعراً ممهوراً بحبَّاتِ القمحِ
إنساناً مهفهفاً بنكهةِ النَّدى
نامَ بينَ أحلامِ المدائنِ
بحثاً عن مدينته المستنبتة
بأزاهيرِ الشِّعرِ
تمزّقتْ رئتاه
من خلخلاتِ أجنحة العراقِ
من تهدُّم جبينِ العراقِ
من جنونِ آخر زمان
من تهدُّلِ خاصرةِ بابل
من أوجاعِ نينوى
من أنينِ الحنينِ إلى كركوكَ
من انشراخِ بغدادَ
من تفشّي زوابعَ الوباءِ
من الورمِ المتطايرِ
في أقصى أقاصي السَّماءِ
من بكاءِ الكربلاءِ!
سركون بولص
وردة ملفّحة حولَ خدودِ الطُّفولةِ
أنشودةٌ غافية
تحتَ أزاهير دوَّارِ الشَّمسِ
رسالةُ طفولة مغموسة بترابِ الحبّانية
قصيدة متهاطلة عشقاً
فوقَ بيوتِ كركوك الطِّينية
حرفٌ مترعٌ بنبيذِ الكرومِ
يشبهُ قيثارةَ عاشقٍ
لونُ الغسقِ في أوجِ الوفاقِ
تساؤلاتُ القمرِ
في أقصى حالاتِ المحاقِ!
سركون بولص
بئرُ حزنٍ مندَّى
بنصاعةِ الثلجِ
رحلَ سريعاً
قبلَ أن أحقِّقَ معهُ حواراً
عن أسرارِ العشقِ
عشقُ الشِّعرِ
عشقُ الكتابةِ
عشقُ العراقِ!
رحلَ تاركاً خلفه حبَّاً
على رحابة القارَّاتِ
شعراً مندلقاَ من شهيقِ البحرِ
وجعاً من دكنةِ اللَّيلِ
رحلَ على أملِ الوصولِ
إلى مدينة أين؟!!!
مدينةُ الشِّعرِ
مدينةُ العزاءِ
مدينةٌ مسترخية
فوقَ مرامي البهاءِ!
من الحبَّانية إلى بيروتَ
إلى تلالِ غربةِ الرُّوحِ
كتبْتَ على مدى محطَّاتِ الرَّحيلِ
حرفاً من أغوارِ الينابيعِ
سركون بولص
طائرٌ من لونِ الغمامِ
من نكهةِ المطرِ
من نصاعةِ النَّسيمِ الهاربِ
من قسوةِ الأيامِ
سركون طائرُ الفينيقِ
ينهضُ باكراً
كي يوشِّحَ صدرَ القصيدةِ
بأنينِ الأمَّهاتِ
كي يمسحَ دموعَ حزنٍ
خرَّتْ أسىً فوقَ تخومِ بلادِ آشور
يمسحُ دموعاً ساخنة
خرّتْ فوقَ بلادِ الحضاراتِ
فوقَ بلادٍ مسترخية
على حدائقِ بابل
على كنوزِ الشِّعرِ
كم من البلادِ
كم من الحنينِ
كم من البوحِ والبكاءِ
كم من التُّرحالِ
حتى تلألأ الشِّعرُ
فوقَ شهقةِ الرُّوحِ!!!
... .... ... ... ... يُتْبَع!
تشرين الأول (اكتوبر) 2007
sabriyousef1@hotmail.com
****
النظرة الأخيرة على ابتسامة سركون
عزيزي صموئيل
وصلتني رسالتك. انا حزين بل اني مرضت منذ اول امس. حمى وقرف واحساس بخسارة شئ ما. لم يكن سركون بولص صديقي. التقيته ثلاث مرات في حياتي. اول مرة كانت بعد حرب تدمير العراق الاولى في العام 91.كان ذلك في باريس، في الخريف على ما اذكر، في مثل هذه الايام. كان برفقة الجنابي والتقينا في تقاطع السان ميشيل مع السان جرمان. جلسنا على رصيف مقهى "كلوني" الصغيرة. كان دمثا وبدا لي انه يعرفني منذ زمن طويل. تحدث عن قصة لي نشرت قبل شهور في العدد الثاني من "فراديس" الذي كان مكرسا للهزيمة العراقية التي مازلت تجرنا بأذيالها. فاجئني يومها تواضعه ولكنته وصورة وجهه الشاب. افكر الآن انه كان حينذاك في نهاية الاربعينات من العمر. كما قلت لك تحدث عني قبل ان يتحدث عن نفسه بل انه تحدث بأعجاب عن تفاصيل القصة التي تدور احداثها في كربلاء، وتأكدت وهو يتحدث، بأنه قد قرأها حقا. كان ذلك غريبا في اوساطنا حيث يتحدث الاغلبية عن اشياء لم ولن يقرؤها كجزء من مجاملات عراقية او عربية.
التقيته مرة ثانية قرب معهد العالم العربي بعد سنوات. كان وحيدا ويبحث عن شخص لا اتذكره الآن. التقينا في الساحة التي امام المعهد والتي حملت فيما بعد اسم ساحة محمد الخامس. كان الوقت ربيعا واظن انه كان حزيران من تلك السنة. جلسنا قليلا في المقهى المقابل. توسطنا البار وكان هناك عرب كثيرون يثرثرون بأصوات عالية. تحدثنا قليلا ثم جاءت فتاة عربية سلمت عليه ومضت خارج المقهى. من تلك الجلسة اذكر ابتسامته وتدويرة الحروف في لكنته. لم نبق كثيرا في المقهى اذ سرعان ماتذكر كل منا موعده وغادرنا. بعد دقائق شاهدته في كافتيريا المعهد في الطابق الارضي يتحدث مع آخرين، تبادلنا الابتسامة من بعيد وحيينا بعضنا بأشارات من ايدينا.
التقيته للمرة الثالثة والاخيرة في برلين 2003. كنت هناك اواسط ايلول حيث شاركت في المهرجان العالمي للأدب الذي ينظمه ايلي شرايبر. كان فوزي كريم هناك في امسية شعرية بضيافة نادي الرافدين. ذهبت الى الامسية التي كانت في قبو. التقيت بحميد الخاقاني ومنصور البكري وصديق طفولتي رضا مهاوش. كان سركون هناك. تعانقنا كأصدقاء قدامى، وقال لي انه عرف بوجودي قبل حين. تحدثنا عن القبو وعلق بكلمات قليلة محايدة. كان يبتسم حينا ثم تغيب نظراته حينا آخر كأنه كان يسافر بعيدا في سهول ليس فيها غير الشمس. افكر الآن انه ربما كان ينظم خيوط قصيدة. بعد الامسية. مضينا مشيا الى بار وجلسنا على الرصيف. كان حشدا من العراقيين. كان هناك مؤيد الراوي، الذي تعرفت عليه ذلك المساء. كنت جالسا قرب سركون وبين حين وآخر كنا نتبادل حديثا آخر بعيدا عن حديث تلك الجلسة الجماعية. تحدثنا كثيرا عن انطباعات عودتي للعراق. ثم افترقنا بعد منتصف الليل وبعد ان فرغ البار من الزبائن او كاد. تصافحنا وقال لي : نشوفك... هه
ولم اره بعد ذلك، فقد تركت برلين بعد يومين من ذلك المساء.
اول مرة قرأت فيها اسم سركون بولص كانت في تصدير قصة لعبد السار ناصر نشرت في مجلة "الطريق" اللبنانية منتصف السبعينات."ايها الماضي، ايها الماضي ما لذي فعلت بي. سركون بولص". هكذا كان التصدير. بعدها بشهور اعارني نجم والي، الذي كان اسمه حينذاك نجم عبد الله، احد اعداد مجلة "شعر". كان بغلاف اخضر على ما اذكر. قرأت في العدد ترجمة سركون بولص لــ "عواء" الن غينسبرغ مع مقدمة عن البتنك. ثم سمعت قصصا عنه وعن هروبه من العراق وعن صفعة عبد الرحمن الربيعي له في حديقة اتحاد الادباء في بغداد. يومها قلت لنجم والي: لابد ان صفعة هذا هي التي دفعته للهروب. اضاف نجم : بل انه شتم أمه. فهمت القصة حينها. واليوم وانا اقرأ الاخبار في الصحف فكرت ان الدورة قد اكتملت. لابد ان يرقد سركون في مقبرة الاشورين قريبا من قبر أمه. لا ادري ان كان قد كتب لها تراتيلا بعد موتها كما فعل غينسبيرغ؟
***
عزيزي صموئيل
الحزن يمس الأحياء فالموتى يرقدون بسلام لحظة اغماض الجفن. لا ادري ان كانت هناك " هيدز " ليهيم فيها من لم تقم له طقوس العزاء. لكن الشعراء يعيشون حياتهم الارضية في هيدز ارضية ولن يهمهم تغيير الطابق ، ارضيا ام سماويا. انت وبضعة اصدقاء قلة كخالد المعالي وكاظم جهاد وعبد القادر الجنابي من احتفلتم بسركون في حياته. اليكم العزاء بعد اهله. كان سركون بولص يجمعكم، رغم تنافركم، وهو الذي كان يمنحكم فرصة الاحتفال بعراقيتكم الدمثة. قبل شهرين حدثتني عنه عبر الهاتف بوجع. كان ذلك حين زيارتك لسان فرانسيسكو ولقائك سركون. قلت لي بوجع: انه مريض وقد أبكاك مشهد قدومه اليك. اليوم وانا استلم رسالتك دمعت عيني وانا اقرأ عبارة النظرة الاخيرة التي ستلقيها على صديقك سركون.
اليك كتبت هذه السطور. فأنا لا احب تشييع الموتى ولن اكتب عنهم، فحسب لكني لا اعترف بأن موتهم حقيقة مؤكدة.
اعانقك بمودة
الموت شئ عابر ايضا
جبار ياسين
صموئييل يلقي النظرة الاخيرة على ابتسامة سركون
في سره كان يردد بلغة قديمة
لماذا تركتني وحيدا
لماذا تركتني وحيدا
يا اخي
ايها الشاعر
اين تمضي والعالم على وشك الانقراض
ألم تتعب من معانقة الموت
بعد ثلاث ليال من الدخلة؟
العشاق يغادرون المخدع بعد ليلة العرس
وانت مازلت هامدا كجثة
لن انطق بعد اليوم بلغتنا القديمة
سأضرب عن القول
كما فعل ابي طوال حياته
فأنا الفرح دوما بالحياة
لا اجيد الندب والشجن
رغم النور المكفهر لصالة الموتى
ورغم عيون الاصدقاء الزائغة
ورغم المراثي التي انهالت كالمطر
كيف تخفيت كل هذا العمر بقناع شاعر
كي لايعرفك الموت؟
منذ ان شهدت القلعة الحجرية تشتعل بنيران القصف
منذ الهجرة الطويلة بين تلال عكار
وانت تدندن بأغان لايعرفها غيرك
"في بطن شاحنة تقطع صحراء حوران
كنت والذهب الاسود نسافر نحو الدورادو
وحين وصلنا كان لون الدورادو بلون عشب ذابل"
هذا ماقلته لي يوما ونحن نحاذي ايلنغ برود ـ وي
في قطار لم يجرؤ على التوقف في المحطات
كي لا يقطع لحنك
لأنك كنت تغني باللغة الاشورية.
لحسن حظك، في يوم بعيد ، كان البتنك يملؤون شوارع المدينة بالصخب
لم يتعرف عليك احد وانت تضع اقدامك في شوارع سان فرانسيسكو العارية
قدح من البيرة كان يكفي يومها لقتل الجوع
وذكرى واحدة لقتل العطش
فأكملت سيرك ، مغنيا، في طريق ريفي
وكانت الريح تدفع شعرك للوراء
للماضي في غير انقطاع
لقد سمعت ما يكفي من الموسيقى
ولم تعد تحتاج الى كتبك
وانت تترك العالم المجبول بأحشاء ضحاياه
والشعر نار كما قلت يوما
تحرق الاخضر واليابس من الكلمات
في الخميس الذي نحن فيه
سيبتدأ الاسبوع من جديد
حينما تحلق الطائرة نحو سان فرانسسكو
سيرافقك ملاك واحد يتحدث بأبجدية قديمة
حينما ستحط الطائرة هناك
ستنفتح ارض المقبرة الاشورية
ستعلو اصوات واعشاب برية
وتزهر زنبقة بلون عينيك
سيعجب الناس منها
وثمة صوت سينادي
"حان لك الآن ان تعطينا
شرارة من نارك القديمة ، ايها الرجل
او شئ من هذا القبيل "
husin@free.fr
****
والبريد هل متوفر هناك؟!
تشاء المصادفات أن أفكر بك. ذاك اليوم حين كنت أفكر بمشروع نهضوي لنشر الشعر في بيروت. وضعت الإسم أمام شريكتي التي لم تسمع بك سابقاً، وباشرت بتعريفها من تكون!.
لكني فكرت بك. كنت أعرف أنك في سان فرانسيسكو فقط. لا عنوان لا هاتف لا تواصل سابق مع غير كتبك. وفقط فكرت بك، وكنت الإسم الوحيد من العراق.
بعد ذلك سألت صديقي صموئيل، الذي أفادني برقم هاتفك في البيت لأنك لا تحمل هاتفاً خلوياً، كما شعراء جيلك أصحاب التواصل العابر للقارات. من أجل قطيعة مع العالم كما قلت لي في أول مكالمة. فالعالم غير مهم! هكذا قلت وأكملنا المكالمة حول ديوانك "عظمة أخرى لكلب القبيلة" الذي سمعت أنه صدر لدى الصديق خالد المعالي في دار الجمل. بعد أن تركت المشروع وغادرت لبنان. لكن تواصلي معك لم ينقطع. هاتفتك من المغرب بعد جلسة مع صديقي الرائع حسن نجمي وكنا قد أنفقنا نصف جلستنا في الحديث عن شعرك وعنك وعن لقاءه بك في سان فرانسيسكو. وهاتفتك مرة ثانية للإطمئنان على صحتك وهاتفتك ثالثة ورابعة وخامسة. وفي كل مرة كنت تشعرني بالسعادة وتعطيني الأمل. وكان ولا يزال كتابك في جهازي أقرأه كلما شعرت بالوحدة في البيت والقطار في كازابلانكا والرباط وحديقة المحمدية، الأثر الباقي من زمن الإستعمار. كنت أعرف أنك متعب من صوتك الذي كان يصلني ثقيلاً ببحة تحمل الكثير من الصمت المكابر. وكنت أفرح لأني أسمعك. وفي كل مدينة ذهبت إليها كنت أعتقد أني ذاهب الى مدينة أين. وحين أصل أدرك بأن الأماكن كلها أين !.
آه، نسيت أن أخبرك بأني وجدت في طنجة شاباً صغيراً، تجاوز المراهقة منذ أيام، يحمل كتاباً لك وكتاب محمد شكري بطبعة مغربية شعبية. كان يأكل البيتزا في الطاولة المجاورة لي ويقرأ شعرك. لم أساله من أين هو، ولا فكرت ان أساله كيف تعرف عليك. فقط انتابني الإستغراب من حمله كتابك وكتاب شكري - ابن المدينة الشهير - وتأملت في الحياة التي تصنع من صبي بعمره شاعراً في طنجة التي هي ممراً للعبارين.
قبل أسابيع كتبت لك رسالة على بريدك، لم يصلني رد. وما زلت أنتظر لغاية الآن رداً لن يأتي، ربما. أعرف أنك هناك حيث أنت الآن، لا وقت. الزمن غير الزمن الذي نعرفه ونعيشه حتى الثمل، نشربه كالويسكي، نتسكعه في المدن والحارات والأزقة الصغيرة كالديدان والكبيرة كالأفاعي والموحشة كالموت. كالممرات البيضاء في المستشفيات وأنت خبير بها.
تشاء المصادفات أيضاً، يا صديقي الذي لم أره يوماً، أن تموت. أوليست مصادفة أن تموت ياعزيزي قبل أن ينشر كتابك الذي كان سبب علاقتنا. هي المصادفات إذا التي تخدعنا دوماً. سينشر الكتاب عند من يفهم الشعر ويقدرك وستولد من جديد عراقياً وصل الى مدينة أين. لكن طمني هل هناك بريد.
البقاء لك في الموت يا صديقي
****
عوليس عراقي رحل خارج المتن الشعري العربي
إن ميزة سركون بولص الأقوى هي تطويع الوجد الرومانسي، الذي ورثه شعراء الستينيات عن بدر شاكر السياب، متأثّرين جميعاً، وإن بدرجات متفاوتة، بحساسية هذا الرومانسي المتأخّر، المتأثّر بدوره بالقصيدة الإنكليزية الحديثة. لكن بولص آثر أن يتكتّم على الكآبة السيابية، فأبقاها مطمورة تحت رماد ثقافته الغربية، الأكثر رصانة وقوة. ترك بولص بلاغة السياب وذاتيته القاتمة، واحتفظ بذاك الحدس الفجائعي الهادئ، الذي يشكل جوهر رؤياه الشعرية للعالم. هذا الحدس جعله يروّض العاطفة السيابية، ويصقلها لتظلّ منحرفة عن نموذجها الأعلى، ولتسدّ فراغاً تركه غياب التفعيلة من قصيدة النثر الحديثة. لكن بولص لم يترك الإيقاع بتركه التفعيلة، وبدل أن يكتب قصيدة النثر «َُِّْم ُِمٍ» بمفهومها الحديث، اختار الشعر الحرّ «نْمم ًّمَّْم»، الخالي من الأوزان والقوافي، لكنه الغني بالإيقاع، والمموسق بمكائد البلاغة وحيلها الرّمزية. وقصيدة بولص موقّعة أيضاً بتلك العاطفة الصامتة، ذات النبرة الخافتة، والحياء التعبيري، فهي تختزن عذابات وجودية بكماء، ذاتية وكونية معاً. وهو، إذ يهجر الموقف الذاتي الغنائي، يختار الموضوعية التعبيرية، القائمة على التضادّ والمفارقة «ِفْفلٍُّ»، ويقيم عند تخومها، لكي يدوّن ألم الكينونة، الفجّ والعاري، مثله مثل العديد من أبناء جيله، كفاضل العزّاوي، المولع بسرد العدم، أو عباس بيضون المفتون بجماليات القطيعة، أو وديع سعادة الشغوف بفلسفة الهباء. لكنّ بولص يكتب من وحي تلك الفجوة «الإليوتية» التي يراها تتّسع وتمتدّ أمامه، والتي تفصل الذات عن العالم، واللغة عن الواقع، وتقذفُ باليقين إلى مهب الحيرة. وككل الحداثيين الكبار، يركّز بولص في شعره على معنى اللا نتماء، وقسوة الإقامة في التيه الوجودي، ما يعني بالضرورة حيرة اللغة إزاء دلالاتها، وتأرجحها الدائم بين الغياب والحضور: «هذه الكلمات، أبداً، تهبّ في مفترق الطرقات/ بين النوم واليقظة».
متأثراً بجيل البيت «قمفُّ» الشعري، وحساسية الثورة الثانية في الحداثة الأميركية، التي رسم معالمها آلن غينسبرغ في ديوانه (عواء)، وجاك كرواك في روايته (الغداء العاري)، في مطلع الستينيات من القرن الماضي، تعلّم بولص أن يصطاد لحظته الجمالية بشغف المتصوف، وحذر العدمي، غائصاً في عمق اللاوعي الكوني، مستخرجاً صوراً ملغزة وصادمة، فائقة الرّوعة، ومدوناً أحلام ذات تنبذ ذاتيتها، وتصير هروباً. فالأنا المتكلّمة في شعره هي أنا هاربة، فارّة من تقليد رومانسي أعلى، لا تبوح بقدر ما تتكتّمُ، ولا تُظهِرُ بقدر ما تُخفي، وربما لا تكشفُ بقدر ما تحجبُ. إنها تلك «الأنا» التي تقدّم نفسها دوماً كقناع، كما في مجمل شعر الحداثة. ففي قصيدة (سقط الرجل)، مثلاً، يكتب بولص عن تراجيديا وجودية فردية، كونية الأبعاد والدلالات، لرجل انحنى فجأةً على ركبتيه، في ساحة عامة، كأنما بسبب ألم مفاجئ، أو بسبب قوة عليا غامضة، إلهية أو شيطانية، أو ربما بسبب ضربة حزن مباغتة: «هل قضى عليه الحزنُ بمطرقةٍ يا تُرى؟» لكنّ بولص، في هذه القصيدة المكثفة، المنسجمة بنيوياً وتعبيرياً، يؤكّد ثيمة السقوط بإطلاق، ربما سقوط آدم من الجنة دينياً، أو سقوط الإنسان من إنسانيته داروينياً، أو سقوط الوعي الفردي فرويدياً، وربما سقوط اللاهوت الجمعي نيتشوياً، لكنّ الرّجل القناع، في النهاية يسقط، ونكاد نسمع صوت ارتطامه الخافت في هذه القفلة الرائعة للقصيدة: «سقط الرجلُ فجأةً مثل حصانٍ/ حصدوا ركبتيه بمنجل».
في استرجاع صورة سركون بولص المنسي في منفاه، استرجاعٌ لصورة الشاعر المفتون بالسفر دائماً، منذ مغادرته كركوك إلى بغداد، ومنها إلى بيروت ثمّ إلى سان فرانسيسكو، التي احتضنته لأكثر من ربع قرن. وفي هذا الاسترجاع تحضرني بغرابة تلك الكلمات الختامية لتنيسي ويليامز في مسرحيته (الحديقة الزجاجية) التي يسوقها على لسان بطله الشغوف بالسفر، توم، والتي تقول: «تنقّلتُ كثيراً. كانت المدنُ تتطايرُ حولي كأوراق ميتة، أوراق ساطعة الألوان، سُلِخَت عن أغصانهِا وتطايرت. كان يمكن لي أن أتوقّف، لكنّ شيئا ما كان يلاحقني. يهبطُ عليّ في غفلتي، ويباغتني. لعلّها مقطوعة موسيقية مألوفة. لعلّها مجرّد نثرةٍ من الزّجاج الشفّاف». لا أتصوّر أنني أتذكر هذه الكلمات عبثاً، ففيها الكثير مما يصف حياة وشعر سركون بولص، حتى ليخيل للمرء أن بولص وليس ويليامز، هو من كتبها. والقارئ لقصائد بولص يجد أنها مكتوبة حقاً عن مدن هاربة، أبطالها جوّابو أحلام، يتنقّلون كثيراً بين الموانئ والمحطّات، مطاردين بأشباح وأطياف شتّى. حياة مشدودة إلى وتد، تتحول بين يدي بولص إلى منحوتة زجاجية، تتناثر لحظاتها إلى أسرار شتّى: «ها هي حياتك مشدودة من شعرها/ إلى وتدِ الأيام، كأنهّا امرأة/ تريد أن تبوح لكَ/ بأوّل الأسرار/ وآخرها». ووراء هذا البوح، يكمن ألم وجودي عميق، مردّه الشعور بعبثية الأشياء، وسقوط الكائن فريسة للضياع واللا جدوى: «ثم كانت الأيام/ ودسّ أحدهم بين يدي/ هذا العود، وعلّمني كيف أغنيّ/ بهذا الصوت الجريح».
ولأن بولص يجيد الإصغاء إلى بوح الحياة، نراه يبحث عن معادل موضوعي لها في تلك القصيدة الحرّة، الشرسة والحزينة، التي تطارده ويطاردها. القصيدة التي تشبه الحياة ذاتها. القصيدة الشفافة، الحية، الغنية بإيقاعات العالم. لا ذهنية ولا فلسفية. قصيدة رشيقة، غنية بالإيقاع الداخلي للتراكيب، إيقاع النثر الذي تحوّل بين يدي هذا الشاعر، بوجه خاص، إلى ندّ حقيقي لإيقاع التفعيلة. وهي قصيدة متحركة، تنام على حلم وتستيقظ على حلم. أقصد أنها ليست قصيدة دوغمائية ساكنة. أي ليست رهينة مقولاتها النظرية أو النقدية. ففيها الكثير من رغبة التجريب والمغامرة، على صعيد البنية والموضوع. ولعلّها القصيدة الرحلة (يَُِّْمۖ ُِمٍ) بامتياز. القصيدة الزورق التي تهب عليها الريح، ويأخذنا المدّ إليها، وتأخذنا، نحن قرّاءها، إلى شواطئ مجهولة، بعيدة وآسرة. ولأن بولص مدمن سفر، يتحوّل المتكلم في قصيدته إلى عوليس آخر، لا يهمّه الوصول إلى ميناء أو محطّة، بل تغويه الرحلة ذاتها، فالسفر غاية لا وسيلة. في إحدى قصائده يسأل: «هل أغرتكَ السفنُ إلى هذا الحدّ/وسرتَ كما قلتَ/ على الماءِ؟» كأنما للتدليل على شفافية الرحلة وصفائها، وربّما على عبثيتها وخفّتها، أي خلوها من كلّ هدف أو غاية، تماماً مثل هذا السير الخرافي فوق موج المجاز. وما العنوان الأخير (إذا كنت نائماً في مركب نوح)، الذي خصّ به مختاراته الشعرية الصادرة عن دار الجمل، قبل سنوات، سوى تأكيد إضافي على شغف بولص بالرحيل والارتحال والسفر. هذا إذا لم نذكر كتابه الشعري الأول، (الوصول إلى مدينة أين)، المفتون بالموانئ والمدن والترحال، والذي يبدأ، بكلمةِ «وصلتُ»، وينتهي بكلمة «ذهبتُ»، وبين الوصول والذهاب رحلة مفتوحة على المجهول، تبدأ ولا تنتهي.
وإذا أردنا أن نبحث عن مرجعية جمالية للشاعر، فإننا لن نجدها في شعر أدونيس مثلاً، المفتون بالرؤيا الميتافيزيقية، أو في شعر سعدي يوسف، الشغوف بالسّرد الزماني، أو في قصيدة أنسي الحاج المائلة إلى عذوبة إنجيلية نادرة، أو في كآبة محمد الماغوط المتضورة وحيدةً في عراء المفارقة. ربما كان بولص، من دون أن يدري، يقيم خارج المتن الشعري العربي كلّه، ليس بفضل إقامته الطويلة في منفاه الاختياري، واحتكاكه المباشر بالثقافة الأميركية فحسب، بل ربما بسبب رؤيا فريدة للشعر، تمثل خلاصة فهم عميق لتقليدين شعريين قويين، غربي وعربي. وهي رؤيا المقيم المهاجر في منفاه وثقافته ولغته، المنتمي واللا منتمي في آن واحد. وهذا المكوث بين لحظتين حضاريتين ولغويتين مختلفتين جعلت الصوت الشعري أكثر تفرّداً واختلافاً، وربما أقوى حضوراً وتأثيراً. ونعلم أن بولص ليس بشاعر بلاغة إنشادية ملحمية، مثلما هو حال أغلب معاصريه. لكنه نحّات الومضة الشعرية الخاطفة، وصاحب الضربة المجازية الرفيعة، التي تجعل الشكل توأماً للمضمون.
هي، إذاً، قصيدة سركون بولص وحده. القصيدة المسكونة بألحان خفية، ونثرات زجاج شفّافة ومشعّة. نثرات مضيئة، تؤلف شعراً طبيعياً «كالدّم والكحول وورق الشجر»، على حدّ تعبير عباس بيضون، تتأمّل ذاتها في مرآة اللغة وتحلم بالديمومة: «أجمع نفسي/ عارضاً وجهي للبرق/ وأنا أهذي بانتظار أن تتركني الموجةُ/ على شاطئ مجهول/ مقيداً إلى حجر». من هذا الحجر تولد تلك النثرات الوجدانية والشعورية والفكرية واللغوية، ثم تنصهرُ وتنصقلُ تحت مطرقة المجاز الرفيع، لتنطلق وتطير مثل شهبٍ في ليل دامس . (عن السفير).
****
سركون بولص حياة مستعادة بقوة الألم
مات سركون بولص إذن، مات هذا الشاعر الاختراقي الذي حفر مجرى تجريبياً بالغ العمق في القصيدة العربية الحديثة، وطرح تساؤلاً حقيقياً امام الحداثة الشعرية العربية برمتها.
قصيدة سركون بولص تأتي من أغوار الكلام السحيق، من غابات، من جذر التربة الاصلية، فرادة في الكتابة حد أن تصبح خطراً أو حافة في مجابهة الحياة والموت.
لنقل أن سركون بولص يكتب بيد قابضة على احشاء وعلى جمر الالم. القصيدة عنده تنتظر تلك اللحظة الجوهرية التي سيقتنص فيها الشاعر جوهر ذاته تلك اللؤلؤة في الطريق، ذلك النبع البعيد على حافة منحدرات العالم.
رحلت وتركتنا وحيدين يا سركون، يتيمين بالمعنى الروحي للكلمة، نحن الذين احببناك كما احببنا شعرك المغسول بطين الحياة.
أجل بصقةٌ سوداء في وجه هذا العالم. بصقة لاولئك الاوغاد الذين (قيدوا بالسلاسل امواج دجلة)
هنا حقاً ينتهي العالم المعروف.
"وكل اسرار الأفق هذا اليوم
لا تساوي رغيفاً بغدادياً واحداً"
كنت تقول، لكنك رحلت مع أسرارك ولم تأكل ذلك الرغيف الطازج.
أما بغداد فقد تحولت كلها الى قرص من رغيف جاف ومّر.
مع ذلك أقول كان صوتك قبل أيام قليلة،
صوتك الضعيف يصلني الى مسقط وفي وسط ذاك الصوت رنة ضحكة الانفاس الاخيرة، ضحكة المصير الاسود، ضحكة من يرحل اخيراً الى الابد.
وانا أقول لك:
- تشبث بالحياة يا سركون!
وأذكرك، أُذكّرك بشعرك:
- "كنت ماهراً في رمي الحجارة الى سقوف مستحيلة"!
وانت تقول لي:
- نعم يا زاهر، لكن هذا هو الوقت، الوقت قد حان الآن!
لا أريد أن أكتب عن شعرك لقد فعلت ذلك سابقاً، أريد أن أُعيد الزمن الى الوراء وان أُدير رأس الكوكب كُله الى الخلف ان أُمكن.
أنت الذي كنت وفياً للشعر والحياة، مرحى يا سركون! مرحى لجيل الكتابة والشعر! لن أكتب عن زيارتك الى مالمو يكفي ان أذكرك بحانة سدوري التي فيها كتبت هذه القصيدة المهداة اليك كنت وقتها ضيفاً كالملاك.
قم أيها الشاعر لقد وصلت الى مدينة "أين؟".
***
سدوري والخرساء والشمس
الإشارات تتبع الشاعر إلى عمق الحانة.
يمشي كأنه يجوس خريطة العالم
حيث ستقودُهُ خطواته إلى تلك النقطة،
إلى ذلك المكان ليكتشف مجدداً مظالم الحياة.
كأنما هذا هو ما ينقصه حقاً! هو الذي جَابَ الآفاق
ورافق الطوفان حتى فاض من عينيه.
لكن سدوري وحدها مَن يعرف بأن الشاعر متعبٌ هذا اليوم.
وهناك تلك المرأة الخرساء الباكية - دون أن تذرف دمعة واحدة -
تشكو تستعطف الزبائن كأنما تخاطب الشمس المتلألئة في تلك الظهيرة
في ذلك اليوم على استعدادٍ دائمٍ للمثول أمام الشاعر مشيرةً بلا أدنى لَبس:
بأنها هي المرأة الطويلة كشتاءٍ اسكندنافي قد تمَّ استعبادها حتى النهاية،
حتى فرَّ منها الكلام.
ورأى في عينيها تلك العبارات التي لم تستطع أن تقولها.
"إن الحياة التي تبغي لن تجدها".
مالمو أمثولة كاذبة يا عزيزي الشاعر.
من هنا مَرَّ ابن فضلان أسيراً في سفن القراصنة.
هذه القصيدة من مجموعة "كلما ظهر ملاك في القلعة" التي ستصدر خلال أيام من بيروت
zaheralghafri@yahoo.se
****
وداع الأجمل
حزين أنا كغابة أحرقوا أشجارها.
كمئذنة هجرها المؤذن.
كقرية فلسطينية اقتلعوا زيتونها.
جف ريقي، ولفني الدوار: منذ عقود تعودت أنه هناك في مكان ما، يلاقي الحياة ويكتب الشعر.
هو ليس واحدا منا.
هو أجملنا.ربما لأنه كذلك لا يليق به الموت، إذ هو يجمّل الموت ويجعله أقل وطأة حين نراه يصل رقبة الأجمل.
سركون بولص لم يكن شاعرا يمر ويذهب.
لم يكن وحسب جزء من ذاكرتنا الشعرية المزدحمة بالأسماء والقصائد. كان ولا يزال بريق الشعر في أعماقنا المثقلة بالسواد ، هو الطالع من "أرض السواد" كما الفجر الأبيض وريش الحمام الأبيض والقلوب البيضاء.
أيها الأصدقاء.لا تبحثوا عن كلمات رثائه في جدارة قصيدة النثر. ذلك دفاع لا يليق بموته الذي يأخذ بتلابيب قصائدنا ويفجع أرواحنا.
إرثوه بالقبض على جمرة الشعر في هذا الزمن الكلب ، المسعور والمنفلت من رباط أسياده ينبح المبدعين ويعض قصائدهم.
سركون هادىء للمرة الأولى.
هو لا يقول قصيدة جديدة. ينصت إلى بكائنا وحسب : أيها الشعراء العرب إبكو أنفسكم واتركوه ينام.
سركون..أيها الأجمل ستظل جميلا.
almadhoon8@hotmail.com
***
الموت يخطف القصيدة
ارحلْ، واترك لنا إمضاءاتك على حيطاننا، واتركْ لنا قليلاً من أبجديتك وثمالتك الوجعية على دفاترنا العاقرة، واتركْ قليلاً من قطرات حبرك الأسود لنخطَّ به قصائد لحبيباتنا، وقليلاً قليلاً.. من خارطة قلبك المطلة على الوطن من كل الجوانب..
اليوم.. لن نوزِّع على نفسنا ملابس النوم، فليلُنا طويل إلى حدَّ العبث.. وقلوبنا تتقاطر دمعاً على الضلوع.. لا وقت يكفي للبكاء، لا شيء ينفع سوى إلقائنا قصائدك بأصواتنا الجهورة المخرَّشة بنيكوتين السجائر والمسكونة ببحّة العرق المغشوش في الحارات العتيقة وفي مقاهي بغداد.
سنقفل المقاهي.. وننصِّب دلال القصائد في الشوارع.. ونقف وقفة حزن طوال العمر عليك.. سنهجر الحبيبات، ونصنع من أبواب منازلنا نعوشاً.. ومن أغطيتنا المنقوعة بالعرق أكفاناً لموتنا..
النجمات اختبأن خلف القمر خشية أن يرى أحد بكاءهن، والقمر شاحب غارقة عيونه بالنجوم..
أيها العرّاف، من سيَفُكّ سحر الأطفال؟.. والطفلة العراقية من سيمسح دمعتها؟..
جبل القديس.. أصبح سهلاً.. فمن سيرثيه؟
"ضريحُ الوليّ تنقصهُ بضعُ آجرّات"..
وضريحك، هل تنقصه آجرّات؟، سيصنعها الشعراء من أوراقهم، أو ربما من أضلاعهم المحنية عليك..
إلى أين سكّة ختامك، في مقبرة، في كتاب، في قصيدة، في أرواحنا، في قصائدنا؟ أم في عراقنا..
Art87omar@yahoo.com
****
عن موت سركون بولص
اتهام
تفّا ًليد آبهة بالمصدر، حيث تنحدر السيول. تفاً لغرائب البلاد تسوقها الرياح وتبعثرها الحناجر.تفاً لغاتسبي العظيم، لزيارة السيدة العجوز وانتقام الماضي.لحلزون الفطنة لأثرياء الخراب وحثالة الكتاب. تفاً لجواب مكتمل القيافة.
أصناف من بقر وماعزومآذن، بل من القسم على شراكة تشد الأيدي وتطلق النار ثأراً لخطيئة. أصناف قبلية ومتمدينة في شعواط ودخان. تفاً لرفاق الوقت الضائع، لحرامية في زي الضحايا، لمستقبل ٍ نصفه أعزل والثاني دخيل، ثم ألف وألف لمثقف أسقط يساره في الموجة بين الزعانف والطفيليات وعمائم بالأبيض والأسود، قريبا من تآمر الأخوة، حيث غزاة ٌ وخونة ٌ وسلالة أشاوس، بعد انفصال الكرخ عن الرصافة، والكاظمية عن الأعظمية. فصيلة ظربان وضباع ومشاعل. تفا ً للصحف والإذاعات، لا عالبال ولا على الخاطر. تفا ً لناتج البطالة للكوادر والخطب، كما الليالي وصفت ضوءنا الأول. عُدْ إلى الليل فالحب الكسير ينتظر. عُدْ إلى أبراج الساعة وسلحفاتها الكبيرة، مكّمماً مثل سمكة خرساء على اليابسة، هناك لا الكفاح المسلح ولا الناي الحبيب، هناك لم تعد "لا" مرجعية لنبع، بينما تنسى كزبرة الجلد واقعيتها.
كذبٌ ذاك الرنين. كذب ذاك الوقت، عطاياه وجمال قوامه وأنانيته. كأن هبّة ً من دوار تأخذ المتيم إلى لماذا ؟
مقاطع من سنين لم تروضها الإنقلابات ولا صدمة العسكر. مقاطع من ديناميت وقرقعة مصادفات. أنت المتخلف عن المباراة جائزتك الوحدة، لعلها تضيئ بجهد شمعة وكبريائها، بيوم وطنيّ للقطيعة، بالأغنية، بملذاّتها والسلوان، بعمق لياليها ومناديلها المرفرفة، بلضمير والندم يمثلاّن دوريهما.
التحالف ينفي غريمه، كلما انقطع التيار عن العاطفة، لأنّك في حيّز الجنسية وشكوكها.
يأتي يومها تلك الصبوات، يأتي يومها الإحتمالات، كي تعيش منفردة بمراياها، كي تنادي بلادا ً عارضتها مؤسسة الله وقيدتها اللحى، كي ُتبقي الوفاق مهدّدا ً بالسفر البعيد. مذْ ستينيات الأصوات، سبعينيات المرايا: العواصف والجدل، عندما بان الحمل على المرأة وهي تنظر إلى الشفق. ربّما هي جريمة الحّب، الصورة النقدية للمثل.
رفاقُ تائهون يصلّون لمستقبل الضحية، عند العمى والهتاف، عند المصب. ثم 63 و68 إلى آخره ..
لذا
سوف أسحق الوردة، وأتفّ على الحدائق
ألعن المرأة َ في قصائد هذه الأيام
وألطخ بالخراء وجوه السياسيين الحمقى
وبالهجاء أعنون اتهاماتي.
jalil344@hotmail.com
***
عزيزي النبيل الرائع سركون بولص:
ما زلت احتفظ بطعم البسكويت!
لم أتكلم معه سوى مرة واحدة بالتلفون، لكنني عشت معه معظم شعره.
اتصلت مرة بصديقي صموئيل فأخبرني ان سركون الى جانبه، ففرحت كأي طفلة يقولون لها: بان السماء ستمطر لعشر دقائق كل أنواع البسكويت بالعالم تكفي سنين عجاف... أو أن يقولوا لها ستتكلمين مع والدك الغائب منذ دهر ليعطيك سر الشعر وسر شفافية الكائن في عشر دقائق.
تضايقت من ضيق الوقت. لكنه كافيا أن أعيش بها لفترة طويلة في مرح وثقة بان الشعر هو روح الكائن ومكان الكائن وزمن لا ينتهي. ولا أبالغ أبدا ازددت قوة حينها كنت في عمان العاصمة حيث الإقامة يجب تجديدها كل ثلاثة أشهر، حيث اللا استقرار.
قلت له كم أنا سعيدة لأنني أتكلم معه ؟قال لي حقا؟ بصوت طفل حزين وأستاذ كبير وتخيلت ابتسامة خجلى هكذا ترجمتُ صوته حينها.
قلت له إننا في العراق نستنسخ (نصوّر) كتاباته القديمة والحديثة (بسبب الحصار الدولي وبسبب اجرام وغباء النظام السابق في منع كل من يحسب على المعارضة ضد سياساته) فما تصلنا نسخ محدودة كأنها جرع من الممنوعات من أصدقائنا في الخارج.عن طريق بعض الضيوف الشرفاء إلى مهرجان المربد او عن طريق من يسافر خارج العراق في إيفاد رسمي ليعود ببعض الكتب وقد قام بتهريبه تهريبا فعليا بدون زيادة أو نقصان عن أي عملية تهريب أخرى!
رد بصوت شيخ اكتشف أخيرا أنه يملك ثروة في مكان ما ولكن بهدوء ... صحيح؟ لم أكن اعرف إن لي هذا الصدى مع الأجيال الآن في العراق؟
قلت له بمرح طفوليّ آخر ((طبعا !...و إنني فخورة كوني من مدينة كركوك حيث هو وجماعة كركوك)).قال لي بأنه يقرا لي أحيانا في صحف العراقيين في الغربة ...
كم كان كبيرا ومجردا من كل أمراض بعض الشعراء. كان طفلا يا الهي، طفلا بكل معنى الكلمة.
في عشر دقائق ... التقطت ما غاب من الشعر في العراق والآن التقط بصوت مخنوق ما غاب من العالم من شعر وروح ... ألا ترون بان عمل الموت مع شعراء العراق أصبح (فاهيا) جدا! (فاهيا ) جدا.
قبل ان اسافر الى الاردن عام 2001 بايام، كنت قد زرت في مدينتي كركوك الاديب والقاص في جليل القيسي وهو من أصدقاء سركون القدامى جدا في كركوك. وعلى سبيل افتراض يائس حملني جليل القيسي سلاما حارا لسركون لو التقيت به في اي مكان من الكرة الأرضية طالما إنني أسافر خارج السجن الكبير العراق!! وكنا قد تحدثنا طويلا أنا والأستاذ جليل القيسي عنه وعن مشروعه الشعري وجماعة كركوك.
ولم انس في لهفة كلامي مع سركون بان أوصل له سلام جليل القيسي ... فرد:
"اللللللللله جليل حبيبي كيف هو سمعت انه مريض أرجوك أن تقولي له إنني أحبه كثيرا لو بينكم اتصال إلا إنني سأحاول الاتصال به أيضا"!
ألا يكفي هذا الموقف أن يتهم النظام السابق بجريمة ضد الإنسانية ضد قطبي الشفافية جليل القيسي وسركون بولص.؟
جميع شعرائنا الموتى حرموا من الاحتفال بهم، تسألنا أرواحهم وهم يسافرون قبلنا إلى مدينة (أين)....؟؟!! الى اين ايها السيد النبيل يا سركون ؟؟ هل وجدت اينك؟
أشباح شعراء العراق يطوفون في مدن العراق التي حرموا من العيش فيها منها او عاشوا فيها ولم يستطيعوا أن يسافروا منها يوما ليمارسوا الاشتياق الصحيّ وليس القسري ّللعراق من خارج الأسوار..
كعادتي مررت بكيكا رأيت الخبر صمتت فقط.... نمت طويلا ذلك اليوم ولم اذهب للجامعة الا اليوم الأربعاء .. نعم لقد رأيت خبر مرضه لكنني لم أكن أريد أن اصدق باني سوف اسمع قريبا بان نفسا أخر من عمالقة الشعر العراقي سيحرمنا من زفيره في هذه الدنيا الخانقة.
أحيانا حين تستيقظ صباحا تتنبأ خيرا حين تعرف أمثاله مازالوا يتنفسون ويعيشون شعرا.
أصدقائي الشعراء العراقيين..... سنموت جميعا ..ونحن نحلم بعراق الشِعر لا عراق المغضوب عليهم من قوات أجنبية ومن مسلحين مجهولين، (واقصد هنا بالأجنبية أيضا العربية) الواردة باسم المقاومة غير الشريفة التي تحصد روح العراق وليس روح المحتل.وتحصد حقنا الطبيعي حتى ولو بجنازة على رأي الشاعر العراقي المغترب صلاح حسن.
أصدقائي شعراء العراق سنرفع رؤوسنا خلسة (ونحن موتى) لنرى من يمشي في جنازتنا من أحبتنا الذين سنشتاق أليهم فلا نجدهم ...
لم أفق بعد من غيابي اللاإرادي عن جنازة أصدقائي الحميمين الذين كانوا يبحثون عني في جنازتهم !! جنازة جليل قيسي ورعد مطشر وحسين الحسيني... أومن يسقط شهيدا من معارفي وأبناء أصدقائي ضمن الرحلات القسرية من قبل المجاهد المنتحر الذي يجعل من دماء الأبرياء بنزينا لرحلته الغبية للجنة .
أي عزاء يا سركون ...اي عزاء سيكفيك!؟
Hope2_life@yahoo.com
***
سركون
أراهُ بعيداً
أراهُ يجوبُ سماءً بعيدة
يسوقُ غماماً
او يستنزلَ مطراً
ويُرضعُ جذوةَ الشعرِ
من وريده
أراهُ قريباً
حاملاً فانوسهُ
يبذرُ في الظلام
نجوماً عديدة
يضيءُ ليلَ الذئابِ من زيتهِ
ويشعل الكون حباً
ليهدأ روع الطريدة
أراهُ وحيداً
نازعاً عنهُ عسفَ اشياءهِ
وجسداً طاغيةً لايريده
نازعاً عنهُ كل شيءٍ
كأسهُ
تبغهُ
شحُّ أيامهِ
نهرينِ من أشواقهِ المَديدة
عدا تاج القصيدة
salaam_sad@tele2.se
***
مؤسّسُ مدينة أين، سركون بولص
من "كركوكَ" الفقراءِ إلى "بغدادَ" السّمواتِ
إلى "بيروتَ" ..إلى "سان فرانسيسكو" اللهِ
ثمَّ إلى "برلينَ" آخرِ جدارٍ للهِ
كيفَ رسمْتَ سِككاً خفِيّةً بينَ حاناتِ الصّحابةِ ومقاهي الفقراءِ
لتكتبَ مصحفكَ الأوّلَ " الذّهابُ إلى مدينةِ أينَ "
تلكَ المدينةُ التي تتسَكّعُ فيكَ نحلاً و أرائجَ برزخٍ
كيفَ ابْتَنَتْ هذي المدينةُ مَصاطبِها داخلكَ منذُ أنْ غادرتَ سِواها
كأنكَ وحدكَ من يعرفُ سِككَ المدينةِ هذي
وفي "برلينَ" محطّتكَ القصوى
صباحَ 22 تشرينَ الأوّلِ كنتَ على سفرٍكما العادةِ
لكنَّ السّفرَ اختلفَ صباحَ 22 تشرينَ الأوّلِ أو غيّرَ سِكّتهُ
القطارُ السّرِيُّ يصفرُ في الأعماقِ
القطارُ بأجنحةٍ من أوراقِ تشرينَ الأوّلِ
القطارُ الأحدُ
ذو المقعدِ الأحدِ
لِتُقلِعَ وحدكَ في النّبوءةِ إلى حيثُ مدينةِ أينَ و
بينَ يديكَ تُصَلْصِلُ مفاتيحُ المدينةِ المُشتهاةِ
وحدَكَ يا أميرَ المدينةِ المُشتهاةِ
وحدكَ الجوّابُ وَوحدكَ الآنَ في مدينةِ أينَ
" سركونُ " أقولُ : إلى أينْ..
*ليلاً \أواخر تشرين الأوّل\طول كرم
Tareq_alkarmi@yahoo.com
****
وداع الأجمل
حزين أنا كغابة أحرقوا أشجارها.
كمئذنة هجرها المؤذن.
كقرية فلسطينية اقتلعوا زيتونها.
جف ريقي، ولفني الدوار: منذ عقود تعودت أنه هناك في مكان ما، يلاقي الحياة ويكتب الشعر.
هو ليس واحدا منا.
هو أجملنا.ربما لأنه كذلك لا يليق به الموت، إذ هو يجمّل الموت ويجعله أقل وطأة حين نراه يصل رقبة الأجمل.
سركون بولص لم يكن شاعرا يمر ويذهب.
لم يكن وحسب جزء من ذاكرتنا الشعرية المزدحمة بالأسماء والقصائد. كان ولا يزال بريق الشعر في أعماقنا المثقلة بالسواد ، هو الطالع من "أرض السواد" كما الفجر الأبيض وريش الحمام الأبيض والقلوب البيضاء.
أيها الأصدقاء.لا تبحثوا عن كلمات رثائه في جدارة قصيدة النثر. ذلك دفاع لا يليق بموته الذي يأخذ بتلابيب قصائدنا ويفجع أرواحنا.
إرثوه بالقبض على جمرة الشعر في هذا الزمن الكلب ، المسعور والمنفلت من رباط أسياده ينبح المبدعين ويعض قصائدهم.
سركون هادىء للمرة الأولى.
هو لا يقول قصيدة جديدة. ينصت إلى بكائنا وحسب : أيها الشعراء العرب إبكو أنفسكم واتركوه ينام.
سركون..أيها الأجمل ستظل جميلا.
almadhoon8@hotmail.com
***
لم تكنْ معكَ سوى كفِّكَ
إلى: سركون بولص
لم تكنْ معكَ سوى كفِّكَ..
زرقاءَ كأنها حياةٌ مخذولةٌ..
مفتوحةٌ كأنها سؤالٌ أبديٌّ خائبٌ..
لم تأخذْ معكَ سوى يدِكَ مدونةً..
فيها رائحةُ سينما السندبادِ..
وقبضةٌ من نسيمٍ شارعِ الرشيدِ..
مقهى هنا.. كوبُ شاي هناك.. قصيدةٌ نصفُ مكتملةٍ.. قصيدةٌ لم تكتملْ أبداً..
لم تكنْ معكَ سوى كفِّكَ..
وبرلين تنطفئُ في إغماءاتِكَ الثقيلةِ..
وتوقَدُ بغدادُ من آخرِ خفقةٍ لقلبِكَ النائمِ كشفةِ طفلٍ..
ها أنتَ تتلمسُكَ الوجوهُ في قصائدِكَ..
ويخذلُكَ الهواءُ.. وكرمةٌ جنبَ نهرِ الفراتِ..
لم يكن معكَ في ليلِ برلين القارصِ سوى قصيدةٍ تكتبُكَ..
وغمامةٍ تمرُّ ولا تلتفتْ لحقولِكَ..
وموسيقى تسهرُ بين جفنيكَ..
تسهرُ معها حيطانٌ وأزقةٌ..
أقدامٌ مشققةٌ وأيادٍ طريةٌ..
خطواتٌ تتبعثرُ قربَ الاكروبول..
ونظراتٌ مازالتْ تلعبُ مع سقوفِ المقاهي..
تسهرُ معكَ نخلةٌ وقيلولةٌ..
كفٌ مفتوحةٌ وقصيدةٌ نسيتَها تحتَ لسانِكَ..
وتنطفئُ أنفاسُكَ في المستشفى الغريبةِ..
ويموتُ النهارُ.
nazem1965@yahoo.com
**********
سركون بولص، ايها الشاعر الفذ
برحيل الشاعر العراقي الكبير سركون بولص يكون المشهد الشعري العراقي خاصة والعربي عامة قد فقد واحدا من عمالقة قصيدة النثر ومن المجددين الذين استطاعوا ان ينقلوا الذائقة العربية وبمهارة قلّ نظيرها من القصيدة الكلاسيكية الى قصيدة النثر. فيما تجاوز سركون بولص في قصيدته الكثير من أقرانه ومجايليه والذين سبقوه، واستطاع بولص منذ بداياته الاولى ان يتسلل خلسة الى قلب المتلقي وان يحدث أنفلاقاً شعرياً داخل القصيدة الحديثة في عقد الستينيات، الامر الذي أنتبهت اليه حينها الشعرية العربية برمتها قبيل ان يغادر وطنه العراق في أواخر العقد الستيني من القرن الماضي .
لم يكن شاعرنا يوماً من الايام يحب الاضواء والاحتفاء به كبقية الشعراء غير انه ضل مواظباً على كتابة القصيدة وتطورها بطريقة المثقف البارع والشاعر المجدد الذي كلما كتب قصيدة جديدة أبدع في تكوينها وتجسيد ملامح صورها البارعة، الامر الذي جعله يتأنى كثيراً حتى يصدر مجموعته الاولى (الوصول الى مدينة أين) في عام 1985، لقد ضل سركون بولص اكثر من عقدين من الزمان وهو يجرب ويجدد في قصيدة النثر حتى رسى على الصورة الواضحة تماماً بعد قراءات واشواط طويلة في معترك المعرفة الشعرية، فهو يمتلك ثقافة واسعة ذات مناخات مختلفة أهلته لان يصنع قصيدة مغايرة عاكسة لمرآة الشعر الحقيقي والذي من خلاله استطاع بولص ان يأتينا بخلاصة الشعر من اعماق البحر، ومن أبعد كوكب في السماء، ومن زوايا درابين المدن المنسية، ومن الارصفة وشوارعها، ومن الغابات وأشجارها صاحبة الظل، ومن الحزن العميق والفرح البائس الذي لم يعرفه العراقي يوماً، ومن الحروب وويلاتها والسلام الذي لم نراه، ومن الحب والاخلاص، ومن الحياة والموت، ومن الطفولة حتى الشيخوخة، ومن الصحراء ورمالها، ومن الشتاء وزمهريره، ومن الصيف وقيظه، ومن كل شيء بعد أن تمكن في ترحاله الطويل من أن يتعرف معرفة دقيقة على مجمل الآداب العالمية ويقارن ما بينها وبين الشعرية العربية. أنه الفنان الماهر شعرياً بتفاصيل الحياة اليومية وبدقة، كما وأنه وظف أحسن توظيف الزمكانية داخل قصيدته التي شقت طريقها المغاير ..
قبل ثلاثة شهور كان سركون بولص قد نشر مجموعة من قصائده الجديدة في موقع كيكا الثقافي ، وهو مقل جداً بالنشر هنا او هناك ، وحين قرأت القصائد ، كنت كمن تلقى لكمات متتالية ، لقوة النصوص التي نشرت ! فكتبت أليه معرباً عن اعجابي الشديد بتلك القصائد وسائلاً عنه، وفي اليوم التالي جاء جوابه ليقول:
(عزيزي هادي، جميل أن أسمع منك وأشكرك على كلمتك بصدد القصائد
في هذا الزمن، كما يبدو يا صديقي، لم يعد لنا نحن العراقيين سوى أن نعري قلوبنا ونحن ندري أن العراقي وحده، أينما كان، سيفهم، . يسعدني أنك اتصلت في هذا الوقت، إذ أنني مسافر الى أوربا بعد اسبوع، وقد أعبر الى أسكندينافيا، من يدري.
على أية حال سأراك بالتأكيد فأنا باق لمدة طويلة بعيداً عن بلد الأوباش هذا، محبتي وتحياتي/ سركون .. 5/6/2007) .
من خلال رسالته هذه أحسست بالعزلة الكبيرة التي يعيشها هذا الشاعر الفذ على الرغم من أنه أحب سان فرانسسكو ومكث فيها سنوات طويلة جداً، كان حدسه في الموت واضحاً وكأنه يعلم سيبقى فترة طويلة حيث رقاده الابدي في برلين وما بين أصدقائه الذين احبهم وأحبوه، ففي برلين يموت شاعر العراق المجدد سركون بولص الذي رفد الشعرية العربية بتجربة غنية بألتقاطاتها وتصورها وموضوعها الانساني البحت
. لقد أستطاع ان يتخطى المحلية ليصل الى العالمية ، فقد ترجمت قصائده الى الكثير من اللغات العالمية وتعرف على اهم الشعراء في العالم خاصة من الامريكيين الذين يمثلون جيل (البيتنكس) مثل ألن غينسبرغ وغريغوري كورسو ولورنس فيرلينغيتي وبوب كوفمن وغيرهم ، كما وأن شاعرنا الراحل أرفد المكتبة العربية بالعديد من الترجمات ونقل لنا الكثير من شعراء العالم الى العربية .
في عام 1985 أصدر سركون بولص ديوانه الاول الوصول الى مدينة أين ، ثم تتالت مجاميعه الشعرية الاخرى، الحياة قرب الاكروبول 1988، والاول والتالي 1992، وحامل الفانوس في ليل الذئاب 1996، وإذا كنت نائماً في مركب نوح 1998، كما وصدرت له مختارات شعرية مترجمة بعنوان (رقائم لروح الكون)، ومختارات قصصية باللغتين العربية والالمانية بعنوان غرفة مهجورة، وكذلك سيرة ذاتية بعنوان شهود على الضفاف، وكان قد وضع اللمسات الأخيرة لديوانه الجديد (عظمة أخرى لكلب القبيلة) الذي سيصدر هذه الأيام عن دار الجمل بألمانيا، إلا أن الموت جعله لم يشهد صدور هذا الديوان المهم، وسيتكفل الشاعر خالد المعالي ناشر الديوان بالاحتفاء به بعد ان رحل سركون عن الدنيا بسرعة احدثت صدمة كبيرة لمحبيه وعشاق شعره وروحه الطيبة ..
بستان الآشوري المتقاعد
النجوم تنطفي فوق سقوف كركوك وتلقي
الافلاك برماحها العمياء
الى آبار النفط المشتعلة في الهواء ،
إلى كلب ينبح في الليل ،
مقيداً إلى المزراب ، حزناً ؟
أو رعباً أو ندماً ،
وضفادع تجثم على أعراشها الآسنة
في بستان مهجور
عندما تشق حجاب الليل صرخة مقهورة ،
إنه الآشوري المتقاعد يقلع ضرسه المنخور
بخيط مشمع إلى أكرة الباب
ثم يرفس الباب بكل قواه مترنحاً
وهو يئن مغمض العينين ،
الى الوراء.
يتبع..